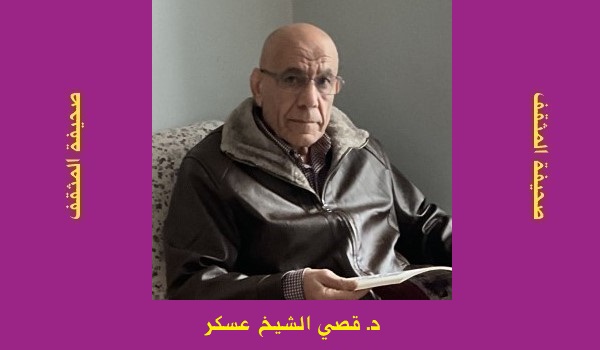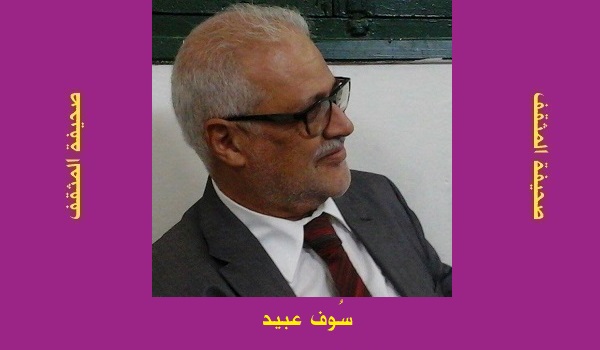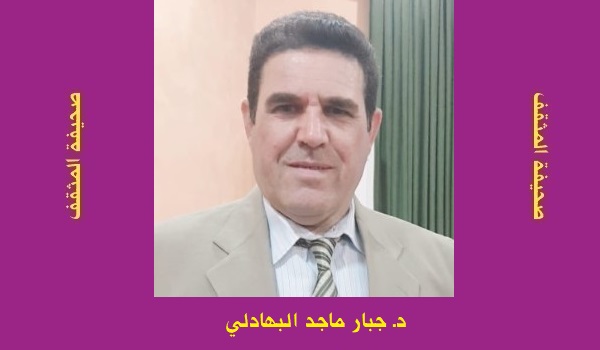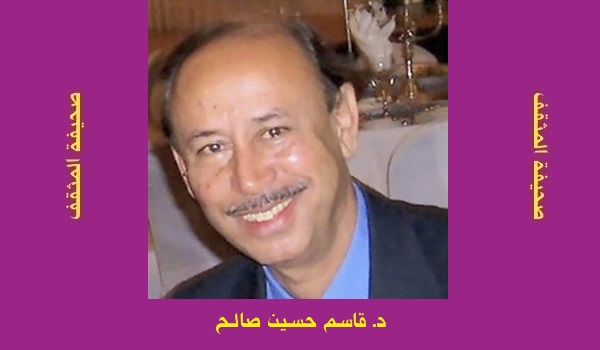دِراسةٌ في شَخصيَّاتِ رِوايةِ (بَابُ الدِّروَازةِ)
تَقديمٌ: (بَابُ الدِّروازَةِ)، مُدوَّنةُ رِوايةٍ للأديب العراقيّ والكاتب الشُّمولي المثابر علي لفتة سعيد، والفائزة بجائزة الإبداع السرديّ العراقيّ لعام (2023م) في حقل الرِّواية التي أطلقتها وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق. تعدُّ هذه الرواية في تصنيفها الأجناسي من الأدب الرِّوائي السِّيري، أو السرد الذاتي التوثيقي للشخصيِّات الروائيَّة (أصواتِ الرِّوايةِ)، أو رموزها الفواعلية القائمة بالحدث، والتي بُنيت عليها وقائع وأحداث الرواية في تَراتُبِها وفق الخطِّ الزمني المُمتدّ لها تاريخيَّاً بنحو ثلاث سنوات، من عام (1978م حتَّى بداية عام 1980م). وقد أشار الكاتب لهذه الأرخنة التاريخيَّة في مطلع افتتاحية السطر الأول من الرواية، وتحديداً في جزئها الأول، ثمُّ تِباعاً في أجزائها العَشرةِ.
تعتمد رواية (بابُ الدِّروازةِ) في تنامي بنائها الهرمي الحثيث وحركة سَيرِها السَّردي الفعلي بالدرجة الأولى على تقنية الحوار الداخلي أو (المُونولوج) الحركي الدَّرامي الذي يمنح السرد الذاتي السِّيري بُعدَاً إثرائيَّاً وفكريَّاً فاعلاً لديمومة الحدث الجمالي في تصاعد ديناميَّة صراعه زمانياً ومكانياً. وقد تمثَّلت تَمظهرات هذا الحوار وحِدَّةُ تشابكه الحَدَثي أو أوج عظمتها بين شخصيَّة (سعيد)، الرجل العلماني بائع الثلج في باب الدِّروازة، وشخصيَّة المجاور لمحلَّه ونظيره (هادي) بائع السِّبَحِ والسِّجاد وتُرب الصلاة،الرَّجلُ المُتدين والمُتلفع بعباءة الدين الإسلامي شَكلاً ومضموناً.
وأنَّ وتيرة هذا الحوار الفكري الناشب عقائدياً وفكريَّاً بين الشخصيتين المتضادتين والمُؤدلَجتين كانت سبباً مهمَّاً من أسباب نزوح الكاتب إلى أنْ يكون تسريده الحكائي لواقعة الحدث الموضوعيَّة على أساس بِنية المِيتا سرد الحداثوي في وقعه الأُسلوبي الذي يلفت اهتمام القارئ وعنايته له، ويَحضُّهُ ذهنيَّاً على التواصل مع مجريَات الحدث الرِّوائي الشائق في التتابع وعدم تركه حتَّى نهاياته الأخيرة. خاصةً وأنَّ الكاتب (السَّارد) قد برعَ في توظيف تقنيتَي (الاستباقِ والاِسترجاعِ) وتوزيعهما على انثيالات فضاء السرد بطريقةٍ فنيَّ وأُسلوبيةٍ تُريحُ المتلقِّي والقارئ وتُسهم إيجابياً في تنامي وتسريع عجلة الصراع الدائر بين الشخصيَّات المتشابكة، وفكّ حبكتها العُقدية المغلقة.
هذا من جانب ومن جانبٍ آخر تمنح المتلقِّي والقارئ معاً مِساحةً كبيرةً من حُريَّة التفكير والتماهي -زمكانياً- مع أنساقها في فهم وقائع أحداث الرواية والاستمتاع ذائقياً بمشاهد حركة شخوصها في حقبةٍ مهمِّةٍ من تاريخ العراق السِّياسي الحديث، والتي ما زالت تأثيراته السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والدينيَّة والثقافيَّة عالقةً في الذهن العراقي. فضلاً عن أنَّ هذا اللَّون من الكتابة السردية ذات الطابع السِّيَرِي والتوثيقي المَدِيْنِي الَّذي تميَّزت به أُسلوبية الكاتب علي لفتة سعيد في خاصية معجمه السردي يجمع في إبداعيته التعبيرية وفنيته الموضوعية الكتابية بين اشتغالات التنقيب في حفريَّات الذاكرة الجمعية المشتركة، والتجريب الذاتي الفنِّي، وبين الواقعة السِّحرية المُتجدِّدة وخاصيَّة التأمُل الفكري والفلسفي الذي يعطي العمل الأدبي أهميةً كبيرةً، وميزةً مغايرةً في السرديَّات الحديثة. ولهذا لا يمكن أنْ نعدَّ سردياَّت متن (بَابُ الدِّروازةِ)عَملاً أدبياً مُتمَايزاً فحسب، وإنَّما هو ثورة ذاتيةٌ داخليَّةٌ ضدَّ فعل ديستوبيا وأشكال الظلم والتهميش والانعتاق والتحرُّر للتعبير عن طابع الهُويَّة والانتماء الذاتي الواحد للوطن الكبير، ومن ثمُّ العبور تلقائياً عبر هذا الخطِّ الدفاعي المُستميت إلى جادة الحقِّ والصَّواب ويُوتويبا مدينة الخير الفاضلة سردياً في الِّرواية.
عَتبةُ الرِّوايةِ العُنوانيَّةِ:
من يقصدُ زيارة الإمامين، موسى الكاظم ومُحمَّد الجَواد بمدينة الكاظمية المقدَّسة في بغدادَ، لا بُدَّ وأنْ يسلكَ أحد الطرق أو شوارع الأبواب الثلاثة المؤدِّية للضريح المقدَّس والتي يُطلقُ عليها أبواب الإمام الكاظم. وأعني بذلك تحديداً بابً القبِلة، حيث الدخول منه إلى ضريح الإمام موسى الكاظم، وباب المراد المرتبط بلقب الإمام الجَواد والدَّال على قضاء الحوائج من خلال اسمه (باب الحوائج)، وباب الدِّروازة (مثابة الرِّواية) المؤدِّي إلى سوق السِّربَادي التاريخي الشهير في مدينة الكاظمية. وكلُّ بابٍ من هذه الأبواب الثلاثة يرتبط بشارع يؤدِّي إلى صحن ضريح الإمام الذي تُحيطُ به المحلَّات الكثيرة المتاجر المتنوعة وبعض الفنادق السِّياحيَّة، ويكثر فيه الباعة المُتجولون.
إنَّ اختيار الكاتب علي لفتة سعيد لِجُملة (بابُ الدِّروازةِ) عتبتهً عنوانيةً رئيسةً لافتةً لروايته، يعدُّ اختياراً عينيَّاً مُوفقاً من حيثُ المعنى الدلالي التاريخ والديني لدَالة (الدِّروازة) ذات الأصل الفارسي، والتي تعني عُجمتها بالعربيَّة البابَ أو الرِّتاجَ المفتوحَ، أمَّا من حيثُ المبنى الموضوعي المكاني فباب الدِّروازة يؤدِّي عمليَّاً وحركيِّاً إلى بابي القبِلة والمراد معاً. فهو الأكثر توسُّطاً وشهرةً من معالم مدينة الكاظمية المُقدَّسة دينياً واقتصادياً وثقافياً وروحياً وفكريَّاً، فضلاً عن كونه مثابة روحيَّة وسياحيةً مكانيةً للزائرين وعمل الفقراء والمُعدمين والمُهمَّشين العاطلين من أبناء الجنوب البسطاء.
ويُعدُّ (بابُ الدروازة) مَعلَمَاً تجارياً بارزاً للزائرين الذين يقصدون زيارة الإمامين. إذنْ (باب الدِّروازة) يُمثِّل أيقونةً ثقافيةً ودينيةً تاريخيَّةً كبيرةً وسيميائية رمزيةً بارزةً من مظاهر هذه المدينة السيَّاحية الكثيرة التي أراد لها الكاتب أنْ تدور فيها أحداث ووقائع روايته السردية وتتفاعل حركيَّاً شخوصها الفواعليَّة في خان الدروازة السكني مع مثابات الحدث الجديدة التي وظَّفها الكاتب له.
وليس مع نفسها فقط وإنَّما مع خطِّ عالمها المحيطي الاجتماعي الذي يلفُّه الكثير من آثار الغموض والضبابية والمجهول إلَّا تحقيق المأمول من الطموح المستقبلي والوصول إلى الغايات والأماني المنشودة. وهذا ما تُوحي به رمزيَّاً لوحة الغلاف الأولى المُتَّشحة بالسواد والحزن الظاهر، والتي تشي في الوقت نفسه بإظهار مظلومية وصرخة الجماهير الشعبية المُحتشدة من أجل التخلُّص من نِيرِ الدكاتورية المُستبدة بوجع الحروب التي تنتظرها وتحطُّم مستقبلها الجودي وتُهدِّد كيانها الآمن.
و(بَابُ الدِّروازة) على الرُّغم من مكانته الدينية والسياحيَّة التي يتمتَّع بهما فإنّه باب الحُريَّة وطريقها المقصود في نيل الغايات والأهداف والتمنيَات لإحلال الأمن والطمأنينة والسلام الوارف: "إنَّ العِراقَ كُلَّمَا تَعرَّضَ إلَى اِحتلالٍ تَتغيرُ الأسماءُ أو تُضافُ لَهُ أسماءٌ جَديدةٌ تَدلُّ عَلَى وجُودِ المُحتلِ". (بابُ الدِّروازةِ، ص 42). هذا الرأي يُعرفُ تَاريخياً في اختيار أسماء تدلُّ على بقايا من المحتل.
أمَّا لوحة الغلاف الثانية أو ما يسمُّى بـغلاف (التَّظهِير)،فَقد جاءت تأكيداً للخطِّ الزمني لسبعينيَّات القَرن العشرين، تلك الحِقبة الزمنية المهمَّة والفارقة من تاريخ العراق السياسي والمحصورة بين نهاية حكم أحمد حسن البكر وبداية تولي صدام حسين حكم العراق. فهي تعدُّ الشرارة النارية التي انطلقت منها أحداث الرواية بِدأً من ريف العراقي الجَنوبي بسوق الشيوخ وانتهاءً ببغداد العاصمة.
والتي شهدت بعدها أحداثاً وتطوراتٍ سياسيَّةً وأيدلوجيةً مهمَّةً ومثيرةً للدولة وواقع الشعب في تقرير المصير المجهول. وجاءت بعدها العتبة الافتتاحية للرواية التي ارتأى فيها الكاتب علي لفتة سعيد أنْ تكون تَجييراً ذاتياً وإهداءً حقيقياً لِجِدَّته العجوز التي ما زال مسكوناً بحبَّها الإنساني ووفاءً لها؛ كونها كما يرى الصَّوت الذي منحه هُويته الإبداعية المتفرِّدة الحروف، حيث قال عنها: "إِلَى جِدَّتِي، لَمْ يَزلْ صَوتُكِ يَمنحنِي هُويَّةَ المُكوثِ بَينَ الحُرُوفِ"، ويَعنِي حروف الكتابة والقراءة.
أَبنيةُ الرِّوايةِ المَكانيَّةُ:
يبدأ خطُّ الشروع المكاني الأوَّل لرِواية (بَابُ الدِّروازةِ)الصادرة بطبعتها الأولى في عام (2022م) عن دار الشؤون الثقافية العامة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في بغداد/ العراق، والتي تعدُّ من فئة القطع الكتابي المُتوسِّط التكثيف، والذي يقع بنحو (240) صفحةً، حيثُ تنطلق رحلة المكان والزمان فيها من مدينة سوق الشيوخ ذات الطابع الريفي بالناصرية، والتي هي إحدى أقضية مركز محافظة ذي قار المهمَّة ثقافيَّاً وإبداعيَّاً في الجَنوب العراقيّ السُّومريّ، وقوفاً بها عند مدينة بغداد مركز العاصمة والثقافة والحياة النابضة. حيث مدينة الكاظميَّة السَّياحية ولدينيَّة المُقدَّسة حتَّى بناية الخان مثابة الحدث الروائي، الذي عُرِفَ عنه أنَّه من المباني التي شُيِّدت إبَّانَ فترة العهد العثماني الذي حكمَ العراق أربعة قرون من الزمن. ويُعدُّ الخان من أولى مباني هذه المنطقة.
وإنَّ ميزة هذا الخان المُوقعيَّة بأنَّه يُمثِّل قلب الحدث، وفي زُقاقٍ قريبٍ من بابي القِبلة والدِّروازة، ومن مكان عمل شخوص الرواية، وخاصةً البطل الرئيس الذي يعمل في معمل الثلج الذي يديره زوج خالته المدعو سعيد. وتأتي أهمية هذا المكان الذي اختاره الكاتب سعيد عنواناً لروايته (بَابُ الدِّروازةِ) في كونه من أكثر الأمكنة والمثابات البغدادية الشهيرة التي مرَّ بها أغلب الرموز السياسية والمسؤولون الذين تعاقبوا على حكم العراق قاصدينَ من خلالهِ الوصول لزيارة ضريح الإمامين (الكاَظم والجَواد)،بُغيةَ تحقيق المُراد وطلبَ الدُّعاء والتَّبَرُّك بهما قولاً وعملاً وربَّما واجباً.
والغريب أنَّ هذا الخان ببنايته الشعبة القديمة المُتهالكة الجدران، والتي كانت مَلاذاً آمناً يأوي المُعدمينَ من عامةِ الفقراء والمُعوزِّين من محافظات الجنوب العراقي يحتوي على عشر غُرف ضيِّقةٍ صغيرةٍ جدَّاً تضمُّ عشر أُسرٍ أو عوائل في غرفة فقيرةٍ بسيطةٍ يصل مجموع ساكنيها بنحو سبعة وعشرين فرداً أو نسمةً بشريةً كما يُشير إلى ذلك كاتب الرِّواية وراويها العليم الذي يصف بطل روايته الفتى أو الَّصبِي الجَنوبي (خلَّاوي) الَّذي له من العمر سِتةَ عَشرَ رَبيعاً، فيقول واصفاً:
"هُوَ الآنَ يَجلسُ فِي غُرفةٍ صَغيرةٍ مِنْ غُرفِ بِنايةٍ قَديمةٍ تُسَمَّى الخَانَ، تَسكنُهُ أكثرُ مِنْ عَشرِ عَوائلَ فَقيرةٍ، كُلّهُم جَاءُوا مِدْنٍ وَمَحافظاتٍ أُخرَى. الغُرفةُ تَقعُ فِي أَولِ الخَانِ، مَا إنْ يَنتهِي مُمرُّ البَابَ الخَشبِيِّ الكَبيرِ الَّذي طُولِ الغُرفةِ ذَاتِها، والَّذي لَا يَتعدَّى ثَلاثَ أمتارٍ، وَعَلَى جِهةِ اليَمينِ تَقعُ الغُرفةُ الِّتي عَرضُهَا لَا يزيد عَلَى المِترينِ وَنِصفِ المَتِرِ.. وَهيَ بِذاتِ المِساحةِ أو أكبرٍ بِقليلٍ لِلغُرفِ الأُخرَى المُوجودةِ عَلَى ثَلاثةِ أضلاعٍ مِنْ أضلاعِ سَاحةِ الخَانِ". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 8).
على الرغم من الشعور بالقَلق والغُربة والحَيرة وعامل التَّوهان النَّفسي فإنَّ هذا المكان وغيره من أحياء بغداد والكاظمية كان مُبهراً وسَاحراً للشاب المراهق القادم من بيئة حياتية شعبية ريفية مسالمةٍ ومُغايرةٍ لتعقيدات المدينة وجوها العام. خاصةً وأنَّ خلَّاوي بطل رواية (بَابُ الدِّروازةِ) الكُلِّي لم يتركَ مدينته سوق الشيوخ يوماً فيجرب السفر أو الرحيل عنها إلَّا لبغداد الساحرة لعقله.
قاصداً هذه المدينة المُذهلة بعمرانها وزحمتها التي وصل إليها وانبهر بها وبمثاباتها العالية الكبيرة التي أدهشته. فاختلطت عليه دالات الطريق وعُنواناتها، واشتبكت عليه تشعُّبَات وكثرة فضاءاتها في الوصول إلى الخان المقصود. فهي أشبه بِحُلُمٍ مرَّ عليه، يراها كامرأةٍ أُنثى تُمشط شَعرَها على ضفاف نهر الفرات كما يوصفها أخوه الأكبر سليم طالب الدكتوراه في معرض المقارنة بين مدينته سُوق الشيوخ الصغيرة وبغداد العاصمة الحضرية الضَّاجة الكبيرة بالسُّكان ومبانيها العالية العمران، وبمشاهد سيَّارات مَصلحة نقل ِالرُّكاب الحمراء الإنكَليزيَّة ذات الطابقين التي تُشبِهُ الكائن الخّرافيَّ بحركتها الإنسيابية المُثيرة كالنحل تجري في شوارع بغداد الأزل.
كلُّ هذه الصور (الإيموجية) والبصرية المتحركة شكَّلت هاجساً مثيراً لديه عن طبيعة الحياة والمكان في الكاظمية والعاصمة بغداد. فهي لحظة كَالحُلُم الذي يمضي سريعاً عنه فجعلته في غمرة اندهاش وذهول وتفكير تامٍ. وكانت له حكاية، بل حكايات وصراع مع تداعيات المكان والزمان وشخوصه في البقعة التي يَقطن فيها ويَحيا ويَعمل رافِلَاً بالحياة ومكابدة العيش، وكان حقَّاً عاشقاً لشوارعه وأزقته الضيِّقة وفضاءاته اللصيقة التي أصبحت جزءاً مهمَّاً من مكان عمله اليومي::
"كَانَ ذَلكَ فِي صيفِ عام 1978،حِينَ وَطَأةْ قَدمَاهُ أَرضَ العَاصمةِ بَغدادَ.. كَانَ وَقتَهَا فَرِحَاً، سَعيدَاً، عَامرَاً بالبهجةِ، كَأنَّهُ تَخلَّصَ مِنْ اِلتصاقِ تَجمُّعاتِ الحُزنِ فِي قَلبِهِ وَعَلَى جَسَدهِ.. كَانَ حِينَهَا مُنبهِرَاً حَتَّى مِنْ ضَوءِ الشَّمسِ، يَرَاهَا تَختلِفُ عَنْ الَّتي تُشرِقُ مِنْ صَوبِ مِنطقةِ الصَّابئةِ مِنَ الجِهةِ الثَّانيةِ مِنْ نَهرِ الفُراتِ الَّذي يَمرُّ بِمدينةِ سُوقِ الشُّيوخِ.. لَمْ يَزلْ لِتَوِّهِ يَنزلُ مِنَ السَّيارةِ الَّتي أقلَّتهُ مِنْ كَراجِ النَّاصريَّةِ إلَى كَراجِ النَّهضةِ. فِي مُنتصفِ الطَّريقِ نَامَ مِنِ تَعبِ السَّهرِ وَهوَ يَحلمُ بِالسفرِ إلَى بَغدادَ وَالعَيشِ فِيهَا كَأيِّ مُواطنٍ لَا تُلاحقُهُ الظُّنونِ ولَاَ العَوزِ وَلَا اليُتمِ.. سَيعيشُ مَعَ أخِيهِ وَجِدَّتِهِ". (باب الدروازة، ص 5).هذه هي الصورة الكُليَّةالتي رسمها الكاتب ابن الناصرية لبطله.
لم تقف حركة البطل على المكان الذي يعيش فيه ويعمل فقط، وإنَّما دفعه شعوره الحركي والنفسي إلى التجريب والتَّنزُّه والتحوَّل والانتقال الحركي والاطِّلاع على أماكن وضواحٍ أخرى في مدينة الكاظمية وبغداد العاصمة، فذهب إلى منطقة الشوصة وإلى ساحة عدن وأحياء في النوَّاب وإلى حديقة 14 تموز. وسمع بالوزيريَّة التي لم يزرها وبكرَّادة مريم وتخيَّلها، تلك المنطقة على نهر دجلة والَّتي يقع فيها بيت نوري السَّعِيد رئيس وزراء العراق في العهد الملكي. ثمَّ اتَّسعت رقعة المكان في الرواية لتشمل أماكن أخرى مثل، كُليَّة الإدارة والاقتصاد وأكاديميَّة الفُنُون الجميلة في جامعة بغداد، ومعاهد وكُليَّات أخرى يسمع بها ولم يرَها من ذي قبل، وكان مَسكوناً بأحيائها.
والَّلافت للنظر أنَّ أغلب أحداث الرواية، بل إنَّ معظمها كان يدور في حيٍّ ما بين الخان القريب من باب الدروازة ومن معمل الثلج الذي يديره زوج خالته سعيد والقريب بمسافة ربع ساعة تقريباً عن موقع الخان الذي يؤدِّي فرعه الضيِّق إلى ضريح الإمام الكاظم. فَالبِنيةُ المَكانيَّةُ على الرغم من كونها ضيِّقة ومحصورةً بين مثابتينِ مُحدَّدتينِ بَيدَ أنَّها تُشكِّل عالماً واسعاً وكبيراً من مُخيلة الفتى خلَّاوي ومن مِساحة تفكيره الذهني الحائر الذي أخذ بالنمو والنضوج الفكري والثقافي والحضاري:
"كَانَ عَليهِ فِي كُلِّ صَباحٍ الذَهابُ إلَى مِنطقةِ بَابِ القِبلَةِ يَقطعُ المَسافةَ مَشيَاً لِمُدَّةِ رُبعِ سَاعةٍ، فِي طِقسٍ يَوميٍّ. كَانَ فِي بِدايتهِ أشبهَ بِاستطلَاعٍ لِمَا يَمكنُ أنْ يَكونَ دَهشةً لِحياتِهِ الجَديدةِ، قَبلَ أنْ تَتَحوَّل هَذهِ الدَّهشةُ إلَى رُوتينٍ يَومِي بِداخلهِ الخَوفُ فِي الكَثيرِ مِنَ الأحيانِ.. يَذهبُ إلَى هُناكَ حَيثُ مَحلِّ زَوجِ خَالتِهِ لِبيعِ الثَّلجِ.. المَحَلُّ يَقعُ فِي زُقاقٍ ضَيِّقٍ لَا يَبعدُ عَنْ مَرقدِ الإمامِ موسَى الكَاظمِ سِوَى عُبورِ شَارعٍ لَا يَزيدُ عُرضهُ عَنْ ثَمانيةِ أمتارٍ وَعُرضُ الزُّقاقِ لَا يَزيدُ عَنْ ثَلاثةِ أمتارٍ، لَهُ فَتحتانِ تَطلُّ الأُولَى عَلَى شَارعِ بَابِ القِبلَةِ والثَّانيةُ عَلَى بَابِ الدِّروازةِ المَلِيءِ بِمحَالٍ مُتنوِّعةٍ لِبيعِ المَلابسِ والأحذيَةِ وَلَعبِ الأطفالِ وَمَلابسِ العِرسَانِ، وَحَتَّى اللِّحِفُ وَالبطانياتُ". (بَابُ الدِّروازة،ص11، 12).
وعلى الرُّغم من كُلِّ ذلك العالم المكاني الجديد على نفسية وتصوُّر الصَّبي خَلَّاوي فإنَّه كان ينتابه شعور داخلي عميق من غربة المكان وغياب أثر الطفولة والمقرَّبينَ من أصدقائه في سُوق الشيوخ والفسحة الدائمة في أماكنها اللصيقة به، وربَّما أثَّرَ عليه أمر الدراسة وجوها مؤقتاً ودخوله في حياة عمليَّةٍ جديدةٍ أخرى مُغايرة لنمط حياته السابقة بسوق الشُّيوخ، فولَّدَ لديه انطباعاً نفسياً قلقاً ورؤى خياليَّةً مُخيفةً شكَّلت جزءاً فكريَّاً كبيراً من روتين حياته الجديدة. ولكن ذلك الحال يحدث لبُرهة من الزمن ويتغيَّر بين لحظة وأخرى، وينتابه شعور جديد بالفرح والسرور حين تبدأُ:
"لَحظاتُ الرَّاحةِ بِالنسبةِ لِخَلَّاوي حِينَ يَحملُ قَالبَ الثَّلجِ أوْ حَتَّى نَصفَهُ وَيَذهبُ بِه إلَى فُندقِ السَّعادةِ أوْ فُندقِ الأُمَّةِ فِي شَارعِ الشَّريفِ الرَّضيِّ المُحاذِي لِشارعِ بَابِ القِبلَةِ، وَالَّذي يَبدأُ مِنْ رَأسِ شَارعِ بَابِ الدِّاروازةِ ويَنتهِي كَمَا شَارعِ بَابِ القِبلَةِ بِساحةِ بَابِ القِبلةِ، أوْ بِالأحرَى سَاحةِ المَدرسَةِ الإيرانيَّةِ الّتِي تَقعُ عَلَى يَمينِ الشَّارعِ مِنْ الجَهةِ الأخُرى، الَّتي يَقعُ خَلفَهَا سُوقُ السّربَادي. المُهمُّ أنْ يَخرجَ ويَحفظَ عَلَى الأقلِّ أسماءَ هَذهِ المَناطقِ وَيَحفظُ خَارطتَهَا وَيَعرفُ أُناسَهَا وَأصحابَ مِحالِهَا وَحتَّى مَجانِينهَا وَمُتسوِّلِيهَا، وَبَائعِي (جَنابرِ) السَّكائرِ وَالعُطورِ عَلَى الأرصفةِ، حَيثُ يَهربونَ كُلَّما شَاهدُوا رِجَالَ البَلديَّةِ...". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 21، 22).
إنَّ أكثر ما يخيف خلَّاوي ليس وحشة المكان وغربته وتصرُّفات سعيد زوج خالته الذي يعمل معه عاملاً في معمل الثلج، وإنَّما ما يُخيفه فعلاً هو تصرُّفات وأفعال أصحاب المحلَّات والفنادق والباعة المتجولون غي هذه المدينة من الذين يعاقرون الخمر ويفعلون الرذيلة، وهم قريبون من ضريح الإمام وفي عتبات محيطه الخارجي، فما أسوأهُ من شعور وإحساس بفعل المنكر السيء:
"لَكنْ هَذِه المَرَّة لَمْ يَكنْ مَا يُخيفهُ زَوجُ خَالتِهِ،بَلْ مَا رَآهُ فِي الفُندقِ،أو مِنْ صَاحبِ الفُندقِ تحديداً، وَلَمْ يَستطعْ تَفسيرَهُ. كَانَ الرَّجلُ يَجلسُ خَلفَ مُنضدةِ الفُندقِ فِي صَالةِ الاِستقبالِ الَّتِي لَا تَنتمِي إلَى الصَّالاتِ الَّتِي يَراهَا فِي التِّلفزيونِ ، هِيَ مُمرٌّ صَغيرٌ يَفصلُ البَابَ الخَارجيَ عَنْ غُرفِ الطَّابقِ الأرضِي، هُناكَ سُلَّمٌ ضَيِّقٌ لَا يَسعُ لِنَزيلينِ، وَحَتَّى سُلَّمُ الخَانِ فِي الزَّاويةِ المَيِتَةِ البَعيدةِ أعرضُ مِنُه. كَانتْ السَّاعةُ فِي حِينِهَا قَدْ أطلَّتْ عَلَى الثَّالثةِ ظُهرَاً، حِينَ دَخَلَ إلَى الفُندقِ وَكَانتْ غُرفةُ صَاحبِ الفُندقِ مَفتوحَةً وًهوً يًشربُ الخَمَر، فِيمَا كَانتْ بِالقربِ مِنهُ مُتسوِّلةٌ رَاهَا كَثيرَاً فِي بَابِ القِبلةِ. خَرَجَ مُسرعَاً بَعدَ أنْ تَحوَّلَ الرَّجلُ إلَى كَلبٍ فِي لَحظةٍ مُباغتةٍ..." (بَابُ الدِّروازةِ، ص 23، 24).
التَّجلِّياتُ الفَنيَّةُ لِشخصيَّاتِ الرِّوايةِ:
من يقرأ التمثَّلات السرديَّة لشخصيَّات مُدوَّنة (بَابُ الدِّروازةِ) بوعيٍ وإدراكٍ عميقينِ سيلحظُ بعينٍ بصريةٍ ثالثةٍ أنَّها من نوع وصنف الروايات (البوليفونيَّة) المُتعدِّدة الأصوات والشخصيَّات والرموز المُتحركة. وعلى الرُّغم من تلك التعدُّدية الشخصيَّة فإنَّ للرواية شخصيتها المركزية وبطلها المحوري الرئيس الذي هو بؤرة الحدث ونقطته المُحورية،والتي يمكن أنْ تتشظى حكاياتها الفاعلية وتنتشر من قلب ثِيمتها المركزية التي هي مركز اشتغالات واقعة الحدث الموضوعية للرواية.
وليس هذا عملها فقط فإنَّها تتجزأ وتتوحَّد فنيَّاً بوحدةٍ سرديَّةٍ مَوضوعيَّةٍ مُترابطةِ البنيان تشكِّل لُحمة الحدثِ وَسُداه العضويَّة الكبرى التي لا ينفرط عقدها أو نسيجها السردي عن الإمساك بتلابيبه الفكري السردي، وعن نواته الحقيقية التي هي بالتأكيد تُعدُّ نقطة التَّلاقي والتَّجافي والتَّصافي والاختلاف معاً عبر سلسلة من الروافد والأنساق الموضوعية والثقافية التي تُبنى عليها أحداث الرواية تصاعديَّاً وتكتمل بها فكرة الخطاب السردي للمُدوُّنة من خلال شخصيتها المركزية الرئيسة أولاً وشخوصها الثانوية المساعدة في بناء الحدث الكلي للرواية ثانياً.
غيرَ أنَّ كلَّ هذا يُعدُّ سياقاً أُسلوبيَّاً تعبيريَّاً معروفاً ومألوفاً في أبجديات السرد الروائي وفي تقاليد كتابته التخليقيَّة إنتاجاً. بيدَّ أنَّ اللَّافت للنظر وغير المعروف من أنساق فنيَّة التعبير السردي الخفية في اشتغالات هذه الرواية يتَّصل بالجانب الإبداعي والفكري والفلسفي لرؤية الكاتب وحصافته التعبيرية في صُنع عملٍ روائيٍّ فنِّيٍّ مُتمايز. ومثيرٌ للدهشة لا في اتِّحاد عناصره الأساسَّية التقليديَّة المعروفة فحسب، وإنَّما في جماليَّات أُسلوبيته الفكرية وشِعريَة لُغته السَّردية الإمتاعية الراكزة.
فضلاً عن حساسيَّة حبكته العُقديَّة، وفرادة مُلهمات فنياته الإبداعية التجدُّدية التي تنفتح على فضاء ما بعد الحداثة في الميتا سرد، فتخلق عوالمَ جديدةً وإضاءاتٍ إمتاعيَّةً مثيرةً من الابتكار والابتداع وتؤصِّل لركائز م السرديات التفاعلية الخلاقة بين (الفكرة والحكاية) في منظومة الحداثة السردية من خلال لغة شفراتها وأنساقها الظاهرة منها والخفية، والتي هي تشكِّل محطَّ اهتمام المُتلقِّي والقارئ النابه (الناقد)، وتشغل باله تفكيكاً وتحليلاً وتأويلاً هيرمنيوطيقياً وموضوعياً كاملاً.
إنَّ ما أُريدُ أنْ ألفتَ النظر إليه جليَّاً وأُنبه القارئ الذكي الواعي إليه في هذه الإلمامة السريعة والإحاطة الأخيرة عن تلك الشخصيات في رواية (باب الدروازة) تتعلَّق بخاصيَّة وأسلوبية الكاتب السارد أو الراوي العليم أو بتمايزها الفني المغاير. ويبدو أنَّ نباهة الرائي علي لفتة سعيد وذكاءه الفكري وسعة ملكته الفطرية واستعداد موهبته المعرفية المكتسبة في القدرة على حبِّ التجديد والتخليق الإجرائي السردي كان سبباً مهمَّاً جداً من أسباب جرأته الإلماعية الفكرية وشجاعته وإقدامه واندفاعه الأسلوبي في تطوير شخصياته الروائيةالرئيسة والثانوية المتوحدنة ثيميَّاً وسرديَّاً.
ومن ثمّتَ الخروج بها من خطٍّ سرديات الرتائبية التقعيدية ومن براثن شِباكِ سياق النمطية والمعجمية الإطارية المملَّة إلى منظومة معرفية وفنيةٍ من الأنساقٍ والبدائل الثقافية والسردية الجديدة النابضة بالحياة تلك التي تبعث على التأمُّل والتفكُّر والانطلاق نحو آفاق مستقبليةٍ وإنسانيةٍ رحبةٍ تبتعد عن ركود وظلال رتابةالمُستهلك والمَعطوب موضوعيَّاً فنيَّاً.فضلاًعن رماد قيم المنتهية صلاحيته الفكرية من خلال هذه البدائل الثقافية المبتكرة لحركة هذه الشخصيات التي تصنع وتؤثَّث لبنية العمل الروائي المسلَّح بالوعي الفكري والمشيَّد بالبناء الجمالي والسردي اللُّغوي المكين.
ما أريد الإشارة إليه مجدَّداً في هذا السياق من دراسة الشخصيَّات المهمَّة وألفتُ التأكيد إليها فنيَّاً مرَّةً أخرى، هوما قام به الكاتب علي لفتة سعيد بخصوص أداء شخصياته الفواعلية وكيف وظَّف أدوارها الحكائية؟ وكيف صيَّرَ وسيَّرَ حركة فعلياتها الحدثية إلى مرموزاتٍ آيدلوجية وموحياتٍ عقائدية تبرز أشكال وتيرة الصراع الداخلي القائم الذي تنتمي إليه -سِرِّيَّاً وعلنياً- أطراف وعيَّنات كبيرة من أبناء الشعب العراقي برغم مركزيَّة الحزب الحاكم الواحد الذي يسود طبيعة نظام الحكم القائم في وقته حينذاك. والذي لا يسمح لِهُويَّة الآخر حتَّى بمجرد التفكير بمشاركته دفَّة الحكم.
لقد استطاع علي لفتة سعيد بحنكته السردية المكينة ورصانة دهائه الفكري البعيد المُتجدِّد الفاعلية أنْ يلعب لُعبته الحداثية في التعامل مع الشخصيَّات، وكيفية توظيفها بنائياً وحركيَّاً وفنيَّاً ودراميَّاً. لقد تَمكَّن سعيد برؤيته الفلسفية السرديَّة أنْ ينقل لنا حركة الصراع الدرامي التسريدي الدائر بين محوري (الخير والشرِّ) من مركزية البطل الرئيس الأوحد مع الأخر إلى مُحوريَّة الشخصيَّات الثانوية التي نفخ في جسدها الميَّت ومنحها رُوحاً سرديَّةً ودماءً نقيَّةً حركيَّةً جديدةً.
وجعل من بطلها المركزي (خلَّاوي) شكلاً رمزيَّاً حَائراً مُعطَّلاً عن دوره الرئيس الفاعل كبطل حكائي للرواية. وقد أحال دوره الفعلي المنظور إلى أشبه بِحَكَمٍ صَامتٍ غيرِ قادرٍ على اتخاذ القرار الشُّجاع حول الطرفين. فهو ينظر ويسمع بإعجابٍ ويُصغي بانتباهٍ شديدٍ إليهُما ويُحلل الأمور وما قد يحصل آنياً؛لكنَّه غيرُ قادرٍ حتَّى على إبداء الرأي أو النطق به حول تواتر الصراع الدائر بينهما.
ويَشي مثلُ هذا السلوك إلى أنَّ الكاتب قد أحال موقف البطل إلى الحيادية والابتعاد عن دهاليز السياسة التي لم يسمع عنها خلَّاوي وعن فلسفتها من ذي قبل؛ كونه فتىً صغيراً فقيراً من مدينة تميل إلى الهدوء والسَّلم وتعيش الفقر والجهل والتهميش، وأقرب ما تكون طبيعتها لِحياة الأرياف التي ترى في السياسة والآيدلوجيات العقائديَّة والفكريَّة من حقِّ أو حصَّة أصحاب العقول في المدن الكبيرة مثل بغداد وغيرها من مدن العراق التاريخية الأخرى المزدحمة بالفكر والثقافة السياسية.
هكذا بَرَعَ عقلُ علي لفتة الفكري وأُسلوبه في أنْ يُؤصِّلَ لشخصيَّاته بِخُطىً ثابتةٍ وواثبةٍ في دفع عجلة سير دراميَّة الحدث الموضوعي للرواية وجعله صراعاً محوريَّاً جدليَّاً عقيماً لا يمكن أنْ ينتهي إلا بانقضاء فلسفة الحكم الدكتاتوري المُتسلط لعقود من الزمن على رقاب الشعب العراقي.
والحقيقة أنَّ هذا النهج والسلوك الأُسلوبي الذي انتهجه الكاتب (الروائي) تُجاه الشخصيَّات في سردياته الحكائية والقصصيَّة المُنتجة لفضاء الخطاب الروائي كانت مِهمَازاً فكريَّاً مُلحَّاً أشبهَ بِمسمارٍ مُدببٍ عَاصفٍ مُباغتٍ ولادغٍ في حضِّه وإيقاظه على نقل عملية أوجه الصراع الفكري بين الشخصيَّات الثانوية المتضادة في الرواية نفسها إلى محورين أساسيين مُتعارضين لا ثالث لهما إلَّا محور الحزب الأحادي الحاكم للبلد، وخلَّاوي الذي يمثل منصَّة الاستماع والإنصات لهما بدقةٍ.
إنَّ هذين المحورين يسعيَان بكل الوسائل الخارجية والداخلية المُتاحة في التخلُّص من ربقة وشِرار نار لهيبه المُحرقة للكلِّ من تثبت نواياه العدائية له. لقد قَدَحَتْ إلى ذهن الكاتب ورؤيته السردية فكرة الصراع بين اتجاهي اليسار واليمين الَّتي جسَّدتها اشتغالاته المركزية في الرواية.
وعلى الرُّغم من اشتداد هُوَّة الصِّراع الدائر بين الطرفين المُتنازعين والغَلبة لمن ستكون في النهاية، فإنَّ بصمة الكاتب الفنيَّة وضربته الإبداعية تأتي في خاتمة الرواية الموضوعية هاتفاً إدهاشياً تحذيريَّاً مُثيراً للمتلقِّي ورجعاً صوتيَّاً لصدىً يُحذِّر فيهِ بطله الأوحد من الانتماء إلى هذه الأحزاب الفاشلة التي تمثِّل الخراب والدَّمار واليأس لدى السواد الأعظم من أبناء الشعب العراقيّ:
"لَمْ يَجدْ شَيئاً يَلوذُ بِهِ غَيرَ الصَّمتِ، وَالنَّظرِ إلَّى الحُفرةِ الَّتِي لَمْ يَجدْ لَهَا فَتحةً مُعلنَةً، فَيأتيهِ الصَّدَى نَابعاً مِنْها، يَرتَدُ إليهِ عَاليَاً: -إيَّاكَ وَالانتماءَ إلَّى الأحَزابِ، حِينَهَا سَيحلُّ الخَرابُ بِكَ وَبِعمرِكِ...". (بَابُ الدِّرازةِ، ص240)
التَّجلِّياتُ السِّيريَّةُ لِشخصيَّاتِ الرِّوايةِ:
حِينَ نَجوسُ النظر بيانيَّاً وإحصائياً في أُسلوبيَّات شخصيَّات مُدوَّنة (بَابُ الدِّروازةِ) نجدها قد تجاوزت سبعَ عشرةَ شخصيةً، منها ثماني شخصيَّاتٍ ذكوريةٍ، وتسعُ شخصيَّاتٍ أنثويةٍ بين رئيسة مؤثِّرةٍ وفرعيةٍ مُساهمةٍ وطارئةٍ مُكمَّلةٍ. لكلِّ شخصيَّةٍ لها رسمها البياني وخطُّها الفواعلي المستقلِّ ومِساحتها العمليَّة والحركيَّة المحدَّدة في فضاء السرد الروائي وانتقالاته المتواثبة. في الوقت الذي يؤكِّد فيه الكاتب سعيد ويشير إلى أنَّ مجموع الشخوص الساكنين في غُرف خان باب الدروازة بلغ سبعاً وعشرينَ فرداً، وقد ورد ذكر سبعة عشر شخصية منهم توزَّعت بأحداث الرواية وفصولها.
وعلى وفق ذلك المنظور السَّردي للشخصيَّات المستدامة ارتأى الروائي علي لفتة سعيد أنْ يكونَ الوجه الحقيقي المُمَثّل لمحورِ اليسار الوطني المنحرف في توجهه السياسي يكمن في شخصيَّة (سعيد) الوطني الشِّيوعي وصاحب معمل الثلج الذي عُرِفَ بآرائه العِلمانيَّة المتشدِّدة وشخصيَّته التحررية والانفتاحية المتواثبة الانطلاق نحو العالم الحُرِّ الآخر الذي لا تقيِّدهُ سلاسل وقُيود آفة الفساد والاستبداد والدكتاتورية والشعارات الظالمة لحقوق الإنسان المناضل التواق للمواجهة.
كان سعيد يعيش عالمه السياسي الخاص وله نظرته المستقبلية البعيدة وتوجّهه في استشراف الماضي والحاضر والقادم من الأيام والسنين الذي ينتظره مصير الحكم القائم بظهور آلهةٍ جُددٍ بَشَرٌ يحكمون الناس بالنار والحديد والقمع والموت والنفي. لهذه الأسباب وغيرها مجتمعةً تعرَّضَ سعيد إلى الاعتقال والتعذيب أكثر من مرَّةٍ وأُدعَ في سجن نقرة السلمان الرهيب في سبعينيَّات القرن العشرين؛ كونه شخصاً مُثَقَّفاً من طرازٍ خاصٍ على الرُّغم من بساطته، وله قراءاته الكثيرة وكُتبه الوفيرة ومكتبته الخاصَّة.وقد يكون سعيداً رمزاً لإحدى شخصيَّات الحزب الشيوعي الوطنية.
وللرجل المكافح سعيد كتاباته ومذكراته التدوينية والتوثيقية التَّحرُّرية المعارضة للنظام والشاهدة على أحداث العصر تركها بمخلَّفات ورقيَّةٍ في صُندوقٍ خشبيٍّ متينٍ مُودعٌ بمحل عمله. إلَّا أنَّ سعيداً كان عصبيِّ المزاج وسريع الغضب يثور سريعاً لأتفه الأسباب حين يُستفَزُ خلال حواراته مع المحور الآخر المناهض له فكريَّاً حول تداعيات الحكم وسياسة النظام الدكتاتوري الحاكم للبلد.
أمَّا المحور الثاني من هذه الشخصيَّات المناوئة لتوجَّه وفكر المحور الأول، فتمثَّل بمحور اليمين الإسلامي المعتدل، وقد تجسَّدَ تمثيله الفكري بشخصيَّة (هادي) بائع السِّبَحِ والسجَّاد والتُّرب القابع تحت عباءة الدين الإسلاموي الجديد. وكان فعلاً رجلاً هادئاً ومسالماً وصبوراً جَلِدَاً باردَ الأعصاب على خلاف نقيضه سعيد الثائر الفائر. كما كان يتحلَّى بأدبِ وصفةِ الإصغاء العالي لمحاوره وبأعصاب قويَّةٍ هادئةٍ وكَيَاسةِ عَقلٍ حَكيمٍ وَرَاجحٍ وَرَزينٍ ثابتٍ يملك نفسهُ عند اشتداد حِدَّة الغضب في المواقف الحرجة، وليس شديد الصُرعة عند الغضب الذي يُطفئ سراج العقل ويُضيِّع الحقوق.
وكان هادي يعتقد كلَّ الاعتقاد ويظنُّ بأنَّ زمام الأمور في نهاية المطاف ستفضي لدولة الإسلام السياسي الجديد متأثراً بما حصل للجارة إيران في ثورة الإمام الخميني؛لذلك كانت حواراته اليومية مع جاره سعيد تأخذ طابعاً نديَّاً وقوياً في النظر إلى ما ستؤول الأمور في المستقبل القادم القريب.
وكانت حدِّة هذا الصراع تتفاعل وتتنامى على أَشُدِّها من أول فصول وأحداث الرواية حتَّى مُنتهاها التحذيري الأخير المفتوح الذي رسمه الكاتب لها، والذي لم تكن خاتمة نهايته الموضوعية متوقعةً لرؤية وحسابات وتصوُّر كلٍّ من المُحورين بين أطراف اليسار واليمين السياسي الشعبي.
أمَّا شخصيَّة خلَّاوي الطرف الثالث لهذا المثلث فكانت تُمثِّل المعادل الموضوعي المحايد بين وجهي الصراعين المُحتدمين. وقد أفاد البطل خلَّاوي كثيراً من تجلِّيات جذوة هذا الصراع القائم والذي لم تكن له معرفة به سابقاً، أو أنَّه قد سَمِعَ عنه وعن عالمه السياسي الرحيب. غير أنَّه في كلَّ الأحوال أصبحت له حصيلة من مُدخلات الثقافة السياسية والاجتماعية، وتطوَّر نضجه العقلي والفكري الواسع، وصار له تصوراته الذاتية عما يحصل من تطوَّرات وأحداث طارئة للعراق.
لقد كان همُّ خلَّاوي الوحيد أنْ يحصل من هذا الوطن على فرصة عملٍ مناسبٍ أو وظيفةٍ بسيطةٍ يُقوُّت بها نفسه ويُعيل بها أسرته الفقيرة، مُمَنِّيَاً نفسه في الوقت ذاته ولو كان ذلك الحُلمُ لأجلٍ بعيد في استكمال تحصيله الدراسي في الابتدائية والإعدادية والذي لم يحصل عليه إطلاقاً حتى في نهاية المطاف؛ بسبب بوادر قيام بشائر الحرب التي تلوح في الأفق في عقد الثمانينيات بين الجارين العراق وإيران، والإعلان المفاجئ في طلب مواليده للالتحاق بإداء خدمة العلم العسكرية الإلزامية. والتي كانت من المفاجآت العصيبة التي تنتظره مستقبلياً. وكأنِّي بالراوي العليم أو السارد علي لفتة أنْ يقول ويخبر في تسريداته الرمزية وموحياته السيميائيَّة لواقعة الحدث الموضوعيَّة بأنَّ خلَّاويَ وسعيداً وهاديَّاً وغيرهم من عامَّة الناس من أبناء الطبقة البروليتارية العاملة هم جميعاً ضحية من ضحايا أنظمة الحكم البعثي الدكتاتوري القائم وحطب لهشيم ناره التي لا تنطفئ أوَارُها:
"وَفِي لَحظةٍ مَا لَا يَدرِي إنْ كَانتْ حَقيقيةً أمْ هِيَ مِنْ صُنعِ الخَيَالِ، رَأى زَوجَ خَالتِهِ وَهوَ يَحفرُ حُفْرَّةً بِيديهِ، حُفرةً عَميقةً جِدَّاً، ثُمَّ نَزَلَ فِيهَا وَلَمْ يُرَ مِنهُ شَيئَاً.. فِي لَحظتِهَا كَانَ يَسمعُ صَوتَ التِّلفزيونِ، إذْ كَانَ المُذيعُ يَصرخُ وَهوَ يَقرَأُ البَيانَ الَّذي أعلَنَ فِيهِ اِستدعاءِ مُواليدهِ لِخدمَةِ الإلزاميَّةِ وَعَلَى الجَميعِ الاِستعدادُ لِلمعركةِ...". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 240).
هذه التجلِّيات السرديَّة الثلاثة من أوجه الاختلاف للصراع الميلودرامي المرئي وغير المرئي من أبرز شخصيَّات الرواية الرئيسة والثانوية المؤثِّرة التي أسهمت إسهاماً كبيراً وفاعلاً في تنمية مسيرة الحوار الداخلي المونولوجي وتصاعد بنائه الموضوعي قنيَّاً وجماليَّاً، وفي إظهار آثار الصور القيمية والفكرية والإنسانية والوطنية المُثلى في مجتمع (بابِ الدِّروازةِ) المُصغَّر سرديَّاً. فهذه الشخصيّات هي أيضاً تعدُّ مزيجاً واقعيَّاً من الفنِّ السردي الدرامي والبُعد العقائدي الثوري.
أمَّا شخصياته الفرعية الأخرى التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع طرفي الصراع الوطني والاجتماعي والروحي الأول والثاني فكان دورها الفواعلي الحدثي تكميلياً ثانوياً؛ لكنَّه دور له تأثيراته الفنية والاجتماعية المؤثرة في الكشف عن حفريَّات وآثار الواقع الحياتي البسيط للمواطن الأعزل في حقبة تاريخية مُهمَّة جِداً من تاريخ العراق السياسي والاقتصادي الحديث والمعاصر.
وقد كشفت حقائق السِّير السرديَّة والذاتية لطبيعة هذه الشخصيَّات المأزومة عن هُوية المجتمع ومعاناته ومظلوميته وشعوره بالحيف والتهميش واللَّامبالاة وتفشي حالات العوز والفقر والفاقة. لكن في الوقت نفسه أثبتت هذه الشخصيَّات بأنها ذات طاقةٍ إيجابيةٍ كبيرةٍ تسعى من خلالها إلى الوصول لنيل حقِّها العلمي والعملي المنشود في التعلُّم العالي والتخرُّج التطور المعرفي، فضلاً عن أملها في الحصول على ما تصبو إليه شخصيَّاً من حُريَّةٍ وكرامةٍ وأمانٍ وسلامٍ وعيشٍ آمنٍ رغيدٍ.
فلو تتبعنا الأثر العملي لهذه الشخصيَّات الذكورية لوجدنا فيها شخصيّة طالب الدكتوراه بكُليَّة الإدارة والاقتصاد والتي تمثَّلت بشخصية سليم الأخ الأكبر لخلَّاوي، وهي من الشخصيَّات التكاملية التي كان لها أثر كبير في توجيه مسيرة أخيه خلَّاوي والمحافظة عليها في عالمه الجديد الآخر. ثمَّ تأتي شخصية حسن طالب كُليَّة الفُنُون الجميلة بجامعة ببغداد، والذي كان من أقرب الشخصيَّات المحلية لقلب البطل خلَّاوي، وله مواقف وحوارات عديدة معه بخصوص مظاهر حياته الجديدة. فضلاً عن شخصية حسين طالب كُليَّة الطبِّ، وهو ممن يسكنون بجوار غرفة خلَّاوي في الخان نفسه، وكان من المحبِّين والناصحين له في تمضية حياته العملية والتكيُّف معها ومع مستجداتها.
ومن بين الشخصيَّات الثانوية الأخرى شخصيَّة جعاز بائع العصير أو الشربت والشاي، وهو من الأفراد الذين يسكنون الخان بباب الدروازة،وتجمعه مع البطل مَحبَّة ومودَّة وعَلاقة جوار اجتماعية وحياتية خاصة ومشتركة تحت سقف واحد ومجتمع يتضوَّر من وقع الألم ويئن من المعاناة. وهذه الشخصيات تجمع في سِيرتها الذاتية والسرديَّة بين جمال البعدالفنِّي الميلودرامي والبعد الاجتماعي.
ونذهب في هذا التقييم السِّيري السَّردي إلى الطرف لآخر من الشخصيَّات الأنثويثة ذات الطابع السردي الثانوي أو الفرعي المُكمِّل في إيقاعه الحدثي لتجليَّات الطرف الأول الذُّكوري المؤثِّرة في شاخصية الحدث. ويأتي على صدر هذه الشخصيَّات الفواعليَّة شخصيَّة فتحيَّة، تلك الفتاة المُثيرة للجدل ذات الأصول العشائرية الجنوبية، والتي دفعتها ظروفها الاجتماعية إلى الهرب من مدينتها الديوانية إلى بغداد مع أبيها على إثر فضيحةٍ أخلاقيةٍ واجتماعيةٍ هَزَّت أركان شرفها ولوَّثت سمعتها الاجتماعية والتي تعرَّضت لها؛ بسبب فعل الغواية الجنسية التي حصلت لها.
ومن ثم الإيقاع بها من قبل شاب يدعي أنَّه ابن عمها وعَدَهَا بالزواج كَذِبَاً وبُهتاناً، ثُمَّ تَخلَّى عنها بعد أن حصل على بُغيته منها مع رفيقه سائق السيارة الذي ارغمها على الفعل ذاته وإلَّا التشهير بشرفها وسمعتها التي نزلت إلى قاع الحضيض. وكانت الفتاة فتحيَّة ضحيةً من ضحايا المجتمع الرجولي القاتلة التي لا تَرحم، وقد أمَّنها بالوعود وخان عهد الوفاء تحت فاحشةالتخدير والإغراء. وقد أدَّت فتحيَّة دوراً اجتماعيَّاً وسرديَّاً تفاعلياً مُريباً مُهمَّاً من أدوار باب الدروازة الحدثية التوقعية.
أمَّا الطرف النسائي النِشط الأثر الآخر الذي يُقابل شخصيَّة الشَّابة فتحية في فعلية الأداء الذي يُحيطه الشكُّ والغموض والرِّيبة فهي شخصية الأرملة أُمّ صلاح، وكيلة صاحب الخان في جمع أموال الإيجارات، والتي تعمل حفَّافة لِشَعرِ النساء في خارج الخان وداخله. وقد عرف عن هذه الشخصيَّة بأنَّها تحمل الكثير من الأسرار الشخصيَّةً الغريبةً والخفيةً الغامضة التي تخصُّ سيرة حياتها الشخصية؛ كونها أولاً امرأةً أرملةً وزوجةَ أحد شهداء حرب تشرين مع إسرائيل في سوريا.
وثانياً ما أصاب سيرتها الأخلاقية من اعتداء رجل عليها يُدعى صاحب محلِّ الأعشاب أثناء قيامه بالفحص الموضعي لمنطقة حسِّاسة من أسفل جسدها وتخديرها ومداعبتها بالملامسة والنيل من شرفها وكرامتها، وبالتالي سقوطها في لذَّة هاوية الإغواء الجنسي الرجولي بفعل شعورها بحميمية اللَّذة بعد سنوات طويلة من الجفاف العاطفي التي مرَّت بها إثر فقدان زوجها الشهيد. فكانت ضحيةً أخرى من ضحايا المجتمع الذكوري الباحث عن لحظات الإمتاع الجسدي للمرأة.
والشخصية النسوية الثالثة التي تمتلك الحكمة والتجربة والخبرة الاجتماعية في الحياة الأسريَّة، هي شخصية المرأة العجوز أم يوسف، التي تعدُّ الجدة الكبيرة لولدي بنتها الوسطى خلَّاوي وسليم وقد جاءت معهما إلى بغداد لتعيش في خان باب الدِّروازة وتتكفَّل برعايتهما؛ كونهما ولدين يتيمين لا راعٍ لهما سواها. وكان لها الدور الكبير في تربية وتنشئة خلَّاوي وسليم وتوجيه حياتهما العملية والأسرية والمحافظة عليهما. وسنتعرَّف عليها أكثر عندما نُجيل النظر بالتمثِّلات الإجرائية لهذه الشخصيَّة، وكيف تمكَّنت من فرض إحكام قبضتها الأُسرية عليهما من تصرُّفات الآخرين، وتوجيه مسيرتهما العلمية والاجتماعية توجيهاً صحيحاً من خلال هذه التنشئة والتربية والمراقبة والوعي.
وهده الشخصيَّات الأنثوية المهمَّة الثلاثة على الرغم من كونها شخصياتٍ ثانويةً هَامشيَّةً فرعيَّةً بَيدَ أنَّها تجمع في رمزيتها السرديَّة بين بعدين مختلفين، البُعدُ الفنِّي العملي السِّيري والبعد الاجتماعي السردي الساعي إلى تحقيق حياة حرَّة كريمةٍ وآمنة مستقرَّةٍ في مجتمعٍ بغدادي مغاير.
لم يبقَ من الشخصيَّات الفرعية إلَّا ستُ شخصيَّاتٍ تكميلية لسدِّ فراغات الفضاء السردي بالحدث الفعلي الميلودرامي والبَصَرَي الحَرَكي الذي يُضفي على واقعة الحدث الموضوعية تصويراً دراميَّاً تكامليَّاً مُذهلاً وناجحاً. فتأتي شخصية أمّ وداد الخيَّاطة على رأس هذه الشخصيَّات، وشخصيَّة أم حسين قارئة الفأل، ثُمَّ شخصيَّتا أمّ رازقيَّة وأمَ جَواد، وشخصيَّةُ صاحبةِ الحَمَّام، وهنَّ جميعاً من اللواتي يسكنَّ في الخان ومن العوائل الفقيرة التي أجبرتها ظروف الحياة على العمل بالكاظمية.
فضلاً عن شخصيَّة فخريَّة خالة خلَّاوي وزوج سعيد بائع الثلج الذي تنحدر أصوله الجنوبية من مدينة سوق الشيوخ التي لم يرها أو عاش فيها أكثر حياته. حتَّى إنَّ لهجته كانت بغدادية بحتةً وليست جنوبية، بل كانت مغايرةً؛ الأمر الذي دفعه إلى التندر والاستهزاء بلهجة خلَّاوي الجَنوبية والسخرية من بعض مفرداتها المحبَّبة للنفس التي اعتادعليها أبناؤها الجنوبيون ولم تفارق ألسنتهم أينما رحلوا وأينما حلَّوا في العراق وخارجه. وربَّما وردت هناك توصيفات لرموز شخصيَّة ليست اسميَّة في الرواية من أجل استكمال مشاهد الرواية وتتمة أحداثها السرديَّة المهمّة إنسانياً وإبداعيَّاً.
أكثر من سبع عشرة شخصيَّةً من جنس الذكور والإناث وظَّفها كاتب الرواية علي لفتة سعيد لتكون الهندسة الفنيَّة والبنائيَّة لِعُمارة شخصيَّات (بابُ الدِّروازة)، والَّتي اجتمعت في هذا الحيِّ الشعبي المقدَّس الذي تختزن ذاكرة جدرانه التأصيلية شخوصاً وأصواتاً وتواريخاً ومدناً ومثاباتٍ.
البُعدُ السَّايكولوجي السِّيرِي لِلشخصيَّاتِ:
إنَّ الشخصيَّات التي وظَّفها الكاتب السارد في حيِّ أو خان (بابُ الدِّروازةِ) المؤدِّي لأبواب كثيرة في الكاظمية، هي شخصياتٌ على الرُّغم من فقرها الاجتماعي الشديد وحاجتها الماسة للعمل وانتظار ساعة الفرج والأمل، فإنَّها تعدُّ شخصيَّاتٍ مُفعمةُ بالحبِّ والحياة الحركية النابضة الدائبة والتي لا تكلُّ أو تملُّ أو تفترُ في مواجهة الصعاب والتحديات في نيل المَراد وتحقيق الطموح.
إنَّها أقلُّ ما يُقالُ عنها شخصيَّات مكافحة عَركَتِ الحياة، وسارت في درب الجهاد والتمنِّيات؛ لذلك فإنَّ علي لفتة أعاد تدويرها وتأويلها وإنتاجها من جديد لا تكريرها، ووضعها تحت كاشف التأمل وسونار الوجود في سرديَّات المكان والزمان الذي لا يكتفي بتقصيص حكاياته، بل يذهب إلى تفعيل جُلَّ فكراته وتجديد رؤى سردياته الحدثية بِكُلِّ ما هو مثير للجدل والفكر ونبض الحياة.
فعلي لفتة سعيد ابن مدينة الناصرية الواعي والمَهجوس بها وبماضيها، وهو الذي خَبرَ دروبها وعجن تاريخها واستوعب رغبات نفوس أبنائها، وعاش مآسي وأوجاع وألم حياتها الِّسيريَّة. وكان شاهداً على تحوُّلاتها العصرية زمكانياً وتاريخياً في الريف والقرية والمدينة مثلما كان أبطالهُ أنفسهم شهوداً أحياءً ثُقاةً على فعل جريمة العصر،بل كانوا الضحايا المفجوعين بالألم والوجع والنكوص والمعاناة،وكانوا مُثقلين بالهمِّ وكثرة الجراح والخوف من المجهول الذي ينتظر حياتهم0
كان الكاتب في رحلة تسريداته الحكائية الميلودرامية وتحولاتها السريعة بين (بغداد والناصريَّة)، و (الكاظمية وسوق الشُّيوخ) باحثاً عن مرآة ماضيه الجنوبي السومري وعن مصادر وأنساق ذاته الوجودية والنفسية القلقة التي تصيَّرت أشياءَ ورموزاً ومواضيعَ نفسية وروحيَّة وثورية وآيدلوجية معقَّدة في تركيبة نفوس أبطاله المجاهدين، وشخوصه الأحرار المسالمين عبر هذا العقد الفريد من السلسلة التجريبية من المواقف والأفكار والتحوُّلات السرديَّةالعَصيبة التي أصابت المكان والزمان.
لم يكتفِ الكاتب في أطياف سرده الفسيفسائي الذي يجمع بين وقائع الماضي والحاضر والمستقبل المتقاطع الآتي برصد واقعية هذه التحوُّلات وجمع أحداثها التاريخية والسياسية والاجتماعية المهمَّة فقد ذهب بعيداً إلى مناطق أكثر حساسيَّةً، وإلى التقاط وتصوير وتجسيد نفسيَّاتِ هذه الشخصيَّات المُهمَّشة التي كانت مُتعدَّدة الثقافة والأهواء والسايكولوجيات. وكانت التمثَّلات السردية شاهداً على تلك النفسيَّات الازواجية وعلى حركاتها الفواعلية الحذرة جدَّاً في هذه البقعة المكانية المقدَّسة.
ويعدُّ الانتقال المكاني من المدن والمحافظات الصغيرة إلى مناطق العاصمة بغداد المأهولة سكَّانيَّاً من العوامل الإركيلوجية المهمة في إظهار آثار العامل النفسي والبشري والذاتي المؤثِّر لبنية هذه الشخصيَّات المركبة في الحفاظ على تراثها الثقافي والإنساني، وفي شحن قدرتها على مواصلة الحدث مهما كانت نتائجه السلبية والإيجابية.
ومن خلال ضمير الفاعلية الحدثي أكان (حاضراً أم غائباً)، والَّذي هو اللِّسان اللُّغوي للراوي العليم أو السارد والمُعبِّرُ الفاصح عن واقع حال أصوات الرواية وتُرجمان نفسيَّة شخوصها القلقة، يطرح الكاتب الراوي علي لفتة سعيد جملةً من التساؤلات التأمُّيلة والفلسفية والوجودية الذاتية حول تقرير المصير وإثبات الوجود (أكونُ أو لا أكونُ) فيقول: (ماذا يعني لنا الوطن الكبير حين يتحوَّل إلى منفىً وتغريبٍ،ويتصيَّر إلى خرابٍ ويَبابٍ ودَمارٍ؟)،إنَّه بالتأكيد شعورٌ بالضيق والتِّيهِ والضياع والتشظي والانتشار بدلاً من الحفاظ على بناء هُوية الذات الوجودية في ظل زحمة هذا التشرذم وسيادة الفُوضى وغشاوة سمادير الكدر والضياع الذي يُهدِّد مستقبل الإنسان وكيان هُويته الذاتية.
فمثل هذه الأسئلة ذات الطابع الوجودي التي تُغور في أعماق النفس الإنسانية وتُسبِرُ أنساقها الحركية الداخلية الفائرة تأتي وتؤكد حضورها السردي الفاعل لا لِتروي لنا حكاياتٍ أبطالها وشخوصها المليئة بالوجع الذاتي، والمضمَّخة بالألم النفسي والهَمِّ الوطني الكبير فحسب، بل إنَّما هي في حقيقة الأمر تُقلِّلُ من غلواء واقعة ذلك الأثر الرُّوحي وتُخفِّفُ من شدَّة الاحتقان النفسي الناقم على هيمنة الحدث الكُلِّي وتصاعد تفاقمه وضرره مع تقدُّم الزمن وبقاء التسلُّط الحاكم لها.
كانت أُسلوبية الرائي علي لفتة سعيد الأنويَّة المتمايزة في تأثيث مُعجمه السردي الروائي لمدوَّنة (بَابُ الدِّروازةِ)، هي المقاربة الشخصيَّة للنفس الإنسانيَّة الأمَّارة بالتنازع في ثنائيَّات عَديدةٍ مثل، ثنائية (الألم والأمل)، و (الماضي والحاضر)، (الحكاية والفكرة)، و (المعنى والمبنى)، و (الحسرة واللّذَة)، و (الواقعي والأُسطوري) من المتخيَّل، وغيرها من المتضادات النفسية والمعنوية المُفخَّخة التي اجتمعت غيوم فضاءاتها المُلبَّدة بالأسى تحت مظلة خطابه السردي لتكون جزءاً كبيراً لسياقٍ يُدشِّنُ مشروعه الفكري والثقافي الإنتاجي الذي تميَّز به أُسلوبه العراقي الروائي المتجدِّد سردياً.
فالكاتب لا يسعى إبداعياً إلى اجترار إنتاجه السردي الكبير وتكرار شخصياته في خط ِّمشروعه التواثبي، بل يكشف بأمانةٍ وحرصٍ عن البعد الفنِّي والنفسي لأنماط تلك الشخصيَّات المُهمَّشة والمسكوت عنها عبر فنيَّة هذا التراسل الزماني والمكاني لواقعة الحدث الموضوعية المتجدِّدة.
وعلى وفق تلك المنظورات الشخصيَّة والفنيَّة والتصوُّرات النفسيَّة الهائلة التي إنماز بها أبطال شخصيَّات رواية (بَابُ الدِّروازةِ)، لا بُدَّ من الإشارة إلى بيان مفهوم البعد النفسي أو السايكولوجي لتلك الشخصيَّات الروائيَّة العاملة على إنتاج الحدث وتفعيله فنيَّاً وإبداعياً وجماليَّاً.
فالبعد السايكولوجي لها يُشير إلى مجموعة من الجوانب النفسيَّة والعاطفية والفكرية التي تتشكَّل من خلالها هُويَّة الشَّخصيَّة الروائية المستقلة وتتبلور. فتتأثَّر هذه الجوانب وتؤثِر على سلوكها الذاتي الخاص وتفاعلاتها الجمعيَّة العامة المشتركة مع الآخرين في فضاء محيطها الخارجي.
ومَنْ يُمعنُ النظرَ جليَّاً ويُدققُ في سرديَّات مفهوم البعد النفسي لأصوات رواية (بَابُ الدِّروازةِ)، سيكتشفُ أنَّ الكاتب، أولاً، تناول الدوافع النفسية المثيرة التي دفعت كلَّ شخصيَّةٍ من شخصيَّات الرواية إلى التصرُّف العقلي بطريقةٍ معيَّنةٍ ما. وثانياً سيلحظ أنَّ هذا البعد تناول جميع المشاعر والعواطف والأحاسيس الجياشة المؤثِّرة في سلوك الشخصيَّات وتفاعلاتها الحركية.
وثالثاً أنَّ هذا البعد تناول من خلال التوصيف السردي كُلَّ الأفكار والمُعتقدات والتصوُّرات الشيئية تلك التي تشكِّل نظرة الشخصيَّة للعالم العالم الخارجي أوَّلاً ولذاتها النفسية الداخلية ثانياً. فهذه المُدخلات الثلاثة تُسهمُ إسهاماً كبيراً في بناء وتنمية البعد النفسي للشخصيَّات الروائية.
والبعد النفسي أو السايكولوجي في مدوُّنة (بَابُ الدِّروازةِ) كان له أهميته المعرفية والفنيَّة والجمالية؛ وذلك كونه يُساعد على فهم الشخصيَّة، أي يُساعد المتلقِّي أو القارئ على إدراك وفهم الشخصيَّة ومعرفة دوافعها النفسية وسلوكها العام. فضلاً عن أنَّه يُسهم كثيراً تنامي وتطوير حِبكة الرواية وفي تقديم الصراعات العُقدية والتَّحديات المَصيريَّة للشخصيَّة الرِّوائيَّة ذاتَ الأثر السردي الكبير.
ولمفهوم البعد النفسي للشخصيَّات الروائية في (بَابُ الدِّروازةِ) له تقنياته البنائية المختلفة التي اعتمدها الكاتب الرائي، وقد استخدم الكاتب والمُؤلِّف علي لفتة سعيد ثلاثاً من هذه التقنيات البنائية المهمَّة.فقد استخدم تقنية (الوصفُ النفسيّ)لهذه الشخصيَّات،وأعني بذلك وصف مشاعر كلِّ شخصيِّة وأفكارها ورؤيتها الوجودية، وإن كان نوع هذا التوصيف توصيفاً سرديَّاً متداخلاً في الحواريات الحدثية للشخصيَّات. وقد تمثَّلت مظاهر هذا التوصيف في الشخصيَّات المركزية والثانوية المُهمَّة، فقد وصف شخصيَّةَ كُلاً من (خلَّاوي وسعيد وهادي وسليم وحسن وفتحيَّة وأُمّ صلاح وأُمّ يُوسف).
وستخدمَ أيضاً الكاتب تقنية (الحِوارٌ الداخليُّ) أو المونولوج الذي يُساعد في تخليق التفاعل العميق والمباشر بين القارئ النابه والشخصيَّة الروائية التي تؤدِّي الحدث السردي بإتقانٍ. ومن أمثلة هذا الحوار النموذجية الإجرائية جميع الحوارات الداخلية الكثيرة والمُحتدمة بين شخصيَّة سعيد الثوريَّة الغاضبة وشخصيَّة هادي السلميَّة الهادئة، وما نتج عن هذه الشخصيَّة من أحداث وتوقُّعات عديدةٍ.
أمَّا التقنية الثالثة التي وظَّفها الكاتب بروايته، فهي استخدامه لتقنية (التَّفاعُ مَع الآخرينَ)، وأعني بذلك ما تَقومُ به الشخصيَّة الروائيَّة من تقديم التفاعلات الشخصيَّة مع الآخرين المُهتمِّين بالحدث، وكيفية تأثير هذه التفاعلات الكيميائية والنفسية على أثر سلوكها وتصرفها وحركتها وثباتها. وهذا ما نجده ماثلاً في المشاهد الِميلودراميَّة والسرديَّة التي أدَّتها الشخصيَّات الأنثويَّة مثل، شخصية (فتحيَّة وأُمّ صلاح وأُمّ يُوسف الجِدَّة)، وشخصيَّات ذكوريَّة مثل، (سليم وحسن وحسين وجعاز) التي تفاعلت جميعها مع شخصية خلَّاوي البطل المركزي الحائر في رواية باب الدِّروازة.
وخلاصة القول إنَّ البعد النفسي أو السايكولوجي الذي ضمَّنه الكاتب حكائياً وسِيريَّاً في رواية (بَابُ الدِّروازة) لَعبَ دوراً مُهمَّاً وكبيراً في إظهار الدوافع النفسيَّة والعاطفية الحماسية والاعتقادية والفكرية للشخصيَّات الروائية في مثابة أو خان باب الدِّروازة، والَّتي اتَّضحت معالمها السردية المائزة من خلال التقنيَات الفنيَّة المُستخدمة التي جاءت بها أسلوبية الكاتب سعيد الإبداعية والإنتاجية في صنع عمل روائي مُبهر له خصوصياته الفنيَّة والجمالية التي تستحق كلَّ التقدير.
تَمثُّلاتُ البُعدِ السَّايكولوجي الشِّخصيَّةُ:
إنَّ من أبرز الشخصيات الروائية المُهمَّة التي تركت طابعاً نفسيَّاً وإنسانيَّاً مُركَّباً وعقائدياً آيدلوجيَّاً مُعقَّداً ووطنياً وروحيَّاً دينياً واجتماعياً مؤثِّراً في إنتاج واقعة الحدث السردية لبابِ الدِّروازة، تلك هيَ شخصيَّة (سعيد) الرجل المثقّف وصاحب مَحلَّ بيع الثلج في شارع ضيق من باب الدِّروازة، وشخصيَّة نظيره (هادي) الدينية صَاحبُ محلَّ بيع السِّجَّاد المجاور لسعيد في الحي أو المَثابة نفسها.
وقد عُرِفَ عن الشخصية الأولى بأنَّها من الشخصيَّات الوطنية ذات الميول المحليَّة الشيوعية والفكرية التحرريَّة التي تُحلِّلُ الأمور وتغربل الأفكار وتَستشرف التوقُّعات حول مصير البلد وما ينتظره من تحوُّلاتٍ وتغيُّراتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ مُقبلة تتقاطع مع مصالح الشعب وتطلُّعاته المستقبلية. في حين أنَّ شخصية هادي الثانية، هي شخصية إنسانيَّة مسالمة كيِّسة تميل إلى الحكمة والهدوءوتنظر إلى الأمورنظرةً من جانب تأمُّلي إسلاميٍّ وروحيٍّ في الخلاص من الواقع المَعيش.
أمَّا الشخصية الثالثة والمُهمَّة على الرغم من أنها تمتاز بالبساطة فهي شخصية الفتى (خلَّاوي) المُحوريَّة الاجتماعية التي عُرِفَ عنها بأنَّها شخصيَّة ازدواجية سايكوباثية مضطربة السلوك ومركَّبة التعقيد، ظاهرها الخارجي الشكلي يُوحي بشيءٍ طبيعيٍّ وسَويٍّ،وأمَّا باطنها الداخلي العميق فيشي بأشياء تَخيُّليةٍ وتَصوُّريةٍ أخرى أكثر تعقيداً وغموضاً وهوساً في المشهد السردي الدرامي.
وقد أدَّى ها المثلث السردي لهذه الشخصيَّات المُغايرة فكراً وعملاً وعقيدةً وإدراكاً دوراً فاعليَّاً وأساسيَّاً في إبراز الوجه النفسي الحقيقي لعمل سردي مثل رواية (بَابُ الدِّروازة)، علماً أنَّ هذه الشخصيَّات المُتصارعة آيدلوجيَّاً وفكريَّاً أصولها الانحدارية جنوبية وليست بغداديةً، غير أنَّ ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وروحها الوطنية وتطلُّعاتها الفكرية ألقتْ بها أن تكون في حيٍّ شعبيٍّ من أحياء الكاظمية المقدَّسة. ويضاف إلى سِيرة هذه الشخصيَّات الذكوريَّة المهمَّة شخصيَّات أُنثوية أخرى مثل، شخصية الفتاة (فتحيَّة)، ومثيلتها أُمّ صلاح المرأة المُريبة، والمثيرتين للجدل والغرابة الموضوعيَّة، والشخصيَّة الثالثة أُمّ يُوسف صمَّام الحكمة والأمان الاجتماعي في الخان.
وعلى وفق هذه البيانات الوصفية لشخصيَّات الرواية ومدخلاتها الموضوعيَّة السِّيرية، فإنَّها شكَّلت في حضورها العتبة المهمَّة الأولى من عتبات الحُمولات الفكرية والحوارية السرديَّة المكثَّفة لواقعة الحدث السردية في هذه الرواية، وذلك بدأً من مَطلعها الافتتاحي وحتَّى خواتيمهَا النهائيَّة.
لقد اتَّخذ البعد السايكولوجي لشخصيَّات (بَابُ الدِرّوازةِ) أبعاداً نفسيَّة سرديَّةً كثيرةً التمثُّلات، فجاءت موضوعات حكائية وقصصيَّة عديدة مثل، (الاختلاف الفكري، والحبّ والخوف والعصبية، والطموح المستقبلي، وإفشاء السرِّ، والمحافظة على التقاليد الاجتماعيَّة).وتعدُّ من أبرز موضوعات البعد النفسي التي شهدت تَمثلاتها السِّيرية أحداث الرواية ووقائها السرديَّة الدَّراميَّة المُتصاعدة.
1-الاختلاف الفكري:
فمن أمثلة الصراع الفكري الذي تحوَّل إلى صراعٍ آيدلوجيٍّ ونفسيٍّ مُختلفٍ على الهُويَّات العقائدية ذلك هو الحُوار الذي دار بين سعيد بائع الثلج المؤمن باليسار الوطني والكارهِ لرجال الدين وتصرفاتهم المزدوجة ومواقفهم الخفيَّة الَّتي لا تَمُتُّ إلى حقيقة الدين بِصلةٍ لا من قريبٍ أو بعيدٍ، وبين هادي المُتدين المنضوي تحت مظلة اليمين الإسلامي والمؤمن بأنَّ الوقت قد حان لهم:
"خَرَجَ سَعيدٌ غَاضبَاً مِنَ المَحلِّ، وتَوجَّهَ إلَى بَائعِ السِّبَحِ وَقَالَ بِصوتٍ عَالٍ:.. إنَّهُم سَيتوالدونَ وَسَيتكاثرونَ، فَالفرصَة ُمُواتيةٌ لِقَلبِ مُعادلةِ الحَياةِ بِالخوفِ، والعَالَمُ كُلُّهٌ سَيصنَعُ المُتغيُّراتِ.. رَأى خَلَّاوي عَلاماتِ القَلقَ عَلَى وَجهِ بَائعِ السِّبَحِ وَهوَ يُشيرُ لَهُ بِالسكوتِ أو عَلَى الأقلِّ تَخفيضِ صَوتِهِ، فَهوَ يَذكرُ رِجالَ الدِّينِ بِالسوءِ وَهَم يَعيشونَ حَولَهُ، وَلَا يَبعُدُ مَكانُهُم فِي الحَضرَةِ سِوَى بِضعةِ أمتارٍ. خَرَجَ بَائعُ السِّبَحِ مِنَ مَحَلِّهِ وَسَحبَ سَعيداً مِنْ يَدِهِ وأدخَلَهُ إلَى دَاخلِ مَحَلِّ الثَّلجِ وَأجلَسَهُ عَلَى الأريكةِ وَطاَلَبَهُ بِأخذِ النَفَسِ، وَوَجَّهَ لَهُ سُؤالاً بِلهجتِهِ بِطريقةٍ تَحمِلُ اِستهجَانَاً وَغضبًاً:- أنتَ مَا تَريدْ أتّْوُّب؟ لكنَّ سَعيداً لَمْ يَهدَأْ فَلَجَأَ إلَى ذِكرِ اِللهِ بِسوْءٍ..." (بَابُ الدِّروازةِ، ص 155).
لم تَنتهِ حِدَّة الصِّراع المتفاقم بين الرجلين المختلفينِ تحاوراً في الفكر والاتِّجاه والعقيدة والرأي، وما يمكن أن يحصل للعراق من أحداثٍ سياسيَّةٍ تَهزُّهُ مثلما حصل للجارة الشرقية إيران في الحقبة نفسها على مستوى تغيير نظام الحكم القائم من غربي علماني إلى إسلامي ديني،وكان سعيد وقتها:
"يَصرَخُ وَيقولُ اِنتبهُوا إلَى الآلهَةِ الجُددِ.. كَانَ يَتحدَّثُ مَعَ جَارِه ِالمُقابلِ لِمحلِّهِ فِي الزُّقاقِ الضّيِّق بِائعِ القائمة بينسِّبحِ وَسجاجيدِ الصَّلاةِ وِمَلابسِ الإِحرامِ وَالأحجَارِ وَالمَحابِسِ وَالخَرزِ، وَكلِّ مّا لّهُ عُلاقةٌ بِالطقُوسِ الدِّينيةِ،بِمَا فِيهَا بَيعِ أكفانِ المُوتَى ومَاء الكَافور..كَانَ زُوجِ خَالتِه يُمازِحُ الرَّجلَ بِطريقةٍ عَجيبةٍ لَا يَفعلُها مَعَ أيَّةِ شَخصيَّةٍ أُخرَى..كَانَ يَقولُ لَهُ:-خّلِّ تَنفعكَ هَذهِ الأشياءً؟ (بَابُ الدِّروازةِ، ص 95).
لم يفهم خلَّاوي ما يدور من أحاديث السياسة المُلغَّزة عن الآلهة الجدُّد بين الرجلين، بل كان: "يَعتقدُ خلَّاوي بَعدَ سَماعِهِ لِلكثيرِ مِنَ الحِكاياتِ أنَّ الآلهَةَ الَّتي كَانتْ فِي عُصورٍ غَابرةِ يَمكنُ لَهَا أنْ تَعودَ، بِل إنَّ زَوجَ خَالتِهِ يَصرُّ عَلَى أنَّها مُوجودةٌ، لَيسَ بِمعنَاهَا التَّوظيفِي الَّذي يَستغلُهُ مِنْ يُريدُ غُسلُ العُقولٍ.. كًانً يًستمعُ وَلَمْ يَكُنْ أمامَهُ سِوَى القُبولِ، فَقدْ صَارَ الأمرُ بِعينٍ أُخرَى وَزاويةٍ نَظرٍ أُخرَى..". (بَابُ الدِّروازة، ص 94، 95).وبالتأكيد أنَّ الآلهةَ الجُددَ المقصودين هُم أدوات الحكم الجديدة.
2- العَصبيةُ وَشِدَّةُ الانفعالِ:
كانت صفات نفسيَّة مثل، العصبية وسرعة الغضب والانفعال والثوران الشعوري من أهمِّ الأبعاد النفسيَّة والطباع الحادَّة التي تميِّز شخصيَّة سعيد وتستفزٌّه في معظم الحوارات السياسية والعقائدية الساخنة القائمة بينه وبين نظيره رجل السِّبَح،ولكنْ ما يغطِّي على شخصيَّة سعيد الانفعالية أنَّه كان:
"يَفهمُ مَا لَا يَفهمُهُ الآخرونَ، وَلَهُ عَقلٌ أكبرُ مِنْ جَميعِ النَّاسِ فِي هَذَا المُجتمعِ، يَفهمُ الكَثيرَ مِنَ الأشياءِ الَّتي لا يَمكنُ أنْ يَفهمَهَا غَيرُهُ، يَتنبَأ بِمَا سَيحصِلُ، لَكنَّهُ عَصبيٌّ وَسَريعَ الانفعالِ، فَيضيعُ مِنهُ خَيطُ الإقناعِ.. وَهوَ أمرُ أيضاً تَعلَّمهُ مِنْ زَوجِ الخَالةِ، وأيضاً مَا تَتَعلَّمهُ مِنْ بِائعِ السِّبحِ، حَيثُ يَنساقُ إلَى هُدوئِهِ وَقُدرتهِ عَلَى الإقناعِ بِأقلِّ الكَلماتِ وَأخفِّ الاِنفعالاتِ الَّتي تَكادُ تَكونُ غَيرَ مَرئيَّةٍ لِمنْ يُشاهدهُ.. حَتَّى إنَّه سَمِعَ مَرَّةً مِنهُ وَهوَ يَتحدَّثُ مَعَ سَعيدٍ مُحاولَاً ثَنيهُ عَن ذِكرِ اِللِه بِسوءٍ وَأنَّ هَذَا لَا يَنفعُ بَلْ يَضرُّ وَيُقلِّلُ اِحترامَ النَّاسِ لَهُ، بِل لَا يَجوزُ أنْ يَكونَ كَذلكَ". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 118، 119)
وقد وصل الحال النفسي بسعيد في عصبيته وانفعاله ومشاجراته إلى حدِّ الاشتباك والتدافع في حواراته مع الآخر الذي يشتدُّ معه في جدال أو نقاش حادٍ. وقد حدث مثل هذا السلوك فعلاً مع خلَّاوي الذي يعمل معه حين طلب من زوج خالته أنْ لا يكون عصبياًغاضبَاً فثارت ثائرته النفسيَّة:
"وَكَأنَّهُ رَمَى جَمرَاً مِنْ بُركانٍ عَلَى رَأسِ الرَّجُل، نَظَرَ إليهِ مُستشيطَاً بِشكلٍ مُخيفٍ حَتَّى خُيِّلَ لَهُ أنَّ قَطيعاً مِنَ الكِلابِ تُطاردُهُ، وَقَبلَ أنْ يَهرُبَ مِنْ أمامهِ أمسَكَهُ زُوجُ خَالتِهِ مِنْ يَاقتِهِ وَهَزَّهُ، وَعينَاهُ تَقدحانِ غَضَبَاً شِريراً.. سَمِعَهُ يَقولُ: لَولَا أنَّكَ يَتيمٌ وَابنُ أُختِ زَوجتِي لَطرتُكَ. دَفَعَهُ مِنْ صَدرِهِ فَسقَطَ عَلَى الأرضِ، وَفِي لَحظةِ نُهوضِهِ مَدَّ سَاقهُ اليُمنَى تَحتِ الأريكَةِ فَارتَطَمَتْ بِصندوقٍ خَشبِيِّ.. لَمْ يَكُنْ خَلَّاوي قَدْ شَاهدَهُ مِنْ قَبلَ، فَالأريكةُ عَليهَا فِرَاشٌ...". (بَابُ الدروازِة، ص 100، 101).
3- عَاملُ الخَوفِ:
إنَّ عامل الخوف والرهبة من العوامل النفسيَّة المُهمَّة التي اتصفت بها شخصيَة خلَّاوي والتصقت وأصبحت جزءاً من تفكيره الخيالي البعيد الذي يُصيِّر الناسَ إلى صورة قطيعٍ من الكلاب السائبة. وأنَّ هذا السلوك التخيُّلي الجديد لخلَّاوي هو ما لاحظه عليه أخوه سليم طالب الدكتوراه وحذَّره منه ومن نتائجه، موجِّهاً له عدة توجيهات وتوصيات لا بُدَّ من الالتزام والأخذ بها،بيدَ أن خَلَّاوي صار:
"لَا يَتذكَّرُ كَمْ مِنَ التَّوصياتِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ أخيهِ، وَاحدةٌ مِنهَا أوصَاهُ وَهوَ يَراهُ يَحضِنُ رَأسَهُ بَينَ رُكبتيهِ ألَّا يَكونَ خاَئفَاً دُومَاً، فَهذَا عَيبٌ بِحَقِّ شَابٍ. لَكنَّهُ لَا يَعلمُ أنَّ صَوتَ الكَلبِ أقوَى مِنَ التَّوصِياتِ بين سعيدٍ وهادي؛ لِذَا حَاولَ البَحثَ عَنْ حَلٍ يَهديهُ إِلَى القُوَّةِ كَي لَا يَخَافُ". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 28).
الخوف الذي يشعر به خلَّاوي لم يكن خوفاً ناتجاً عن أمر طبيعيٍّ مُعيَّن ما يحدث له طارئاً، بل كان خوفاً نفسيَّاً مضطرباً تتحوُّل آثاره الفعلية إلى كِلابٍ يتخيَّلها على شكل صورٍ حَركيَةٍ حيَّةٍ تحدث أمامه لا يمكن التخلُّص منها إلا بالهرب والابتعاد من مكان الواقعة إلى فضاء مكاني آخر:
"مَرَّةً حًصلًتْ مُشاجرةٌ فِي رَأسِ بَابِ الدِّروازةِ الَّذِي يُؤدِّي إلَى بَابِي القِبلَةِ وَالمَرَادِ بَينَ اِثنينِ مِنَ بَاعةِ المَلابِسِ النِّسائيَّةِ فِي وَسَطِ الشَّارعِ، تَمَّ فِيهَا اِستخدامُ الأسلحةِ البِيضاءِ مِنْ سَكاكينَ وعصيٍّ .. تَسمَرَّ مِثلَ خَشبةٍ كَأنَّهُ يُراقبُ فِيلَمَاً سِينمائيَّاً، لَمْ يَتحرَّكْ مِنْ مَكانهِ حَتَّى اِزدادَ مَنسوبِ الخَوفِ وتحوِّلِ الجَميعُ إلَى كِلابٍ، حِينَهَا هَربَ رَاكضَاً إلَّى مَحلِّ بِيعِ الثَّلجِ فِي الزَاويَةِ البَعيدةِ؛ لِيتخلَصَ مِنِ جَمهرةِ النُّبَاحِ". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 40، 41).
وقد تحوَّل عامل الخوف عندَ خلَّاوي إلى عامل اقترانٍ شرطيٍّ له مثيراته واستجاباته النفسية التي ترتبط بفاعلية الحدث الحسَّاس والمُخِيف، وخاصةً عندما يتحوَّل النقاش بين سعيد وهادي إلى خلافٍ ومشاجرةٍ وتوترِ وانفعالِ شديدِوحادٍ فيما يخصُّ واقع الحال ويلامسُّ أثرَالمُحال،لكنَّ خلَّاوي:
"مُشكلتُهُ لَمْ تَزلْ فِي الخَوفِ الَّذِي يَعتريهِ، وَمَا أُضِيفَ لَهُ مِنْ وُجودِ الآلهَةِ، آلهةُ الدِّينِ كَمَا يَقولُ صَديقُهُ الفَنَّانُ وَآلهَةُ السِّياسةِ كَمَا يُسمِّيهُم زَوجُ خَالتِهِ وَآلهةُ القَدرِ كَمَا يُسمِّيهُم أخوهُ سَليمٌ .. رُبَّما أَرجِعُ الأمرَ إلَى عَدمِ قُدرتِهِ عَلَى الفَصلِ، حَتَّى الآنَ بَينَ مَا يَعرفُهُ وَمَا يُريدُ فَهمَهُ.. فَقَدْ اِختلطتْ عَليهِ المَعلوماتُ الكَثيرةُ الَّتِي سَقطتْ فِي حَوضِ عَقلِهِ بِصورةٍ مُتسارعةٍ خِلَالَ أَشهُرٍ مَعدودةٍ. وَرَغمَ عَدَمِ اِختلاطِهِ بِالنَّاسِ، لَكنَّهُم وَخَاصةً أبناءُ المَنطَقَةِ...". (بَابُ الدروازةِ، ص 118).
إنَّ شعور البطل خلَّاوي بالخوف ولَّدَ لديهِ شعوراً سريعاً بنضوج الوعي وتنامي الفكر والطموح بالمستقبل الذي ينتظره فراحَ ينظر لما يجري حوله نظرة إحاطةٍ وتحليلٍ ومعرفةٍ ويأخذ بالجديد:
"كُلُّ شَيءٍ تَغيَّرَ فِي المَكانِ وَلِذَا تَغيَّرَ خَلَّاوي،حَتَّى أخوهُ سَليمٌ لاحظّ ذَلكَ وَأغلبُ سُكَّانِ الخَانِ.صَارَ أكثرَ صَمتَاً وَأكثرَ فَهمَاً لِمَا يَجرِي، لَكنَّهُ ظَلَّ وَهوَ مَا لَا يَعرفُهُ أحدٌ، يُحاولُ الوُصولَ إلَى فَهمِ الآلهةِ، وَهَلْ لَهَا عَلاقةٌ بِمَا يَحصلُ لَهُ مِنْ رُؤيةِ الكِلَابِ النَابحَةِ؟ الآلهَةُ الَّذينَ يَقصدُهُم يَختلفونَ عَنْ آلهةِ العَمِّ سَعيدٍ أوْ الفَنَّانِ حَسنِ أو أخيهِ، بَلْ آلهةٍ مِنْ خَوفٍ.. تُطاردُهُ وَكَأنَّها تَقولُ لَهُ لِمَاذَا أَدخلتَ عَقلكَ وَتَفكيركَ فِي أشياءَ لَا يُرادُ لَكَ الوُصولُ لَهَا أوحتَّى التَّفكيرُ فِيها؟" (بَابُ الدِّروازةِ، ص 121).
4- المَحافظةُ عَلَى التَّقاليدِ وَالأعرافِ:
ومن الأبعاد النفسيَّة التي حرص الكاتب علي لفتة سعيد على توظيفها في الرواية، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأعراف والتقاليد والعادات المجتمعية العشائرية هي المحافظة على التقاليد وعدم كسرها بما يجلب لها العار والسمعة السيِّئة بين القبائل. وذلك فعلاً هو ما حصل للفتاة فتحيَّة بفعل حادثة اغتصاب شرفها والاعتداء عليها من قبل شاب سبَّبَ لها الهجرة مع أبيها من بيتها بالديوانية إلى زقاق خان الدروازة ببغداد، الأمر الذي جعلها إحدى ضحايا المجتمع الذي لاذت منه بالفرار:
"مَرَّتْ ثَلاثُ سَنواتٍ عَلَى الحَادثةَ وَسَنتانِ مِنْ الهُروبِ مَعَ أبيهَا الَّذي صَارَ يَصرخُ بإخَوتِهِ مُعترضاً عَلَى طَلبِ قَتلِهَا غَسلَاً لِلعارِ، مَرفُوضاً مِنْ قِبَلِهِ؛ كَونَهَا ضَحيةً.. كانَ الأجدَى بِقتلِ النَّزقَينِ؛ لأنَّهما اِرتكَبَا إثمَاً كَبيراً بِشابةٍ يَتيمةٍ. كَانتْ هِيَ البِنتُ الَوَحيدةُ لَهُ مِنْ أُمِّهَا المَيِّتَةِ.. لَكنَّ الأعمامَ أصرَّوا إمَّا قَتلُها أو الخُروجُ مِنَ القَريةِ، فَهذهِ الفَتاةُ سَتجلبُ العَارَ، وَكانِ عَليهَا الصُّراخُ والاِمتناعُ..لَكنَّ الأبّ هَدَّدَهًم بِكشفِ الجَريمةِ إلَّى الشُّرطةِ أوْ الزَّواجُ مِنهَا". (بَابُ الدروازةِ، ص141، 142)
5- تَفشِّي الأَسرارِ الشَّخصيَّةِ:
ومن التمثُّلات السايكولوجية الأخرى التي طالت شخصيَّات هذه الرواية وأصبحت جزءاً مهمَّاً من ممارساتها الحدثية المُلحَّة في الاشتغال النفسي تلك هي نزعة تفشي الأسرار الشخصيَّة التي تغلف بواطن الشخصيَّة وتُحيطها بالغموض. غير أنَّ مرموزات قصص هذه الشخصيِّات السِّيريَّة وموحياتتها الخارجية والداخلية تفضحُ غشاوة تلك الأسراروتضعها أمام طاولة التساؤل الشخصي، وخاصةً تمثُّلاتها ظهرت عند شخصيَّات الرواية الأنثوية تمثَّلت بالشابة اليتيمة فتحيَّة المُريبة، وشخصيَّة أُمّ صلاح الحفَّافة الَّتي يلفها كثيراً الغموض والسَّرِّية والكتمان والانغلاق الشَّخصي التَّام:
"كَانَتْ أُمُّ صَلَاحٍ تُريدُ سَكبَ مَا بِداخلِهَا لِأغراضٍ تَعتقدُ أنَّها تَستَبِقُ فِيهَا فَتحيَةً، إذَا مَا فَضَحَتْ سِرَّهَا..فالنِّساءُ لَا يَبقَى حَرفُ تَحَت أَلسنتِهُنَّ، فَكيفَ إذَا كَانَ السِّرُّ مِنَ العِيارِ الثَّقيلِ، فَسيبقَى قَولَاً مَشهورَاً مَفضوحَاً يُسيءُإلى السُّمعةِ مَهمَا كَانَ نَوعُهُ،رغمَ هُدوئِهَا وَقدرَتِهَا عَلَى لَملمَةِ الأوضَاعِ، لَكنَّها مِنْ ذَاتَ النِّساءِ الكَثيراتِ الكَلامِ، البَاحثَاتِ عَنِ المَصلَحَةِ... ". (بَابُ الدروازةِ، ص 74).
لقد تمكَّنت أُمُّ صلاح الحفَّافة بشخصيتها العتيدة من أنْ تُشرك معها الحاجَّة أُمَّ يُوسف التي هي جدَّة خلَّاوي، وأنْ تُفضي إليها بأسرارٍ خاصةٍ عن فتحيَّة، وخاصَّةً عن موضوع يخصُّ عذريتها، وليست عن علاقتها الخاصة بخلَّاوي،والتي كانت الحاجَّة أُمُّ يوسف تعتقد أنَّها تخصُّ خلَّاوي معها:
"رَمَتْ أُمُّ صَلاح ٍ كَلماتِهَا فُوقَ الطّبَّاخِ النَّفطيِّ لِتصِلَ إلَّى أَذانِ الحَاجةِ مُباشرَةً كأنَّها تَرمِي ثُقْلَاً كَبيراً خائفة فِي الوَقتِ نَفِسهِ مِنْ رَدَّةِ فِعلِ الحَاجَّةِ قَدْ تَكونُ عَكسيَّةً وَلَنْ تَقبلَ بِمَا تَقولُهُ وَتَعَدُهُ غَيرَ مُناسِبٍ.. (فَتحيَّة لَيستْ بٍاكِرَاً)!! ". (بَابُ الدروازةِ، ص 76).
أمَّا الأسرار الخاصة بأمِّ صلاحٍ والتي كانت تخفيها عن عِلمِ الآخرين فقد أفشت بها إلى صنوها وقرينتها فتحيَّة لكي تستريح من هذا الحمل أو العبء الثقيل ذلك الهمُّ الذي يؤرقها ويزعجها دوماً:
" رَمَتْ أُمُّ صَلَاحٍ تَفاصيلَ مَا حَدَثَ لَهَا فِي أُذنِي فَتحيةَ، وَكَأنَّها رَمَتْ بِكُلِّ اِحتراقاتِهَا وَبراكينهَا وَجمرِهَا؛ لِتشعرَ بِالراحةِ وَالخَوفِ مَعَاً، رَمَتْ مِنْ أولِ حِكايةِ الشَّعَرِ إلَّى لَحظةِ اِستغلالِهَا بَعدَ أنْ نَزلَ الدَواءُ الَّذي وَصَفَهُ صاَحبُ مَحَلِّ الأعشَابِ لها، إلَّى أسفلِ جَسدِهَا حَتَّى حُدودِ رُكبتيهَا، فَكَانَ خَوفُها هُوَ الَّذي جَعلَهَا تَستجيبُ لِطلبِهِ بِرُؤيةِ مَا تَعانِيهُ بِمَا فِيهَا الكَشفُ عَنْ عَانتِهَا وَمُداعبتِهَا بِأصابعِهِ بِحُجَّةِ القِيامِ بِالفحصِ، وَكَيفَ اِنهارتْ صَارخَةً لَيس َفِي وَجهِهِ، بَلْ مِنْ اللَّذةِ بَعدَ جفافِ أعوامٍ". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 152).
6- الطموحُ المَعرفيُّ المُستقبليُّ:
حين نبحث في التنقيب عن أثر عامل الطموح الذاتي والمستقبلي نجده حاضراً في الشخصيَّات الروائية الذكورية التي ورد الحديث الحكائي عنها في سرديَّات الرواية والتي تشكِّل جانباً نفسيَّاً وثقافياً مُهمَّاً من شخصيَّات الرواية المتنوُّعة الاتجاهات، والتي لديها أيضاً رغبةٌ عارمةٌ في تحقيق مطامحها الشخصيَّة والمعرفية في المستقبل القريب. فترى شخصيَّة سليم الطالب الطموح في الحصول على شهادة الدكتوراه، وشخصيَّة حُسين طالب الطبِّ الذي يطمح نفسيَّاً واجتماعياً أنْ يكون طبيباً يوماً ما،وشخصيَّة حسن طالب أكاديمية الفنون الجميلة الذي يحلمُ أنْ يكون فنَّاناً مبدعاً:
"وَحقَّاً فَقدْ رأى[سَليمُ] أنَّ أخاهُ[خَلَّاويَ] قَليلَ الكَلامِ مَعَ الجِيرانِ إلَّا مَعَ اِثنينِ، حُسَينٌ جِيرانهُ فِي السَّكَنِ، وَهوَ أيضاً طَالب كُلَّيةِ الطِّبِ، وَحَسنُ وَهوَ أيضاً طَالبٌ فِي أكاديميةِ الفُنُونِ الجَميلَةِ.. وَهوَ مَا فَعَلَهُ حِينَ وَجَدَ ضَالتَهُ فِي الفِكرِ وَالفَنِّ وَالحَياةِ مَعَ حَسنِ الفَنَّانِ". (باب الدروازة، ص 14).
ويُلاحظ من خلال المسرودات الحكائيَّة والقصصيَّة لأحداث الرواية أنَّ الفتى (خلَّاوي) على الرغم من كونه شاباً مراهقاً لم يكمل الإعدادية في تحصيله العلمي والدراسي؛ لكنَّه كان ميَّالاً لمجالسة المُتعلِّمين والاستماع لأحاديثهم ونصائحهم التنويريَّة والمعرفيَّة، وكان أيضاً شديد الحبِّ والرغبة في التعلم من أجل مستقبل زاهر يضمن له الحياة رغم عوامل الفشل التي واجهها عمليَّاً:
"لَمْ يَكُنْ حِينِهَا قَدْ أكمَلَ عَامَهُ السَّاسَ عَشرَ.. يَرَى المَدينةَ الَّتي تَعنِي العِراقَ وَيَسمعُ بِهَا مِنْ أَفواهِ الَّذينَ زَارُوهَا وَمِنْ فَمِ أخيهِ الَّذي قُبِلَ فِي كُلَّيَّةِ الإدارةِ وَالاقتصادِ يَرَاهَا مِثلَ اِمرأةٍ تُمَشِطُ شَعرَهَا عَلَى نَهرِ الفُراتِ، وَلَمْ يَعلمْ بَعدَ أنَّ بَغدادَ يَشطرُها نَهرُ دِجلةَ الخَالدُ الَّذي يَتغَنَّى بِهِ كُلَّمَا قَرَأ نَشيدَاً عَنِ الوَطنِ، يَرَاهَا غَافيَةً تَحتَ سَعفَاتِ النَّخيلِ...". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 6، 7).
7-الرَّغبةُ بِالحبٍّ والإغْوَاءِ العَاطفِي:
لم يبقَ من الأبعاد النفسيَّة السايكولوجية التي زخرت بها أحداث رواية (بَابُ الدِّروازة) إلّا عامل نفسي مُهمٌّ جدَّاً، ذلك هو نزعة الحُبِّ أو العشق والغرام وما يرافقه من إغواء وتحرُّش جنسي.وهو الذي سعت إليه شخصيَّة الفتاة فتحيَّة وما خطَّطت له للإيقاع بالفتى القروي الطاهر خلَّاوي بحبال غرامها وهو المُتردِّد والمُحافظ الذي يشعر بالحياء والخجل؛بسبب تربيته الاجتماعية ويتمه المُبكِّر. فهو لم يجرب معنى العشق أو الغرام مع أي فتاةٍ في مدينته ذات الطبيعة العشائرية سوق الشيوخ:
"ظّلَّ خَلَّاوي يَابِسَاً فِي مَكانِهِ وَعيناهُ عَلَى صُنبورِ المَاءِ دُونَ كَلمةٍ إلَّا مِنْ أنفاسِهِ المُتلاحقةِ.. وَعَيناهُ تَجوبانِ الأبوابَ المُنغلقةَ حتَّى بَابَ المَرافقِ البَعيدةِ.. وَبَعدَ جهدٍ اِنتبهَ إلَى أنَّها كَانتْ تَتقَصَّدُ الوُقوفَ لَصقهِ. لَمْ تَنزلْ مِنْ دَرجِ الطَّابوقِ، وَلَمْ تَتحرَّكْ عَنهُ مَسافةَ سَنتمتراتٍ، بَلْ كَانتْ تَتَعمَّدُ كُلَّمَا تَمدُّ يَدَهَا إلّى المَاءِ تَضربُ خَاصرَتَهُ أوْ بَطنَهُ أوْ حَتَّى أسفلَ بَطنهِ. كَانتْ تَتشرَّبُ دُونَ هَوادةٍ كَأنَّها قَطَعتِ المَسافاتِ الكَبيرةَ فِي الصَّحراءِ.. بَلْ إنَّها زَادتْ مِنَ الحَركةِ وَتَركَتْ فُخذَهَا يُلامسُ فَخذَهُ. كَانتْ هِيَ بِجسدٍ مَربوعٍ قَليلاً.. لَهَا وَجهٌ دَائريُّ وَعَينانِ لَمْ يتبيَّنهُما مِنْ قَبلُ كَونهُ لَمْ يُطلْ النَّظرَ إليهَا أبداً.. وَرُبَّما هَذَا السُّكونُ اِعتبرتهُ فَتحيَّةُ مَقصودَاً، أوْ أنَّها شَعَرَتْ أنَّه يَستصغرُهَا وَلَا يُبالِي بِجمالِهَا، وَهوَ أمرٌّ لَا تَرضاهُ.. لَكنَّه لَمْ يِكُنْ مَشغولاً بهَا، بَلْ كِانَ مُنشغلاً فِي تِلكَ اللَّحظةِ بِكيفيةِ التَّخلُّصِ مِنْ لِزوجةِ المَكانِ وَرعشَةِ التَّلامُسِ". (بَابُ الدِّروازةِ، ص 35، 36).
هذا ما يخصَّ أو يتعلَّق بعلاقة فتحيَّة بالشاب خلَّاوي، وكيف أن الأمور لم تضبط وفشلت معها في تحقيق مراميها السديدة؛ لأن هناك توجُّساً ورقيباً حوله، وعيوناً تلاحقه وتحدُّ من حركته البريئة وتضبط حسن سلوكه ونشءتربيته التي كان شاهداً وصفياًعلى أخلاقه الحميدة وسيرته الحسنة فقد:
"كَانَ الزَّمنُ يَمشِي خَافتَاً فِي الخَانِ، وَثمَّةُ مُماحكاتٌ لَا يَرَاهَا أحدٌ بَينَ أُمِّ صَلاحٍ وَفتحيَّةَ، وَلَمْ تَشغلْ بَالَهَا الحَاجَّةُ أُمُّ يُوسفَ بِالأمرِ، فَكُلُّ مَا يَعنيهَا ألَّا يَكونُ حَفيدُهَا قَدْ تَورَّطَ بِعَلاقةٍ مُرِيبةٍ مَعَ فَتحيَّةَ مَهمَا كَانَ نَوعُهَا، سَواءٌ كَانتْ عَلاقةَ حُبٍّ أمْ عِشقٍ أوْ كَمَا تُسمِّيهَا (يِنامُ وَيَّاهَا)، وَهذَا كُفرٌ وَعَيبُ". (بَابُ الدِروازةِ، ص127).
إنَّ العَلاقات الشخصيَّة التي تحدث بين رجل وامرأة تحت ما يُسمَّى بالعَلاقة العاطفيَّة أو الحبِّ له نتائجه النفسيَّة والاجتماعية الخطيرة إذا لم يكن يسوده الثقة والأمان والوفاء والإخلاص. وقد يتحوُّل إلى دمارٍ وتحطيمٍ للشخصيَّة وخاصةً الأُنثوية التي تسعى إلى استثمار علاقتها الإنسانية من أجل الزواج والارتباط الصحيح؟ وهذا ما حصل لفتحيَّة في علاقتها المُريبة مع ابن عمها الشَّاب الذي خدعها ثم اغتصبها مع صديقة سائق السيَّارة الذي أقلهما، فتركا فتحيَّة في قارعة الطريق المُغاير فريسةً للمجهول. هذه القصة ترويها أُمُّ صلاحٍ للحاجَّة أُمِّ يُوسف لما حصل لفتحيَّة فتقول:
"وَبِصراحةٍ كَبيرةٍ أخبرتهَا أُمُّ صَلاحٍ بِشكوكِهَا مِنْ خِلالِ مَشيتِهَا وَنهديهَا وَفَرجةِ مُؤخرتِهَا.. لَكنَّ الحَقيقةَ الَّتِي أرادتْ فَتحيَّةُ التأكيدَ عَلَى أنَّها ضَحيةٌ لِعمليَّةِ اِختطافٍ مُدبَّرٍ بِحَّجةِ الحُبِّ. أخبرتهَا أنَّهُ أَخذَهَا مَعَ صَديقٍ يَمتلكُ سَيَّارةً مِنْ نَوعِ (لَادَا)، طَلبَ مِنهَا الصُعودَ سَألتهُ عَنْ السَّائقِ، قَالَ لَهَا إنَّه صَديقٌ مُهمَّتهُ إيصالُنا إلَّى المَكانِ وَيَذهبُ. أعادتِ الحَكايةَ مُنذُ البِدايةِ وقَالتْ إنَّها كَانتْ وَاقفةُ فِي ظَهيرةٍ تُموزيَّةٍ قَاسيةٍ، عَائدةً مِنْ بَيتِ خَالتِها حِينَ طَلَبَ مِنهُ ذَلكَ. طَبعاً فِي الحَالتينِ هِيَ تَقولُ الحقيقةَ، فَقدْ كَانتْ عَائدةً حَقَّاً مِنْ بِيتِ خَالتِهَا، لَكنَّهَا كَانتْ عِلِى مَوعدٍ مَعهُ، لَمْ تَذكرْ ذَلكَ فِي حَديثِهاَ. المُهمُّ السَّائقُ أوصلَهَا إلَى البَيتِ المَهجورِ وَغَادرَ بِسيارتِهِ...". (بَابُ الدِّروازةِ، ص142، 143).
ومن أمثلة وشواهد الإغواء والتحرُّش الجنسي الذي قامت به فتحيَّة لإيقاع خلَّاوي في شباك حبِّها، كونه يتيماً مثلها وقريباً لنفسها ومستواها الاجتماعي مع فارق بسيط بينهما، وهي فتاة ناضجةٌ ومستحقة للزواج وعمرها يفرض عليها الشعور بالحاجة الماسة للمُتعة الجسدية والجنسية، خاصةً وأنها بايلولوجياً قد ذاقت طعمها حين تم اختطافها واغتصاب عفتها وشرفها من قبل قريبها الشاب المخادع الذي يسكن في مدينتها الديوانية.فتحيَّة ضحيَّة وفتاة مسكينة تبحث عن فرصتها في الحياة:
"نَعودُ إلَى تِلكَ اللَّحظةِ الَّتِي لَمْ تَزلْ فِيهَا فَتحيَّةُ وَاقفةً إلَّى جَانبِ خَلَّاوي عَلَى تِلكِ الطَّابوقاتِ فِي دُرجِ الحَوضِ أوْ سُلَّمِهِ.. سَمّهِ مَا شِئتَ.. فَقدْ جَعلتهُ مُتعمِّدةً يَرتعدُ خَوفَاً وَتَرَقُّبَاً وَهيَ تَضربُ بِفردةِ مُؤخرتهِ أعلَى فُخذهِ حِينَ مَحنيَّةً عَلَى صُنبورِ المَاءِ لِتغسِلَ وَجهَهَا وَلَا تَجعلُ المَاءَ يَسقطُ إلَّى السَّاحةِ.. حَاولَ النُّزولَ، لكنَّهَا وَقَفَتْ خَلفَهُ تَمَامَاً، فَصارتْ بَطنُها لَصقَ ظَهرِهِ، فَارتعَدَتُ حَرائقُ المِعدانِ فِي سُوقِ الشُّيوخِ وَهيَ تَأكُلُ عَشراتِ البُيُوتِ المِبنيَّةِ مِنَ القَصبِ فِي اِشتعالِ التِّبنِ وِالأبقارِ وَحتَّى الجَاموسُ...". (بَاُب الدِّروازةِ، ص 40).
ليس هذا هو المشهد المُتفرِّد والأخير للإغواء والتحرُّش الجنسي مع ما حصل لشخصيَّات رواية (بَابُ الدِّروازة) الُأنثوية والذكورية، فقد كان المشهد الميلودرامي السردي الذي حصل لأمِّ صلاح الحفَّافة مع صاحب محلِّ الأعشاب في سوق السَّربادي لمعاينتها والكشف على المنطقة السفلى الحسَّاسة من بطنها ومداعبتها حتّى بلغت ذروته الحسيَّة التأوه (والتَّنيطُ الصوتي) من أكثر المشاهد الإغرائية الجنسية إثارة وتهيُّجاً لحركة الأنوثة الصوتية. وقد أبدع الكاتب سعيد في توصيف إيقاع هذه اللحظة الإمتاعيَّة الفارقة حين مزجَ بينَ الحركة الصوتية المُتمثِّلة بالصُّراخ والتأوُّه الصوتي الجنسي، وفعل الحركة الإمتاعية الروحية للجفاف النفسي لهذه الصورة السردية حين قال عنها: "اِنهارتْ صَارخةً لَيسَ فِي وَجههِ،بَلْ مِنَ اللَّذةِ بَعدَ جَفافَ أعوامٍ"الظَّمأِالطِّوالِ. (بَابُ الدِّروازةِ، ص 152).
فضلاً عن هذا كلِّه يضاف إلى ذلك ما حصلَ في حمَّام النساء من مشاهد عُريٍّ وإغراءٍ جنسيٍّ وعاطفيٍّ داخل أروقة وخلف سِتار هذا الحمَّام، وقد ذكرت فتحيَّة الكثير من هذه المشاهد حينما زارت الحمَّام أول مرَّةٍ لها برفقة شريكتها أمّ صلاح. وقد تمَّ الحديث عن بعض السرديَّات في هذه الدراسة. فمثل هذه المشاهد في الرواية التي وظَّفها الكاتب لم تاتِ اعتباطاً لغرض إثارة القارئ وتسخين مشاعرة، وإنَّما كانت جزءاً مهمَّاً من المشاهد الحكائية الموضوعية لتنشيط وتكثيف فاعلية السرد الروائي فنيَّاً وجماليَّاً ونفسيَّاً. وهي تعبيرٌ فنِّيٌّ عن تقانات الكاتب وإيقاعه الأُسلوبي النفسي.
وقبل أنَّ أختم الحديث عن تمثَّلات البعد الفنِّي والجمالي والنفسي أو السايكولوجي لشخصيَّات باب الدِّروازة، لا بُدَّ من الإشارة والتنبيهِ لا التنويه النقدي إلى أنَّ معظم شخصيَّات هذه الرواية تميَّزت بأنها من أكثر الشخصيَّات المُهمَّشة والمُغيَّبة فكرياً وآيدلوجياً وعقائدياً وثقافياً، والمسكوت عنها قصدياً أو عن غير قصدٍ في الواقع الحياتي المعيش. وخاصةً شخصيَّاتها الأنثوية التي تعاني شظف العيش والجهل والفقر والفاقة والعوز والإهمال الشديد للمرأة ودورها الاجتماعي والحياتي.
أمَّا شخصيَّات الرواية الذكورية على الرغم من أنَّ بعضها يتحلَّى بمكانة علميَّةٍ وفنيَّةٍ ومعرفيةٍ وثقافية كفاحيةً مهمَّةٍ، فإنها غير قادرة على النهوض بدورها القيادي الفاعل في المجتمع تُجاه تعدُّد الآلهة ودورها القمعي الحاكم لها. وهي أيضاً مُعطَّلة غير قادرة على اتخاذ أي قرارٍ جريءٍ وشجاعٍ وحاسمٍ في المواجهة والتصدّي لتمظهرات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يَئنُّ من الظلم والاستبداد المناطقي لها. وخيرُ دليلٍ على ذلك التهميش عجزُ بطل الرواية المركزي وفقدان شجاعته وركونه لزاوية الاستماع والصمت والإذعان والقبول بالمحيط.
هذه الأفكار جميعها أسهمت بإمتاع وإتباع ٍفي صنع وإنتاج وتخليق عمل روائي تاريخي مهمٍّ من تاريخ العراق السياسي والثقافي في حيٍّ شعبيٍّ من أحياء بغداد يُدعى خان (بَابُ الدِّروازةِ)، حتماً ستكون له مكانته الثقافيَّة والفنيَّةً وإضافته المعرفية المهمَّة في رفوف وأروقة السرديَّات الروائيَّة للمكتبة العراقيَّة خاصَّةً، والعربيَّة عامَّةً. وسَتشهدُ نقديَّات الثقافة العراقية لكاتبه المثابر الشُّمولي علي لفتة سعيد بمكانته الإبداعية والثقافية المتمايزة بين مُجايليه من أدباء وكُتَّاب الوطن الكبير.
***
د. جبَّار ماجد البهادليّ / ناقدٌ وكاتبٌ عراقيّ