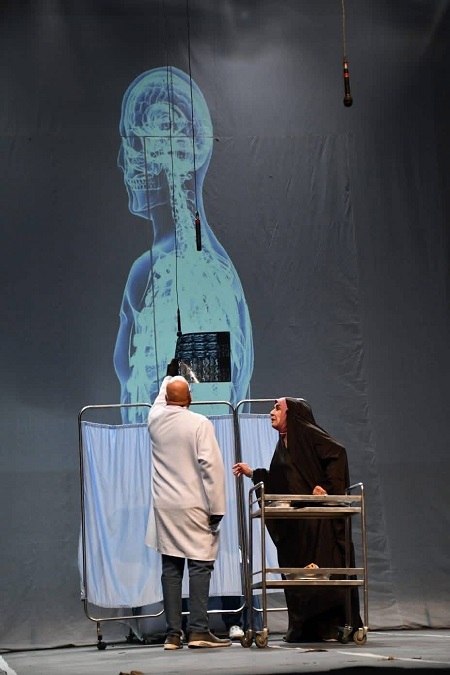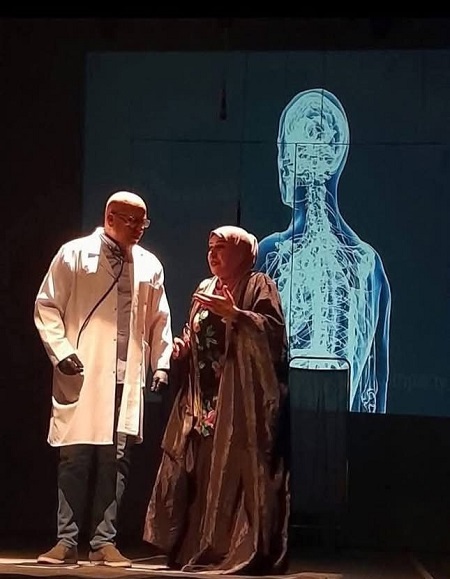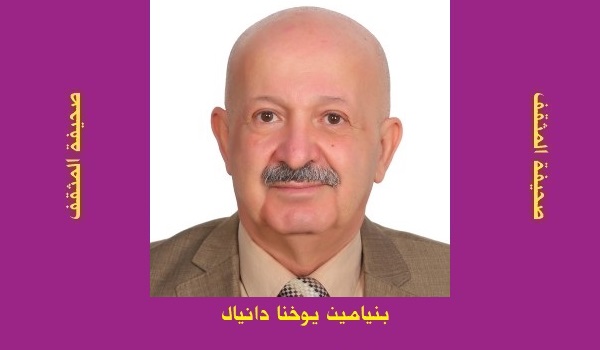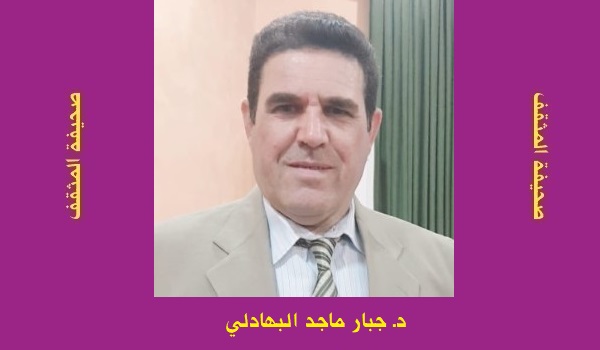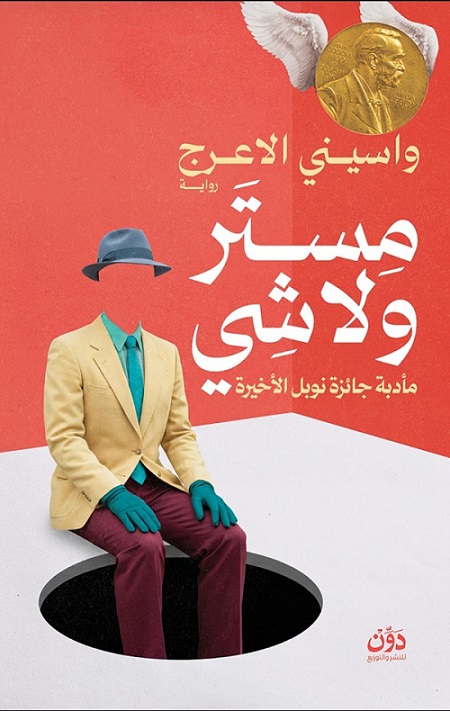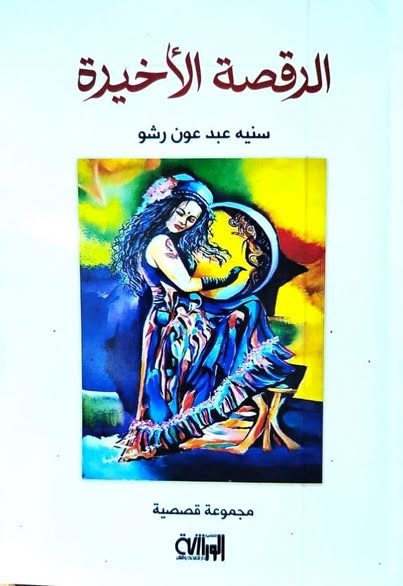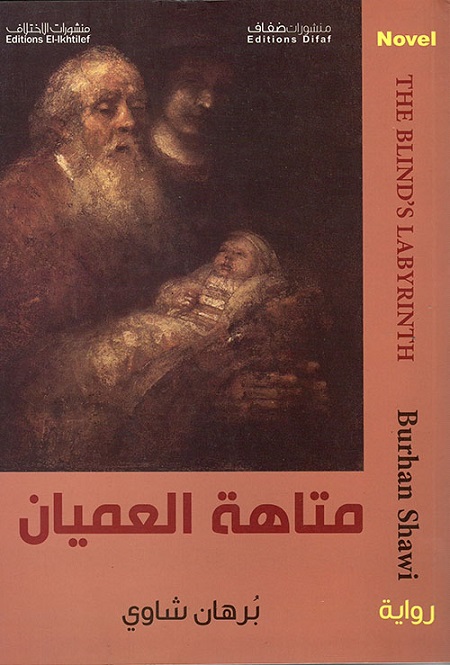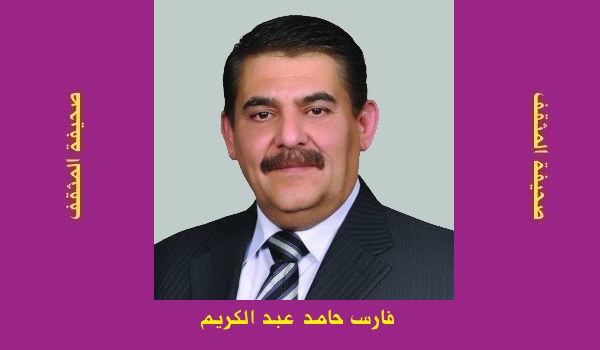في شَخصيَّاتِ (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحِيلَ)
تَقديـمٌ: حِينَ يتحوَّلُ القصُّ الحكائي إلى لُغة مكانٍ وزمانٍ ورموزٍ تاريخيِّة روحيَّة، وشخصيَّاتٍ شعبيَّة واجتماعيةٍ حقيقيةٍ وواقعية، ضاربةٍ جذورها العميقة بأرض الواقع الوجودي الكوني الذي ينتمي إليه الإنسان حياةً ومِماتاً، وليست حركةً عابرةً الوجود، فإنَّ لُغة الإبداع السردي تتفجَّر عيوناً محكيَّةً من أديم هذه السرديَّات، وتنبجسُ إشراقاتٍ توهُّجيَّةً عديدةً وامضةَ الأثر النَّفسي من خلال الصدى الحركي لتلك الشخصيَّات الفواعلية، وفعل حركتها المتنامية على أرض الواقع وفضائه المعيش.
الأمر المُثير الذي ينعكس أثره الفعلي الإيجابي على ذائقة المتلقِّي النصِّي، ويُلقي بظلاله الآسرة على نفسية القارئ الظمأى التي تبحث دائماً عن معاني الإشراق الصوري وجمال التكثيف اللُّغوي، وصفات التجديد الذي يُنشِّطُ ذاكرتها الفكريَّة، ويُحيي جفافَ رَواءَها الرُّوحي والإنساني عبر مجسَّات هذا التراسل الزمكاني الفعلي الذي يستشعره ألقَاً حيَّاً في شفرات رسائل الإبداع النصِّي.
من ثوابت النقديَّة المُنصِفة، أنَّ ليسَ كلُّ قديمٍ بَالٍ يُعدًّ نظريَّاً قديماً، ولا كلُّ جديدٍ مُستحدَثٍ يُعدُّ جديداً مواكباً لضرورات الحداثة وما بعدها، وإنَّما في الحقيقة، أنَّ مظاهر الجِدَّة والتخليق والابتكار والإبداع تكمن روافده الجديدة في منابت القديم ونتاجات الجديد، وفي مُوحيات التُراث والمعاصرة.
وهذا التمايز الفنِّي والجمالي هو ما تَشي به حكايات هذه المجموعة القصصيَّة البيئية القصيرة، وتنطق به أصداء موضوعاتها الإنسانية البحتة ووحداتها العضويَّة السَّريَّة التي يجمعُها رابط واحد يمثِّل مُعادِلاً مُوضوعيَّاً فنيَّاً وإنسانيَّاً جمعياً يتداخل فيه أثر الفعل السردي الواقعي بالتاريخي الديني الرمزي، والواقعي المَعيش بالغرائبي الفِنتازي أو العجائبي الفنِّي المُذهل الذي ترتبط جذوره الأساسية وأُسهُ الحدثي بالواقعية نفسها مصدر إلهام الكاتب ومُوئِل إبداعه الفكري الفلسفي الأصيل.
بِناءُ المُدوَّنةِ القصصيَّةِ وتَأثيثُها لُغويَّاً وفَنيَّاً:
(مَشاحيفٌ تًأبى الرَّحيلَ)، هي المجموعة القصصيَّة القصيرة للأديب والكاتب السومري العراقي الجَنوبي السَّاخر مُحمَّد سيِّد كرم الموسوي، والصادرة بطبعتها الأولى عام 2025م عن دار السرد للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد، ومن القطع الكتابي المتوسِّط وبواقع كمِّيٍ بلغ نحو (95) صفحةً. تُمثِّل هذه المجموعة واحدةً من أبرز مجاميع الميتا سرد القِصصي الحديث الذي يعتمد فيه الكاتب شكلاً ومضموناً على لُغة الموروث الشعبي العراقي.تلك اللُّغة المَحكيَّة أوالشعبيَّة المَحَليَّة القُح لأهل الريف أو عرب الأهوار في الجنوب العراقي، والتي تمثِّل بالأصل (لُغة المِعدانِ) امتداداً للسُومريين.
وهذه اللُّغة المكانية لا يفهمُها الكثيرُ منَّا إلَّا مَنْ كان يَنتسب إليها أو عاش فيها، وفهم معانيها ومغزى دلالاتها القريبة والبعيدة الموغلة في قدِمِ المنطقة. ولا شكَّ أنَّ الكاتب محمَّد كَرَم الموسوي هو ترجمانها الناطق وابن منطقتها الذي تربَّى وسطَ ربوع بيئتها الأهواريَّة، وهو أدرى بِطُرق شِعابِها، وأعلمُ بثقافتها الشعبيَّة وعاداتها وتقاليدها وهمومها وأحزانها، وهو من أدرك تحوُّلاتها النسقية ونظمها الاجتماعيَّة والطبقيَّة؛ فضلاً عن كونِ نسبُهُ سَيِّداً من أشرافها، وأنَّ أباه وجيهاً منها. فلا ضيرَ أنْ يكون شاهداً حيَّاً على هُوِيَتِها المكانيَّة وثقافتها الزمانية العشائرية والإقطاعية السائدة.
كلُّ هذه المُدخَلات الأرضيَّة للطبيعة والحياة والناس، والمُخرجات الفكريَّة لعوالمها الإنسانية الوجودية جعلت من القاصِّ محمَّد كرم الموسوي في هذه المُدوَّنة أنْ يكون عَيناً بصريَّةً ونقديَّة ثقافيةً ثالثةً لها، وصارَ مَعيناً فكريَّاً ومعرفيَّاً إنتاجياً مُخَلَّقاً زاخراًومؤهَّلاً لمثل هذا اللُّون الشعبي من السرديَّات القصصيِّة المحلِّية الناطقة بأعباء الحياة وتجلِّياتها الضَاجَّة الحركة لسُكَّان تلك المنطقة الموغلة في الِقدَم زماناً، وتلك القرى والقصبات المجاورة لها في الأهوار والمِسَاحاتِ اليابسة منها.
كانت منطقة (الخُمُسِ) ذات الطبيعة الأهوارية البحتة، ونُهر (البُتيرة) في شمالي مدينة العمارة، هما نقطة الانطلاق المركزية لاشتغالات الكاتب، وخطّ مثابة التكثيف البؤري السردي التي بنى عليها الكاتب تصاميم هندسته المعمارية في تأثيث قصص هذه المجموعة المُذهِلة مُحتوىً وفكرةً ولغةً.
تسعةُ نُصوصٍ قصصيَّةٍ نسقيَّةٍ مُتراتبةِ الأثر يتبعها نصٌّ عاشر آخر لا ينتمي إليها؛ كونه نصَّاً فنيَّاً مُغايراً في صياغة الفكرة والهدف والمَغزى. وكلِّ نصٍّ من نصوصها التسعة يمثِّلُ قصَّةً تكامليةً متفرِّدةً في موضوع وحدتها وثيمتها العضوية الفكريَّة المُرتبطة بها. وأنَّ كلَّ قِصةٍ تُعدُّ مَشحوفاً سُومريَّاً من مشاحيف تلك المنطقة القابعة في حافَّات ووسط الأهوار التي تأبى مفارقتها والرحيل عنها وعن خريطة وجودها الانطلوجي المكاني.إنَّها تَمثُّلاتُ عشق الإنسان الأهواري وحبِّه لأرضه وطبيعتها الكونية المتحركة والثاتبة، وانتمائه العرقي لأصله وحياته الاجتماعية والمعيشية القَارَّة.
أُسلوبيةُ الكَاتبِ المُوسويّ القِصصيَّةُ:
إنَّ مَنْ يطَّلع بتؤدةٍ على إعمال ونتاجات الكاتب القاصِّ محمَّد سيَّد كرم الموسوي ويقراً مجاميعه القصصيَّة وسرديَّاته الأُخرى، سيخرجُ بنتيجةٍ فنيَّةٍ وموضوعيَّةٍ مَفادُها أن الكاتب الموسوي ينماز في مركزيَّة اشتغالاته بخاصِّيتينِ إبداعيتينِ مُختلفتين في فنيَّة التعبير السرديَّة. الخاصِّيةُ الأُولى، إنَّ الموسوي كاتب ساخر بامتيازٍ ومن النوع الحاذق والمثابر في رسم معالم السُّخرية النقديَّة اللَّاذعة في سهم الصميم السردي، ولا سيَّما في نتاجاته القِصصيَّةِ القصيرة جِدَّاً التي تمثِّل أدباً نثرياً إشكاليَّاً حديثاً، والَّتي يمتلك فيها عيناً نقديَّةً سرديَّة ثاقبةً ومؤثِّرةً في التقاطاته للواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي الشعبي. وهذا ما هو موثَّقٌ جدَّاً في جُلِّ كتاباته السرديَّة القصيرة الأخرى.
أمَّا الخاصِّية الثانية التي تميَّزت بمغايرتها الفنيَّة عن أثر الأولى، هي كتاباته الألمعية وفتوحاته الإشراقية المُكثَّفة الجادَّة، وخاصَّةً في قِصصه القصيرة وكتاباته السرديَّة الأخرى، وفي تمثُّلات المقاربة والتماهي مع الواقع الحياتي المَعيش ومحاكاته بعين سرديَّةٍ مُبهرةٍ ترصد تجلياته الوجودية وتكويناته، وتتقفَّى بحفريَّاتها وتنقيباتِها السياقيَّة والنسقيَّة الثقافية آثار طبيعته التاريخية والحضارية التأصيلية الضاربة في العمق التاريخي. فهو يرصد بعدسته الواقع الحياتي المثير بكلِّ فئاته وطبقاته المختلفة0 ويكشف بصدق عن أبعاد حمولاته الفكرية والثقافية، ويُشخِّص هُوِيَتَه الإنسانية المتفرِّدة وطابعه التكويني الذي درجت عليه العادة أنْ يكون شاخصاً معروفاً بهُوِيَته الحضارية.
وهذه الخاصِّيَّة الأخيرةُ هي ما تكشف عنه بصدقٍ وحياديَّةٍ مُجانبةٍ لأثرِ الواقع الجمعي الحياتي موضوعاتُ وشخوصُ قصصِ هذه المجموعة (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ) التي نحنُ بصدد دراستها وتفكيكها، والكشف عن رؤى فلسفتها الفكرية ومصادر أنساقها الأدبية والثقافية الظاهرة والخفيَّة.
وأنَّ اللَّافت المُثير في قصص هذه المُدوَّنة وطبيعة استجاباتها السرديَّة الحكائية الفاعلة، ذلك هو أنَّ كُلَّ قصَّةٍ من قصصها التسع تحمل بصمةً موضوعيَّةً، وفنيَّةً جماليًّةً تفرُّديَّةً في جميع طيَّاتها الانثياليَّة الواثبة عن سجايا وطبائع وصفات وإيثار وعدل رمزٍ من رموز الأمة التاريخيَّة والدينية الإسلامية الخالدة، ذلك هو صوت العدالة الإنسانية، والبطل التاريخي الغالب، عليُّ بن أبي طالب، ليس تقديساً مَذهبيَّاً وإنَّما إيماناً وتعضيداُ لمقولة الرسول الكريم (ص) : "عليُّ معَ الحقِّ والحقُّ مَعهُ".
فعدلُ عليٍّ وإيثاره ومناقبه وشجاعته وإقدامه وبطولاته كانت بحقٍّ منارةً هذه القصص والبؤرة المركزية لاشتغالاتها الفكرية وثيمها الموضوعيَّة المُتعدِّدة النظر والمتوحِّدة الأثر. فَعليُّ بنُ أبي طالبٍ هو المعادل الموضوعي الكبير والميزان العادل للحقِّ في أنساق هذه القصص التي لم تُبَخَسْ شخصياتُها، ولم تُهزمْ في حياتها طالما هي متمسكةً بجدوى ذلك الأثرالمُشرق وتاريخه الطويل الذي لا ينكسر مَهما تطاولت عليه يَدُ الزمن وكَثُرتْ خيباته واشتدَّت به الرَّزايا وغربلته عاديات المحن .
تَمثُّلاتُ الكاتبِ لِشخصيَّاته القِصصيَّةِ:
لم تأتِ تمثُّلات الكاتب محمَّد سيِّد كرم ومقصدياته السرديَّة لشخصيَّة هذا الرمز التاريخي العادل بصورة تكلُّفيةٍ أو مصطنعةٍ، ولم يقحمها إقحاماً جبريَّاً؛ بل كانت غايته الموضوعية فنيَّةً وجماليَّةً لتكونَ شاهداً على تلك الشخصيَّة المِقدامة وتأثيراتها النفسيَّة والروحيَّة على شخصياته الفواعلية وحركتها الفعليَّة.وكان حضورها السردي ومجيؤها الحدثي عفويَّاً طبيعياً خالصاً لا تشعر معه بثقلٍ أو إملالٍ أو تَبرُّمٍ في قراءاته حيالَهُ، وإنَّما كان هو ملحُ هذه القصص ودواؤها الشافي لزيغ النفوس.
والأجدر في مسار ذلك الانطباع الفكري، وتلك السلاسة التعبيريَّة وهُدى سيره الانقيادي العذب في مضامين فنيَّة التعبير، هو تلك اللُّغة الفارقة المُغرقة بالمعاني والدلالات الشعبيَّة المحليَّة المُحبَّبة التي تجمع بين شخصيَّة الرمز الديني الوثوقيَّة المُبهرة الأثر، وفعل تلك الشخصيَّات القصصيَّة الاجتماعية المؤمنة بها إيماناً مُطلقاً. حيث لا يُمكن أن تشعر بوجود هوَّةٍ ساحقةٍ بينها وبين الرمزِ.
لقد عمد السيِّد محمَّد كرم في عنوانات سردياته القِصصيَّة التسع إلى إسقاط تأثيرات تلك الشخصيَّة الفعلية الرامزة وإبراز مُوحياتها الإنسانيَّة والدينيَّة على بساط واقعة الحدث الموضوعية، وعلى تجلِّيات الراهن المعيش. فهوَ لم يُسقطْ مُؤثِرات الواقع وتداعياته على ذات تلك الشخصية الرمزية؛ لينسجَ منها قِصصاً وحكاياتٍ موضوعيةً وإيثاريةً مُبهجةً مؤثرةً، بل عَكَسَ ذلكَ الموروث على المعاصرة في انعطافاته السرديَّة التي تَمُّتُ بصلةٍ كبيرةٍ إلى صميم واقعه الزمكاني المثير.
فمثل هذه المغايرة الأسلوبيَّة والتمايز الفني يُضفي على السرد القِصصي مَهابةً فنيَّةً رَائعةً وجمالاً إمتاعياً تنعكس مرآة رؤاه الفكرية وصوره الإنسانية المُدهشة على نفسيَّة القارئ وتمنح النصَّ جَلالاً وقدسيةً خالصةً. فما من قصَّةٍ من قصص خطابه السردي تخلو من مؤثِّرات ورفعة وسمو وجلال الخلودية لهذه الشخصيَّة التي يدين لها التاريخ العالمي بالتقدير والاحترام والامتنان العادل.
وعلى الرُّغم من أن شخصيَّات محمَّد كرم الموسوي القصصيّة تتراوح مكانتها الوجودية بين الشخصيَّات الشعبيَّة الفقيرة المُعدَمة في مثابات المجتمع الريفي والأهواري الجنوبي، وشخصيٍّات اجتماعيةٍ أخرى ذات المكانة والجاهِ الاقتصادي والثقافي والسياسي والرُّوحي الداخلي والخارجي لمدينة العمارة ذات الطابع الجنوبي المتمايز في خصوصيته المكانية المعروفة، فإنّ الكاتب استطاع أنْ يوازن بين واقع تلك الشخصيَّات المُختلفة ويُحْسِنُ توزيعها بشكلٍ عادلٍ ومتساوٍ في خريطة مضامين هذه القصص وتمثُّلات وقائعها الحدثية ومقارباتها الصوريَّة المتنامية.
وتمكن القاصُّ الموسوي أيضاً من خلال سعة ثقافته الفكريَّة واستعداده المَعرفي الابستمولوجي المُكتسب إنْ يجمع في سردياته بينَ مُختلف المَذاهب الدينية والإثنيِّات الِّتي تَدين بهاهذه الشخصيَّات القصصيَّة المُتنوُّعة، فضلاً عن ذلك قومياتها العربية والكُرديَّة العراقيَّة والعربيَّة الأُخرى المُتَّصلة بالحدث والتي يجمعها رابط المحبَّة القويِّ والعرفان والتبجيل والقداسة والإنصاف لشخصيَّة الإمام علي التاريخية العادلة التي لا تُفرِقُ بين انتماءات هذه الشخصيَّات وأصولها المذهبية والعِرقية، إلَّا لكونَّها تَدينُ بصفات الجامعة الإنسانية التي يستظلُّ بظلها الوارف أبناء المعمورة البشريَّة جمعاء.
عتباتُ النصِّ المُوازي:
يُعدُّ العُنوان الرئيس أُوْلَى عتباتِ النَّصِّ المُوازي، بل هو أهمُّ عتبةٍ عنوانيةٍ شاخصةٍ من عتبات النصِّ الموازي؛ كونه مفتاحاً لبوابة النصِّ الذي يُحيط به، والطريق المؤدِّي إلى ظلال شطآنه الوارفة. وهو الكاشف عن وقائع وتجلَّيات فضائه الرمزي والدلالي المعنوي؛ لأنَّ النصَّ الموازي هو في الحقيقة دراسةٌ مستفيضةٌ لتلك العتبات المُحيطة بأرجائه، بدءاً من العنوان الرئيس، رأس خيط أو (الوِشِيْعَةُ) التي يُمسك بها القارئ والمتلقِّي، ومروراً بخيوطه المتشابكة الأخرى أو عتباته الفرعية مثل، (التصدير والتمهيد والمدخل أو التقديم)، وحتَّى عتبة الإهداء، وانتهاءً بعتباتِ عُنواناته الداخلية القصيرة وخواتيمها، حتَّى لوحة التظهير الخارجيَّة الثانية الَّتي هي خلاصة قصديَّة الكاتب.
أمَّا (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحِيلَ) فَهيَ لوحةُ الكتاب العنوانية الأولى، وهي رايةُ وشاخصُ معماريَّة النصِّ الموازي المُهمَّة التي تَقرُّ مشروعيته الفنيَّة والموضوعية بشكلٍ خاصٍ، والتي تُزيلُ عنه كلَّ إشكالات الغموض والارتياب من خلال إستراتيجيته العنوانية الشعريَّة والسرديَّة الإعلانيَّة.
ونذهبُ في الاتجاه نفسه إلى فنيَّة (التصدير) أو التمهيد لهذا الكتاب الذي هو مجموعة قصصية لمدوَّنةٍ سرديَّةٍ، فقد ارتأى الكاتب الموسوي أن يكون التصدير المُمَهِّد لمجموعته هذه قولاً صريحاً عن رمزية الكتاب وإشارةً واضحةً بالاسم إلى شخصيَّة علٍي بنِ أبي طالبِ الإنسانية التي توحدن موضوعات هذه القصص وتغلِّفها بإطار رمزيٍّ وروحيٍّ لمناقب هذه الشخصيَّة وكثرةِ صفاتها الإنسانية الجميلة، مستشهداً الكاتب بمقولة رجلٍ كتابيٍّ مُحايدٍ ذلك، هو الكاتب العربي المَهجري جبران خليل جبران أحد رموز الشعر العربي الحديث الذي شغف بعليٍ، وفهم جيَّداً شخصيته: "ماذا أقولُ عَنْ (عَليٍ) ؛ الرَجلُ الَذي أقرَّ لَهُ أعداؤهُ وَخُصومُهَ بِالفضلِ، وَلَمْ يُمكِّنُهم مِنْ جَحدِ مَناقبِهِ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 5) . وتكفي هذه الإشارة النصيَّة الواضحة التي استعارها الكاتب نصيَّاً عن علاقة عليِ بن ِأبي طالبٍ بسرديَّات نصِّه المُوازي القِصصية ومحتواه الفكري رمزيَّاً.
ولم يكتفِ القاصُّ الرائيُّ محمَّد الموسوي بالمدخل التصديري لمجموعته القصصية، بل ذهبَ إلى عتبة نصيَّةٍ أُخرى من عتبات النصِّ الموازي، تلك هي المقدِّمة التي نادراً أو قلَّما تأتي في بداية المُدوَّنات السرديَّة القِصصيِّة؛ ولكن الكاتب كَتبَ مُقدِّمةً قصيرةً لمجموعتهِ بدافع الضرورة التي تفرض نفسها، ولغرض تنبيه القارئ إلى أنَّ العنوان السابقَ الذي أعدَّه الكاتب لم يكن نفسه العنوان الحالي (مَشاحيفٌ تَأبى الرَّحيلَ)، وإنَّما كان غيره كما يذكُر بهذهِ المُقدِّمة، كان اسمه القارُّ الصريح، (عليٌّ والمِعدانُ)، وهو العُنوان الذي كان مُقرَّراً سلفاً لهذه المجموعة القصصيَّة، إذ يقول:
"مُنذُ عَامينِ أو أكثرَ، وَحتَّى قَبلَ إصدارِها بِأُسبوعينِ، أو لِنَقُلْ حَتَّى تَدخَّلَ بَعضُ الأُدباءِ مِمَّنْ اعتبرَهُم فِي مُقدِّمةِ الوَسط الثَّقافِي المَيسانِي، فَتناطحتِ الأسماءَ البَديلةَ، من بينهَا: شِغافُ القَصبِ، جُذورُ الوَلاءِ، قَصبُ الانِتماءِ، إلى أنْ استقرَّ الرأيُ عَلَى ذَاكرةِ الطينِ، الذَاكرةُ الِّتي لَمْ تَكنْ نَعلمْ أنَّها (قَويَّةٌّ) إلَى هَذَا الحَدِّ...يَبقَى عَليٌّ حَاضراً فِي المَتنِ وَفِي ضَمير المِعدانِ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 7) .
وعلى الرُّغم من الاستقرار على العنوان الأخير (ذَاكرةُ الطِّينِ)، فقد كانت المفاجأة أنَّ العنوان كان مطروقاً في السابق بإصدارين لغيره؛ لذلك تمَّ العدول عنه إلى العنوان الحالي (مَشاحيفٌ تأبَى الرَّحيلَ) الذي أراد الكاتب فيه أن ينقل لنا بصمةَ هؤلاءِ المِعدان في جنوب العراق؛ لكي يكون عليٌّ كما يرى حاضراً في ضمير المعدان السومريين ووجدانهم، واللَّذين هُم أصلِ هذه الأرض الرَّحِبة.
إنَّ اختيار الكاتب العنوان الأخير كان هادفاً وفي مَحلِّه، فمفردة (المَشاحيفُ) التي هي جمع لكلمة (مشحوف)، القارب أو الزورق الصغير من بين المفردات المحليَّة التُّراثية المتوارثة التي كان السومريون يتداولونها حياتياً في مستنقعاتهم الأهوارية لغرض التنقل بواسطتها، فضلاً على ذلك أنَّها تَمُّتُ بصلةٍ كبيرة لسكَّان الأرض (المِعدان) الأصليين. وهي أيضاً ذاتها الكلمة التي يشمئزُ منها الكثير من الناس الذين لا يعرفون أصل معناها الحقيقي وجذورها السومريَّة العريقة فَيرونَها تَخَلَّفاً.
هذا يعني أنَّ لكلِّ مَشحوفٍ قصَّةً من قصص هذه المدوَّنة السومريَّة التي لا يُريدُ الكاتب أنْ تندرسُ آثارها وتُمحى معالمها التاريخيَّة عن وجه الأرض خاصَّةً وأن المِعدانَ المُتأخِّرين من سُكَّانها ينظرون بمحبَّةِ تقديسٍ وإيمانٍ كبيرين إلى عليٍّ بن أبي طالبٍ الذي هو عدو الفقر والفاقة، ونصير الفقراء والمساكين وسادنهم الرُّوحي والاجتماعي الذي يرون فيه صور حياتهم ومماتهم فكيف لا؟!
عَتباتُ المُدوَّنةِ السَّرديَّةِ وتَمثُّلَاتُها الدَاخليةُ:
قَطعاً لا يمكن أنْ نُحيط بعتبات النصِّ الداخلية لهذه لمدوُّنة ونستطيع أن نستجلي أغوارها الدلالية والموضوعية بعمقٍ ما لم نقرأ كُلَّ قِصّةٍ من قصص هذه المجموعة منفردةً ونُفكِّك عُقَدَ شفراتها اللُّغوية والدلاليَّة، ونُدرك حكايات أنساقها الثقافيَّة ومضمراتها الدلالية الظاهرة والخفيَّة، ونقف على عمق العلاقة الروحيَّة الوثيقة بين شخصيَّاتها البطوليَّة المتنوُّعة، وبين شاخص الرمزية التاريخية الدينية التي تغوَّرت بينَ طيَّاتها شاهداًإنسانياً على العصروارتباطه برموزه وقادته المائزين الأفذاذ.
1- قِصَّةُ (ذَاكرةُ الطِّينِ)
يفتتحُ الكاتب والقاصُّ مُحمَّد سيِّد كرم أُولى قصص هذه المجموعة بحكاية قصَّة (ذاكرةُ الطِّينِ) التي يطوف فيها بذاكرة المكان السومري جنوباً مشحوناً بتمنيِّات الرجل المُسنِّ الثَّمانيني عبدالسَّادة ذلك القابع في مغتربه بهولندا مع ولده الشَّاب حسن السُّومري الذي يُمازح أباه ويسأله، ماذا يتمنَّى في ليلة عيد رأس السنه الميلادية التي يحتفل بها الناس من العرب والأجانب في أوربا. فما كان من عبد السادة إلَّا أنْ طلبَ منه مُتمنيَاً بكلِّ بساطةٍ وتواضعٍ وحنينٍ وبلهجته الجنوبية المَحليَّة المكانية:
"مَفرشَ كَصَبٍ، وَمِدخنةً والبَرشَةَ هَيج مِنْك تِلبِكُ بِذِيْلهَا". (مَشاحيفُ تَأبَى الرَّحيلَ، ص9) .ومثلُ هذا الطلب يعدُّ كثيراً على عبد السادة الذي يشعر بغربته حاملاً ذكرياته عن ذلك الطين الذي كان همَّهُ.
لكنَّ حلم الأب الحقيقي ليس هذه الأشياء المادية التي تُعيده إلى ذاكرة الطين المكاني الأول للوطن والحياة الفائتة، بل كان ذلك مزحةً؛ وإنَّما التمنيِّات الحقيقية التي يَتُوقُ إليها الأبُّ عبد السَّادة ويسعى لتحقيقها هي التواجد بحضرة أميرالمؤمنين عليٍّ حبيبِ القلوبِ وأن يحظى بفرصة زيارته:
"أَمزحُ مَعَكَ ياَ وَلَدِي، فَمَا أتمنَّاهُ فِعلاً فِي هَذهِ اللَّحظةِ هُوَ أنْ أنعَمَ بِإغفاءَةٍ عَلى المَرمَرِ البَاردِ في حَضرةِ أبي الحَسنينِ وَأشمُّ بِنَهمٍ عِطرِ شُبَّاكهِ الطَّاهرِ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص10) .أيُّ حُبٍّ هذا لِعَلي!
ويستطرد الكاتب في عرض شوق عبد السَّادة وحنينه الطفولي إلى الأهل والمكان والزمان الذي غادره دون رجعةٍ، فيَستذكر بلهجته الدارجة والمحليَّة الكثير من الأسماء والمسمَّيات الخاصَّة بالمأكل والمشرب، من مظاهر طيورٍ وأبقارٍ وفاكهةٍ وحليبٍ ومشتقاته المحليَّة الكثيرة. فضلاً عن ذلك تتعدَّى تمنياته الذوقيَّة والجسديَّة ذلك الشوق والرغبة إلى تحقيق حُلُمه الأخير في أن يكون رُقَاده النهائي في المثابة التي يتوق لها تلك أرضُ (الغْرَيْريَّة) بالقرب من مرقد سيِّده عليٍّ في الغري.
هذا الرجل القرشي والرمز البطولي الذي ارتبط اسمه بالفقراء من سواد الناس في بلاد سومر من الذين يتصدَّق عليهم ويغدق بالمساعدة والعطايا والهَبات الإنسانية التي تَسدُّ رمقهم. هؤلاءِ الناسُ المُسلون المتعبون هم من أقاصي مدينة العمارة.حتّى نظراؤهم في الحياة من الإخوة الصابئة المندائيين ممن يعيشون في الأهوار واليابسة، وكانوا يلهجون دائماً بذكرعليٍّ وحبَّه ويَقسمُونَ باسمه الصريح في أوقات سرَّائِهم وضَرَّائِهم. تُرُى مَا سرُّ هذا الترابط الروحي الوشيج بين عليٍّ وهؤلاءِ الناس البسطاء من فقراء عامة الشعب؟!إنَّه حقَّاً الحبُّ والعشق الإنساني لشخص عليِ أثير النفوس.
ويرسم لنا الكاتب في خواتيم قصَّته (ذَاكرةُ الطينِ) الأولى حُلُماً فنتازياً لأُمنية الرجل الجنوبي: "يَحلمُ عَبدُ السَّادةِ بِحَيدرةَ وَقَدْ أتاهُ عَلَى حِصانهِ، يَحملُهُ مَعَهُ وَيَغيرُ بِهِ إلى أرضِ الأنبياءِ والأوليَاءِ، يَدخُلُ حَسنُ لِيَطمئنَ عَلَى أبيهِ، يُشاهدهُ مُبتسمَاً؛ يَقتربُ مِنهُ وَيبتسِمُ هُوَ الآخرُ بَعدَ أنْ تَأكَّدَ مِنْ أنَّه نَائِمٌ، يُطفِئ ضَوءَ الغُرفةِ وَيُغلِقُ البابَ، يَتركُهُ مُسافرَاً مَعَ حَاضرِ الشِّدَّاتِ[عليٍّ]، يَجوبُ بِهِ أَروقةِ الحُلُم"ِ. (مَشاحيفٌ تَأبى الرَّحيلَ، ص 14) . وتنتهي قصَّة عبد السادة المغرم بسيرة وحياة عليٍّ بانتهاء حُلُم الأخير، لكن الرابط الإنساني به أقوى من كل الأحلام والتمنيات الشخصية نفسها.
2- قصَّةُ (رصيفُ الوجعِ)
هي القصَّةُ الثانية المُغايرة من قصص هذه المُدونة الحكائية، والتي اختار لها الكاتب الموسوي عنواناً فنيَّاً مُشبعاً بالألم والمعاناة والفقر، العنوان الذي هو في واقع الأمر يعدُّ كنايةً عن ذلك الوجع المرير الذي أصاب صاحبه الرجل المكافح المدعو جمعة بائع النايات وعازفها في قارعة الطريق. وقد عُرِفَ عن جمعة معاقرته الدائمة للخمر وحبِّه الأثير للغناء السَّبعيني العراقي الأصيل وترديده:
"كَانَ جُمعةُ يَحتسِي الخَمرَ وَيُدخنُ السَّجائِرَ مَعاً حَتَّى أكمَلَ الزُّجاجَةَ؛ أَخرجَ نَايهُ وَصارَ يَعزفُ أُغنيةَ البَنفسجِ لِشاعرِهَا مُظَفَّرِ النَّوابِ، إلى أنْ تَبادرَ إلى ذِهنهِ جُملةُ: (وَعَلَى المَامِشِ عَودتنِي وألمِتنِي) ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص16) .
هذه بعض من صفات شخصية جمعة الظاهرة وسنعرف الخفيَّة الغامضة منها خلال هذه القراءة النصيَّة لحكايته. وتدور بين جمعة ونايِهِ حُواراتٌ حميمةٌ ومؤلمةٌ، يبدي فيها الرجل عتبه وتذكيره لنايه، أنَّ سبب وجوده وتداوله بين الناس هو أصابعهم التي لا تصنع ألحاناً عذبةً ومختلفةً، فمن خلالها تأتي مآرب كثيرةٌ شتَّى، فلولا هذه الأصابع لما صمدَ النَّايُ في البقاء والتواصل، فلهذه الأصابع سحر كبير في صنع الأشياء وأنسنتها. فَيُذَكُّره ما لهذه الأصابع من فعلٍ حياتي مؤثِّر إذ يقول عنها بحسٍ شاعريٍّ وقلبٍ مملوء بالأمل رغم الألم الوجع والجراحات التي تغلِّف روحه:
" (الأصابعُ حُروفُ شَاعرٍ...)، و (الأصابعُ نَشيدُ نَايٍّ...)، و (الأصابعُ سُعالُ المَحاكمِ فِي صَالاتِ الاتّهامِ...)، و (الأصابعُ مَصانعٌ لِتعليبِ الخِزيِّ والعَارِ...)، و (الأصابعُ حَسَّابةٌ تَتَلَذَّذُ بِانزلاقِ العُملةِ الخَضراءِ[الدُولارِ]...)، و (الأصابعُ مَخالبٌ تُوجعُ وُجهُ التُّرابِ...)، و (الأصابعُ سبَّاباتُ أربابٍ (قَادةٌ) ...) و (الأصابعُ فَاعلاتُ خَيرٍ...) ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلِ، ص 16- 19) .هكذا يصف الكاتب مهارةَ الأصابع.
هذا الوجع الكبير الذي يستشعره قلب جمعة من خلال بيعه للناي، وما خلَّفته آثاره من نكوص نفسي دفعه إلى ترك تلك الحرفة البسيطة، واتخاذه وسيلةً أخرى له بدلاً منها، تلك هي قيامه ببيع صور الأئمة والآيات القرآنيَّة التي اقترحتها عليه بائعة الدولمة في (المُيدَان) الذي يعمل فيه ببغداد.
وإذا كان شعوره الأول مع الناي ومحاورته الدائمة له، صار الآن يتحدَّث مع صورة الرمز عليٍ بن أبي طالب في محاورة يستحضر فيها شخصية الإمام ويوجِّه له سؤالاً فكريَّاً وكأنَّه صديقه:
"لِماذَا لَمْ تَعِشِ حَتَّى يُومنِا هَذَا؟ يَا أبَا الأيتامِ، أمَا تَعلَمُ أنَّني يَتيمٌ وبِحاجتِكَ؟ أمَا تَعلمُ أنَّ الفُقرَ فِي أيامنَا هَذهِ صَارَ رَجُلاً؟ رَجُلاً يَمشِي عَلَى قَامتهِ مُتطاولاً دُونَ أنْ يَخافَ؟ مِنْ سَيقتلُهُ وخَوارجُ هذَا الزَّمان ِتَهتفُ لِلصِّ (عِلِي وِيَاْك عِلي) "! (مَشاحيفٌ تأبَى الرحيلَ، ص22) . كان عليُّ بن أبي طالب المُحارب التأصيلي الأول لفعل الفقر والفاقة بعد الرسول، والفقر عند عليٍّ غربةٌ للروح ما بعدها غربةٌ، (الفُقرُ في الوطنِ غُربةٌ)، ولا يُلقَّاهَا إلَّا من عاشها وذاق مصيرها الإنساني وأذاها العدواني.
والسؤال الذي يخالج أذهاننا في هذا الحوار الذي جرى بين رجلٍ وضيع وآخر رفيعٍ، بين جمعة الرجل المخمور المعدم البائس الفقير، وعليٍ الرمز البطولي الصادق الأثير. أليس ما صَرَّح به عليٌّ عن الفقر الذي يسلب الناس حياتهم؟ أليس عليٌّ هو الفاعل القائل: (لَوْ كَانَ الفقرُ رَجُلاً لِقتلتَهُ) ؟ فهذا لشعور الضافي الذي يؤمن به جمعة الرجل الفقير هو من حَملَهُ إلى كتابة وصيته الأخيرة حين يحين الحينُ ويُلقي ربَّه بوجه أبيض فيه من الولاءِ والمحبَّة و الأخلاق لرمز الإمة الإسلاميَّة:
"إلَى مَنْ يَضعنِي بِالقبرِ اِتركْ لِي عَلَى شَاهدةٍ صُورةً لِعَلِي وَنَايَاً، ثُمَّ اِحتضنْ الصُورةَ وَنَامَ إلَّى الأبدِ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرّحيلَ، ص22) .صورة عّلٍي كَشاهدةٍ عَلَى قَبرِ جًمعة هي أشبه بقصيدة رثاءٍ تُوثِّقُ لجمعة الحِرَفِي المَيِّت وعليٍّ الإنساني الفذِّ المؤمن.والجمع بين أخلاق الفضيلة والرذيلة عنوان مهمٌ.
3- قِصَّةُ (رُجوعٌ بَيدَ أنَّهُ اِنطلَاقٍ)
على الرغم من كونه رجوعاً بالمعنى اللُّغوي والدلالي لهذا المصدر التوصيفي العنواني، بيد أنَّه نقطة شروعٍ جديدةٍ مهمةٍ تُشكِّل بدايةَ البداية نحو حياةٍ عقائديةٍ مُغايرةٍ، وفَحوَى هذا الكتابة التأمُّلية تتحدَّث عن شخصيَّة الرجل (ضُرغام)، ذلك الشَاب الوسيم الذي عاشَ في كَنَفٍ أُمِّه في منطقة زيُّونة التي تقع وسط بغداد بعد أن عاد من انكلترا واستقرَّ به المَقامُ بهذا الحيِّ. وأنَّ تسميته باسم ضرغام لم تأتِ جُزافاً عابراً على سبيل المصادفة أو لغرضٍ جَماليٍ، وإنَّما كانت تسميتهُ قصديةً لغايةٍ مَذهبيةٍ وعًقائديةٍ تيمُّناً بأسماء وصفات عليٍ، وقد أقرَّت بها أُمُّه واعترفت له بهذه التسمية المعروفة:
"وَأسميتُكَ ضُرغامَاً تَيمناً بِواحدةٍ مِنْ كُنَى أميرِي عَليٍّ (عليهِ السَّلامُ)، أفْضلُ البَشرِ بَعدَ النَّبِي (صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلهِ وَسَلَمَ)، وَنَجحتُ بِكُلِّ شَيءٍ إلَّا أنْ أجعلَكَ مُتديناً تُصلِّي وَتَصومُ، وَأقولُ رَبِّي سَيهدِيَك يَومَاً، فَهوَ يَهدِي مَنْ يَشاءُ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 24) .
وتسميةُ ابنها باسم ضُرغامٍ أوَّل علامة من علامات التأثُّر بشخصيَّة الإمام عليٍّ الفريدة، خاصَّةً وأنَّ ضُرغاماً قد عاش مع أبيه الأجنبي الانكَليزي في بلدٍ مثل انكلترا، ومعَ ذلك تمضي الأقدار مع ضرغامٍ على العادة التي دَرجَ عليها في بريطانيا والثقافة التي طبعت هُوِيَته الغربية. فهل يَا تُرَى يبقى ضرغامٌ على هذه الشَّاكلة التي اكتسبهاأم أنه يحدث تراجع في شخصيته وثقافة الغربية؟ هذا ما تتحدَّث عنه صُلب القِصَة بمفاجأةٍ سوف تغيَّر حياته إلى نحوٍ جديدٍ أفضل، والذي سيكتشفه هو بنفسه في مُجتمعٍ عربيٍّ إسلاميٍّ شيعيٍّ تأثراً بما يراه واقعاً ويلمسه عن أثر عليٍّ في النفوس.
تمضي الأيام والسنون سريعاً مع الشَّاب اليافع الطَّموح ضرغام فيذهب يوماً ما معَ جماعةِ حقوقِ الإنسان بزيارة خاصَّةٍ إلى مدينة النجف الأشرف، والِّتي من خلالها يفتح له السفر المفاجئ إليها أبواب النجاة وعلامات الانبهار وآفاقاً رَحبة لِمَا رآهُ من صور ومشاهد روحيَّة وإيمانيَّة ونفسيَّةٍ عميقةٍ لضريح الإمام عليٍ، وسلوك زائريه وحُجَّاجِهِ من الناس مختلفي الأجناس والهُوِيَّات.
ويرى ضُرغام خلال زيارته امرأةً كبيرةً في السِّنِّ تنوحُ وتبكي نواح الثكلى بلحنٍ سومريٍّ جنوبيٍّ شجيِّ يأخذُ النفوس الحزينة ويُقَطِّع نياطَ القلب وعلائقها الداخلية بالألم؛ كونها تَرثي فقيدَاً لها وأحباباً أعزةً. فتتدفَّق مشاعره الإنسانية حيالها، ويبادرها دون تردِّدٍ بسؤال بريءٍ، لماذا أنتِ تندبيهم وتخاطبي عليَّاً (عليهِ السَّلامُ) وجهاً لوجهٍ؟ وهي المرَّة الأولى التي يذكر فيها (عليهٍ السلامُ) . فما كان من تلك المرأة أنْ تُجيبه عن سؤاله قائلةً له بكلٍّ عفويةٍ وصراحةٍ جنوبيةٍ خالصةٍ محببةٍ:
" (إحنَا اليَتَامى وهوَ أبونَا)، فَتصفعهُ هَذهِ الجُملةُ، وَيَرمِي رَأسَهُ بِأحضانِ المَرأةِ ويَنفجرُ بِالبكاءِ، تَمسَحُ عَلَى رَأسِهِ، تُداخِلُ أصابعَهَا بِشعرِهِ وَكأنَّهَا تُمشطُهُ بِكَفِّهَا، يَتغشَّاهَا فَجأةً شُعورُ الأُمومةِ؛ تَعودُ مُستأنفةً نًعيًهًا وًرأسُ ضُرغامٍ فِي حِجْرِهَا". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 29، 30) .
هذه المشاهد الطبيعة الإجرائية لهذه المرأة الجنوبية الثكلى أثَّرتْ جدَّاً في نفسيَّة ضرغام تأثيراً روحيَّاً شديداً، وهزّتُ مشاعره الإنسانية والإيمانية وجعلته منبهراً من سجايا عليٍّ وتأثيره السحري في نفوس شيعته وأتباعه الخُلَّصِ ومُعتقديهِ. بَيدَ أنَّها لم تقف عند هذا الحدِّ من التأثر الشكلي، وإنما كانت سبباً ودافعاً مباشراً لقيامه بأداء فريضة الصلاة على المسلم الحقيقي، والتي لم تكن يوما ما في جدول حسابته الفكرية وأولويَّات معتقداته الدينيَّة والآيدلوجية الغربية التي تربَّى عليها:
"وفِي صَباحِ اليَومِ التَّالي، كَانتْ أُمُّ ضُرغامٍ تَعدُّ طَاولةَ الإفطارِ، وَتُنادي وَلدَهَا، كَي يُشاركُها الطَّعامَ، وَبَعدَ تكرارٍ لَمْ يَرِدْ [عِليهَا]، فَقصدتْ غُرفتَهُ قَلقةً وَخائفَةً، وَهيَ تَفتحُ البَابَ بِتوجِّسٍ، شَاهدتهُ عِندَ الزَّاويةِ، سَاجداً للهِ يُصلَّي". (مَشاحيفٌ تَأبى الرَّحيلَ، ص31) . فهذ الختام هو مفارقة التأثُّر بعليٍّ وبمعتقدي مذهبه يعدُّ بحدِّ ذاته رجوعاً بعد انطلاقٍ مغايرٍ لهُويَّة الإنسانِ العقائدية وسلوكياته.
4- قصَّةُ (حُكومةُ المَجانينِ)
هذه القصَّة على الرُّغم من كونها قصةَ حكومةِ مجانينٍ، بَيدَ أنَّها حكومةٌ تجمع بين دفتيها بين فلسفة الحكم السياسي، والفلسفة الغُنوصيَّة الفكريَّة ولُغة الاقتصاد. وهذه هي المحاور الرئيسة لحكومة المجانين التي نَحنُ بصددِ قراءتها لمعرفة واقعتها الحدثية وفعل حكايتها السرديَّة. وقُطبَا هذه القصة الغرائبية شخصيتانِ فكريتانِ مرموقتانِ، لهما أثرهما الكبير في قيادة حكومةٍ ودولةِ التَّغيُّرات من تحت مِظلَّةِ الجسرِ الحديدي العتيق. فقد قرَّرالاثنان أنْ يُديرا هذه الحكومة عن بعدٍ من مرأى الناس.
الشخصية الأولى التي عَرَّفت عن نفسها الأنويَّة، هي شخصيَّة الرجل الصابئي المندائي التي يُطلَقُ عليه (عبدُ الشَّطِ)، الذي هو بالحقيقة أستاذ التاريخ والدراسات الذي اتَّخذ من الفلسفة الغُنوصَّية التي تعود إلى المعرفة سبباً مُهمَّاً في عزلته الحياتية. وهو الرجل المؤمن جدَّاً بما قاله النبيُّ بحقِّ عليٍّ، (عليٌّ معَ الحَقَّ، والحَقُّ مَعَ عَليٍّ)، والتي آمن بها من خلال قراءته لمجموعة كبيرة من الكتب التي بحوزته.والغريب أنَّ قرينه كان ينظر إليه بَأنَّه رجلٌ مجنونٌ، وهو ليس كذلك وإنَّما كان اِدِّعاءً:
"الجُنونُ هُوَ أنْ جَعلتُ نَفسِي مَجنونَاً لِأتوارَى عَنْ هَذَا العَالمِ، حَتَّى أُمارسَ طُقوسِي مَعَ النَّهرِ بِأريحيةٍ، دُونَ اِعتراضِ فُلانٍ وَعلَّانٍ. ألِهذَا السَّببِ يَدعوكَ السُّكَّانُ بِعبدِ الشَّطِ؟ - نَعم وَأنَا سَعيدٌ بِهذهِ التَّسميةِ. أتؤمِنُ بِعبوديةِ الرَّبِّ؟ - نَعَم. وَهَلْ تَعتبرُ النَّهرَ رَبَّك؟- هُوَ الطُّهرُ والنَّقاءُ الَّذِي يَجعلنِي مُتَّصلاً بِالرَبِّ. مَا قِيمةُ حَياتِكَ وَأنتَ فِي هَذهِ العُزلةِ؟". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 34، 35) .
أمَّا الشخصية الثانية لهذه الحكاية القصصيَّة، فهي شخصيَّة (مُجاهدُ) الخبير الاقتصادي والرجل الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط، والذي أفنى ثُلثِي عمره بالدراسة العلميَّة. وقد كان على صلةٍ كبيرةٍ بأحد المُقرَّبينَ له من الأحزاب الكبيرة المُتنفذه التي تقود البلاد، والِّتي أوصلته هذه العلاقة إلى سُدَّة الحكم رئيساً للوزراء يوماً ما. وبسبب مساومتهم الوقحة له في تحقيق مآربهم لما يرمون إليه ويأمرون به أو قوله بخلاف ذلك الشَّرط، فكان الهروب وترك الحُكم هو نتيجة ذلك.
إنَّ أول شآبيب صلة التقارب والـتأثُّر الفكري بين الرجلين (الصَّابئي والمُسلم) هو طريفة الحوار الفكري الجادِّ الذي دار بينهما حول الغُنوصيَّة الِّتي وجدها الصابئي في شخصيَّة عليٍّ بن أبي طالبٍ على حَدِّ قوله: (كُلُ الَّذي عَرفتهُ عن الغنوصية وجدتهُ فِي عليٍّ!)، وجوابهُ هذا كان سبباً في أنْ يُلقيَ عليه نظيره المُسلمٌ سؤالاً مباشراً وعميقاً، (هل تعتقد بأنَّ الإمام علياً كان صابِئيَّاً؟)، ويأتيه الجواب الشافي الكافي عن علاقته بهذا الرمز الذي خلَّد التاريخ صحائف عمله للإنسانية:
"بَلْ كَانَ كُّلُّ مَا فَكَّرَ بِهِ البَشرُ بِشَأنِ الرُّبوبيةِ وَاللَّاهوتِ، وَنقاءِ الرُّوحِ وَعُمقِ السَّريرةِ وَالارتقاءِ بِالنفسَ بِالزُهدِ وَالوَرَعِ، وَفَلسفةِ الذَّاتِ؛ أَلمْ يَقُلْ لَهَا: (غُرِّي غَيرِي)؟ وَلَهُم قَالَ: إنَّ حُكمَكُم هَذَا عِندِي كَعفطةِ عَنزِ". (مشَاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص ص35، 36) . هكذا كانت نظرة الصابئي لرجاحة عليٍّ.
فهذا الاعتقاد الكبير بمكانة عليٍّ في الإنسانيَّة وعدالته في الحكم جعلتا الرجلين أن يحكما البلاد والعباد دون ضجيجٍ من حولِهم، ومن مثابة مكانٍ آمنٍ تحت الجسر العتيق. وذلك من خلال إسهام الصابئي بفكره السياسي الثاقب والمُسلم بفكره الاقتصادي الواعد، والأهمًّ في كلِّ ذلك عدالة أمير المؤمنين عليٍّ الذي يرى الحكمَ (عفطةَ عَنزٍ) كما وصفه، وكان الاتَّفاق بينهما ميزاناً وميثاقَاً للعهد:
"اِنتَهىَ الخِطابُ وأُطفِئَتِ الشَّاشاتِ، عَادَ مُجاهدُ لِبيتِهِ، بَقِيَ عَبدُ الَّشطِ يُمارسُ عُزلَتَهُ مَعَ النَّهرِ، وَبَدَأ بَرنامجَ الحُكمِ عَلَى طَريقةِ المَجنُونَيْنِ وَعَدالةِ أبي تُرابٍ بِالعَملِ فَورَا". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص43) .
بهذه الطريقة التي لا تخطر على بال وفكر سياسيٍّ أخر تَمكَّنا الاثنانِ الحاذقانِ أنْ يُقدما أُنموذجاً جديداً خالياً مِنَ التَّهويل المُؤسساتي لأجهزة الدولة الجديدة التي تقود مصائر الشعب إلى الفشل الذريع الذي يَعقُبه فشل آخر دون حنكةٍ ودرايةٍ تُصلح زمام الأمور غيرَ عَدالةِ عليٍّ وفكرهِ النّيِّرِ.
5- قِصَّةُ (عِشقٌ فِي أَروِقَةِ الخَطَايَا)
العشقُ الذي يكتنف مضامين هذه القصَّة وأروقتها المكانية والزمانية متعدِّد الأوجه والأبعاد، ذلك هو عشق الصداقة والمحبَّة والإيمان والحكم العادل الذي لا يَضيعُ أملُ رجائه مهما استبدَّ الظُّلم وانتشرت فوضى الفساد. لا عجبَ هذه المرَّة أنْ تكون شخصيَّات هذه الحكاية مظاهر الأُلفة التعدديَّة التي جمعت ثلاثة أطراف تكامليةٍ مهمةٍ. الأوَّل بين السيِّد عبَّاس الجنوبي الشِّيعي المذهب والعربي القومية، والثاني قيس الشمالي السُّني والكُري الأصل، زَمِيلِي الدِّراسةِ الأوليَّةِ اللَّذينِ كانا يدرسان معاً بإحدى كليَّات جامعة البصرة، والطرف الثالث أصحاب البخت والحظ من شيوخ العشائر العربية في جنوب العراق مع إيمانهم بعدالة الرمز عليٍّ الذي ملأ عدله نفوس كُلِّ النَّاس.
اتَّفق الصديقانِ السيِّد عبَّاس وقيس بالذهاب إلى كليتهما بجامعة البصرة في سيارة قيس الخاصَّة لاستحصال صورةٍ من وثيقة التَّخرُّج الجامعية لقيس، وعند عودتهما بعد الانتهاء من الحصول عليها تعرَّضا إلى عملية تسليبٍ منظمٍ من قِبَلِ قُطَّاعِ الطرقِ في المنطقة الواقعة بين مدينتي البصرة والعمارة، وفَقَدَا على إثرها سيارة قيس التي اُنتزِعَتْ منه غَصبَاً، وكان ذلك إبَّانَ نظام الحكم السابق.
ومن حُسن المُصادفة قد تعرَّفَ عليهما سائقُ سيَّارة أجرةٍ يعمل في خطِّ الطريق نفسه الذي زودهما بمعلوماتٍ خاصَّةٍ عن الأشخاص الذين سرقوا السيَّارة وتواروا بها إلى جهة خفيةٍ مجهولةٍ. وقد طلب منهما السائق الاتِّصال بشيخ عشيرتهم العام والمسؤول عنهم عشائريَّاً، والذي عرف عنه بأنه رجل وقورٌ عادلٌ لا يبخسُ الناسَ أشياءَهم أو يُفَرِّطُ بحقوقهم المفقودة عند كلِّ ظالمٍ من أفراد عشيرته السُّرَّاق الذين أجبرتهم ظروف حياتهم الاجتماعية القاهرة وضائقة العيش والفاقة والعوز الاجتماعي في ممارسة هكذا أعمالٍ إجراميةٍ تنتهك حقوق الآخرين وتسلبهم ممتلكاتهم الشخصيَّة.
فهؤلاء الأفراد على لرُّغم من ممارستهم اليومية القميئة لهذه التصرُّفات، بَيدَ أنَّهم يؤمنون بعدالة وحبِّ عليٍّ ولا يقسمون به كَذِبَاً من أجل سرقة سيارةٍ؛ لكن خصاصة الحاجة كانت سبيلاً أقوى من الإحجام عن الفعل السيَّئ ومقاومته. وكانوا ينكرون القيام بمثل هكذا أعمال إجراميَّةٍ دنيئةٍ، وكانوا يتحجَّجون بأقاويل وأعذارٍ غير مشروعةٍ، لكنَّهم يمتنعون عن أداء القسم باسم عليٍ بن أبي طالبٍ. فلنقرأ كيفَ طلبَ شيخُهم العام من أحدهم أن يبدأ القسم ويَحلفُ بعليٍّ، فأطرقَ برأسَهُ وامتنع عن ذك.
"إنْ كُنتَ صَادقَاً مُدَّ يَدَكَ إلَى صُورةِ أميرِ المُؤمنينَ وَأقسمْ بِهَا ثَلاثٍ مرَّاتٍ. أطرقَ الرَّجلُ بِرأسِهِ إلَى الأرضِ وَرَفضَ التَّنفيذُ. (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 49) . إنَّ هذا الرفض كان مدعاةً لاعتذار شيخهم.
فما كان من ردَّة فعلِ شيخهم العام الذي كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه من ألمانيا الذي أقسم مرتينِ بالله وبحقِّ أمير المؤمنين عليٍّ قد أمهل اللُّصوص بعد إدانتهم مدة ثلاثةِ أيامٍ كأقصى حَدٍّ لاسترجاع السيَّارة المفقودة وإلَّا سوف يفصلهم بكتاب عشائريٍّ ويُبلغُ السُّلطات الحكوميَّةعن فعلتهم .ولولا وقع هذا الأمر الفاعل لشيخهم وصرامة حكمه عليهم، وتأثُّر هؤلاء قُطَّاع الطُّرق بعدالة عليٍ والإيمان بحبِّه، وعدمِ مخالفتهم لحكمه العادل لكان ما قاموا به من أفعالٍ دونِ جدوى تَجبرُهم عليه:
" يَقومُ السَّيِّد وَيَحتضنُ الشَّيخَ مُعجبَاً بِحنكتِهِ وَدَماثةِ خُلُقهِ وَثقافتِهِ، وَيَخرجُ مِرتَاحاً، وَبِنفسٍ الوَقتِ مُتألِّماً عًلًى مًصيرِ هَؤلاءِ مِمَّنْ تَعلَّقَتْ قُلُوبُهُم بِحبِّ آلِ البَيتِ، لكنَّ الزَمنَ لَمْ يَرحمْهُم مُنذُ أنْ جَارَ عَلَى أهلِّ البَيتِ أنفسِهم وإِلَى يَومِنا هذا". (مشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 52) .
6- قِصَّةُ (نحيبُ النهرِ)
أنسنةُ العُنصرِ الطبيعيِّ النهر بصفتي البكاء والنحيب، ما أجملَها من استعارةٍ بلاغيةٍ مؤثِّرة! وما أحسنه من توصيف فنِّي مُبهرٍ لذلك النهر الباكي كالإنسان النائح الذي فقد ماءه وصار أرضاً جفافاً ومنبتا لظهور الحشائش وأحراش اليابسة، إنه الرَّواء الرُّوحي الذي لم يَعُدْ بعد أبداً للحياة الواقعية.
قِصَّةُ (نَحيبُ النَّهرِ)، قِصَّةٌ واقعيةٌ وسردٌ زمكاني بامتياز، حكايةً قِصَّةٍ تتحدَّث عن أكثر من تنوُّع في قرية (الخُمُسُ) التي هي امتداد طولي لنهر البُتيرة المُتفرِّع من دجله الذي فقد ظله؛ بسبب إجراءات النظام البعثي السياسي الحاكم في محاربة المعارضين له والخارجين عن طاعته العمياء.
بطل ِّقصةُ (نَحيبُ النَّهِر) هو معلِّم مدرسة الاعتماد الابتدائية في منطقة (الخُمُسِ) لنائية عن مدينتي المَجر الكبير والعَدل، وهو المٌثقف الشيوعي والشَّاعر الشَّعبي الأثير المائز عبد الرِّضا الحاج غالي مهاوي (أبو حكيم) الذي عاش ردحاً طويلاً من الزمن في هذه القرية النائية من أهوار العمارة، والتي وصفها الأستاذ والشاعر العتيد عبد الرضا في قصيدة شعبيَّةٍ له أواخر أيام حياته في المدينة.
ومن المفارقات التي حصلت لشخصيَّة عبد الرضا أثناء حواره مع أحد أنصار البعث ومُريديه، كونه كان مُحبَّاً للزعيم عبد الكريم قاسم نصير الشيوعيين ومنصف الفلاحين الكادحين. وأهم من ذلك كلِّهِ عَلاقةُ عبد الرضا الرُّوحيَّة والإنسانيَّة بأبي الاشتراكية العادلة عليٍ بن أبي طالب. فهذه القصَّة تكاد تكون أرخنةً وتوثيقاً ذاتياً وإنسانيَّاً واجتماعيَّاً وسياسيَّاً حيَّاً لشخصيَّة الأُستاذ عبد الرضا المُعلِّم الثائر والشاعر والإنسان الاجتماعي ابن البيئة الريفية والأهواري الأصيل الذي ينتمي إليها شكلاً ومضموناً، بل هو وليدها روحاً وجسداً وحياة ومماتاً. فكيف يضمر ولاءه وإخلاصه لغيرها.
وعلى الرُّغم من كون عبد الرِّضا كان رجلاً شيوعياً ومثقَّفاً خالصاً فإنَّه كان مُحبَّاً لعليٍّ ولِوَلدهِ الحسُين شهيد واقعة الطف بكربلاء، لا لكونه عليَّاً الحاكم فحسب، وإنَّما لكونه إنسانياً عادلاً بامتيازٍ لا يبخس مِيزان عدله وصدق إنسانيته المأثورة فنقرأ ماذا قال في وصفه لعليٍّ وولده الحسين:
هَذَا عَلِيٌّ إِمامُ الكَونِ أَجمعِهِ وَذَا حُسينٌ عَلَى الأرجَاسِ يَنتَصِرُ
إذن عَلاقة عبد الرضا بأبي الحسنين عليٍ عَلاقة إنسانية كبيرة لا علاقةَ لها بعقيدةِ الإيمان والكفر، فهو يُنادي بأفكارِ ومعتقداتِ ماركس، ويُمُجِّد في الوقت نفسه بإنسانية عليٍّ، ويُرثِي ولدهُ الحُسين قتيل العبرات في مواسم شهر عاشوراء ومُحرَّم الحرام، ويسأله مناؤوه، كيف جمعت في أفكارك وعقائدك الشخصيَّة بين ماركس الشيوعي والحسين الشِّيعي الثائر ضد الظلم ونصرة الحقِّ فيجيب:
"الحُسينُ الثَّائرُ هُوَ ابنُ البَطلِ عَليٍ بِنِ أبي طَالبٍ، وَعَليٌّ عَليهُ السَّلامُ اشترَاكِي أكثرُ مِنْ مَاركسَ، ويَأخذُ بِيدِ الطَّبقةِ العَاملةِ أكثرَ مِنْ مَاركسَ، وَأنَا لَا أحبُّ عَليَّاً لِأنَّني مُتدينٌ، بَلْ أحبُّهُ لِأنَّني شِيوعيٌّ". (مَشاحيفٌ تَأبى الرَّحيلَ، ص 58) . هذا هو سبب حُبِّ الشيوعي لعليٍّ؛ كونه أهلاً لهذه المنزلة. فعبد الرّضا الإنسان يؤمن إيماناً كاملاً بأنَّ عليّاً هو الأُنموذج الفذ الكبير والراقي للإنسانية جميعاً:
"المَوضوعُ لَهُ عَلاقةٌ بِالعدلِ وَالظُّلمِ، وَعَليٌّ هُوَ رَمزُ العَدالةِ، الَموضوعُ لَهُ عَلاقةٌ بِالشَّجاعةِ والجُبْنِ، وَعَليٌ هُوَ رَمزُ الرُّجولةِ والشَجاعةِ والشَّهامةِ والإيثَارِ، المَوضوعُ لَهُ عَلاقةُ بِالكرامةِ والإذلالِ، وَعَليٌّ هُوَ المَثلُ الأعلَى لِقيمةِ الإنسانِ الحُرِّ الكَريمِ الأبِيِّ، المَوضوعُ لَا عَلاقةِ لُهُ بِالدينِ والتَّدينِ بِقدرِ مَا هُوَ مُتعلِّقٌ بِالطُّهرِ والنَقاءِ وَسُموِ النَّفسِ البَشريةِ وَالزُّهدِ وَالتَّضحيةِ وَنُكرانِ الذَّاتِ وَكُلِ ذَلكِ عُلِيٌّ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص58) . إذن عَلاقة عبد الرِّضا بعليٍّ كعلاقةِ حقٍّ بباطلٍ؟
وكم من مرَّةٍ اُتِّهمَ أُستاذ عبد الرضا من قبل خُصومه الموالين للبعث بأنَّه ملحدٌ وكافر بالرَّب ويُزايدهم على حبِّ عليِّ؛ فالعَلاقة بينه وبين عليٍّ بن أبي طالبٍ أكبر من أنْ تكون علاقةً وصفيةً عابرةً، بل هي أبيَّةٌ مُتجذِّرةٌ في النفس ولا يمكن اجتثاثها من روحه الأسيرة في حبٍّ عليٍّ رمز العدالة الكونية الَّذي يشهد له أغلب خصومه قبل مُناصريه كُلّ هذه المناقب والصفات التي رسمت شخصيته الخلوديَّة في التاريخ العربي الإسلامي. وقد تَجسَّدَت معاني هذا الحبِّ لعليٍّ أبي الحسن والحسين وانبجستْ عُيونهُ المُتدفقة في ثنايا هذه المقطوعة الشعريَّة الشعبيَّة التي تفيض به سبيلاً:
"اِنجرحْ رَاس الكُون/وَيْ رَاس أبو حْسين/حِزنُ اليَتامَى اليوم وَيَّا المَساكين". (مَشاحيفٌ تَأبى..، ص61) .
فكيف لا يكون عبد الرضا غالي مُحبَّاً لعليٍّ وولده الحسين، حتَّى وإنْ كَلَّفهُ هذا الحبُّ فُقدانَ مُعتقدهِ الآيدلوجي أمام عظمة هذا الرمز الإنساني الخالد الذي لا مُماراة أو نفاقٌ أمامَ فعلهِ البُطولي الغالب.
7- قصِّةُ (الكُنيةُ الَّتي تَوسَّمَتْ اِسمَاً)
لعل َّأقربَ تَوضيحٍ، وأوجزَ تعريفٍ لهذه العتبة العنوانية كلمة أو مُفردة (السَّيِّدُ)، والتي صارت لقباً تكريمياً بدلاً عن الذات الاسمية أو هُوِيّتَه الشَّخصيَّة، وليست كنيةً كما يفهمها الكاتب أو القارئ. فهي إمَّا صفةُ تخاطبٍ توقيريَّةٍ للآخر مضافةً إلى اسمه الحقيقي، أو قد تكون صفةً أو رُتبةً دينيةً أو سياسيةً عند اتباعِ أهل البيت من الشيِّعة. وباختصار شديدٍ أنَّ (السيِّدَ) عندهم مَنْ يتَّصلُ نسبه بالسُّلالة الهاشمية لآل النَّبي محمَّدِ، وتنحدر أصوله أو ينتسب بنسلٍ أو ذريَّة فاطمة الزهراء زوج عليٍّ بن أبي طالبٍ (عليهِ السَّلامُ)، الذي هو جدُّ كُلِّ سيِّدٍ اليوم كما هو مُتعارفٌ عليه بإرثِ الشَّعبيَّات.
إذن السيِّد هو لقب يُطلقُ على هذه الذرية اختصاراً عن الاسمية الخاصَّة بِكلِّ شخصٍ، وليست كنيةً لها. وعلى وفق هذا الإطلاق الوصفي بَطلُ حكاية هذه القصَّة والتي تنطبق مقارباتها تماماً في تماهيها وتماثلها النظري والإجرائي على اسم ورسم كاتبها المبدع الموسوي، ذلك هو سيِّد محمَّد الذي عُرِفَ بهذا التعريف الشخصي واُشتُهِرَ وتميَّزَ.وهوَ الطالب الجامعي الذي انفرد بهذه التسمية.
وتشاء مصادفات الدراسةِ الجامعية الأوليَّة للسيِّد أنْ يتعرَّف عليه طالبُ زمالة دراسية من تونس يُدْعَى (المُنصِف بُوزيد) الذي سأل السيِّد عن اسمه الحقيقي، فكشف له غطاء وحقيقة حسبه ونسبه. فما كان من زميله التونسي إلَّا أْنْ انبهر بهذه التسمية التي عُرِفَ بها السيِّد، وأن نسبه يرجع إلى آل بيت النبي محمَّدٍ وعليٍّ. وأوضح له سيِّد محمَّد أنَّ مُدخلاتِ الاسمية الرمزية، وحمولاتها الإيجابية ومخرجاتها السلبية، فإنًّ حَسُنَتْ سيرتُهُ الفعليَّة قِيْلَ هذا الأثر الخَيِّر لفُلانٍ بن فلانٍ، وإنْ ساءتْ سيرتُهُ الشخصيَّة فعلتها قِيلَ، فَعلَها السيِّد الذي يتَّصل بنسب آل محمَّدٍ عليه أفضل الصلاة والتسليم.
وعلى إثر ما دار بينهما من حوار طلبَ الرجل التُّونسي من سيِّد محمَّد بيان رأيه الخاص بما يحمل لقبُ السيِّد من تَضاداتٍ فعليةٍ في مسألة إشكاليَّة السلوكيات المنسوبة إليه فعلاً وقولاً، فيكشف له: "أقولُ مَا قَالَهُ سَيِّدُ البَشرِ (عَليهِ وَعَلَى آلهِ أفضلُ الصَّلاة وَالسَّلامِ) : أنَا وَعَليٌّ أبَوَا هَذهِ الأُمَّةِ؛ فَمنْ سَارَ علَى نَهجِهَا، فَهوَ سَيَّدٌ، وَمَنْ لَمْ يَسِرْ، فَهوَ لَيسَ بِسَيِّدٍ وَإنْ اِنتسبَ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 64) .
فإنَّ إجابة السيِّد قد أبهرت التونسي ونالت استحسانه النفسي والعقائدي بما تحمل من حِيادٍ وعدلٍ وموضوعية وإيثار وخصوصيَّةٍ تفرُّديةٍ انماز بها عليٌّ بن أبي طالبٍ على غيره. وَعُدَّ سلوكه بهذا النهج امتداداً قويماً لنهج النبي الأكرم وآل بيته الأطهار. ثم يدفع السؤال الطالب التونسي لمعرفة طموح وحُلُمِ سيِّد محمَّد العراقي الشَّيعي الذي يتوقُ لسماعه منه مباشرةً فيردُّ عليه قائلاً بما يضمر في نفسه من اعتقاد مذهبي توارثه بطل هذ القصّة سَيّدمحمَّد وكاتبها سَيِّد محمَّد سيِّد كَرم المُوسوي:
"وَحُلُمِي بِاختصارٍ هُوَ أنْ أدركَ دَولةَ العهدِ الإلهِي المُتمِّثِّلةَ بِحُكمِ عَليٍّ (عَليهِ السَّلامُ) بِواسطةِ حَفيدهِ آخرَ الأئمةِ المَهدِي المَنتظَر (عَجَّلَ اللهُ ظُهورَه وَسهَّلَ مَخرجَهُ) ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 65) .
ويطمح الطالب التونسي الذي ينتمي إلى مذهب إسلاميٍ مغاير غير مذهب السيٍّد محمَّد الشيعي إلى فهم ماذا يعني السيِّد محمَّد بكلامه الأخير هذا من خلال إجابته الصريحة المباشرة التي استقرَّ رأيه الخاص عليها دون غطاءٍ حاجب لمعناها؟ راجياً في الوقت ذاته التوضيح لما يرمي به من قولٍ فما كان من السيِّد قد أرجأ الحديثَ عن رأيهِ لوقتٍ مناسبٍ آخر ربَّما أراد أن يُشركَ مُتلقِّيه به.
8- قصَّة (صَلَاةُ نَهايةِ المَطافِ)
إنَّها الصَّلاة الحقَّة التي ستحصلُ لاحقاً بعد انتهاء زيارةٍ لمطافٍ مشوبٍ بالحذرِ والقلق والخوف والتردِّد لأمر هذه الزيارة. إنَّها الصَّلاة التي ستكشف وجه الحقيقة الناصع الذي دون رياءٍ أو نفاقٍ أو زيغٍ مفتعلٍ لا أساس له في الوجود المكاني المرتقب. وهي الصلاة الإيمانية التي سَتُوئِدُ التضليل وتنصر رايةَ الحقِّ البيضاء على ادِّعاءات الباطل الذي يروُّج له المُتعصِّبُون من أصحاب التطرُّف المذهبي والإثني من الذين لا يريدون لوحدة الإسلام أنْ تتكشف بها الحقيقة المُضَلَّلة وتموت النظرة التطرفية المتوارثة جهلاً، والتي تلقَّفَها الأبناءُ عن الآباء والأجداد ممن يأخذون بأقاويل المغرضينَ والمُتفيقهين، وأولئك الذين يقبعون تحت عباءة الدين والمذهب دون أن يكلِّفوا أنفسهم بتحرِّي الآخر.
تحكي مُدوَنة (صلاةُ نهايةِ المطافِ) قصَّة صديقين جمعهما الفنُّ الإبداعي الجمالي في بلدين عربيين مُسلمين، ضاربة جذورهما التاريخية في أعماق الحضارتين العراقية والمصرية، حضارة وادي الرافدين، سومر وأكد وبابل وشور، وحضارة وادي النيل الفرعونية العريقة بكل تفرُّعاتها الخالدة.
تبدأ هذه القصَّة نسج خيوطها السرديَّة المتشاكلة بدعوةٍ كريمةٍ من الدكتور العراقي عادل، الأُستاذ الجامعي والشاعر لصديقه العربي المصري الدكتور عبدة، النَّحاةُ الكبيرُ والأُستاذ بجامعة كَفر الشِّيخ بمصر لتلبية المجيء إلى العراق وبالذَّات لزيارة النجف الأشرف مدينة الإمام عليٍّ، التي هي مدينة العلم والعلماء والدين والتاريخ والمجد الإسلامي الكبير. وقد جاءت هذه الدعوة بناء على إثر دعوة قام بها دكتور عماد لصديقه المصري دكتور عبدة الذي ضيَّفه في بيته الخاصِّ مع عائلته وأهله. فكانت من باب ردِّ الجميل أولاً، وثانياً لكشف حقيقة النسق المذهبي الخفي المجهول الذي سيستشعره الدكتور عبده ويتلمَّسَهُ بنفسه وجهاً لوجهٍ دون وسيط آخر أو من خلال كتاب يُفسِّره.
تبدأ بواكير هذه القصَّة بحُوارٍ تَساؤليٍّ إخباري تواصلي بين الصديقين المبدعين عماد العراقي وعبدة المصري من أجُّل تنامي الودِّ والمحبَّة بينهما لتقريب المسافات المذهبيَّة والفكريَّة لكليهما:
"هَلْ زُرتَ العِراقَ؟ - أُمنيتِي أنْ أزورَهُ، وَمَا المَانعُ؟ - لَا مَانعَ حَقيقيَ غَيرُ أنَّي لَمْ أضعْ أُمنيتِي قَيدَ التَّنفيذ.- ضَعهَا فِي طَريقِ التَّطبيقِ الآنَ، وَأنَا سَأضمنُ لَكَ رِحْلَةً مُمتعةً، رُبَّما لَمْ تَشهدْ مِثلَهَا بِكُلِّ البُلدانِ الّتي زُرتَهَا مِنَ قَبلَ، سَأكونُ بِانتظارِكَم فِي المَطارِ أنتَ وَعَائلتكَ وَسَتكونونَ بِضيافتِي طِيلةَ فَترةِ الرِّحْلَةِ، أتنقَّلُ بِكُم بِسيَّارتِي الخَاصَّةِ، وَأسْكُنكُم بَيتِي كَمَا أنتُم الآن َتسكنوننِي بَيتَكُم، هَلْ أنتَ مُوافقٌ؟... سَأفكِرُ يا صَديقِي، لَكنْ اِعلمْ أنَّ اِحتمالَ المُوافقةِ كَبيرٌ جداً". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص69) .
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من قُبَيْلَ الانتظار والتأمُّل والترقُّب والتمحيص في اتِّخاذ القرار الحاسم تأتي الموافقة بالزيارة المُرتقبة من قبل عبدة المصري لصديقه عماد العراقي، فيهبط عبدة بمعية عائلته أرض النجف الأشرف وبضيافة أُسرة صديقه العراقي الذي سُرَّ بهذه الزيارة الميمونة لمدينة الإمام عليٍ بن أبي طالبٍ، والتي ستكون مفاجأةً مُدهشةً ما بعدها مفاجأة كبرى لها خاصيتها:
"فِي أروقةِ مَرقدِ أميرِ المُؤمنين َعَليٍ، هُمْ يَتنقَّلُونَ فِي أروقةِ الحَرمِ العَلويِّ الشّريفِ، حَيثُ يَعجُّ الَمكانُ بِالزائرينَ عَلَى مُختلفِ هَيئاتهِم وَأشكالهِم وكَأنَّهُم فِي عرَضٍ لِمختلفِ دُولِ العَالمِ، وَالصَّمتُ والخُشوعُ سيِّدَا المَوقفِ، بَينَمَا يَختار بَعضُهُم كُتُباً وَكَراريسَ مِنْ تِلكَ المُتاحةِ مَجانَا لِلزائرينَ، وَدُونَ مُقدِّمَاتٍ يَتناولُ الدُّكتورُ عَبدهُ كُرَّاسَاً مِنْها كُتُبَ عَلَى جِلادِه زِيارةُ أميرِ المُؤمنينَ (عَليهِ السَّلامُ)، وصَار يَقرأُ[خِلالِ ذَلكَ الطَّوافِ فِقراتِ الدُّعاءِ فِي الكِتَاب بِتؤدةٍ]" (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص70)
بعد أن أنهى الدكتور عبدة مراسم الزيارة مرتين في كتيب زيارة أمير المؤمنين انبهر ما في هذا الدعاء من كشفٍ وتوضيحٍ للحقائق الِّتي يتوجَّه بها الشيعي إلى ألله أولاً من خلال التوسُّل بأهل البيت لتحقيق أمنيةٍ خاصَّة على الخلاف من نظيره الآخر في الدين والذي يشككُّ بأثر هذه الدعوة الخالصة ويظنُّها إشراكاً بالله ولوحدانيته التي لا تتجزأ أبداً مهما كانت شُقة الخلاف المذهبي بينهما:
"ماَذَا يَا دُكتورُ؟ أبَداً يا صَديقِي إنَّما هِيَ نَفحاتٌ مِنَ التَّقاربِ الرُّوحيِ تَغبطنِي الآنَ وَهوَ يُحِّدثُ نَفسَهُ (تَباً لِمَنْ يَدُسَّ البَغضاءَ بَبيننَا وَنَحُن مُسلمونَ، نَعبدُ اللهَ ذَاتَ العِبادةِ، اللهُ وَحدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، تَباً لأَنَّني رَأيتُ بأِمِّ عَينِي، كَيفَ شُوِّهَتْ صُورةُ هَؤلاءِ، هُمْ بِالحقيقةِ يَتَخذونَ الأولياءَ مَثَلَاً أعلَى، وَوَسيلةً يُجمِّلُونَ بِهَا مناسِكَهُم، وَهوَ مِنَ المُستحَبَّات وَليسَ فِيهِ تَعدٍّ عَلَى الوَاجباتِ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَحيلَ، ص 71) .
لم يكتفِ الدكتور عبدة بقراءة كُرَّاس الدُّعاء والنظر فيه بتشككٍ، والذي من خلاله كشف به الضوء الأول لحقيقة ما يفعله الشيعة في طقوس زيارتهم لأضرحة الأئمة والأولياء الصالحين، بل راح يبحث في المَصاحف القرآنيَّة الشريفة المُتاحةِ في أروقة مكتبة صحن ضريح الإمام عليٍ، فلم يجدْ أيَّ مصاحفٍ أخرى طباعتُها عراقيةً أو غيرُ عربيَّةٍ مشكوكٍ بأمرها المريب. فهي جميعها لدور نشرٍ عربيةٍ معروفةٍ وموثوقٍ بها عربيَّاً ودَولِّيّاً. ولم يجد شيئاً اسمهُ (مُصحفُ فاطمةَ)، وهو بؤرة الشكِّ ومصدر الضلال الذي يبحث عنها والذي روَّج له بعض الطائفيين المتطرفين في الدين:
"هَا دُكتورُ هَلْ وَجَدتَ مُصحفَ فَاطمةَ؟- وَاللهِ حَاولتُ أنْ أقولَهَا لَكَ؛ لَكنْ خَجَلِي مِنكَ وَبِسببِ مَا تَأكَّدتُ مِنهُ الآنَ بِعدمِ صِحةِ ذَلكَ مَنعنِي مِنَ القَولِ، أتَعرفُ يَا صَديقِي.- نَعم، عُمرِي الآنَ تَجاوزَ السَّبعينَ، وَأنَا نَادمٌ علَى كُلِّ يَومٍ فَاتَ مِنهُ قَبلَ أنْ أكونَ هُنَا فِي حَضرةِ هَذَا المَكانِ الشَّريفِ، أنَا لا أُلقِي اللَّومَ عَليكَ وَلَا عَلينَا، إنَّما هِيَ الأنظمةُ الَّتي كَرَّستِ الطَّائفيةَ، وَمَنعتنَا مِنَ التَّواصِلِ وَرُؤيةِ الحَقائقِ كَمَا هِيَ، أعترفُ أنَّك صَديقي وحَبيبِي مُنذُ أنْ جَمعنَا فَضاءُ الفَنِّ والأدبِ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 72) . وتكون هذه الحقيقة الماثلة مدعاةً لعناق أخوي صادق بين الصديقين الفاتحين لها.
ويأتي النسق الخفي الثالث في كشف أضواء هذه الحقيقة التي حققتها صلاة نهاية المطاف، ذلك هو أداء الصلاة في وقت الزيارة التي كان مُتحرِّجاً منها الدكتور عبدة، وكيف أيؤدِّيها بطريقة مذهبة أم بطريقة الأخر له أمام زائري الإمام عليٍّ من مختلف بقاع الأرض؟! وحين أراد الدكتور عبدة القيام بها وأَذِنَ من صديقه العراقي عماد، فقد آثر الدكتورعماد أن يلزم الصمت لِيتعرَّف عبدة بنفسه كما هو يرى الزوُّارَ الآخرين َمن مختلف العالم شيعةً وسُنَّةً كُلَّاً حسب مذهبه وطريقته دون إحراج للآخر أو شعور بالرهبة والتفرقة، إنَّها الكيفية التي لا بُدَّ منها مهما اختلف الاثنان عليها:
"لَمْ يُجِبْهُ عِمادُ وَاكتَفَى بِالإشارةِ إلَى مَجموعةٍ مَنَ الزُّوارِ تَبدو مِنْ هَيْأَتِهُم بَأنَّهُم آسيويونَ، وَكَانَ يَئِمهُم شَخصٌ مِنهُم، هُمْ يُصلِّونَ عَلَى طَريقةِ مَذهبِ الدُّكتورِ عَبدةَ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 72) .
إنَّ امتناع عماد عن الإجابة لصديقه الدكتور عبدة حين سأله أنَّه يُريد القيام بالصلاة ِوفقاً لما يراه مذهبه، إنَّما أراد من ذلك النسق الظاهر لمعرفة الخفي منه الذي يضع حدَّاً لتلك الطائفية المقيتة بين مذاهب الإسلام الأخرى في احترام عقائد الناس وأصولها التي درجتِ العادة، وَجُبِلَتْ عليها بحياتها.
9- قِصَّةُ (عَهدُ الشَّواربِ)
(عَهدُ الشُّواربِ) تعتمد مِعماريَّةُ هذه القِصَّة في بنائها التركيبي الحكائي ومضمون محتواها الدلالي المعنوي؛ بكونها عتبةً عنوانيةً موازيةً للنصِّ الذي يشكِّل متنَ القصَّة وبنيتها الداخلية على جملةٍ من المورثات الشعبية المكانية لُغةً وبناءً وعاداتٍ وتقاليدَ اجتماعيةٍ وعشائريةٍ تَوارثتْ مع الإنسان منذ أقدم السنين وتغلغلتْ في نفوس الناس الذين يسكنون أقاصي أهوار الجنوب العراقي من عرب المستنقعات والأرياف، وخاصَّةً المعدانُ أبناءُ هذ الأرض السومريَّة، ومُعمِّرُوها الأصلاء.
ومن رَحِمِ هذهِ الأرض تأتي مفردةُ (الشَّواربُ) التي ارتبطتْ بِالقَسَمِ كمعادلٍ موضوعيٍّ ولُغويٍّ ودلاليٍّ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشخصيَّة وأخلاق أهل الهور من السُّومريينَ خَاصَّةً والعراقيين عامَّةً. وكيف تكون اسماً مقدَّساً وبصمَةً متفرِّدةً لها اعتباراتها الاجتماعيَّة والدينيةَّ والزمانيَّة المُتعارَف عليها عند هؤلاء الناس من الذين درجت العادة أن يكون الشارب رمزاً شخصيَّاً للرجولة ولمعاني الشرف والعهد والميثاق الشَّخصي الذي يُميِّز صاحبهُ عن غيره الرديء والرذيل من صنف البشر.
والفرد الذكوري من عرب الأهوار حين يُمسكُ بشاربهِ ويُقْسِمُ به مرَّةً أو ثلاثاً قسماً غليظاً يكون قد أوفى بتنفيذ هذا القسم مهما كانت نتائجه الإيجابية أو السلبية. فالشَّارب هو اليمين بعينهِ والقسمُ الذي لا يمكن أن يحنث به أبداً. ومن رَحِمِ هذا المنطلق النَّسقي الشعبوي المتوارث عُرْفَاً وتأصيلاً استمدَّت عتبة (عَهدُ الشَّواربِ) ثيمتها الفكريَّة الرئيسة وجسَّدتَ تنامي مُحتواها الحكائي فنِّيَّاً وَنصيًّاً.
ركَّزت هذه القصَّة على من مجموعةٍ من الشخصَّيات والفواعل الحركيَّة الذكوريَّة والأنثويَّة، وهم أربع شخصيَّاتٍ متوازنةِ العددِ والعُدَّةِ، وأُولى هذه الشخصيَّات الرمزيَّة الأنثوية (وَبْرِيَّةُ) الزوجةُ والأمُّ العجوزُ التي استمدَّتْ اشتقاق اسمها من عباءة الوَبَرِ، وهي المرأة الكبيرة الآمرة والناهية في بيتها:
"كَانَّ كَفُّ وَبرَّيةَ الأسمرُ، وَالمُكافحُ، المُخشوشِنُ، وَالمُطرَّزُ بِالوشمِ الأزرقِ دَائمَ الدُّعاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَمَا مِنْ مَرَّةٍ تَبسطُهُ لِلدُعاءِ إلَّا وَوَضعتْ عَليَّاً عَليهِ السَّلامُ وَاسطةً بَينَهَا وَبينَ رَبِّها. حَتَّى جَاموستُهَا الدَاكنةُ السَّوداءُ الَّتي تَحبُّها أَكثرَ مِنْ قَريناتِهَا، كَانتْ تَعقدُ عَلَى قَرنِهَا خِرْقَةً خَضراءَ كَتميمةٍ؛ لِأنَّها جَلبتهَا مَعهَا مِنْ مَرقدهِ عليهِ السَّلامُ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 77) .هذا هو إيمان وبريَّة الفُطري وحبُّها الأخلاقي والإنساني لعليٍّ حبَّاً استدعائياً لا مزايدة عليه في النفوس الحُرَّة الأبيَّة.
أما الشخصيَّة النسوية الإشكاليَّة الثانية فهي ضُرَّتُها أو شريكتها في الزواج تلك شخصية (نوعةُ) المرأة (الفُصليَّة) التي سِيقتْ معَ الديَّةِ سَداداً للزواج من زوج وبريَّة، وهو الرجل الذي يكبرها بأربعين عاماً نتيجة مقتل ولده صكَر الذي هو ابن ضُرتِها وبْريَّة، وبسلاح أخيها لازم الذي قتلهُ عمداً. والاسم نوعة أخذَ معناه من النوع أو الجودة وربَّما من التنوُّع أي النظر أو الرؤية البصرية،
في حينَ يُقابل المرأتين في الطرف الآخر الرجولي شخصيَّة (وْحَيِّد) الشاب ابن (الفُصليَّة) نوعة، وشخصيَّة خالهِ أخي نوعة الرجل القاتل (لازم)، وما سيحصل لهاتينِ الشخصيتين من تطور درامي خطير في حياتهما الشخصية القلقة في نهاية القصَّة التي تَتسارع فيها الأحداث من واقع اجتماعي شعبي إلى واقعة حدثٍ وطنيٍ ودينيٍ كبيرٍ ذلك هو نداء المرجعية العليا في تلبية نداءالجهادالكفائي.
القتل والثأر وأخذ الدِّيَّة والمرأة الفصليَّة في العرف العشائري العراقي المُباد، هي موضوعات القصة التي ارتبطت بعهد الشارب.وقد بدأت هذه القصَّة حركتها الفعلية الحدثية التي خاض الكاتب بشغفٍ الحديثَ عن هذه الموضوعات الاجتماعية التي تُؤرِّق همومَ النَّاس من أبناء الريف ذات التركيب القَبَلي والعشائري وقيِّد حريتهم، ولاسيَّما المجتمع الأهواري المنغلق على نفسه وتقاليده:
"نُوْعَةُ الِّتي عَانتْ مًا عًانتْ، مُنذُ أنْ أُخذتْ (فُصْلِيَّةً) لِرجلٍ يَكبرُها بَأربعينَ عَاماً، سِداداً لولدِهِ المَقتولِ بِسلاحِ أخيهَا لَازمٍ". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 78) .ومسرحُ الأحداث على ضفاف نهر الأكَرح.
وعلى الرغم من تكريس هذه الموضوعات العشائرية المتوارثة والمغروسة نَبتَاً في نفوسهم منذَ أمدٍ بعيدٍ، فإنَّ النسق الثقافي يأخذ طابعاً وطنياً آخر غير الاجتماعي العشائري التقليدي. وهنا تبرز أهمية فكرة (عَهدُ الشَّواربِ) التي يلزم بها أشخاصها أنفسهم قطْعَاً للعهد، فما هذا العهد الذي قطعه وحيِّد الابن على نفسه وأمسك به شواربه؟ الأمر غير الطبيعي المُهمّ الذي أقلق خاله لازم وسيطر على فكره، والِّذي يرغب بمعرفته من قبل ابن أخته وْحيَّد صاحب القسم بالشوارب فيأتيه الجواب:
"هَذَا العَهدُ لَا يُقلقُ يَا خَالُ. لَقْد قَطَعتُ عَهداً عَلَى أنْ أُلبِي فَتوى المَرجعِ الأعَلَى بِمقاتلِة داعشٍ. عَلَى الفُورِ، يَنهضُ لَازمُ، وَيُمسكُ بِشواربِهِ، وَهذهِ المَرَّةُ يَقولُ: لَبيكَ أيُّها المرجعُ، لَبيكَ يا مُولَاي، حَيَّ عَلَى الجِهادِ". (مَشاحيفٌ تَأبى الرَّحيلَ، ص 81) .
وقد أخذ الاثنان على نفسيهما عهداً بأن يجمعا بين عهد الشوارب وفتوى المرجعية الشريفة، واللَّذان التزما بهما، وهذا ما دفع خاله لازماً إلى التفاعل مع الحدث والاستعداد له وقد ارتجزاً قائلاً:
"هَا تثور بِصدرك داعش، ها تثور بصدرك داعش/ عِدْنا اِتفَاك تَجيس الخيط، تْثُور بِصدركَ دَاعش. مِا هي إلا أيامٌ ..حتَّى جَهزَ وَحيِّد نَفسَهُ للرَّحيلِ: (مَشاحيفُ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 82) .
وسارع وحيَّد لوداع أُمِّه، وأخواته والعجوز وبريَّة، الوداع الأخير الذي لا يعرف وراءه عودة أم لا. وقد شغل الأمر وبريَّة وقطَّعَ نياطها بالبكاء والنحيب والنعي وامتلأت بالدموع حزناً وخوفاً عليه:
"يُمهْ كَوطَر ضَعنهُم، أنَا جْويعدَه وَكَوطَر ضَعنهُم./ يُمهْ مُوشْ مِنهُم، جنِّي غِريبهْ ومُوشْ مِنهُم يَا وَحيِّد يَا يُمّهْ./ خَايبة لَاحكَتهُم شِمالِك يَا رُوحِي لَا حكتهُم؟/وِلجْ نِيام كلهُم، أهلج كضوا نِيام كِلهُم". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلِ، ص 82، 83) . بهذا النحيب رَاحَ صوت وبريَّة يَرنُّ بأُذن وْحيِّد كسمفونيةِ الوجود.
وجد لازم وابن أخته وحيِّد نفسيهما يقاتلان داعشَاً ببسالةٍ وشجاعةٍ مُنقطعةِ النظير، وموقفهما هذا شجعهما على الرغبة في هذا العمل للتخلُّص من كاهل العُرف وعُقدة الذنب العشائرية التي اقترفها خاله لازم في حياته حين أقدم على قتل صكَر الرجل الذي يسكن في قريتهما، فهي في نظره فرصة مؤاتية لتطهير النفس من الثأر العشائري البغيض الذي ألزمه بارتكاب جريمةِ القتل العمد.
لقد كان إيمان الرجل لازم والشاب وْحِّيد قد دفعهما إلى البسالة والإقدام في مواجهة خطر داعش الذي بسببه نالا فضيلة الشهادة؛ استجابةً لنداءِ الوَطنِ والمرجعيَّة العليا. وليس هذا هو الشعور الضافي وحدهُ على نفسيهما، فقد كان حُبُّ عليٍ حاضراً بين القلوب المستهامة به. فها هو وْحيِّد يطلب من خاله لازم ما أوصته به وبريَّة حينَ تُلقي رَبَّها بقلبٍ أبيضَ ناصعٍ سليمٍ قائلاً وصيتها:
"أُمِّي وبريَّة مْذممهْ عَليهْ، عُود مِنْ تْمُوت، أطوفُ بِيهَا عَلى ضَريحِ أميرِ المُؤمنينٍ عَليهِ السَّلامُ. –بْإيدي، وَعَلَى هَذَا الكَتفِ أشيلهَا، وَأطوفْ بِيهَا.- بَعَدْ، يَا خَالي أوصيْك بْنوعَة وبَناتها. - احطْهِنْ بِعيونِي.- لَا هَاي مَا تَكفَّي يَا خَال أريدكْ تْكِظ شَاربَكَ وَتُوعِدْنِي". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 87) .
وفي مثل هذ الموقف النبيل لحكاية| (عَهدُ الشَّواربِ) العشائرية والوطنية تختلط كلُّ الأعراف الاجتماعية التقليدية والشعبية المتوارثة- جهلاً لا حُكماً- لنداء الوطن وفتوى المرجعية لبيك يا وطن. وفوق كلِّ هذا الحدث الكبير يتغلَّب على مشاعر وبْريَّة ونُوعة ولازم ووْحيَّد، الأربعة جميعاً استحضار أثرِ الرمز البطولي الخالد عليٍ ومكانته المحفوظة بين قلوبهم وإيمانهم الفطري البعيد.
10- قِصَّة (حَمَّادُ والنَّهرُ)
هذه القصَّة العاشرة من قصص هذه المجموعة، والتي لا تمتُّ في سردها بأيِّ صلةٍ مباشرةٍ إليها وبالنسق الإجرائي الذي اتَّبعه الكاتب في تأثيث الوحدة العضوية لـحكاياتِ (مَشاحيفٌ تَأبى الرَّحيلَ) . وأعني بذلك لا جامع بينها وبين عتبات النصِّ الموازي لهذه المدوَّنة التي احتوت مضامينها الفكريَّة على تمثُّلات الرَّمز التاريخي والديني البطولي الغالب عليٍّ بنِ أبي طالبٍ وأثره في شخصياتها.
وكان الأجدر بالكاتب محمَّد سيِّد كرم الموسوي أن يستحضر مزايا هذا الرمز الديني الإنسانية ويستدعي صفاته وشجاعته الشخصية وعدالته الوجوديَّة التي حيَّرت خصومه قبل مؤيِّديه وأتباعه الخُلَّص في بنية هذا النصِّ الطفولي. أليس عليٌّ كالنهر الدافق عطاءً وكرمَاً ومحبًّة وصدقَاً ووفَاءً.
فكان من المفترض بكاتب قصَّة (حمَّاد والنهرُ) بعد فوزها بجائزة القصَّة القصيرة أنْ يجري عليها تعديلاً مُضافاً طفيفاً يُضيء به تمثُّلات الرمز، وأنْ يصفَ أنسنةَ النَّهر في ثرائه وخيرهِ الوفير كما يصف عليَّاً بأبي اليتامى والفقراء والمساكين من عامة أبناء الشعب الذين يَغدقُ عليهم الأرزاقَ والطعامَ والهباتِ الاجتماعية والإنسانية في أضيق الحالات الحرجة. فَعليٌّ كريمٌ كالنهرِ عفيفٌ كثيرُ الخيرِ والسِّعةِ على الآخرين، وشحيح على نفسهِ وعياله وأثيرٌ مِعطاءٌ لغيرهِ من ألطاف الله ونعمه.
على الرُّغم من كون قصًّة (حمَّادُ والنهرُ) أُعُدَّتْ أصلاً لأدب الطفولة أقترحُ على مؤلِّفها محمّد سيِّد كرم الموسوي أن يجري عليها تغييراً بسيطاً مُضافاً لواقعتها، ويُحدثُ فيها تضميناً واستحضاراً أدبيَّاً سيريَّاً لارتحالات الإمام علي وتعامله مع مصادر الطبيعة الكونية المُتحرِّكة والثابتة التي تُناسب عقل الطفولة وتغذِّي خيالَ روحِها الجامح بهذا النهج القويم الذي زخرتْ به مناقبه الفكرية والإنسانية العادلة وصارت مناراً للعلم والمعرفة عبر هذا التاريخ الطويل لِسفْرِهِ الشَّخصي الكبير. وإلَّا فإنَّ وجود هذه القصَّة بهذه المجموعة سيجعلها يتيمةً لا أُخت لها مع قصص المُدوَّنة التسع الأخرى على الرغم من كونها قصَّةً بيئيَّةً تشترك معها في رصد تجلِّيات الواقع الريفي بثوبٍ جديدٍ.
(حُمَّادُ والنَّهرُ)، هي النصُّ القصصي الفائز بجائزة القصّة القصيرة بدورتها الأولى لاتَّحاد أدباء وكتَّاب والبصرة عام 2024م، والتي كُتِبَتْ خصيصَاً لأدب الأطفال، وبطل هذه القصَّة حماد الطفل والنَّهرُ وكلبُه الصَّغير. فهؤلاء الثلاثة هم الفواعل الحركية لهذه القصَّة الغرائبية التي تجمع ما بين الواقعية السحرية وقنتازيا الواقع الغرائبي والأسطوري المخيالي بلغةٍ شفيفةٍ مُحبَّبةٍ ماتعة لا تستهوي الفتيان الصغار من الأطفال فحسب، وإنّما واقعتها الحَدَثيَّة المُؤنسنة تحوز على اهتمام قدرٍ كبير من المتلقِّين الكُبار لجمالياتها التعبيرية الفنيَّة وصياغتها البنيوية الهادفة في صنع الخيال.
تقوم بواكير هذا النصِّ السردي على بنية الحوار التساؤلي بين الابن وأبيه حينما يبدأ الطفل حمَّاد بسؤال مُحُّير لأبيه حول النهر الصغير في قريتهما عندما اصطحبه أبوه لغرض تسجيله بالمدرسة لأوِّل مرَّةٍ، وقد مَرَّا بهذا النهر الذي أثار تفكير حَمَّاد وشغل نفستيه التي فاقت فرحته بالمدرسة:
"أبِي - نَعَم يَا وَلَدَي/ لِماذَا يَمشِي النَهرُ سَريعَاً؟- لأنَّ فيهَ ماءً وفَيرَاً يَا حَمَّادُ/ إلَى أينَ يَذهبُ؟- إلَى المَكانِ البَعيدِ، البَعيدِ جدَّاً./ مَاذَا يَفعلُ هُناكَ فِي البَعيدِ؟ - هُوَ يُعطِي للنَّاسِ والحَيواناتِ والطُّيورِ، النَهرُ يَا وَلَدِي مِعطاءٌ يُعطِي كَثيراً./ وَمَاذَا يُعطِي؟ - يُعطيهُم الخُبزَ والنُّقودَ وأشياءَ أُخرى كَثيرةً/ هَلْ يُعطِي مِثلَ الرَّئيسِ؟- بَلْ أكثرُ./ هَلْ تُريدُ أنْ أقولِ لِكَ سِرَّاً؟- مَاذَا يَا أبِي؟- النَّهرٌ هُوَ الِّذي يُعطِي الرَّئيسَ، وَيَقولُ لَهُ وَزِّعَها عَلى النَّاسِ./ يَا إلَهِي، كَمْ هُوَ كَريمٌ إذَاً؟ لَكنْ يِا أبِي هَلْ لَهُ يَدٌ سَيُعطِي بِها؟- لَهُ أذرعُ كَثيرةٌ وَطويلةٌ يُعطي بِهَا، ألَمْ أَقُلْ لَكَ أنَّه مِعطاءٌ؟". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 90، 91) .
بهذا الأُسلوب التعبيري الفنِّي المخيالي والجمالي للكاتب، ولُغة التكثيف اللِّساني الواقعي التي يُخاطب فيها الاب ابنه، لكي يوصل له الإجابات القريبة من الحقيقة التي يستوعبها تفكيره وتخزنها ذاكرته على أنها أمرٌ حقيقيٌّ. حتَّى غدا النهر الصغير في نظر حَمَّادٍ إنساناً كريماً مِعطاءً له أفرع أخرى كثيرة توِّزع خيراته كأذرع الإنسان؛لذلك شَبَّهَ الأبُ لابنهِ النَّهرَ بالرئيس القادر على العطاء.
أنسنة النهر رمز العطاء الوفير بالإنسان الكريم فكرة شغلت حَمَّادَاً الصغيرَ واستولت على عقله، فراح يبحث عن هذا النَّهر البعيد الذي ظنَّه إنساناً حقيقياً حينما قرَّر رِحلةَ البحث عنه عندما ركب زورقه واصطحب كلبَهُ الصغيرَ مُبتعداً عن مكان القرية، حتى تسوقه أقدار سير البحث عنه إلى متاهةٍ بعيدةٍ جدَّاً من أجل لقائه ومعرفته، فيلتقي في هذه المصادفة السرديَّة التي صنعها تخليق الكاتب برجلٍ وَحيدٍ في المكان القصيِّ فيخبره بأنه هو النهر عينه الذي يبحث عنه لتحقيق مراده:
"مَاذا تَفعلُ يَا وَلَدِي فِي هَذَا المَكانِ البَعيدِ؟- جِئتُ لِالتقيَ بِالنهرِ وأتحدَّثُ إليهِ، هَل تَعرفُ أينَ أجدهُ؟- وَصَلتَ يَا وَلَدِي، أنَا هُوَ النَّهرُ، أهلَاً وَسَهلاً بِكَ، يَا مَرحباً، يَا مَرحبَاً. أنتَ؟- وِاللهِ هُوَ أنَا. - آهٍ لَوْ تَعلمُ كَمَ أنَا سَعيدٌ يَا جَنابَ النَّهرِ.- صَدقنِي أنَّ فَرحتِي الآنَ لَا تُوصفُ. يَقولونَ أنَّك كَثيرُ العَطاءِ. - تُعطي الخُبزَ والنُّقودَ، وَأينَ هِيَ أذرعُكَ الطَّويلةُ الكَثيرةٌ؟". (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ، ص92) .
فمثل هذا الحوار المُجْدِي بينَ الرجل المجهول الكريم وحماد يُفضي لقضيةٍ أُخرى أكثر اهتماماً بمصير الطفل وحياته القادمة، ذلك هو المستقبل الواعد الذي ينتظره والذي استطاع الرجل أن يجعله عطيةً للطفل حينما بَادرَ إلى افتعال حَدثٍ سحريٍ ينطلي عليه عندما وضع يده على رأسهِ، وراحَ يُتمتمُ بكلماتٍ وكلامٍ غريبٍ غيرِ مَفهومٍ كأنَّه من الغيبيات التي لا يعرفها فتخصَّ مَصيرهُ:
"مَاذَا قُلتَ أيُّهَا النَّهرُ، وَمَاذَا أعطيتَنِي؟ لَقدْ شَعرتَ بِشيءٍ عَجيبٍ يَستقرُّ فِي رَأسِي، شَيءٍ عظيمٍ وكبيرٍ، مَا هَذَا؟ أخبِرنِي أيُّهَا النَّهرُ.- إنَّهُ المُستقبلُ يَا وَلَدِي، لَقدْ أعطيتُكَ المُستقبلَ، وَأدخلتُهُ فشي رَأسِكَ، فَاحتفظْ بِهِ، وَإيَّاكَ أنْ تُفرِّطَ بِهِ [...]أريدُكَ أنْ تَتذكرنِي كُلَّما عَملتَ شَيئَاً مِنْ أجلِ مُستقبلِكَ، تَتذكَّرُ النَهرَ العَظيمَ الِّذي تَعيشُ أنتَ وَكُلُ أهْلكَ عَلى جَانبِهِ...". (مَشاحيفُ تَأبَى الرَّحيلَ، ص 93) .
النَّهرُ الذي يُشكِّلُ عنصراً مُهمَّاً من عناصر الطبيعة الكونية في الوجود، والمستقبل الذي يُمثِّلُ مَصدراً مُهمَّاً من مصادر حياة الإنسان الانطلوجيَّة في التفاعل مع الحياة والطبيعة، هُمَا مركزا اشتغالات الكاتب الموسوي في هذا النصِّ المِيتا سردي الإبداعي الغرائبي الذي يشحذُ مَخيلةَ لطفل بكلِّ ماهو جديدُ يَغُذُّهُ لعوالم السمو والارتقاء الروحي والجمالي المُوصِلِ إلى شُطْآن الأمنِ والسَّلامِ:
"فَلمَّا وَصلُوا قَفزَ الكَلبُ إلَى الشاطئِ، صَارَ النَهرُ يُوشوشُ فِي أُذنِ حَمَّادٍ وَهوَ يُكلِّمَ النَهرَ بِصوت خَافتٍ، كَي لَا يَسمعُهُ أحدٌ.وَأنتَ أيُّها النَهرُ أينَ سَتذهبُ؟- سَأعودُ يَا وَلَدِي، فَهُناكَ الكَثيرونَ يَنتظرونَ عَطائِي، لَا تَنسَ المسُتقبلَ يَاحَمَّادَ...يَنامُ نَوماًهَائناً وَالمُستقبلُ فِي رَأسِهِ". (مَشاحيفٌ تًأبَى الرَّحيلَ، ص 94) .
تُعدُّ قصَّةُ (حَمَّادُ والنَّهرُ) من النصوص القِصصيَة المُذهلة التي تستمدُّ نسغ روحها واشتغالاتها الفنيَّة والموضوعيَّة الجماليَّة من السرد الحداثي وما بعد الحداثي الذي يؤكِّد في بنائه المعرفي على تقنياتِ الجِّدة والتأصيل التواصلي مع ثقافة المجتمع وعصرنته الزمكانية التي تَهُمُّ بناء مستقبل الإنسان؛ لذلك أتمنَّى على القائمين في زوارة التربيَّة أنْ يلتفتوا لمثل هكذا نصوصٍ راقيةِ السَّبكِ والحّبكِ وأصيلة الجوهر والمظهر فيضعوها في مناهج الأدب السردي الذي يُنمِّي قدرات التلاميذ.
تنقلنا نصوص محمَّد سيِّد كرم العشرة في مدوُّنته السرديَّة (مَشاحيفٌ تَأبَى الرَّحيلَ)، إلى ذاكرة الطِّين الأوليَّة ورائحة الهور والطبيعة الريفيَّة الشائقة المظهر والصادقة الجوهر بكلِّ تفاصيلها الاجتماعية البيئية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتاريخية حينما تستدعي بنيتها السردية رموزاً روحيَّة وإنسانيَّة عُليا لا فلسفتها الغنوصيَّة الرُّوحيَّة والدينيَّة فحسبَ، وإنَّما لكلِّ ما لهُ عَلاقةٌ بمصير الإنسان وتطلُّعاته الحياتية في تأثيث مستقبل معيشي آمنٍ وعادلٍ له يُحقِّقُ حُرِّيته الفرديَّة ويُعطي له حقوق يوتوبيا الخير بعيداً عن أشكال ديستوبيا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان الآخر. في هذه الرحلة المشحوفيَّة العابقة بنسمات هواءالجَنوب ومِلْحِهَا السُّومري الَّتي (طَرَّنَا) فيها الكاتب بأهوار العمارة.
***
د. جبَّار ماجد البهادليّ - ناقدٌ وكاتبٌ عراقيّ