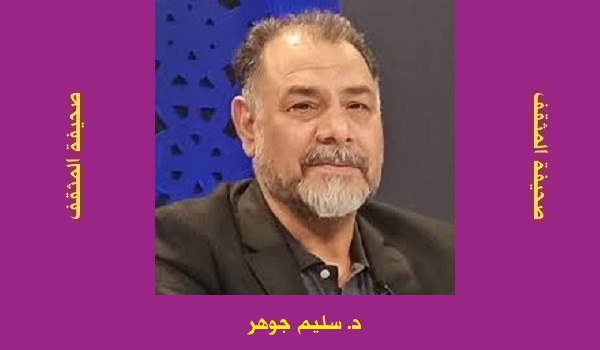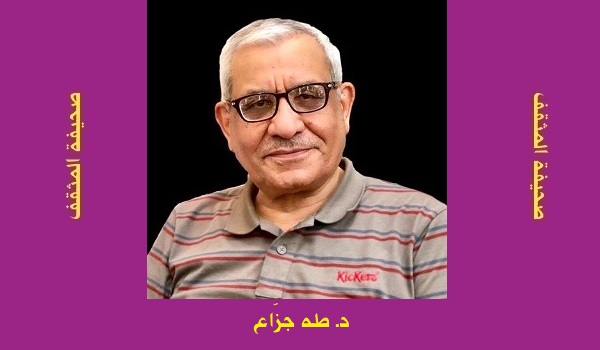قراءات نقدية
سوران محمد: بين عقيق العتيق وفريد الجديد

بما ان هنالك آراء مختلفة حول کل مبتكر حديث وامكانية تعارضه مع العتيق الاصيل، هنا في هذا المقال أود أن القي نظرة سريعة على بعض الاشكاليات التي تعيق التقاء هاتين المدرستين المختلفتين وأسباب اتساع هوة الاختلاف بينهما وكذلك بين المتحمسين لهما، من حيث اطرها العام ومن ثم بالتحديد حول التغييرات الحاصلة في هيکل الشعر العمودي الموزون وما بعده مع شعر التفعيلة.
الحداثة في اللغة هي مصدر للفعل حدث يحدث حدوثا وحداثة، وهذا الفعل يدل على التجديد والاستمرار، ومن أهم معانيه اللغوية الجديد أو الكلام والخبر.
إذاً الحداثة هي الشيء الجديد وهي الانتقال من حالة قديمة الى حالة جديدة، وقد تشمل وجود تغيير ما. كما ارتبط أفكار الحداثة مع العلوم والاختراعات، فظهرت العديد من الوسائل التي لم تكن مستكشفة مسبقا. وهي قيمة خالدة في صيرورة أنشطة إنسانيّة.
أما بالنسبة لتأريخ هذا التيار الحداثي في الغرب؛ فترجع ارهاصاته الى أواخر قرن التاسع عشر وقد شملت مجالات واسعة كالفلسفة والفنون الى جانب التغيرات في الاتجاهات الثقافية من تحولات واسعة النطاق وبعيدة المدى في عالم الغرب.
لو القينا نظرة خاطفة الى نقاط الاختلاف والتشابه بين الشعر التقليدي والحر، سنلاحظ بأن الشعر الحر بكل مدارسه مكتمل لمرحلة ما قبله وليس رفضا لها! بل بناء ما وصل اليه الشعراء الحداثة على هذا الصرح العظيم والذي يسمی بشعر الكلاسيكي أو التقليدي. فلماذا نفكر بعقلية السياسة الضيقة ونحسب ان كل ما لا ينتمي الينا فهو ضدنا؟
فلو نظرنا الى مكونات الشعر بشكل عام نلاحظ بأن (المضمون، البناء، المعجم، الصورة الشعرية) موجودة في کلتا المدرستين الشعريتين، الا ان الفرق والاختلاف الواضح هو في طريقة التشكيل الشعري، اذ ان الفارق الأكبر والملمح الجلي من حيث الشكل هو استعمال بحور العروض الستة عشر في الشعر التقليدي والتي هي منابع النغمات وقياس التشكيلة الشعرية وتعرف ببحور الشعر، وقد يتبلور هذا العنصر في شعر الحر من خلال الايقاع الداخلي للكلمات بدلا عن تفعيلات البحر الشعري. أما التكثيف والايجاز والتوهج والموسيقی والتخيل تعتبر من العناصر المشتركة في قصائد تلك المرحلتين المتفاوتتين، أي نص يتخلى عن هذه العناصر فلا يمكن أن نسميه شعرا. ومن المنطقي ان ما وصلنا اليه اليوم هو نتاج عطاءات السلف وقد بنی عليه الانسان المعاصر ما أبدعه القدماء، وبالاخص المتعلق بمجال الادب والذي يعتبر اللغة المشتركة بين المجاميع البشرية والمعلم المشترك بينهم أينما كانوا ستضاف الى ركب الحضارة.
من جهة أخری نستطيع أن نعمم فكرة هذا المقال على كل موجودات الحياة ونطرحه في شكل سوءال مثمر، بحيث نصل الى مبتغانا ونقول: هل كل جديد ضد القديم؟ وهل كل جديد سيء وكل قديم حسن أم العكس صحيح؟ وهل هما مكملان للبعض أم متضادان؟ بالطبع لاء؛ كما ان هنالك أمورا مرفوضة في الجاهلية وأمورا حسنة في ذات الوقت لم يطرأ عليها تبديل ولا تغيير بعدما انطوت صفحات زمنها، فعلى سبيل المثال ان الصدق من المسلمات الاخلاقية لا يمكن أن يتغير بمرور الزمان وتغيير الظروف ولو مرت عليه آلاف السنين، فهو من الخصال الحميدة التي يبنى عليها بقاء الأمم وصلاح الانسان اجتماعيا، إذاً ليس كل قديم سيء وكل جديد حسن والعكس صحيح؛ لكن لو نقلنا هذه النظرة الى عوالم الفن والادب والتي تعتبر من المتغيرات وليس الثوابت، فيمكننا ان نقيس أحوال وأطوار الزمان عليه، فاللغات الحية في حد ذاتها تتحرك الى الامام في دوامة التطور ومرتبطة بجميع مجالات الحياة الاخرى، وهكذا تختلف قرائح الناس ومذاقاتهم الشعرية وميولهم، بحيث ترى ان لكل نوع من الشعر جمهوره الخاص ومتابعيه والذي يتدخل الرصيد المعرفي والطبع الخلقي في هذا التوجه، فاذا كان كل سطر في الشعر الكلاسيکي حاملا في طياته معانيه المستقلة فان نص الشعر الحر بأجمله يعتبر وحدة متكاملة فلربما تضم معنى واحدا بعينه وتشارك في صنع هذا المعنى سائر الاسطر مكتملا له، في هذا الجنس الادبي لا يكون الشاعر مقيدا بالبحور لرسم الصور المجازية وابتكار جزالة الالفاظ، لكنه في الوقت نفسه لا يمكنە ان ينأى بنفسه عن الموسيقی والايقاع الداخلي. وهكذا يرى الشاعر المنتج الحداثي بأن الشعر الكلاسيكي يعتبر موروثا غنيا وكنزا ثمينا غني عن التعريف، فلربما يصبح مصدرا لألهام الشعراء الجدد، وليس رفضا له بل بناء على ما ورثنا من أسلافنا بلغة اليوم وبمكوناتها الشكلية والضمنية بحيث تتماشی مع التطورات الحياتية المتنوعة والكينونة المعنوية لانسان العصر، اذ ان الشعر بدوره كلغة راقية للأحاسيس الممتزجة بالخيال يعتبر استجابة طبيعية لمطالب الحياة الجديدة وسبر أغوارها، فعلى سبيل المثال في زماننا وكما يزعمون؛ أصبح العالم قرية صغيرة بواسطة التقدم التكنلوجي واقترب البلدان من البعض كاسرا حاجز الحدود الجغرافي، وبالتالي كل ما يرى ويسمع في العالم أصبحت مادة خامة لأنتاج نص شعري عند الحداثوي ومع ترجمة أي قصيدة تقليدية ستفقد جزءا من رونقها الشكلي ومن بينها تفعيلاتها في اللغة الثانية وتبقی منها المضمون والصور والمجاز والدلالات. كما ان هذه الحرية أمام الشاعر تفتح لە أبواب الابداع على مصراعيه كي يخيره بين انتقاء عناصر معينة في الشعر والتعمق فيها والتركيز عليها في نصه بشرط ان لا تتعدى لغته مواصفات
جمالية اللغة الشعرية وكثافته الدلالية، وفي الضفة الاخرى يتفق معظم النقاد مع بعض الآراء التي تنتقد الاشعار الرديئة التي تكتب بأسم الحداثة والشعر الحر، والتي تخلو من أي قيمة جمالية وابداع شعري ولا تمت بأي صلة الى الشعر وآفاقه الابداعية. فمن الحداثيون من وظفوا الرموز والاساطير في القصائد بحيث ساد الغموض بعض النصوص، وقد لجأ البعض الى عالم ماوراء الشعور في تخيلاتهم لرسم صور شعرية سريالية، منهم من نجح وبقی واقفا على ساقيه ومنهم من سقط ونسي.
ناهيك عن رغبة التغيير والتطور عند بني البشر منذ القدم الى وقتنا الحاضر، فكل حضارة حسب رأي أرسطو تمر بمراحل الولادة ثم الطفولة والشباب والاكتمال ثم الشيخوخة، ثم الضعف والموت، مثلما حدث مع الشعر العربي في عصر الانحطاط بعد العصر العباسي، وحتی في العصر العباسي کانت هنالك نزعة التجديد والحداثة ظهرت الى الوجود، كما يعتبر البعض: أبو نواس(231هـ/846م)، وأبو تمّام(196هـ/811م) في الحداثة الأدبيّة العربيّة في العصر العبّاسيّ من الاوائل.
في حين تكتب سوزان برنار في جزء الاول من کتابها (قصيدة النثر) عن بداية نشوء هذا الصراع بين الكلاسيكي الغربي وتيار الحداثة كالآتي: (هذه االرغبة الواعية في بث الشعر في النثر كانت في بدئها خميرة ثورية، وفهمها الحديثون بأعتبارها كذلك حقا خلال المشاجرة الشهيرة ورفعوا تليماك كأنها راية الثورة . ودفعوا بقيادة (هولار دي لاموت) المتحمس للهجوم على قلعة القافية المنيعة حتی هذه اللحظة، وقدم فنيلون بنفسه المعونة العسكرية، بطريقة فعالة، عندما قام في خطاب الى الاكاديمية ١٧١٤ بالفصل بين الشعر والنظم، وعندما تكفل بقضية القافية:
ان نظمنا للشعر ان لم أكن مخطئا، يفقد أكثر مما يكسب من القافية، انه يفقد الكثير من التنوع، والسلاسة والانسجام.
وعبثا حاول حزب الكلاسيکيين المعارضة، والتذرع بالتمييز المقدس بين الانواع ، والاعلان بقلم الاب ديفونتين:
انها لاساءة استخدام المصطلحات، وتخل عن الافكار الواضحة والجلية، ان تمنح اسم الشعر -جديا- الى النثر الشعري، على نحو ما حدث مع تليماك.
لم يكن قد حدث شيء من ذلك، فقد أعلن الكتاب بحماس غامر انهم تخلصوا من عبودية نظم الشعر، كما قال الحديثون واندفعوا في أثر فنيلون، ليكتبوا اشعارا ملحميا نثرية -ص ٤٦،٤٥)٤٤٨٨٨
في الختام أود أن أشير الى ان الغلو سيٶدي الى الهلاك في الامور كلها وما كان الرِّفْقُ في شيءٍ إلَّا زانَه، فكم يؤلمني عندما أرى شغوفا بالشعر يستهتر بشعراء ويستهين بنتاجاتهم سواء أكان الشاعر من جيل العروض أو الحديث، فهذه علامة مرضية بحاجة الى تصحيح وعلاج، فكل كلمة لها مدلولاتها سواء أكانت في شعر القديم أو الجديد، وهناك زوايا نقدية متعددة للنظر والتقييم، فالمحب للابداع والكلمة الخلابة لا ينحاز الى فئة ليرفعهم الى السماء وينزل بالآخرين الذين لا يرغب بقراءة أعمالهم الى باطن الأرض وأسفل السافلين، صحيح ان القريحة الشعرية لكل منا مختلفة ومتفاوتة، لكن المثقف الحقيقي لا ينتهج نهج المستبدين بتصفير الاخرين.
مع انني لا تربطني أي علاقة بالشاعر لكننا لو تأملنا على سبيل المثال في نص (الشمس تُحِبّ دروب مايا) لأدونيس وهي قصيدة في المجموعة الشعرية (زوكالو) نستكشف من خلال كثافة لغة النص ورموزه أمورا عدة، لكن مع القراءة السطحية لربما يضحك المتابع من أسماء (مايا) أو (زوكالو) ولايفهمه ولا يريد أن يسأل نفسه ولا يتعب نفسه في عناء البحث لفك شفرات النص، ومع أول قراءة يرفضه رفضا تاما، بينما نجد في هذا السطر لوحده احالات عدة من بينها حضارة مايا والتي سكنت في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا وولايات جنوبية في المكسيك، حيث كانت لديهم حضارة يقدر تاريخها بحوالي 3000 سنة. خلال ذلك الوقت الطويل كانوا يتحدثون في تلك الأراضي مئات اللهجات، التي تولد منها هذا اليوم حوالي 44 لغة ماياوية مختلفة. وقد عرفت بالحضارة الوحيدة في تطور اللغة الكتابية في الأمريكتين زمن ما قبل كولومبوس، فضلا عن الفن، الهندسة المعمارية، وأنظمة الرياضيات والفلك. فانه من العيب للمثقف والناقد الشعري ان يتجاهل هذه الحقائق والاشارات الشعرية والحضارات البشرية العريقة ويدعي كونه ناقدا ومنظرا للشعر التقليدي، في حين لا يتعارض الجيد القديم مع الجيد الحديث.
كما ان هناك اشارة في نفس السطر الى نص (حجر الشمس) للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث، فأنی لمتابع وناقد شعري يكون جهولا بهذه البديهيات المعرفية لضرورة فهم رموز النص وسياقاتها الدلالية؟ حيث يقول باث في مقطع له:
الزمن يعود كمدٍّ
وينحسر بدون أن يلتفت،
ما مضى لم يكنْ لكنّه يأتي
وبكلّ هدوء يصبّ
في لحظةٍ أخرى تتلاشى:
أمام مساء البارود والحجرِ
المسلّح بسكاكين خفيّة،
بكتابةٍ حمراء لا تُحلّ رموزها،
تكتبين على جِلدي، وهذه الجروح
تُغطّيني كرداءٍ من شُعَلٍ،
وأشتعل ولا أتلف، أبحث عن الماء،
ولا ماء في عينيكِ، عيناكِ من حجَرٍ
وقد كتب الاستاذ هادي الحسيني بعنوان (زوكالو أودنيس ، نافذة تطل على الشعر) عنه:
أودنيس الذي عودنا دائماً على الجديد والمختلف منذ قصائده الاولى، وأغاني مهيار الدمشقي وحتى اليوم كان دائما يأتينا بالشعر من اعماق البحر ونبقى في دهشة ونحن نرى اللؤلؤ والمحار المستخرج من نصوص مختلفة وعميقة في الرؤيا والخيال. وتأتي تسمية (زوكالو) والتي اتخذها عنوانا لكتابه الأنيق وهي الساحة الرئيسية في مدينة مكسيكو ستي حيث يفتح الشاعر نافذة فندق (لاكاسونا) الذي سكنه ليرى الشمس وهي تضع أولى خطواتها فوق عتبة مكسيكو. ويصور اودنيس بأول قصيدة في هذا الكتاب الذي يقترب كثيرا من قصيدة النثر في غالبية نصوصه واخرى يقترب فيها الى النص المفتوح، وقد استغنى الشاعر في كتابه عن اوزان الخليل الفراهيدي كما معروف عنه في كتابته للشعر منذ اكثر من ستة عقود من الزمن وتزيد ليطل ّعلينا بزوكالو ونصوصها العذبة التي تنسال منها رائحة الشمس الصافية في (مايا) حيث يقول في مقطع له:
هل أُصادق ذئاب الطبيعة؟
أقتل تلك الّتي تربضُ تحت أظافري؟
أُركِّز بصري على بصيرتي، وهذه على ذاكَ، وأرافقُ إلى بلاده القصوى عِطْر وَرْدةٍ تموت.
بدأ ثوبُ السّماء يتبلّل بالجراح. إذاً، أخذت هذه البائسة تتعلّم كيف تُنشِد معنا:
الطائر عابرٌ،
والقفص بلا نهاية.
الشمس تُحِبّ دروب مايا
***
سوران محمد - شاعر ومترجم وناقد
..................
المصادر
١- قصيدة النثر/ 1، سوزان برنار، ترجمة: راوية صادق، دار شرقيات للنشر والتوزيع.
٢- -Understanding Poetry. 4th edition. by: Brooks, Cleanth, Robert Warren, Wadsworth Publishing.
٣- زوكالو، أودنيس، دار الساقي، ٢٠١٤
٤- (حجر الشمس) للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث. ثلاثون قصيدة في الشعر الامريكي اللاتيني المعاصر، ترجمة: محمد الخطابي.
٥- أدونيس وتجلي الخلل العقلي اللغوي، الاستاذ محمد رشيد، ٢٠٢٤.
٦- هادي الحسيني، الحوار المتمدن، ١٣/٤/٢٠١٧.