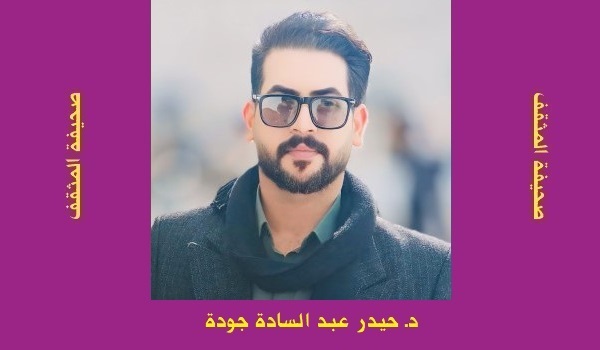أقلام فكرية
عبد الحليم لوكيلي: استيعاب الدين فلسفيا

يحتل موضوع الدين في تاريخ الفلسفة مكانة هامة، من حيث إنه موضوع من الموضوعات الذي اهتمت به منذ ظهورها نظريا في اليونان. غير أنها مكانة لا تستمد -في نظرنا- من طبيعة حضور الدين في السياقات الاجتماعية والثقافية فقط، وإنما من طبيعة النسق الفلسفي نفسه. بحيث إذا كانت الفلسفة منذ تقعيدها نظريا في اليونان، كانت غايتها الكشف عن معقولية الأشياء التي يجدها الإنسان-الفيلسوف في فضاء حياته ومعيشه اليومي، فإن ظهور الدين سواء في بعده الطبيعي النابع من مقومات الذات الإنسانية، أو في بعده الفائق للطبيعة النابع من كائن متعال هو الإله، شكل «ظاهرة فكرية جديدة، كان لزاما على النظرية الفلسفية القائمة استيعابها، وإدماجها ضمن معقوليتها.»[2]. لكن، لم الحاجة إلى لزوم تناول موضوع الدين فلسفيا؟
في نظرنا، تعود الحاجة إلى تناول موضوع الدين فلسفيا إلى شروط نظرية مرتبطة بطبيعة موضوع الفلسفة نفسه. فالفلسفة، بما هي نمط من التفكير الإنساني القائم على العقل/المنطق، لم تظهر في بدايتها الأولى تحت اسم فلسفة (Philosophia/La Philosophie)، بقدر ما أنها ظهرت في شكل حكمة (La sagesse/Sophia). لذلك، ابتدأت الحكمة بفكرة غريبة-كإجابة عن سؤال أساسي هو؛ ما أصل الأشياء في الطبيعة؟-متمثلة في أن «الماء هو أصل كل الأشياء»[3]، وغرابتها تتجلى في أنها تجيب عن سؤال مركزي في تلك المرحلة اليونانية التي كان السائد فيها بوجه عام، هو التفكير القائم على الأساطير التي ترجع سبب الأشياء إلى تعدد الآلهة[4]. كما أنها فكرة لا تقوم على أية صور أو سرد أسطوري خيالي، لاسيما، وأنها ترجع الكل إلى واحد هو الماء، الذي في إمكان كل إنسان أن يكشف عن ذلك بنفسه؛ فيما إذا كان أصل ما يوجد في الطبيعة هو الماء، أم لا. يترتب عن ذلك، أن الحكمة ابتدأت بسؤال الطبيعة؛ أي أن الموضوع الأساس الذي ابتدأ به الحكماء الطبيعيون هو البحث عن أصل الأشياء في الطبيعة. لذا، كان هناك اختلاف بينهما في تحديد طبيعة هذا الأصل، إذ هناك من يرجعه إلى الماء (طاليس)، وهناك من يرجعه إلى العدد (فيثاغورس)، وهناك من يرجعه إلى الهواء (انكسمانس) ...إلخ.
غير أن التفكير القائم على العقل-المنطق، سيعرف تحولا من مستوى القول بكونه حكمة، إلى مستوى القول بكونه فلسفة. وهو تحول كان لأول مرة كما يشاع مع الفيلسوف والرياضي «فيثاغورس» الذي أشار بالقول «لست حكيما، فإن الحكمة لا تضاف لغير الآلهة، وما أنا إلا فيلسوف.»: أي محب للحكمة[5]. فالذي يبحث في أسباب الأشياء، لا يمكن أن يكون «حكيما» (Sophos): أي ذاك الذي في مقدرته معرفة حقيقة الأشياء كما هي، بقدر ما أنه «محب للحكمة» (Philosophos/Philosophe): أي أنه الشخص الذي يستعمل عقله بكيفية منطقية بغية ملامسة حقيقة الأشياء فقط. خصوصا، وأن الحكمة هي من اختصاص الآلهة التي أوجدت الطبيعة، لا من اختصاص البشر. وبهذا المعنى، ستظهر كلمة الفلسفة التي ستتخذ لنفسها مسارا آخرا، من حيث طبيعة الموضوع الذي يمكن تناوله في مجالها. فمع «سقراط» في محاورة فيدروس ستعرف الفلسفة تحولا عميقا يتجلى في الانتقال من مستوى اعتبار الطبيعة كموضوع للحكمة-الفلسفة، إلى مستوى اعتبار الإنسان هو الموضوع الأساس الذي تدور في فلكه الفلسفة[6]. بمعنى آخر، ستعرف الفلسفة تغييرا في طبيعة الموضوع الذي ينبغي أن يكون مجالا للدراسة الفلسفية من الطبيعة إلى الإنسان، غير أن هذا التحول لا يعني التخلي عن موضوع الطبيعة، بقدر ما يعني أن الاشتغال على موضوع الإنسان هو اشتغال يتضمن كل ما يرتبط به من موضوعات؛ سواء تعلق الأمر بالطبيعة، أو الكواكب، أو غيرهما.
وإذا أصبح الإنسان موضوعا للدراسات الفلسفية، فإن الإمساك بمقوماته وقدراته، لا يمكن أن يتم إلا من خلال الوقوف عند ما يميزه عن سائر الكائنات الأخرى، خصوصا، وأنه لا وجود لمعرفة كلية به. وإذا كانت المعرفة الكلية بالإنسان منعدمة، فإنه لا يبقى أمام الفيلسوف من زوايا النظر فيه، إلا الكشف عن السمات والخصائص التي ينفرد بها لذاته. لذلك، إن أهم سمة يتميز بها الكائن البشري -نظريا- عن سائر الكائنات الأخرى، هي سمة العقل (أو التعقل). فالإنسان-مثلما هو متعارف عليه- هو الكائن الوحيد الذي يملك عقلا، يجعله في حال تفكير ومساءلة لذاته وللعالم الذي يعيش فيه، بغية بناء تصور عن أسباب الأشياء، ومن ثم، بناء المعنى لذاته وللعالم. وإذا كان الإنسان متفردا بكونه كائنا عاقلا، فإن تفرده ذاك يجعله حاملا لصفات وسمات أخرى، لا يمكن أن نجدها عند كائن غير الإنسان. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحمل جملة من السمات والخصائص التي لا يمكن أن يتفرد بها كائن غيره، باعتباره حاملا لسمة العقل، مثل: كونه كائنا معرفيا، أو سياسيا، أو أخلاقيا، أو متدينا ...إلخ.
وبناء عليه، وبما أن الموضوع الأساس للفلسفة هو الإنسان، فإن ذلك يفيد أن مجال الاشتغال حوله يتوقف على تحديد طبيعة الخصائص والسمات التي ينفرد بها عن سائر الكائنات الأخرى. ولربما هنا تنبع مسألة اعتبارنا بكون الاهتمام بالدين في تاريخ الفلسفة عامة، هو اهتمام نابع من طبيعة الفلسفة نفسها. فما دامت الفلسفة مهتمة بالإنسان كموضوع لها، فإن الدين هو خاصية إنسانية، وإذا كان كذلك، فإنه موضوع للدراسة الفلسفية. خصوصا، وأنه لا وجود لكائن غير الإنسان يمكن اعتباره كائنا متدينا. فالفلسفة إذن، بما هي سيرورة عقلنة وكشف لأسباب الأشياء، فقد كان منبع اهتمامها بالدين مرتبطا بكونه موضوعا لصيقا بالكائن البشري. لذا، يتطلب الأمر الخوض فيه بغية استيعاب تعاليمه[7]، بما يتماشى والأسس المعرفية والفكرية لكل عصر.
وبهذا المعنى، لم يكن النظر إلى الدين في تاريخ الفكر الفلسفي الكوني، نشازا أو ترفا فكريا، بقدر ما أنه توجه يسعى إلى استيعابه، وعقلنته في حدود مدركاته ككائن بشري متناهي، ما دامت هي سمة لصيقة به (أي سمة الدين)، من حيث إنه كائن عاقل.
***
د. لوكيلي عبد الحليم - المغرب
أستاذ مادة الفلسفة
...............................
[2] عبد المجيد باعكريم. "العنف في تاريخ الفكر النظري؛ إشكالية العقل والإيمان نموذجا". مجلة وليلي. المدرسة العليا للأساتذة-مكناس، (2009)، عدد 14، ص. ص. 87-124.
[3] فريديريك نيتشه. الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي. تعريب سهيل القش. ط.2. (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1983)، ص. 46.
[4] مثال أسطورة «ثيوغونيا» (La Théogonie) التي كانت نموذجا للتفسير المتخيل-الأسطوري لنشأة الأشياء في الطبيعة، انطلاقا من فكرة تعدد الآلهة.
[5] نقلا عن: يوسف كرم. تاريخ الفلسفة اليونانية. مراجعة وتنقيح الدكتورة هلا رشيد أمون. ط.1. (دبي: دار القلم للنشر والطباعة والتوزيع، 1936)، ص. 33.
[6] يقول سقراط «إنني لا أفكر فيها (الآلهة)، بل أفكر في نفسي.».
[7] أنظر: فانسان كارو. ابتكار الأنا. ترجمة عبد المجيد باعكريم. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2021)، ص.14.