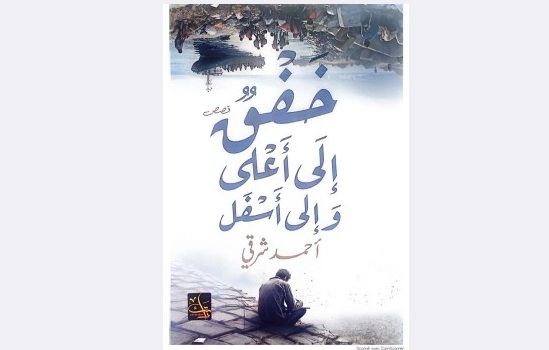قراءات نقدية
رحمن غركان: قصائد الموضوع والبحث عن الحضور في المجموعة الشعرية

(أيها المحتمي بالأرق) لشلال عنوز
مما يميّز الموضوع في القصيدة الكبيرة، أنها تقترحه انطلاقاً منها، وتتخيّله مثولاً بين يدي أساليبها، ولهذا يتعذّر الفصل بين الشكل، بوصفه كيفية إبداع المعنى الشعري وبين المضمون كونه باعثاً على القول، أو مؤثراً في إبداعه، أو ما يقوله من معنى له حضور ما قبل الشكل، فهو ملحوظ، من لدن المتلقين قبل القصيدة. وقد قام الشعر العربي القديم والشعر التقليدي الذي جرى على نهجه إلى اليوم، على الموضوع قبل الشكل، وعلى الغرض قبل الفن، وعلى الفكرة الموضوعية قبل كيفية قولها، حتى لكأنّ الشاعر يترجم الموضوع إلى كلام شعري مستجيباً لمتطلبات الشكل، أو ينقل معاني الغرض المقصود قبل الكتابة إلى صياغات اجتهد ناظمها في تطبيق مكونات الإنتاج الشعري لأجل قولها في صورةٍ من قالب القصيدة. ومن ثمة فقد عمل العلماء في علوم كثيرة وحقول معرفية أكثر على ترجمة متبنياتهم وأفكارهم ورؤاهم وطروحاتهم إلى ممكنات الخلق الشعري في صورتها العقلية الصناعية الظاهرة، وظهرت على إثر ذلك منظومات في النحو والصرف والعروض والفقه والجغرافيا وعلوم كثيرة مما عرف تحت مصطلح (الشعر التعليمي).
ويظن أكثر المتلقين وكثير من الشعراء، أن مجرد الانتقال من اللغة المباشرة في الفكرة الجاهزة التي كانت في الشعر التعليمي أو المؤدلج إلى اللغة المجازية أو ذات الثراء التخيلي، ينتقل الكلام - إثر ذلك كله - إلى الشعر العالي، وهو تصوّر صحيح جزئياً؛ من جهة أن القول يصبح شعراً، ولكنه شعر تقليدي، لأن الارتفاع بعد ذلك يستدعي اكتناز رؤية ما، وإقامة النص على فلسفة خلقٍ أسلوبي من جهة المنشئ، وخلقٍ رؤيوي من جهة التخيّل، ونهج في إبداع معجم جامع لكلام القصيدة يوظف كلّ ما يدخل في التدوين الخطي عند الكتابة، أو في الأداء الإلقائي عند الإنشاد، لأن معجم القصيدة، هو الأشياء كلها، فالشعراء الاستثنائيون يجعلون موجودات العالم وأشياءه ومعانيها جزء معجمهم الجامع الذي يصدرون عنه، والذين هم فيه يضيفون إلى المألوف جديداً، وإلى درجة الصفر في الكتابة أرقاماً، وإلى الممكن من الأشياء محالاً متخيلاً واسعاً، ذلك أن المعجم يصل الشعر بالحياة، لا من جهة التوظيف، إنما القدرة على الخلق، ولما اعتاد الناس على الكلام اليومي المألوف فقد عدّوا الكلام الشعري العالي غامضاً، لأنه خلق شعري جديد، فهم يتذوقونه انطلاقاً من التناول اليومي القريب من درجة الصفر، وكأنهم يبحثون عمَّن يتوافقون معه، في مألوف ألفاظه، وشائع معانيه، وراسخ تقاليده، وهو بحث لا يستجيب له الشعر العالي، ولا الشاعر الاستثنائي.
وفي قصيدة الشطرين، لا يتحقق لشاعرٍ الإدهاش بمعزل عن فائض مجاز، وثري انزياح، ورؤية فردية، ونهج ذي حضور يكون الشاعر فيه (أمةً وحده) بين يدي تجربته التي يقدمها لعالم التلقي، وأحسب أن هذا السقف من (الأماني النقدية) مرتفع على جدران الشعر الشائع المألوف في المشهد الراهن، لذا فهو سقف محلق في الهواء على مبعدة أمانٍ من التجارب الشعرية التي تملأ الأوراق والمنابر والمهرجانات. حتى إذا بحث المتلقي النوعي الناقد عن الشعر الاستثنائي المدهش الذي يغذي اللغة بالماء، والوعي بالأسماء لم يجده إلّا نادراً، ولا سيما بعد (إعصار) قصيدة النثر التي غلب على الشعر الحر (التفعيلة) والشعر العمودي (الشطرين) غلبة المنظومات التعليمية على القصيدة في (ألفيات الشعر) التعليمي، لأن السقف التصق بالأرض فصارت مساحات العشب الأصفر الذابل، شبه اليابس، تلتحق ظنّاً بالمروج الخضراء، ولم تعد تقاليد الإبداع الخالص منظوراً إليها، بل صار مجرد القول المتخيّل القريب من الذاكرة اليومية محسوباً على (قصيدة النثر) المحسوبة على (قصيدة الشعر)، وصار قول الشعر بالرغبة لا بالإبداع، وبمجرد الرصف لا بالابتكار الذي يضئ الخيال، صار الشعر كتابة من يحسن الخطَّ، وموهبة من يتخيّل المرأة الجميلة ورداً، والرجل أسداً، والسراب ماءً. ويعرّفه بأنه (الموزون المقفى الدال على معنى أو الكلام المحتفل بالأخيلة أساليب تعبير، ومذاهب تخيّل أولية).
الشعر إحساس خالق باللغة، إحساس باللغة يتفوّق على إحساسك بنفسك معاني، وبجسدك حواسَّ، وبمشاعرك عواطف، وبرؤاك فائض أخيلة، الشعر إحساس هائل باللغة تكون أنت فيه نبياً، ذا نبوءات، ونبوّات، تكون فيه مجدداً ذات أبناء وأحفاد وقبائل وشعوباً تعارف بالإبداع لا الاتباع، وبمعزل عن أن يكون إحساسك باللغة إحساسك بمسلمات جسدك وبرغبات أناك، وأحلامك وطموحاتك، وأطفالك وحبيباتك، وعواطفك - بمعزل عن ذلك - لن تكتب إلّا شعراً منظوماً وإلّا شعراً تعليمياً مصنوعاً وإلّا كلاماً بارداً. وقد قال - قبل ألف وأربعمائة سنة - الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ انطلاقاً من هذا: (الشعراء أمراء الكلام، يصرفونه أنى شاءوا، ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، من إطلاق المعنى وتقييده، ومن تصريف اللفظ وتعقيده... واستخراج ما كلّت الألسن عن وصفه ونعته، والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد، ويبعدون القريب، ويحتج بهم، ولا يحتج عليهم، ويصورون الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل( (منهاج البلغاء/١٤٣)، وإنما هم أمراء الإحساس باللغة ويصرفونها فرط ذلك الإحساس، ولدقتهم فيه فيجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، ولفرط إنسانيتهم فيه، فهم يطلقون المعنى حيناً، ويقيدونه حيناً، ولصفاء ذلك الطبع من الإحساس أيضاً فهم يصرفون اللفظ عند إبداع المعنى؛ لحاجة الإبداع لذلك، ويقيدونه لمقتضيات الإبداع لذلك. ويبعدون القريب متى رأوا في تبعيده دقة في الرؤية الشعرية ببصيرة الإحساس، ويعقّدون اللفظ بطفولة ذلك الإحساس حتى ينضج ويتحرر عند ذلك، ويؤول عنهم ما تكل عنه الألسن، ويصدر عنهم ما تكل عن وصفه الأذهان، لأن الإحساس به من لدنهم يؤدي إلى الفهم والإيضاح، فلا شعر ولا شاعر إلّا هواء الإحساس باللغة.
ولا يكون الشاعر شاعراً حقيقياً محترفاً، يعلو ولا يعلى عليه، إلّا بذلك الإحساس الهائل باللغة التي تكون فيه القصيدة كلامه الشخصي الشعري. والشعراء المدارس إنما كانوا مدارس بإحساسهم الذي يخلق اللغة، ويرتفع بها من درجة الصفر التي تنزل إليها في الكلام العلمي الخالص في الرياضيات والقانون والشريعة وتلك العلوم التي تستدعي أن نستخدمها ملتزمين (بدرجة الصفر) منها عند الكتابة، وإنما غادرَ بعض الشعراء العرب المعاصرين الشعر العربي في صورتيه: الشطرية في العمود والسطرية في الحر إلى (قصيدة النثر)، لأنّ إحساسهم بالعالم والمعنى وأنفسهم لم ينْبع من إحساسهم باللغة نفسها، بوسيلة تعبيرهم، إنما نبع من انتباههم إلى الفكرة، وإحساسهم بالمعنى لهذا تقدمت الفكرة على الرؤيا الشعرية، والعقل الفلسفي الحر على الخيال الرؤيوي الخالق، صاروا يجتهدون إحساساً منهم بالأفكار لا الألفاظ حتى صارت اللغة في المرتبة الثانية، صارت وسيلة مصطنعة باردة، ولم تعد تخلق الفكرة التي بها يعيد خلق العالم لغوياً؛ لأنه تأخر عن اللغة وتقدّم في الفكرة.
وإنما صار النقاد العرب والشعراء كذلك إلى القول بعدِّ قصيدة النثر شكلاً شعرياً ثالثاً مضافاً لـ (شكل الشطرين) و(شكل التفعيلة) (وشكل اللاوزن)، لأنهم مكثوا بعيداً عن الإحساس باللغة، بما فقدوا الإحساس بخصوصيتها بوصفها لغة إيقاعية، كمية لا نبرية، وذات نظام صرفي نحوي دلالي هائل، وإنّ الإحساس بوسيلة التعبير يحيي التعبير نفسه، ويتصل بالخلود غير بعيد منه، لأن الحاس شاعر بما يحسّ، حتى إذا انتقل إلى القول جاء الشعور بالمعنى صادراً عن الإحساس بوسيلة التعبير عنه، وعلى إثر ذلك يأتي المعطى الشعري مؤثراً صافياً ذا حضور وتأثير، وذا إنتاجية عالية. وبمعزل عن الشعور بالشيء شعوراً متصلاً بالإحساس بوسيلة التعبير عنه فإن الكلام الحامل لكل ذلك لا يكون حيوياً، ولا يجيء مؤثراً، إنما يأتي مفتعلا مصنوعا. وإن الشعراء الأوائل ذوي الفطرة اللغوية الصافية كان إحساسهم باللغة هائلاً، وكذلك الأجيال الأخرى من المتنبي حتى محمود درويش وصولاً إلى محمد عبد الباري وجاسم الصحيح وأجود مجبل وقليل من الآخرين، ومن ذلك فإنني أعرّف الشعر وأتعرّف إليه على أنه: إحساس بكر متجدد باللغة تصير على إثره كلاماً شعرياً منسوباً لأسلوب قائله، وشعور بالأشياء والمعاني؛ الموجودة والممكنة والمحالة شعوراً يظهر للمتلقين بين يدي ذلك الإحساس البكر. فإذا ضعف الإحساس ضعف الشعور وجاء الشعر مصنوعاً بارداً، لا روح فيه، ولا إدهاش، وإذا دَقَّ الإحساس وشَفَّ اتقد الشعور وتجلّى، وتبدّى الشعرُ إبداعاً هائلاً، حيوياً، لافتاً؛ يؤثّر في الآخرين، ويتأثّر به آخرون، وقد يصل شاعره إلى أن يكون مدرسة، أو يكون ظاهرة. وهو ما يؤدي إلى أن يتعدد الشاعر الواحد في قصائد كثيرة، وعلى إثر ذلك يتطوّر ويجدد في تجربته، ولا يسكن إلى صورة واحدة. وهذا النهج في الكتابة، يجدد في مناهج النقد أيضاً، لأنه يمكث غير بعيد من الحاجة إلى جديد منهجي لقراءة الجديد الشعري. وحين نلتفت اليوم إلى أشكال كتابة القصيدة العربية المعاصرة نجدها متعددة كثيراً، متجددة قليلاً. على أنها لا تغادر الشكلين الرئيسين؛ أعني: (الشطرين والتفعيلة)، لأن قصيدة النثر جنس أدبي مستقل، وليست شكلاً شعرياً وإن اتصفت بالشعرية.
وفي الأداء بالعمود ذي الشطرين أشكال خلق للمعنى الشعري كثيرة جداً، كما في الأداء بالتفعيلة في الشعر الحر أشكال خلق للمعنى الشعري كثيرة جداً. ذلك أن الشكل في صورته الجزئية الأسلوبية كيفية في الخلق الشعري، كيفية في تفعيل كيميائه الإبداعية، وهي نهج يتباين فيه الشعراء كثيراً، (فقصيدة القناع) شكل قد يكون في الشطرين، وقد يكون في التفعيلة، وكذلك القصيدة (السير ذاتية)، وكذلك (قصيدة العائلة)، وهكذا في (القصيدة القصصية)، حتى تجد التجارب تنفتح على أشكال أخرى كثيرة جداً، تتعدد بحسب متغيرات الحياة، وتتطور بحسب ثراء التجارب، وتتجدد بحسب متغيرات الأسلوب، ونزعة التجديد في الزمكان الثقافي.
وفي قصيدة العمود عني شعراء الألفية الثالثة في الربع الأول من قرنها الأول باجتراح أشكال جديدة لافتة، وقفت عندها في دراسات خاصة منها قصيدة القناع عند محمد عبد الباري في (حدوس في استشراف الحجازي المقدس/ دار تموز دمشق، ط١، ٢٠٢١)، وقصيدة النبوءة في(قصيدة النبوءة/دار تموز، دمشق، ط ١، ٢٠٢٠م)، وقصيدة العائلة في (قصيدة العائلة/ مفهومها، مكوناتها، أنواعها)، وهي من منشورات اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين، ط١، ٢٠٢٢م).
وقد وقفت في سلسلة (نقد الشعر الآن) في إصداراتها العشرين من سنة (٢٠٢١م) إلى سنة (٢٠٢٣م) - وهي ما زالت مستمرة - على أشكال هائلة لكتابة القصيدة العربية الحديثة في شكلي أدائها الرئيسين.
وهنا - بين يدي هذه المجموعة الشعرية للصديق الشاعر: شلال عنوز - أقف على شكل تقليدي في كتابة قصيدة الشطرين ينتمي لاتجاه (قصيدة الأداء الموضوعي) الذي هو اتجاه في التعامل مع الشكل، ومن ثمة فهو شكل في قصيدة الشطرين يقوم على: أن يلتفت الشاعر إلى موضوع ما، يعيشه، مباشرة أو تخيلاً، إلتفاتاً يقصد الإحاطة به من خلال ممكنات الخلق الشعري التي يستطيعها، أو متبنيات فن الشعر التي يقدر عليها، فهو ينجز المعنى شعرياً بحسب رؤيته المتصلة برؤى خلت وتجارب كانت، فهو يستعيدها معبراً عن نفسه، ويترجمها كاشفاً عن رأيه ورؤاه، يقدم المألوف بممكنات المجاز الشعري التي يستطيعها، ويجتهد في الانزياح مستعيداً ما كان من انزياحات الشعراء المدارس أو الشعراء الظواهر، فلا يخلو من الصدور عنهم والانتماء لكثير من مؤثراتهم وأساليبهم. يجد كثيراً في تقديم ما يعيشه تقدمة لغوية بيانية فنية، في معطيات إيقاعية مستقرة، وتصويرية مألوفة، ودلالية ذات شيوع.
في هذه المجموعة التي عنوانها: (أيها المحتمي بالأرق) بدءاً من عتبتي: العنوان والإهداء، ثم استمراراً في القصائد والنصوص الستين التي تضمنتها المجموعة، وقد أقيمت على ثنائية رئيسة تصدر عنها عتباتها، وبقية مكوناتها، وهي: (الوصول - الإبعاد)، وفي الوصول نزعة للمكوث فيما ينفع الناس، ويخضرَّ في الأرض، وفي الإبعاد زبد هائل يحمل سفينة الوصول ليلقي بها في متناول غيابٍ ما. وفي كلام القصائد تصوير لذلك الوصول يتخذ أساليب فيها البياني التقليدي والفني الحديث من ترميز وأسطرة وتوظيف استعاري لممكنات راهن ما، يرسم الخيال المعاني الشعرية بالأساليب البيانية والفنية بطرائق مألوفة شائعة، وعلى وفق تقاليد ألفتها القصيد العربية، وشاعت في خطابها. غير أن هذه الثنائية: (الوصول - الإبعاد) أضمرت (الوصول) نزعةً يعيشها الشاعر، يقصدها بكل حضورها، أما (الإبعاد) فمفروض من الآخر السلبي أو الآخر العدو، الآخر: الزبد، ومن ثمة فهو (إبعاد)، وليس (بعاداً) هو مصنوع مفتعل، وليس فطرةً في الحياة، هو غريب عليها، وليس أليفاً، وهو ما جعل الآخر السلبي هو ما يمثّل الفاعل في (الإبعاد)، والآخر الإيجابي هو عالم الوصول الذي يسكن إليه الشاعر.
ويمكن الكشف عن متبنيات هذه الثنائية في المجموعة كلها، على النحو الذي أوجزه فيما يأتي:
- في عتبة العنوان (أيها المحتمي بالأرق) قاصد وصول هو (المحتمي) المنادى فرط بعادهِ بـ (أيها) فهو قاصد وصول، وليس قريباً منه بدلالة النداء (أيَّها)، وهناك (إبعاد) هو (شبه الجملة: بالأرق) هو يقصد الوصول، ولكنه احتمى بالإبعاد، فالأرق دال على ذلك موحٍ به، فالطمأنينة والسكينة مضمرتان في جملة النداء والإبعاد هو الظاهر المكشوف في (الأرق) بما يجعل عتبة العنوان ترسم الشاعر وهو يتوق للوصول إلى الطمأنينة، ولكنه فرط إبعاده عنها (يحتمي بالأرق)، فهو عالم محتلٌّ بالغياب، ماكث في تمنّي ما يحب، تحت غلبة ما يكره. ولهذا يضمر الأرق سبيلاً لفائض الكلام الشعري الذي دعاه إلى عدّ هذه التجربة (ديوان شعر) كما يحددها، وهي ليست بديوان شعر، إنما هي مجموعة شعرية، لأنها لم تنبنِ على تجربة ذات نظام متكامل، إنما هي مجموعة قصائد تتعدد حتى في أبعاد تجاربها أحياناً، ومن ثمة فهي مجموعة شعرية، وليست ديواناً، وأجد التصنيف الشكلي للتجربة يضعها تحت مصطلح (مجموعة)،بسبب هذا، و بسبب من غلبة هذه الثنائية التي تستدعي فائض الكلام في المصطلحات كما في المجازات والانزياحات استدعاءً يعوّض عن انحسار الوصول، وغلبة الإبعاد. وهو نهج يقصده الكلام الشعري في هذه التجربة بعناية.
- في عتبة الإهداء جاء: (إلى الوطن الذي يستنزفه الضجيج، وهو يتلمس الحلم)، حيث يتماهى الكلام - هنا - بما أوحت به عتبة العنوان، لأن (ما يستنزفه الضجيج) إبعاد، والذي (يتلمس الحلم) ينزع إلى الوصول؛ وقد انتقل الشاعر من المعنوي في الأرق عند عتبة العنوان، إلى الحسي: سمعاً عند الضجيج، واللمسي عند تلمس الحلم، في لغة من بناءٍ استعاري تشخصن الصوت، تؤنسن الحلم. والشاعر في (العنوان) كما في (الإهداء) يصف الأسى حيث (الاحتماء بالأرق) وحيث (الذي يستنزفه الضجيج)، ولكنه وصف لا يخلص إلى الحلِّ، لا يحيل المتلقي إلى الوصول الذي يتوق إليه، بقي يرثي الحال التي هو فيها بين يدي (الإبعاد)؛ وبلغة البيان فإن الشاعر فيهما معاً يكني عن الإبعاد، مرةً عبر الاحتماء بالأرق، وأخرى عبر تحمل الضجيج الذي يستنزفه، وعبر الحلم الذي ينزع إليه، في تلمس أخيلته، لا في الإحاطة واقعاً، فهو بين يدي تجربة واحدة، يكمل بعضها بعضاً.
- في عنوانات القصائد غير القصيرة إيحاء بالثنائية التي أوضحتها وإنما أقصد (غير القصيرة)، لأن الصلة بين العنوان والنص تنتمي للتجربة الكلية انتماءً عضوياً؛ هكذا أفترض، وذلك لا يتحقق بالقوة الدلالية نفسها في النصوص القصيرة غالباً. وهنا أذكر عنوانات القصائد الطوال وهي: (هي النجفُ، أنشودة ثورة التغيير، دع السرابا، ألق السماء، عفواً عراق المجد، أيها المحتمي بالأرق، غناء في المحنة)، وعند قراءة هذه القصائد التي تلحظ عنواناتها وهي تحتفي بمتبنياتها المباشرة احتفاء الخطاب الآني بالمعنى، في معجم يجمع بين الذاتية الحزينة المنكسرة عاطفيا والاخرى الحماسية الخطابية، وهو نهج يماهي فيه الشاعر بين المعجم وثنائية: الإبعاد – الوصول، وهو ما يلحظه المتلقي في: تركيب الجملة وفي بناء الصورة أيضا:
- في قصيدة (هي النجف) يتأمّل النجف على النحو الحقيقي المباشر على أنها نهج في الوصول، وطريق فيه، لكنه يلتفت بعد ذلك إلى ما يؤدي إلى (إبعادها) عن حضورها هذا، فكأن الجملة الاسمية (هي النجف) وصول دائم، أما ما يلمح إليه الشاعر في مجازات القصيدة فهو (إبعادها) عن أن تكون كذلك، وبحسب ما خلص إليه فيها حيث قال: (1)
إني حزين ومدمى في محادثتي
بالسارقين، ومَنْ، من نهرها اغترفوا
بالخائنين دم الأحرار مذ قدموا
والنافثين سموم الحقد مذ وقفوا
يداهنون على أحلامنا عنتا
ويرقصون على أوجاع من رعفوا
تصدر القصيدة بدءاً من إيحاءات (عتبة العنوان) عن هذه الثنائية: (الوصول - الإبعاد)، فأخذ الأبيات الخمسة الختامية، لأنه مسكون بمعاني الوصول، ناءٍ عن دلائل الإبعاد فهي مؤقتة، وجاءت في لغة ذات بثٍّ بيانيِّ، مألوف متوقّع، لا تثير فيه اللغة أخيلة مستجدة، ولا ترتفع إلى الإضافة، ولكنها تسكن إلى (الوصول) سكناً شعرياً بيانياً. أما العنوان الثاني (أنشودة ثورة التغيير) فقد جعل المبتدأ (أنشودة ثورة التغيير) بكل هذا التعريف الإضافي المضاعف صوتاً في الوصول، أما القصيدة فقد أقيمت على وصف معاني (الوصول) بوصفها خبراً لعتبة العنوان التي جاءت مبتدأ، ليخلص كما في القصيدة الأولى في الأبيات الختامية إلى (الإبعاد) على أنه نهج تغييب مؤقت في: (2 )
هم راحلون وأنت وحدك شامخ
فاصدحْ فديتك، سيَّدَ البلدانِ
هيّا تمرَّدْ، لا تَهبْ، لرصاصهم
واخلعْ ثياب البؤس والخذلان
بلغة ذات خطاب مباشر، وأساليب طلب بياني تقدّم المعنى موضوعياً أكثر منها شعرياً، وهو نهج في قصيدة (الأداء الموضوعي) لم تعد تحفل به القصيدة الحديثة في شكلها العمودي الجديد، ولاسيما على مستوى إبداع المعنى الشعري.
أما العنوان الثالث (دَعِ السرابا) فقد رسم بدلالة الرفض معنى الوصول، وبدلالة لفظ السراب معنى (الإبعاد)، ثم جاءت القصيدة ليكون صوت الشاعر فيها معنياً بالوصول منتمياً إليه، ولتكون أساليب: النهي والنفي والأمر التي هيمنت على أبيات القصيدة معبرةً عن معاني الإبعاد، حيث تكررت ست عشرة مرّة على نحو مباشر أو غير مباشر في خلال أساليب التمني والشرط والترجي. فهناك تقابل بين صوتي: الشاعر وصوت الواقع الذي تضمره الأساليب المباشرة لبث المعاني الموضوعية على نحو مباشر. فالشاعر نزعة وصول، أمنيات وصول، ولكن الواقع الذي يظهر هو أسيره: صوت إبعاد، وتتبدّى الخطابية والمباشرة في القصيدة دافعاً ذاتياً مضمراً لِأن يرد الصوتان في كلام القصيدة موارد خطابية مقالية موضوعية مباشرة، فقد استهلها هكذا: (3 )
تمهَّلْ... واستفقْ ودعِ السرابا
فإن العمر قد بلغ النصابا
ولا تطربْ لأمنية تصابت
فهذا الدهر من أزلٍ تصابى
ولا تحزن على ما فات طرّا
فقلبك أعصرٌ رحلَتْ يبابا
فالشاعر في القصيدة كلها يخاطب نفسه، منتمياً للوصول، ومأخوذاً بأسبابه في كثير من الخطاب المباشر الذي يستدعي فيه بعض روح (بائية أحمد شوقي الشهيرة) حيناً، ويتناص معها أحياناً أخرى؛ نفساً وإيقاعاً وتضميناً، فأما النفس فيمثله أن كل واحد من الشاعرين يخاطب نفسه، وأما الإيقاع ففي الأسلوب حيناً وفي الوزن والتقفية أحياناً أخرى، وأما التضمين فأوضحه في قوله: (4)
وليس المجد يؤخذ بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
الذي هو تضمين لقول شوقي الشهير: (5)
وما نيل المطالب بالتمني
ولكنْ تؤخذ الدنيا غلابا
وفي هذا النهج من التناص مع شوقي نزوع إبعادٍ أكثر منه إمكان وصول، لأن الشاعر استدعى الآخر المؤثر ليكون مسافة وصول للمعنى الشعري أسلوباً، وللمعنى الموضوعي رؤيةً وأفكاراً. وأما غلبة أساليب: الأمر والنهي والنفي فتسحب جهة الكلام للإيحاء بالامتناع الذي يسكن إليه الواقع، أو تسكن إليه الحياة المجتمعية التي يصدر عنها هنا، لأن المخاطب بهذه الأساليب ينزع إلى الوصول ولو على جهة الطلب، وهو مغلوب بأشكال الامتناع التي يقع بين ظهرانيها؛ إنساناً وشاعراً ومجتمعاً.
والعنوان الرابع (ألق السماء) مأخوذ بالوصول في تمني ذلك الألق، ومحتل بالامتناع عن أن يكون ذلك الألق عالم حضور في الحياة، ويمثل الدال الاستعاري: (ألق السماء) توق الوصول ولو بالخيال، أما مضمرات الخطاب في عتبة العنوان، ثم في القصيدة كلها فتتمثّل (الوطن) الذي هو ماكث (ظلام الأرض) و(ألق السماء) عالم وصول و(ظلام الأرض) عالم امتناع، ويلحظ المتلقي ذلك في أول القصيدة الذي يقول: (6 )
تغفو العصورُ... وتستفيقُ... تغادرُ
إلّا سناك فمنْذُ ألفٍ ساهرُ
إلّا سناك يبثَّ في هذا المدى
دفق الشعور فتشرئبُ منائرُ
إلّا سناك يزقُّ في رئة الدنى
ألق السماءِ فتستنيرُ حواضرُ
في القصيدة تقابل ثنائية: (الوطن - الزمن) بوصفها الكيفية التي تشكلت بها، ثنائية بنائية أخرى هي ما تشكّل نهج المجموعة كلها، أعني: (الوصول – الامتناع)، حيث جاء الزمان في القصيدة مسافة وصول مائية سابقة، أما الوطن في مكينه الذي يؤلف (ممكناته) فجاء امتناعاً حتى بلغ الامتناع أن قال مستوحياً ذلك (المكين) (7)
ذبحوا العراقَ، وشيعوه جنازةً
وتقاسموا ميراثه، وتنافروا
وتجري النصوص الستون التي تؤلف هذه المجموعة على هذا النهج الذي تتحكم بمعطياته التعبيرية هذه الثنائية (الوصول - الامتناع)، وإنما (أقدّم الوصول) على غيره، لأنه خلق مقصود، وإبداع دائم مراد، وهو النشأة الأولى، والدوام المتوقع، أما (غيره) فمؤقت إلى زوال. ثم أن الشاعر - هنا – يقدم الوصول (خريطة طريق)، ونهج حياة، وإنما يعنى بالامتناع، وتهيمن دواله على خطابه على نحو لافت، لأنه جعل نفسه في (موضع دفاع)، فهو جزء من وصول دائم، والآخر: الخصم أو الضد أو العدو شكل امتناع رئيس، وقد غلب عليه (هجاء ذلك الامتناع) في صوره الكثيرة، حتى ليجد المتلقي أن صور (الوصول) واضحة، متقاربة، ممكنة الرصد، أما صور (الامتناع) فكثيرة، لا لأنها كثيرة، ولكن لأنه مأخوذ بتجليتها وكشفها، بما يستدعي منه هذه المباشرة في الخطاب، وهذا الوضوح في الرسم هذه (السيرة الأدائية) في الارتجالية المنبرية، التي لم تعد تأخذ بها التجارب الشعرية المسكونة بالتجديد.
وبناء التجربة على الخيال اللغوي في أبعاده المجازية وانزياحاته البيانية والفنية فقط، بمعزل عن رؤية فلسفية أو رؤية معرفية تستدعي الإضافة وتنفعل بها، وتضمر أسلوباً منفعلاً بشيء من التفرّد الذي يلمسه (المتلقي العابر) قبل (المتلقي الفائق) لا يكون الشعر فاعلاً حقيقياً مؤثراً ذا ممكنات هائلة، سيظلّ في متناول العاطفة فقط، وبين يدي ظهراني الخيال فقط، وهذا في عصرنا اليوم، وعند تأمّل التجارب الشعرية الهائلة الفاعلة ذات المكوث الجمالي في الأرض، يصعب الإشارة إلى فاعلية فن شعري ما، أو تجربة، تقرؤها موجودة، ولا تعدّها مؤثرة. وهنا في قصيدة (أيها المحتمي بالأرق) التي استمدت منها المجموعة عنوانها خطاب شعري حافل بالعاطفة، يمتثل لحنوِّ البيان التصويري، ويوظف الانزياحات الشعرية في أشكال حضورها المألوفة في الشعرية العربية، ولكنه خطاب لا ينافس اللافت، ولا يتجاوز المؤثر النوعي، ويجري بين ضفتي هذا النهر الشعري المألوف الشائع، وهو - هنا – مأخوذ بثنائية (الوصول – الإبعاد) بدءاً من العنوان الذي أشرتُ إليه ثم جرياناً في مطلع القصيدة الذي يقول: (8)
طبولَّ مآذنُ هذا المدقْ
على أي كفٍّ ينامُ القلَقْ
وفي أي ركن تلوذ النفوس
فراراً إذا ما الملاذُ احتَرقْ
وفي أيِّ جنْبٍ أخبِّي المنى
يقوم ويجثو، ولم ينطلقْ
حيث المشابهة بين (طبول ومآذن) تؤدي معنى (غيابة البيان) تقع في سجن الصمت والغياب، مع أن المآذن معنى في الوصول لكن الطبول بديلاً عنها معنى في الإبعاد، وقد جعل الصورة التشبيهية في الشطر الأوّل تبلغ انحسار الوصول عند جملة السؤال في: (على أي كفٍّ ينام القلق؟)، حتى استمر السؤال في البيتين الثاني والثالث اللذين يؤولان السؤال بصورة في الشطر الثاني تنزع منزعاً (درامياً) في تمثيل حال الإبعاد، بأسلوب تقريري مباشر في جملتي: (إذا ما الملاذ احتَرقْ) و(يقوم ويجثو، ولم ينطلق)، وهما صورتان مباشرتان في متناول الذاكرة اليومية، أقرّهما الخيال الشعري، ولم يجترحهما، ويجري كلام القصيدة كله على هذا النحو من الأسلوب والنهج من الأداء حتى غلبت صيغ الإيحاء بنزعة الوصول ثم انحسارها، بسبب من هيمنة أشكال الإبعاد، حتى لتبدو القصيدة كلها في (رثاء معاني الوصول)!!
وفي حال تعدد الأصوات في القصيدة الحوارية فإن أي صوتين رئيسين مهيمنين سيمثلان هذه الثنائية التي أشرت إليها أعني: (الوصول – الإبعاد)، لأنها البنية الدلالية الباعثة للمعنى الشعري التي صدر الشاعر عنها، بما يبدو، أنه يعيشها، من ذلك قصيدة: (قالوا... فقلنا) التي جاءت في صياغة خطابية مباشرة: (9)
قالوا: هجمنا، فقلنا: إننا القدَرُ
من أيِّما جئتم... سجيلنا مطَرُ
من أيما جئتم... ضجّتٍ بنادقنا
من أيما جئتم... لواحة سَقرُ
كلُّ الدروب حرامٌ: قال مدفعنا
لا تدخلوها... حرام: قالها الشجَرُ
وتجري القصيدة على هذا النهج الذي يظهر فيه صوتا: (الوصول) في خلال ضمير (الشاعر المتكلم) بلسان جماعي. وهناك صوت (الإبعاد) الذي يمثله الآخر الموصوف على أنه الخصم، وهنا لا يرثي (الوصول) إنما ينتصر له، ولا يهجو (الإبعاد) إنما يصف انحساره، لأن ضمير (الأنا الجمعي) يستدعي هذا النهج ويتطلبه معطى خطابياً؛ واضحاً مباشراً. حتى تؤول القصيدة في ختامها إلى صور غزلية، عني الشاعر بها انتصاراً لوصوله العاطفي أو الوجداني، وبضمير المتكلم المفرد.
وتذهب هذه الثنائية في مجرى الصور الشعرية مذاهب متعددة يجمعها إحساس الشاعر بالعالم والإنسان بخاصة، متخذاً من مخاطبة ذاته بُعْداً ينتمي إليه الصوت، وقد بدأ من العنوان مخاطباً نفسه في جملة طلبية مبنية على فعل الأمر: (كفْكفْ دموعك) ليكون المحيط السلبي الغالب هو ما يشكل حال (الإبعاد)، وليكون (الشاعر) في حضوره الرمزي هو ما يمثل (نزعة الوصول)، ويبدأ القصيدة هكذا: ( 10)
كفْكفْ دموعك أيها الحيرانَ
وانثرْ أساكَ فهذه ميسانُ
وامسك جراحك؛ مستباحاً مذعنا
وانْدُبْ، فقد أكل الخطى الميدانَ
فعلام تبكي، تستشيط بحسرة
فالعيش يتْمٌ ها هنا وهوانُ
بناء القصيدة بدءاً من العنوان الذي يتنفّسه كلامها في أول جملة من بيتها الأوّل بناءً يقارب فيه بين الوصول انكساراً، والذكرى على أنها عالم إبعاد، لأن إحساسه بالزمن - هنا – رثائي سلبي في معطياته التي كانت حيث: (أكلها الميدان من قبل، وصودر إنسانها، وانحسر صباحها عن وضوح عاقر...)، حتى ليقف المتلقي على الصور الشعرية مرسومة بأسلوبين رئيسين؛ بعضهما من بعض هما: (التشبيه والاستعارة) اللذان تقوم بنيتهما على التقابل الثنائي بين (المشبه والمشبه به) أو (المستعار والمستعار منه)، وقد رسماً في ثنائية (الوصول – الإبعاد) رسماً شعرياً.
الشاعر المحتمي بالأرق: شلال عنوز، مسكون بالواقع المباشر سكناً وجدانياً، ومنفعل بالتعبير عن ذلك انفعالاً خطابياً بيانياً يقدّم المعنى الشعري على ثنائية: الإحساس – العاطفة تقدمة يتفوق المجاز المألوف فيها على المجاز المتخيّل، والانزياحات المنتجة للمعنى الخطابي على تلك التي تبعث على التأمّل في عميق ترميز، وتقارب المعنى المتخيّل بالمباني اللغوية المكشوفة أسلوبياً بأن يقع مراد الخطاب بين يدي ظاهر اللفظ. وهو نهج شاع في القصيدة العربية من عصورها الأولى حتى عهودها الأخيرة من عصرنا الراهن بما استدعى أن يلتفت الشعراء إلى مذاهب أخرى، وأن ينهجوا سبلاً شعرية، ويجترحوا ممكنات أداء لم تكن مألوفة حتى وهم يوظفون الأساليب نفسها التي بالغ القدماء في توظيفها، لأنهم يعدون الطريق واحداً أحياناً، ولكن السائرين فيه متعددون.
وأحسب أن شلال عنوز يشتغل في منطقة أليفة مألوفة، وبخطاب متوقع ممكن يدهش العاطفة إحساساً، ولا يدهش مجسات الخلق الشعري بجديد لافت، لأن القصيدة عنده حاسة إنسانية وجدانية يتلمس بها الواقع ومعانيه، ويستدعي الخيال وممكناته التي تصل أسلوب الشاعر بخيال المتلقي، والقصد من المعنى بالفهم من القراءة، بما يقترب فيه من الطين كله في زراعة الشعر، ولا يمكث عند ضفة واحدة، ذلك أن الشاعر المأخوذ بالخطاب المألوف والخلق الشعري المتوقع شاعر جماهيري، وليس شاعر نوع شعري خالص.
وهنا سيقرأ المتلقي الكريم خطاباً شعرياً مباشراً، وتتبدّى له أساليب خلق المعاني الشعرية، وهي تأخذ بتلابيب القارئ إلى واضح المعنى، وظاهر الدلالة، لأنّ فاعلية الإحساس بالأشياء عنده تقصد الظاهر، ولا تذهب إلى الغموض، وتعني المباشرة، ولا تلتفت إلى (غيابة المجاز)، هو شاعر منتمٍ لساحل القصيدة، لأنه مأخوذ بالوصول، منتمٍ إليه؛ شاعراً وإنساناً.
***
الدكتور رحمن غركان
.....................
الهوامش
1 – أيها المحتمي بالأرق، (مجموعة شعرية)، شلال عنوز، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بغداد، 2023 م، ص 9.
2 – نفسه، ص 58.
3 – نفسه، ص 58.
4 – نفسه، ص 59.
5 – الشوقيات، أحمد شوقي، 1 / 211.
6 – أيها المحتمي بالارق، ص 62.
8 – نفسه، ص 88.
9 – نفسه، ص 93.
10 – نفسه، ص 99.