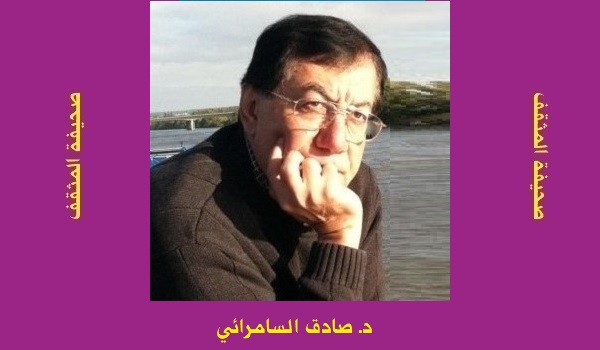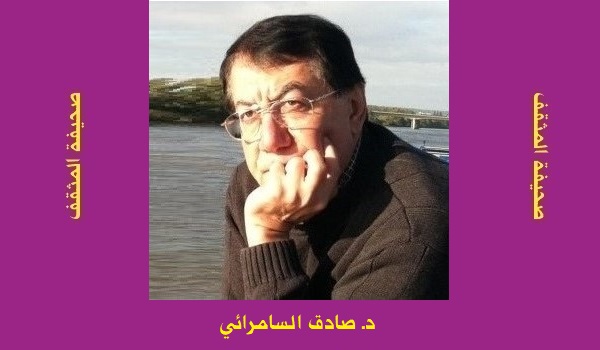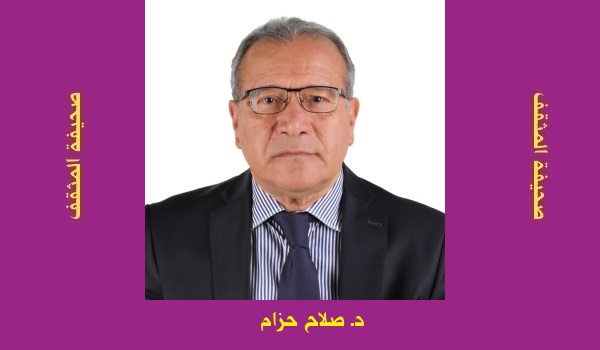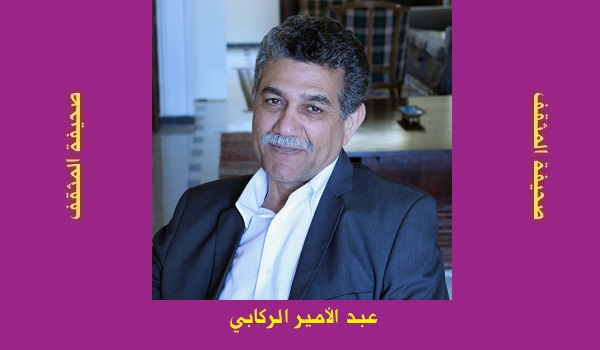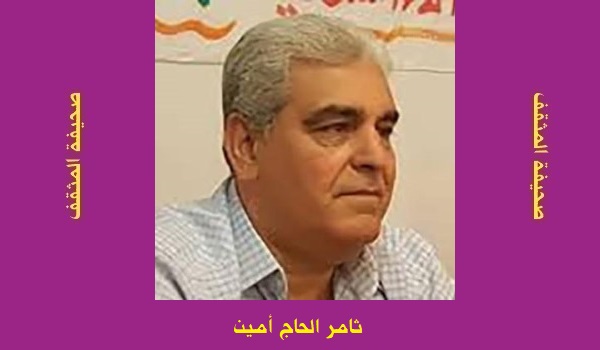يتمثل الحلم في الوعي الجمعي قيمةً إيجابية: فضاءً للحرية، ومجالًا للأمل، ودليلًا على الحيوية والطموح. غير أن هذه الصورة تخفي سؤالًا جوهريًا قلّما يُطرح وهو: لماذا نحتاج إلى الحلم أصلًا؟
لو كان الإنسان قادرًا على تحقيق مقاصده في الواقع، وعلى تحويل إرادته إلى فعل، فهل كان سيمنح الحلم هذه المكانة في حياته؟
الحلم، في صورته الرائجة لدى الناس، ليس امتدادًا طبيعيًا للفعل، بل غالبا هو بديل عنه. إنه ليس مرحلة أولى من مراحل التحقيق، بل نتيجة مباشرة لتعطّل التحقيق نفسه.
الهدف بطبيعته واقعي، محدد، مشروط بالقدرة والزمان والوسائل.
أما الحلم فهو هدف منزوع الشروط، محرَّر من القيود، لا يُسأل عن إمكانه ولا عن طريقه.
حين يعجز الإنسان عن الانتقال من الإرادة إلى الفعل، ومن التصور إلى الإنجاز، يحدث تحوّل خفي:
الهدف الذي فشل في أن يتحقق، يُعاد إنتاجه في صورة حلم.
بهذا المعنى، الحلم ليس بداية الطريق، بل نهايته المؤجلة. إنه الشكل الذي يتخذه الهدف بعد أن يُسحب من ساحة الواقع ويُنقل إلى فضاء التخيّل.
العجز عن تحقيق الحلم يولّد ألمًا وجوديًا: شعورًا بالنقص، وبالقصور، وبالاصطدام القاسي مع حدود وشروط الذات والواقع.
هنا يتدخل الحلم بوصفه آلية دفاع، يخفف وطأة الفشل دون معالجته. ويمنح الإحساس بالمعنى دون تحقيقه، ويقدّم وهم الإمكان بدل الإمكان نفسه.
الحلم لا يغيّر الواقع، لكنه يغيّر إحساسنا به. ولذلك يُفضَّل على الفعل، لأن الفعل يعرّي القدرة، بينما الحلم يحميها من الإختبار والخيبة.
يرغب الناس في الحلم لأن الحلم لا يطالب ببرهان، لا يفضح العجز، لا يفرض مسؤولية، لا يعرّض صاحبه للهزيمة.
في الحلم، الجميع ناجحون، أحرار، مقتدرون.
أما في الواقع، فالمعايير قاسية، والنتائج مكلفة، والفشل لايرحم.
الرغبة في الحلم ليست محبة للقيمة، بل هروب من المحكّ. إنها تفضيلٌ لحياة بلا امتحان على حياة تُقاس بالنتائج.
في كثير من الحالات، لا يكون الحلم نتيجة قهر خارجي فقط، بل نتيجة قهر داخلي نفسي.
حين يدرك الإنسان بوعي أو دون وعي أن الطريق يتطلب جهدًا وصبرًا، وتضحية واحتمال خيبة، فإنه قد يختار طريقًا أسهل، هو الحلم.
بهذا يصير الحلم شكلًا راقيًا من الكسل: كسل لا يبدو كذلك، لأنه يتزيّا بلباس الطموح، بينما هو في حقيقته تعليق للفعل لا تحفيز له.
وتختلف الرؤية عن الحلم في كونها: مرتبطة بإمكانات واقعية، وخاضعة للتخطيط، وقابلة للتحويل إلى أفعال.
أما الحلم بالمعنى الرائج، فهو تصور بلا جسد، معنى بلا ممارسة، إرادة بلا أثر.
إنه فكرة ارتاحت من عناء المحاولة والمخاطرة وامتلاك المستلزمات.
الحلم، حين يتحول إلى قيمة مستقلة، يصير خطرًا أخلاقيًا.
لأنه يعلّم الإنسان الرضا بالتصور بدل الإنجاز، وبالتمنّي بدل العمل، وبالاحتمال الذهني بدل الحقيقة الواقعية.
ليس المطلوب قتل الحلم، بل كشف وظيفته الحقيقية: فإما أن يكون خطوة في مسار الفعل والإنجاز، وإما أن يكون شهادة صامتة على عجز لم نجرؤ على مواجهته.
ربما، نحن لا نحلم لأننا أقوياء، بل لأننا عجزنا عن أن نكون أقوياء.
***
جميل شيخو