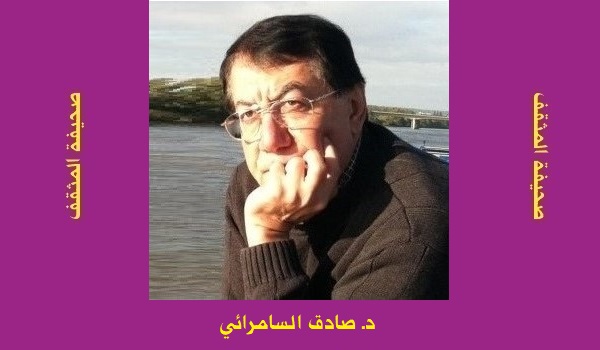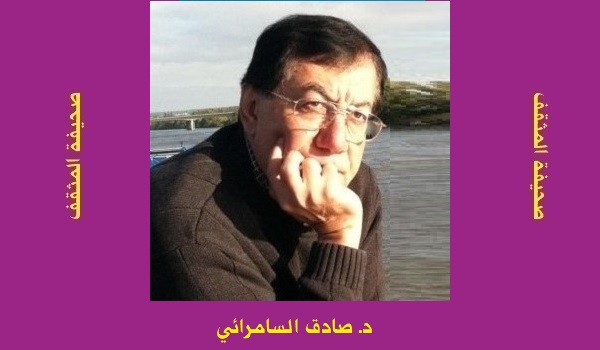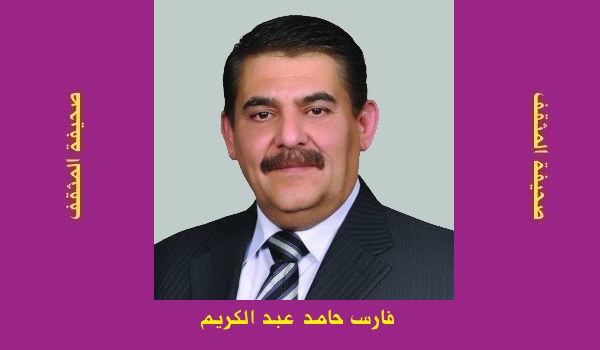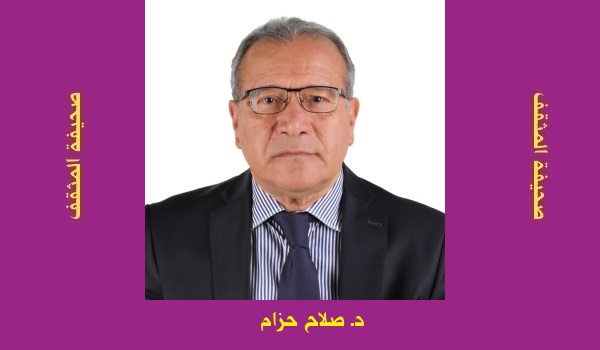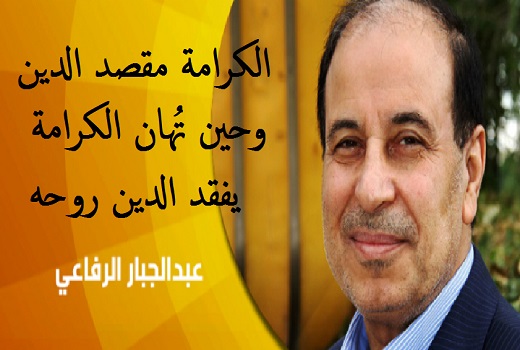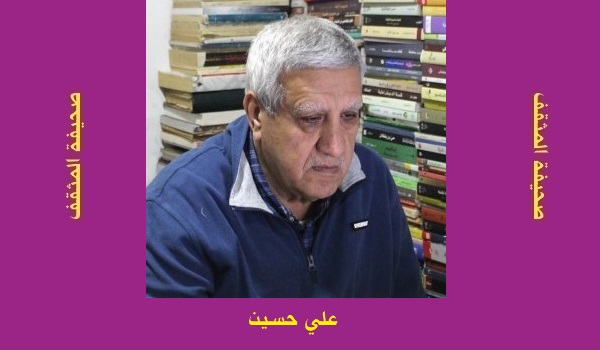حصلت على رزمة صغيرة من اوراق الراحل عامر عبد الله، (1924- 29 كانون الثاني | يناير 2000) القيادي الشيوعي والوزير السابق، (نسخ مصورة، فوتوكوبي) من ما سماه (من دفتر مذكراتي)، التي نشر عدد من الكتاب او القريبين من الراحل انها كانت مخطوطة من اكثر من الف ورقة A4 بخط يده، او باشرافه ووجود تصحيح او اضافات بخط يده عليها. ومازال السؤال عنها قائما، اين اختفت؟ ومن قام بذلك؟ ولمصلحة من او من يستفيد من تضييعها؟!!.
على كل حال، اثار اهتمامي في هذه الاوراق، ولاهمية ما كتبه الراحل عنها، كونها تتعلق بمصائر مناضلين استشهدوا وغيبوا، وسانقلها كما وردت في الاوراق، التي كما يبدو بقية من مذكرات الراحل وبخط يده، وعسى ان تثير من جديد موضوع البحث عنها ونشرها!.
وكما كتب الراحل: منذ المذبحة التي نظمها (صدام) اوائل عام 1978 ضد ما سمي افتراءً ب"التنظيم الشيوعي العسكري في الجيش العراقي، لم يتم نشر اسماء شهداء هذه المذبحة، رغم ان نسخة من المذكرات الاحتجاجية كانت محفوظة دوما في مقر الحزب ولدى قيادة الحزب، وهي تتضمن اسماء هؤلاء الشهداء ومهنهم وانتماءاتهم، وكان اخر نسخة اودعتها لدى قيادة الحزب في بريطانيا، من خلال احد الرفاق في اوائل 1993، هذا الى جانب التباين في اعداد هؤلاء الشهداء، حيث يجري الحديث على لسان الحزب او بعض القادة والكتاب عن (21) او (31) شهيدا، مع ان عددهم الحقيقي هو (39). فضلا عن اعداد اخرى سبقت هذه المذبحة او اعقبتها، وهي ما تطرقت اليها في سياق هذه الاستذكارات المقتبسة عن مذكرات موجهة الى رئيس الجمهورية، والى (صدام حسين) اودعتها للحفاظ عليها، اسوة مع غيرها من وثائق هامة لدى قيادة (الحزب الاشتراكي اليمني) في عدن، ولا ادري ان كان بالامكان الوصول اليها او استعادتها.
وفي كل الاحوال، فان هدفي من اقتباس هذه السطور من (دفتر الذكريات) ونشرها، هو تكريم هؤلاء الشهداء والضحايا واعلان اسمائهم وتثبيتها في سجل التاريخ، فضلا عن التوقف لدى تلك الفترة المازومة بالانتهاك والقمع والقتل، وبالتالي اعلان العداء والخصومة من جانب الحزب الحاكم ضد الحزب الشيوعي، وتفكيك الجبهة، (بعد ان تعاظم بسرعة دور الحزب ومكانته في صفوف الشعب وهو ما اثار القلق والرعب في صفوف هذا الحزب الحاكم)، هذا فضلا عما آل اليه الوضع لاحقا، وهو ما تابعه ويعرفه الجميع.
بعد هذه الاسطر عدة صفحات بخط يد اخرى، اتمنى ان يتحدث عنها صاحبها بعد الاطلاع على هذا الموضوع، ولكن هناك عددا من الهوامش عليها بخط يد الراحل، وهي حوارات ومذكرات بينه وبين احمد حسن البكر، واخرى بينه و(صدام حسين)، وفي هامش ذكر الراحل ان هذه الاحاديث مدونة مع وثائق شخصية اودعتها للحفظ لدى الاخ (علي ناصر محمد) واخبرني مؤخرا انها لا تزال محفوظة في ملف موجود في دار سكرتارية اللجنة المركزية للحزب في عدن.
واعود الى قائمة الاسماء، وانقل نصا ما يلي: وتلك قضية خطيرة، لا يليق التعامل معها بالارقام فمن هو هؤلاء الضحايا ان يذكروا بالاسماء على الاقل، تكريما لماثرتهم وتضحيتهم. هؤلاء الشهداء الذين سبق هذا اللقاء تقديم مذكرة بوضعهم والمطالبة باطلاق سراحهم باسمي واسم عزيز محمد ، ومن ثم بمذكرة اخرى اعددتها على عجل في اليوم الثاني من اللقاء مع احمد حسن البكر، مع نبذة موجزة عن كل منهم، هم:
المحكومون بالاعدام:
1- عدنان شرهان (جندي مكلف) صدر عليه الحكم في 1974/4/19 من محكمة الثورة بتهمة انتسابه للحزب واقامة تنظيم شيوعي في الجيش. كان صديقا للحزب.
2- سهيل شرهان (جندي مكلف) نفس الحكم والجهة التي اصدرت الحكم والتهمة والتاريخ، نظمت بعض الجهات عملية الايقاع به، رغم انه قطع صلته بالحزب لدى التحاقه بالجيش.
3- ماجد جلوب حافظ (جندي مكلف) نفس الحكم وتاريخه والاتهام.
4- عباس فاضل عباس (جندي مكلف) نفس الحكم وتاريخه والاتهام، رغم انه لم تكن له علاقة بالحزب.
5- حسين علي الطريحي (جندي مكلف) صدر عليه الحكم في 1974/9/19 نفس الحكم والاتهام، رغم انه ليست له علاقة بالحزب.
6- عبد المطلب ابراهيم سلمان (جندي مكلف) نفس التاريخ والحكم والتهمة ولا علاقة له بالحزب. (حكم على كل من عدنان وسهيل وعباس وحسين وعبد المطلب بقضية واحدة بسبب علاقتهم الشخصية اثناء وجودهم في وحدة عسكرية واحدة ولكونهم زملاء من ايام الدراسة ومن مدينة واحدة).
7- اسماعيل عبد الحسن طاهر (جندي) صدر الحكم عليه في 1974/6/8 من قبل محكمة الثورة، كان شيوعيا انقطعت صلته بالحزب بعد التحاقه بالجيش.
8- جعفر عبد الله (جندي) نفس الحكم والتاريخ والتهمة، كان صديقا للحزب ولم تكن له صلة تنظيمية به.
9- خالد علو (جندي) نفس الحكم والتاريخ والتهمة، كان صديقا للحزب ولم تكن له صلة تنظيمية به.
10- خميس عباس (جندي) نفس الحكم والتاريخ والتهمة والصفة.
( ان كلا من اسماعيل وجعفر وخالد وخميس قد حكموا في قضية واحدة بسبب وابط الصداقة المتكونة بينهم من قبل، ولانهم ابناء مدينة واحدة وذوي افكار تقدمية).
11- حامد كشاش لفتة (رئيس عرفاء) حكم بالاعدام في 1974/9/19 من قبل محكمة الثورة بتهمة الانتماء لتنظيم سياسي، لم تكن له علاقة بالحزب الشيوعي.
12- رحيم هادي كاسب (عريف مخابرة) حكم بالاعدام في 1974/3/23 من قبل محكمة الثورة بتهمة الانضمام الى الحزب الشيوعي، ولم يكن حزبيا، ولكن كان من عائلة شيوعية.
13- مسلول كريم حازم (جندي مكلف) حكم بالاعدام في 1974/9/19 من قبل محكمة الثورة، كان صديقا للحزب وانقطعت صلته بعد التحاقه بالجيش.
14- ناطق عبد الواحد الحديثي (جندي مكلف) حكم بالاعدام في 1975/3/23 من قبل محكمة الثورة بنفس التهمة مع انه لم يكن يوما ما عضوا في الحزب او له صلة به.
15- حميد عبد العال (نائب عريف) نفس التاريخ والجالة السابقة.
16- اسماعيل حسين حميد (نائب عريف) نفس التاريخ والحالة.
17- كيلو صبيح طلال (نائب ضابط) حكم بالاعدام في 1977/4/17 من قبل محكمة الثورة، نفس التهمة، ولا علاقة له بالحزب.
18- مجيد حسين داود (جندي مكلف) حكم بالاعدام في 1977/5/21 بتهمة الاشتراك في مظاهرة تاييد للحكم الذاتي، ولم يقم بنشاط حزبي او سياسي داخل الجيش.
19- جلال حسن عبد الوهاب (جندي اول متطوع) حكم بالاعدام في 1972/5/22 من قبل محكمة الثورة بتهمة الالتحاق بجماعة مسلحة وتقاضى راتبا من الشيوعيين، في حين انه كان قد هرب من الجيش والتحق بالانصار ثم ترك الحزب وصفوف الانصار ولم يشمله العفو السابق.
20- عامر سلطان هندي (ملازم عسكري) حكم بنفس التاريخ والتهمة، ليست له علاقة بالحزب الشيوعي.
شملت احكام الاعدام عددا من افراد سلك الشرطة والمعلمين والفلاحين والمواطنين المدنين، وهم:
21- حامد خضير خير الله (شرطي مكلف) حكم بالاعدام في 1976/5/25 من قبل محكمة الثورة، بتهمة التنظيم الشيوعي مع انه لا علاقة له بالحزب الشيوعي.
22- عبد الكريم عبد الله المياحي (جابي في مصلحة نقل الركاب) نفس التاريخ والجهة، وبتهمة تنظيم احد افراد الشرطة، انقطعت صلته بالحزب منذ عام 1972.
23- صميدح خزيم الركابي (شرطي) نفس الحالة السابقة وبتهمة صلته بكريم عبد الله.
24- عباس عبد حسن (من سكنة حي الثورة) نفس الحكم والجهة والتهمة والتاريخ.
25- عزرة حسين عبد الله (شرطي) نفس الحكم والجهة والتهمة والتاريخ.
26- صباح شياع (موظف صحي في البصرة) حكم بالاعدام في 1977/4/17 بتهمة تنظيم احد الافراد العسكريين مع انه كان ضمن (30) شيوعيا اعتقلوا في البصرة في حزيران 1976.
27- عبد الزهرة محمد علي (معلم في محافظة القادسية) حكم بالاعدام في 1977/5/21 بتهمة ازدواجية الانتماء الحزبي، مع انه كان عضوا في الحزب الشيوعي ولم يسبق له الانتماء لحزب البعث.
28- عبد القادر مشكور (فلاح من محافظة كركوك) حكم من قبل المحكمة العسكرية الخاصة بتهمة التمرد مع انه لم ينتسب الى المتمردين بل كان موضع ملاحقتهم، من عائلة شيوعية.
29- سعيد رسول نادر (فلاح من محافظة كركوك) نفس الحالة السابقة.
30- صبيح جابر فارس (جندي) حكم بالاعدام من جانب محكمة الثورة بتهمة التنظيم الشيوعي، كان شيوعيا وقطع علاقته بالحزب بعد التحاقه بالجيش.
31- حبيب عبد ابراهيم (مواطن) حكم بالاعدام في 1976/2/23 من قبل محكمة الثورة، بتهمة الانتساب للحزب الشيوعي مع انه كان قد فصل منه بعد التحاقه بسلك الشرطة.
32- بشار رشيد (مفوض شرطة ولاعب كرة قدم) حكم بالاعدام بتاريخ 1975/3/23 من قبل محكمة الثورة بتهمة الاتصال بالحزب الشيوعي، مع انه ليست له علاقة بالحزب.
33- سعدي خالد (فلاح من اربيل) حكم عليه بالاعدام في 1975/3/15 من قبل محكمة الثورة، بتهمة انتمائه الى القيادة المركزية، ورغم انه تركهم بعد ان التحق بكردستان، ثم عاد الى اهله.
34- نعيم حسين البدري (مواطن) حكم بالاعدام بتاريخ 1977/5/21 بتهمة تنظيم عسكريين من اقاربه واصدقائه، مع انه لم يكن عضوا في الحزب.
35- نوري قادر غفور، حكم بالاعدام منذ عام 1961 من قبل المجلس العسكري العرفي الاول في قضايا كركوك (التي اغلقت مع زميل له) حكم بالاعدام ايضا وحكم للمرة الثالثة بالسجن ثلاث سنوات متعاقبة.
36- عاصي علي محمود (فلاح من كركوك) حكم بالاعدام من قبل المجلس العرفي العسكري الاول في قضايا كركوك بتاريخ 1962/2/11 وقد القي القبض عليه مؤخرا وحكم عليه بالاعدام.
37- اسماعيل حسين حميد (نائب عريف) حكم بالاعدام بتهمة تنظيمه شاكر ناصر رحيم.
38- شاكر ناصر رحيم (نائب عريف شرطة) حكم بالاعدام ولا علاقة له بالحزب.
39- عبد الرحمن علي رحيم (عامل) حكم بالاعدام بتهمة تنظيم شاكر ناصر رحيم مع ان العلاقة النقابية بينهما انقطعت منذ عام 1973.
واضافت الاوراق ما يلي نصا: كان هناك ايضا (34) شخصا من المحكومين بالاشغال الشاقة المؤبدة وبضمنهم اعضاء بالحزب، وانصار من الشمال، الى جانب عدد من المواطنين لا علاقة لهم بالحزب او محسوبين على ملاك القيادة المركزية.
وعدا هؤلاء وأولئك كان هناك (17) شخصا اخرين محكومين بالسجن مددا مختلفة تتراوح بين 15 و10 و5 سنوات، بينهم اثنان محكومان غيابيا بتهم ملفقة، وحتى سنة واحدة.
ويكمل الراحل نصوص المذكرات المقدمة منه الى رئيس الجمهورية عن كل الاسماء والارقام التي سبقت اعلاه. قد نعود لها لاستكمال جهود الراحل وفيها معلومات عن طبيعة المذكرات والردود عليها.
***
اعداد وتقديم: كاظم الموسوي