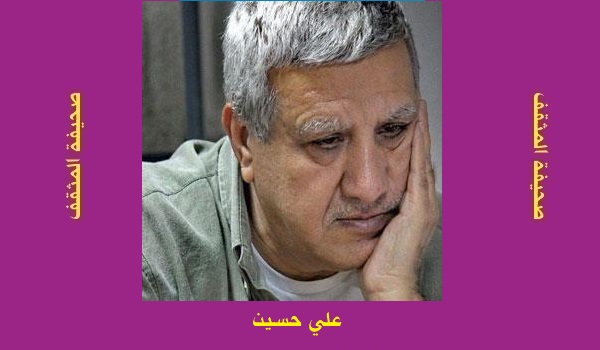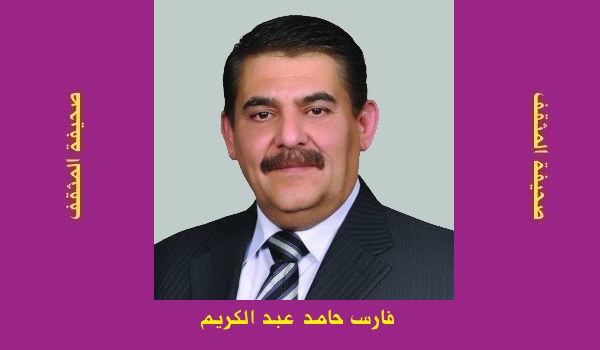في خضم التحديات التي تواجه وطننا، يظل التعليم العالي منارة الامل وشعلة التغيير. ففي عام 2024، شهد العالم نقلة نوعية في مناهج التعليم واساليب البحث، شكلت منعطفا هاما في مسيرة التعليم العالي، حيث شهد تحولات جذرية في المناهج الدراسية واساليب التدريس والبحث العلمي، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل المتغيرة. من هنا، تبرز اهمية التعرف على هذه التطورات بالنسبة لوطننا، اذ يعد تطوير منظومة التعليم العالي في الدول العربية وبالخصوص العراق ضرورة لمواكبة هذه التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. يشمل ذلك الاطلاع على احدث المناهج والبرامج التعليمية في الجامعات العالمية لتطوير المناهج العربية وتخريج كفاءات قادرة على المنافسة عالميا. كما يعد تعزيز البحث العلمي والابتكار اساسا للتنمية، من خلال الاطلاع على احدث التطورات وتشجيع الابتكار لا يجاد حلول للتحديات. ويتحقق التطوير ايضا بتحسين جودة التعليم عبر الاطلاع على افضل الممارسات وتوفير بيئة تعليمية محفزة.
بناء على نتائج البحث، تميز عام 2024 بعدة جوانب مهمة في مجال الجامعات والتعليم العالي على مستوى العالم، والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا العرض. باعتقادي ان فهم هذه الجوانب وتحليلها هو خطوة اساسية نحو وضع استراتيجيات فعالة لتطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية الشاملة. من ضمن هذه الجوانب:
تطوير المناهج الدراسية:
تجلى التوجه في تطوير المناهج من خلال عدة جوانب متكاملة، حيث لم يعد التعليم مجرد تلقين نظري بل اصبح يركز بشكل كبير على اكتساب الطلاب مهارات عملية قابلة للتطبيق في سوق العمل، وذلك عبر دمج التدريب العملي والمشاريع الواقعية في المناهج الدراسية واشراكهم في حل مشكلات حقيقية تواجه الشركات والمؤسسات. كما ازداد التركيز على تطوير المناهج متعددة التخصصات لتلبية حاجة سوق العمل للخريجين الذين يمتلكون معرفة ومهارات في مجالات متنوعة، مثل البرامج التي تجمع بين الهندسة والادارة او علوم الحاسوب والاقتصاد، بهدف تخريج كوادر قادرة على التعامل مع التحديات المعقدة. ويعتبر الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار من المحركات الرئيسية لهذا التغيير، حيث اولت الجامعات اهمية كبيرة لتضمينها في مناهجها من خلال تدريس احدث التقنيات واساليب البحث العلمي وتشجيع ريادة الاعمال وتطوير المشاريع الخاصة. اضافة الى ذلك، عززت الجامعات مهارات التعلم الذاتي والتفكير النقدي لدى الطلاب لمساعدتهم على مواجهة التحديات المتجددة في سوق العمل والتكيف مع التغييرات المستمرة، وذلك عبر تشجيع البحث والاستقصاء والتفكير النقدي وحل المشكلات بشكل ابداعي. وجسدت جامعات عالمية رائدة هذا التوجه بشكل واضح، فمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) عزز من مشاريعه في تشجيع الطلاب على المشاركة في مشاريع بحثية متقدمة وتطوير تقنيات جديدة، كما قدم برامج دراسية متعددة التخصصات تجمع بين الهندسة وعلوم الحاسوب والادارة. وبالمثل، وفرت جامعة ستانفورد برامج تدريبية وورش عمل لمساعدة الطلاب على تاسيس شركاتهم الخاصة، مع التركيز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. اما جامعة كامبريدج فتميزت بتقديم برامج دراسية متنوعة تغطي مختلف المجالات، مع تشجيع المشاركة في الانشطة اللامنهجية لتطوير المهارات الشخصية. وفي اليابان، اولت جامعة طوكيو اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والابتكار واجراء ابحاث متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع التركيز على تعليم القيم الاخلاقية والمسؤولية الاجتماعية.
الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار:
شهد عام 2024 اهتماما متصاعدا بالبحث العلمي والابتكار، تجسد في تعزيز التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والجهات البحثية والهيئات الصناعية، بهدف تحويل نتائج الابحاث العلمية الى تطبيقات عملية تساهم في دفع عجلة التنمية. لم يعد البحث العلمي مجرد نشاط اكاديمي منعزل، بل اصبح محركا اساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التركيز على دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الطلاب والباحثين على الانخراط الفعال في هذا المجال. يتجلى هذا الاهتمام في جوانب متكاملة، منها التركيز على البحوث متعددة التخصصات التي تساهم في ايجاد حلول شاملة للمشكلات المعقدة التي تواجه الصناعة والمجتمع، ودعم البحوث التطبيقية التي تؤدي الى تطبيقات عملية قابلة للتسويق والاستخدام، وتشجيع ريادة الاعمال القائمة على المعرفة من خلال تحويل نتائج الابحاث الى شركات ناشئة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي لتبادل المعرفة وتسريع وتيرة الاكتشافات. وتجسد جامعات عالمية هذا التوجه من خلال تمويل ودعم بحوث ضخمة، فجامعة كاليفورنيا، بيركلي، تعرف بابحاثها المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث قادت مبادرة "معهد الطاقة الحيوية" الذي يهدف الى تطوير وقود حيوي مستدام من مصادر غير غذائية. كما تشتهر جامعة تورنتو في كندا بابحاثها الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث ساهم باحثوها في تطوير تقنيات التعلم العميق التي تستخدم اليوم في مختلف التطبيقات. وفي سويسرا، تعتبر جامعة زيورخ مركزا رائدا للابحاث في مجال علم الاعصاب، حيث تجري ابحاثا متقدمة لفهم وعلاج الامراض العصبية مثل الزهايمر وباركنسون. اما في اسيا، تولي جامعة سنغافورة الوطنية اهتماما كبيرا بابحاث الاستدامة والتنمية الحضرية، حيث تجري ابحاثا متطورة لايجاد حلول لمشاكل الازدحام والتلوث وتغير المناخ في المدن الكبيرة. هذه الامثلة تؤكد على الاهمية المتزايدة للبحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية المستدامة.
تحسين جودة التعليم:
شهد عام 2024 جهودا متزايدة لتحسين جودة التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابداع والابتكار، وذلك من خلال التركيز على تطوير البنية التحتية والتجهيزات، وتحسين وضعية اساتذة التعليم العالي، واعتماد ابتكارات تربوية حديثة. لم يقتصر التطوير على جانب واحد بل شمل جوانب متعددة ومتكاملة. ففي مجال البنية التحتية، شهد التعليم العالي تطوير المكتبات الرقمية لتوفير مصادر المعلومات الالكترونية، وانشاء فضاءات للابتكار وريادة الاعمال. اما فيما يتعلق بتحسين وضعية اساتذة التعليم العالي، فقد تم التركيز على رفع مستوى الرواتب والحوافز، وتوفير فرص التطوير المهني والتدريب المستمر، وتوفير بيئة عمل محفزة على البحث العلمي والابتكار. والاهم من ذلك، تمت زيادة كبيرة في الاعتماد على الابتكارات التربوية الحديثة التي تركز على التفاعل والمشاركة، مثل اسلوب "التعلم القائم على المشاريع" حيث يكلف الطلاب بانجاز مشاريع واقعية تمكنهم من تطبيق المعرفة النظرية، واطلاق برامج جديدة متخصصة في المجالات الناشئة كبرامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل الطلاب والاساتذة لتبادل الخبرات، وانشاء مراكز للتميز في مجالات محددة كمركز للتميز في الطاقة المتجددة، ورقمنة الخدمات الجامعية لتسهيل الاجراءات الادارية. ومن الامثلة الملموسة على هذه الابتكارات، نجد جامعات بدات في استخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في التدريس لزيادة التفاعل وجعل المفاهيم اكثر وضوحا، كما بدات جامعات اخرى في اعتماد نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بعد، مما يتيح مرونة اكبر للطلاب. بالاضافة الى ذلك، تم التركيز على تطوير مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب، مثل مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والعمل الجماعي والتواصل الفعال، من خلال ورش العمل والانشطة اللامنهجية. تؤكد هذه الجهود على التزام الجامعات بتحسين جودة التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابداع والابتكار، مما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المساهمة في بناء مستقبل مزدهر.
دمج المؤسسات التعليمية والكليات:
شهد عام 2024 توجها متصاعدا نحو دمج الجامعات والكليات في مؤسسات تعليمية اكبر، بهدف تحقيق ادارة اكثر فعالية، وترشيد استخدام الموارد، وتحسين جودة التعليم. يعتبر هذا الدمج استراتيجية تهدف الى تعزيز الكفاءة والفعالية في قطاع التعليم العالي من خلال تجميع الموارد والخبرات تحت مظلة واحدة. من الاسباب الرئيسية لهذا التوجه، تحسين الادارة والحوكمة من خلال انشاء هيكل اداري اكثر مركزية وفعالية، وترشيد الامكانيات والموارد عن طريق تجميع الموارد المالية والبشرية والمادية لتقليل الهدر، وتحسين جودة التعليم بتوفير برامج دراسية اكثر تنوعا وشمولية، وزيادة القدرة التنافسية للجامعات على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. وقد تجسد هذا التوجه في عمليات دمج مختلفة حول العالم، فمثلا، شهدنا دمج كليات الهندسة المختلفة في جامعة واحدة شاملة لتوفير موارد مشتركة للمختبرات وورش العمل وتطوير برامج دراسية متداخلة، كما تم دمج كليات العلوم الانسانية والاجتماعية لانشاء برامج دراسية تجمع بين تخصصات مختلفة مثل علم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ، ودمج كليات التربية مع كليات اخرى لتعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في اعداد المعلمين.
الابتكارات التربوية والتعليمية
في عام 2024، شهدت الجامعات العالمية العديد من الابتكارات التربوية والتعليمية التي تهدف الى تحسين التعليم وتوفير تجارب تعليمية اكثر فعالية ومتقدمة. من بين هذه الابتكارات، تبرز استخدام تقنيات الواقع الافتراضي لتقديم تجارب تعليمية ثلاثية الابعاد، مما يساعد الطلاب على فهم المفاهيم العلمية والهندسية بشكل اكثر واقعية. كذلك، يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات تخصيصية للطلاب بناء على ادائهم واحتياجاتهم التعليمية. بالاضافة الى ذلك، يجمع نموذج التعليم الجماعي المتعدد الجانب (HyFlex) بين التعليم الشخصي والتعليم الافتراضي، مما يتيح للطلاب اختيار الطريقة التي تناسبهم بشكل افضل. ولم تغفل الجامعات عن استخدام تقنيات تحليل البيانات لتحليل اداء الطلاب وتقديم توصيات لتحسين التعليم والتعلم، فيما يركز نهج التعليم الشامل للمهارات (WIL) على تطبيق المعرفة الاكاديمية في سياقات عملية، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية والمهنية.
التصنيفات العالمية للجامعات:
في عام 2024، شهدت الساحة الاكاديمية تراجعا ملحوظا في اهتمام الجامعات بالتصنيفات العالمية، وهو توجه متزايد نابع من الاعتراف بان هذه التصنيفات قد لا تعكس بالضرورة جودة التعليم والتعلم الفعلي داخل المؤسسات. فبينما تستمر الجامعات الرائدة في استخدام هذه التصنيفات كوسيلة لجذب الطلاب وتحسين سمعتها الاكاديمية، تبتعد العديد من المؤسسات الاخرى عنها لاسباب متعددة، من اهمها التركيز الكبير على معايير قد لا تكون دائما ذات صلة بجودة التعليم، واعتمادها الزائد على المعايير الكمية والبيانات التي قد لا تكون شاملة او دقيقة بشكل كاف واحيانا كاذبة، مما قد يؤدي الى تاثيرات سلبية على عملية تطوير التعليم وتحسين الجودة. هذا التاثير السلبي بدا اكثر وضوحا في الدول النامية، حيث تركز الجامعات احيانا على تحسين مراكزها في التصنيفات بدلا من التركيز على جوهر تحسين جودة التعليم والتعلم.
تعكس التصنيفات الدولية في الغالب منظورا غربيا للتعليم، حيث تعطى الاولوية لمعايير كالبحث العلمي المنشور في مجلات غربية والتعاون مع مؤسسات غربية، مما يهمش مساهمات الجامعات التي تخدم مجتمعاتها المحلية او تجري ابحاثا ذات صلة بتحديات اقليمية. هذا يشجع على تبني نموذج غربي قد لا يتناسب مع السياق المحلي. كما تشجع هذه التصنيفات على التنافسية السلبية بدلا من التعاون، حيث يسعى كل منها لتحقيق مراكز متقدمة بغض النظر عن جودة التعليم، مما قد يدفع الجامعات الى اتخاذ اجراءات شكلية كزيادة المنشورات (بغض النظر عن جودتها) او التركيز على جذب الطلاب مهما كانت مستوياتهم. تركز التصنيفات ايضا على المعايير الكمية كعدد الطلاب والميزانية، مهمشة الجوانب النوعية كجودة التدريس وتفاعل الطلاب. يضاف الى ذلك التكلفة العالية للاشتراك فيها، وعدد الجامعات المشاركة المحدود (حوالي 2000 من اصل 24000)، مما يقلل من مصداقيتها. باختصار، يعكس تراجع الاهتمام بالتصنيفات رغبة في اعادة التفكير في مفهوم جودة التعليم ووضع معايير اكثر شمولية تراعي السياقات المحلية وتشجع التعاون.
بشكل عام، يمكن القول ان عام 2024 يشهد تطورات ايجابية في مجال الجامعات والتعليم العالي على مستوى العالم، مع التركيز على تحسين الجودة وتطوير المناهج ودعم البحث العلمي والابتكار وتلبية احتياجات سوق العمل. هذه التطورات تشمل تحولات جذرية في المناهج الدراسية نحو التركيز على المهارات العملية والتخصصات المتداخلة، واهتمام متزايد بالبحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع وريادة الاعمال القائمة على المعرفة، وجهود مستمرة لتحسين جودة التعليم عبر تطوير البنية التحتية والابتكارات التربوية. ان مواكبة هذه التطورات والاستفادة منها يتطلب من المؤسسات التعليمية في العالم العربي، وخاصة في العراق، وضع استراتيجيات فعالة تهدف الى بناء انظمة تعليمية عالية الجودة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
***
ا. د. محمد الربيعي
بروفسور متمرس ومستشار علمي