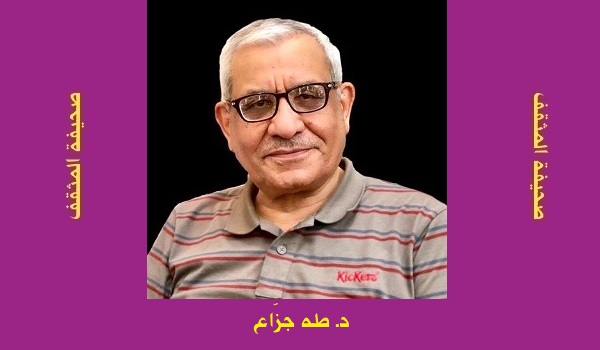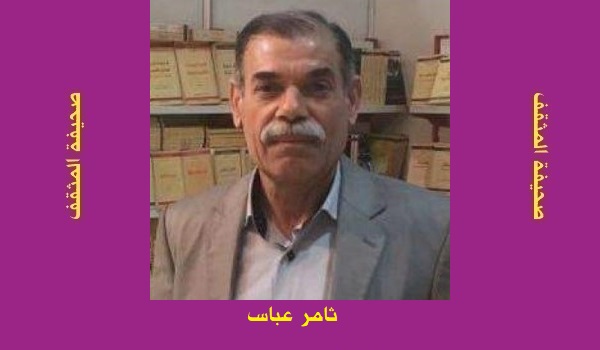أن تدخل عالم جواد سليم من بابه السيكولوجي فهذا يعني فتح باب جديد في تاريخ حياة هذا الفنان الخالد، ويعني ايضا ان القائم بهذا العمل يتحمل مسؤولية علمية وادبية قد لا تسعفه مصادر وادوات بحثه في التوصل الى الصدق في الاستنتاج. ذلك ان موضوعي "الابداع في الفن" و "الشخصية" من المواضيع المعقدة في علم النفس، لعدم وجود منهج سيكولوجي في دراسة الاعمال الفنية وتحليل شخصيات مبدعيها. وحتى "فرويد" في دراسته المعروفة "دافنشي".. اعترف بأن منهجه الذي استخدمه لا يكفي لتحليل شخصية دافنشي.
القسم الأول: مؤشرات عن شخصية جواد
1. طفولة هادئة وميل مبكر للرسم
لعلماء النفس موقفان في تقيمهم لمرحلة الطفولة،
الأول: يتمثل بما يراه الفرويديون من ان السنوات الخمس او السبع الاولى للطفولة هي الأساس في تشكيل شخصية الانسان، وهي التي تقرر سلوك الفرد حين يصبح راشدا.. بمعنى ان سلوك الراشد يكون محددا سلفا بطبيعة مرحلة الطفولة.
والثاني: يختلف معهم في ان الطفولة ليست العامل الوحيد في تشكيل الشخصية، وينطلقون من مسلمة تقول.. ما دامت المتغيرات الاجتماعية في حالة تفاعل مستمر فأن الشخصية تتغير تبعا لذلك.
ويرى بعض الذين قاموا بدراسات نفسية للمبدعين من الفنانيين أن سبب ابداعهم يعود الى ان قسما كبيرا منهم عاشوا طفولة قاسية اوقضت فيهم الابداع عند الذين يحملون استعدادا ابداعيا. فعلى سبيل المثال يعزى فشل " دافنشي" في تكوين علاقات عاطفية ناضجة وانشغاله بتصوير رؤوس نساء باسمات الى انه كان اسير ابتسامة أمه وانوثتها التي انفصل عنها في سن مبكرة.
غير ان الأمر مختلف مع جواد، فهو عاش طفولة هانئة وسعيدة، في بيت توافرت به وسائل الراحة والعلاقات الطيبة. ولعل الاسباب الرئيسة في ابداعه الفني هو انه نشأ في عائلة تهوى الفن والرسم. وهو بذلك قد يشبه "باخ" الذي ولد في عائلة تعشق الموسيقى فتأثر بذلك واصبح موسيقارا.
فالوالد "سليم علي عبد القادر الخالدي الموصلي" تميز بقدرته على الرسم. ورغم ان انتاجه الفني كان قليلا، فأن بعضهم يرى في لوحاته مصدرا لمن يريد تسجيل تاريخ الفن العراقي اوائل عشرينيات القرن الماضي.
و"سعاد" شقيقه الأكبر، هو الاخر فنان أسهم مع ابيه ومعهما جواد بتأسيس اول جمعية فنية في العراق هي "جمعية اصدقاء الفن" عام 1941. اما شقيقه الأخر "نزار" وشقيقته "نزيهة" فكلاهما اصبح رساما معروفا. كذلك كانت والدته هي الأخرى تهتم بزخرفة اشغالها اليدوية، وتشجع ابنها جواد منذ كان عمره اربع سنوات بصنع الدمى من الطين والشمع ليستمتع ويلعب بها، واللعب يفيد، سيكولوجيا، في التدرّب على المهارات الجديدة.
هذا يعني وجود اكثر من نموذج في عائلته، يوحدّها ميل مشترك نحو الفنون التشكيلية، فتأصل هذا الميل بفعل تشجيع افراد عائلته له وظهر لديه مبكرا. اذ يذكر احد اصدقائه انه كان وجواد في الصف السادس الابتدائي قد شاركا بأول معرض شامل للفنانين العراقيين وحصل جواد على الجائزة الثانية. واستمر هذا الميل بالنمو والممارسة حين دخل المتوسطة الغربية التي كانت جدرانها عامرة بلوحاته مما شجع مديرها منح جواد واصدقائه مرسما مزودا بأدوات الرسم على نفقة الدولة.
ولقد تابع جواد رعاية ميله الفني فسافر الى باريس لدراسة الرسم وعمره (19) سنة ثم الى روما وعمره (20) سنة لدراسة فن النحت ثم حصل من معهد "السليد " بانكلترا على دبلوم شرف في الرسم والنحت ليستقر بعدها في وطنة العراق.
2. التفاؤل وحب الحياة
لعل اهم صفة تمتاز بها شخصية جواد هي حبه العميق للحياة وايمانه القوي بالمستقبل. ففي مذكراته بتاريخ (16/11/1944) زمن الحرب العالمية الثانية، كتب يقول:(انني من الذين يؤمنون بالمستقبل. انني اثق بالغد وأؤمن بفوز الحق والافضل. وفي السنة نفسها يكتب جواد بمذكراته قولا لمايكل انجلو (الفن والموت لا ينسجمان). ويعكس تفاءله هذا على وطنه وفنه فيقول: (وللعراق مستقبل باهر في النحت لافتقار متاحفنا ومياديننا وبيوتنا الى انتاج النحات. وكما كانت في اوربا حركة واسعة بعد الحرب العظمى لاقامة النصب التذكارية واشتراك النحات والمعمار في عمل دنيا جميلة، فأن انتهاء هذه الحرب سيفتح بابا اوسع لاشتراك الفنان في بناء دنيا جديدة مفرحة وصالحة).
جواد سليم بين (الأنا) و(النحن)
يمتاز معظم الكتّاب والفنانيين المبدعين بتضخّم (الأنا) كونهم يعيشون حالة غير اعتيادية من القلق والحساسية. ويسعى الفنان بشكل أخص الى ان يكون اكثر اكتمالا مما يريد، لكنه يعيش في وضع محدد بزمان ومكان وبعلاقات اجتماعية تشكل بمجموعها ملتقى لكل التناقضات. فهناك اهداف عامة (اجتماعية) واهداف خاصة (فردية).. والتناقض بين العام والخاص تناقض أزلي، والصراع بين الخاص (الأنا) والجماعة (النحن) يخلق عند الفنان حالة عنيفة من القلق والتوتر.
ورغم تنوع طرق خفض التوتر هذا، فان هناك نوعان متميزان منها،
الأول: منح الأنا امتيازا منفردا كما هي الحال عند المتنبي الذي يقول:
(أمط عنك تشبيهي بما وكأنه
فما أحد فوقي ولا احد قبلي)
وقد يولد تضخّم الانا حالة انقطاع عن المجتمع ورفض لكل مفهومة تتعلق بالنحن:اخلاق، قيم، تقاليد، التزامات.. كما هو الحال مع (اوسكار وايلد ونيتشه وفان كوخ وشيللي) التي غالبا ما تنتهي الى تدمير نفسي للأنا (جنونا في الغالب) او تدميرا جسديا.. الانتحار.
والاسلوب الثاني، هو ان يجعل الفنان من (الأنا) استقطابا لقلق مجتمعه وقلق الانسانية المتفاعل مع قلقه الخاص فيبحث عن خلاص (للانا) و (النحن) من خلال معاناة مشتركة وبهدف متعة مشتركة.
وجواد هو من الفنانين المتميزين الذي توحدت عنده (الأنا) مع (النحن). وادرك بأنه لا يستطيع ان يكون كذلك الا اذا غار في (النحن) التاريخية وحصل على تجارب الاخرين.
يقول جواد: (ليس الفن بالشىء الذي يحتاج الى فنان فقط. الفن هو العيش في بقعة ما. انه شىء يحدث بين انسان وما بين الأرض التي يعيش عليها وهو بحاجة الى فهم. وان يفهم شعب جديد وارض جديدة كلاهما الاخر.. يستغرق زمنا طويلا).
وقال في كلمته بمناسبة افتتاح المعرض الأول لجماعة بغداد للفن الحديث.. (انا والكاتب نريد ان نشارك كل البشرية ما نريد ان نقوله). ويضيف.. (ليس الفن في عمل صورة للويس الرابع عشر، او تمجيد سيف الدولة، او رسم تفاحة. الفن اسمى من ذلك، الفن قطعة لموزارت، صفحة من موليير، قصيدة من المعري او من الجواهري، لوحة كورنيكا.. فهذه اشياء خدمة البشرية.
ولهذا اطّلع جواد على الفن السومري والآشوري والأسلامي والاوربي، لا بهدف خدمة صنعته وتطوير فنه وحسب، وانما بحثا عن الذوات المتحدة للجماعات. وكان استيعابه الواعي للتراث قد شكّل احد اسباب توحّد (اناه) في (النحن).. الأمّة والأنسانية، وأحد الاسباب الجوهرية في ابداعه الفني الذي انطلق من المحلية الى العالمية.
القسم الثاني: المرأة في حياة واعمال جواد
الفن نشاط انساني وشكل من اشكال الوعي الاجتماعي.. ما يعني ان الانتاج الفني الذي ابدعه جواد هو انعكاس لواقع اجتماعي كان قد عاشه مرحلة الأربعينيات والخمسينيات، وتجسيد لواقع المرأة فيه.
ونشير الى ان السمة المميزة للمجتمع العراقي بتلك الفترة هي التخلف، وهذا يعني ان المرأة في المجتمع المتخلف، أّمّا كانت ام زوجة ام حبيبة، هي اكثر افراده معاناة وقهرا واستلابا، واكثر عناصره تعرّضا للتبخيس في وجودها.. فحيثما وجد القهر والأستلاب والتبخيس والأضطهاد، يكون نصيب المرأة منها حصة الاسد!
والمرأة بالنسبة للفنان التشكيلي، هي اكثر المفردات استيعابا للرموز. فهي: الكون، الأرض، الخصب، الخلود، الغذاء. وهي:الجمال، النبع، الحرية، السلام.. والحاجات النفسية التي تجلب المسرّة والمتعة. وقد تمثل المرأة رموزا مناقضة تستقطبها مقولة: المرأة هي الشرّ الذي لا بد منه.
ان تحليلنا لاعمال جواد المتعلقة بالمرأة، يقودنا الى تأشير ثلاثة نماذج اساسية هي:المرأة الأم، المرأة المضطهدة، والمرأة في التجربة الذاتية لجواد.
1. المرأة الأم
يميل جواد الى ان يرسم وينحت الأم بشكل دائري او هلالي فيه انحناءه وانكسار واحتضان كما في تمثال الأم في منحوتة الشهيد (نصب الحرية) و (الأم في الزخارف الهلالية).
في منحوتته (الأم).. اروع تمثال نحته جواد للمرأة، جسّد فيه ان روعة الأم لا تكمن في حنانها وعاطفتها ودفئها وقدسيتها فقط بل وان يتجسّد فيها ايضا اروع جمال للانثى. وفيها علّق جواد هوية الأم بيدها اليمنى.. يتدلى منها خيط يحمل شكلا بيضويا هو رمز الطفولة. ومدّ في يدي الأم باستقامة تتناغم مع استقامة جسمها، وجعل منها شيئا يشبه الاشجار ليمنح المشاهد جوا نفسيا عطرا وتصويرا جميلا وكأن الطفولة عصفور ينعم في بستان!
2. المرأة المضطهدة
عاش جواد في فترة تاريخية كان فيه الاقطاعيون والبرجوازيون يملكون كل شيء، فيما تعيش الجماهير المسحوقة حالة من التأخر والجهل والحرمان والقهر. ولأن المراة، في مجتمع كهذا، تتجسّد فيها كل انواع الأستلابات والعذابات، فانها تثير في المتلقي عواطف الشفقه والعزاء.. عزاء المرأة في نفسها، وعزاء الرجل المسحوق المتجسّد في المرأة الأكثر انسحاقا.
وتمثل (نساء في الانتظار) نساءا في المبغى ايام كانت بغداد قبل اسقاط النظام الملكي (1958) اماكن معروفة، تعرض فيها النساء اجسادهن لمستلبيها الذين اختزلوا المرأة الى جسد، والجسد الى وعاء للجنس.
3. المرأة.. في التجربة الذاتية لجواد
هناك لوحتان من أجمل لوحات جواد المتعلقة بالمرأة، هما (القيلوله والسيدة وابن البستاني). ويبدو أن لهما علاقة بتجربة ذاتية تدور حول قصة حب كان قد عاشها جواد أيام شبابه، وكتب عنها في مذكراته التي دونها بين عامي (1941 و1946)، وكان عمره حينذاك (22 الى 26) سنة. وتفيد مذكراته بأن جواد كانت له علاقة حب بفتاة عراقية ارستقراطية، واخرى بامرأة بولونية لجأت مع بولونيين الى العراق خلال الحرب العالمية الثانية.
ان استقراء مذكراته يقود الى ان الموضوع الذي يستقطب اهتمام جواد في المرأة هو (الجسد) ولكن ليس في المضمون الذي تجسده قرويتان، وهو عمل نحاسي مطروق يمثل قرويتين تحملان سلتين وقد صيغ جسد المرأة القروية على شكل دلّة عربية تعبيرا عن ذوق العربي في الجسد المكتنز للمرأة ، واشارة لهويته التي كان يفاخر بها كونه صاحب الدلات والزوجات الكثيرات.
يصف جواد فتاته الارستقراطية هكذا:
(ذهبت لترتدي ثوبا جديدا، وعندما دخلت.. كدت انصعق، فلقد ظهرت فيه بصورة من أفضع الصور الجمالية والفتنة. وفي تلك اللحظة، كدت اذوب، كدت ابكي.. ان هذه القطعة من القماش الالهية الرائعة التي فصلتها ايادي الجنة.. كانت على بدنها العاري تماما).
وبعد ان قطعت فتاته الارستقراطيه صلتها به وأقام علاقة جديدة بالجديدة البولونية.. فانه كتب عنها الكثير بمذكراته (تأملات روحي) يصف مفاتن جسدها ايضا، نقتطف عبارة واحدة:
(كان ثدياها بارزين بشكل مثير، وقدماها حافيتين، ورأيت لأول مرّة ساقيها وكانتا عاريتين.. لقد كان لونهما جذابا ومهيجا.. .) نفس المفردات لنفس الموضوع.
صحيح ان جواد كان يومها شابا عشرينيا، لكن جمال ما يصفه من مشاعر، تعداه من التعبير بالكلام الى التعبير بالرسم. فلقد ظهر ذلك الثوب الشفّاف على جسد حبيبته الأرستقراطية بحالة من الاغراء في لوحته (القيلولة). والجميل ايضا.. انه رسم قطة بعينين مفتوحتين على سعتيهما قرب قدميها، قد تكون رمزا الى أن المرأة هي كالقطة.. أليفة.. لكنها نفورة في الوقت نفسه.
القيلولة
أما (السيدة وابن البستاني) فهي الأخرى تعبير عن الكبت الجنسي. السيدة على ارجوحتها ومستسلمة.. وابن البستاني يمسك بيده خرطوم ماء.. يمر بالسيدة ويلتف، وقد يشير الى رمز جنسي. والجو صيف.. وقد يرمز للعطش الجنسي، والديكور الأعلى للأرجوحة التي تنام عليها السيدة، رسم بشكل سياج مدبب مقلوب باتجاه السيدة.. يرمز الى القيود الأجتماعية.
السيدة وابن البستاني
واللوحة هي في موضوعها.. تحليل طريف لعلاقة انسانية بين رجل وأمرأة، كلاهما يشتهي الآخر، وما بينهما المجتمع بكل قيوده، صيغت بفكاهة تثير ابتسامة خفيفة.. لكنها غاية في التأثير.
المؤسف، ان جواد رحل مبكرا بعمر 42 سنة في(23 كانون الثاني 1961) بسبب نوبة قلبية ولم يفرح برؤية افتتاح نصبه في (16 تموز 1961).. نصب التحرير الذي خلده في قلب بغداد وقلوب العراقيين.
***
أ.د. قاسم حسين صالح
مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية