قضايا
صادق السامرائي: الموت والموت العقلي!!
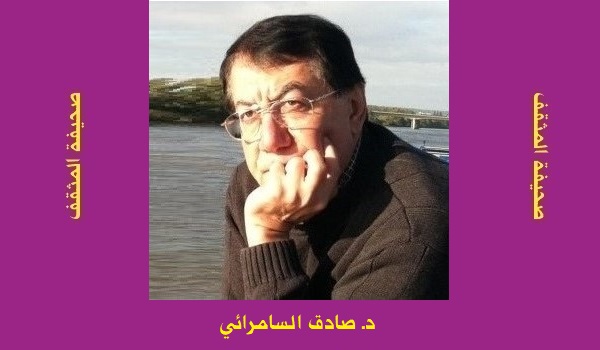
الموت حق والحقيقة اليقينية الواضحة التي لا يختلف عليها إثنان، فكل موجود يسير على سكة الرحيل، وتنتظره محطته الموعودة التي عليه أن يترجل فيها من قاطرة الحياة. "وما تدري نفس بأي أرضٍ تموت"!!. وتلك هي قصة التفاعل ما بين الولادة الضاجة بالصراخ، والنهاية المحفوفة بالصمت والرهبة والإندهاش. و"إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون"!!. والوهم في العيش كأننا لا نغادر الدنيا، كالعيش وكأننا سنموت غدا أو بعد سويعات، يترجم القول:
"إحرص على الموت توهب لم الحياة"!!
وهذه إقترابات تأملية في الموت، و"رب موتٍ كالحياة"!!
أولا: الغاطسون في الماضي ميتون!!
الماضي ليس للغطس وإنما للعوم، والسباحة الرشيقة للوصول إلى الضفة الأخرى، والإنطلاق بالبناء والتفاعل مع معطيات المكان الجديد.
وما يسود في المواقع ووسائل التواصل المتنوعة، الحديث عن الماضي وإعتباره الأجمل، وتشتاق إليه الأجيال المرهونة بالويلات والتداعيات، والإندحارات والحرمان من أبسط الحاجات.
وهذه شهادة مرعبة على أن المجتمع يتقهقر والحاضر يتدهور، والمستقبل يتدمر، فلا يوجد مجتمع يتخندق بماضيه ويستكين فيه، بل مجتمعات الدنيا متوثبة نحو غدها الذي تتطلع إليه، وفي وعيها ما فات مات، وعليها بما هو آت.
القول بأن الماضي هو الأفضل يتسبب بإنهيارات نفسية وإحباطات سلوكية، ويعزز القنوط والتشاؤم واليأس، وفقدان الإحساس بقيمة الحياة.
ومجتمعاتنا جائعة لثقافة التفاؤل والإقدام، وتحسس طعم الحياة وتذوقها بسعادة وبهجة وأمان، وأقلامنا كأنها لاتستشعر معاناة الناس ولا تقترب منهم، فتكتب ما يضرهم، ولا تجتهد بتقديم ما ينفعهم، ويبني إرادتهم وثقتهم بأنفسهم.
فالكلمة من أخطر الأسلحة القادرة على تحقيق الهزيمة النفسية في دنيا الشعوب، وتحويلها إلى أهداف سهلة متذمرة من أوطانها وناقمة على وجودها فيها، وتأمل في الهروب والتوطن في غيرها من البلدان، رغم توفر الخيرات والفرص والطاقات والتطلعات الكبيرة.
ويبدو أن العديد من القوى المعادية لوجود الأمة تسعى بإصرار لترسيخ المفاهيم السلبية، وتحويل الأجيال إلى ركام مبرقع بالتبعية والخنوع، والركون لصوت السمع والطاعة، لتتحقق البرامج المرسومة والأهداف الخفية والعلنية بسهولة.
فالمطلوب من الأقلام أن تتناول الحاضر والمستقبل، وتتدارس التحديات والمستجدات، وتستحضر الطاقات للتفاعل الإيجابي معها، للوصول إلى ما يصلح لوجود الأمة وعزتها وكرامتها.
فهل سترعوي الأقلام؟!!
ثانيا: نُذِلُ أحياءَنا ونُجِلُ أمواتنا!!
ظاهرة لا مثيل لها في دول الأمة الأخرى، وتتكرر عبر الأجيال.
فلو نظرنا لِما حصل في القرن العشرين للأشخاص الذين برزوا بميادين الحياة المتنوعة، لتبين أنهم تعرضوا للتصديات والمعوقات والعدوان على ما يمت بصلة إليهم.
ولو تابعنا مسيراتهم، فسنجد معظمهم غادروا الوطن، وإنتهوا في بلاد الآخرين، وما ظفروا بإعتبار أو قيمة في وطنهم وهم أحياء.
وحالما يُعلن نبأ وفاتهم، تستيقظ الغيرة والحماسة، بإدعاء محاسنهم وأنهم أبناء الوطن، وما منهم مَن تم تكريمه وهو حي إلا فيما ندر.
مات فلان وإذا به يبدو وكأنه لا يتكرر ولا كمثله في الدنيا، وتبدأ أحاديث النفاق والرياء والتفاعل المريب معه، والبعض يستغله لتمرير أجندات معينة.
لو سألت عن أي مبدع وذي عقل فاعل في البلاد ستجده ذليلا، إن لم يكن صاحبا للكرسي!!
الكراسي لها دورها في الموضوع، لأنها تمضي على سكة أما أن تكون معي أو أنت عدوي، فيكون المبدع الحر عدوا ولا بد من محاربته وحرمانه وتمريغ رأسه بالذل والهوان، وعندما يموت يكون قد رحل وحان وقت التفاعل بوجه آخر معه.
في حياته عدوّي وعند مماته صديقي العزيز، وتلك لعبة غبية تسمى سياسة، وما هي كذلك؟
وعندما تسأل عن الشعب، فهو بلا قدرة على النعبير عن رأيه، ويتعبّد في محاريب الكراسي، فالشعوب مطية حكامها، شئنا أم أبينا.
والقضية الأخرى الفاعلة في الحالة، نشاطات لاواعية في أعماق الناس تأخذها إلى فضاءات التفديس والتنزيه للأموات، وكلما إبتعدوا في زمانهم تراكمت التوصيفات التقديسية المغالية حولهم، حتى تجد القرون المتوالية تلقي بأحمالها عليهم، فتخرجهم من بشريتهم، وترفعهم فوق العرش درجات، وبتكرار التداعيات المتصلة ببعضها، تجدنا أمام أهوال توصيفات، تمحق العقل، وتتجذر في النفوس والأعماق المتأججة بعواطف ملتهبة ذات إقترانية عالية.
وهكذا يعاني الأحياء المبدعون، وكأن تأنيب الضمير يأخذنا إلى عوالم التكفير عن سيئاتنا بتقديسهم الوهمي الفتاك.
فهل من موضوعية وعقل قويم؟!!
ثالثا: أفكارنا ميتة!!
الأفكار الميتة تحقق وجودا ميتا!!
تلك حقيقة حضارية وحكمة تأريخية، فلكي تكون المجتمعات حية عليها أن تستحضر أفكارا ذات حياة.
فالأفكار الميتة تمتلك طاقات سلبية هائلة ومتنامية، تسعى لتوفير الأسباب اللازمة لصناعة الموت وما ينجم عنه من تداعيات وتفاعلات ذات إتجاهات قتّالة.
والمجتمعات المتأخرة تزخر بالأفكار الميتة، مما يؤدي إلى إشاعة الكآبة واليأس والبؤس وفقدان الثقة بالذات والموضوع، ويمنع عنها قدرات العطاء والنماء ويعتقلها في حفر التلاحي والخسران.
الأفكار الميتة هي التي عفى عليها الزمن وأصبحت في عداد "ما فات مات"، فكل فكرة قادمة من نبش تراب الأزمان، رفاة لأموات لا قيمة لها في حاضر الحياة.
رابعا: أمواتنا أحياء وأحياؤنا أموات!!
ظاهرة غريبة فاعلة في واقع الأمة وتنخر وجودها عبر العصور، فترى الأجيال تضفي هالة القدسية والمجد الأعظم على أمواتها، وتستحضرهم لقيادة الحياة، والتعبير عن أفكارهم المقبورة معهم.
فتراها منهمكة في نبش الأجداث، والتغني بقيادة الأموات لأيامها، فهم الأقدر والأقوى والذين لا مثيل لهم في الحاضر والمستقبل وعليهم تسنم القيادة وتقرير مصير الأيام.
وبموجب ذلك، تجد أحياء الأمة وقادتها في صراعات مريرة، وأكثر عقولها المستنيرة هاربة أو مصابة بالتعطيل والتعويق، ووضع المصدات أمامها، والتنكيل بها ومحق وجودها وإلغاء دورها، وتنطلق نشاطات التغني بالأموات، وتخليد ذكراهم، وإخراجهم من طورهم الآدمي وتحويلهم إلى مخلوقات خيالية فادحة التأثير.
وهذا سلوك تحققت تنميته في القرن العشرين وتواصل تعزيزه على مر العقود، حتى ألفيتنا في رحاب الأموات الذين أيقظناهم من رميم القرون السالبات، فلا هم عندنا سوى الحديث عن الذي مضى وما إنقضى، وعن الرموز الآدمية الآسنة في وعينا الجمعي، والتي نحسبها لا تمت إلى البشرية بصلة، وإنما مخلوقات فنتازية وردت إلى الدنيا وأنجزت الملاحم الخارقة، وعلينا أن نستلهمها ونتغنى بها، ونموت في سبيلها، ولو إستيقظوا لإستخفوا بعقولنا، ولخجلوا من أحوالنا.
فنحن بسلوكنا نذلهم، ونستهين بهم، ولا نتعلم منهم ما يعيننا على صناعة حاضر مقتدر ومستقبل مزدهر، بل نتسبث بالرميم، ونحسب التقهقر سيخمد سعير الجحيم الذي تورطت فيه أمة ذات أدوات إحباطية وتيئيسية وتخاذلية فائقة التأثير والتمرير.
لو تصفحت المنصات الإعلامية، الورقية والإليكترونية، لتبين أن الأموات قادتنا، والأحياء أعداؤنا، وكأننا الأموات وهم الأحياء الفاعلون في صناعة وجودنا.
فتمجيد الأموات مذهبنا، ومناهضة الحياة منهجنا.
وما صح فينا القول: " إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وإعمل لآخرتك كأنك تموت غدا"!!
فجحود حق الحياة قانوننا، المشرعن بفتاوى مؤدينة!!
خامسا: موت قبل موت!!
يبدو أن الموت يتحقق نفسيا أولا وبدنيا ثانيا، فلا بد من الموت النفسي المسبق لكي يتحقق الموت البدني، فحالما يموت المخلوق نفسيا، فأن موته الجسمي سيكون حتميا، حتى ولو كان في تمام صحته وعافيته البدنية.
والذين ينتحرون يموتون نفسيا أولا، ويعبّرون عن هذا الموت بالإنقضاض على وجودهم المادي.
ويمكن تقدير مدى إقتراب الشخص من الإنتحار من معرفة نسبة موته النفسي.
ومن علامات الموت النفسي أن البشر يكون خاليا من نسغ الحياة وطعمها وقيمتها ومعانيها، وكأنه أفرغ شحناتها في التراب، وأصبح موجودا ماديا خاويا.
فالحياة طاقة تسري في البدن، وإذا فقدها البشر سيكون ميتا نفسيا، وعازما على إنهاء وجوده البدني.
ويمكن إشاعة الموت النفسي بالمواعظ الموتية المتكررة، وبالمواقف المقرونة بآليات عاطفية إنفعالية عدوانية، تدفع لتفريغه من طاقة النفس، وتحيله أحطابا يابسة جاهزة للتحول إلى رماد.
وتلعب الطائفية والمذهبية وتوظيف الدين دورها في إنجاز الموت النفسي، ودفع البشر للإنتحار الفردي والجماعي بسهولة وإندفاعية خارقة.
ولهذا تجد رخص البشر في المجتمعات المرهونة بالتفاعلات الفئوية، لأن قادتها يعملون بتكرار ومواظبة وبإستحضارات إنفعالية وعاطفية سيئة، تقتل البشر نفسيا وتدمره روحيا، وتحوّله إلى أداة لتمرير رغباتهم وأهدافهم الشنعاء.
ومن هنا فأن الإنتحار كسلوك سيتعاظم في هذه المجتمعات، والسلوكيات المنحرفة ستتنامى، والميل للمخدرات وغيرها من المروعات سيتفاقم.
لأن الميت نفسيا لا يشعر، ويميل للإقتراب مما يدمره ويقضي عليه، فقد يلجأ إلى الإنتحار الفعلي الصاخب، أو السلبي الخنوعي، كالقتل البطيئ للبدن، لأن الموت النفسي ينفي وجوده ويحسبه عالة، ومأساة يجب أن تصل إلى خاتمتها الترابية.
فهل من قدرة على إحياء النفوس لا تمويتها؟!!
وفي الختام، فالموت ظاهرة طبيعية، لكن الموت العقلي اخطر منه وأشد تدميرا لمعاني الحياة، فالموت سنة الحياة، والموت العقلي عدوها، فعلينا أن نتنبه لميتتنا العقلية.
***
د-صادق السامرائي







