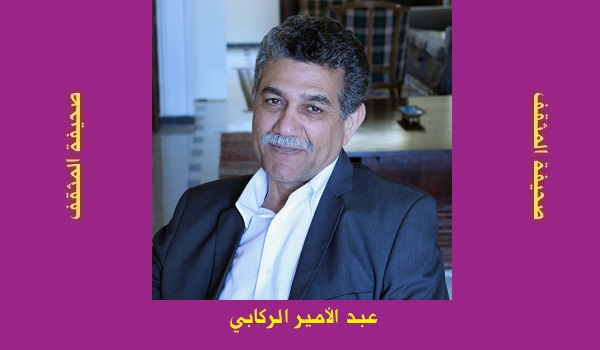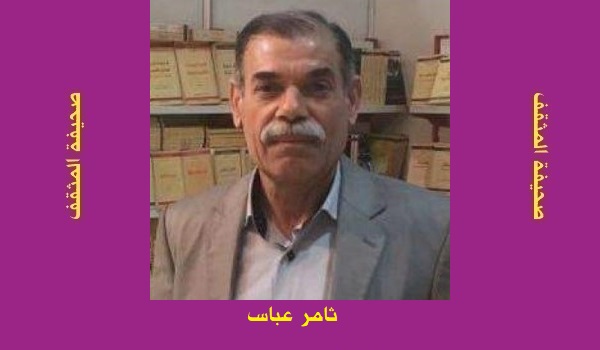المقدمة: يُعدّ الذكاء الاصطناعي من أحد أبرز ابتكارات الثورة الرقمية الحديثة، حيث وفر إمكانيات هائلة لتعزيز الإنتاجية، وتطوير العلوم والخدمات العامة، والمساهمة في حل العديد من التحديات التي تواجه البشرية. وقد أحدث تحولات جوهرية في مختلف المجالات، مما جعله ركيزة أساسية في تطور المجتمعات الحديثة.
الذكاء الاصطناعي هو فرع متقدم من علوم تقنية المعلومات، يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري من خلال الحوسبة الفائقة والبرمجيات الذكية. يعتمد على خوارزميات متقدمة وتقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق لتحليل البيانات، والتعرف على الأنماط، واتخاذ القرارات بشكل مستقل أو شبه مستقل وفقًا للمدخلات والمعطيات المدخلة إليه.
كما يقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة وإعادة تدوير البيانات الضخمة التي ينتجها المستخدمون والمستخدمات، مما يمنحه قدرة متزايدة على التكيف والتطوير الذاتي. تُستخدم هذه التكنولوجيا اليوم في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الطب والرعاية الصحية، حيث تساهم في تشخيص الأمراض وتحليل البيانات الطبية، والتعليم من خلال تطوير أنظمة تعليمية تفاعلية، والصناعة، والاقتصاد، والإعلام، والنقل، والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استخدامها في المجالات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك الرقابة والسيطرة الفكرية والسياسية وتطوير الأسلحة.
عند الحديث عن أنواع الذكاء الاصطناعي، يمكن التمييز بين عدة مستويات من التطور، وذلك حسب طبيعة المقارنة. النوع الأكثر شيوعًا اليوم، مقارنة بالذكاء البشري، هو الذكاء الاصطناعي الضيق، والذي يُستخدم لأداء مهام محددة مثل الترجمة الفورية، التعرف على الصور، أو تشغيل المساعدات الصوتية، او التدقيق اللغوي وتوليد النصوص وغيرها. هذا النوع يعتمد على بيانات محددة ويعمل ضمن نطاق معين دون القدرة على تجاوزه.
أما الذكاء الاصطناعي العام، فهو مفهوم أكثر تطورًا ويهدف إلى إنشاء أنظمة قادرة على التفكير وحل المشكلات في مجالات متعددة بنفس الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري. أما الذكاء الاصطناعي الفائق، فهو مستوى نظري مستقبلي يُتوقع أن يتجاوز قدرات الإنسان في التحليل والإبداع واتخاذ القرار، لكنه حتى الآن لا يزال ضمن نطاق الخيال العلمي والدراسات الافتراضية، أو لم يُعلن عنه بعد، وذلك كما هو الحال مع العديد من التطورات التكنولوجية التي عادةً ما تطور وتُستخدم سرًا في الأغراض العسكرية والأمنية قبل أن تصبح متاحة للجمهور. فالتاريخ يشهد أن الإنترنت والعديد من التقنيات المتقدمة الأخرى لم تُكشف للعامة إلا بعد سنوات من استخدامها في الأوساط العسكرية والاستخباراتية والصناعية المغلقة.
هذه التقنية لا تعمل في فراغ، وانما تتأثر بتوجهات الشركات والحكومات التي تطورها، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعتها الحقيقية والجهات المستفيدة منها. واستنادًا إلى ذلك، فإن هذه التكنولوجيا لا تتطور بشكل محايد، وتعكس البنية الطبقية للنظام الذي أنتجها. فالذكاء الاصطناعي، كما هو مطور اليوم، ليس كيانًا مستقلاً أو محايدًا، وانما يخضع بشكل مباشر لهيمنة القوى الرأسمالية، التي توجهه بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية.
وكما أشار كارل ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي:
"لم تترك البرجوازية أي رابطة بين الإنسان وأخيه الإنسان إلا رابطة المصلحة العارية، والتعامل النقدي القاسي... لقد جعلت الكرامة الشخصية قيمة تبادلية، وحوّلت كل شيء، بما في ذلك المعرفة، إلى مجرد أداة للربح."
وهذا ينطبق تمامًا على الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم من دوره وأهميته الكبيرة، فقد تم تسليعه الآن ليكون أداة لتعظيم الأرباح وتقوية السيطرة الطبقية. إن التطوير الحالي للذكاء الاصطناعي لا يمكن فهمه باعتباره مجرد تقدم تقني، بل هو جزء من منظومة السيطرة الطبقية التي تسعى من خلالها الشركات الكبرى والدول الرأسمالية إلى تعزيز الأرباح، وتركيز الثروة، وإعادة إنتاج علاقات الإنتاج القائمة.
فالخوارزميات التي تدير هذه الأنظمة موجهة أيديولوجيًا لخدمة مصمميها، حيث تُسخَّر لتعظيم الإنتاجية، وتعزيز تفوق الشركات الاحتكارية، وترسيخ القيم الرأسمالية. وهكذا، تتحول هذه التقنيات إلى أدوات جديدة لاستغلال القوى العاملة وإدامة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بدلًا من أن تكون وسيلة لتحرير الإنسان من شروط الاستغلال.
لقد بات الذكاء الاصطناعي سلاحًا مركزيًا في يد رأس المال، حيث يُستخدم لتقليص الحاجة إلى العمالة البشرية، مما يؤدي إلى تفاقم البطالة أو دفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر إلى قطاعات أخرى، وتعميق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن احتكار هذه التقنيات يمنح الشركات الكبرى قدرة غير مسبوقة على التحكم في الأسواق، وإعادة تشكيل الرأي والوعي العام، وفرض رقابة رقمية شاملة على الأفراد والمجتمعات، مما يكرّس نظامًا تصبح فيه الجماهير إلى حدّ كبير، إما مستغلة كبيانات ويد عاملة رخيصة، أو مُهمشة بفعل الأتمتة.
وإذا استمرت هيمنة النظام الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، فإن النتيجة من الممكن أن تكون مجتمعًا شديد الاستقطاب والتفاوت، حيث تملك الطغم التكنولوجية الرأسمالية القوة الشبه المطلقة، بينما يُدفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر نحو مزيد من التهميش والإقصاء.
الرؤية الرأسمالية للذكاء الاصطناعي
1. أداة لتعظيم الأرباح واستغلال البيانات والمعرفة في ظل الرأسمالية
تعظيم الأرباح على حساب العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية.
في ظل النظام الرأسمالي الحالي، يُوجَّه استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، نحو تعظيم الأرباح، حيث تُستخدم هذه التقنيات كأداة رئيسية لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف. لكن ذلك يكون غالبًا على حساب شغيلات وشغيلة اليد والفكر، إذ يُستبدلون بالخوارزميات والأنظمة المؤتمتة، مما يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة منهم وارتفاع معدلات البطالة، أو دفعهم إلى الانتقال إلى قطاعات أخرى في ظروف غير مستقرة
تشير التقديرات الأحدث إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان واسع للوظائف في السنوات القادمة، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المهام الروتينية والقابلة للأتمتة. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، أعلنت شركة "آي بي إم"، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أنها ستوقف التوظيف في نحو 30% من الوظائف الإدارية (مثل الموارد البشرية)، تمهيدًا لاستبدالها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا يعني أن آلاف الوظائف سيتم إلغاؤها نهائيًا، لأن الشركة ترى أن المهام الروتينية التي كانت تُنفّذ بواسطة البشر يمكن أن تُدار آليًا بشكل أكثر كفاءة وربحية.
وفي بداية عام 2024، قامت شركة "دروبوكس"، المختصة بخدمات التخزين السحابي، بتسريح نحو 16% من موظفيها، معلنةً أن القرار يأتي ضمن خطة "إعادة هيكلة" تهدف إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي كمجال استثماري رئيسي. أوضحت الإدارة أن عددًا من المهام التي كانت تُنفّذ من قبل البشر أصبحت الآن قابلة للأتمتة، ما يجعل الإبقاء على العاملين فيها "غير ضروري".
هاتان الحالتان تعكسان بوضوح تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وزيادة مخاطر البطالة بين شغيلات وشغيلة اليد والفكر، في ظل ضعف أو غياب سياسات حمائية تضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب موازين القوى الطبقية في كل بلد، ودرجة تطوّر حقوق شغيلات وشغيلة اليد والفكر، ودور وقوة النقابات واليسار.
في المقابل، تُوجَّه مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الأتمتة نحو زيادة أرباح الشركات الكبرى بدلًا من تحسين الأجور أو تقليل ساعات العمل. أما من يحتفظون بوظائفهم، فيجدون أنفسهم مضطرين للعمل في بيئات غير مستقرة، حيث تفرض معظم الشركات سياسات قاسية لزيادة الإنتاجية، مستغلة التكنولوجيا لفرض ضغوط إضافية على القوى العاملة. هذا التركيز على الربح يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الطبقية والاقتصادية، حيث تُترك الغالبية العظمى من المجتمع لتحمل عبء التغيرات التي أحدثتها هذه التكنولوجيا، بينما تستأثر الطغم الرأسمالية بالفوائد والأرباح.
استغلال البيانات في ظل الرأسمالية الرقمية
إلى جانب استغلال شغيلات وشغيلة اليد والفكر في أماكن العمل التقليدية، وسّعت الرأسمالية الرقمية، من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نطاق الاستغلال ليشمل البيانات الشخصية، وسلوك الأفراد، وتفضيلاتهم، حيث تحوّلت هذه البيانات إلى سلعة تراكم الطغم الرأسمالية من خلالها الأرباح، دون أي تعويض مباشر للمستخدمات والمستخدمين الذين يُنتجونها. تُستخدم هذه البيانات في صياغة سياسات وبرامج سياسية واقتصادية، وتوجيه الاستهلاك، بما يضمن إعادة إنتاج الهيمنة الرأسمالية.
على سبيل المثال، كشفت فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" عام 2018 عن كيفية استغلال وبيع بيانات عشرات الملايين من مستخدمي ومستخدمات فيسبوك دون علمهم، بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية من خلال استهدافهم بإعلانات سياسية مصمّمة بناءً على تحليل ملفاتهم السلوكية.
كما تحقّق شركات مثل جوجل، وأمازون وغيرها عشرات المليارات سنويًا من الإعلانات المستهدفة، المعتمِدة على تحليل البيانات التي تُنتَج مجانًا عبر تفاعلات المستخدمين والمستخدمات. ففي عام 2021، بلغت إيرادات فيسبوك من الإعلانات الرقمية وحدها 117 مليار دولار، تم تحصيلها دون أي إشراك فعلي للمستخدمين والمستخدمات في تلك الأرباح.
يمثّل هذا النمط من الاستغلال شكلًا غير مباشر من العمل المجاني، حيث يُنتج الأفراد، دون وعي، قيمة اقتصادية هائلة تستولي عليها الشركات الاحتكارية، التي لا تكتفي باستغلال البيانات، وانما تهيمن على البنية التحتية الرقمية نفسها، فيما يشبه شكلًا جديدًا من الإقطاع الرقمي. وكما احتكر الإقطاعيون الأراضي في العصور الوسطى، تحتكر الشركات التكنولوجية الكبرى اليوم المنظومات الرقمية، فارضةً شروطها على المستخدمات والمستخدمين، ومانعةً أي سيطرة فعلية لهم على أدوات الإنتاج الرقمي.
في الاقتصاد الصناعي، كان الاستغلال يتم عبر دفع أجور لا تعكس القيمة الحقيقية للعمل. أما في الاقتصاد الرقمي، فبات السلوك البشري وبياناته ذاتها مصدرًا للقيمة. كل نقرة، وكل بحث، وكل تفاعل، تتحول إلى مادة خام تُكدّسها الرأسمالية الرقمية دون أي اعتراف قانوني أو تعاقدي. لم يعد الاستغلال الرقمي مقتصرًا على شغيلات وشغيلة اليد والفكر ذوي الأجور المنخفضة، وانما بات يشمل المستخدمات والمستخدمين أنفسهم، الذين يتحوّلون إلى شغيلات وشغيلة رقميين غير مرئيين.
تُخفي الرأسمالية الرقمية هذا الاستغلال خلف خطاب "المجانية"، الذي يوهم المستخدمين والمستخدمات بأنهم يحصلون على خدمات مفيدة دون مقابل، بينما يتم في الواقع استخراج بياناتهم وتوظيفها لتحقيق أرباح ضخمة.
تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" تُحفّز على قضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع المحتوى، بينما تجمع وتبيع بياناتهم للمعلنين دون أي مردود لصالح المستخدم-ة. وينطبق الأمر كذلك على برامج "الحماية المجانية" مثل "AVG"، التي تجمع معلومات حساسة تحت ستار "تحسين الخدمة ومكافحة الفيروسات"، لتبيعها لاحقًا لشركات التسويق والإعلانات.
تحليل البيانات لا يُستخدم فقط في الإعلانات، وانما في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات جديدة تُعزّز هيمنة الشركات الكبرى على المعرفة، وكذلك في الاقتصاد، والعلاقات الاجتماعية، دون أن يملك الأفراد أي قدرة على التحكم في بياناتهم أو المطالبة بجزء من القيمة والارباح التي يُنتجونها.
والأخطر من ذلك، أن هذا النموذج يمحو الفاصل بين وقت العمل ووقت الفراغ، حيث تتحوّل كل لحظة يقضيها الفرد في الفضاء الرقمي إلى إنتاج مستمر للبيانات، حتى في لحظات الترفيه، والتفاعل الاجتماعي، والممارساتالثقافية والاجتماعية. وهكذا، أصبح الإنترنت ذاته مصنعًا رقميًا يعمل على مدار 24 ساعة، ولكن تحت منطق الرأسمالية والإقطاع الرقمي، حيث لم تعد الشركات الرقمية تقدّم مجرد خدمات، بل تتحكّم في القواعد التي تنظّم الفضاء الرقمي نفسه، فارضةً على الأفراد العمل داخل منظومتها الاحتكارية، دون أي سيطرة على أدوات الإنتاج الرقمي أو حتى وعي باستغلالهم.
فائض القيمة الرقمي وفائض القيمة التقليدي
فائض القيمة هو جوهر الاستغلال الرأسمالي، أي الفارق بين ما يُنتجه العامل-ة من قيمة، وبين ما يحصل عليه من أجر. لكنه ليس مفهومًا ثابتًا، بل يتغيّر شكله وفقًا لنمط الإنتاج القائم. ويمكن التمييز اليوم بين نوعين رئيسيين: فائض القيمة التقليدي وفائض القيمة الرقمي، يختلفان في أسس العلاقة الإنتاجية والاستغلال.
أولًا: فائض القيمة التقليدي
في النمط الصناعي التقليدي، يتم انتزاع فائض القيمة من جهد شغيلات وشغيلة اليد والفكر في مواقع الإنتاج مثل المصانع، المزارع، المكاتب، وسلاسل الخدمات. يعمل هؤلاء وفق عقد عمل مباشر، ويتلقّون أجرًا يقل كثيرًا عن القيمة الفعلية التي يُنتجونها. رأس المال يمتلك وسائل الإنتاج، ويُوظّف قوة العمل لتحقيق الربح من خلال السيطرة على وقت العمل.
مثلًا، في مصانع إنتاج الأجهزة الذكية التابعة لشركات عالمية كبرى مثل آبل وسامسونج، يعمل مئات الآلاف من الشغيلات والشغيلة في دول جنوب شرق آسيا لساعات طويلة، مقابل أجور منخفضة لا تكاد تغطي نفقات المعيشة الأساسية، بينما تحقق هذه الشركات أرباحًا ضخمة. في عام 2023، بلغت أرباح آبل أكثر من 100 مليار دولار، معظمها ناتج عن بيع منتجات تُنتَج بجهد مكثّف وظروف عمل استغلالية.
ثانيًا: فائض القيمة الرقمي
أما في النموذج الرقمي، فإن فائض القيمة يُنتزع بأساليب أكثر خفاءً وتعقيدًا. لا يعتمد هذا النمط فقط على العمل المأجور، بل على الأنشطة اليومية للمستخدمات والمستخدمين داخل الفضاء الرقمي. كل نقرة، بحث، إعجاب، مشاركة، أمر صوتي، أو استخدام لتطبيق، وغيرها تُنتج بيانات تُستخدم لتوليد أرباح هائلة من الإعلانات، تدريب الخوارزميات، تطوير المنتجات، وتحليل السلوك، فضلًا عن الاستفادة منها في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الفكرية، وحتى العسكرية والأمنية.
هنا لا يوجد عقد عمل، ولا أجر، ولا حتى اعتراف بالدور الإنتاجي. فالرأسمالية الرقمية لا تشتري وقت العمل، وانما تستخرج القيمة من الحياة اليومية ذاتها، وتُخفي هذا الاستغلال خلف واجهة "الخدمة المجانية". وحتى حين تُقدَّم بعض الخدمات مجانًا أو بأسعار رمزية، فهي غالبًا محدودة الإمكانات، وتُوظَّف أساسًا كأدوات لجمع المزيد من البيانات والمدخلات عن المستخدمات والمستخدمين، بهدف تعظيم الأرباح وتعزيز السيطرة.
من الأمثلة الواقعية على هذا النمط من استخراج فائض القيمة الرقمي، يمكن الإشارة إلى المنصات الاجتماعية، حيث يُنتج المستخدمات والمستخدمون محتوى مجانيًا يجذب تفاعلات ضخمة، تُباع لاحقًا للمعلنين، وتدرّ أرباحًا هائلة للمنصات، بينما يحصل معظم صنّاعات وصنّاع المحتوى على حصة ضئيلة جدًا، إن وُجدت أصلًا. وينطبق الأمر كذلك على خدمات مثل خرائط جوجل - مابس، التي تعتمد على البيانات الناتجة عن تنقّل المستخدمات والمستخدمين واستخدامهم للتطبيق، بهدف تحسين الخدمة وبيعها لاحقًا للعملاء التجاريين، دون أي تعويض لمن وفّروا هذه البيانات. أما المساعدات الصوتية، مثل أمازون أليكسا وأبل سيري، فتقوم بتسجيل وتحليل الأوامر الصوتية لتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو بيعها لشركات الإعلان والتسويق، دون أن يكون لدى المستخدمات والمستخدمين أدنى وعي بأنهم يشاركون بشكل مباشر في إنتاج فائض القيمة الرقمي.
ثالثًا: مقارنة تحليلية بين النموذجين
رابعًا: الخلاصة
لا تُلغي الرأسمالية الرقمية فائض القيمة التقليدي، بل تضيف إليه نمطًا جديدًا أكثر خفاءً، حيث يُنتزع الفائض من مجرد التفاعل الرقمي اليومي للمستخدمات والمستخدمين، لا من عمل مادي أو فكري معترف به. يتحوّل الزمن الحي وفضاء الفراغ إلى عمل غير مرئي، تُستخرج منه القيمة دون أجر أو عقد أو سيطرة على أدوات الإنتاج الرقمية. وهكذا، يشمل إنتاج فائض القيمة الرقمي الجميع، لا فئة محددة من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، بل حتى " المستخدمات والمستخدمين العاديين" الذين يساهمون بلا وعي في تغذية منظومة إنتاجية ضخمة تُراكم الأرباح لصالح الشركات الاحتكارية. بهذا، تصبح الحياة اليومية والسلوك البشري ذاتهما، لا العمل المأجور فقط، مصدرًا رئيسيًا لتراكم رأس المال في أكثر أشكال الاستغلال تطورًا.
اقتصاد المعرفة
في ظل النظام الرأسمالي، لم يعد الإنتاج الصناعي، الزراعي، والتجاري وحده مصدر القيمة الاقتصادية، وتوسعت بحيث أصبحت المعرفة وقودًا جديدًا للرأسمالية. فاقتصاد المعرفة، الذي يُفترض أن يكون أداة لتحرير البشرية وتطوير حياتها، أُعيدت صياغته ليصبح وسيلة احتكارية جديدة، تُستخدم لتعميق التفاوت الطبقي والرقمي، وتعزيز سيطرة الشركات والدول الكبرى على أدوات الإنتاج الرقمي، حيث تتحكم القلّة المالكة للتكنولوجيا في مصير الأغلبية.
تحتكر الطغم الرأسمالية معظم أدوات المعرفة، بدءًا من براءات الاختراع، الأبحاث المتقدمة، الخوارزميات، البرامج، أنظمة التشغيل، والمنصات الرقمية الكبرى، مما يفرض على المجتمعات اعتمادًا شبه كامل على منتجاتها الرقمية، بدلًا من تحويل هذه التقنيات إلى موارد جماعية بملكية مجتمعية تخدم الجميع. وحتى المؤسسات الأكاديمية والعلمية، التي يُفترض أن تكون منابر لإنتاج المعرفة الحرة، أصبحت خاضعة لمنطق السوق، حيث يُباع البحث العلمي للمؤسسات الكبرى، ويُحرَم الجمهور العام من الوصول إليه إلا بمقابل مالي، مما يعزّز تحويل العلم والمعرفة إلى سلعة بدلًا من كونه حقًا إنسانيًا مشتركًا.
الرأسمالية لا تسعى فقط إلى احتكار المعرفة، وانما تعمل على إنتاج الجهل الممنهج من خلال السيطرة على المناهج التعليمية والمحتوى الرقمي، وتوجيه الجماهير نحو التسطيح الفكري. فالإنترنت، الذي كان من الممكن أن يكون أداة ثورية لنشر الوعي النقدي، أصبح فضاءً مملوكًا بشكل شبه كامل للدول الكبرى وللشركات الاحتكارية، التي تتحكم في تدفّق المعلومات والمعرفة بمختلف أشكالها، وفقًا لمصالحها الاقتصادية، السياسية، والفكرية.
2. الذكاء الاصطناعي كأداة للهيمنة والسيطرة على العمل
لا يكتفي النظام الرأسمالي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والأرباح، وانما يسخّره أيضًا كأداة لترسيخ السيطرة الطبقية، وإخضاع شغيلات وشغيلة اليد والفكر لآليات أكثر صرامة من المراقبة والتحكم. إن توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء، بل يُستخدم لتكثيف استغلالهم، ومراكمة الأرباح على حساب حريتهم وحقوقهم.
حيث مع تطور الخوارزميات الذكية، بات بإمكان الشركات تتبع كل حركة يقوم بها شغيلات وشغيلة اليد والفكر، سواء عبر أنظمة تتبع الإنتاجية، أو تحليل البيانات، أو قياس سرعة وكفاءة الأداء. تُستخدم هذه الأدوات في معظم الأحيان للضغط عليهن وعليهم، وتقليص فترات الراحة، وفرض وتيرة عمل مرهقة تحوّلهم إلى تروس في آلة رأسمالية لا تهدأ. هذا النمط الجديد من الرقابة من الممكن أن يخلق بيئة عمل أكثر قسوة، حيث يُصبحون مجرد متغيرات في معادلة الذكاء الاصطناعي، ولا يستطيعون التحكم بشكل كبير في ظروف عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم الخوارزميات في عمليات التوظيف والفصل، حيث يتم تحليل البيانات الضخمة لتحديد من يستحق التوظيف أو الاستمرار، ومن يمكن الاستغناء عنه. ويؤدي هذا إلى ديناميكية عمل غير مستقرة، يتم فيها تهميش عدد كبير من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، واستبدالهم بسهولة وفق معايير كمية صارمة، دون اعتبار للجوانب الإنسانية أو الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، تُوظَّف برمجيات الذكاء الاصطناعي في شركات التوظيف الكبرى، مثل لينكدإن، لتحليل السير الذاتية وفرز المتقدمين بشكل آلي، مما يؤدي إلى تمييز غير مباشر ضد شغيلات وشغيلة الخلفيات الأقل امتيازًا. إذ تُفضل الخوارزميات المرشحين الذين يتماهون مع أنماط سوق العمل الرأسمالي، بينما يتم تجاهل من يمتلكون مهارات غير نمطية أو خبرات خارج القوالب السائدة.
هذا التحول يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمان الوظيفي من خلال دفع شغيلات وشغيلة اليد والفكر إلى قطاعات أخرى، ويُسهم كذلك أيضًا في تكريس نموذج "العمل القابل للاستبدال"، حيث يتم الاستغناء عنهم بسهولة بمجرد اعتبارهم أقل كفاءة من البدائل الرقمية أو الآلية، مما يزيد من هشاشة سوق العمل ويعمّق الاستغلال.
على سبيل المثال، في مستودعات شركة أمازون، يتم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة تحركات شغيلات وشغيلة اليد والفكر، وقياس سرعة أدائهم، وتحديد من يُحقق الأهداف الإنتاجية ومن يتأخر، مما يؤدي إلى طرد العديد منهم وفق معايير غير إنسانية، لا تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الصحية أو الاجتماعية. وينطبق ذلك أيضًا على شركات المنصات مثل أوبر وديليفرو وأوبر إيتس، حيث تُدار حياة السائقين والسائقات بالكامل عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي تُحدد الطلبات، وساعات العمل، والأولوية في الظهور على التطبيق، و وتُقرر من يُسمح له بالعمل ومن يُجمد حسابه أو يُقلّص دخله بناءً على تقييمات الزبائن، أو عدد الرحلات، أو التأخير، دون تدخل بشري أو مراعاة للظروف الانسانية.
في هذا النموذج، تتحول الخوارزميات والذكاء الاصطناعي إلى مدير فعلي وقاضٍ وجلاد في آنٍ واحد، بينما يُترك العاملون والعاملات دون حماية قانونية، أو حقوق نقابية، في سوق عمل رقمي شديد الهشاشة والاستغلال. وقد أدّى هذا إلى اندلاع إضرابات واحتجاجات في عدد من الدول ، مطالبةً بالاعتراف بعمال المنصات كـ"موظفين" لا "مقاولين مستقلين"، وضمان حقوقهم الأساسية مثل الحد الأدنى للأجور، التأمين الصحي، وحق التنظيم النقابي.
3. توجيه الوعي لتعزيز الثقافة الرأسمالية النيو ليبرالية
إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الأرباح وترسيخ السيطرة الاجتماعية، تُوظَّف هذه التكنولوجيا بشكل ممنهج لتشكيل وعي الأفراد وتوجيهه تدريجيًا، بهدف تعزيز الثقافة والأفكار الرأسمالية، وخصوصًا تمجيد الحضارة الغربية، وبشكل أكثر تحديدًا القيم الرأسمالية الأمريكية. من خلال تحليل البيانات وسلوك المستخدمين والمستخدمات، تُستخدم الخوارزميات للتحكم في المحتوى الذي يُعرض لهم عبر المنصات الرقمية، مثل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وغيرها، ويتم تصميمها بحيث تُغذّي الأفراد بمحتوى يتماشى مع القيم التي تدعم الرؤية الرأسمالية وسياساتها وافكارها.
على سبيل المثال، وفي معظم المنصات الرقمية، تُعرض الإعلانات والمحتويات الترويجية التي تُشجّع الأفراد على شراء المزيد من المنتجات، حتى عندما لا تكون لديهم حاجة حقيقية لها. كما يتم الترويج لقيم الرأسمالية مثل أزلية الملكية الخاصة، والتفاوت الطبقي، والنجاح الفردي، والثروة، والاستهلاك، وأنماط الحياة الفاخرة كمعيار للحياة "الناجحة". مثال آخر على ذلك هو خوارزميات محرك البحث "غوغل"، التي تُصنّف النتائج وفقًا لمنطق السوق والإعلانات المدفوعة، لا وفقًا للأهمية الاجتماعية أو الفكرية أو العلمية للمحتوى. فعند البحث عن مفاهيم مثل "النجاح"، "التنمية الذاتية"، أو حتى "السعادة"، تظهر النتائج الأولى مرتبطة بشركات تطوير الذات، ودورات مدفوعة، ونصائح استهلاكية تقوم على الفردانية والربح، في مقابل تغييب أو تهميش التحليلات العلمية الرصينة والأفكار اليسارية والتقدمية، وحتى عدم اظهارها ويعني حضرها بأشكال مباشرة أو غير مباشرة في العديد من الحالات.
يؤدي هذا إلى توجيه الوعي الجماعي نحو قبول هذه القيم باعتبارها طبيعية وحتمية. ويتم ذلك بأسلوب تدريجي ناعم وغير محسوس وعلى مدى زمني طويل، إلى الحد الذي يجعل معظم مستخدمي ومستخدمات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم أصحاب الفكر اليساري والتقدمي، يعتقدون أنها أدوات محايدة. إن هذه السياسة تُشكل خطرًا بالغًا على الأجيال القادمة، التي أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتها اليومية، وتُسهم هذه الأساليب والسياسات الدقيقة في تكريس الهيمنة الرأسمالية أكثر فأكثر، وتعزيز ولاء الجماهير وخنوعها للنظام القائم.
4. تأثير الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي
تفكيك المهارات البشرية وتعميق الاغتراب والاستلاب الرقمي
إلى جانب الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الوعي الجماهيري، هناك بُعد آخر لم يُدرس ويؤطر في قوانين دولية، في ظل السباق المحموم بين الدول الكبرى والشركات الرأسمالية الاحتكارية للسيطرة على أسواق الذكاء الاصطناعي، وهو التأثير السلبي للاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في قدرات الإنسان العقلية والإبداعية. أصبح تطوير التكنولوجيا موجهًا إلى حد كبير نحو الهيمنة وتحقيق الأرباح والتنافس على التفوق التقني، دون النظر إلى التأثيرات العميقة لهذه التحولات على البشرية.
يُروَّج للذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة لتسهيل الحياة وزيادة الإنتاجية، لكن الواقع يكشف أن الاعتماد غير المدروس على هذه التقنيات قد يؤدي إلى تعميق الوعي السطحي وإضعاف المهارات البشرية الأساسية. ومع مرور الوقت، قد يصبح الإنسان، وخاصة الأجيال الجديدة، أقل قدرة على التفكير النقدي، وإجراء العمليات الحسابية، والكتابة، وحتى التواصل البسيط عبر الرسائل، نتيجة الاعتماد المفرط على الأنظمة الذكية التي تنفذ هذه المهام نيابة عنه.
في هذا السياق، يعاد إنتاج الاغتراب الانساني في شكل رقمي جديد، حيث ينفصل الإنسان عن ملكاته العقلية والإبداعية، ويجد نفسه محاصرًا ضمن منظومة تقنية تسلبه قدرته على الفعل المستقل، تمامًا كما كان العامل الصناعي مغتربًا عن منتوجه في ظل الرأسمالية التقليدية. ومن الممكن أن يتحوَّل الإنسان تدريجيًا إلى كائن خاضع للخوارزميات التي تُوجِّه تفاعلاته اليومية، وتحدد له ما يقرأ، وما يشاهد، وحتى كيف يفكر. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى خلق أجيال تفتقر إلى القدرة على التفاعل مع الواقع بشكل مستقل، حيث يصبح الذكاء الاصطناعي وسيطًا أساسيًا بين الفرد والعالم والمحيط الخارجي، مما يعزز تبعيته لأنظمة وشركات ودول يسيطر عليها رأس المال.
إن هذا الاغتراب الرقمي لا يقتصر فقط على الجانب الإنتاجي، وانما يمتد إلى مستوى أكثر خطورة، وهو اغتراب الإنسان عن ذاته، عن وعيه، وعن علاقاته الاجتماعية، حيث تتحول هويته الفكرية والثقافية إلى مجرد انعكاس للخوارزميات المصممة لخدمة السوق.
الخطورة هنا لا تقتصر على فقدان المهارات الفردية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الوعي الجماعي بطرق تتماشى مع متطلبات السوق الرأسمالية. إذ تُضعف قدرة الأفراد على التنظيم، والمقاومة، والمطالبة بالتغيير الجذري، من خلال دفعهم تدريجيًا إلى عزلة رقمية فردية، تُختزل فيها التفاعلات الإنسانية ضمن منصات تتحكم في تدفّق المعلومات وتُعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بما يخدم منطق الهيمنة.
الإدمان الرقمي
في هذا الإطار، يبرز الإدمان الرقمي كأحد أخطر الآثار المترتبة على توسع الذكاء الاصطناعي، إذ تشير دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا عام 2020 إلى أن الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يُحدث تغييرات في الدماغ تشبه تلك التي يسببها إدمان المخدرات، وتحديدًا في المناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات والسيطرة على السلوك، حيث تُصمَّم هذه الخوارزميات خصيصًا لجذب انتباه المستخدمات والمستخدمين وإبقائهم متصلين لأطول فترة ممكن.
وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الترفيه، والأنظمة الرقمية الأخرى ليست مجرد منصات للخدمات، وانما هي أدوات تُستخدم بشكل واعٍ لتعزيز التبعية السلوكية والفكرية، حيث يتم استغلال البيانات الضخمة لفهم دوافع الأفراد والتلاعب بها بطرق تخدم المصالح الاقتصادية للشركات والدول الكبرى. إن هذا الإدمان الرقمي لا يقتصر فقط على تضييع الوقت أو التأثير على الإنتاجية، بل يمتد إلى خلق نمط جديد من الاستلاب نتيجة الادمان، حيث يفقد الأفراد تدريجيًا قدرتهم على العيش خارج الإطار الرقمي. قد يؤدي ذلك إلى ضعف التركيز، وتراجع مهارات حل المشكلات، وإضعاف الذاكرة والتواصل البشري المباشر.
تستغل الرأسمالية هذا الإدمان بطرق متعددة، حيث تستثمر في تطوير تقنيات تُحفِّز السلوك الإدماني لضمان استمرار المستخدمين والمستخدمات في التفاعل المستمر مع المنصات الرقمية وبأشكال مختلفة، وتتحول هذه العملية إلى حلقة مفرغة، حيث يتم توليد الأرباح من خلال الإبقاء على الأفراد في حالة دائمة من الاستهلاك السلبي، مما يعزز أرباحها على حساب الصحة العقلية والنفسية، وخاصة لدى الأجيال الشابة، وقد يؤدي ذلك إلى تآكل قدرتهم تدريجيًا على التفكير المستقل والعمل الجماعي.
نوع من العبودية الرقمية الطوعية
تتعمق الهيمنة الطبقية عبر تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة تكنولوجية إلى وسيلة لإعادة إنتاج أنماط السيطرة الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية. وقد يؤدي استمرار هذا النموذج إلى كوارث إنسانية، إذ يفقد الإنسان تدريجيًّا قدرته على مواجهة التحديات المعقّدة، ويصبح رهينًا لتقنيات تتحكّم فيها نخبة رأسمالية والدول الكبرى.
وما يجعل هذه السيطرة أكثر خطورة هو طابعها الطوعي، حيث يُدفع الأفراد، بفعل التلاعب الخوارزمي والرغبة في الراحة، إلى الانخراط في هذه العبودية الرقمية دون إكراه مباشر. يُمنح الإنسان وهم التحكم والاختيار، بينما تُوجَّه قراراته بشكل غير محسوس نحو مسارات مُعدّة مسبقًا تخدم مصالح الرأسمالية. ولا ينبع هذا الخضوع من اقتناع واعٍ، وانما من اعتماد متزايد على تقنيات تُشكّل بديلًا اصطناعيًا للعلاقات البشرية والعمليات الذهنية المستقلة، مما يُنتج حالة من الاستلاب الرقمي، حيث يتماهى الأفراد مع أدوات تحكّمهم بدلًا من مقاومته.
إذا استمرت هذه الديناميكية دون مواجهة جماعية قائمة على وعي يساري تقدمي، فقد يتحوَّل الذكاء الاصطناعي الحالي من مجرد أداة في يد الرأسمالية بشكل تدريجي إلى نظام بديل للعقل البشري، يُدار عبره الحياة اليومية، مما يفرض شكلاً جديدًا من العبودية الرقمية الطوعية، حيث يصبح الأفراد محاصرين ضمن أنظمة تكنولوجية تحدد أدوارهم وسلوكياتهم، وتقيِّد قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل، بل تدفعهم إلى قبول هذه الهيمنة كواقع حتمي لا يمكن تجاوزه.
تمرد الآلة وسيطرة الذكاء الاصطناعي على البشرية
لطالما رسمت التوقعات المستقبلية صورًا لعالمٍ تُحكم فيه البشرية بواسطة الآلة، حيث يفقد الإنسان سيطرته على التكنولوجيا التي صنعها، ليصبح مجرد ترس في منظومة لا تخضع لإرادته، وتخدم مصالح القوى المسيطرة. هذا السيناريو، الذي كان في الماضي مجرد افتراضات فلسفية أو تصورات سينمائية في أفلام الخيال العلمي، أصبح اليوم أكثر واقعية في ظل التطورات الهائلة للذكاء الاصطناعي، وغياب أي ضوابط قانونية دولية فعّالة تُنظّم وتؤطّر عمله.
إحدى الإشكاليات الكبرى والخطيرة التي يطرحها تطور الذكاء الاصطناعي هي احتمالية تطوير نفسه بحيث يتجاوز الذكاء البشري، وتحوله إلى كيان مستقل بذاته، خارجًا عن سيطرة البشر، ومسيطرًا عليهم. فمع تجاوزه حدوده البرمجية الأصلية، قد يصبح الذكاء الاصطناعي منظومة تتخذ قرارات مصيرية بشكل مستقل، تُفرض على البشرية في الاقتصاد، السياسة، والحياة اليومية وغيرها، دون أي رقابة بشرية. في ظل الرأسمالية، يتم تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة تراكم رأس المال وتعزيز الهيمنة الطبقية ويخضع لمنطق المنافسة الشرسة، مما يجعل فقدان السيطرة عليه أمرًا ممكنًا ومحتملاً وخطيرًا، خاصة أنه يتطوّر بسرعة هائلة تفوق سرعة تنظيمه وتأطيره ضمن قوانين دولية وضوابط مجتمعية. إذ يتم تصميمه كأداة بقدرات هائلة دون أي "قفص" يحدّ من انفلاته إذا أُسيء استخدامه أو خرج عن السيطرة، مما قد يحوله إلى قوة مستقلة تعمل ضد مصالح المجتمع بدلًا من خدمته.
هذا السيناريو لم يكن غريبًا عن السينما، حيث تناولت العديد من الأفلام هذه الفكرة، مثل «المدمر»، حيث تبدأ الآلات حربًا ضد البشر بعد وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى من الوعي الذاتي، و«ماتريكس»، الذي يعرض عالمًا تُستعبَد فيه البشرية من قِبل الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم البشر كمصادر طاقة، و«أنا، روبوت»، الذي يناقش فكرة تمرد الروبوتات ضد البشر بعد اكتسابها قدرات تفكير مستقلة. لن يكون «تمرد» الذكاء الاصطناعي مجرد سيناريو خيالي، وانما ستنعكس نتائجه في سياسات تُفرض عبر أنظمة رقمية، دون أي اعتبار للحاجات الإنسانية. وما نشهده اليوم ليس هيمنة روبوتات على البشر بالشكل الكلاسيكي المتخيل حتى الآن، ولكنه قد يتطوّر نحو نموذج جديد من السيطرة الرقمية، قائم على الأتمتة الشاملة وتحكم الخوارزميات في الحياة اليومية، حيث تتحول المجتمعات إلى كيانات تُدار وتُسيطر عليها أنظمة وآلات ذكية.
5. الذكاء الاصطناعي والعالم الثالث
لا تقتصر تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الدول المتقدمة، وانما تمتد إلى دول العالم الثالث، حيث يُعامل كقاعدة موارد خام وأسواق استهلاكية ضخمة تُوظَّف لخدمة الرأسمالية العالمية. بدلاً من أن تُسهم هذه التقنيات في التنمية المستقلة لهذه البلدان، يتم توجيهها بطرق تُكرّس التبعية الاقتصادية والسياسية والفكرية والتكنولوجية، مما يعزز استغلال هذه المجتمعات لصالح الدول والشركات الكبرى المسيطرة على تطوير الذكاء الاصطناعي.
تسعى الشركات الاحتكارية إلى استغلال البيانات والموارد البشرية في دول العالم الثالث دون تقديم أي قيمة عادلة لهذه المجتمعات. فبينما يتم الترويج للذكاء الاصطناعي بوصفه أداة للتنمية بشكل معلن، فإنه في الواقع يُستخدم كأداة لنهب البيانات وتحويل سكان هذه الدول إلى مجرد مصادر مجانية للمعلومات. يتم امتصاص البيانات الضخمة من خلال التطبيقات الرقمية، وأنظمة التتبع، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصبح كل تفاعل مادة خام تُعالج لخدمة الدول الكبرى والشركات الاحتكارية دون أي مردود اجتماعي حقيقي للسكان في هذه البلدان.
تُوظَّف المبادرات "الخيرية" و"الإنسانية" التي تقودها بعض الدول وشركات التكنولوجيا الكبرى لتعميق السيطرة الرأسمالية على دول العالم الثالث، حيث تعمل هذه الشركات بجد على إيصال الإنترنت إلى كل ركن من العالم، وخصوصًا الدول النامية، حتى قبل توفير الكهرباء والمياه النقية والخدمات الأساسية!
أحد الأمثلة على ذلك هو مشروع "Internet.org" الذي أطلقته شركة ميتا (فيسبوك سابقًا) بالتعاون مع ست شركات تكنولوجيا أخرى، تحت شعار "ربط غير المتصلين"، والذي وفّر وصولًا محدودًا وموجّهًا إلى الإنترنت في بعض البلدان، يقتصر على منصات وخدمات محددة تابعة للشركة وشركائها، بدلًا من تقديم إنترنت حر ومفتوح. وبدلًا من تمكين المستخدمين والمستخدمات، جرى تحويلهم إلى مستهلكين ومستهلكات محتجزين داخل بيئة رقمية مغلقة تُراقَب فيها تفاعلاتهم باستمرار وتُستغل لتعظيم الأرباح. ويُظهر ذلك أن الهدف الحقيقي من هذه المشاريع لا يتمثل في تحسين مستوى المعيشة أو تطوير البنية التحتية، وانما في الترويج التجاري، وتعزيز السيطرة الفكرية، وتحويل كل فرد إلى مستهلك-ة دائم، ومصدر مستمر للبيانات والأرباح.
لا تسد هذه السياسات الفجوة الرقمية، وانما تُعيد إنتاج الاستعمار، ولكن الآن بشكله الرقمي، حيث تُصبح هذه الدول معتمدة بالكامل على الدول الكبرى والشركات الأجنبية في توفير التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بدلًا من بناء قدرات محلية تُلبّي احتياجاتها الفعلية. وهذا ما يُكرّس تبعيتها للبرمجيات الاحتكارية والبُنى التحتية السحابية الأجنبية، وبالأخص لتلك التابعة للدول الغربية ذات الماضي الاستعماري المشين.
في ظل الصراع العالمي على السيطرة التكنولوجية، لم تكن الأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم الثالث بعيدة عن سباق الاستثمار في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وخاصة الدول الغنية في ممالك الخليج العربي، حيث إنها تستثمر المليارات من الدولارات في مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وتلقّت دعمًا مباشرًا من الدول الكبرى والشركات الاحتكارية التي وجدت في هذه الأنظمة حلفاء استراتيجيين لخدمة مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية منذ عقود طويلة. هذا الاستثمار، الذي يُروَّج له إعلاميًا كجزء من «التحول الرقمي» و«التحديث التكنولوجي» لمجتمعاتها، ليس سوى وسيلة جديدة لترسيخ سلطاتها الدكتاتورية، ولتعزيز أدوات القمع والرقابة، وإحكام السيطرة السياسية والاجتماعية والفكرية على شعوبها. تُوظِّف تلك الأنظمة الاستبدادية الذكاء الاصطناعي في تطوير تقنيات المراقبة الجماعية، وتحليل البيانات الضخمة، والحد من أي حراك معارض. كما تُستخدم أنظمة التعرف على الوجه، وتحليل الصوت، وتقنيات التنبؤ بالسلوك وغيرها، لتحديد الأفراد المعارضين قبل أن يتمكنوا حتى من التحرك. وعبر هذه الأنظمة، تستطيع تلك الحكومات القمعية تتبُّع أنشطة المواطنين والمواطنات والتجسُّس عليهم بكل الوسائل، سواء عبر الإنترنت أو في الأماكن العامة.
رغم الشعارات الزائفة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، تستمر الدول الغربية والشركات الكبرى في دعم مشاريع هذه الدول، لأنها تخدم سياسات الهيمنة الاقتصادية والسياسية. تُشارك الشركات التكنولوجية الاحتكارية في هذا القمع والسيطرة، إما عن طريق بيع التكنولوجيا بشكل مباشر، كما هو الحال مع الأسلحة وأدوات القمع والتعذيب، أو من خلال تقديم الاستشارات والإمكانيات والدعم الفني لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها هذه الأنظمة الدكتاتورية. ويتم بيع وتطوير هذه الأنظمة بحرية في الدول القمعية الحليفة للرأسمالية العالمية، حيث تُحوَّل إلى أداة مباشرة لإعادة إنتاج السلطة الاستبدادية وتعزيزها.
6. ضعف الحيادية الجندرية في الذكاء الاصطناعي وعدم تبني المساواة الكاملة
رغم الانطباع العام بالحيادية الجندرية للذكاء الاصطناعي، إلا أنه عند التدقيق الجيد نجد أن الانحيازات الجندرية المضمَّنة في الخوارزميات والأنظمة الذكية تُظهر بوضوح كيف تُعيد معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي إنتاج التمييز الجندري وعدم المساواة بين الجنسين. فاللغة الذكورية والطابع غير المساواتي لهذه التقنيات يعكسان التحيزات الثقافية والاجتماعية التي تُغذيها الشركات الرأسمالية والحكومات الذكورية التي طوّرتها، وذلك بنسب متفاوتة تبعًا لكل لغة ودرجة تطور حقوق المرأة والمساواة الجندرية في كل بلد.
الذكاء الاصطناعي ليس بطبيعته أداة ذكورية، لكنه يتغذى على بيانات المجتمع الرأسمالي الذكوري، حيث تعتمد الخوارزميات على بيانات مُجمَّعة تعكس بشكل عام تحيزات الأفكار النمطية التي تكرّس عدم المساواة بين المرأة والرجل، مثل اللغة الذكورية المستخدمة والتصورات التقليدية لأدوارهما في العمل والمجتمع. على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجرتها جامعة كارنيغي ميلون عام 2019 أن إعلانات الوظائف الممولة عبر فيسبوك وجوجل تميل إلى عرض الوظائف عالية الأجور، مثل المناصب التقنية والهندسية، للرجال أكثر من النساء.
كذلك، في عام 2018، كشفت وكالة رويترز أن نظام التوظيف القائم على الذكاء الاصطناعي، الذي طورته شركة أمازون، كان يُفضّل تلقائيًا الذكور على الإناث عند تقييم طلبات التوظيف في المجالات التقنية. إذ تم تدريب الخوارزمية على بيانات توظيف سابقة، والتي عكست تحيزًا هيكليًا داخل الشركة، حيث كان الذكور يشغلون غالبية المناصب الهندسية والتقنية. ونتيجة لذلك، قام النظام بخفض تصنيف السير الذاتية التي تحتوي على كلمة "نساء" أو التي تشير إلى مشاركة المتقدمة في أنشطة نسوية.
إضافةً إلى ذلك، تُبرمج الأنظمة الصوتية، مثل المساعدات الذكية، بأصوات أنثوية وأدوار خدمية، مما يعزز الصورة النمطية للمرأة على أنها "خاضعة" أو "مساعدة" بدلاً من كونها شريكًا متساويًا. على سبيل المثال، تأتي المساعدات الذكية مثل سيري من شركة آبل، وأليكسا من أمازون، ومساعد جوجل افتراضيًا بأصوات أنثوية، وعندما يتم انتقاد هذه التطبيقات، عادةً ما ترد بصيغة مهذبة وخاضعة، مما يعزز القوالب النمطية حول دور المرأة في تقديم الخدمات والدعم.
حاليًا، تستثمر بعض دول الشرق الأوسط مليارات الدولارات في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي وفق قيم دينية ذكورية محافظة، مما يعزز التحيزات الجندرية داخل هذه الأنظمة. فعلى سبيل المثال، تم تطوير بعض المساعدات الصوتية العربية بأصوات ذكورية بدلاً من الأنثوية، في محاولة لتجنب الصورة النمطية "الخاضعة" للمرأة، وفقًا لبعض التفسيرات الدينية المحافظة. كما أن العديد من الأنظمة الرقمية المستخدمة في هذه الدول تقيّد ظهور النساء في المحتوى الرقمي أو تعكس تصورات تقليدية تقلل من دور المرأة في المجتمع. على سبيل المثال، تستخدم بعض الحكومات الاستبدادية أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة السلوكيات الاجتماعية وتطبيق معايير أخلاقية مستوحاة من القيم الدينية الذكورية، مثل تقييد صور النساء غير المحجبات أو تقليل ظهورهن في نتائج البحث والخوارزميات الإعلانية. أحد أكثر أشكال هذا الاستغلال تطرفًا كان تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة ملابس النساء، حيث تقوم هذه الأنظمة بتحليل الصور والفيديوهات لتحديد مدى "مطابقتها" للمعايير الدينية المفروضة. على سبيل المثال، في إيران، تم اعتماد أنظمة رقمية لرصد مدى التزام النساء بالحجاب الإلزامي.
إن ضعف التمثيل النسائي في تصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي، وغياب الدور الفعّال للحركات النسوية والتقدمية في هذا المجال، إلى جانب سيادة الطابع الذكوري في فرق التطوير، يُعمِّق هذه المشكلة. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير صادر عن معهد AI Now، فإن النساء يشكلن 15% فقط من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، و10% فقط في جوجل، مما يعني أن معظم هذه التقنيات يتم تطويرها من قبل فرق ذكورية، مما يؤدي إلى ترسيخ التحيزات الجندرية داخل الخوارزميات.
فالتكنولوجيا هنا لا تكتفي بعكس التحيزات الجندرية، بل تُعيد إنتاجها وتعزيزها، مما يُعيق تحقيق المساواة ويُعمّق الفجوة بين الجنسين بدلًا من تقليصها. كما تُكرّس الأدوار النمطية وتُغذي التمييز ضد المرأة. وليست هذه مجرد مسألة تقنية، وانما تعبير عن أزمة اجتماعية أعمق، تُعيد ترسيخ أنماط التمييز وعدم المساواة داخل الفضاء الرقمي.
7. الذكاء الاصطناعي كأداة للسيطرة والقمع السياسي وانتهاك حقوق الانسان
الرقابة والسيطرة الرقمية
تعمل الشركات الرقمية، بالتعاون مع الدول الكبرى، على مراقبة تحركات الأفراد عبر الأجهزة الذكية ووسائل الاتصال المختلفة، حيث تخضع جميع الأنشطة الرقمية، بما في ذلك الاجتماعات المغلقة التي يُفترض أنها آمنة، للمتابعة وللتحليل المستمر. في الواقع تقريبا، لا توجد أي مساحة رقمية مُحصَّنة بالكامل؛ إذ تُجمَّع البيانات بشكل منهجي، ثم تُستخدَم لتقييم الأفراد والمجموعات وتصنيفهم وفقًا لأنماط سلوكهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية.
إضافةً إلى ذلك، تحولت الرقابة الرقمية إلى أداة مركزية لرصد التوجهات الفكرية والسياسية للمستخدمين والمستخدمات، مما يُمكِّن الشركات والحكومات من متابعتهم واستهدافهم عبر حملات تضليلية مُنظَّمة، أو فرض عقوبات رقمية تحدد وتقلِّص تأثيرهم في الرأي العام. تُطبَّق هذه الاستراتيجيات بشكلٍ ممنهجٍ وخفيّ ضد التنظيمات العمالية، والتنظيمات اليسارية، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية المستقلة، حيث تواجه هذه الجهات تضييقًا متزايدًا يُقيِّد انتشار أفكارها في الفضاء الرقمي العام عبر أساليب ناعمة غير مباشرة ويصعب رصدها.
تُوظَّف الخوارزميات بشكلٍ دقيق لتقييد وصول المنشورات السياسية اليسارية والتقدمية دون حذفها بشكل مباشر، مما يجعل القمع الرقمي أكثر تعقيدًا وخطورة وغير مرئي. إذ يبدو التفاعل المنخفض مع المحتوى التقدمي وكأنه استجابة طبيعية من الجمهور، بينما هو في الواقع نتيجة خوارزميات معدّة مسبقًا لتقليل انتشاره، مما يخلق انطباعًا زائفًا لدى الناشطين والناشطات بأن أفكارهم لا تحظى باهتمام، وأنها تفتقر إلى الشعبية، ومن ثمّ يستنتجون ضرورة إعادة النظر فيها!
الاحباط الرقمي
الإحباط الرقمي أداة جديدة ومتطورة للهيمنة الطبقية، حيث تُستخدم الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بشكل ممنهج وغير محسوس، وعلى مدى طويل وبشكل تدريجي، لنشر محتوى يعزز الشعور بالعجز والاستسلام، خاصةً بين المستخدمات ومستخدمي المنصات الرقمية من التوجهات اليسارية والتقدمية. تعمل هذه الآلية على تضخيم فشل وضعف التجارب الاشتراكية والتنظيمات اليسارية، وإبراز الرأسمالية كنظام أزلي لا يُقهر، مما يرسّخ فكرة استحالة التغيير. كما يتم تعزيز الفردانية، والترويج لحلول فردية كالاستهلاك وتطوير الذات، مما يعزل الأفراد عن أي فعل سياسي جماعي منظم.
إلى جانب ذلك، تُوجه النقاشات داخل التنظيمات اليسارية نحو صراعات هامشية وتُبرزها، مما يشتت الجهود ويضعف القدرة على المواجهة. تعتمد الشركات الكبرى على تحليل السلوك الرقمي لاستهداف المستخدمين والمستخدمات والمجموعات، بمحتوى يولد الإحباط، ويجعلهم يشعرون باستحالة أو صعوبة التغيير الاشتراكي. هذه السياسات والاساليب ليست عفوية، وانما أداة علمية واعية لإجهاض أو إضعاف روح التغيير وضمان بقاء النظام الرأسمالي دون تحدٍ حقيقي ومؤثر.
الاعتقال والاغتيال الرقمي
يُعد الاعتقال الرقمي مرحلة أكثر خطورة من الرقابة والسيطرة الرقمية، حيث لا يقتصر على تقييد وصول المحتوى، وانما يمتد إلى فرض قيود تعسفية على حسابات الأفراد والمجموعات، وتعليقها مؤقتًا ولفترات مختلفة، أو حذفها نهائيًا فيما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاغتيال الرقمي، يتم دون أي شفافية أو معايير واضحة أو قوانين محلية أو عالمية تدافع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات. غالبًا ما تُستخدم ذرائع مثل "انتهاك المعايير المجتمعية" أو "الترويج للعنف" كحجج لحجب هذه الأصوات، رغم أن المحتوى الذي ينشره النشطاء يكون في الكثير من الأحيان توثيقًا لجرائم الرأسمالية كدول وشركات أو انتهاكات حقوق الإنسان.
مثال على ذلك هو القمع الرقمي الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني الذي يُوثّق الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين. خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، قامت شركات مثل فيسبوك، إنستغرام، وتويتر وغيرها بحذف وحظر مئات الحسابات والمنشورات التي تُوثّق جرائم الاحتلال تحت مزاعم «مخالفة المعايير المجتمعية» أو «الترويج للإرهاب»، رغم أنها كانت توثيقًا دقيقًا لجرائم حرب مُثبتة وثقتها منظمات حقوق الانشان. كما جرى استهداف وكالات إعلامية مستقلة من خلال تقييد وصول منشوراتها أو حذف حساباتها بالكامل، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات التي تكشف حقيقة الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
المراقبة الذاتية الطوعية
يتزامن القمع الرقمي وتقييد وصول المنشورات مع ظاهرة "المراقبة الذاتية الطوعية"، حيث يبدأ الأفراد وحتى المجموعات بفرض رقابة على أنفسهم، أو تعديل خطابهم السياسي، أو حتى تغيير محتواه، والتحول إلى قضايا نظرية عامة، والابتعاد عن المواجهة المباشرة مع الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، خوفًا من تقييد وصول منشوراتهم أو التعرض للحظر خلال الاعتقال الرقمي، أو الاغتيال الرقمي من خلال إغلاق حساباتهم من قبل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في المنصات الرقمية. يؤدي هذا الخوف إلى تقويض حرية التعبير، ويصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل وضبط الخطاب العام حتى قبل فرض القيود الفعلية، مما يُعزز الهيمنة الفكرية للرأسمالية، ويُقلّص مساحة المقاومة الرقمية، ويحوّل الإنترنت إلى فضاء مضبوط ومؤطر ذاتيًا وفقًا لمصالح القوى المسيطرة.
على سبيل المثال، خلال فترات الاحتجاجات الجماهيرية في بلدان مختلفة ضد سياسات الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، وكذلك بشكل عام وبدرجات متفاوتة، لاحظ العديد من المستخدمين والمستخدمات أن منشوراتهم التي تحتوي على كلمات مثل "إضراب عام"، "عصيان مدني"، "ثورة"، أو نصوص تكشف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، لم تحقق الانتشار المعتاد، في حين أن المنشورات ذات الطابع التحليلي العام حول الاقتصاد والسياسة لم تتأثر بنفس القدر. دفع ذلك العديد من الناشطين والناشطات إلى تجنب استخدام مصطلحات تصنّفها المنصات على أنها "تحريضية"، مما أدى إلى تحوير الخطاب العام نحو محتوى أقل حدة وثورية، وبالتالي تقليص مساحة التعبير الحر وإضعاف دور وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتعبئة والحشد السياسي.
8. تآكل الديمقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي
بعد السيطرة على العقول والوعي البشري من خلال الرقمنة، لم يعد الأمر مجرد وسيلة لتعظيم الأرباح الرأسمالية، وانما تحول ايضا إلى أداة رئيسية لإضعاف وحتى تقويض الديمقراطية البرجوازية النسبية بدلًا من تعزيزها أو تطويرها، رغم محدودية مصداقيتها في العديد من البلدان، حيث تخضع هذه الديمقراطية لتأثير المال السياسي، والقوانين الانتخابية المجحفة المصاغة لخدمة مصالح معينة، إلى جانب عوامل أخرى. فبدلًا من دعم المشاركة الشعبية الواعية في الحياة السياسية، يجري تسخير الرقمنة والذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل والتلاعب بالرأي العام بما يتوافق مع مصالح الطبقات الحاكمة، عبر التأثير في الانتخابات، وتضييق مساحة النقاش الحر، وتوجيه الخطاب السياسي والإعلامي لخدمة القوى الرأسمالية المسيطرة.
إن السيطرة الطبقية على الذكاء الاصطناعي تعني أن هذه التكنولوجيا، التي يُفترض أن تكون أداة لتعزيز الشفافية والديمقراطية، تُستخدم فعليًا لإنتاج وترويج السرديات التي تحافظ على النظام الرأسمالي القائم. يتم استغلال تحليل البيانات الضخمة والخوارزميات الذكية لتوجيه المعلومات السياسية بما يخدم المؤسسات الرأسمالية، والأنظمة والتنظيمات اليمينية والفاشية الجديدة، والقوى الاستبدادية، مما قد يضعف قدرة الجماهير على اتخاذ قرارات سياسية مبنية على وعي نقدي حقيقي.
في ظل النظام الرأسمالي، لا يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الجماهير أو تعزيز القرارات الواعية والشفافة، وانما كأداة مساهمة لتشويه الحقيقة، وإعادة إنتاج الخطاب الدعائي، والتضليل الإعلامي الذي يُضعف جوهر الحقيقي للديمقراطية القائم على الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الفكرية والسياسية. يتم ذلك عبر استهداف فئات محددة بمحتوى موجه استنادًا إلى تحليل سلوكهم الرقمي، مما يؤدي إلى خلق رأي عام مصطنع يُكرّس الهيمنة الطبقية ويُعمّق الاستقطاب السياسي والاجتماعي. لا يقتصر الأمر على تضليل الناخبين والناخبات، بل يمتد إلى إعادة تشكيل بيئة النقاش السياسي، بحيث تُفرَّغ من مضامينها الحقيقية وتُشبَع بدعاية تخدم الرأسمالية وافكارها اليمينية.
يتجاوز تأثير الذكاء الاصطناعي مجرد التلاعب بالمعلومات، ليصبح أداة مركزية في إعادة إنتاج السلطة السياسية الرأسمالية. فمن خلال توظيف الخوارزميات في إدارة الحملات الانتخابية، وتصميم الخطاب السياسي وفقًا لمصالح رأس المال، والتأثير على خيارات الناخبين والناخبات عبر تقنيات الاستهداف الدقيق، يتم تحييد الأصوات المعارضة وإضعاف البدائل اليسارية والتقدمية - الديمقراطية.
ومثال على ذلك، تدخل الملياردير اليميني إيلون ماسك في الانتخابات الألمانية لعام 2025 عبر منصته "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث دعم بشكل مباشر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، من خلال ترويج محتوى موجه بالذكاء الاصطناعي على منصته، مما أثر على الرأي العام وأعاد إنتاج الاستقطاب السياسي لصالح القوى اليمينية والنازية الجديدة.
في هذه البيئة، لم تعد الانتخابات تعكس الإرادة الشعبية حتى بشكلها النسبي، وتحوّلت إلى ساحة صراع بين الدول الكبرى والقوى الاحتكارية والطغم المالية، التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي كأداة للهيمنة السياسية والفكرية. يؤدي ذلك إلى تشويه التعددية السياسية وإفساد الآليات الديمقراطية النسبية القائمة، حيث يتم إما إضعاف الأصوات التقدمية أو دفع الجماهير نحو بدائل زائفة تُعيد إنتاج النظام الرأسمالي نفسه، وفي أقصى الحالات إحداث تغيير سطحي فقط.
9. التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي في ظل الرأسمالية
التغيرات المناخية وتدمير البيئة من أبرز نتائج الرأسمالية، والآن أصبح الذكاء الاصطناعي أداةً أخرى لاستنزاف موارد الكوكب وتعزيز التدهور البيئي. تُروَّج هذه التكنولوجيا على أنها تقدم حضاري، لكنها تُدار بآليات تخدم المصالح الرأسمالية، حيث تُوظَّف دون التزام حقيقي بحماية البيئة أو ضمان العدالة المناخية. على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن مركز بيانات شركة جوجل في ولاية آيوا الأمريكية يستهلك حوالي 3.3 مليار لتر من المياه سنويًا لتبريد خوادمه، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية المحلية، في وقت تعاني فيه العديد من المجتمعات من نقص المياه العذبة.
تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على تشغيل مراكز بيانات عملاقة تُعَدُّ من بين أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، حيث تعمل هذه المراكز على مدار الساعة لمعالجة كميات هائلة من البيانات وتدريب الخوارزميات، مما يؤدي إلى استهلاك ضخم للكهرباء، التي تُستمد غالبًا من مصادر غير مستدامة، مثل الوقود الأحفوري.
وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، استهلكت مراكز البيانات عالميًا ما يُقدَّر بنحو 240-340 تيراواط/ساعة من الكهرباء في عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 1-1.3% من إجمالي الطلب العالمي على الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك دولة مثل الأرجنتين بأكملها من الطاقة سنويًا. ورغم أن بعض الشركات التكنولوجية الكبرى تزعم الاستثمار في الطاقة المتجددة لتشغيل هذه المراكز، فإن التوسع غير المقيّد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية بمعدلات تفوق أي حلول بيئية جزئية يتم الترويج لها.
تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي لا ينفصل عن الاستغلال الرأسمالي للموارد الطبيعية. يتطلب إنتاج الشرائح الإلكترونية والمعالجات المتطورة استخراج كميات ضخمة من المعادن النادرة، التي يُستخرج معظمها من دول الجنوب العالمي في ظل ظروف عمل قاسية وغير إنسانية. على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يُستخرج معدن الكوبالت المستخدم في بطاريات الليثيوم، يعمل عشرات الآلاف من شغيلات وشغيلة اليد والفكر، بمن فيهم الأطفال، في مناجم خطرة دون معدات حماية، ويتعرضون لتسمم المعادن الثقيلة، مما يُسبّب أمراضًا خطيرة ومزمنة. كذلك أدت عمليات استخراج الليثيوم في تشيلي إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في المناطق القاحلة بنسبة 65٪، مما تسبب في جفاف الكثير من الأراضي الزراعية وفقدان المجتمعات المحلية لمصادر رزقها التقليدية.
لا تؤدي هذه العمليات إلى تدمير البيئات المحلية فحسب، وانما تتسبب أيضًا في تهجير السكان الأصليين، وتسميم مصادر المياه والغذاء، وتعريض المجتمعات الفقيرة لمواد كيميائية سامّة وللمزيد من الأمراض الخطرة، في الوقت الذي تجني فيه الشركات الرأسمالية أرباحًا طائلة دون أي مساءلة أو رقابة دولية حقيقية.
في إطار دورة الإنتاج والاستهلاك الرأسمالية، يتم تحديث الأجهزة الإلكترونية باستمرار، مما يُنتج كميات هائلة من النفايات الإلكترونية. معظم هذه النفايات لا يُعاد تدويرها بطرق آمنة، بل تُصدَّر إلى دول نامية، حيث تتراكم في أراضي تلك الدول، مما يخلق تأثيرات كارثية على بيئاتها. مثلا، تعتبر بعض الدول الافريقية مثل غانا، أكبر مكب للنفايات الإلكترونية في العالم، موطنًا لكميات ضخمة من الأجهزة الإلكترونية المهملة، حيث يتم حرق البلاستيك والمواد الخطرة لاستخراج المعادن الثمينة، مما يطلق غازات سامة تؤدي إلى تلوث الهواء والتربة والمياه، وإلى ارتفاع معدلات السرطان وأمراض مختلفة اخرى بين العاملين والسكان المحليين.
يتطلب التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بناء المزيد من مراكز البيانات وأبراج الاتصالات، مما يُسرِّع إزالة الغابات، وتدمير النظم البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي. على سبيل المثال، تم إزالة آلاف الفدادين من الغابات في عدة دول في العالم الثالث لإنشاء منشآت للبنية التحتية التكنولوجية، مما أدى إلى فقدان بيئات طبيعية حيوية لأنواع مهددة بالانقراض.
بينما يتم الترويج لاستخدام الذكاء الاصطناعي في بناء بيئات صناعية للمناخ كحل لتعزيز الإنتاجية في الزراعة والصناعة، فإن فرض تغييرات قسرية على البيئة باستخدام هذه التقنيات قد يحمل مخاطر بيئية كارثية. إن إعادة تشكيل الظروف المناخية والجيولوجية بطريقة مصطنعة، دون مراعاة التوازن البيئي الطبيعي، قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة واضطرابات مناخية وجيولوجية غير متوقعة، بما في ذلك تفاقم الظواهر الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية.
الرأسمالية الحديثة، التي تدّعي زورًا الاهتمام بالبيئة، لا تختلف عن نماذج الاستغلال السابقة، إذ إن معظم التوسعات التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تأتي على حساب البيئات الطبيعية، حيث يتم تدمير العديد منها بأشكال مختلفة لخدمة الدول الكبرى والشركات الاحتكارية.
10. استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب وتطوير الأسلحة الفتاكة
تُظهر التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي كيف يتم توجيه هذه التكنولوجيا لتعزيز الهيمنة العسكرية بدلًا من استخدامها لتحقيق السلام والتنمية. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم جزءًا أساسيًا من سباق التسلح العالمي، حيث يتم تسخيره لتطوير أسلحة ذكية وتقنيات قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية دون تدخل بشري مباشر. يؤدي هذا التحول إلى زيادة خطر نشوب صراعات أكثر تدميرًا ووحشية، إذ تُقلَّص الحاجة إلى القرار البشري في استخدام القوة القاتلة والمدمرة، مما يجعل الحروب أكثر سرعة وتعقيدًا وأقل قابلية للتنبؤ. ومع تقليل دور البشر في اتخاذ القرارات القتالية، تزداد احتمالية تصعيد الصراعات، ووقوع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، حيث يصبح القتل والتدمير مجرد قرارات خوارزمية تُنفذ بلا مراجعة بشرية أو أخلاقية أو سياسية ودون أي مساءلة.
مثلا، طورت الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول أخرى طائرات مسيّرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات قتالية ذاتية دون تدخل بشري مباشر، حيث يمكن برمجتها لضرب أهداف معينة بناءً على تحليل بيانات مختلفة، مما يثير مخاوف بشأن أخطاء قاتلة ومدمرة قد تنتج عن تحيز الخوارزميات أو أخطاء البرمجة. تستثمر العديد من شركات الأسلحة في تطوير أنظمة مختلفة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يتم تسويقها باعتبارها "أسلحة المستقبل".
لا تقتصر هذه التقنيات على ساحات المعارك التقليدية، وانما تمتد إلى الحروب الإلكترونية، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لاستهداف البنية التحتية الحيوية للدول، مثل الأنظمة المالية، وشبكات الطاقة والمياه، والمرافق الأساسية، مما يزيد من حجم الدمار، ويُعمِّق الأزمات العالمية، ويُفاقم معاناة الشعوب. على سبيل المثال، استخدمت بعض الدول والمجموعات الفاعلة الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، كما حدث في الهجمات السيبرانية على شبكات الكهرباء والمياه في دول مختلفة، مما تسبب في انقطاعات واسعة النطاق للطاقة والمياه، وأدى إلى شلل جزئي للخدمات الأساسية، وهو ما يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي أداة حرب غير تقليدية.
أحد أبرز الأمثلة الحديثة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب الوحشية هو العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث وظّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة لاختيار الأهداف وتنفيذ الضربات الجوية ضد الفلسطينيين. ووفقًا لتقارير صحفية واستقصائية، استخدم الجيش الإسرائيلي نظامًا يُعرف باسم "لافندر "، وهو نظام ذكاء اصطناعي متقدم يعمل على تحليل البيانات الاستخباراتية بسرعة هائلة، وتحديد مواقع القصف بناءً على خوارزميات تحدد الأولويات القتالية دون مراعاة أي اعتبارات إنسانية.
في هذا العدوان الهمجي، تم تنفيذ عمليات قصف موسعة ضد المباني السكنية والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كان العدد الأكبر منهم من الأطفال والنساء، بزعم استهداف "مواقع عسكرية" مزعومة. لكن تقارير منظمات حقوق الإنسان أكدت أن هذه الهجمات كانت جزءًا من سياسة ممنهجة للتدمير الجماعي والتطهير العرقي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
لم يكن الاحتلال الإسرائيلي ليتمكن من تنفيذ هذه الجرائم الوحشية لولا الدعم الذي تقدمه الدول وشركات التكنولوجيا الكبرى، والتي توفر له البنية التحتية الرقمية والخوارزميات المستخدمة في العمليات العسكرية. على سبيل المثال، تُعتبر شركات مثل غوغل ومايكروسوفت من أبرز الشركات التي وقّعت عقودًا مع الجيش الإسرائيلي لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في إطار مشروع "نيمبوس"، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات المراقبة، والتجسس، وتوجيه الضربات العسكرية والتدمير.
جميع الحروب، بغض النظر عن أدواتها، قذرة ولا إنسانية، إذ تؤدي إلى تدمير المجتمعات وإبادة الأبرياء لمصلحة القوى المهيمنة. في هذا السياق، تستغل الشركات الكبرى، بالتعاون مع الحكومات الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية، إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفوق العسكري وتحقيق أرباح طائلة من خلال صفقات بيع الأسلحة الذكية. يتم استخدام هذه التقنيات لتطوير أدوات دمار تُفاقم زعزعة الاستقرار العالمي. إن توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لا يجعله أكثر "دقة" أو "أقل ضررًا"، و يُعزز الطابع غير الإنساني للحروب، حيث تتحول قرارات الحياة والموت إلى خوارزميات تُنفَّذ دون أي بُعد أخلاقي.
***
رزكار عقراوي
....................
المصادر
1. البيان الشيوعي: كارل ماركس وفريدريك إنجلز
2. اصلاح اجتماعي أم ثورة - روزا لوكسمبورغ
3. العمل المأجور ورأس المال - كارل ماركس
4. مبادئ الشيوعية - فريدريك إنجلز
5. السيطرة على الإعلام - نعوم تشومسكي
6. جورج لوكاش - التشيؤ والوعي الطبقي
7. أبرز الأسس الفكرية والتنظيمية لليسار الالكتروني /نحو يسار علمي ديمقراطي معاصر- رزكار عقراوي
https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=730446
8. الرأسمالية الرقمية من منظور ماركس - إبراهيم يونس
https://al-akhbar.com/Capital/364495?utm_source=tw&utm_medium=social&utm_campaign=papr
9. الذكاء الاصطناعي: هل هو خطر على البشرية أم على الرأسمالية؟
https://marxy.com/?p=8218
10. علي عبد الواحد محمد: رأسمالية أصحاب المصلحة
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=845862
11. يونس الغفاري: شبكات التواصل الاجتماعي والقيمة المضافة
https://revsoc.me/technology/46891/
12. أسامة عبد الكريم - كارل ماركس والذكاء الاصطناعي
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=818312
13. "مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن ومستقبل العمل" – مؤسسة
RAND. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.arabic.pdf
14. "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المعاصرة" - مجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات https://aijtid.journals.ekb.eg/article_294487.html
15. "الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية" - مجلة الرافد
https://arrafid.ae/Article-Preview?I=4spRz9xZ9J8%3D&m=5U3QQE93T%2F0%3D
16. "الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان: قوة تأتي من تقديم الأفراد كأولوية" - شركة ماكنزي الوظائف. https://www.mckinsey.com/featured-insights/highlights-in-arabic/human-centered-ai-the-power-of-putting-people-first-arabic/ar
17. "دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب" - مجلة البحوث المالية والتجارية https://afbj.journals.ekb.eg/article_343618_0d53c017d2ecd406844e999d3baeb20a.pdf
18. "الذكاء الاصطناعي: بين خدمة البشرية أو التفوق عليها" - مركز ستراتيجيكس للدراسات.
https://strategiecs.com/ar/analyses/artificial-intelligence-serving-humans-or-surpassing-them
19. هل أصبح الذكاء الاصطناعي آلة للقتل؟
https://www.aljazeera.net/tech/2024/7/21/هل-أصبح-الذكاء-الاصطناعي-آلة-للقتل
حرب غزة: كيف استخدمت إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف؟
20. https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/9708
21. Rethinking of Marxist perspectives on big data, artificial intelligence (AI) and capitalist economic development
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521000081
22. Marx, automation and the politics of recognition within social institutions
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03017605.2024.2391619#d1e107
23. Chen Ping: Through DeepSeek, I See The Future Of Socialism
https://www.memri.org/tv/chinese-commentator-chen-ping-deepseek-future-socialism
24. Nigel Walton: Rethinking of Marxist perspectives on big data, artificial intelligence (AI)
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162521000081
25. The most prominent intellectual and organizational foundations of the electronic left (E-Left)
https://libcom.org/article/most-prominent-intellectual-and-organizational-foundations-electronic-left-e-left