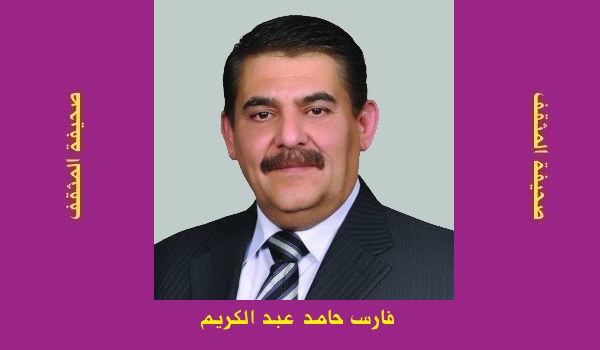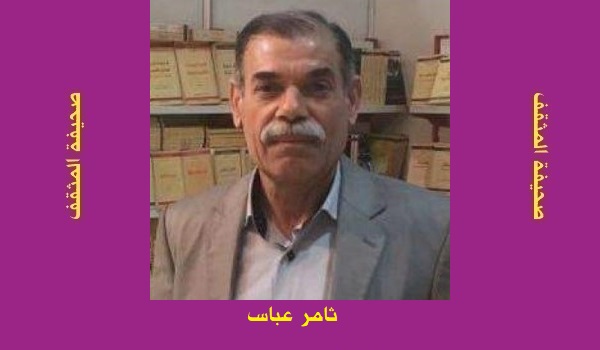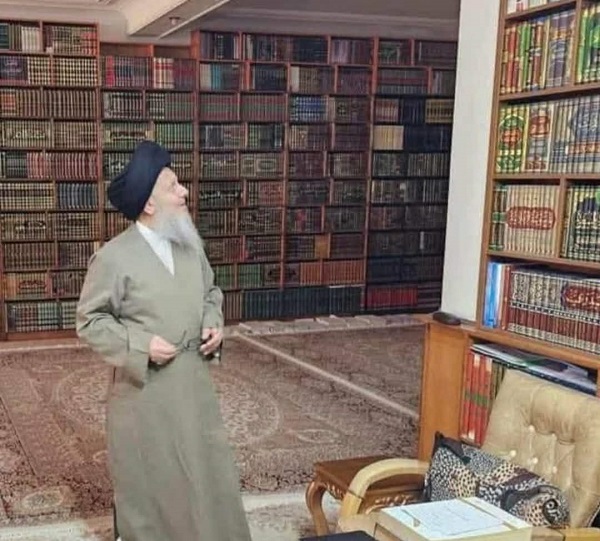يتجلى دور المثقف في لحظات التحول إما كقائد للوعي، أو كشاهد على تفكك المجتمع، وفي الوطن العربي عموماً وسوريا خصوصاً، يواجه المثقف أزمةً عميقةّ يمكن تناولها من ثلاثة محاور:
أولاً: أزمة المثقف و"برجه العاجي"
تتلخص أزمة المثقف في سوريا في تهميشه السياسي والاجتماعي، وغالباً ما يكون دوره سلبياً للأسباب التالية:
1. الغياب عن الشارع والواقع: يميل جزءٌ من النخبة المثقفة التقليدية، إلى الانعزالية النخبوية، حيث ينشغلون بإشكالياتٍ فكريةٍ وثقافيةٍ بعيدةٍ عن هموم المواطنين اليومية، مما يخلق فجوةً واسعةً بين منتِج الثقافة (المثقف) ومستهلِكها (الجمهور العادي). هذا الانفصال يقلّل من قدرتهم على التعبئة والتأثير.
2. التعالي على القضايا الشعبية: بدلاً من الانخراط الفعّال واقتسام الآلام والتعبير عن آمال الناس، يكتفي بعضهم بـالنقد النظري، دون تقديم حلولٍ عمليّةٍ، أو الانخراط في نشاطٍ عمليٍّ لتحقيق الأهداف الديمقراطية.
3. خيار الاستقالة أو المعارضة السلبية: يختار بعض المثقفين الاعتصام بالاستقالة من الشأن العام أو الاكتفاء بـالمعارضة السلبية، مما يفتح الساحة أمام قوى أخرى –غير مدنية– لملء الفراغ القيادي.
ثانياً: إشكالية العلاقة بين الثقافي والسياسي
في سياق التحولات، تبرز صراعاتٌ أيديولوجية تُعقّد دور المثقف، منها:
* هيمنة السياسي على الثقافي: في أغلب الأحيان، يهيمن السياسي على المشهد العام ويهمّش دور المثقف، مما يدفع الأخير إما إلى الولاء للسلطة، ما يُسمى "مثقفي البلاط"، أو الانكفاء، مكتفين بخطابٍ سلبي لا يعترف بالسلطة، دون تقديم أيّ برنامجٍ سياسيّ بديل، يقبله الشعب المسحوق، ويلبي تطلعات الأغلبية الساحقة.
* القيود الأيديولوجية: تقوقع المثقفين داخل مرجعياتهم الأيديولوجية، واعتبار الآخر، من المرجعيات الأخرى، دينية أو ليبرالية، هي آخر منافس وليس مكملا، اوانحراف بوصلة النضال من النضال لبناء دولة قائمة على سلطة القانون الذي يحمي حقوق الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم، وتحوّل الصراع من صراع بناء، إلى إنكار للاخر، لا ييما الذي في السلطة، إذا كان هذا الآخر يخالفهم بالانتماء.
المرجعية اليسارية والقومية: من المثقفين السياسيين التقليديين الذين تسمّرت مفاهيمهم الفكرية، الاجتماعية والسياسية، داخل الفكر الشيوعي، أو القومي، رغم أن الأحزاب اليسارية والقومية، في سوريا، لم تحقق أي نهضة أو تطور في الديمقراطية أو تحسين مستوى معيشة المواطن، على طول المدة التي هيمنت فيها تلك الأحزاب على المشهد الثقافي والسياسي. ورغم أن اليسار الشيوعي، كان منقسماً إلى فئتين لم تحققا نهضة، ولا قبولاً في لدى أغلبية السوريين: إما عضوية ديكورية في الحبهة الوطنية التقدمية، مشارك، وشاهد زور على كل مظالم النظام البائد، يعاني من أمراض النظام الديكتاتوري ذاتها، أو أحزاب شيوعية راديكالية، منهزمة، خائفة، لا يصل مدى تأثيرها لأي أحد، بسبب الخوف من الملاحقة، وطبيعتها السرية. باختصار: رغم فشل التيارات اليسارية والقومية عن تغيير حال الديمقراطية، أو تحسين الوضع المعيشي، فهي لا تعترف بسلطة تختلف عنها في التفكير، وتحوّل دور هذه الفئة من المثقفين إلى تصيّد الأخطاء، وأحيانا ركوب موجة الأخبار الكاذبة، والتعاون مع كلّ الفئات الانفصالية والانعزالية، لإفشال السلطة القائمة، بغض النظر عن الأسلوب والنتائج، متقوقعة في دائرتها النخبوية المغلقة، لا يلتفت إليها أحد من الشعب المنهك، الخارج من قمع نصف قرن، كانت فيه النزعات اليسارية والقومية هي المهيمنة على الوضع السياسي في سوريا.
المرجعية الثيوقراطية: وهناك نمطٌ آخر من المثقفين يستمدّ أدواته الفكرية من النصوص الدينية ذات الصبغة الوثوقية والإطلاقية، ويختزلون الإصلاح المجتمعي في رؤية ثيوقراطية (دينية تحكمية). هذا النمط يتعارض جوهرياً مع مفهوم الديمقراطية المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون وفصل الدين عن الدولة.
* التحالفات غير المدنية: يقع بعض المثقفين في فخ التحالف التكتيكي الخاطئ مع أصحاب النفوذ الخارج عن القانون (تجار المخدرات، أمراء الحرب، العصابات) ظناً منهم أن ذلك وسيلة لإسقاط النظام القائم أو تحقيق مكاسب آنية، متجاهلين أنّ هؤلاء لا يمكنهم بناء مجتمع مدني أو تحقيق مشاركة ديمقراطية، لأن مصالحهم مرتبطة بالفوضى وكسر القانون.
ثالثاً: تحدي الحكم الذاتي واللامركزية
في مناطق مثل السويداء التي تطالب بالاستقلال، أو بعض المناطق الأخرى التي تنادي بالحكم الذاتي أو الإدارة المحلية، يواجه المثقف تحدّياتٍ خاصة:
1. تعزيز الهوية المدنية: بدلاً من الانجرار خلف الانقسامات المذهبية أو القبلية، يُفترض بالمثقف أن يعمل على دمج التنوع الثقافي والاجتماعي في إطار هوية وطنية ومدنية مشتركة.
2. نقد الذهنية التقليدية: يجب على النخب الطليعية مواجهة الذهنية التقليدية التي قد تتفشى في نموذج الحكم الذاتي (مثل سيطرة شيوخ العشائر، أو رجال الدين، أو الفصائل المسلحة)، والتمسّك بالمبادئ الديمقراطية مثل الفصل بين السلطات والعدالة والحريات الفردية.
3. تقديم البدائل: إن دور المثقف الحقيقي في هذه المرحلة هو صياغة مشروع متكامل للحكم الذاتي يرتكز على اللامركزية الإدارية الديمقراطية وليس عسكرة المجتمع أو هيمنة الفصيل الواحد، أو أحلام الاستقلال والنزعات الانفصالية.
إن إفلاس دور المثقف عندما يتقاطع مع الفشل في تقديم مرجعية مدنية بديلة، هو ما يترك الساحة فارغة أمام القوى غير المدنية لفرض أجندتها بالقوة أو النفوذ المالي، مما يقضي على أيّ فرصةٍ حقيقية لبناء نظامٍ ديمقراطيٍّ حديث.
تحليل معمق لأزمة المثقفين من خلال تحليل الأزمة في السويداء
تُظهر الأحداث الأخيرة في السويداء، خاصةً التحالفات والتوترات بين القوى المختلفة، أن هناك أزمة عميقة في الدور الطليعي للمثقفين، وهو ما يجب نقده بوضوح للدعوة إلى تصحيح المسار.
1. تراجع الدور الطليعي وتحول المثقف إلى أداة
التحول الأكثر خطورة هو انزلاق دور المثقف من قائد للوعي ومؤسس للخطاب التنويري إلى تابع أو أداة في يد قوى غير مدنية.
* الخضوع للفكر الدوغمائي: في ظل غياب الدولة والمؤسسات المدنية القوية، لجأ بعض المثقفين إلى المرجعيات الدينية أو الفكر الدوغمائي القروسطي (المتصلب غير النقدي) طلباً للحماية أو الانتماء أو النفوذ الآني. وبدلاً من أن يكون المثقف ناقداً للخطاب الطائفي، والعشائري، تحول إلى مبررٍ له، أو مجرّد صدىً لخطاب رجُل الدين، أو شيخ العشيرة الذي يرفض المساءلة والتعددية.
* الانصياع لمنتفعي الأزمة: تحول جزءٌ من النخب الفكرية، على ضفتي السلطة، موالٍ أو معارض، إلى متعاونٍ صامت مع السلطة وأخطائها، وتقصيرها في الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وسحب السلاح، والبدء الجدّي في تطبيق العدالة والمحاسبة، من جهة، أو مع قوى الأمر الواقع، من تجار المخدرات والعصابات المسلحة التي تسيطر على مفاصل الحياة في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة. هذا التعاون يهدف إلى الحفاظ على مكاسب ضيقة أو تجنب الخطر، وهو ما يُعد استقالة أخلاقية وفكرية كبرى، حيث يتم التنازل عن مبادئ سيادة القانون والعدالة لصالح الفوضى المنظمة.
2. انكشاف عجز القوى غير المدنية عن البناء
لقد كشفت الأحداث المتتالية في السويداء عن حقيقة ثابتة يجب أن يدركها الجميع:
1. عدم القدرة على البناء الديمقراطي: أثبتت التجربة أن رجُل الدين (بمرجعيته غير المدنية)، وتجار المخدرات، والعصابات المسلحة، هم أدوات هدم لا بناء. هم يستطيعون التدمير والتخريب والحماية الذاتية الضيقة، لكنهم يفتقرون كلياً إلى الأدوات المنهجية والفكرية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي تعددي.
2. الطبيعة التناقضية: الهدف الأساسي لهذه المجموعات هو فرض السيطرة والنفوذ خارج إطار القانون، والحصول على مكاسب غير مشروعة (مال، سلطة، سلاح). وهذا يتعارض جذرياً مع جوهر الديمقراطية القائم على التداول السلمي للسلطة، والمحاسبة، وتساوي المواطنين أمام القانون. لا يمكن لمن يعيش على الفوضى أن يؤسس نظاماً مستقراً.
3. الإفلاس الفكري للمشروع: ليس لدى هذه القوى أي مشروع وطني أو رؤية تنموية حقيقية. جلّ ما تقدمه هو التقوقع الطائفي أو القبلي والتبريرات الدوغمائية، مما يساهم في زيادة تفكك المجتمع بدل وحدته.
3. دعوة إلى استعادة الموقع القيادي للمثقفين
في ظل هذا الانكشاف، يُصبح الواجب الأخلاقي والوطني على مثقفي السويداء (وكل مثقفي سوريا) هو استعادة زمام المبادرة والقيادة الفكرية، من خلال:
1. النقد البناء للسلبيات: يجب على المثقف أن يرفع صوته عالياً في نقد كل السلبيات بوضوح، دون خوف أو مواربة، سواء كانت هذه السلبيات صادرة عن الميليشيات، أو رجال الدين، أو مؤسسات الدولة التي تتقاعس عن حماية المواطن، ونهضته، ورفع الغبن عنه، بعيداّ عن انتمائه أو منطقته.
2. التواصل الفعال مع البنى المجتمعية: لا يكفي النقد من "برج عاجي"؛ بل يجب الانخراط الفعلي في البنى المجتمعية، من المجالس المحلية والفعاليات المدنية، لـتجسير الفجوة بين الفكر التنويري واحتياجات الناس اليومية.
3. التعاون لفرض سيادة القانون: على المثقفين التنويريين تشكيل شبكة ضغط واسعة النطاق، للعمل على فرض سيادة القانون ومحاسبة المجرمين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو المناطقي. هذا هو الشرط الأول لبناء المجتمع المدني.
4. هدف المجتمع الديمقراطي الموحد: يجب أن يكون الهدف الأسمى هو الوصول إلى المجتمع الديمقراطي الموحد الذي يسوده القانون والعدل والمواطنة المتساوية، حيث يتم النهوض بالمجتمع وعياً وعمراناً، وحيث تكون الكلمة الفصل للعقل والمنطق وليس للسلاح أو الغلو الديني.
خلاصة القول: المثقف هو ضمير الأمة وبوصلة التنوير. يجب عليه أن يختار بوضوح: إما أن يبقى تابعاً ومبرراً للفوضى، أو أن يعود ليأخذ موقعه كقائد فكري يقود مجتمعه نحو المدنية والديمقراطية وسيادة القانون، وهذا يتطلب شجاعة فكرية تسبق الشجاعة الجسدية.
آليات استعادة الدور القيادي للمثقفين والتواصل الفعّال
إن استعادة المثقفين السوريين لموقعهم القيادي تتطلب الانتقال من النقد النظري إلى العمل المنظم والمؤسسي. يجب على المثقفين العمل ضمن مسارين متوازيين: مسار الضغط والمساءلة على السلطة، ومسار التعبئة وبناء الجسور مع المجتمع المدني.
1. مسار التواصل والضغط على السلطة والمؤسسات
الهدف الرئيسي في هذا المسار هو تحويل المثقف من ناقد معزول إلى شريك ضغط ومساءلة فاعل داخل المشهد السياسي والإداري، يمكن ذكر مجموعة من الإجراءات العملية:
1. تأسيس لجان رصد ومساءلة: بدلاً من الاكتفاء بالانتقاد الفردي، يجب تشكيل مجموعات عمل متخصصة (حقوقية، اقتصادية، إدارية). مهمة هذه المجموعات هي رفع تقارير دورية ومقترحات سياسات بديلة إلى الجهات الرسمية (سواء كانت مؤسسات الدولة أو الإدارة المحلية). هذا يهدف إلى توفير مرجعية فكرية مدنية لمتخذي القرار وتصحيح مساراته بعيداً عن المصالح الضيقة.
2. فرض قنوات حوار مفتوحة ومؤطرة: يجب على المثقفين المطالبة بتفعيل آلية حوار دوري وعلني بين ممثليهم والمؤسسات الرسمية لمناقشة القضايا الحيوية كالتنمية والأمن ومشاريع اللامركزية. هذا يهدف إلى إجبار السلطة على الاعتراف بالصوت المدني وإشراكه في صنع القرار بدلاً من إقصائه.
3. حملات الضغط القانوني والمدني: يتوجب استخدام الأدوات القانونية المتاحة لرفع شكاوى، أو دعاوى ضد الفساد، أو الانتهاكات، أو غياب الخدمات الأساسية، مصحوبة بـحملات إعلامية مدنية ضاغطة. هذا العمل يمثل آلية لـفرض سيادة القانون من القاعدة إلى القمة ومحاسبة المجرمين والمتجاوزين.
4. المشاركة الفعّالة في المجالس المحلية: يجب على المثقفين عدم الاكتفاء بالانتقاد من الخارج، بل الترشح والاندماج الفعلي في المجالس المحلية (البلديات، مجالس الإدارة الذاتية المقترحة) لضمان التعددية داخل هذه المؤسسات ومنع هيمنة اللون الواحد (العشائري أو الديني أو العسكري).
2. مسار التعبئة وبناء الجسور مع المجتمع المدني
يهدف هذا المسار إلى كسر جدار العزلة المناطقي وتوحيد الخطاب المدني على مستوى وطني أوسع، لمواجهة خطر الانقسام المجتمعي.
1. تنظيم "ملتقيات المواطنة السورية": يجب إطلاق مبادرات لتنظيم مؤتمرات وندوات (حتى عبر الإنترنت) تجمع مثقفين وتنويريين من كافة المناطق السورية. هذه الملتقيات يجب أن تركز على الهوية الوطنية الجامعة وصياغة مشروع مشترك للدولة المدنية الموحدة، لكسر الانعزال المناطقي وتوحيد الرؤية المستقبلية.
* الشراكات الثقافية العابرة للمناطق: ينبغي إطلاق مشاريع ثقافية مشتركة مثل المعارض الفنية، أو المهرجانات الأدبية، أو المبادرات التعليمية التي يشارك فيها فنانون وكُتاب من مختلف المحافظات، بعيداً عن، أو بالتوازي مع الفعاليات الثقافية الحكومية. هذا يعزز الاحترام المتبادل للثقافات المحلية، ويؤكد التنوع السوري كقوة وطنية.
* إنشاء منصات إعلامية مستقلة: يجب تطوير منابر إعلامية رقمية (مواقع، مدونات، قنوات بودكاست) يكون شعارها النقد التنويري والتحليل العقلاني، بعيداً عن التمويل والتبعية لأي طرف متشدد أو فصائلي. هذا يهدف إلى استعادة المثقف كمرجعية إعلامية بديلة وكسر هيمنة خطاب اللون الواحد، وخطاب التفاهة، وثقافة (الترند).
* برامج التوعية المجتمعية القاعدية: تنظيم ورش عمل وجلسات حوار مفتوحة في الأحياء والجامعات حول مفاهيم أساسية مثل حقوق الإنسان، اللامركزية، المساءلة، والديمقراطية المحلية. هذا يساهم في بناء وعي مدني لدى القاعدة الشعبية، لتكون حائط صد ضد محاولات المتشددين والمنتفعين.
النقطة المفتاحية: التخلص من فكرة "المثقف المنفرد"
يجب أن يدرك المثقف السوري أن قوته لا تكمن في عبقريته الفردية، بل في قدرته على التنظيم والتشبيك والعمل كمؤسسات مدنية موحدة. إن العمل كـ "لوبي فكري" قادر على فرض رؤية العقل والتنوير كبديل وحيد وفعال للفوضى والطائفية والدكتاتورية هو الطريق الوحيد لاستعادة زمام القيادة المجتمعية.
أزمة غياب المثقف السوري عن القيادة المدنية
تُظهر الأحداث في السويداء، وما سبقها في مناطق سورية أخرى، أن الأزمة الأعمق تكمن في تراجع دور المثقف السوري من قيادة الوعي إلى الانكفاء أو التبعية، مما يهدد مستقبل الدولة المدنية والتعددية.
1. غياب النقد والحوار الفعّال مع السلطة السياسية
أحد الجوانب الأكثر سلبية في دور المثقف هو عزوفه عن المواجهة الفكرية والنقد البنّاء مع القوى السياسية القائمة (سواء كانت سلطة مركزية أو سلطات أمر واقع محلية).
* فقدان وظيفة النقد: المثقف هو مرآة المجتمع وناقده الأول. عندما يغيب دوره في النقد المستمر للسلبيات ومحاسبة المتنفذين، تترسخ سياسة الإفلات من العقاب وتزداد الديكتاتورية قوة.
* عزل المثقف عن الدولة: لم ينجح المثقفون في إقامة قنوات حوار فعّالة ودائمة مع مؤسسات الدولة والبنى السياسية، بهدف توجيه القرارات نحو مصالح الشعب السوري عموماً وأبناء محافظتهم خصوصاً. هذا الغياب يترك المؤسسات فريسة لأصحاب المصالح الضيقة والتوجهات الأحادية.
* المشاركة العادلة: يترتب على غياب المثقف عن الحوار فقدان فرص الضغط من أجل ضمان المشاركة العادلة لجميع الفئات، ومنها المثقفون وقوى المجتمع المدني، في قيادة البلد، مما يجعل الدولة أو الإدارة المحلية رهينة ل "اللون الواحد" (العسكري، الديني، أو العشائري).
2. خطر الانعزال وخلق "الجزر المجتمعية"
الخطر الأكبر الذي يواجه المثقف السوري اليوم هو الانعزال المناطقي عن بقية النسيج المجتمعي، وهو ما يتناقض مع دوره التاريخي كـقوة توحيد.
* غياب الحوار بين المكونات: فشل المثقفون في السويداء، وفي مناطق أخرى، في فتح قنوات تواصل وحوار فعّال ودائم مع الفعاليات المجتمعية والثقافية في مناطق سورية أخرى. هذا الغياب يؤدي إلى تأكيد الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
* الانزلاق نحو التطرف والدكتاتورية الدينية: عندما يغيب الصوت المدني التعددي، تزداد احتمالية انزلاق مؤسسات الدولة أو الإدارة المحلية إلى اللون الواحد، خاصة الصبغة الدينية المتشددة من اتجاه واحد. هذا الانزلاق يولد تطرفاً ودكتاتورية من نوع خاص، حيث تسود مظاهر اجتماعية وثقافية انعزالية ترفض الآخر المختلف.
* خلق جزر منعزلة وغياب المواطنة: النتيجة الحتمية لهذا الانزواء هي خلق جزر مجتمعية منعزلة ومتقوقعة على ذاتها (سواء كانت طائفية أو مناطقية)، مما يؤدي إلى غياب الشعور بالمواطنة الجامعة لدى جميع الفئات السورية. المواطنة لا تُبنى بالانعزال، بل بالتفاعل والتشارك.
3. استعادة الدور الطليعي نحو المجتمع الديمقراطي المتنور
يجب على المثقفين وقوى المجتمع المدني في السويداء (وسوريا عموماً) استعادة موقعهم القيادي الطليعي عبر:
* التمسك بالمرجعية المدنية: إعلان الرفض القاطع لأي تحالف مع القوى الخارجة عن القانون (تجار، عصابات مسلحة) أو أي محاولة لفرض المرجعية الدينية الأحادية على المجتمع والدولة.
* فرض سيادة القانون: يجب أن يكون المثقفون هم أول من يطالب بالتعاون مع كل القوى التنويرية في الوطن لـفرض سيادة القانون ومحاسبة المجرمين والمنتفعين من أي طائفة أو منطقة كانوا، كشرط أساسي للنهوض.
* بناء المجتمع المتنور والموحد: يتركز دور المثقف في بناء المجتمع الديمقراطي المتنور القادر على استيعاب جميع مواطنيه واحترام الثقافات المحلية المتنوعة التي تشكل النسيج المجتمعي السوري الممتد عبر مئات السنين. هذه التعددية هي قوة المجتمع وليست نقطة ضعفه.
الخلاصة: إن مهمة المثقف اليوم هي كسر جدار العزلة، واستئناف النقد الفعّال، وتوحيد الخطاب المدني، لكي يثبت أن قيادة الدولة يجب أن تكون للمدنيين الواعين وليس لأصحاب السلاح أو الفكر الدوغمائي، منعاً للانزلاق إلى دولة فاشلة يسيطر عليها التطرف والانعزال.
***
منذر فالح الغزالي
30.11.2025