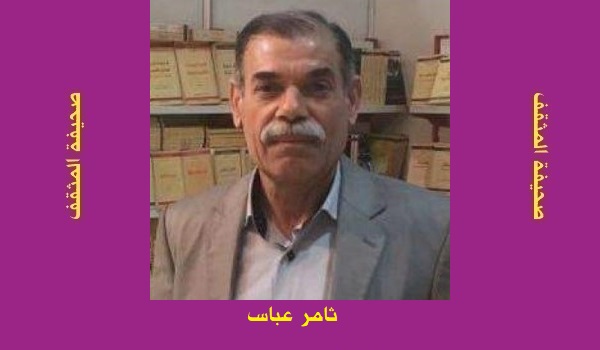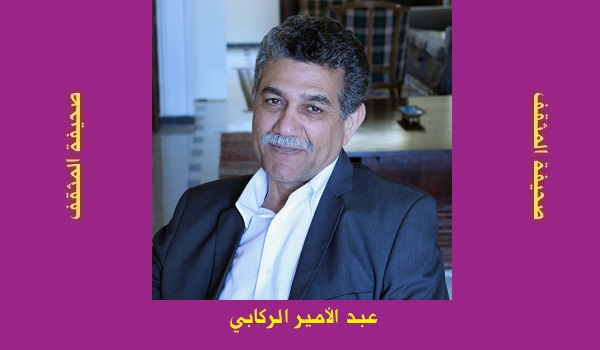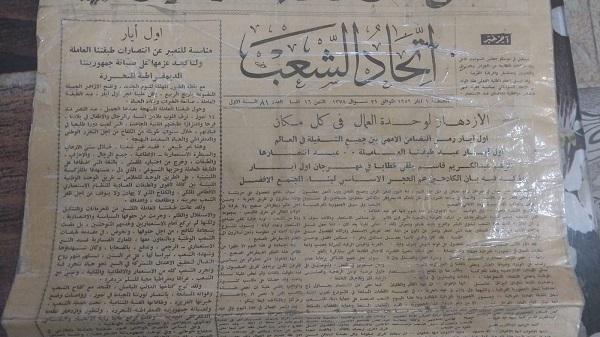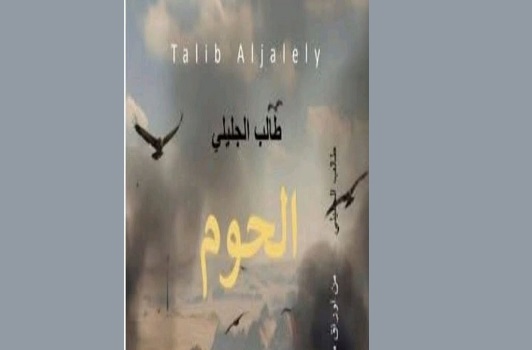امتثلت رؤية الأنظمة العربية لواقع التبعية المشبوهة المفعمة بالشر، واعتمدت تلك الأنظمة على سياسةٍ قمعية بحقِ شعبها على امتداد الساحةِ العربيةِ المتراميةِ الأطراف، وانحازت بمجملها إلى جانب القوى الأجنبية الخارجية، وبذلك تلاشت السيادة، وتلاشى الاستقلال والتحرّر.
ومن خلالهم ووفق توجيهات من يدعمهم تشوّهت الرسالة الإعلامية، كما الرسالة الثقافية والتربوية، وبرزت ثوابت الانتهازية والفساد والتكبّر والإقصاء والقمع.
كما تلاشى الحقّ العربي منذ سنواتٍ طوال، وتلاشت أيضاً اللحمة العربية أيضاً، حيث عجزت كل القمم العربية من توحيد الصف العربي، ومن تطوير مشروع الأمن القومي العربي، أو أي مشروع واضح المعالم والأهداف، يجمع العرب ويوحّدهم، رغم كثافة طاقتهم وقدرتهم وثرواتهم، وعلى الأقل على المستوى الإقتصادي، أو التعاون العسكري، أو حتّى تطوير المؤسسات التربوية. لكنهم نجحوا فعلاً في مُطاردةِ المواطن العربي وقمعه ومحاربته في أمنه الغذائي والصحي.
لذلك فرغت الساحة العربية من المفكرين ومن السياسيين الجادين في عمل أي خطوةٍ إيجابية ٍ نحو الأمام.
كما انتشرت الإجتهادات الغوغائية التي تلعب دورها أيضاً في تمزيق الأمّة والموقف العربي.
فهل يُعقل أن الأنظمة العربية والحكّام العرب عجزوا فعلاً عن رؤية الطريق الصائب نحو بناء الإنسان العربي المبدع والمبتكر والحفاظ على كرامته وسيادته.
من خلال هذا الواقع المتردي إنتشرت شعارات دخيلة على الساحة كأن يُقال الأردن أولاً أو لبنان أولاً. في الوقت الذي يُعاني فيه الشعب الفلسطيني وتواجهه مشروعات إبادة، لكنه لا يزال صامداً ومقاوماً وهو يتطلّع بشغف إلى دولته على رقعة جغرافية من وطن، كما رسمها لهم العرب.
إن الذي أوقف وحدة الشارع العربي، وثقافة التعايش العربي والإعتزاز، وامتلاك الهيمنة والقوة، وعلى كل المستويات، أسباب عديدة.
مثل القمع الذي مارسته الأنظمة العربية بحق المواطن، والذي أثار الكراهية بين الشعب الواحد، فهناك شريحة واسعة من الناس تم حرمانها من الوظائف بسبب رؤيتها للواقع المُعاش، أو لموقفها السياسي، وبقيت الوظائف في الدولة محجوزة لمن يوالون النظام القائم.
وكثيرون من الناس تتم ملاحقتهم ويتم زجّهم في السجون، ومنهم من تمت تصفيته، ومنهم أيضاً من فرّ إلى خارج البلاد.
كافة الأنظمة العربية تُكرّم على الدوام من يواليها، كما تُقدّم جماعة على أخرى، وطائفة على أخرى، وتنحاز بشكلٍ جلي لصالح مجموعة سياسية على حساب مجموعات سياسية أخرى.
الجميع يعلم أن كل الدول العربية في القرن الماضي تحررت من الاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي، وأعلنت إستقلالها، لكن هذا الاستقلال تبرعت به الأنظمة العربية مرة أخرى للقوى الإستعمارية من خلال التبعية الشريرة التي تحكم العالم العربي كله.
الأنظمة العربية نفسها هي التي اجتهدت ونشرت قيم الفساد والنفاق والكراهية، وفرّقت الناس عن بعضهم، ونشرت فيما بينهم الأحقاد والفتن لسببٍ وجيهٍ واحد، أن الأنظمة القمعية المشبوهة ليس بوسعها أن تكون لصالحِ المواطن والمجتمع، بل تضخ بين مواطنيها كلّ أشكال الفتن كي يبقى الحاكم على الكرسي كحارسٍ أمين للمجتمع وللدولة من وجهة نظرها.
وهذا يكفي وكما يشاء الغرب أن تتدهور الدول العربية، حتّى أن أي حاكمٍ لم يعد بمقدوره تحقيق التآلف في وطنه.
تمزّقت الهوية العربية، وبالتالي تشوّهت هوية المواطن أمام نفسه والآخرين.
علينا أن لا ننسى أن تجّار الدين المقرّبون من الأنظمة الذين أباحوا لأنفسهم أن يقوموا بالإفتاء في مختلف الأمور نيابةً عن الأمّة، ووجّهوا الأمور ليس وفق التعاليم الإلهية، بل وفق مصالحهم ومصالح الحاكم، وكما يُملى عليهم.
ومعظم هؤلاء فتحوا درب التمزّق والاقتتال، لذا انتشرت العديد من الجماعات الإسلامية التكفيرية المتشددة والمتطرفة، وكلّ منها يدّعي أنه يملك مفاتيح الجنّة ومجموعته هي الفائزة.
هؤلاء تحوّلوا إلى خلفاء الله على الأرض ولديهم التفويض المطلق لتوزيع الناس، هذ إلى الجنة، وذاك إلى النار، ويجب قتله.
وأصبحت كل جماعةٍ تُكفّر الأخرى، بل وتُخرجها من ملّةِ الإسلام، وبالتالي انتشرت الفتن المذهبية.
ويبقى المواطن وحده هو الذي يدفع ثمن العهر السياسي للدولة والفتن المذهبية، دماً غزيراً في كلّ بقعةٍ جغرافيةٍ عربية.
وانحاز الإعلام العربي الأسود والمشبوه للفرق الضالة، ضد فرقٍ أخرى، وهو يُمجّد بسلطان الدولة، فغرقَ العربي في التشويه والتضليل الذي زاد الهوّة بين الناس وغُيّبَ وإلى الأبد أي مشروعٍ عربي موحد.
مشكلتنا الأساسية نحن العرب بأننا نفتقد الطموح والإبداع، ولا نريد أن نتعلّم ونسمو بالعقلِ وبالفكرِ والتحليل الموضوعي لكل مشاكلنا، ولكل الظواهر السياسية والاجتماعية التي نعاني منها.
وستبقى الأوضاع تتدهور ويتحكّم بنا الأجنبي الذي يُسيّرنا وفق مصالحه ومخططاته المدمّرة، ما دام التفكير غائباً، والفهم العقلاني لمجريات الأمور لا يُؤخذ به، ولا تأتي الصحوة إلاّ بعد أن يبلغ نزيف دماء الساحة العربية حدّه الأقصى، وعندما تقع الفأس على الرأس، حينها يمكن أن نفكّر.
مع الأسف معظم مشاكلنا ونزيفنا الدموي لم يتوقّف ما دامت هناك دول عربية تقوم بسكب الزيت على النار وعلى الدوام، بسبب الخلاف العربي - العربي.
والكيان الصهيوني يلعب دوراً مهماً في هذا المجال، فلقد إستطاع أن يكسب ود بعض الأنظمة العربية التي أصبحت حليفة له، ووفيّة للكيان الصهيوني وتُنفّذ كل أوامره وطلباته.
كما أن الكيان الصهيوني يعنيه تماماً إضعاف العرب وتمزيق العرب، من خلال ممارساته في إشعال الفتن وتمزيق كلّ ما يمسّ النسيج الاجتماعي والأخلاقي والإنساني العربي.
بكل تأكيد إن المسؤولية تقع علينا حول التدخل الصهيوني والخارجي بشؤوننا، لأننا ربطنا تبعيتنا معهم وبهم، ومن خلال هذه التبعية قاموا بفتح كلّ الثغرات في بلادنا، إن كانت اجتماعية أو ثقافية أو عسكرية وسياسية واقتصادية، وأصبح هو الذي يتحكّم بنا وبمسيرتنا.
إذاً العرب أنفسهم هم الذين يسمسروا على أوطانهم وعلى أنفسهم، وبذلك أصبح العداء بين العربي والعربي أشدّ وأقسى من عدائنا لكل الأعداء الخارجيين بما فيهم الكيان الصهيوني.
مع الأسف أمّتنا تعيش أسوأ أحوالها، بينما الصهيونية أصبحت في أحسن أحوالها وتطورها، وتقوم أيضاً بتصعيد الحروب الأهلية والصراعات داخل المنطقة العربية، وتُدمّر بنفس الوقت تركيبة الجيوش العربية.
لقد ساهمت الدول الاستعمارية بعد مرحلة الاستقلال العربي بصناعة نظاماً عربياً مختلاً، رغم أن المنطقة العربية تملك كل مقوّمات التمسّك والشموخ والقوة والثروات الهائلة، والحضارة والتاريخ والمصالح الواحدة، وزرعت في أحضان هذه الأمّة كياناً صهيونياً غريباً.
لا ننكر أن النظام الاقليمي العربي قد وُلدَ مختلاً فعلاً، لذلك اليوم يحصد هذا العالم العربي نتاج ما زرعته الأنظمة العربية طوال سنواتٍ سابقة طوال، ولن تقوم له أي قائمة إلاّ بعد إصلاح هذا الخلل، والإصلاح في حالة سُبات.
الخلل في ممارسة كل أنواع القمع والوصاية والإقصاء من قبلِ الأنظمة الحاكمة، وتبعيتها للأجنبي من أجلِ حماية الكرسي، واحتكار هذه الأنظمة لكل الثروات الطبيعية الوطنية، ونشر الفساد وحيتانه، وتجميد العقول والسيطرة عليها، وانتشار مفهوم دولة المخابرات، حيث أُهين المواطن، وتم الإختراق الخارجي لهيبة الدولة.
لقد أصرّ الحكّام العرب على إغلاق مختلف أبواب التغيير السياسي، من خلال تبريرات سرابية، مفعمة بالشعارات الزائفة.
ولا بُدّ لنا إلاّ أن نتساءل، ما هو موقف العرب في حال اندلاع حربٍ موسّعة إقليمية أو دولية، وما هو مستقبل " جامعة الدول العربية "، وما هو موقف الأنظمة العربية من الموجة التصاعدية للحركات المتطرفة بعد سنواتٍ من موجات العنف وبروز التنظيمات المسلحة المتطرفة الجهادية في الميدان العربي ؟.
كلّ المؤشّرات تؤكّد أن الوطن العربي يمرّ بأزمةٍ كبيرة، وأن الحديث عن مستقبل العرب المعروف منذ إنتهاء الحرب العالمية الأولى والخلافة العثمانية، لا يزال الحديث عنه قائماً منذ أكثر من 100 عام بدون أي إجابةٍ أو حل، إنّه الفراغ الفكري والايديولوجي لكافة الأنظمة العربية.
لذا على كافة الكتاب والمفكرين المثقفين العرب أن يأخذوا دورهم الفاعل ويتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية والقومية والإنسانية من أجل تقييم الواقع، ورسم البرنامج الفعّال كرؤيةٍ مستقبلية جديدة، وتفعيل مشروعٍ نهضوي للعالم العربي، يستطيع الإجابة بعمق عن " مستقبل العرب ".
مع الأسف لقد إنهزمت الأنظمة العربية استراتيجيّاً، والتجأت إلى القوى الخارجية وحوّلت الساحة العربية إلأى ساحةٍِ لصراعات المصالح الأجنبية، وبذلك تلاشت الثروة العربية، المال العربي، والأمن العربي، والمواطن العربي.
الإقليم العربي يشهد صراعات وترتيب صفقة المستقبل، كل القوى العدوّة تلعب كما يحلو لها ويروق في الميدان، ووحدهم العرب هم الغائبون عن الميدان، في الوقتِ الذي تصلهم فيه أخبار الميدان من الخارج، وكأن ما يحدث في المنطقة العربية لا يعنيهم، أو أنه يحدث في مناطق نائية خلف المحيطات.
مع الأسف أن العرب هم آخر من يعلم تأثير الأزمات الاقليمية عليهم، ومن المؤكّد أن كلّ أزمةٍ إقليمية ينتج عنها العديد من التداعيات والشروخات، والتي بالتالي تؤثّر عميقاً في الدول، بحيث لا تستطيع أجهزة تلك الدول منع حصولها.
فقط العرب الذين يقعون في هكذا مطبات التي تُعتبر من البديهيات عند الدول الأخرى، المُعادلة تؤكّد أن القوة والحكمة تكمن في السيطرة على الأزمة قبل وقوعها، بهدفِ صيانة الأمن الإقليمي.
أمام هذا الواقع المتردي والمتشعّب لا بُدّ إلاّ أن نتساءل:
هل هناك من وسيلة للحدّ من مسار الانحدار المتفاقم عند العرب؟.
الشعب العربي هو كبقية شعوب العالم، الجميع يتشاركون بشكلٍ جاد للنضال ضد العدوان والقمع والإستبداد، والجميع تابع ولا يزال التضحيات التي قدّمتها الجزائر وسورية ومصر وفلسطين واليمن وليبيا، والدم الذي قدّمته هذه الدول وغيرها بهدفِ التحرّر والسيادة، ومع ذلك هذه الدول لم تصل إلى برّ الأمان المُراد، فالشعارات والأغاني الوطنية لا تصنع دولاً، والحاكم المستبد ولا جيشه يصتع وطناً.
ما تشهده الساحة العربية يُؤكّد لنا بصيص النور الذي يُرى في نهاية النفق، لا يملك الأمل للخروج من هذا الواقع المرير، غزّة وفلسطين ينتهج الكيان الصهيوني حولها حرب إبادةٍ صريحة، والعرب صامتون لغاية الآن، والعالم كله يتابع بصمتٍ وتجاهل.
في عملية إستلام وتسليم برعايةٍ إقليمية ودولية، جاؤوا بأبو محمد الجولاني ليكون متنفّذاً بسورية، وهو الذي كان في القاعدة، ومن ثُمّ في داعش وبعد ذلك جبهة النصرة، ومن ثم في فتح الشام وأخيراً في تحرير الشام، وتاريخه كله يشهد له بأنه كان يُمارس القتل والذبح والإبادة لمختلف الطوائف التي يجدها أمامه، وأصبح الجيش السوري معظمه من الأجانب المتطرفين والجهاديين المرتزقة من الشيشان والأنغور وسواهم، وكلهم عبارة عن فصائل مسلحة تكفيرية يحكمون سورية الآن، وإسرائيل اقتحمت الجنوب السوري ووصلت إلى حدود الأردن والعراق، والعرب صامتون وكأنهم لم يسمعوا شيئاً، وتركيا تقيم قواعد عسكرية، وأمريكا أيضاً، والأكراد أيضاً لهم حصّة، والساحل السوري له حصّة، وهذا يعني أن سورية تتحوّل تدريجياً إلى خمس دويلات، والعرب نائمون في سباتٍ عميق، والمخطط الصهيوني يتابع مسيره فهو واضحٌ وتم الإعلان عنه، سورية هي المفتاح ومن ثم يبدأ دور لبنان والأردن والعراق ومصر والسعودية، وأيضاً العرب يتجاهلون، وكأنهم ينتظرون أن يصل الدور عليهم.
المخطط واسع وخطير، ومع الأسف العرب لم يتفاعلوا مع هكذا مخطط بشكلٍ يتناسب مع خطورة الحدث، وكأنهم في حالة موتٍ سريري.
كافة المنظمات الحزبية والفكرية والأدبية تتناول الأزمات بشكلٍ خجول مع الأسف.
إننا بحاجةٍ ماسّة إلى صحوة الضمير العربي، وإلى العمل الجاد من أجلِ النهوض بمشروعٍ عربي قبل فوات الأوان.
وعلى الأنظمة العربية الكف عن تقليد النعامة ودفن الرأس في الرمال، وكأن الأمّة مصرّة على تلقّي النكسات المتتالية، والصعود وبقوة نحو الهاوية.
يا ابن الوليد ألا سيفُ تؤجّره
فكلّ أسيافنا قد أصبحت خشبا.
نزار قباني.
إن انتهاج سياسة الحكمة والعقلنة قبل فوات الأوان جديرٌ بأن يُخرج المنطقة العربية من هذا الوضع اليائس.
إن التمترس وراء ممارساتٍ كيدية على حساب الأمن القومي العربي المشترك، وعلى حساب الأمن الاستراتيجي سيجعل المنطقة العربية بقعةً من سراب.
يبدو أن الحكّام العرب لا يعنيهم إلاّ الكرسي مهما كان الثمن، حتّى ولو أُبيدت الأوطان أمام أعينهم وهم يتباهون بأوسمة التبعية، ولا يحرك ذلك فيهم أي أي حسٍ وطني أو قومي أو إنساني. كأن ضميرهم ميّت، بل هم كذلك.
كما صمتوا عن ذبح وإبادة العربي في غزّة وفلسطين فإن مدية الجزّار ستحزّ دمهم عاجلاً أم آجلاً ومن الوريد إلى الوريد.
هل يستطيع المفكرون والسياسيون وعلماء النفس البشرية والاجتماع أن يأخذوا دورهم الجريء لبناء جيلٍ حر كاسر لجدار الخوف وهو بطبعه ينادي بجرأة وإخلاص ووعي وإدراك من أجل الحرية وطمس كلّ معالم القمع الإستبدادي والفساد والعهر السياسي المتفشي في البلاد، وأخذ دوره الفاعل المُشارك في صناعة القرار السياسي والعسكري والأمني والثقافي والتربوي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة ؟.
على كافة الكتّاب والمفكرين والمثقفين والأدباء العرب أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الجادّة من أجلِ إعادةِ الصواب إلى البوصلة العربية، وإلاّ عليهم أن يستمروا في صمتهم، ويعلنون فشلهم وبالتالي أن يخرجوا من الميدان، ويكفّوا عن النفاق، وعلى الأمّة والأوطان السلام.
وسيبقى السؤال الذي يأتينا وعلى الدوام بدون أي إجابة، وكأنه قادمٌ من سهول السراب مخترقاً الفضاء المبهم.
***
د. أنور ساطع أصفري