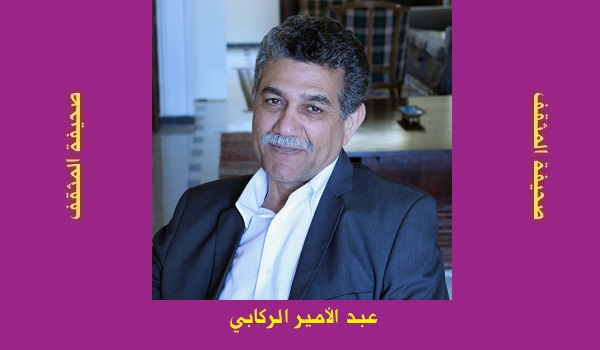في مطلع القرن العشرين، وفي سياق الصراعات الطبقية العنيفة التي ولّدتها أزمة الرأسمالية وحروبها الهمجية، برزت فكرة عالم جديد داخل حركات المساواة. وفي مواجهة فكرة القطيعة الثورية هذه، برز تياران سياسيان جديدان أيضاً: الفاشية والاشتراكية الوطنية. وقد أفسح سحق الثورة الاجتماعية في إيطاليا وهزيمة الثورة الألمانية المجال لهذه التنظيمات الشمولية.
تتميز الفترة الحالية باختلال التوازن الاقتصادي، وتنامي التفاوت الطبقي، وانهيار فكرة المصلحة الاجتماعية، وانهيار جماعات المستغَلين أيضاً. ومرة أخرى، يظل أفق الرأسمالية غامضاً. الأيديولوجيات القديمة مُهتزة، ويسود انعدام الأمن والخوف، وقانون الأقوى يَعِدُ بالسلامة، حتى مع تقليص متطلبات الربح للمساحة السياسية "للإصلاحات". أمام اتساع نطاق القضايا المطروحة، تفقد معالم الماضي وضوحها مع نسيان التاريخ، ويتسع مجال الالتباس. تكتسب التحالفات والتقاربات السياسية قوةً من خلال استحضار قيمة مبدأ السلطة القديم. يبدو أن الانفصال الواعي عن نظام الربح وحده كفيلٌ بتوضيح الأفكار وفتح آفاق جديدة. في غضون ذلك، يبدو أن توضيح جوانب الحاضر المظلمة من خلال فهم أفضل للماضي أمرٌ حيوي.
الاشتراكية الاستبدادية
الاشتراكية الاستبدادية، أو الاشتراكية من الأعلى، هي نظام اقتصادي وسياسي يدعم شكلاً من أشكال الاقتصاد الاشتراكي، ويرفض التعددية السياسية. يُمثل مصطلحها مجموعة من الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي تصف نفسها بأنها "اشتراكية" وترفض المفاهيم الليبرالية الديمقراطية للتعددية الحزبية، وحرية التجمع، وحق المثول أمام القضاء، وحرية التعبير، إما خوفاً من الثورة المضادة أو كوسيلة لتحقيق غايات اشتراكية. وقد وصف الكتّاب والباحثون العديد من الدول، أبرزها الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا وحلفاؤها، بأنها دول اشتراكية استبدادية.
على النقيض من أشكال الاشتراكية الديمقراطية، والمناهضة للدولة، والليبرالية، تشمل الاشتراكية الاستبدادية بعض أشكال الاشتراكية الأفريقية، والعربية، وأمريكا اللاتينية. على الرغم من اعتبارها شكلاً استبدادياً أو غير ليبرالي من أشكال اشتراكية الدولة، والتي غالباً ما يُشار إليها ويُخلط بينها وبين الاشتراكية من قِبل النقاد، ويُجادل النقاد اليساريون بأنها شكل من أشكال رأسمالية الدولة، إلا أن تلك الدول كانت ماركسية لينينية أيديولوجياً وأعلنت نفسها ديمقراطيات عمال وفلاحين أو ديمقراطيات شعبية. يميل الأكاديميون والمعلقون السياسيون وغيرهم من العلماء إلى التمييز بين الدول الاشتراكية الاستبدادية والدول الاشتراكية الديمقراطية، حيث كانت تُمثل الأولى في الكتلة السوفيتية، وتُمثل الثانية دول الكتلة الغربية التي حُكمت ديمقراطياً من قِبل أحزاب اشتراكية - مثل بريطانيا، وفرنسا، والسويد، والديمقراطيات الاجتماعية الغربية بشكل عام، من بين دول أخرى. يُعرف أولئك الذين يدعمون الأنظمة الاشتراكية السلطوية باسم "التانكي" tankies ازدرائياً. على الرغم من أن الاشتراكية الاستبدادية نشأت من الاشتراكية الطوباوية التي دعا إليها الكاتب السياسي الأمريكي "إدوارد بيلامي" Edward Bellamy (1850-1898) والتي وصفها الباحث الاشتراكي الأمريكي "هال درابر" Hal Draper (1914-1990) بأنها "اشتراكية من أعلى"، إلا أنها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالنموذج السوفيتي، وتمت مقارنتها بالرأسمالية الاستبدادية. وقد تعرضت الاشتراكية الاستبدادية لانتقادات من اليسار واليمين، نظرياً وعملياً.
الجذور السياسية
تنبع الاشتراكية الاستبدادية من مفهوم الاشتراكية من أعلى. عرّف "هال درابر" الاشتراكية من أعلى بأنها الفلسفة التي تستخدم إدارة نخبوية لإدارة الدولة الاشتراكية. أما الجانب الآخر من الاشتراكية فهو اشتراكية أكثر ديمقراطية من أسفل. وتُناقش فكرة الاشتراكية من أعلى في دوائر النخبة أكثر من الاشتراكية من أسفل - حتى لو كانت هذه هي الفكرة المثالية الماركسية - لأنها أكثر عملية. اعتبر درابر الاشتراكية من الأسفل النسخة الأنقى والأكثر ماركسية منها. ووفقاً له كان "كارل ماركس" و"فريدريك إنجلز" معارضين بشدة لأي مؤسسة اشتراكية "تؤدي إلى استبداد خرافي". ويجادل درابر بأن هذا التقسيم يعكس الانقسام بين الإصلاحي والثوري، السلمي والعنيف، الديمقراطي والسلطوي، إلخ، ويحدد النخبوية كأحد الأنواع الستة الرئيسية للاشتراكية من الأعلى، من بينها "العمل الخيري"، و"النخبوية"، و"البانيّة"، و"الشيوعية"، و"النفاذية"، و"الاشتراكية من الخارج".
ووفقًا للمؤرخ الاشتراكي الأمريكي "آرثر ليبو" Arthur Lipow كان ماركس وإنجلز "مؤسسي الاشتراكية الديمقراطية الثورية الحديثة"، التي وُصفت بأنها شكل من أشكال "الاشتراكية من الأسفل" القائمة على حركة جماهيرية للطبقة العاملة، تُناضل من الأسفل من أجل توسيع نطاق الديمقراطية وحرية الإنسان. يُناقض هذا النوع من الاشتراكية العقيدة الاستبدادية المناهضة للديمقراطية" و"الأيديولوجيات الجماعية الشمولية المختلفة التي تدّعي الاشتراكية"، بالإضافة إلى الأنواع العديدة من "الاشتراكية من الأعلى" التي أدت في القرن العشرين إلى حركات وأشكال دولة تحكم فيها طبقة جديدة استبدادية اقتصاداً خاضعاً للدولة باسم الاشتراكية، وهو انقسام يمتد عبر تاريخ الحركة الاشتراكية. يُحدد ليبو "البيلاامية" Bellamyism نسبة إلى إدوارد بيلامي و"الستالينية" Stalinism نسبة إلى جوزف ستالين كتيارين اشتراكيين استبداديين بارزين داخل الحركة الاشتراكية.
تاريخ الحركة الاشتراكية
تعود الصراعات والنزاعات السلطوية-الليبرالية داخل الحركة الاشتراكية إلى الأممية الأولى وطرد الفوضويين عام 1872، الذين قادوا الأممية المناهضة للسلطوية، ثم أسسوا أمميتهم التحررية الخاصة، الأممية االفوضوية "سانت إيميير" St. Imier. في عام 1888، أدرج المحرر اليساري الأمريكي "بنيامين تاكر" Benjamin Tucker الذي أعلن نفسه اشتراكياً فوضوياً واشتراكياً ليبرالياً معارضاً لاشتراكية الدولة السلطوية والشيوعية الإجبارية. ووفقاً للكاتب المؤرخ الفرنسي "إرنست ليسين" هناك نوعان من الاشتراكية: "أحدهما ديكتاتوري، والآخر ليبرالي". كانت اشتراكيتا تاكر هما: اشتراكية الدولة الاستبدادية التي ربطها بالمدرسة الماركسية، والاشتراكية الفوضوية الليبرالية، أو الأتاركية التي دعا إليها. وأشار تاكر إلى أن "طغيان اشتراكية الدولة الاستبدادية على أشكال أخرى من الاشتراكية لا يمنحها الحق في احتكار فكرةالاشتراكية". ووفقًا لتاكر، فإن ما يجمع بين هاتين المدرستين الاشتراكيتين هو نظرية العمل في القيمة والغايات، التي سعت الفوضوية من خلالها إلى وسائل مختلفة.
ووفقاً للكاتب السياسي الأتاركي اللاسلطوي الكندي "جورج وودكوك" George Woodcock تحولت الأممية الثانية إلى ساحة صراع حول مسألة الاشتراكية الليبرالية مقابل الاشتراكية الاستبدادية. لم يقتصر الأمر على تقديم أنفسهم بفعالية كمدافعين عن حقوق الأقليات، بل استفزوا أيضاً الماركسيين الألمان لإظهار تعصب ديكتاتوري كان عاملاً في منع الحركة العمالية البريطانية من اتباع التوجه الماركسي الذي أشار إليه قادة مثل الكاتب والسياسي الاشتراكي الإنجليزي "هنري هيندمان" Henry Hyndman. وفقًا للفوضويين، مثل مؤلفي كتاب "الأسئلة الشائعة للفوضويين"، فإن أشكال الاشتراكية من الأعلى، مثل الاشتراكية الاستبدادية أو اشتراكية الدولة، هي التناقضات الحقيقية، بينما تُمثل الاشتراكية الليبرالية من الأسفل الاشتراكية الحقيقية. بالنسبة للفوضويين وغيرهم من الاشتراكيين المناهضين للسلطوية، فإن الاشتراكية "لا تعني سوى مجتمع بلا طبقات ومعادٍ للسلطوية (أي ليبرالي) يدير فيه الناس شؤونهم بأنفسهم، سواءً كأفراد أو كجزء من مجموعة (حسب الوضع). بعبارة أخرى، تعني الاشتراكية الإدارة الذاتية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك في مكان العمل. وصف المؤرخ الأمريكي "هربرت أوسجود" Herbert Osgood الفوضوية بأنها "النقيض المتطرف" للشيوعية الاستبدادية واشتراكية الدولة.
الاشتراكية الطوباوية
وُصف اقتصاد إمبراطورية "موريا" Mauryan الهندية في القرن الثالث قبل الميلاد بأنه "ملكية اشتراكية" و"نوع من اشتراكية الدولة". وقد برزت عناصر من الفكر الاشتراكي الاستبدادي في سياسات فلاسفة يونانيين قدماء مثل "أرسطو" و"أفلاطون". وقد فضّل أوائل دعاة الاشتراكية الحديثة المساواة الاجتماعية من أجل إنشاء مجتمع قائم على الجدارة أو التكنوقراطية، قائم على المواهب الفردية. ويُعتبر "هنري دي سان سيمون" Henri de Saint-Simon أول من صاغ مصطلح الاشتراكية. كان سان سيمون مفتوناً بالإمكانيات الهائلة للعلم والتكنولوجيا، ودعا إلى مجتمع اشتراكي يقضي على الجوانب الفوضوية للرأسمالية، ويقوم على تكافؤ الفرص. ودعا إلى إنشاء مجتمع يُصنّف فيه كل فرد وفقاً لقدراته، ويُكافأ وفقاً لعمله. ركّزت اشتراكية سان سيمون بشكل أساسي على الكفاءة الإدارية والصناعة، وعلى الاعتقاد بأن العلم هو مفتاح التقدم. ورافق ذلك رغبة في تطبيق اقتصاد منظم بعقلانية، قائم على التخطيط، ومُوجّه نحو التقدم العلمي واسع النطاق والتقدم المادي.
كانت أول رواية روائية رئيسية اقترحت دولة اشتراكية استبدادية هي رواية "إدوارد بيلامي" Edward Bellamy بعنوان "النظر إلى الوراء" Looking Backward، التي صوّرت يوتوبيا اشتراكية بيروقراطية. نأى بيلامي بنفسه عن القيم الاشتراكية الراديكالية، وفي نواحٍ عديدة، لا يزال مجتمعه المثالي يُقلّد العديد من الأنظمة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. ومع ذلك، ألهم كتابه حركة سياسية جماهيرية تُعرف بالقومية داخل الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. كانت هذه الأندية القومية، التي سُميت بهذا الاسم لرغبتها في تأميم الصناعة، داعمةً قويةً للشعبويين الذين سعوا إلى تأميم أنظمة السكك الحديدية والتلغراف. ورغم دعايتها وانخراطها في السياسة، لم تُحقق هذه الأندية أي نجاح يُذكر.
بدأت الحركة القومية في التراجع عام 1893 بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها منشوراتها الرئيسية وتدهور صحة بيلامي، والتي اختفت بشكل أساسي بحلول مطلع القرن. في المجتمع الذي تصوره الرواية، تم إلغاء الملكية الخاصة لصالح ملكية الدولة، وتم القضاء على الطبقات الاجتماعية، وتم القيام بجميع الأعمال البسيطة والسهلة نسبياً طواعية من قبل جميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و45 عاماً. تمت مكافأة العمال وتقديرهم من خلال نظام تصنيف يعتمد على الجيش. الحكومة هي المؤسسة الأقوى والأكثر احتراماً، وهي ضرورية لتوفير هذه اليوتوبيا والحفاظ عليها. يحدد "آرثر ليبو" Arthur Lipow الحكم البيروقراطي لهذا المجتمع المثالي كمنظمة شبه عسكرية للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية. رفع بيلامي من شأن الجيش الحديث كمحفز للمصلحة الوطنية.
أكبر انتقاد لمجتمع بيلامي هو أنه يقوم على فكرة الاشتراكية من الأعلى. يُفرض النظام على الشعب من قِبل نخبة من الخبراء، ولا توجد سيطرة ديمقراطية أو حرية فردية. ويجادل ليبو بأن هذا يؤدي بطبيعته إلى الاستبداد، إذ كتب: "لو كان العمال والأغلبية العظمى كتلةً وحشية، لما كان هناك مجالٌ لتشكيل حركة سياسية منهم ولا لتكليفهم بمهمة بناء مجتمع اشتراكي. لن تُنشأ المؤسسات الجديدة وتُشكل من الأسفل، بل ستتوافق بالضرورة مع الخطة التي وضعها مُسبقاً المُخطط الطوباوي".
في مُقدمته لكتاب "بيتر كروبوتكين" Peter Kropotkin's بعنوان "غزو الخبز" The Conquest of Bread، اعتبر "كينت بروملي" Kent Bromleyأن أفكار الاشتراكيين الطوباويين، مثل الفرنسي "فرانسوا نويل بابوف" François-Noël Babeuf والإيطالي "فيليب بوناروتي" Philippe Buonarroti، تُمثل الاشتراكية السلطوية، على عكس الاشتراكي الفرنسي "شارل فورييه" Charles Fourier، الذي يُوصف بأنه مؤسس الاشتراكية التحررية.
المدرستان النمساوية والشيكاغوية في الاقتصاد
مع التمييز بين "المسارين الطوعيين والقسريين"، إلا أن فهمهما وتوصيفهما للاشتراكية يقومان على الاستبداد والدولانية. ويستند أحد التعريفات النمساوية للاشتراكية إلى مفهوم اشتراكية الدولة المتمثل في "ملكية الدولة للسلع الرأسمالية". وينص تعريف آخر على أن الاشتراكية "يجب أن تُفهم على أنها تدخل أو اعتداء مؤسسي على الملكية الخاصة ومطالباتها. أما الرأسمالية، فهي نظام اجتماعي قائم على الاعتراف الصريح بالملكية الخاصة والتبادلات التعاقدية غير العدوانية بين مالكي الممتلكات الخاصة".
كان "فريدريش هايك" Friedrich Hayek، اقتصادي المدرسة النمساوية، أحد أبرز النقاد الأكاديميين للجماعية في القرن العشرين. وقد أدرك اتجاهات الاشتراكية من الأعلى في الجماعية، بما في ذلك النظريات القائمة على التعاون الطوعي، وانتقدها بشدة. بخلاف "بيلامي"، الذي أشاد بفكرة النخب التي تُطبّق السياسات، جادل "هايك" بأن الاشتراكية تؤدي بطبيعتها إلى الاستبداد، مدعيًا أنه "لتحقيق غاياتهم، يجب على المخططين خلق سلطة - سلطة على رجال يمارسها رجال آخرون - بحجم لم يُعهد من قبل. الديمقراطية عقبة أمام هذا القمع للحرية الذي يتطلبه التوجيه المركزي للنشاط الاقتصادي. ومن هنا ينشأ الصدام بين التخطيط والديمقراطية.".[43] جادل "هايك" أيضاً بأن كلاً من الفاشية والاشتراكية يستندان إلى التخطيط الاقتصادي المركزي، ويُقدّران الدولة على الفرد. ووفقاً لهووفقًا لهايك، بهذه الطريقة يُصبح من الممكن للزعماء الشموليين الوصول إلى السلطة كما حدث في السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى..[43] كما استخدم اقتصاديو المدرسة النمساوية، مثل "هايك" ومعلمه "لودفيج فون ميزس" Ludwig von Mises، كلمة الاشتراكية كمرادف للاشتراكية الاستبدادية والتخطيط المركزي والاشتراكية الحكومية، وربطوها زوراًزورًا بالفاشية،،[44][45][46] حيث كتب "هايك" أنه "على الرغم من أن وعد اشتراكيينا المعاصرين بمزيد من الحرية حقيقي وصادق، إلا أنه في السنوات الأخيرة انبهر المراقب تلو الآخر بالعواقب غير المتوقعة للاشتراكية، والتشابه الاستثنائي في كثير من النواحي بين الظروف في ظل "الشيوعية" و"الفاشية".".[47] كما ساوى اقتصاديو مدرسة شيكاغو، مثل "ميلتون فريدمان" Milton Friedman، بين الاشتراكية والتخطيط الاقتصادي المركزي، بالإضافة إلى الدول الاشتراكية الاستبدادية والاقتصادات الموجهة من قبل الدولة، مشيرين إلى الرأسمالية باعتبارها السوق الحرة..[48] ومع ذلك، يعتبر الباحثون الفاشية ومشتقاتها، مثل "الفالانجية" Falangism و"النازية" Nazism والنازية، إلى جانب أنظمة عسكرية أخرى مستوحاة من الفاشية، أيديولوجيات يمينية متطرفة معادية للاشتراكية، تبنت إلى حد كبير سياسات اقتصادية سوقية ليبرالية، مع حصر التخطيط الاقتصادي في جهود الحرب..[49]
انتقد "ميزس" السياسات الليبرالية الاجتماعية ذات الميول اليسارية، مثل الضرائب التصاعدية، ووصفها بالاشتراكية، ووقف خلال اجتماع لجمعية "مونت بيليرين" Mont Pelerin واصفاً، واصفًا أولئك الذين "يعبرون عن وجهة نظر مفادها أنه قد يكون هناك مبرر" لهم بأنهم "حفنة من الاشتراكيين".".[50] من ناحية أخرى، جادل "هايك" بأن الدولة يمكن أن تلعب دوراً دورًا
في الاقتصاد، وتحديداً في إنشاء شبكة أمان اجتماعي، منتقداً اليمين والمحافظة، بل ومدافعاً عن بعض أشكال اشتراكية السوق أو اشتراكية هايك. دعا "هايك" إلى توفير بعض الدعم لمن يُهددهم الفقر المدقع أو المجاعة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم. وجادل بأن ضرورة مثل هذا الترتيب في المجتمع الصناعي لا شك فيها، سواء كان فقط لمصلحة من يحتاجون إلى الحماية، أم الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية والتأمين ضد البطالة، على أن تُنفذ الدولة ذلك، إن لم تُقدمه مباشرةً. وكان "هايك" مُصراً على ذلك. كما ساوى "ميزس" بين المصارف المركزية والاشتراكية والتخطيط المركزي. ووفقاً له تُمكّن البنوك المركزية البنوك التجارية من تمويل القروض بأسعار فائدة منخفضة بشكل مصطنع، مما يؤدي إلى توسع غير مستدام للائتمان المصرفي وإعاقة أي انكماش لاحق. ومع ذلك، اختلف "هايك" مع هذا الرأي، وصرح بأن الحاجة إلى سيطرة البنوك المركزية أمر لا مفر منه. وبالمثل، خلص "فريدمان" إلى أن للحكومة دوراً في النظام النقدي، واعتقد أنه يجب استبدال نظام الاحتياطي الفيدرالي في النهاية ببرنامج كمبيوتر. بينما انتقد "فريدمان" الرعاية الاجتماعية، وخاصة الضمان الاجتماعي، بحجة أنه خلق حالة من الاعتماد على الرعاية الاجتماعية، كان مؤيداً لتوفير الدولة لبعض السلع العامة التي لا تُعتبر الشركات الخاصة قادرة على توفيرها، ودعا إلى فرض ضريبة دخل سلبية بدلاً من معظم الرعاية الاجتماعية واستندت آراؤه إلى اعتقاد مفاده أنه بينما تُنجز قوى السوق أمورًا رائعة، إلا أنها لا تستطيع ضمان توزيع الدخل بما يُمكّن جميع المواطنين من تلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية. يتبع بعض اقتصاديي المدرسة النمساوية "ميزس" في القول بأن السياسات التي يدعمها "هايك" و"فريدمان" تُشكل شكلاً من أشكال الاشتراكية.
المدرستان النمساوية والماركسية في الاقتصاد
تتفق المدرستان النمساوية والماركسية في الاقتصاد في انتقادهما للاقتصاد المختلط، لكنهما تتوصلان إلى استنتاجات مختلفة بشأن الدول الاشتراكية الاستبدادية. في كتابه "العمل البشري"Human Labor جادل "ميزس" بأنه لا يمكن أن يكون هناك مزيج من الرأسمالية والاشتراكية - يجب أن يهيمن إما منطق السوق أو التخطيط الاقتصادي على الاقتصاد. وشرح "ميزس" هذه النقطة بالتفصيل مجادلاً بأنه حتى لو احتوى اقتصاد السوق على العديد من المؤسسات التي تديرها الدولة أو الشركات المؤممة، لن يجعل هذا الاقتصاد مختلطاً لأن هذه المؤسسات لا تُغير الخصائص الأساسية لاقتصاد السوق. ستظل هذه الشركات المملوكة للقطاع العام خاضعة لسيادة السوق، إذ سيتعين عليها الحصول على السلع الرأسمالية من خلال الأسواق، والسعي لتعظيم الأرباح، أو على الأقل محاولة تقليل التكاليف واستخدام المحاسبة النقدية في الحسابات الاقتصادية.
وبالمثل، يُجادل المنظرون الماركسيون الكلاسيكيون والأرثوذكسيون في جدوى الاقتصاد المختلط كحل وسط بين الاشتراكية والرأسمالية. وبغض النظر عن ملكية الشركات، إما أن يكون قانون القيمة وتراكم رأس المال الرأسمالي هو الذي يُحرك الاقتصاد، أو أن التخطيط الواعي وأشكال التقييم غير النقدية، مثل الحساب العيني، هي التي تُحرك الاقتصاد في نهاية المطاف. منذ الكساد الكبير فصاعداً، لا تزال الاقتصادات المختلطة القائمة في العالم الغربي رأسمالية وظيفياً لأنها تعمل على أساس تراكم رأس المال. وعلى هذا الأساس، يُجادل بعض الماركسيين وغير الماركسيين على حد سواء، بمن فيهم الأكاديميون والاقتصاديون والمثقفون، بأن الاتحاد السوفيتي السابق ودولاً أخرى كانت دولاً رأسمالية دولة، وأنه بدلاً من أن تكون اقتصادات اشتراكية مُخططة، كانت تُمثل نظاماً إدارياً قيادياً. في عام 1985، جادل السياسي الأسترالي "جون هوارد" John Howard بأن الوصف الشائع للتخطيط الاقتصادي على النمط السوفيتي بأنه اقتصاد مُخطط هو وصف مُضلّل، فبينما لعب التخطيط المركزي دوراً هاماً، كان الاقتصاد السوفيتي يتميز بحكم الواقع بأولوية الإدارة شديدة المركزية على التخطيط. لذلك، فإن المصطلح الصحيح هو اقتصاد يُدار مركزياً بدلاً من التخطيط المركزي. وقد نُسب هذا إلى اقتصاد الاتحاد السوفيتي واقتصاد حلفائه الذين اتبعوا النموذج السوفيتي عن كثب. من ناحية أخرى، بينما يصف اقتصاديو المدرسة النمساوية الاقتصادات المختلطة الغنية بأنها لا تزال "رأسمالية"، فإنهم يصفون سياسات الاقتصاد المختلط بشكل روتيني بأنها "اشتراكية". وبالمثل، يصفون الأنظمة الفاشية مثل إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية بأنها "اشتراكية"، مع أن الباحثين يصفونها بأنها أنظمة رأسمالية.
نظام الحزب الواحد
غالباً ما تُعارض الدول الاشتراكية الاستبدادية نظام التعددية الحزبية بهدف ترسيخ سلطة الحكومة في حزب واحد يمكن أن يقوده رئيس دولة واحد. ويكمن المنطق وراء ذلك في أن النخب لديها الوقت والموارد اللازمة لتطبيق النظرية الاشتراكية، لأن مصالح الشعب في هذه الدولة الاشتراكية تُمثل من قِبل الحزب أو رئيس الحزب. وقد أشار الباحث الاشتراكي الأمريكي "هال درابر" Hal Draper إلى هذا باسم "الاشتراكية من الأعلى" socialism from above. ووفقًا لـ "درابر" تأتي الاشتراكية من الأعلى في ستة أشكال تُبرر وتتطلب وجود نخبة في قمة النظام الاشتراكي. ويختلف هذا عن المنظور الماركسي الذي يدعو إلى الاشتراكية من الأسفل، وهي شكل من أشكال الاشتراكية أكثر نقاءً وديمقراطية.
تُعتبر إريتريا، وموزمبيق، وفيتنام أمثلة خارج أوروبا على دول كانت اشتراكية يحكمها حزب واحد في مرحلة ما من القرن العشرين. في إريتريا، برز الحزب الحاكم عام 1970 وهو جبهة تحرير شعب إريتريا (EPLF)، ومع سيطرتها على الدولة، بدأت الجبهة العمل على مبادئ اشتراكية مثل توسيع نطاق حقوق المرأة وتوسيع نطاق التعليم. في موزمبيق، نشأ حكم الدولة الواحدة لجبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO) بينما كانت الدولة لا تزال اشتراكية أيديولوجياً بعد انتهاء الحكم البرتغالي عام 1975. في فيتنام، يعتبر الحزب الشيوعي الفيتنامي نفسه في مرحلة انتقالية نحو الاشتراكية، كما يعتبر نفسه طليعة الشعب العامل والأمة بأسرها.
الاقتصاد
هناك العديد من الخصائص الأساسية للنظام الاقتصادي الاشتراكي الاستبدادي التي تميزه عن اقتصاد السوق الرأسمالي، وهي أن الحزب الشيوعي لديه تركيز للسلطة في تمثيل الطبقة العاملة وقرارات الحزب هي مُدمجة في الحياة العامة لدرجة أن قراراتها الاقتصادية وغير الاقتصادية تُصبح جزءًا لا يتجزأ من أفعالها العامة؛ ملكية الدولة لوسائل الإنتاج التي تُصبح فيها الموارد الطبيعية ورأس المال ملكاً للمجتمع؛ التخطيط الاقتصادي المركزي، وهو السمة الرئيسية للاقتصاد الاشتراكي ذي الدولة الاستبدادية؛ تُخطط السوق من قِبل وكالة حكومية مركزية، عادةً ما تكون لجنة تخطيط حكومية؛ وتوزيع عادل اجتماعياً للدخل القومي حيث تُقدم الدولة السلع والخدمات مجاناً وتُكمل الاستهلاك الخاص. يتميز هذا النموذج الاقتصادي بشكل كبير بالتخطيط المركزي الحكومي. من الناحية المثالية، يكون المجتمع هو المالك كما هو الحال في الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، ولكن في الممارسة العملية، تكون الدولة هي مالكة وسائل الإنتاج. إذا كانت الدولة هي المالكة، فإن الفكرة هي أنها ستعمل لصالح الطبقة العاملة والمجتمع ككل. عملياً، يكون المجتمع هو المالك نظرياً فقط، والمؤسسات السياسية التي تحكم المجتمع مُنشأة بالكامل من قِبل الدولة. بينما يؤكد الماركسيون اللينينيون أن العمال في الاتحاد السوفيتي السابق والدول الاشتراكية الأخرى كانوا يتمتعون بسيطرة حقيقية على وسائل الإنتاج من خلال مؤسسات مثل النقابات العمالية، يجادل الاشتراكيون الديمقراطيون والليبراليون بأن هذه الدول لم تمتلك سوى عدد محدود من الخصائص الاشتراكية، وأنها عملياً كانت رأسمالية دولة تتبع نمط الإنتاج الرأسمالي. جادل "فريدريك إنجلز" Friedrich Engels في كتاب "الاشتراكية: الطوباوية والعلمية" Socialism: Utopian and Scientific، بأن ملكية الدولة لا تلغي الرأسمالية في حد ذاتها، بل ستكون المرحلة النهائية للرأسمالية، والتي تتكون من ملكية وإدارة الإنتاج واسع النطاق والاتصالات من قبل الدولة البرجوازية. في كتابي "الإمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية" Imperialism, the Highest Stage of Capitalism و"الإمبريالية والاقتصاد العالمي" mperialism and the World Economy ، عرّف كل من "فلاديمير لينين" Vladimir Lenin و"نيكولاي بوخارين" Nikolai Bukharin على التوالي، "نمو رأسمالية الدولة كواحدة من السمات الرئيسية للرأسمالية في عصرها الإمبريالي. في كتابه "الدولة والثورة State and Revolution "، كتب لينين أن الادعاء الإصلاحي البرجوازي الخاطئ بأن الرأسمالية الاحتكارية أو رأسمالية الدولة الاحتكارية لم تعد رأسمالية، بل يمكن تسميتها الآن "اشتراكية الدولة" وما إلى ذلك، شائع جداً.
هل يُمكن لدولة ديمقراطية أن تكون اشتراكية؟
خلال الحرب الباردة، غالباً ما كان العديد من المراقبين العاديين يجمعون بين الأنظمة السياسية والاقتصادية في فكرة عامة واحدة هي "الرأسمالية" أو "الشيوعية". ومع ذلك، فإن النظامين منفصلان. في الواقع، كانت هناك أنظمة استبدادية رأسمالية. ومن الأمثلة على ذلك كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة. كانت لهذه الدول أنظمة سياسية استبدادية، لكنها سمحت بالملكية الخاصة لرأس المال (المصانع) والاستثمار الأجنبي. وبالتالي، لا ترتبط الرأسمالية دائماً بالديمقراطية.
ولا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كانت الديمقراطيات الحقيقية، كتلك الموجودة في غرب وشمال أوروبا، اشتراكية بالفعل، مع وجود العديد منها. حيث يُطلق على الدول الإسكندنافية اسم "الديمقراطيات الاجتماعية" بدلاً من الاشتراكية الديمقراطية. تتمتع هذه الدول بحكومات ديمقراطية، لكنها تُنفق مبالغ طائلة على الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، يُزعم أن "العصر الذهبي" للاشتراكية الديمقراطية قد انتهى بحلول أوائل سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت التكاليف المرتفعة لبرامج الرعاية الاجتماعية تُبطئ النمو الاقتصادي. وبغض النظر عن الجدل الدائر حول مدى اشتراكية الدول الإسكندنافية، يُظهر التاريخ أن الدول يُمكن أن تمتلك حكومات ديمقراطية وأنظمة اقتصادية اشتراكية.
توجد كل من الاشتراكية الاستبدادية والاشتراكية الديمقراطية، ولكن على نطاق واسع، وليس على مستويات نهائية يسهل فصلها. لا تزال كوريا الشمالية قائمة كأثر من آثار التخطيط المركزي على النمط السوفيتي، بحكومة استبدادية تماماً واقتصاد تسيطر عليه الدولة بشكل شبه كامل. تقدم الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، والدول الاسكندنافية، رعاية صحية بنظام الدفع الفردي، والعديد من برامج الرعاية الاجتماعية السخية الأخرى لسكانها. تتمتع هذه الدول بحكومات ديمقراطية، لكن سيطرة حكومية كبيرة على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم.
كما تُعدّ الصين أبرز مثال حديث على اقتصاد سوقي قائم إلى حد كبير على حكومة استبدادية. في الواقع، يُعزي البعض النمو الاقتصادي السريع للصين منذ تسعينيات القرن الماضي إلى حكومتها الشيوعية الصارمة. ومثل الاتحاد السوفيتي من قبله، لا يسمح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين للأحزاب السياسية الأخرى بالتنافس على السلطة. ومع ذلك، وعلى عكس الاتحاد السوفيتي، شجعت الحكومة الصينية بنشاط الاستثمار الأجنبي. لذلك، على الرغم من أن تدفق العلامات التجارية الأجنبية والشركات الخاصة قد يجعل الصين تبدو كديمقراطية غربية على مستوى الشارع، إلا أن حكومتها لا تزال استبدادية بحتة.
***
الدكتور حسن العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا