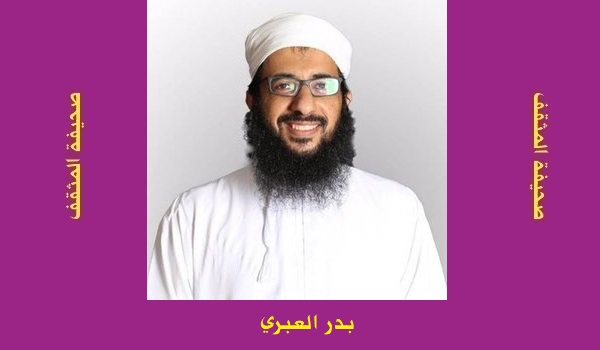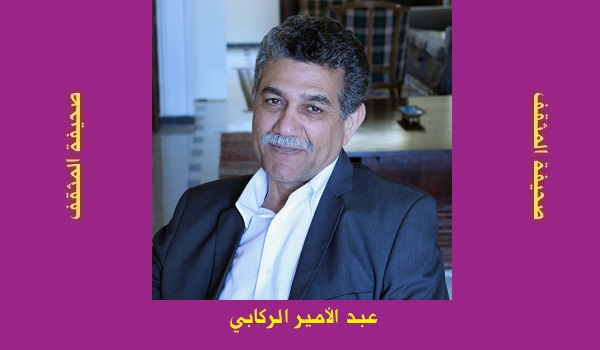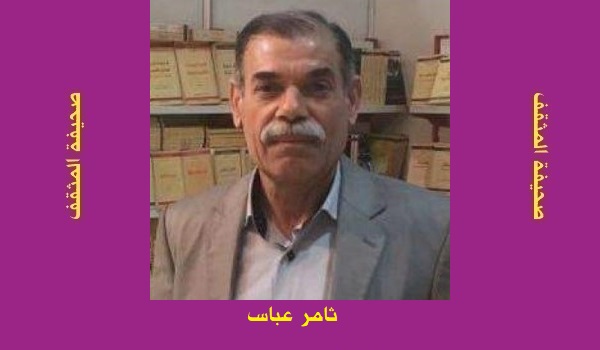مقدمة توضيحية: هذا المقال ليس جديداً، إذ نشرته قبل أربع سنوات وتحديداً يوم 31/12/2021 على مواقع الانترنت، كتعليق على مقابلة تلفزيونية مع الدكتور علي علاوي، وزير المالية الأسبق في حكومة السيد مصطفى الكاظمي (7 أيار 2020 حتى 13 أكتوبر 2022)، وموقفه السلبي من ثورة 14 تموز، وخاصة عن قيام قيادة الثورة بحل مجلس الإعمار، ومنجزات الثورة الكثيرة في عمرها القصير. وكان مقالي بعنوان (مستقبل العراق المظلم)، وهو، كما يلاحظ الأخوة القراء، وكما اكتشفتُ أنا أيضاً فيما بعد، أنه غير موفق، وفيه نوع من الانفعال والتسرع، إذ كما تفيد الحكمة: (الكتاب أو المقال، يعرف من عنوانه). وهذا العنوان: "مستقبل العراق المظلم" رغم أنه يدل على جزء من محتوى المقال بسبب المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه العراق، ولكن ليس على المحتوى الرئيسي. وقبل أيام أردت مراجعة هذا المقال بمناسبة الذكرى 67 لذكرى الثورة، فلم أتذكر العنوان! وأخيراً عثرت عليه، ولكن بعد جهد جهيد وبمساعدة غوغل. لذلك أرى من الضروري أن يكون العنوان يدل على المحتوى، ويساعد على معرفة مكان المقال في الآرشفة الحاسوبية. لذا عدت إليه وراجعته، ووضعت له عنواناً جديداً يساعدني على معرفة مكانه عند الحاجة في المستقبل، وهو المثبت أعلاه. وبمناسبة ذكرى الثورة رأيت من المفيد إعادة نشره لفائدة الجيل الجديد في معرفة التاريخ والحقيقة.
***
العودة للمقال الذي نشر في 31/12/2021
بمناسبة مئوية تأسيس الدولة العراقية، أجرت فضائية (العراقية) شبه الرسمية، مقابلة مع السيد وزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي، دامت ساعة و 21 دقيقة، استعرض فيها المراحل المهمة التي مر بها العراق منذ التأسيس عام 1921 و إلى يومنا هذا.(رابط الشريط رقم 1 في الهامش).
ونظراً لأهميتها، نالت تصريحات السيد الوزير اهتمام الإعلاميين والمعلقين السياسيين. فقد أشار إلى المشاكل الكبرى التي تهدد وجود العراق ومستقبله كدولة وسماها بحق (المشاكل الوجودية)، مثل اعتماد العراق شبه الكلي على النفط لنحو 90% من موارده المالية، وخطر الاستغناء عن النفط بعد حوالي عشر سنوات من الآن، حيث هناك توجه عالمي لحماية البيئة من انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون، والاحتباس الحراري ومخاطره على البشرية، و الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح والشلالات والأمواج البحرية وغيرها. ولذلك فمصير النفط كمصير سلفه الفحم، سيتحول إلى بضاعة بائرة في باطن الأرض، وبالتأكيد سينهار سعر البرميل إلى أدنى ما يمكن، وهذا يعني إفلاس العراق مالياً.
وجواباً على سؤال مقدم البرنامج، الاعلامي السيد كريم حمادي، حول أفضل مرحلة في تاريخ الدولة العراقية حصل فيها بناء المشاريع الاقتصادية والخدمية، ركز الضيف على السنوات الأخيرة من العهد الملكي، وأشاد بدور مجلس الإعمار، الذي تم حله في عهد ثورة 14 تموز 1958 دون أن يوضح مبررات هذا الحل. كذلك لتبخيس دور قائد المثورة في إنجاز الكثير من المشاريع، قال أن أغلب المشاريع التي انجزها عبدالكريم قاسم، كانت مخططة من قبل مجلس الإعمار إبان العهد الملكي مثل مدينة الثورة (الصدر حالياً) وغيرها، وأن قاسم أخذ الفخر الـ(credit) له أي نسب الفضل لنفسه في تنفيذ هذه المشاريع !
لا أريد أن أناقش كل ما صرح به السيد الوزير، فأغلبها صحيحة، وخاصة مخاطر الاعتماد الكلي على النفط في الموارد المالية، لأن هذا يعني انهيار الدولة العراقية في المستقبل القريب. ولكني أود في هذا المقال أن أوضح بعض الأمور التي مر عليها السيد الوزير دون أن يفيها حقها، وكذلك المخاطر الأخرى التي تهدد وجود العراق كدولة ولم يشر إليها. فهناك الكثير من المخاطر إن لم يتخذ المسؤولون إجراءات وقائية ضدها فمستقبل العراق في مهب الريح، ويكون مظلماً ومرعباً وربما سيكون غير قابل للبقاء كدولة. وقد يرى البعض أن هذه نظرة تشاؤمية، ونقد مبالغ به...الخ، فالجواب أن من واجب المثقف تشخيص مواطن الخطأ، ودق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان، وتجنب سياسة النعامة في دفن رأسها بالرمال.
أولاً، مرحلة الإزدهار الاقتصادي:
يشهد التاريخ أن أهم مرحلة تحقق فيها ازدهار اقتصادي هي مرحلة ثورة 14 تموز(1958-1963) بلا أي شك، وذلك لإعتماد قائد الثورة ورئيس الحكومة الزعيم عبد الكريم قاسم على خيرة الكفاءات الوطنية المخلصة، والمتحمسة لخدمة الوطن عملاً بمبدأ: (الشخص المناسب في المكان المناسب)، بدون أي تمييز. ويشهد بذلك باحثون أجانب مثل حنا بطاطو الذي قال: "ومما له مغزى أن أصحاب المصانع لم يعرفوا ازدهاراً كالذي عرفوه في عهد عبد الكريم قاسم (1958-1963)، الذي كانت سياساته الاقتصادية والمالية موحى بها - إلى درجة غير قليلة- من الوطنيين الديمقراطيين [يقصد الحزب الوطني الديمقراطي]، وبدقة أكبر، من محمد حديد الذي كان له في تلك السنوات نفوذه في الحكومة حتى عندما كان خارجها" (حنا بطاطو، تاريخ العراق، ج1، ص346). وللمزيد للإطلاع على منجزات ثورة 14 تموز 1958، في التنمية الاقتصادية، - الإنتاجية والخدمية-، والتنمية البشرية في عمرها القصير، يرجى فتح الرابطين 2 و3 في الهامش.
ثانياً، مَنْ خطط لهذه المشاريع ولمن الفضل في تنفيذها:
بعد أكثر من نصف قرن على الثورة، وللانتقاص من دور حكومتها، وزعيمها في تحقيق أكبر ما يمكن من منجزات للشعب العراقي من مشاريع وقوانين تقدمية مثل (قانون الأحوال الشخصية رقم 181 لعام 1959) الذي أنصف المرأة، وقانون الإصلاح الزراعي، وقانون إلغاء حكم العشائر، و(قانون رقم 80 لسنة 1961) الذي استرجع بموجبه 99.5% من مساحة العراق من الشركات النفطية، وغيرها كثير... قالوا أن جميع هذه المشاريع والقوانين كان قد خطط لها في العهد الملكي، مثل بناء ميناء أم قصر، ومد الخط العريض بين بغداد والبصرة، وبناء مدينة الثورة، ومدينة الطب، ومعمل الأدوية في سامراء، والزجاج في الرمادي، وتعليب الفواكه في كربلاء، ومضاعفة عدد المدارس والطلبة والمعلمين والمئات غيرها، أقول ولو افترضنا جدلاً أن جميع هذه المشاريع والقوانين قد خطط لها في العهد الملكي، فما قيمة هذه المخططات التي كانت حبراً على ورق، وحبيسة الأدراج لسنين طويلة في العهد الملكي، إلى أن جاء عبدالكريم قاسم، وحولها إلى مشاريع حقيقية قائمة على أرض الواقع، وبتلك الإمكانيات المالية المحدودة في ذلك الوقت العصيب حيث المؤامرات الداخلية والخارجية لوأد الثورة؟ هذه المشاريع ستبقى نصباً تاريخية شامخة على مر السنين تذكر بوطنية وإخلاص الزعيم عبدالكريم قاسم وثورة 14 تموز المجيدة.
فالعبرة ليست بالتخطيط، ومن الذي خطط فحسب، بل بالتنفيذ ومن نفذ. فبعد 2003 هناك المئات من المشاريع التي خُطط لها، وحتى دُفِع الكثير من تكاليفها بالعملة الصعبة لجهات أغلبها وهمية، ولكن لم يتم تنفيذها، بل سُرقت تلك الأموال الهائلة وبقيت المشاريع بلا تنفيذ. كذلك هناك الألوف من المعامل المعطلة مثل معمل الورق في البصرة، وغيره، ترفض حكومات ما بعد 2003 إعادة تأهيلها بضغوط من أتباع دول الجوار مثل إيران وتركيا، لإنعاش اقتصاديات هاتين الدولتين، إضافة إلى ما يحصل عليه التجار من أرباح فاحشة، وإبقاء العراق بلداً مستهلكاً يستورد حتى الغاز من إيران ويترك غازه الطبيعي يُحرق في الجو ويدمر البيئة العراقية.
ثالثاً: حل مجلس الإعمار:
هذا المجلس تأسس بناءً على اقتراح المرحوم عبدالكريم الأزري، الوزير المخضرم في العهد الملكي، كما أشار الدكتور علي علاوي، وكما جاء في مذكرات الأزري. وفعلاً قام المجلس ببناء السدود مثل سد سامراء لحماية بغداد من الغرق ولأغراض زراعية أيضاً. وبالمناسبة، هذه السدود وغيرها من المشاريع الإروائية الكبيرة لم تكن من تخطيط مجلس الإعمار، بل كانت من تخطيط خبير الري البريطاني المعروف (ويليم ويلكوس)، في أواخر العهد العثماني كما درَّوسنا في مرحلة تعليمنا الابتدائي عن هذه المشاريع المنجزة وغير المنجزة.
لماذا تم حل مجلس الإعمار؟؟؟
والآن نأتي إلى بيت القصد! لماذا تم حل مجلس الإعمار بعد ثورة 14 تموز في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم؟، علينا أن نرجع إلى الشخصية الوطنية الفذة، والخبير الاقتصادي الراحل محمد حديد الذي تبوأ منصب وزارة المالية في حكومة الثورة. وهو بالمناسبة، أول عراقي خريج جامعة لندن للاقتصاد (London School of Economics)، والذي شهد بحقه الباحث حنا بطاطو كما أشرنا أعلاه.
يقول الراحل محمد حديد في مذكراته عن أسباب حل مجلس الإعمار ما يلي:
(حول تخصيص 70% من واردات النفط لوزارة الإعمار و 30% فقط للشؤون الأخرى، المشاريع الاجتماعية والخدمات مثل الصحة والتعليم ...الخ: أن حكومة الثورة غيرت المعادلة فجعلتها 50% للإعمار، و50% للميزانية الاعتيادية لسببين: أولاً، إن هذه المشاريع الاجتماعية لا تقل شأناً ومركزاً في الأسبقية عن المشاريع الاقتصادية العمرانية، ذلك أن التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية المعنية بالإنسان، ربما تكون أكثر تحقيقاً لمصلحته من المشاريع العمرانية الاقتصادية، أي أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار المادي في المشروعات الاقتصادية مع الاعتراف بأهميتها بالنسبة للتنمية الاقتصادية. والسبب الثاني هو أن الـ 70 في المائة من واردات النفط، التي كانت تخصص للخطة الاقتصادية كانت لا تنفق جميعها بسبب عجز الجهاز الفني والإداري عن تنفيذ الخطة الاقتصادية، وتبقى مبالغ كبيرة منها مجمدة في الميزانية، وتنعكس في أرصدة نقدية إما في حسابات البنك المركزي، وإما الأرصدة الإسترلينية المودعة في بريطانيا وغيرها من الأقطار الأوربية. ولذلك كان من غير المعقول لأن يبقى المجتمع محروماً من الخدمات التي يحتاج إليها، في الوقت الذي تبقى واردات الدولة معطلة في حسابات مجمدة.)) (محمد حديد، مذكراتي، الساقي، ط1، 2006، ص339).
وكما ذكرنا آنفاً أن حكومة الثورة قد حققت منجزات في مختلف المجالات من مشاريع اقتصادية وتنمية بشرية في اربع سنوات ونصف السنة وبدون مجلس الإعمار، حققت ضعف ما حققه العهد الملكي خلال 38 سنة. فإعمار البلاد لا يعتمد على وجود أو عدم وجود مجلس الإعمار، بل بتوافر النزاهة و الاخلاص الوطني، والضمير والشرف لدى القيادات السياسية المتنفذة في الحكومة. علماً بأن حكومة الثورة " أسست وزارة التخطيط في العراق عام 1959 تم استحداثها بعد إلغاء وزارة الاعمار. أول وزير للوزارة كان الدكتور طلعت الشيباني." (ويكيبيديا). فوزارة التخطيط يا سادة يا كرام، لا تقل أهمية عن مجلس الإعمار، إن لا تفوقه، كما هو السائد في معظم دول العالم المتقدم والمتخلف!
رابعاً، قانون الإصلاح الزراعي وهجرة الفلاحين إلى المدن
وعن هجرة الناس من الريف إلى المدن وخاصة بغداد، (سكان خلف السدة والشاكرية...الخ)، حاول السيد الوزير أن يلقي اللوم على قانون الإصلاح الزراعي، ولكن بعد قليل تراجع واعترف أن الهجرات بدأت في أوائل الخمسينات، أي في العهد الملكي، وقبل الثورة بسنوات. وهنا أود أن أشير إلى أن سبب الهجرة ليس قانون الإصلاح الزراعي، بل ظلم الاقطاعيين، وقانون حكم العشائر الذي سنه الإنكليز بعد احتلالهم للعراق، حيث وزعوا عليهم الأراضي الزراعية الأميرية كرشوة لكسب شيوخ العشائر، وتحويلهم من شيوخ ووجهاء لرعاية أبناء عشائرهم إلى إقطاعيين ظالمين لهم، وحولوا أبناء عشائرهم إلى أقنان وعبيد يباعون مع الأرض، يعانون من الجوع والجهل والمرض. وهذا كان سبب الهجرة، وليس قانون الإصلاح الزراعي. وهذه الظاهرة لم ينفرد بها العراق، بل كانت ومازالت متفشية في معظم بلدان العالم الثالث، خاصة في مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952.
المخاطر التي تهدد مستقبل العراق
1- الاعتماد الكلي على النفط المعرض للزوال بعد عقد أو عقدين من الزمن، وعدم الاعتماد عليه في إنتاج الطاقة والموارد المالية.
2- شح المياه: جميع منابع مياه الرافدين وشط العرب هي في تركيا وإيران، وهاتان الدولتان مستمرتان في بناء السدود وحجز المياه عن العراق وهلاكه عطشاً، ولذلك فبعد عقد أو عقدين ستجف الأنهر العراقية. أما شط العرب، وأنهر البصرة فقد تحولت بعد 2003 إلى مستودعات لمياه الصرف الصحي، التي تسبب في تفشي الأمراض.
3- اتساع التصحر، وهو نتيجة لشح المياه،
4-الانفجار السكاني، كان تعداد نفوس العراق عام 1920 نحو 1.4 مليون نسمة، وبعد مائة سنة قفز العدد إلى 40 مليون، أي حوالي 28 ضعفاً. إذ تفيد الدراسات أن هناك زيادة في السكان بنحو مليون نسمة في السنة في مستواه الحالي. وهذا يعني أن العراق يواجه مشكلة الزيادة في السكان، ونقص في موارد المعيشة وغيرها من الموارد الضرورية لإدامة الحياة.
5- الصراع الطائفي والأثني بين مكونات الشعب العراقي، وتغلب نزعة الولاء للانتماءات الثانوية (الدينية، الطائفية، الأثنية، والمناطقية)، على الولاء الوطني العراقي، بل وضعف الشعور بالانتماء لهذا الوطن، وعدم حرص المواطن على ممتلكات الدولة، بل ويسعى إلى تخريبها عمداً. وهناك معلومات كثيرة في هذا الشأن لا مجال لذكرها.
6- تفتت النسيج الاجتماعي، وعودة البداوة، والقبلية والعشائرية وما يرتبط بها من تخلف، وصراعات وحروب داخلية فيما بين العشائر، كلها بدأت في عهد حكم البعث الصدامي الساقط،
7- تفشي وباء الإسلام السياسي ومليشياتهم المنفلتة، وعدم اعتماد السياسيين الإسلامويين على العلوم والتكنولوجيا وفن الممكن في حل المشاكل، بل الاعتماد على الغيبيات والدعاء بالنصر من عنده تعالى، وشيطنة المعارضين لهم لتصفيتهم بشتى الوسائل،
8- انهيار التعليم في جميع مراحله، وتفشي البطالة، والفقر، والاعتماد الكلي على الدولة في التعيينات،
9- تفشي الفساد الإداري والرشوة في جميع مفاصل الدولة، فالمواطن العراقي الذي يراجع دوائر الدولة لأي سبب، لا تُحل مشكلته ما لم يدفع رشوة للموظف،
10- عدم التزام المواطنين بالقوانين وواجباتهم إزاء الدولة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، وكما ذكر السيد الوزير، لم يدفع أغلب المواطنين فواتير الكهرباء، وأن هناك 13 تريلون دينار بذمة المواطنين لوزارة الكهرباء، أي ما يعادل 10 مليار دولار. وهذا يعتبر سرقة للمال العام لم يحصل في أي بلد في العالم غير العراق.
11- محاولات دول الجوار، وخاصة إيران وتركيا لإضعاف العراق وإنهاكه وتدميره. إذ تحاول تركيا احتلال نحو 100 ألف كم مربع من شمال العراق بحجة أن هذه كانت أراضي عثمانية، والآن لتركيا قوات عسكرية في بعشيقة بدعوى محاربة حزب العمال الكردي (PKK).(شاهد فيديو في الهامش رقم 4). ولهذه الدول مثل إيران أنصار على شكل أحزاب سياسية متنفذة، ومليشيات مسلحة في العراق، تأتمر بأمر الولي الفقيه الإيراني على حساب وطنهم وشعبهم، لأن الإسلام السياسي لا يعترف بالوطن ولا بالوطنية.
ولا شك أن هناك مشاكل كثيرة أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر.
ما العمل؟ مقترحات لتحويل العراق إلى دولة صناعية، وزراعية وسياحية
لذلك، وإزاء هذه المشاكل المتراكمة وتصاعدها نحو الأسوأ، ولا شك أن كل منها يكفي لقصم ظهر البعير كما يقول الأعراب، فهل يمكن لهذا العراق أن يعيش كدولة عصرية متحضرة بحدوده الجغرافية الحالية، تتكيف مع ما يتطلبه العصر الحديث؟
أنا أشك في ذلك، وأعتقد أن هذا شبه مستحيل، ولذلك فمستقبل العراق مظلم ومرعب، ومعرض للإنهيار ما لم يعي المسؤولون في الدولة حجم المشكلة، ويتخذوا التدابير اللازمة لدرأ الكارثة، وهذا ممكن فقط لو توافرت النوايا الصادقة، والنزاهة والشرف والاخلاص للوطن، يعني شخصيات وطنية مثل الزعيم عبدالكريم قاسم وأعضاء حكومته النجباء (حكومة ثورة 14 تموز)، وحقاً ما قاله الشاعر:
سَيَـذْكُـرُني قـومي إذا جَـدَّ جِـدُّهُـمْ.... وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر.
السؤال هنا: هل يمكن منع كارثة انهيار الدولة العراقية عند الاستغناء عن النفط وغيره من المشاكل؟
الجواب: نعم ممكن إذا حاول المخلصون تلافي الكارثة بصدق ونزاهة، وهناك اقتراحات وحلول كثيرة طرحها العديد من الزملاء الأفاضل في مقالاتهم، ومناقشاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كما يقول المثل الإنكليزي: (القول اسهل من الفعل Easier said than done).
فحكومات الدول المصدرة للنفط كانت تعلم بنضوب النفط والغاز يوماً، ولكن اليوم ظهر سبب آخر، وهو ترك النفط والغاز كمصدر من مصادر الطاقة وذلك للحفاظ على سلامة البيئة من التقلبات المناخية، وظهور البدائل النظيفة المتجددة للطاقة.
وقد اهتمت حكومات الدول الخليجية منذ بداية نهضتها الاقتصادية في منتصف القرن الماضي، بإيجاد البدائل عن النفط والغاز كمصدر للموارد المالية، والحفاظ على حصة الأجيال القادمة من هذه الثروة الناضبة، وذلك بتخصيص نسبة معينة من الموارد النفطية في الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية وفي مختلف دول العالم. وقد نجحت الدول الخليجية أيما نجاح في هذا المضمار، بحيث صارت الموارد المالية من هذه الاستثمارات تعادل الموارد النفطية وربما تفوقها في المستقبل. لذلك فعندما يصبح النفط ثروة بائرة، يكون لدى هذه الدول البديل الدائم، ويتحملون الصدمة، وكأن شيئاً لم يكن.
أما في حالتنا العراقية، فأفضل فرصة ذهبية توفرت للاستثمار في المشاريع غير النفطية، ودعم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والقطاعات الخدمية، والسياحية، توفرت في عهد حكم البعث، حيث بلغت الواردات النفطية أرقاماً فلكية للدولة، ففي عام 1979 كان رصيد الدولة نحو أربعين مليار دولار. وهذا مبلغ ضخم في ذلك الوقت، كان بإمكان حكومة البعث أن تحذو حذو الدول الخليجية في الصناعة والزراعة والتنمية البشرية وغيرها، ولكن بدلاً من ذلك، راحت الحكومة، وخاصة في فترة رئاسة صدام حسين، بتبديد هذه الثروة واستدان عليها نحو 120 مليار دولار، وصرفها على عسكرة المجتمع، وشراء ذمم الاعلاميين في العالم لتجميل وجه الدكتاتور، وحكاية كوبونات النفط باتت معروفة للجميع، وتم تبديد هذه الثروات على شن الحروب العبثية على إيران ومن ثم احتلال الكويت...و(حرب تلد حرباً أخرى) إلى آخره من قائمة كوارث الدمار الشامل. وكما أشار الوزير علاوي، أن الحروب الصدامية العبثية كلفت العراق نحو 400 مليار دولار.
ثم جاءت مرحلة ما بعد 2003، وخلال الـ 18 سنة الماضية فشلت الحكومات المتعاقبة في التخلص من تركة البعث، بل زادوا عليها بالفساد، والأنانية، وسرقة أموال الشعب، وفقدان الشعور بالوطنية والمسؤولية، إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع المأساوي المزري، وضع اللادولة، والدولة الرديفة، والدولة الفاشلة وغيرها من المسميات..
لست خبيراً بالاقتصاد، ولكن اعتماداً على الحس العام (commonsense)، فمن واجب الدولة القيام بتشكيل لجان من الخبراء الوطنيين النظيفين في مختلف المجالات، وبالأخص الاقتصاديين والصناعيين والماليين، والمفكرين وغيرهم، وما أكثرهم، والحمد لله، لدراسة الأزمة، وإيجاد الحلول الواقعية لها، ولكن حسب تقديراتي كمواطن متابع للقضية العراقية ومهتم بها، أطرح النقاط أدناه قابلة للتعديل والإضافات. فلو توفرت النوايا الصادقة، والنزاهة والاخلاص للشعب والوطن، لأمكن إخراج العراق من مأزقه وأزمته المالية وغيرها وذلك كالتالي:
1- من الممكن الإسراع في الاستثمار الاقتصادي بمختلف مجالاته بما هو متوفر من الواردات النفطية، وحذو الدول النفطية وغير النفطية في هذا المجال.
2- التخلص من المحاصصة الطائفية في مؤسسات الدولة، واعتماد مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب،
3- مواجهة الانقسامات المجتمعية بحملة تثقيفية مكثفة، ومستدامة، ومنع أي تمييز: ديني، أو طائفي، أو أثني أو مناطقي..الخ
4- منع ذكر الانتماء الديني والطائفي والأثني في بطاقة الهوية الوطنية العراقية،
5- حل المليشيات المسلحة السائبة وحصر السلاح بيد الدولة فقط،
6- حملة تأهيل جميع المعامل المتوقفة عن العمل، إذ هناك آلاف المعامل الصغيرة المتوقفة عن العمل، يجب الاسراع في تأهيلها، لتوفير العمل لملايين العاطلين، فهناك عشرات الجامعات والمعاهد، وألوف المدارس الاعدادية وغيرها تخرج سنوياً مئات الألوف من الخريجين الشباب يبحثون عن عمل،
7- تشجيع القطاع الخاص، إذ لا يمكن للدولة وحدها أن تكون هي المصدر الوحيد لإيجاد العمل للعاطلين، أما التعيينات بدون عمل فهي بطالة مقنعة تؤدي إلى تضخم جهاز الدولة، وترهله، والكسل والخمول في أداء الواجب،
8- تشجيع الأفراد على المبادرات الشخصية، في خلق أعمال حرة لهم مع مساعدة الدولة لهم مادياً في أول الأمر.
9- تشجيع الاستثمارات الخارجية في جميع المجالات في العراق،
10- الاستثمار في إنتاج الطاقة من المصادر البديلة المتجددة مثل الطاقة الشمسية حيث تتوفر أشعة الشمس في العراق في جميع فصول السنة. وفي هذا الخصوص يجب إقامة علاقات اقتصادية مع الصين الشعبية المعروفة بقدرتها في صناعة الألواح الشمسية ونصبها، وذلك بفتح معامل لصنع الألواح الشمسية في العراق، وتشجيع شركات أهليه عراقية، وتدريب العراقيين في هذه الصناعة، وحث الناس على استخدام هذه الطاقة النظيفة والمجانية عدا تكاليف نصب الألواح على سطوح بيوتهم، كذلك قيام الحكومة بتجهيز جميع أبنيتها بالطاقة الشمسية. فهناك دول تخطط للاستفادة من صحاريها لإنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية وتصديرها إلى دول أخرى.
11- في قطاع السياحة: العراق بحكم موقعه الجغرافي، وتاريخه العميق والعريق، وكونه مهد الحضارة البشرية، وغزارة الآثار التاريخية، والمواقع الدينية، مؤهل ليكون أفضل دولة سياحية لمختلف أنواع السياحة، الترفهية، والثقافية، والدينية لأتباع مختلف الديانات والمذاهب. إضافة إلى إمكانية تحويل منطقة الأهوار، وشط العرب إلى مشتى والرياضة المائية.
12- الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية، وتطويرها بحيث توفر مواداً تستخدم في الصناعات المختلفة،
فطالما عندنا النفط كمادة أولية يمكن التقدم في هذا المجال، وكذلك صناعة الأسمدة الكيمياوية،
13- تقليص العطل بشكل عام، فهناك من يستغل المناسبات الدينية، وأغلبها ليست عطل رسمية، ولكن هؤلاء البعض يستغلونها للتهرب من العمل. وإذا ما أضفنا إليها يومين في كل أسبوع، إضافة إلى العطل الرسمية، فالوقت المهدور بالعطل يساوي ما يقارب نصف سنة تكون دوائر الدولة والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية وغيرها معطلة. وهذا لا يوجد إلا في العراق.
14- الاهتمام بالثروة الزراعية والحيوانية، وبالأخص زراعة النخيل، إذ كما جاء في الحديث: "أكرموا عمتكم النخلة". فقبل الحروب الصدامية العبثية كان العراق أكبر بلد مصدِّر للتمور، حيث كان فيه نحو 40 مليون نخلة، وعند سقوط الصنم الصدامي كان في العراق نحو 8 ملايين نخلة فقط. كذلك يجب تشجيع إنشاء أحواض لتربية الأسماك، والاهتمام بتكاثرها في الأنهر والبحيرات، وسن قوانين تمنع استخدام السموم والمتفجرات لصيد الأسماك بالطرق الهمجية التي تؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الأحياء المائية، وهذه جريمة لا تغتفر،
15- الإهتمام بقطاع النقل: يتميز العراق بموقعه الجغرافي فهو الطريق الرابط بين آسيا وأوربا، وعليه يجب التركيز على شبكة النقل بمختلف أنواعه، الجوي والبري والبحري، وهذا يحتم الاهتمام بالنقطة الأخيرة وهي:
16- الإسراع في بناء مشروع ميناء الفاو الكبير، وبذلك يمكن تحويل الفاو إلى أكبر مصدر يدر على العراق في الموارد المالية، كما هونكونغ ودبي وغيرهما من الموانئ. ولذلك تحاول دول الجوار قتل هذا المشروع لكي لا ينافس موانئها.
لا شك أن هناك وسائل أخرى كثيرة يمكن أن تساهم كبديل عن النفط في تمويل الموازنة العراقية وحل الأزمة المالية ودرأ خطر انهيار الدولة العراقية بعد النفط.
وكل عام وأنتم وعراقنا الحبيب والعالم بألف خير
***
د. عبد الخالق حسين
...........................
روابط ذات علاقة
1- تغطية خاصة مع كريم حمادي | الضيف: علي علاوي .. وزير المالية | العراق والدولة.. مئة عام من التقلبات
https://www.youtube.com/watch?v=McTBsH8HfY4
2- عبد الخالق حسين: منجزات ثورة 14 تموز 1958
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=605277
3- منجزات الزعيم عبدالكريم قاسم خلال فترة حكمه
http://www.akhbaar.org/home/2018/7/246337.html
4- فيديو قصير: متحدث عراقي يؤكد أن تركيا تتأهب للسيطرة على أراض عراقية غالية وضمها لها وتبلغ مساحتها 100 ألف كم بحجة أنها كانت يوما تابعة لها
https://www.facebook.com/abdulkhaliq.hussein.1
5- د. حميد الكفائي: استعادة الدولة أولى من الاحتفال بذكراها المئوية
https://akhbaar.org/home/2021/12/289956.html
5- أ. د. عادل شريف: العراق في مئويته الأولى، سياسات مستوردة وانقسام مجتمعي
https://almasalah.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=220434