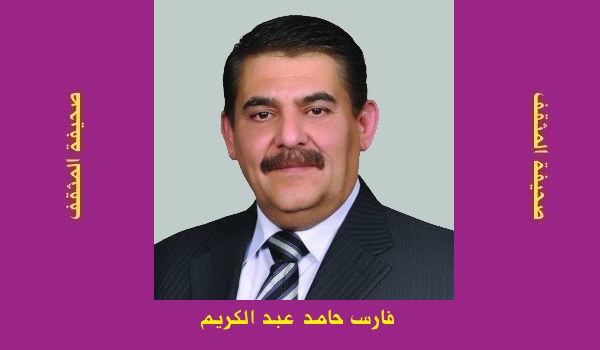فرضية الدراسة: تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها: أن المسئول الأول عن ظاهرة العنف والغلو وغياب التسامح في مجتمعاتنا العربية، هو الاستبداد السياسي والأنظمة الشمولية والدولة التسلطية، التي تزيد من الاحتقانات والتناقضات، ولا توفر مجالا ومناخا للتنافس السلمي أو ممارسة السياسة بعيدا عن المشاحنات واستخدام العنف.
لهذا فهي أنظمة قمعية وتمارس الإقصاء بكل صنوفه. ولا ريب أن من متواليات هذه الحالة هو زيادة وتيرة العنف وحالات اللاتسامح بين أبناء ومكونات المجتمع العربي.
لهذا فإننا نعتقد أن إزالة هذه العقبة الكأداء (أي الأنظمة التسلطية) سيكون له تأثيره العميق على حالة التسامح في العالم العربي. فرياح التغيير التي هبت على أكثر من منطقة عربية قبل عقد من الزمن وزيادة، هي رياح داعمة لخيار الاعتدال والتسامح، لأنها وببساطة شديدة تعمل على توسيع القاعدة الاجتماعية للسلطة وتطوير مفهوم المشاركة السياسية، وتزيد من تمثيل قوى المجتمع المختلفة في مؤسسات الدولة والسلطة. وسنناقش هذه الفرضية من خلال المحاور التالية:
- البيئة السياسية لمفهوم التسامح.
- الإصلاح السياسي، جسر العبور إلى التسامح.
- نحو حركة مدنية عربية.
مفتتح:
لا ريب أن الذي جرى في بعض البلدان العربية، مذهل وحيوي ومؤثر على عموم المنطقة خلال الفترة القادمة. ف (قد تمر عقود لا يقع فيها شيء يذكر، وقد تأتي أسابيع تقع فيها عقود).. إذ ساد في الفكر السياسي العربي خلال العقود الثلاثة الماضية، قناعة مفادها: أنه لا يمكن الاعتماد على الثورات الشعبية كوسيلة للإصلاح والتغيير السياسي في المنطقة. حتى اعتبر الكاتب المعروف محمد حسنين هيكل أن الثورة الإسلامية في إيران هي آخر الثورات الشعبية.
فجاءت أحداث وتطورات تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن لتعيد الاعتبار والدور للشعب والجمهور في عملية التغيير السياسي. ولا ريب أن هذه الحقيقة ستعيد النظر في الكثير من البديهيات السياسية التي سادت خلال السنين الماضية. وهذه الحقيقة بطبيعة الحال، بحاجة إلى تفاكر عميق وتداول للرأي متواصل لفهم ما جرى، وأخذ العبر والدروس منه.
فعلى المستوى الواقعي لا توجد آلية وطريقة واحدة، لإحداث التحول والتغيير في المجتمع. لهذا فإن نزعة النمذجة والاستنساخ، لا تساعد على إنضاج شروط التغيير والإصلاح في الواقع السياسي والاجتماعي.
ولعل من أهم تأثيرات كل هذه التحولات والتطورات المذهلة، هو تعزيز ثقة الناس بذاتها، وقدرتها على اجتراح عملية التغيير والإصلاح، مهما كانت الظروف والصعاب. وتحريك عجلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل بلدان المنطقة. وبمقدار ما تكون هناك قوى مجتمعية محلية فاعلة وقادرة على الضغط والفعل والتأثير، ستكون هناك تأثيرات فعلية في كل الساحات والمناطق العربية. فما جرى في تونس ومصر وبقية البلاد العربية، بمثابة الزلزال العميق والذي ستعيش المنطقة بأسرها تحت تأثير ارتداداته في الحقبة القادمة. ولكن مقدار هذا التأثير وفعاليته، مرهون على قدرة القوى المحلية في كل بلد من توظيف هذه الأحداث لصالح عملية الإصلاح السياسي. ودائما نحن بحاجة أن ندرك أن الحكومات لا تمارس التغيير ولا تقوم بإصلاح الأوضاع من تلقاء نفسها، وإنما يتحقق الإصلاح والتغيير حينما تتشكل كتلة وطنية واسعة تطالب بالإصلاح وتعمل وتكافح من أجله. وإن سرعة انهيار أنظمة الدولة التسلطية يعلمنا أن حكم الشعب بالإكراه والقمع والاستبداد وبغير رضا ومشاركة قد يطول، لكنه لا يمكنه أن يستمر ويدوم. ووجود جماعات فاعلة تطالب بالإصلاح وتعمل من أجله، يقلل من سنوات الظلم والاستبداد، وينهي ظاهرة العنف السياسي، ويفكك الحوامل التي تنتج هذه الآفة الخطيرة.
من هنا ينبغي أن ندرك أنه مهما كانت الصعوبات والمشاكل، فإن حركة التاريخ تثبت أن حكم الناس والشعب بالقهر وتكميم الأفواه لا يدوم، والمستقبل يصنعه فعل الإصلاح والمطالبة بالحقوق والحريات العامة. وما نود أن نتحدث عنه في هذه الدراسة وعلى ضوء تطورات وتحولات العالم العربي الحالية، هو قراءة في التحولات العربية، التي فاجأتنا جميعا، وأدخلتنا في مرحلة جديدة على مختلف الصعد والمستويات.
وأعتقد إن ما جرى في العالم العربي من ثورات ومطالبة بالحقوق والإصلاح السياسي، هي أهم ظاهرة سياسية عرفوها العرب منذ الاستقلال الأول للعديد من الدول والشعوب العربية.. فالاستقلال الأول للعرب كان عنوانه العريض هو التخلص من الاستعمار الذي جثم على صدر الشعوب العربية ونهب خيراتها وتحكم بمصائرها حقبا طويلة..
أما الاستقلال الثاني الذي دشنته الثورة التونسية فعنوانه العريض هو التخلص من الاستبداد السياسي ودمقرطة الحياة العربية..
المحور الأول: البيئة السياسية لمفهوم التسامح:
ثمة علاقة عميقة وعلى أكثر من مستوى تربط قيمة الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي تجربة إنسانية وقيمة العدالة. بمعنى أن كل المجتمعات الإنسانية، تنشد الاستقرار وتعمل إليه وتطمح إلى حقائقه في واقعها، إلا أن هذه المجتمعات الإنسانية، تتباين وتختلف في الطرق التي تسلكها، والسبل التي تنتهجها للوصول إلى حقيقة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
فالمجتمعات الإنسانية المتقدمة حضاريا، تعتمد في بناء استقرارها الداخلي، السياسي والاجتماعي على وسائل الرضا والمشاركة والديمقراطية والعلاقة الايجابية والمفتوحة بين مؤسسات الدولة والسلطة والمجتمع بكل مؤسساته المدنية والأهلية وشرائحه الاجتماعية وفئاته الشعبية. لذلك يكون الاستقرار، هو بمثابة النتاج الطبيعي لعملية الانسجام والتناغم بين خيارات الدولة وخيارات المجتمع.
بحيث يصبح الجميع في مركب واحد ويعمل وفق أجندة مشتركة لصالح أهداف وغايات واحدة ومشتركة.
لذلك غالبا ما تغيب القلاقل السياسية والاضطرابات الاجتماعية في هذه الدول والتجارب الإنسانية، وإن وجدت اضطرابات اجتماعية أو مشاكل سياسية وأمنية، فإن حيوية نظامها السياسي ومرونة إجراءاتها الأمنية وفعالية مؤسساتها وأطرها المدنية، هي العناصر القادرة على إيجاد معالجات حقيقية وواعية للأسباب الموجبة لتلك الاضطرابات أو المشاكل.
وإذا تحقق الاستقرار العميق والمبني على أسس صلبة في أي تجربة إنسانية، فإنه يوفر الأرضية المناسبة لانطلاق هذا المجتمع أو تلك التجربة في مشروع البناء والعمران والتقدم.
فالتقدم لا يحصل في مجتمعات تعيش الفوضى والاضطرابات المتنقلة، وإنما يحصل في المجتمعات المستقرة، والتي لا تعاني من مشكلات بنيوية في طبيعة خياراتها، أو شكل العلاقة التي تربط الدولة بالمجتمع والعكس.
فالمقدمة الضرورية لعمليات التقدم الاقتصادي والعلمي والصناعي، هي الاستقرار السياسي والاجتماعي وكل التجارب الإنسانية، تثبت هذه الحقيقة. ومن يبحث عن التقدم بعيدا عن مقدمته الحقيقية والضرورية، فإنه لن يحصل إلا على المزيد من المشاكل والمآزق، التي تعقد العلاقة بين الدولة والمجتمع وتربكها وتدخلها في دهاليز اللاتفاهم واللاثقة.
وفي مقابل هذه المجتمعات الحضارية - المتقدمة، التي تحصل على استقرارها السياسي والاجتماعي، من خلال وسائل المشاركة والديمقراطية والتوسيع الدائم للقاعدة الاجتماعية للسلطة، هناك مجتمعات إنسانية تتبنى وسائل قسرية وتنتهج سبل قهرية للحصول على استقرارها السياسي والاجتماعي.
فالقوة المادية الغاشمة، هي وسيلة العديد من الأمم والشعوب، لنيل استقرارها ومنع أي اضطراب أو فوضى اجتماعية وسياسية. وهي وسيلة على المستوى الحضاري والتاريخي، تثبت عدم جدوائيتها وعدم قدرتها على إنجاز مفهوم الاستقرار السياسي والاجتماعي بمتطلباته الحقيقية وعناصره الجوهرية.
لأن استخدام وسائل القهر والعنف يفضي اجتماعيا وسياسيا إلى تأسيس عميق لكل الأسباب المفضية إلى التباعد بين الدولة والمجتمع وإلى بناء الاستقرار السياسي على أسس هشة وضعيفة، سرعان ما تزول عند أية محنة اجتماعية أو سياسية.
وتجارب الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا والعراق، كلها تثبت بشكل لا مجال فيه للشك، أن العنف لا يبني استقرارا، وإن القوة الغاشمة لا توفر الأرضية المناسبة لبناء منجزات حضارية وتقدمية لدى أي شعب أو أمة.
فلا استقرار بلا عدالة، ومن يبحث عن الاستقرار بعيدا عن قيمة العدالة ومتطلباتها الأخلاقية والمؤسسية، فإنه لن يحصد إلا المزيد من الضعف والهوان.
فتجارب الأمم والشعوب جميعها تثبت أن العلاقة بين الاستقرار والعدالة هي علاقة عميقة وحيوية بحيث أن الاستقرار العميق هو الوليد الشرعي للعدالة بكل مستوياتها. وحين يتأسس الاستقرار السياسي والاجتماعي، لى أسس صلبة وعميقة، تتوفر الإمكانية اللازمة لمواجهة أي تحد داخلي أو خطر خارجي.
فالتحديات الداخلية لا يمكن مواجهتها على نحو فعال، بدون انسجام عميق بين الدولة والمجتمع. كما أن المخاطر الخارجية لا يمكن إفشالها بدون التناغم العميق بين خيارات الدولة والمجتمع. وكل هذا لن يتأتى بدون بناء الاستقرار السياسي والاجتماعي على أسس العدالة الأخلاقية والمؤسسية.
وإن الإنسان أو المجتمع، حينما يشعر بالرضا عن أحواله وأوضاعه، فإنه يدافع عنها بكل ما يملك، ويضحي في سبيل ذلك حتى بنفسه. وأي مجتمع يصل إلى هذه الحالة، فإن أكبر قوة مادية، لن تتمكن من النيل منه أو هزيمته.
فالاستقرار السياسي والاجتماعي المبني على العدالة، هو الذي يصنع القوة الحقيقية لدى أي شعب أو مجتمع.
لهذا فإن المجتمعات التي تعيش الاستقرار وفق هذه الرؤية والنمط، هي مجتمعات قوية وقادرة على مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية.
ونحن كمجتمعات عربية وإسلامية اليوم، وفي ظل التحديات الكثيرة، التي تواجهنا على أكثر من صعيد ومستوى، بحاجة إلى هذه النوعية من الاستقرار حتى نتمكن من مجابهة تحدياتنا والتغلب على مشاكلنا والتخلص من كل الثغرات الداخلية التي لا تنسجم ومقتضيات الاستقرار العميق. وخلاصة القول: أن البيئة السياسية لمفهوم التسامح وحقائقه المجتمعية، هي الاستقرار السياسي والاجتماعي المستند على قاعدة العدالة بكل تجلياتها ومجالاتها. والمجتمع الذي تغيب عن فضائه السياسي والاجتماعي والثقافي، حقائق العدالة تبرز فيه مظاهر ونزعات الغلظة والعنف والتشدد وكل حقائق اللا تسامح.
فالطريق الى التسامح هو انجاز مفهوم العدالة والذي يؤسس لاستقرار عميق بين الدولة والمجتمع، وبين المجتمع بمختلف مكوناته وتعبيراته.
وللاستقرار السياسي المبني على قاعدة العدالة الكثير من الثمار والآثار الإيجابية من أبرزها سيادة قيم وحقائق التسامح في الفضاء الاجتماعي
المحور الثاني: الإصلاح السياسي جسر العبور إلى التسامح:
لعل من أهم الآثار التي وضحتها رياح التغيير التي اجتاحت بعض دول العالم العربي، أن المنطقة العربية بأسرها، تحتاج إلى إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية. وإن الأمن الحقيقي لهذه الدول والمجتمعات، لا يتأتى بالمزيد من الكبت والقمع، بل بالانخراط الحقيقي في عملية الإصلاح السياسي.
وإن عملية الإصلاح السياسي بكل مجالاته وآفاقه، هو الخيار الأمثل لإنجاز مفهوم وحقائق التسامح في العالم العربي. وتتضح هذه الحقيقة من خلال بيان العناوين التالية:
- الإصلاح السياسي حاجة عربية.
- العالم العربي ودولة المواطنة.
- العالم العربي والحكم الرشيد.
الإصلاح السياسي .. حاجة عربية:
إن إصلاح الأوضاع العربية وتطوير أحوالها، هو حاجة عربية أصيلة، قبل أن تكون رغبة أمريكية وأوروبية، تبلورت وفق أجندة وأهداف خاصة واستراتيجية.
وهي شوق عربي تاريخي ومتراكم وعميق، إذ لا تخلو حقبة من حقب التاريخ العربي الحديث والمعاصر من هذا الشوق والصوت والفعل الذي يطالب بالإصلاح وسد الثغرات وتطوير الأوضاع.
لذلك فإن المطالبة بالإصلاح في الحياة العامة العربية، هو شوق أصيل، قبل أن يكون مشروعاً أميركياً يحتضن في أحشائه الكثير من المصالح الاستراتيجية والاستهدافات التي لا تنسجم ومصالحنا ورؤيتنا لموقعنا الخاص والعام. لذلك من الظلم لعالمنا العربي حينما نتعامل مع مقولة ومشروع الإصلاح، بوصفها مقولة أميركية - غربية. وذلك لأن العديد من الشخصيات والنخب العربية كانت تطالب بالإصلاح وتدفع ثمنه. في الوقت الذي كانت الإرادة الأميركية مغايرة ومناقضة لهذا المشروع.
بل كانت آليات وأدوات السياسة الأميركية في المنطقة معرقلة ومجهضة لكل خطوات ومبادرات الإصلاح.
من هنا فإننا من الأهمية بمكان أن لانقبل أو لا تنطلي علينا لعبة الإصلاح الأميركي في العالم العربي والشرق الأوسط الكبير.
فالإصلاح بكل بنوده وآفاقه، هو حاجة عربية أصيلة، ودفعنا كشعوب ومجتمعات تضحيات ودماء غزيرة لتثبيت هذا الخيار في الفضاء العربي.
ومن المغالطات التاريخية الكبرى أن نتعامل مع هذه المقولة بوصفها طارئة على عالمنا العربي، أو هي خاصة بالمشروع الأميركي للإصلاح، مما يحول على المستوى الفعلي من تنفيذ خطوات إصلاحية في العالم العربي.
وعليه فإن الإصلاح السياسي والثقافي والاقتصادي في العالم العربي، هو حاجة عربية أصيلة وملحة وبعيداً عن كل الإسقاطات الخارجية التي لا تستهدف سوى مصالحها وأجندتها الاستراتيجية.
وإن هذه الحاجة العربية الملحة والمتعاظمة باستمرار، لا تلغيها شعارات ومشروعات الولايات المتحدة الأميركية للإصلاح. ولعلنا نجد وبوضوح في الأفق السياسي للمشهد العربي مقولات التأجيل ومشروعات التسويف ويافطات التعليق بدعوى المشروعات والضغوطات الأميركية والأوروبية.
وإننا نعتقد أن هذه المقولات والمشروعات العربية التي تبرر الجمود والتوقف عن مشروعات الإصلاح وفق الأجندة والإرادة العربية، هي ليست مؤمنة بشكل عميق وحقيقي بضرورات الإصلاح في العالم العربي، وتبحث باستمرار عن حجج لترحيل الإصلاح أو تأجيله أو تعليقه وربطه بقضايا ومسائل، نحن نعتقد بشكل جازم أن الإصلاح هو طريقنا لنيل حقوقنا في تلك القضايا والمسائل.
وما نود أن نؤكد عليه ف هذا السياق، هو أن إصلاح الأوضاع في العالم العربي وفي حقول الحياة المختلفة، هو حاجة عربية أصيلة وشوق تاريخي لكل نخب الأمة. لذلك لا يجوز إغفال هذه الحقيقة أو تشويهها، لأنها تستند إلى عمق تاريخي وشواهد معاصرة، بدعوى أن الولايات المتحدة الأميركية هي صاحبة مشروع الإصلاح في المنطقة.
إن المجتمعات العربية بكل فئاتها وشرائحها، طالبت وتطالب بإصلاح أوضاعها وتطوير أحوالها، وفي الوقت الذي كانت السياسة الأميركية في المنطقة تحارب كل دعوات الإصلاح، وتجهض كل خطواته ومبادراته.
لذلك لا يصح بأي شكل من الأشكال، أن نزور حقائق التاريخ، وندعي ادعاءات تكذبها وقائع الراهن وأشواق الأمة العميقة للإصلاح والتطوير والتقدم. كما أننا نعتقد وبشكل عميق، أننا لا نتمكن على الصعيد العملي من مجابهة مخططات الولايات المتحدة الأميركية تجاه منطقتنا إلا بالانخراط في مشروع الإصلاح وفق الأجندة والإرادة العربية.
ووجود مشروعات أميركية وغربية للإصلاح في منطقتنا هو مدعاة للتفكير في مشروع عربي للإصلاح نبدأ بتنفيذ خطواته وبرنامجه.
فمن الخطأ أن نواجه مخططات أميركا في المنطقة، بالنكوص من حاجاتنا ومتطلباتنا الحقيقية.
إننا بحاجة أن ننصت إلى حاجاتنا ومتطلباتنا، بعيداً عن مخططات الآخرين وشعاراتهم ومشروعاتهم.
ونرتكب جريمة كبرى بحق أنفسنا وتاريخنا، حينما نتوقف عن مشروعات تلبي حاجاتنا وتفي بمتطلباتنا بدعوى أن الآخرين قد حملوا ذات الشعار أو المشروع.
كما أننا نعتقد وبشكل جازم أن الإصلاح الحقيقي لأوضاعنا وأحوالنا، لا يمكن أن يستورد أو نجلبه من الخارج، وإنما هو نابع من داخلنا وحاجاتنا الذاتية. ونحن الذين ينبغي أن نبلور لأنفسنا خطة للإصلاح ومشروعاً للتغيير والتطوير.
وبطبيعة الحال لا يمكن أن نمنع الآخرين عن التفكير فأوضاعنا وأحوالنا، ولكن تفكيرهم ليس مشروعنا، وإرادتهم ليست إرادتنا. والمطلوب دائماً هو بلورة إرادة عربية ذاتية، تتجه صوب الإصلاح والتطوير، بعيداً عن مخططات الآخرين وأجندتهم الخاصة والاستراتيجية.
ونحن هنا لا ندعو إلى عدم إدراك تطورات اللحظة الراهنة وتحولاتها، ولكننا نريد أن نقول أن حجر الأساس في مشروعات الإصلاح في العالم العربي ليس مشروعات الآخرين واستهدافاتهم، وإنما هو إرادتنا وحاجتنا الفعلية إلى الإصلاح.
لذلك فإن المطلوب ليس التحايل على مشروعات الآخرين أو تزويرها، وإنما الإنصات الدقيق لحاجاتنا ومتطلباتنا الذاتية والداخلية بعيداً عن كل ضغوطات الخارج وإملاءاته. فقوتنا الحقيقية ليست في الانصياع لمشروعات الخارج أو تمرير أجندته، وإنما في المزيد من التلاحم الداخلي وتطوير مستوى الرضا بين السلطة والمجتمع في المجال العربي.
فقوة دولنا في استنادها على مجتمعاتها وشعوبها، وهذا يتطلب باستمرار تطوير مستوى الانسجام والمشاركة بين الطرفين.
فصم الآذان تجاه إيقاع المجتمع ومتطلباته وحاجاته، هو الذي يخلق الظروف والمناخ المناسب للخضوع لإملاءات الخارج وأجندته. ولابد أن ندرك أن إصلاح الأوضاع وتطوير الأحوال على الصعد كافة، هو من السنن الاجتماعية الرئيسية، لأن التوقف عن التطوير والجمود على الحال، سيكلفنا خسائر أكبر بكثير من الخسائر المتوقعة لمشروع التطوير والإصلاح.
حيث إننا نعيش في ظل ظروف وتطورات تطال العالم بأسره، وتؤكد وتلح في التأكيد، على أن إصلاح الأوضاع هو أسهل الخيارات وأقلها كلفة.
وإن تلكؤ أي مجتمع عن هذا، سيفقده استقلاله وسيدخله في أتون الضغوطات والإكراهات التي ستكلف هذا المجتمع الكثير من الخسائر والأثمان.
إننا مع الإصلاح الذي ينطلق من ذاتنا ويلبي حاجاتنا ومتطلباتنا، ولكننا نعيش في ظل أوضاع إقليمية ودولية تدفعنا إلى الاعتقاد أن تراخينا أو تراجعنا عن مشروع الإصلاح وفق رغبتنا وحاجاتنا ومتطلباتنا، سيدفع المتربصين بنا إلى الضغط علينا وتحميلنا أجندتهم ومشروعاتهم.
لذلك فإن التأخير أو التوقف عن مشروعات الإصلاح في العالم العربي، ليس في مصلحة استقرار واستقلال عالمنا العربي.
وأود في إطار التأكيد على أن الإصلاح حاجة عربية، قبل أن يكون أي شيء آخر، أن أركز على النقاط التالية:
1- إن إصلاح الأوضاع في العالم العربي، ليس تطلعاً اجتماعياً وشعبياً فحسب، بل هو ضرورة قصوى للاستقرار السياسي في العديد من البلدان العربية.
إذ أن هذه الدول تعيش أوضاعاً وأحوالاً، تستلزم الانخراط الحقيقي في مشروعات الإصلاح حتى يتسنى لها الخروج من مأزق الفتن والتحولات العشوائية غير المدروسة.
فالإصلاح حاجة اجتماعية وشعبية، كما هو ضرورة للاستقرار السياسي. لذلك من الخطأ أن يتم التعامل مع مقولة ومشروع الإصلاح بوصفه مهدداً للمكاسب أو محرضاً على الحكومات.
إن الإصلاح السياسي في العالم العربي، حاجة ماسة للجميع وبدون استثناء، والفوائد والأرباح المتوقعة منه أيضاً شاملة للجميع. فإن الظروف السياسية والاجتماعية في العالم العربي، وصلت إلى مستوى صعوبة بقاء الأمور والأوضاع على حالها، وإن الإصلاح وتطوير الأوضاع هو أقل الطرق خسائر سياسية واجتماعية وإنسانية.
وإن الإصرار على إبقاء الأمور على حالها، ينذر بكوارث خطيرة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لهذا فإن الإصلاح هو ضرورة للحكومات والمؤسسات الرسمية، كما هو يلبي طموحات وتطلعات المجتمعات العربية.
2- بدون إغفال دور العوامل الخارجية وتأثيراتها السلبية على مستقبل القضية الفلسطينية، فإننا نستطيع القول : إن إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، هو من العوامل والحقائق المساندة لنضال وجهاد الشعب الفلسطيني.
ونخطئ حينما نتصور أن إبقاء الأمور على حالها، سيوفر لنا إمكانية الدعم والإسناد للقضية الفلسطينية. إن إصلاح أوضاعنا وتطوير أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية والقبض على أسباب الاستقرار السياسي العميق وتمتين أواصر العلاقة بين السلطة والمجتمع في الفضاء العربي، كل هذا يصب في المحصلة النهائية لصالح القضية الفلسطينية. وذلك لأن هيمنة المشروع الصهيوني في المنطقة، هو وعبر التسلسل المنطقي هو من جراء اهتراء حياتنا السياسية وتراجع أدائنا الاقتصادي. وإن جمود الأوضاع سيشجع العدو الصهيوني على المزيد من الغطرسة والهيمنة.
وفي تقديري أن الرد الاستراتيجي على المشروع الصهيوني وهيمنته وغطرسته وذبحه اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني، هو في إصلاح أوضاع العالم العربي وإنهاء نقاط التوتر ومجالات الضعف، وذلك حتى يتسنى لعالمنا العربي ومن موقع القدرة والتميز دعم الشعب الفلسطيني وصولاً لتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجماع القول: إن الإصلاح في العالم العربي غير قابل للتأجيل والترحيل، لأنه خيارنا الحيوي الوحيد، الذي نتمكن من خلاله تطوير مستوى الاستقرار وتعزيز البناء الداخلي الوطني والقومي ومجابهة مخاطر الخارج وتحدياته المتعددة والمتشعبة.
وثمة حقيقة أساسية في هذا السياق ينبغي البوح بها وهي: أن العالم العربي بكل دوله وشعوبه وبعيداً عن المشاريع الإصلاحية المطروحة من قبل جهات دولية عديدة، التي وصل عددها إلى (21 مبادرة) هو بحاجة إلى عملية إصلاح تنبثق من إرادته الذاتية، وتجيب بشكل حضاري على تحدياته ومآزقه. ولم يعد مجدياً التحجج بوجود مشروعات دولية للإصلاح في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، لأن بعض النخب العربية تنظر إلى وجود مبادرات دولية على الصعيد، يلزمنا بتأجيل هذا المشروع، والانخراط في مشروع مقاومة التدخلات الأجنبية في مناطقنا ودولنا. بينما القراءة السليمة والواعية لهذه المبادرات، ينبغي أن تدفعنا إلى الإسراع في مشروع الإصلاحات السياسية والثقافية والاقتصادية في العالم العربي ووفق أجندتنا الذاتية، وحتى نتمكن من إفشال كل المخططات التي تستهدف فرض أنماط معينة للإصلاح، أو تسعى إلى التدخل في شؤوننا.
لا يمكننا اليوم ووفق التطورات الكبرى التي تجري في المشهد الإقليمي والدولي والمحلي، وكذلك حجم التحديات التي تواجهنا من الوقوف سلبيين أمام حاجتنا الملحة إلى الإصلاح على الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية.
فحاجتنا إلى الإصلاح، نابعة من أوضاعنا وأحوالنا التي تتراجع وتعيش القهقرى، وإصرارنا على أن خيار الإصلاح هو جسر الجميع للخروج من مآزق الراهن، هو بسبب إدراكنا العميق أن التأخر عن الاستجابة الحقيقية لتحديات اللحظة الراهنة ومتطلباتها، سيكلفنا الكثير وسيدخلنا في ظروف وأوضاع لا تنسجم وتطلعاتنا لواقعنا العربي.
كما أننا كدول وشعوب عربية، لا يمكن أن نواجه تحديات الخارج ومخططاته ومشاريعه ومبادراته، إلا بسحب البساط منها، وسد ثغرات واقعنا الداخلي. وكل هذا لا يتم إلا بالانخراط في مشروع الإصلاح، الذي يزيل الاحتقانات، وينهي التوترات، ويجيب إجابة فعلية على تحديات المرحلة.
ولمعطيات ومؤشرات وحقائق سياسية ومجتمعية قائمة في الفضاء العربي، نستطيع القول: إن تأخير مشروع الإصلاح سيكلف العالم العربي الكثير من الخسائر البشرية والمادية وسيفاقم من التوترات والتهديدات على المستويين الداخلي والخارجي.
فاللحظة الزمنية الحالية، هي لحظة الانخراط في مشروع الاصلاحات ووفق أجندة وأولويات عربية، وأي تأخير لأي سبب من الأسباب، يعني ضياع الفرصة والمزيد من الأزمات والتوترات والمخاطر.
لذلك فإننا نعتقد أن خيار الإصلاح السياسي في اللحظة الراهنة، هو الخيار القادر على إخراج مؤسسة الدولة في العالم العربي من الكثير من نقاط ضعفها وقصورها البنيوي والوظيفي.
كما أن هذا الخيار، هو القادر على ضبط المجتمع وإنهاء توتراته بعيداً عن خيارات العنف والعنف المضاد. لذلك فإن الإصلاح السياسي حاجة عربية أكيدة وضرورة مشتركة للدولة والمجتمع.
وإن العلاقة جد قريبة بين مفهوم الأمن ومفهوم الإصلاح، إذ في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، لا يمكن صيانة الأمن الوطني لكل دولة عربية، إلا بمشروع الإصلاح، الذي ينهي الكثير من العوامل والأسباب التي تفضي أو تؤدي في محصلتها النهائية إلى الإخلال بالأمن والاستقرار.
فالأمن الشامل اليوم، أضحى ضرورة لكل شيء. فلا تنمية بلا أمن ولا استقرار بلا أمن ولا علاقات طبيعية بلا أمن. ولكن السؤال الذي يطرح دائماً: هل يمكن أن نحقق الأمن الشامل بدون الإصلاح السياسي؟
إننا نرى ومن خلال تجارب العديد من الأمم والشعوب، أن الإصلاح وما يخلق من ظروف وأوضاع جديدة، من المداخل الأساسية والضرورية لإنجاز مفهوم الأمن.
فالإصلاح السياسي حاجة عربية، لأنه سبيلنا لتحقيق أمننا الشامل ولا يمكننا بأية حال من الأحوال، أن ننهي عوامل الإخلال بالأمن في الفضاء العربي، إلا بالانخراط الحقيقي في مشروع الإصلاحات السياسية والثقافية والاقتصادية.
وجماع القول: إن العالم العربي بكل دوله وشعوبه، بحاجة أن يخطو خطوات عملية وحقيقية في مشروع الإصلاح. وذلك من أجل إنهاء الاحتقانات والتوترات الداخلية، وحتى يتمكن هذا الفضاء السياسي من امتلاك القدرة الحقيقية على مجابهة تحديات الخارج ومشروعاته ومبادراته.
العالم العربي ودولة المواطنة:
لعلنا لا نأت بجديد حي القول: أن أغلب المجال العربي بكل دوله وشعوبه، يعاني من تحديات خطية وأزمات بنيوية، ترهق كاهل الجميع وتدخلهم في أتون مآزق كارثية.
فبعض دول هذا المجال العربي، دخلت في نطاق الدول الفاشلة، التي لا تتمكن من تسيير شؤون مجتمعها، مما أفضى إلى استفحال أزماتها ومآزقها على كل الصعد سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية. والبعض الآخر من الدول والمجتمعات، مهدد في وحدته الاجتماعية والسياسية، حيث قاب قوسين أو أدنى من اندلاع بعض أشكال وصور الحرب الأهلية.
ودول أخرى تعاني من غياب النظام السياسي المستقر، ولا زالت أطرافه ومكوناته السياسية والمذهبية، تتصارع على شكل النظام السياسي، وطبيعة التمثيل لمكونات وتعبيرات مجتمعها.
إضافة إلى هذه الصور، هناك انفجار للهويات الفرعية في المجال العربي بشكل عمودي وأفقي، مما يجعل النسيج الاجتماعي مهددا بحروب وصراعات مذهبية وطائفية وقومية وجهوية. ونحن نعتقد أن اللحظة العربية الراهنة، مليئة بتحديات خطيرة، تهدد استقرار الكثير من الدول والمجتمعات العربية وتدخل الجميع في أتون نزاعات عبثية، تستنزف الجميع وتضعفهم وتعمق الفجوة بين جميع الأطراف والمكونات.
وفي تقديرنا أن المشكلة الجوهرية، التي ساهمت بشكل أو بآخر في بروز هذه المآزق والتوترات في المجال العربي، هي غياب علاقة المواطنة بين مكونات وتعبيرات المجتمع العربي الواحد.
فالمجتمعات العربية تعيش التنوع الديني والمذهبي والقومي وغياب نظام المواطنة كنظام متجاوز للتعبيرات التقليدية، جعل بعض هذه المكونات تعيش التوتر في علاقتها وبرزت في الأفق توترات طائفية ومذهبية وقومية. فالعلاقات الإسلامية – المسيحية في المجال العربي، شابها بعض التوتر وحدثت بعض الصدامات والتوترات في بعض البلدان العربية التي يتواجد فيها مسيحيون عرب.
وفي دول عربية أخرى، ساءت العلاقة بين مكوناتها القومية، بحيث برزت توترات وأزمات قومية في المجال العربي. وليس بعيدا عنا المشكلة الأمازيغية والكردية والأفريقية.
وإضافة إلى هذه التوترات الدينية والقومية، هناك توترات مذهبية بين السنة والشيعة، وعاشت بعض الدول والمجتمعات العربية توترات مذهبية خطيرة تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي.
فحينما تتراجع قيم المواطنة في العلاقات بين مكونات المجتمعات العربية، تزداد فرص التوترات الداخلية في هذه المجتمعات. لهذا فإننا نعتقد أن العالم العربي يعيش مآزق خطيرة على أكثر من صعيد، وهي بالدرجة الأولى تعود إلى خياراته السياسية والثقافية. فحينما يغيب المشروع الوطني والعربي والذي يستهدف استيعاب أطياف المجتمع العربي وإخراجه من دائرة انحباسه في الأطر والتعبيرات التقليدية إلى رحاب المواطنة.
فإن هذا الغياب سيدخل المجتمعات العربية في تناقضات أفقية وعمودية، تهدد استقرارها السياسي والاجتماعي.
وإن نزعات الاستئصال أو تعميم النماذج، لا تفضي إلى معالجة هذه الفتنة والمحنة، بل توفر لها المزيد من المبررات والمسوغات. فدول المجال العربي معنية اليوم وبالدرجة الأولى بإنهاء مشاكلها الداخلية الخطيرة، التي أدخلت بعض هذه الدول في خانة الدول الفاشلة والبعض الآخر على حافة الحرب الداخلية التي تنذر بالمزيد من التشظي والانقسام.
فما تعانيه بعض دول المجال العربي على هذا الصعيد خطير وإذا استمرت الأحوال على حالها فإن المجال العربي سيخرج من حركة التاريخ وسيخضع لظروف وتحديات قاسية على كل الصعد والمستويات.
وإن حالة التداعي والتآكل في الأوضاع الداخلية العربية، لا يمكن إيقافها أو الحد من تأثيراتها الكارثية، إلا بصياغة العلاقة بين أطياف المجتمع على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وإن غياب مقتضيات وحقائق المواطنة في الاجتماع السياسي العربي، سيقوي من اندفاع المواطنين العرب نحو انتماءاتهم التقليدية، وعودة الصراعات المذهبية والقومية والدينية بينهم، وسيوفر لخصوم المجال العربي الخارجي إمكانية التدخل والتأثير في راهن هذا المجال ومستقبله.
فالمجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات الإنسانية، التي تحتضن تعدديات وتنوعات مختلفة، لا يمكن إدارة هذه التعدديات على نحو إيجابي إلا بالقاعدة الدستورية الحديثة [المواطنة] كما فعلت تلك المجتمعات الإنسانية التي حافظت على أمنها واستقرارها.
فالاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمعات العربية، هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية.
وأي مجتمع عربي لا يفي بمقتضيات هذه المواطنة، فإن تباينات واقعه ستنفجر وسيعمل كل طرف للاحتماء بانتماءه التقليدي والتاريخي. مما يصنع الحواجز النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية بين مكونات المجتمع الواحد.
وفي غالب الأحيان فإن هذه الحواجز، لا تصنع إلا بمبررات ومسوغات صراعية وعنفية بين جميع الأطراف. فتنتهي موجبات الاستقرار ويدخل الجميع في نفق التوترات والمآزق المفتوحة على كل الاحتمالات.
لهذا فإن دولة المواطنة هي الحل الناجح لخروج العالم العربي من مآزقه وتوتراته الراهنة.
فدولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه، وهي التي تستوعب جميع التعدديات وتجعلها شريكة فعلية في الشأن العام وهي التي تجعل خيارات المجتمع العليا منسجمة مع خيارات الدولة العليا والعكس وهي التي تشعر الجميع بأهمية العمل على بناء تجربة جديدة على كل المستويات وهي التي تصنع الأمن الحقيقي لكل المواطنين في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي تمر بها المنطقة .
والمجتمعات لا تحيا حق الحياة، إلا بشعور الجميع بالأمن والاستقرار. لهذا فإن الأمن والاستقرار لا يبنى بإبعاد طرف أو تهميشه وإنما بإشراكه والعمل على دمجه وفق رؤية ومشروع متكامل في الحياة العامة.
وهذا لا تقوم به إلا دولة المواطنة، التي تعلي من شأن هذه القيمة، ولا تفرق بين مواطنيها لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية.
فهي دولة الجميع وهي التمثيل الأمين لكل تعبيرات وحراك المجتمع.
فالمجال العربي اليوم من أقصاه إلى أقصاه، أمام مفترق طرق. فإما المزيد من التداعي والتآكل أو وقف الانحدار عبر إصلاح أوضاعه وتطوير أحواله والانخراط في مشروع استيعاب جميع أطرافه ومكوناته في الحياة السياسية العامة. فالخطوة الأولى المطلوبة للخروج من كل مآزق الراهن وتوتراته في المجال العربي، هي أن تتحول الدولة في المجال العربي إلى دولة استيعابية للجميع، بحيث لا يشعر أحد بالبعد والاستبعاد. دولة المواطن بصرف النظر عن دينه أو مذهبه أو قومه، بحيث تكون المواطنة هي العقد الذي ينظم العلاقة بين جميع الأطراف. فالمواطنة هي الجامع المشترك، وهي حصن الجميع الذي يحول دون افتئات أحد على أحد.
وخلاصة القول: أن دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، هي خشبة الخلاص من الكثير من المآزق والأزمات.
العالم العربي والحكم الرشيد:
يعيش العالم العربي بكل دوله وشعوبه اليوم، الكثير من التحولات والتطورات المتسارعة. حيث دشنت لحظة سقوط نظام بن علي في تونس عملية التغييرات والتحولات التي لا زال تأثيرها ممتدا ومتواصلا في كل أرجاء العالم العربي بمستويات وأشكال متفاوتة ومختلفة. ولا ريب أن ما يجري من أحداث وتطورات في بعض البلدان العربية، هو مذهل وغير متوقع وكل المعطيات السابقة، لا تؤشر أن ما حدث سيكون قريبا.
لهذا فإن كل هذه التطورات والتحولات هي بمستوى من المستويات مفاجئة للجميع.
لذلك فإن النخب السياسية في العالم العربي بكل أيديولوجياتها وخلفياتها الفكرية، كانت تعيش حالة من اليأس تجاه قدرة الشعب أو الشعوب العربية من إحداث تحولات دراماتيكية ف واقعها السياسي وواقع المنطقة بشكل عام. ولكن جاءت أحداث وتطورات وتحولات تونس ومن بعدها مصر، لكي تثبت عكس ما كانت تروجه بعض الأيديولوجيات والنخب تجاه الجماهير وقدرتها على إحداث تغيير سياسي في واقعها العام. والملفت للنظر والذي يحتاج إلى الكثير من التأمل العميق هو أن جيل الشباب، أي جيل الإعلام الجديد من الفيسبوك وتويتر ويوتيوب، هو الذي قاد عملية التغيير، وهو الذي تمكن من تحريك الشارع العام في تونس ومصر. فالجيل الجديد الذي كانت تصفه بعض النخب والجماعات، بأنه جيل ترعرع بدون قضية عامة يسعى من أجلها ويناضل في الدفاع عنها عكس أجيال الخمسينيات والستينيات، هو الذي قاد عملية التغيير، وبوسائله السلمية استطاع أن يحرك كل النخب وكل شرائح وفئات المجتمع الأخرى.
لهذا فإن ما حدث ويحدث في العالم العربي اليوم هو مذهل وقد أنهى حقبة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث كان الغرب ينظر إلى شرائح المجتمعات العربية المختلفة بوصفها مشروع قائم أو محتمل للإنسان الإرهابي الذي يفجر نفسه ويقوم بأعمال عنفية لا تنسجم وقيم الدين وأعراف العالم العربي وتقاليده الراسخة.
فما جرى في تونس ومصر، حيث حضر الشباب، ومارسوا حقهم بالتعبير عن الرأي، أنهى على المستوى الاستراتيجي حقبة بقاء الشباب العربي تحت تهمة وتداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
فالنموذج الجديد الذي قدمه الشباب العربي في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا وسياسيا ومطلبيا هو أنه جيل يستحق أن يعيش حياة كريمة وأن تعاطيه الشأن العام عبر عنه خارج الأطر والأحزاب الأيدلوجية، وإنما مارسه بطريقته الخاصة، والمذهل في الأمر أن هذه الطريقة غير المتوقعة هي التي أتت أكلها، ونجحت في إحداث تغييرات وتحولات سياسية واجتماعية كبرى في أكثر من بلد عربي. لهذا فإننا نعتقد أن المنطقة العربية بأسرها، تعيش مرحلة جديدة على أكثر من صعيد. وما نود أن نؤكد عليه في هذا السياق هي النقاط التالية:
– إن المجتمعات والشعوب العربية تستحق حكومات وأنظمة سياسية متطورة ومدنية وتفسح المجال للكفاءات الوطنية المختلفة للمشاركة في تنمية الأوطان العربية وتطويرها على مختلف الصعد والمستويات.
والذي يلاحظ أن الدول العربية التي كانت أو لا زالت في منأى من موجة المطالبة بالإصلاحات والتغييرات، هي تلك الدول التي تعيش ف ظل أنظمة وحكومات فيها بعض اللمسات أو الحقائق الديمقراطية أو تمكنت من حل بعض مشاكل شعبها الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك فإننا نعتقد أن هذه الموجة ستطال بشكل أو بآخر كل الدول والشعوب العربية.
ونحن نعتقد أن مسارعة الدول العربية في القيام بإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، سيقلل من فرص خروج الناس إلى الشارع إلى المطالبة بحقوقهم. وما جرى في تونس ومصر، يوضح بشكل لا لبس فيه أن المجتمعات العربية تستحق أوضاعا سياسية واقتصادية وقانونية أفضل مما تعيشه الآن.
- إن التحولات السياسية الكبرى التي تحققت في تونس ومصر وموجاتهما الارتدادية في أكثر من بلد عربي، تجعلنا نعتقد وبعمق أن المشاكل الكبرى وبالذات على الصعيد السياسي متشابهة في أغلب الدول العربية. فالحكومات والأنظمة السياسية في هذه الدول، هي أنظمة ذات قاعدة اجتماعية ضيقة، مع تضخم في أجهزتها الأمنية التي تمارس الإرهاب والقمع بكل صوره وأشكاله، مما زاد من الاحتقانات، وراكم من المشكلات البنيوية التي يعيشها المجتمع والدولة في هذا البلد العربي أو ذاك.
وبفعل هذه الحقيقة تمكنت هذه الدول التسلطية من إفراغ كل الأشكال والحقائق الديمقراطية الموجودة في أكثر من بلد عربي من مضمونها الحقيقي، حتى أضحت نموذجا صارخا للمقولة التي أطلقها المفكر المصري (عصمت سيف الدولة) بالاستبداد الديمقراطي. فالأشكال الديمقراطية أصبحت عبئا حقيقيا على المجتمعات العربية ونخبها السياسية والاجتماعية والثقافية، لأنه باسم الديمقراطية يتم تأييد السلطة واحتكار عناصر القوة وتستفحل من جراء هذا كل أمراض الاستبداد والديكتاتورية.
– إن الإصلاح السياسي الذي نراه أنه جسر عبور لكل الدول العربية إلى مرحلة جديدة، تؤهلها لتجاوز بعض مشكلاتها ومعالجة أزماتها الداخلية ويحصنها من خلال تطوير علاقة الدولة بمجتمعها تجاه كل التحديات والمخاطر. أقول أن هذا الإصلاح السياسي هو ضرورة حكومية – رسمية، كما هو حاجة وضرورة مجتمعية.
فهو (الإصلاح) ضرورة للحكومات العربية لتجديد شرعيتها الوطنية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية ولكي تتمكن من مواجهة التحديات المختلفة. كما هو (أي الإصلاح) ضرورة وحاجة للمجتمعات العربية، لأنه هو الذي يخرج الجميع من أتون التناقضات الأفقية والعمودية الكامنة في قاع المجتمعات العربية، وهو الذي يصيغ العلاقة بين مختلف المكونات على أسس الاحترام المتبادل والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ومن المعلوم أن الانغلاق في السلطة سمة من سمات الدولة التسلطية (على حد تعبير خلدون النقيب في كتابه: الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر – دراسة بنائية مقارنة). وهو يعبر عن حالة غير طبيعية في مسيرة الدولة الحديثة، هي حالة التماهي بين السلطة والدولة. لهذا فإن العالم العربي بحاجة إلى أنظمة سياسية حديثة تستجيب لشروط العصر وتتناسب والدينامية الاجتماعية المتدفقة.
– إن التجارب والتحولات السياسية الكبرى، تجعلنا نعتقد أن الشيء الأساسي الذي يجعل عمر الدول طويلا وممتدا عبر التاريخ، ليس هو ترسانتها العسكرية وموقعها الجغرافي والاستراتيجي وإنما هو قبول ورضا الناس بها. إذ أن كل تجارب الدول عبر التاريخ الطويل تثبت بشكل لا لبس فيه أن حكم الناس بالإكراه قد يطول، إلا أنه لا يدوم. وإن عمر الدول واستمرارها مرهون بقدرة هذه الدول على تحقيق رضا وقبول الناس بها. بمعنى أن الدول حتى ولو كانت إمكاناتها البشرية محدودة وثرواتها الطبيعية والاقتصادية متواضعة، إلا أن رضا الناس بها، وقبول الشعب بأدائها وخياراتها، فإن هذا الرضا والقبول يجبر الكثير من نواقص الدولة الذاتية أو الموضوعية، ويمدها بأسباب الاستمرار والديمومة.
فالذي يديم الدول ويوفر لها إمكانية الاستمرار، هو مشاركة الناس في شؤونها المختلفة واحتضانهم إلى مشروعها وشعورهم بأنها (أي الدولة) هي التعبير الأمثل لآمالهم وطموحاتهم المختلفة.
وما جرى في تونس ومصر من أحداث وتحولات سياسية سريعة، يؤكد هذه الحقيقة. فكل المؤسسات والأجهزة العسكرية، لم تستطع أن تدافع عن مؤسسة السلطة التي يرفضها الناس ويعتبرونها معادية لهم في حياتهم اليومية وتصوراتهم لذاتهم الجمعية والمستقبلية. لهذا فإننا نعتقد إن إسراع الدول في إصلاح أوضاعها وتطوير أنظمتها القانونية والدستورية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية وتجديد شرعيتها السياسية، كل هذه العناصر تساهم ف إعطاء عمر جديد لهذه الدول.
فتحريك عجلة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دولنا العربية، أضحى اليوم من الضرورات والأولويات، التي تحول دون دخول دولنا العربية في أتون المشكلات والأزمات التي تعوق من مسيرتها ودورها في الحياة الوطنية والقومية والدولية.
ومن المؤكد أن اقتراب الدول العربية من قيم ومعايير الحكم الرشيد، هو الذي سيعيد الاعتبار إلى المنطقة العربية وهو السبيل المتاح والممكن اليوم للخروج من العديد من الأزمات والمآزق على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وحده الحكم الرشيد بكل قيمه ومضامينه ومقتضياته، هو الذي سيعيد العالم العربي إلى حركة التاريخ ودون ذلك ستبقى المنطقة بكل ثرواتها البشرية والاقتصادية بعيدا عن القبض على أسباب التقدم والاستمرار الحضاري.
المحور الثالث: نحو حركة عربية مدنية:
لقد أبانت التطورات والتحولات الكبرى، التي جرت في أكثر من بلد عربي، هو أن مشاكل البلاد العربية متشابهة مع بعضها البعض، وإن الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج تتفاعل وتتعاطف مع بعضها البعض، كما أن آمال هذه الشعوب وطموحاتها السياسية والمدنية متطابقة إلى حد كبير. فالجميع يشعر أنهم يستحقون أنظمة سياسية أفضل مما عليه اليوم، سواء من ناحية نوعية النخب السائدة، أو في طبيعة خياراتها السياسية والاقتصادية أو تمثيلها لتعبيرات ومكونات المجتمع المختلفة. فهي (أي الشعوب العربية) تنشد بمستويات مختلفة أنظمة سياسية جديدة تنسجم ومعايير الحكم الرشيد وهي تتطلع إلى تحسين نوعية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها.
لهذا فإن الشعوب العربية – مع اختلاف في المستوى والدرجة – تعيش مشاكل واحدة وتتطلع إلى أهداف وغايات متشابهة. كما أن التحولات الأخيرة التي جرت في البلاد العربية تجاوزت بعض المشكلات التي كانت تهدد بعض البلدان في وحدتها الداخلية والوطنية. فجميع الأطياف الدينية والمذهبية والاجتماعية والجهوية، ساهمت في عملية التغيير السياسي وإنها تكاتفت وتضامنت مع بعضها البعض من أجل تفكيك حوامل الاستبداد السياسي الجاثم على صدور الجميع.
فهذه التحولات أخرجت الجميع من سجون الطائفية والمذهبية والجهوية وأعلت من شأن الشخصية الوطنية الجامعة. فالملايين التي خرجت في البلدان العربية وتطالب بتغيير أنظمتها السياسية، كانت من جميع الأطياف والمكونات. فالإصلاح السياسي ليس مهمة طرف دون آخر وإنما هو مهمة الجميع. وإن الاستبداد السياسي بكل متوالياته، هو المسئول الأول عن نزعات التشظي التي سادت في أكثر من بلد عربي تحت عناوين ويافطات دينية أو مذهبية أو قومية أو جهوية.
فالأنظمة السياسية الشمولية هي التي تعمل على تنمية الفوارق الأفقية والعمودية بين المواطنين. وهي التي تعمل عبر ممارساتها وبرامجها المختلفة إلى توتير العلاقة وتأزيمها بين أهل الأديان والطوائف والقوميات.
فالتعددية الدينية والمذهبية والقومية الموجودة في العالم العربي، ليست هي المسئولة عن نزعات الاستئصال والتشظي وإنما المسئول هو النظام السياسي العربي الذي يحتكر القوة والقرار باعتبارات وعناوين عصبوية ضيقة، فتمنح جميع المناصب والامتيازات لفئة قليلة من المجتمع وتعمل على طرد وتهميش بقية المكونات والتعبيرات. لهذا فإننا نعتقد أن اللحظة العربية الراهنة، من اللحظات الحيوية القادرة على إخراج الكثير من الشعوب العربية من أتون ودهاليز الطائفية والمذهبية وتدخلها في مرحلة بناء الدولة المدنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وإن هذه الغاية تتطلب العمل على بناء حركة مدنية عربية، تتجاوز الأطر والعناوين الضيقة وتعمل على نسج العلاقة بين مختلف المكونات على أسس ومعايير جديدة، تساهم في تعزيز مرجعية الوطن والمواطنة الجامعة. وإن بناء الحركة المدنية العربية هو الذي يديم لحظة الإصلاح بكل أبعادها في العالم العربي وهو الذي يوفر الإمكانية الحقيقية لمواجهة مخاطر الاستبداد بكل صنوفه.
وكما أن الاستبداد العربي يتعاون مع بعضه البعض وينسق في مواقفه وخطواته المختلفة ويتبادل الرأي والخبرة، فإن القوى والمؤسسات المدنية العربية معنية أيضا بهذا الأمر. فهي مطالبة بالتنسيق والتعاون مع بعضها البعض وبزيادة وتيرة التلاقي وتبادل الرأي والخبرة.
ولعلنا لا نجانب الصواب حين القول: أن بزوغ الهويات الفرعية في العالم العربي وتعلق المواطنين بها يعود إلى سببين أساسيين وهما: طبيعة علاقة السلطة بمجتمعها ومواطنيها وهي علاقة غير محايدة تجاه عقائد وقناعات مواطنيها. فتتحول الدولة بمؤسساتها المختلفة إلى سلطة قامعة ونابذة لبعض مكونات مجتمعها. فتضمحل علاقة المواطنة لصالح العناوين الفرعية. والسبب الآخر هو غياب المؤسسات والأطر المدنية التي تتجاوز الانتماءات الفرعية لصالح قضايا ومفاهيم جامعة للمواطنين بعيدا عن انتماءاتهم التقليدية.
وحينما تغيب المؤسسات الجامعة والحاضنة لجميع المواطنين مع احترام تام لعقائدهم وانتماءاتهم التاريخية، حينذاك يبحث المواطن عن مؤسسات أهلية تحميه من تغول الدولة ومؤسساتها، فلا يجد إلا الانتماء التقليدي أو التاريخي كعنوان لحمايته والدفاع عن مصالحه.
لهذا فإن تأسيس وبناء حركة مدنية عربية فاعلة وحيوية، يساهم في الحد من تغول السلطة والدولة في العالم العربي ومن جهة أخرى تكون رافعة للمواطنين للخروج من آسار انتماءاتهم التاريخية لصالح الانتماء إلى المواطنة التي هي قاعدة الحقوق والواجبات.
فالمطلوب هو إخراج المجتمعات العربية من مستنقع الطائفية والقبلية والعشائرية وهذا لن يتأتى إلا بحركة مجتمعية نشطة تتجاوز هذه العناوين وتوفر البدائل والأطر المتجاوزة لها.
الخلاصة:
إننا ننظر ونتعامل مع التغيرات السياسية الراهنة في العالم العربي، بوصفها تحولات إيجابية، وهي الخطوة الأولى في مشروع التحول نحو الديمقراطية والتخلص من براثن الاستبداد والديكتاتورية ومتوالياتهما. وإن بناء الأنظمة السياسية في عالمنا العربي على أسس الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة، سيعزز من حقائق التسامح في المجتمعات العربية، وسيطرد كل الحوامل والثقافات والنزعات المضادة لذلك.
فما يجري اليوم من إصلاحات وتحولات في العديد من الدول العربية، هو بإرادة شعبية عربية بعيدا عن إملاءات الخارج ومؤامراته المختلفة.
لهذا فإننا نستطيع القول: أن العالم العربي اليوم، دخل فعلا وممارسة مرحلة جديدة نتجاوز فيها إحن الماضي ومعوقات الواقع الهيكلية. وإن تهاوي بعض الأنظمة المستبدة بشكل سريع، يبشر بهذه المرحلة، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي حجر الزاوية في مشروع الإصلاح والتغيير في العالم العربي.
وإن أمام العالم العربي بكل دوله وشعوبه، فرصة تاريخية لإعادة بناء أنظمته السياسية على أسس جديدة تنسجم ومنطق العصر وحقائق الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
***
محمد محفوظ – باحث سعودي