آراء
بدر العبري: أخلاقيّة الدّولة الوطنيّة
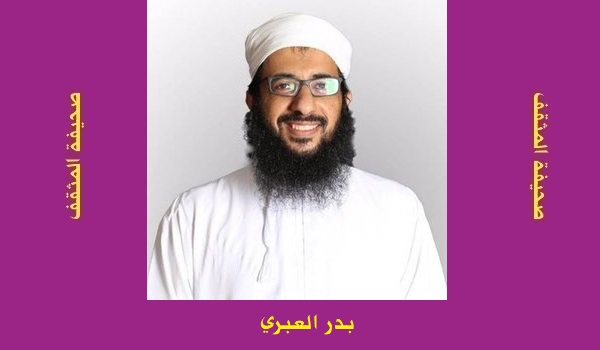
تتعلّق أخلاقيّة الدّولة الوطنيّة بمفهوم الأخلاق المرتبطة بالدّولة، ومصدريّة أخلاق الدّولة، وفيما تتعلّق أخلاق الدّولة. هذه جدليّات يصعب حصرها في مقال بسيط كهذا، ولكن ممكن وضع صورة مفاهيميّة ابتدائيّة لذلك من خلال بعض النّقولات القديمة والحديثة لتأثيرها في الدّولة الوطنيّة المعاصرة، وتكييف الأخلاق قديما كما يذكر ابن تنباك في «موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربيّة والإسلاميّة» عن ابن منظور (ت: 711هـ) أنّ الأخلاق في حقيقتها «انعكاس لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصّة بها». وبمثله ذهب الجاحظ (ت: 255هـ) إلى أنّ الخلق «هو حال النّفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا رويّة، ولا اختيار، والخلق قد يكون في بعض النّاس غريزة وطبعا، وبعضهم لا يكون إلا بالرّياضة والاجتهاد كالسّخاء؛ فقد يوجد في كثير من النّاس من غير رياضة ولا تعمّل، وكالشّجاعة والحلم والعفّة والعدل، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة».
هناك قابليّة في النّفس الإنسانيّة لاكتساب السّجايا الحسنة والسّلبيّة المتفق عليها، أو أنّها حسنة عند قوم سيئة عند آخرين. والعكس صحيح؛ ولهذا يرى إخوان الصّفاء قديما أنّ طبائع الأخلاق تختلف لأسباب أربعة: «أحدها من جهة أخلاط أجسادهم ومزاجِ أخلاطها، والثّاني من جهة تربة بلدانهم، واختلاف أهويّتها. والثّالث من جهة نُشوئهم على ديانات آبائهم ومعلّميهم وأستاذيهم ومن يربّيهم ويؤدّبهم. والرّابع من جهة موجبات أحكام النّجوم في أصول مواليدهم، ومساقط نطفهم»، ويرون أنّ الإنسان المطلق «مطبوع على قبول جميع الأخلاق البشريّة».
الخطّ العربيّ والإسلاميّ قديما في جملته لم يخرج في فهم الأخلاق عن المفاهيم اليونانيّة، والّتي هي أقرب إلى الفضائل المكتسبة، والمرتبطة بقابليّة النّفس الإنسانيّة في اكتساب السّجايا من خلال هيئة راسخة في النّفس، ومع هذا جدليّة مفاهيميّة الأخلاق ظلّت عالقة إلى اليوم كما يرى طه عبد الرّحمن «حتّى إذا اتّفق الفلاسفة على أن الخُلُق موجود في فعل من الأفعال أو في شخص من الأشخاص، فإنّهم لا يتّفقون على تعريف واحد يميّزه عن غيره».
جدليّة مصدريّة الأخلاق لا زالت محلّ جدل حتّى يومنا هذا، وإن كان الإنسان بعيدا عن المصدريّة يكتسب خلقه ابتداء من البيئة الّتي ولد فيها، كما يكتسب منها دينه ومذهبه ولغته وثقافته، ويعبّر عنها اليوم بمسألة الأخلاق: هل هي ذاتيّة أم تأريخيّة، مطلقة أم ظرفيّة؟ والقول بتأريخيّة الأخلاق كما يذكر حسام محيي الدّين في كتابه «التّطوّر والنّسبيّة في الأخلاق» يعني أنّها «نشأت في طور معين من مراحل اجتماعيّة البشر، وأنّها تطوّرت من التّقاليد والأعراف، وأنّها ترتبط بأسس المجتمع الماديّة، وبمجمل الظّروف الأخرى، بما في ذلك آماله وتخيّلاته... وأنّ الضّمير ليس فطريّا، بل هو تأريخيّ النّشأة على النّطاق الاجتماعيّ خلال العصور، وعلى نطاق حياة كلّ فرد على حدة» في حين يرى فريق آخر «أنّ القيم والتّصوّرات الخلقيّة، كالعدالة أو الصّدق، شأنها شأن البديهيّات الرّياضيّة ضرورة يقتضيها العقل، ويدركها بداهة دون حاجة إلى برهنة. ومنذ أن يولد الإنسان يكون مزوّدا بقواعد خلقيّة، وهذه القواعد ثابتة دائمة مطلقة عامّة في النّاس بصرف النّظر عن الزّمان والمكان ونوع المجتمع السّائد، ومستوى الحضارة له، ومقياس كلّ قيمة خلقيّة أو عمل خلقيّ ذاتي مستقلّ عن كلّ ما يترتب عليه من سعادة أو تعاسة، ويذهبون إلى أنّ في كلّ إنسان وازعا للأخلاق هو قوة غريزيّة يميّز بها الخير من الشّرّ والحقّ من الباطل، وهي ليست نتيجة مجتمع ولا بيئة ولا زمان ولا مكان ولا تربية، بل هي مثل حاسّة البصر، تولد معنا، يسمّيها بعضهم العقل أو العقل العمليّ، ويسمّيها آخرون الضّمير أو الوجدان، أو الحاسّة السّادسة».
الدّولة الوطنيّة ليست بمعزل عن مسألة الأخلاق، وحاول صادق جواد سليمان (ت: 2021م) تقديم رؤية لأخلاقيّة الدّولة الوطنيّة من خلال الممايزة بين الدّولة العصريّة والدّولة المعاصرة، والفارق بينهما بشكل عام أنّ «الدّولة العصريّة هي تلك الّتي تتسم بنية ونظاما بسمات هذا العصر، أمّا الدّولة المعاصرة فهي تلك الّتي تعيش العصر، وتستعمل معطياته دونما تحفظ، لكنّها لا تزال تركد في بنية ماضويّة ونظام ماضويّ؛ هي بذلك تخفق في تحقيق طموحات مواطنيها إلى حياة وطنيّة أوفى تواؤما مع استحقاقات هذا العصر» بمعنى أنّ الدّولة العصريّة تعيش التّحديث والحداثة معا، أمّا الدّولة المعاصرة تعيش التّحديث دون الحداثة.
يظهر البعد الأخلاقيّ لديه في الدّولة العصريّة وفق بالمبادئ والقيم الأخلاقيّة المتمثلة في العدل والمساواة والكرامة الإنسانيّة، وسدّ منابع الاستبداد، والّذي به تتشكل الدّولة الوطنيّة وفق أخلاقيّة «المواطنة المتساوية الّتي لا تشوبها امتيازات خاصّة ببعض دون سائر المواطنين»، «وسيادة القانون وضمانه يكون بنظام قضائي مستقل، محصّن من أيّ تأثير خارجيّ، أكان من شخص أو أشخاص ذوي نفوذ مالي أو اجتماعي أو سلطوي، أو نفوذ مؤسّسي»، «واقتصاد منتج منصف، أي اقتصاد سليم يعنى بزيادة الإنتاج وعدالة التّوزيع معا»، «والاستقرار السّياسيّ والوئام الاجتماعيّ؛ فمجتمعات عصرنا في معظم الدّول تعيش تعدّديّة من حيث العرق واللّون والدّين والمذهب، وسوى ذلك من خلفيات سائر النّاس، مع ذلك هي تعيش استقرارا سياسيّا، ووئاما اجتماعيّا تصونهما مواطنة متساوية»، ومواجهة الفساد الّذي «يستعمل الوجاهة التّقليديّة لاستجلاب منافع دونما استحقاق، واقتصاديّا يسري بالتّراشي بين الدّافع والقابض، نقدا أو بمقايضة منافع، بتحايل على القانون»، ومواكبة الحضارة والتّقدّم الإنسانيّ.
أخلاقيّة الدّولة الوطنيّة تقودنا إلى ضرورة المراجعات، وعدم تسطيح مفهوم الأخلاق ليكون أقرب إلى الوعظ الدّينيّ والمجتمعيّ المنحصر في السّجايا الإيجابيّة أو السّلبيّة، وإنّما من خلال المبادئ الكبرى الّتي تخلق مجتمعا تربطه ذات واحدة؛ يسوده التّعايش المشترك الذي يعطي قاعدة للتّنمية والإحياء الاقتصاديّ، ما يرفع من درجة العدالة، وتحقّق الكرامة الإنسانيّة في الوطن الواحد. هذه الأخلاقيّات بها يتحقّق مسار السّلطات الثّلاثة: التّشريعيّة والتّنفيذيّة والرّقابيّة، وبها تتحقّق العلاقات الدّوليّة القائمة ابتداء على القيم الأخلاقيّة الإنسانيّة الكبرى، ومواجهة التّدخلات السّلبيّة، والحدّ من انتشار وتمدّد الحروب والكراهيّة، ومحاربة الجهل والفقر، ورفع مستوى المساواة الإنسانيّة وإحياء شعوب العالم جميعا.
***
بدر العبري كاتب مهتم بقضايا التقارب والتفاهم ومؤلف كتاب «فقه التطرف»







