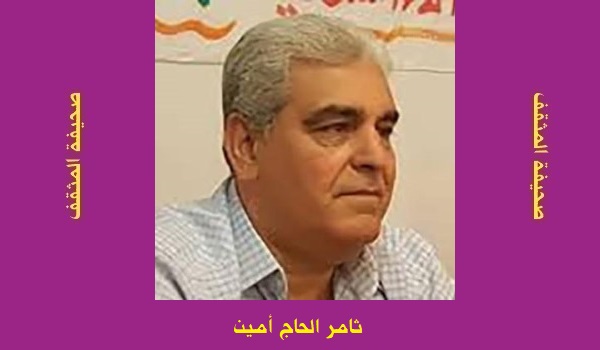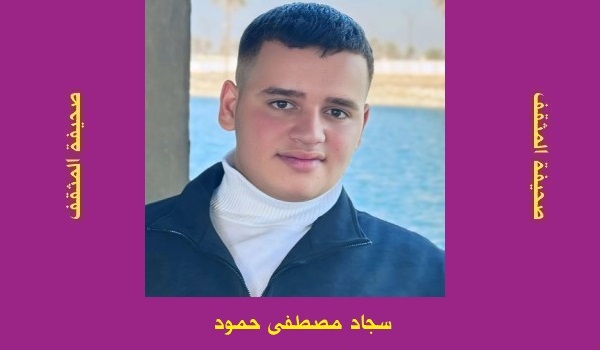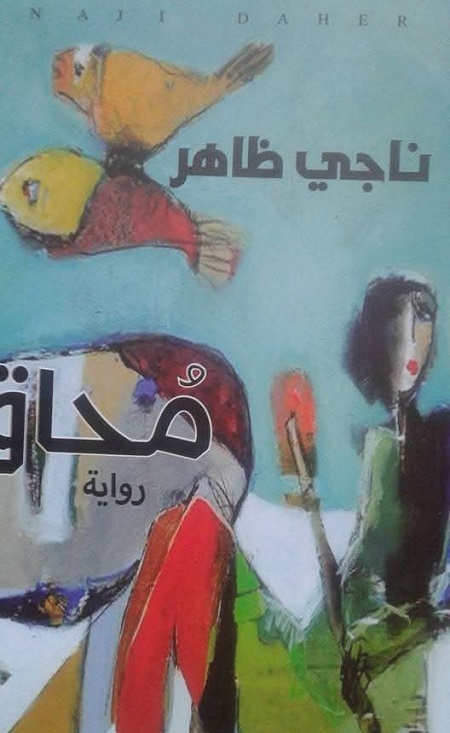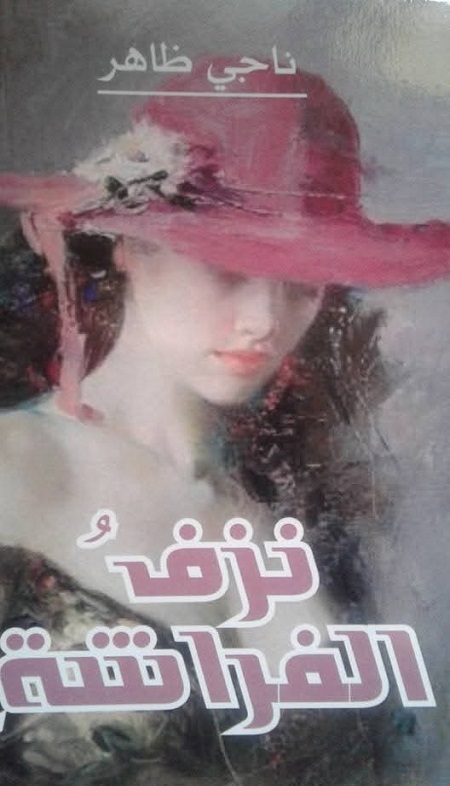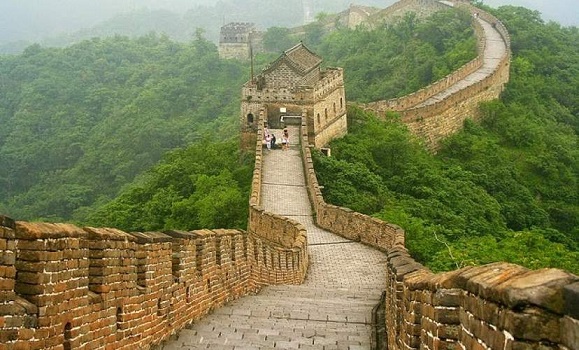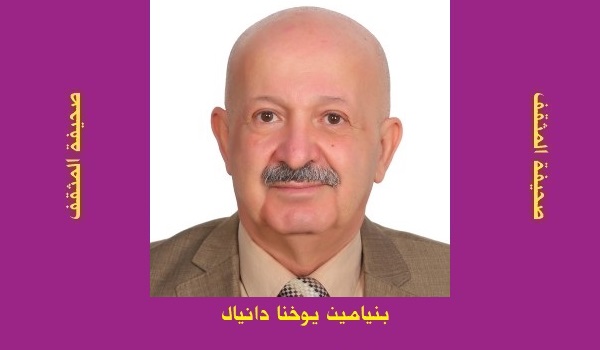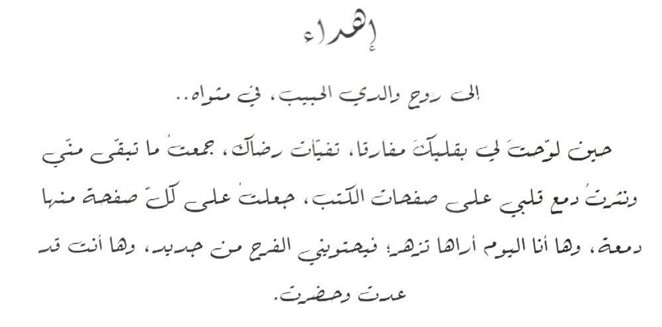أعماقي العارية تستغيث.. فمن يشعر بها؟
قبل أيام، انتابني شعور عميق بالندم، تصاعدت حدته مع تطور سواد الليل، ومع سيطرة الأحلام على المدينة، طاردتني كوابيس التساؤلات بضراوة غير مسبوقة!
لماذا ارتكبت هذا الفعل البشع؟!
منذ متى وأنا بهذا الغباء؟!
لمَ التهور والاندفاع دون التفكير في العواقب؟!
لماذا وكيف ولمَ ومتى وأين؟!!
واستمر هذا الحال حتى تسلل شعاع الفجر عبر الفضاء الواسع، وأنا في غرفتي الضيقة أغرق في الظلام وحدي.
كم كانت ليلة غليظة وباردة!
حاولت النوم ولو لساعة واحدة، لتجديد الخلايا واستئناف الروتين الممل في الصباح، ولا جدوى من المحاولات.. فقدت الاتزان، وهي بداية النهاية!
انتكست كلما هربت بخيالي من الحسرة واللوم الفتاك، وفي كل مرة أصطدم بهمسات توبخني: "لا مجال للراحة يا حمقاء، إصلاح الموقف أولًا ومن ثم النوم كما يحلو لكِ"
موقف؟
أي موقف يستحق هذه الجلبة؟!
سأنقله لكم بأمانة وكما هو، وإن كنت أخشى عليكم من الصدمة!
كانت مكالمة هاتفية عادية مع صديقة غالية، استغرقت دقيقة وربما أقل للاستفسار عن أمر ما، لاحظت من نبرة صوتها الانشغال وبصوت يُناديها: "يا فلانة، تعالي"، فأنهيت النقاش بالاتفاق معها على موعد آخر يُناسبها، واختتمنا المكالمة بسلامات لطيفة، ووضعتني أنا في ورطة خطيرة لم تكن في الحسبان!
كيف أجرؤ على الاتصال بها في وقت غير ملائم كهذا؟!
وإن كنت لا أعلم بانشغالها!
هل طالها الضيق من إزعاجي؟!
الذي يُصوره لي ذهني!
وماذا قال عني الشخص مجهول الهوية بجوارها؟
لا تُحسن اختيار الوقت؟ كانت ساعة المغربية.
ثرثارة؟ لم يرن هاتفي على رقمها منذ زمن.
عاطلة بلا مسؤوليات تقوم بها؟ أوراقي في تكدس دائم فوق المكتب ولا تحتمل مكالمة تقطعني عن حبل أفكاري.
كل هذا وأكثر دار في خاطري، وهو كما ترون لا يمت للواقع بأي صلة!
فما العمل الآن؟!
قررت أن أرسل لها اعتذار صريح على اقتحامي ليومها بغير تعمد، وفجأة تراجعت عنه ولجأت إلى الصبر والحكمة في فك الاشتباك بيني وبين نفسي.
تمهلت، وفكرت أنني لو انجرفت وراء اضطرابي وأرسلت لها أسفي فلن أصل إلى نتائج مُرضية.
هل ستدرك أسبابه؟
ستقول لي في ذهول: ولمَ الأسف؟!
وسأجيب عليها بلا تردد: لا أعرف!
وهكذا نقع في قبضة صراع أشد عنفًا.. الحيرة أمام اللا شيء!
كان السؤال الأهم حينها.. ماذا أصابني؟!
لقد عشت صعوبة بالغة في تخطي ثورات الغضب الناجمة عن دقيقة واحدة!
كنت في حاجة إلى تماسك عاجل، فلا حلول وأنا أُهشم رأسي في الحائط كالمجانين!
التقطت أنفاسي الساخنة، تأملت الوضع، وتبين لي أخيرًا أني وقعت ضحية "الحساسية المفرطة"!
ذلك الخوف القابع في وجداني أنا يقتلني بوحشية من آن لآخر! خوفي من إيذاء أي مخلوق بلا قصد، أو أن أكون ثقيلة الحضور ولو بذكر اسمي، لدرجة تقليص دائرة معارفي على من يتفهمون حالتي تمامًا، فلا تهزمني مشاعري غير المنضبطة أمامهم.
أصبحت في مراقبة مستمرة لخط سير حروفي وتصرفاتي، وبمجرد أن أنتهي من مجالسة إنسان، أعود بسرعة البرق إلى أرشيف ذاكرتي، لأقتنص من شريط الحوار كل العبارات واللمسات التي قد تُلحق الضرر به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فلا تصدر مني مجددًا ولا تُراودني الفكرة من الأساس.
يبدو أنها نتيجة رائعة تضمن سلامة العلاقات من الموت، ولكنها لن تضمن لي الحياة!
إنها ليست فوضى عارمة تمر بي في مواسم محددة، وإنما هو مأزق كبير معي في كل الأزمان، أنا أواجه أزمة حقيقية سأختصرها لكم في جملة بسيطة لعلها تكفي.. لقد خُلقت في عالم لا يُرحب بأمثالي!
أتساءل.. هل ما أنا عليه الآن منزلة عالية من الإنسانية كما يُقال، أم هي مرحلة نفسية أكثر تعقيدًا؟!
ما أعرفه وبحق أن من تكتب إليكم ليست الأولى ولا الأخيرة التي تحكمها عاطفتها، فما أكثرنا!
نحن من تُدمرنا نظرة سخرية لأحدهم ولو بدافع المزاح.
من نموت قهرًا برؤية طفل يبكي، مسنة تُطرد، مسكين يُهان، كلها مشاهد مرعبة تقتلع سلامنا من الجذور.
من تجملنا بالعطاء والاحتواء، ولم نجد من يتكفل بتهدئة ذعرنا من قوة الملاحظة وهشاشة الأنفاس.
حتى السعادة تؤلمنا!
نفرح من الأعماق، نحزن من الأعماق، نبدع من الأعماق ونعشق من الأعماق.. لم نعرف الاعتدال يومًا، تضخم الشعور يُلازمنا كما الظل الوفي، ولا انسلاخ منه حتى قيام الساعة!
أنا اليوم أشعر برجفة عروقي أكثر من قبل، والسبب لا يعود لتذبذب مستوى ضغط الدم مثلًا أو لأنيميا حادة، أنا بخير، أتعايش بطاقتي المتبقية ولا اختلاف كبير في ظاهري، فتاة عشرينية ذات ملامح شبابية وهيئة مقبولة وفكر يُكافح الغفلة، لكنها الروح.
ثمة تغيير طرأ عليها دون سابق إنذار، أشبه بجرح ملتهب لم يلتئم بعد وأقل احتكاك به يُفجر الأوجاع، ورغم ذلك لا أستطيع حتى الصراخ!
روحي عارية بحق، فماذا عن الضلوع المتجمدة؟!
ومن أين يُمكننا شراء ما يستر دواخلنا المتجردة من رداء الطمأنينة؟!
روحي الآن متلهفة لشعاع ضوء ساخن يمنحها القليل من الاستقرار، إنها نكتة سخيفة أن أملك عشرات "البلوفرات" في خزانتي وأفتقر لما يرتديه كياني لحمايته من عواصف التأثر!
رقة الشعور هذه تُنقذنا من تحجر النبض، ولكنها تُعسر علينا مهمة الوجود!
فأنا أظهر بكامل أناقتي وأملي ونجاحي، وأشتاط غيظًا على عقاب طفلة كسرت كوبًا وهي تلهو ولو كانت على المريخ!
أتكاتف معها دون أن أعرفها.. هل تعي مأساتي؟!
تفترسني الرغبة في البكاء، وأخشى أن أستسلم لدموعي كي لا تذمني ألسنة الناس بالضعيفة! ولكني أمارس حقي المشروع.. "إنسانيتي"..
فهل أصبح البكاء من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون؟!
تحضرني الآن المرات التي انقلب مزاجي فيها رأسًا على عقب حينما صادفت قطة تطلب شربة ماء دون الرحمة بها، شعرت بمدى عجزها وهوان روحها، وربما روحي أنا أيضًا، طعنت قلبي وقتها بشراسة تأديبًا له على إحساسه ليكف عن تعذيبي بهذا الشكل.
المؤسف أن قلبي كان ينزف بغزارة، بينما كانت المدينة تضج بالحيوية والأضواء وسيارات الأجرة والملاكي وكأن شيئًا لم يكن!
فمن يهتم بالأرواح المرهقة؟!
لست وحدي؟ أحسست بمواساة من هذا القبيل.
أعرف، ولكن شعوري ربما تجاوز المعقول، وعزائي أنه في مكان ما على الكرة الأرضية من يتنسم الهواء بـ "إحساس مفرط" كما يُسمونه، لكنه صادق.
الحمد لله أنني لم أتسرع في إرسال اعتذاري لها، كانت رسالة عبثية بالفعل، سأعيد صياغتها في هذه الأثناء بكلمات امتنان وشكر وإلى أصحابها البواسل.. إلينا نحن، أصحاب القضية.
صحيح أننا نخرج للعالم بفكر ينصهر في أبسط التفاصيل، وفي أشياء لا معنى لها أصلًا، والحق أننا لسنا ضحايا كما كنت أعتقد، المنطق يؤكد ذلك، وإنما نحن أبطال من طراز فريد، نقاوم العذاب بعذاب أشد!
أتفهم أن بعض الدروب لا تليق بنا وبحالتنا الخاصة المزمنة، إن المعضلة ليست وليدة اللحظة، لقد بدأت معنا منذ زمن بعيد وتراكمت في سراديب الروح حتى تحررت كلماتي بهذا الشجن، فإن أزمتنا تكمن في الخروج عن إطار اللوحة، بعيدًا حد السماء، ولا عجب في ذلك، "لم نعرف الاعتدال"، ألا تتذكر تلك السطور؟ فكان الابتعاد عين الرؤية، لتتضح لنا الصورة بكل المحاسن والمساوئ بينما غيرنا يمتزج بزاوية عقيمة.. وهو الفرق الجوهري بيننا وبينهم.
خلاصة القول.. يكفي أننا نُحارب من أجل الحفاظ على فطرتنا السليمة في عالم ملوث والإنسان فيه لا يهم.. مريض، جائع، مفتقد الأمان.. لا يهم!
نحن في عالم السطحية والماديات والتفاهات، عالم جامد لا يشعر.. فكيف نلوم أنفسنا على نُبل المضمون؟!
لن أغضب من نفسي أبدًا، وأنتم كذلك، سأحترم فيها المصداقية والشفافية ولو كان المقابل حياتي، إحساسي بالأكوان هو الغاية الأسمى مهما كلفني الأمر.
وهُنا شكر واجب لمن دفع الثمن كما دفعته، الشكر لنا على الثبات في حربنا مع الواقع، وإن كانت غير متكافئة الأطراف.
شكرًا على الإنسانية.. أقولها لي ولكل محارب شجاع يقرأ بصمت أنيق وإحساس عميق.. وبعض الألم!
***
بقلم: نورا حنفي