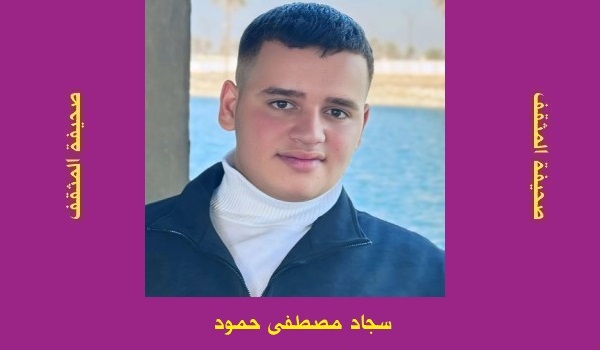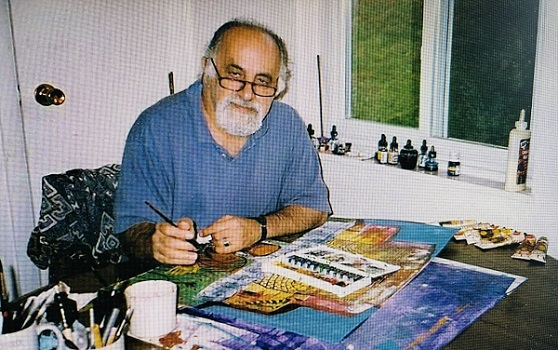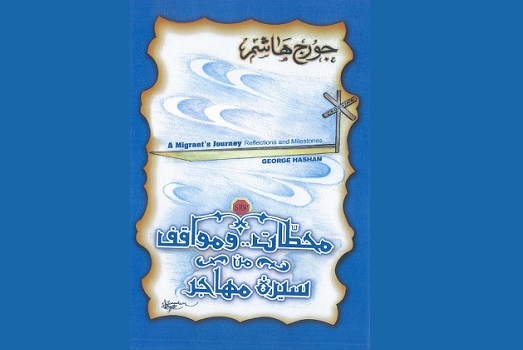من منا لا يعرف أمير الشعراء أحمد شوقي؟ فقصائده وأشعاره في المقررات المدرسية يدرسها الطلاب ويمتحنون فيها ولكن كثير منا يجهل أن هذه الشخصية المثقفة المتقنة للفرنسية والمطلعة على الآداب الأجنبية هي روائية أيضا أبدعت في فن الرواية وكتبت خمس روايات استلهم فيها التاريخ الفرعوني وجاءت على هذا الترتيب التاريخي..
أولا: رواية "عذراء الهند"
فحسب الكاتب محمد عبد الرحمن "نشرت هذه الرواية أولاً على حلقات فى جريدة الأهرام عام 1897م، ثم صدرت طبعتها الأولى فى كتاب فى نفس العام، عن مطبعة الأهرام بالإسكندرية. تقع الرواية فى ثلاثة أقسام، يتضمّن الأول منها 7 فصول، والثانى 12 فصلاً، والثالث 7 فصول، وصدّرها بإهداءٍ إلى الخديوى، الذى كان شوقى حينها موظفًا فى ديوانه.
وهي رواية غرامية غريبة السرد تنتهي وقتها إلى زمن رمعسيس الثاني المعروف سيزو وستريس أحد فراعنة مصر الأقدمين
ثانيا رواية "لادياس":
وهي رواية نثرية تاريخية تدور أحداثها في عهد الفراعنة في زمن “البرياس" ضمّن شوقى هذه الأحداث فى روايتين، الأولى منهما "لادياس"، نشرها أولاً على حلقات فى مجلة "الموسوعات" من 6 أكتوبر 1898م، إلى 26 أبريل 1899م، وظهرت الطبعة الأولى منها فى كتاب عام 1898م عن مطبعة الآداب والمؤيد.
ثالثا: رواية "دل وتيمان":
جزء ثانٍ متمّم لأحداث "لادياس"، ونشرت فى "الموسوعات" من 1899م، إلى 1900م وظهرت طبعتها الأولى فى كتاب عام 1899م، عن مطبعة الآداب والمؤيد بمصر، ثم أعاد الباحث محمود على نشرها فى حلقات فى مجلة الإذاعة والتلفزيون من 16 أكتوبر 1983" (1)
رابعا: شيطان بنتاؤور”:
"أخرج شوقي هذه الرواية عام 1901م وتختلف هذه الرواية عن رواياته الأخرى في كونها وكيانها. اعتمد شوفي فيها على الحوار بأسلوب مقامات الهمذاني والحريري. يدور الحوار في هذه الرواية بين طائر الهدهد الذي يرمز إلى شوقي نفسه وطائر النسر الذي يرمز إلى بنتاؤور، شاعر مصر الفرعوني القديم
خامسا: "ورقة الآس”:
أخرج شوقي هذه الرواية عام 1905م وهي الرواية العربية الوحيدة من بين رواياته الفرعونية. ترجع أحداثها إلى العام 272م. وقد أخذ موضوعها من التاريخ العربي قبل الإسلام. تدور أحداث الرواية حول غدر “النضيرة” وخيانتها لوطنها ودولة أبيها أولا ثم محاولتها مع خيانة زوجها “سابور”."(2)
فيمكن عزيزي القارئ أن يبدع الشاعر أيضا في مجال الرواية فهو يملك اللغة الراقية والأسلوب الأنيق والثقافة الواسعة والخيال الخصب فالانتقال من فن الشعر إلى السرد ليس بالمستحيل على من يملك المؤهلات اللازمة والرغبة المشتعلة وعندنا في تاريخنا المعاصر شعراء أبدعوا في مجال الرواية..
***
الكاتب شدري معمر علي - الجزائر
..........................
المرجع
1- محمد عبد الرحمن، أحمد شوقي روائيا، اليوم السابع.
2- د. معراج أحمد المعراج الندوي، أحمد شوقي وإبداعه في مجال الرواية، موقع أقلام الهند.