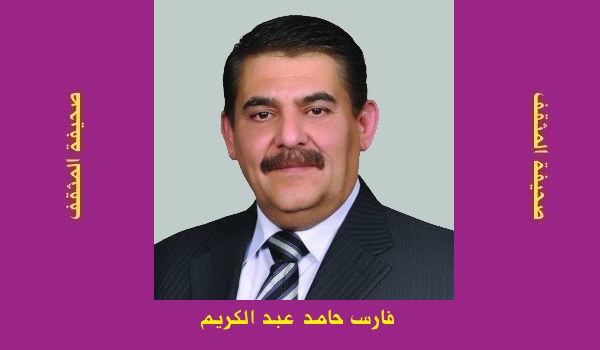أقلام ثقافية
جمال العتّابي: في مدينة الحرية.. مملكة اسمها "ستوديو الشعب"

عند ملتقى الطرق، كان تقاطع (باتا) يعجّ بالحركة، أربعة شوارع تتقاطع، كأنها شرايين تضخّ الحياة في قلب المدينة. ليتني الآن أرى شارع المشتل الذي افتتحه الزعيم، من ذاك الملتقى يبدأ الشارع، الآخر الذاهب إلى الشمال الغربي نحو الحرية الثانية، والقادم من مطحنة الچلبي مدخل المدينة الرئيس. ماراً بدور العمال والموظفين، وصغار العسكر.
في التقاطع مفاتن كثيرة، فضاؤه الرحب أحاله إلى موقف باص (الأمانة رقم 25)، وسيارات النقل، ذاكرة أحذية (باتا) جزء من سيرة المدينة أيضاً، في خمسينيات بغداد، كانت خطوات الفتيان متشابهة بأحذية باتا الرياضية البيضاء، كانت رخيصة ب (الفلسان)، لا أحد يتفاخر بحذاء مستورد، ولايلهث وراء ماركة أجنبية، أصحاب الرواتب فقط يلبسون أحذية بصناعة محلية (دجلة، زبلوق، حرّاق، كاهچي)
أصبحت الساحة مقصداً لكل أبناء المدينة، هناك أقام المصوّر صلاح الجاف مملكته (ستوديو الشعب) في بداية ستينيات القرن الماضي، لم يكن مجرد مكان، بل محراب ضوء ومرآة حلم، تزيّن واجهته الزجاجية اللامعة صور الصبايا والشباب، بالأسود والأبيض، تضفي قدراً وافراً من الألوان والضياء والمهابة على الساحة المفتوحة على القلوب التي تخفق بالحب. على بعد خطوات من المكان يطلّ بيت الصديقين فاطمة المحسن وشقيقها فرات، بيت يختزن وداعة اللقاءات، يتسع للحوار والضحكات والذكريات.
الوجوه لها حكايا، عيون مشعّة بالضوء، صور للعرسان، لطلاب بزي التخرج الجامعي، صورة للاعبي الكرة والمغنين، والممثلين، صور لطلاب الكلية العسكرية، صورة العائلة: الأب في الوسط، الأم على اليمين، الأطفال مصطفّون كزهور الحديقة. صورة الصبي ببدلة ضيقة وربطة عنق حمراء رفيعة، يضع يده في جيبه كأنه نجم سينما.
كل صورة لها حكاية، تراقب المارّة بعيون صامتة، تستدرج فيهم رغبةً أو حنيناً، منهم من يتوقف، ومنهم من يلتقط منها الومضات السريعة، تاركين الوجوه في أسرارها الأنيقة خلف الزجاج تروي لمن يعرف كيف يصغي: أن الحرية كانت مدينة تصنع الحب والمبدعين، والبطولات، قبل أن تصاب بالخرس.
صلاح شاب وسيم، (يحمّض، ويرتّش، ويطبع ويعرض) وجهه من ضوء، لا ترتجف يده حين يوجّه الضوء نحو الوجوه، ويعدّل من تسريحات شعر الفتيات، كان يحرّك عدسته باتجاهات عدّة كما لو كان يعزف مقطوعة من الخجل والدهشة. ليلتقط صورة تحمل كلّ ألوان الجمال في الحياة.
كان كاكا صلاح يجمع بين وسامة ممثلي السينما وهدوء المصورين المحترفين، يقف خلف الكاميرا أشبه بمن يقود اوركسترا من الضوء والظل، شعره أسود كثيف، يرتدي قمصاناً بيضاء مكويّة بعناية، أكمامها مطويّة حتى منتصف الساعد، وبنطالاً أسودَ، تنبعث منه رائحة الكولونيا (الريف دور) المستوردة.
لدي اعتقاد أن كل شباب الحرية مرّوا من هناك، كانت وجوههم نضرة كالماء، وضحكاتهم حرّة، وثيابهم نظيفة بلا تكلّف. يقيمون احتفالهم تحت الأنوار الكاشفة،
وهم يرددون: “من لم يصوّره صلاح لم يُولد بعد في الحرية”. كان الاستوديو نظيفًا كقلب صلاح، عابقًا برائحة الماء الممزوج بكيماويات غسل الأفلام. يا له من جمال! تسريحات البنات متشابهة، كن يدخلن بخطوات خجولة، فيتناثر حول وجوههن الضوء،
شَعْر طويل مصفوف بعناية، مدهون، مشدود إلى الخلف بشريط ساتان ابيضّ أو وردي، يتشبهن بتسريحة الممثلة نادية لطفي في فلم الخطايا.
ضفائر مربوطة بشرائط ملونة، بأناقة وأنوثة، وتموّجات ناعمة تنحدر على الكتفين كأسرار،
وغُرّة كأنها موجة على جبين تنسدل على جانب منه خصلة سوداء أنيقة.
والشباب؟
يا لسحر (البُكله) التي ترتفع فوق الجبين، شعر الرأس مدهون بالكريم (الياردلي)، لمعانه كان علامة فارقة، وقمصانهم مكويّة بعناية، وبنطلونات تشي بأنّ الأم سهرت الليل تكويها على لَهب خافت.
كان الشباب متأثرين بممثلين مصريين (كمال الشناوي، عبد الحليم حافظ، رشدي أباظة)، يتشبهون بتسريحات شعر الممثل الأمريكي (جيمس دين)، شعر متوسط الطول، مرفوع قليلاً من الأمام، وبخصلات (مارلون براندو) المسحوبة إلى الخلف، تأثروا أو جربوا تسريحة شعر (إلفيس بريسلي)، رفع الشعر إلى الأعلى.
كانت الحياة نفسها تمرّ من أمام الاستوديو، تسلّم عليه، وتبتسم. في تلك اللحظة، كان كل واحد يضع قلبه في الصورة، الابتسامة صافية بلا رياء، والنظرات واثقة من الغد، في كل الوجوه هناك شيء واحد لا تخطئه العين: ذلك الصفاء الذي لا يعرف المساحيق الزائدة، أو صالونات التجميل الباذخة.
البيوت قريبة، والقلوب أقرب.
الطرق نظيفة، بلا ضجيج. كانت المدينة تعرف كيف تُحسن الإصغاء، كيف تحيي الأصوات في ذاكرة الحيطان.
ثم، مرّت السنوات مثل إعصار صامت. شاخ صلاح، ثم هاجر،الكاميرا صمتت. الصور بهتت.
الضوء الذي كان يحيط وجوه العاشقين بدأ يتلاشى.
الخراب بدأ يتسلل.
ليس فقط إلى الجدران، بل إلى الأرواح.
المدينة التي كانت تنام على صوت ضحكات الشباب،
صارت تصحو على صدى الرصاص والخوف.
أحياء بغداد تمزقت، كأن يدًا غريبة أعادت ترتيبها بالمقلوب.
الحرية… ما عادت كما كانت.
كل شارع فقد اسمه، وكل زاوية فقدت دفأها.
ستوديو الشعب، ذلك المكان الذي كان يوثق الجمال،تحوّل إلى نقطة نسيان في خريطة موجوعة.
كأن كل الصور التي كانت فيه، حزمت حقائبها، ومضت.
***
جمال العتّابي
…………..
أود أن أقدم جزيل شكري وامتناني للصديق العزيز مهدي الطعمة الذي أفادني بمعلومات تفصيلية عن ستوديو الشعب، مع عدد من الصور، اتمنى له موفور الصحة ليواصل مشروعه النبيل في توثيق تاريخ (العمارة الإنسانيّة) الحرية.