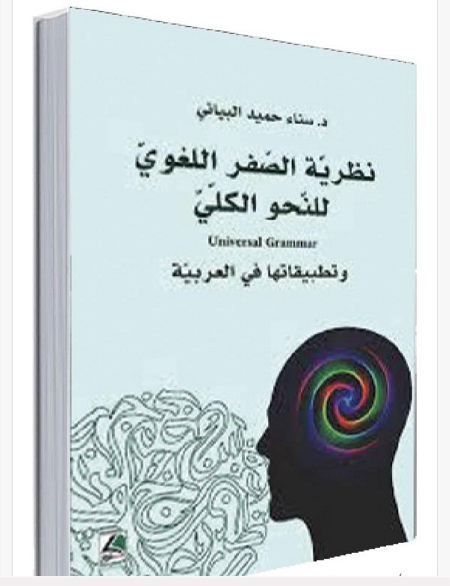"القراءة هي السلاح الأول في معركة الحياة".. طه حسين
لا يمكن لأي مقاربة للقضايا والاشكاليات المرتبطة بتداول الثقافة المكتوبة في المجتمعات العربية والإسلامية أن تكون مقنعة ما لم يتم ربطها باستراتيجيات السلطة، والتي قامت في هذه المجتمعات مند بداياتها على احتكار الكتابة والقراءة معا بوصفهما أي الكتابة والقراءة وجهين متكاملين ومترابطين في استراتيجية الهيمنة والتحكم، وكل مقاربة ينبغي أن تأسس على معرفة دقيقة بالماضي، بحيث أن هذا الحاضر هو استمرار للماضي بكل ما يتضمن من ظواهر، سواء أطلقنا عليها ظواهر القطيعة والاستمرارية. فمن الضروري الوقوف على العوامل التي أدت إلى بداية الكتابة أو ما عرف بالتدوين، والذي نتج عنه هيمنة نمط من المعرفة على أنماط أخرى، والتي اقترنت بهيمنة سلطة بعينها.
أزمة القراءة في المجتمعات العربية: جذور تاريخية وتجليات حديثة
في بداية هذه الدراسة ينبغي لنا أن نطرح هذا التساؤل الهام والعريض: هل وجدت في المجتمعات العربية تقاليد أو مؤسسات تقترن بالقراءة وتداول المعرفة على نطاق واسع بين أفراد هذه المجتمعات مما نتج عنه وجود سوق نشطة للكتاب والمطبوعات بشكل عام؟
مند فترة ليست بالقصيرة، طفت على السطح نقاشات بين المثقفين والمهتمين بالنشر والكتابة نقاشات حول ظاهرة يعبر عنها أحيانا ب '' أزمة القراءة ''أو ''كساد سوق الكتاب"، وفي السياق سنحاول على وجه الدقة أن نركز النقاشات التي عرفها السياق المغربي.
في الواقع، قد تكون هذه الظاهرة موجودة مند القدم، لكنها وفي الآونة الأخيرة اتخذت ابعادا أكثر تعقيدا، إذ ارتبطت بوجود نشاط اقتصادي يشمل فاعلين متعددين وهذا ما يفسر تعدد الأصوات التي دقت ناقوس الخطر-خاصة الكتاب والناشرين- محذرة ومعلنة عن انحسار القراءة، ومتسائلة عن مصير الكتاب ومستقبل القراءة والمعرفة، ورافعة بشكل ضمني أو صريح نداء قديما: اقرأ.
لم تبدأ أزمة القراءة مع انتشار الانترنت ووسائل التواصل الحديثة، بل تواجدت على الدوام، غير انها ازدادت استفحالا وبالخصوص إذا ما استحضرنا ارتفاع نسبة المتعلمين، وقد بدا ذلك بجلاء مند تسعينيات القرن الماضي، حيث توالت التحذيرات من تدهور القراءة، وفي هذا السياق قرأنا العديد من المقالات والتي نشرتها الجرائد الوطنية وملاحقها الثقافية، كتب نجيب خداري:" تضاعفت نسبة المتعلمين في الوطن العربي مرات ومرات...لكن قراءة الإبداع-نوعا وكما-في تناقص مفزع، ولا شك أن اختفاء المتلقي الجاد للعمل الإبداعي هو من العوامل الرئيسية لترهل الإبداع وخفوته"[1]، وأضاف بوجمعة العوفي في "الأبواب السرية":" ليس قارئا جليلا من لا يدعو للقراءة ويحفز عليها، ومن لا ينشر هذه الدعوة الفاتنة، هذه الدعوة الجميلة بين الناس، إن تعليم القراءة، وتحيينها جزء من "النضال الطبقي" ووعي المجتمعات يقاس بعدد قرائها"[2]. وبدورها نادية بنعباس الدكالي كتبت رسالة بهذا العنوان: ماذا يقرأ المتعلم في بادية المغرب" حيث أرجعت تقلص القراءة إلى الوضعية المادية والاجتماعية لقطاع عريض ورئيسي من المتعلمين المغاربة[3].
واعتبر إبراهيم الخطيب من جانبه تقلص أو تدهور القراءة مسألة عادية على اعتبار أن القراءة كانت دوما عملية تقوم بها الأقلية، وكتب:" ليس للأدب الرائع إلا قراء قليلون، إن هذه الملاحظة بديهية ومقلقة بالنسبة لمن يفكرون في الكتب الأدبية، وهي منشورة في المساحات لا حد لها ليبتاعها قراء لا حصر لهم، ويحاول الناشرون أن يقنعوا أنفسهم بمنطق العدد القليل، ويعتقد بعض علماء الاجتماع المهتمين بالثقافة أن ذلك هو مكمن الخطر، حيث يتم إهمال الموهبة التي تتوارى دائما وراء القلة، تلك الموهبة التي هي مستقبل النشر، أردت بهذا المدخل المركب الإجابة على الشكوى التي نسمعها عادة، وسمعناها مؤخرا هذه الأيام على صفحات الصحف وفي بعض برامج التلفزة...[4]
وأرجع عبد الوهاب الدبيش أسباب هذه العودة إلى الوراء (أي تقلص القراءة) إلى عاملين أساسين ويتعلق الأول بانعدام سياسة ثقافية واضحة، إن لم أقل إلى التهميش الثقافي الذي يطال المجتمع، في حين يتعلق الثاني بالقدرة الشرائية للمستهلك وعلاقتها بطبيعة الاستثمارات المخصصة في مجال النشر والتوزيع وانعدام تكافؤ العلاقة بين المنتجين (المبدعين والكتاب والدارسين) وبين أصحاب رؤوس الأموال الموظفة في القطاع[5]. وأضاف مشددا على العامل الاقتصادي في فهم هذه الظاهرة بالقول: " أعود للحديث عن الدور الأخر وأعني به ضعف المداخيل وعلاقتها باقتناء الكتاب، فأسرد حدثين عابرين كافيين للدلالة على الوضع المادي السيئ الذي يعاني منه القارئ في علاقته بالكتاب، المثال الأول: وهو ما نلاحظه في المقاهي من تهافت على قراءة الصحف الموجودة بالمقاهي بالمجان. إن الذي ينتظر مدة زمنية غير يسيرة بالمقاهي من أجل دوره في الصحيفة التي لا يتجاوز ثمنها درهما ونصف، لا يعني سوى أنه غير قادر على توفيرها من ماليته الخاصة، فكيف ننتظر من مثل هذا المواطن أن يذهب إلى المكتبة، ويقتني كتابا أو كتابين في الشهر، وهذا المثال لا ينطبق فقط على المواطن العادي، بل يتعداه ليشمل من نعتبرهم حاملي المعرفة وأدوات تمريرها إلى المجتمع، بل إن الأستاذ الجامعي مثلا يقد يكتفي بشراء كتابين في السنة بعدما كان يخصص مبلغا لا يقل في أسوء الحالات 600درهم لاقتناء ما جد في عالمه المعرفي من جديد...[6]
وفي السياق ذاته، نشرت جريدة ليبراسيون المغربية؛ وتحت عنوان عريض وبأحرف بارزة وعلى أعلى صفحتها الأولى هذا النداء: " هذه الجريدة ليست للكراء"[7]، وكتب نوفل البرنوصي في نفس العدد من نفس الجريدة تحت هذا العنوان: " للقراءة وليس للكراء"، مستحضرا نداء النقابة الوطنية للصحافة المغربية وشركة توزيع (سابريس) من أجل حملة ضد الممارسات الاحتيالية واللامشروعة والمتعلقة ب"كراء" الجرائد والمنشورات، ومما جاء في هذه المقالة:"إن هذه الجريدة لا تكترى وإنما تباع وتقرأ بتمعن. إن شراء الجريدة وخاصة في مجتمعنا هو دعم لحرية التعبير والتعددية والديمقراطية...[8]
عكست هذه الأصوات في وقتها أزمة القراءة في المجتمع المغربي، بعد عقود من هذه التحذيرات، وفي الوقت الحاضر لا تزال الأزمة مستمرة وقائمة، بل وتتعمق مع ظهور أجيال من ''المتعلمين'' و '' اشباه المتعلمين '' والذين يساهمون – عن قصد أو عن غير قصد – في اعادة انتاج واقع يكرس القطيعة مع الكتاب بدء من المدرسة والجامعة ووصولا إلى الحزب السياسي وانتهاء بالشارع.
كيف يمكن إعادة الاعتبار للقراءة كفعل حيوي واستراتيجي في بناء الوعي الفردي والجماعي؟
فعل القراءة وفعل الكتابة: الابعاد الاستراتيجية
يجد التساؤل حول فعل القراءة ومشروعيته في القراءة ذاتها باعتبارها: " فعلا اجتماعيا ولا اجتماعيا في نفس الآن، إنها فعل لا اجتماعي إذ أن القراءة مؤقتا تعزل الفرد عن مجموع علاقاته مع المحيط، كي يعيد علاقات جديدة مع عالم العمل، واجتماعية القراءة تكمن في انطلاقها من مجموعة من المعايير والتقاليد التي وضعها المجتمع والتي تمثل جزءا من ثقافته وتجربته الجمالية[9]، وكذلك الثقافة والرؤية التي يطمح المجتمع إلى تكريسها وترسيخها كبديل، وتساهم بذلك في تشكيل رؤيته المستقبلية باعتباره فردا ينتمي لمجتمع.
لا أحد ينكر أهمية القراءة وتداول المعرفة على نطاق واسع، فالمعرفة التي يتم تداولها وتلقينها داخل المدرسة - رغم أهميتها – تظل محكومة بمنظومة محددة، تختلف حسب المجتمعات ودرجة تحررها وتشبعها بقيم الديموقراطية، أما القراءة وتداول المعرفة فهي إشكالية معقدة يصعب فهم العوامل المتحكمة فيها، وتتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الابعاد والزوايا. إن سوسيولوجية القراءة كي تكون مقنعة، يجب عليها أن تتناول في نفس الوقت: العلاقات الخارج نصية (أي سوق الكتاب، والشروط الاجتماعية والاقتصادية) من جهة، والعلاقات النصية (أي دراسة المحتوى ودلالاته) من جهة أخرى[10].
تهدف سوسيولوجية القراءة أو الكتابة دراسة سوق الكتاب من جهة، ومضمون الكتاب من جهة ثانية، فالقراءة والكتابة فعلان متلازمان، يكمل أحدهما الأخر، ويخضعان لنفس الشروط الاجتماعية والبنيات الثقافية، فالثقافة المكتوبة لا يمكن أن تفهم خارج سياق تداولها وانتاجها، والذي يتحدد وفقا لطبيعة السلطة والمجتمع وأدوات انتاج الثقافة والابداع بشكل عام. لا يمكن النظر إلى فعل القراءة كمجرد تلق سلبي، بل كفعل استراتيجي، يتشكل منه وعبره الوعي الفردي والجماعي، وهي تتجاوز النص المقروء لترتبط بسياقاته الاقتصادي والاجتماعية والسياسية، والكتابة بدورها ليست فعلا بريئا، فهي أداة لتكريس الهيمنة أو مقاومتها، كما نقرأ ذلك في تاريخ المجتمعات العربية، حيث احتكر الفقهاء والعلماء الكتابة أو التدوين لتحديد ما يقرأ وما يهمل. إن أزمة القراءة ليست نتاج العوامل الحالية فقط، بل إن جذورها ممتدة في تاريخ احتكار المعرفة ونطاق تداولها، ولفهم بعض جوانب هذه الازمة لا بد من تفكيك بنياتها التاريخية، من إعادة طرح السؤال: لمن تكتب النصوص؟ لماذا؟ إن فعل القراءة – كما فعل الكتابة – هو صراع مستمر حول السلطة والهوية والوجود.
الكتابة بوصفها فعلا مكملا لفعل القراءة
يكتمل فعل الكتابة بفعل القراءة، فالثقافة المكتوبة تخضع لشروط تداولها في المجتمع، بحيث أن محتواها يحدد شكل وطبيعة تداولها، وذلك في انسجام تام مع المثقف والمجتمع وطبيعة السلطة، وقد أبرز موليم العروسي للتطابق بين هذه العناصر في سياق تحليله للمجتمع المغربي والمثقف خلال القرن التاسع عشر بالقول:" بالتأكيد إن مثقف القرن التاسع عشر في شخص العالم، كان يعيش في تفاعل مع الشروط الاجتماعية، فالمجتمع المغربي الذي توقف عن إنتاج وتجديد بنياته خلق مثقفا على صورته، إن هذا المجتمع في حالة "جمود" مارس ضغطا على ذهنية العالم، حتى فيما يتعلق بوجهات نظره وتدخلاته بغية حل النوازل، وعلى صعيد التعليم، فالجمود يترجم في حفظ الموروث الثقافي بواسطة الحواشي على الحواشي وشرح الشرح وعلى صعيد الفتوى، فالعالم يعيد انتاج الحلول التي قال بها القدماء...[11]
فعل القراءة ومفارقات التأسيس: الأمية والإعجاز
تكشف الشروط التاريخية والاجتماعية، والتي أسست لبداية تداول الثقافة المكتوبة في المجتمعات العربية الإسلامية عن مفارقات ذات أهمية بالغة ضرورية، والتي لا غنى عنها لفهم وتفسير هزالة تداول الثقافة المكتوبة وانحسار القراءة، فرسالة نبي الإسلام رسالة نبي أمي بدأت بدعوة " اقرأ"[12]، وهي دعوة تحمل تناقضا ظاهريا، فالأمية هنا إعجاز يبرهن على أن القرآن ليس إبداعا بشريا بل هو وحي إلهي، لكن دعوة " اقرأ" هي دعوة لتجاوز الأمية، وكأن الاعجاز لا يدرك إلا بالقراءة نفسها.
قد يكون كل شيء قابلا للقراءة، فالقراءة في العمق هي إمساك بالمعنى وإدراك له بواسطة علامة أو إشارة، إن القراءة نوعان: قراءة تتم بواسطة نظام حروف اللغة، وقراءة تكون عن طريق إدراك الرموز والعلامات التي تتداولها جماعة بشرية بموازاة اللغة، أو في غيابها كقراءة الوشم وغيرها من الأشكال التعبيرية التي تزخر بها الابداعات الإنسانية، وهذا النمط من القراءة لا يقل أهمية من القراءة بواسطة نظام اللغة، فهي تماما مثل اللغة أداة للمعرفة والفهم.
إن القراءة بواسطة نظام حروف اللغة تؤرخ لظهور الكتابة، ويقول ابن خلدون في مقدمته مستعرضا منافعها: "فهي تطلع على ما في الضمائر، وتتأدى بها الأغراض البعيدة فتقضى الحاجات، وقد دفعت مؤنة المباشرة لها، ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأوليين وما كتبوه من علومهم وأخبارهم، فهي صناعة شريفة بهذه الوجوه والمنافع، وخروجها من القوة إلى الفعل، يكون إنما بالتعلم وعلى قدر الاجتماع والعمران"[13]، فالكتابة عند صاحب المقدمة ترتبط بالعمران، إذ أن أكثر البدو وعلى حد تعبيرهم أميون لا يكتبون ولا يقرأون[14].
تشكل الأمية إعجازا، والدعوة إلى القراءة محاولة للاقتراب وتلمس الإعجاز ذاته، وكأن الأمية ليست سوى حالة يمكن تجاوزها وتخطيها، ولكنها وما دامت إعجازا فأنت مدعو للقراءة من أجل تصديق الإعجاز، وما الإعجاز في نهاية المطاف سوى فن الكلام وفن البلاغة، والذي يتوخى توحيد القبائل العربية أو بالأحرى قبائل شبه الجزيرة العربية تحت سلطة واحدة، فالأمية وفن البلاغة ضدان، لكنهما الآن يتوحدان ويشكلان قمة الإعجاز، بينما تبقى القراءة مشروعا محتملا، والكتابة هي الصورة النهائية التي تجسده كنظام أحرف،" ويبين التاريخ وما يجري حاليا من وقائع أن الطبقات الحاكمة لم تكف عن استخدام الكلام كأداة للسلطة، بل والمطالبة لتملكه، الأمر الذي يحصل في الغرب كما في الشرق[15].
إن الإعجاز هو ما يؤسس السلطة والنفوذ، وفن الكلام شكل ويشكل سلطة اجتماعية بامتياز، ويمكن التذكير هنا بالمكانة التي كان يحتلها الكاهن قبل مجيء الإسلام الذي كان يعتمد في كلامه على السجع، بل إن من بضائع سوق عكاظ كانت توجد الفصاحة العربية[16]، لذلك لا غرابة أن يتبرك الأميون وأن يمسحوا جباههم بالكتب، ويعتقد الأميون وأنصاف الأميون في بعض جزر المحيط الهادي الجنوبي أن الأوراق الرسمية أدوات سحرية [17]، كما هو الحال في المجتمع المغربي حيث يعتقد أن "الكتابة" ذات مفعول سحري، إذ يتم الاستعانة والتوسل بما قد يكتبه الفقيه أو المشعوذ من طلاسم وحروف واشكال لقضاء بعض الأغراض والمصالح.
يظل فعل الكتابة ناقصا، لا يكتمل إلا بفعل القراءة، والسلطة لا تقوم إلا من خلال احتكارهما وإضفاء طابع السحرية والإعجاز عليهما، وقد ربط ابن خلدون بين قيام الملك وازدهار الكتابة: "ولما جاء الملك العرب وفتحوا الأمصار وملكوا الممالك ونزلوا الكوفة والبصرة واحتاجت الدولة إلى الكتابة واستعملوا الخط وطلبوا صناعته وتداولوه وترقت الإجادة فيه...[18]
شكلت الكتابة في المجتمع العربي الإسلامي مركز الصراعات السياسية، وستأخذ معنى التدوين، حيث يمكن أن نميز في الثقافة العربية الإسلامية بين مرحليتين: مرحلة الشفاهية أو مرحلة السماع ومرحلة الكتابة، فسمة المرحلة الأولى كانت تداول القرآن والسنة عن طريق السماع أو بشكل شفاهي، مما سمح بتعدد الروايات والتأويلات، أما المرحلة الثانية، فبدأت بجمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ثم كتابة السنة لاحقا.
ارتبط التدوين بإقرار وتثبيت السلطة السياسية من خلال احتواء الانقسامات التي ظهرت وسط الأمة الاسلامية، والاختلافات التي أعقبتها في تأويل النصوص الدينية بعد موت الرسول[19]، ونتيجة ذلك تحولت الكتابة إلى آلية للقضاء على الانقسامات السياسية، وتثبيت رواية السلطة في كل ما يتعلق بحياة الفرد والجماعة، بحيث يمكن اعتبار أن " التدوين هو في نهاية المطاف تثبيت لسنة ضمن أخريات ممكنات[20].
ارتكزت السلطة السياسية على الكتابة وقامت على أساسها، الشيء الذي يفترض احتكارها وتنظيمها، والمؤكد أن كل كتابة تسعى إلى إيصال معنى ما أو عدة معاني، الشيء الذي لا يمكن أن يحصل إلا بواسطة فعل القراءة، والقراءة لا تتحقق إلا بادراك واستيعاب الكتابة كحروف وأنظمة دلالية. إن القراءة والكتابة وجهان لعملة واحدة، فهما وسيلتان لتداول وإنتاج المعرفة، والتي عنهما تتأسس ضرورة الاحتكار: احتكار المعرفة عبر احتكار وسائل إنتاجها وتداولها، ونتيجة ذلك تم تحويل الكتابة إلى خط نخبوي (الخط العربي) والذي تم أيضا ربطه بالمقدس، حيث خضعت كتابة القرآن بدوره لأنماط خاصة من الخط، مما يفرض احتكارا للقراءة عبر تحديد ما يجب أن يقرأ وبالكيفية التي ينبغي أن يقرأ، وفي الوقت ذاته ما يمنع من القراءة، والذي تدرج تحت خانته ما يمكن أن ينعت بالهرطقة والزندقة، فالدعوة التي بدأت كدعوة للتحرر من خلال " اقرأ" تحولت إلى أداة للهيمنة من خلال احتكار الكتابة والقراءة معا.
فعل القراءة كموضوع للكتابة وكفعل مقاوم
أجمعت العديد من النصوص الأدبية عن حقيقة واحدة، حقيقة غير ممكنة إلا من خلال فعل القراءة، فهي شرط لتحققها. إن القراءة- من خلال هذه النصوص- أصبحت موضوع خطاب، أي خطابا عن فعل نحن بصدد القيام به، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه علينا في هذا السياق: لماذا تتخذ نصوصا ما القراءة موضوعا لها وهي في الأصل نصوصا كتبت من أجل القراءة أو على الأقل تمتلك وعيا بذاتها، على اعتبار أن كل كتابة هي مشروع قراءة محتمل؟
يحضر القارئ من خلال هذه النصوص بقوة، وحقيقة واحدة تقال له، وتعلن عن نفسها بشكل واضح وحتى حينما لا تكون واضحة، فهي لا تحتاج إلى جهد وعناء كبيرين لتنكشف، هذه الحقيقة تقرأ في أكثر من نص أدبي، وهي أن القراءة شرط للحياة أو هي الحياة ذاتها، لذلك نعتقد أن الجدية التي تحدث عنها بيير بورديو فيما يتعلق بالعمل الأدبي كفيلة بإضاءة جوانب مهمة من تساؤلاتنا، " إن سحر العمل الأدبي يرجع دون شك في جزء كبير إلى كونه يتحدث عن الأشياء الأكثر جدية دون أن يطلب منه - بعكس العلم - بجدية تامة[21].
إن الموت كان سيلحق بكل النساء، وبدون استثناء، وهن اللواتي يحمين الجنس البشري من الانقراض والفناء لولا شهرزاد "التي قرأت الكتب والتواريخ وسير الملوك والمتقدمين وأخبار الأمم الماضيين، قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء...[22]وبذلك تمكنت من أن تضمن الحياة لنفسها وتوقف الموت الذي كان سيلحق بكل النساء وذلك بفضل قراءاتها الواسعة، والتي حولتها الى قصص كانت أداة لتأجيل اعدامها، بل بفضلها غيرت مصيرها ومصير النساء كلهن، إذ كانت تحكي كل ليلة حكاية غير مكتملة، ترتبط نهايتها بالليلة القادمة وهذا دواليك، فشهرزاد لم تكن مجرد راوية للقصص، بل كانت قارئة، حولت قراءاتها كمقاومة لعنف السلطة وكاستراتيجية للبقاء والحياة.
كانت شهرزاد تعي موقعها وتدرك كل الاحتمالات بما في ذلك الموت، فهي اختارت المغامرة وقبلت الزواج من شهريار بكامل وعيها وعن سابق إصرار وعزيمة، إذ قالت لأبيها الوزير والمكلف بالبحث عن زوجة للملك كل ليلة: "يا أبتي زوجني هذا الملك، فإما أن أعيش وإما أن أكون فداء بنات المسلمين وسببا لخلاصهن من يديه..."[23].
إن احتمال الموت كان حاضرا في ذهن شهرزاد منذ البداية، فإذا كانت كما يقول –جمال الدين ابن الشيخ-لا تقص للاشيء، بل لأن الموت كان لها بالمرصاد...وهو ما كان يحث شهرزاد على استلام الكلمة واتخاذ القول سلاحا ضد الموت[24].
تثير نهاية "ألف ليلة وليلة" مسألة ذات أهمية بالغة، إذ أن شهرزاد سترى في قتلها من طرف الملك ضياعا لأطفالها: "وقالت شهرزاد: يا ملك الزمان إن هؤلاء أولادك وقد تمنيت عليك أن تعتقني من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال فإنك إن قتلتني يصير الأطفال من غير أم، ولا يجدون من يحسن تربيتهم من الناس، فعند ذلك بكى الملك وضم الأولاد إلى صدره وقال شهريار: والله إني قد عفوت عنك...[25]
إن شهرزاد حتى لو قتلت في الليلة الواحدة بعد الألف فإنها ستبقى على قيد الحياة، فهي من جهة تجاوزت كل النساء اللواتي سبقنها من حيث البقاء على قيد الحياة بعد الليلة الأولى من الزواج، ومن جهة ثانية فهي خلفت أبناء بمعنى نوعا من الاستمرارية والبقاء لها، وبذلك فهي تجد مسوغا وسببا لعفو الملك عليها، ويرجع السبب في كل هذا إلى كون شهرزاد كانت قارئة من الدرجة الأولى، كما تقول الحكاية: "وذلك أن ثقافتها ليست شفوية، مادامت قد قرأت العديد من الكتب وتأدبت في وسط اجتماعي متميز(ولهذا الوسط دور مهم في نشأتها وثقافتها، فهي ابنة وزير الملك أي جزء من السلطة وبشكل أو بآخر فهي ليست من عامة الناس) وهيأت لنفسها الوسائل المادية التي بواسطتها امتلكت معرفة صلبة وغدت بين يديها سلاحا خارقا للدفاع[26].
تتكرر نفس الفكرة في قصة من الادب العالمي، وهي القصة التي كتبها إدغار آلان بو إذ يربط الكتابة بالموت: "أنا الذي أكتب أقتفي طريقي نحو موطن الضلال"، ويربط القراءة بالحياة: " أنت الذي تقرأ مازلت ضمن الأحياء أما أنا الذي أكتب..."[27]، ويذهب فيليب سولزر في نفس الاتجاه:" إن الأمية والجهل يمكن التغلب عليهما بالتأكيد، لكن معرفة القراءة هي مسألة ذات بعد آخر، وتلقي ما نسميه حياة يتوقف على ذلك. إن معرفة القراءة هي أيضا القدرة على قراءة كل الأشياء دون إقصاء ودون أحكام مسبقة...[28]
ونفس المعنى يردده ولتر.ج.أونج، إذ يقول:"...وتكمن المفارقة في حقيقة افتقاد النص للحياة أي زواله من عالم الحياة الإنسانية الحي من ناحية وثباته المرئي الصارم من ناحية أخرى يؤكد أن قدرته على البقاء، كما يؤكدان إن كان يبعث في سياقات حية، لا حد لها من خلال عدد يمكن أن يكون بلا حدود من القراء الأحياء[29].
تقترن القراءة بالحياة وتغدو شرطا ضروريا لها، فكل قراءة هي امتلاك للمعرفة، التي هي موضوع احتفاء وتقدير باعتبارها سلطة وتؤسس للسلطة، فالاستعارة التي قامت بها عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي في كتابها "شهرزاد ليست مغربية"[30] تنتصر لنفس المعنى وتؤكد نفس الحقيقة: إن المرأة المغربية لا تشبه شهرزاد في أي شيء، فهي لا تمتلك معرفة كتلك التي امتلكتها شهرزاد من خلال قراءاتها الواسعة والمتعددة، وبالتالي لا قدرة لها على الدفاع عن حقها في الحياة، فشهرزاد بهذا المعنى أضحت رمزا للمعرفة التي تعادل الحياة كحق لا غنى عنه بالنسبة للإنسان.
إن القراءة كفعل استراتيجي هي فعل مضاد، مضاد في مواجهة ثقافة وسلطة قائمة، والتي تلعب فيها المدرسة دورا مركزيا ومسيطرا، إذ لا أحد يعير اهتماما لموسيقاها، فهي موسيقى صامتة، إن المدرسة تأخذ الأولاد من الروضة من كل الطبقات الاجتماعية وتلقنهم منذ الروضة إن بالطرق الحديثة أو بالطرق القديمة أصول التصرف الملتصق بالايديولجية المسيطرة[31].
تبقى روح شهرزاد غائبة وغير مرغوب فيها، ولا تؤخذ بعين الاعتبار في الكتب المدرسية أو التعليم المدرسي بشكل عام، وهذا بالفعل ما أكده عالم الاجتماع المغربي بول باسكون بالقول: "إن التعليم لا يساعد على ولوج الحياة بل يساعد على ولوج الإدارة"[32]، ونفس الرأي قال به طه حسين: "وهكذا فمنذ دخول الطفل إلى المدرسة يوجه إلى الامتحان أكثر من توجيهه إلى التعلم والعلم، فهو يهيأ إلى الامتحان أكثر مما يهيأ للحياة"[33].
إن الخلاصة الوحيدة التي تبدو ممكنة ومنطقية هي أن الكتاب المدرسي والمدرسة بشكل عام تعيق امتلاك روح شهرزاد، بل وتقتلها، لذلك تبقى القراءة خارج الكتاب المدرسي مقياسا لقياس روح شهرزاد (أو الشهرزادية) كامتلاك للمعرفة بغية ولوج الحياة، مادام الكتاب المدرسي يقف على نقيضها ويعمل على إدامة نوع من السكونية والجمود داخل المعرفة التي تنتجها المؤسسة وتحميها.
***
عبد القادر بوطالب
................................
[1]- نجيب الخدري: "زمن الانحسار"، الملحق الثقافي لجريدة العلم15. يناير1994
[2] -بوجمعة العوفي:"الأبواب السرية"، الملحق الثقافي لجريدة العلم 19. فبراير 1994
[3] -نادية بنعباس الدكالي: "ماذا يقرأ المتعلم في بادية المغرب" الملحق الثقافي لجريدة العلم. 26فبراير 1994
[4] -ابراهيم الخطيب: "قراء الأدب: أقلية دائما"، الملحق الثقافي لجريدة العلم. 26فبراير1994
[5] - عبد الوهاب الدبيش:"المجتمع المغربي والقراءة: أية آفاق"، الاتحاد الاشتراكي. 16 يناير 1994 العدد: 3812
[6] - المرجع السابق
[7] -libération. Numéro: 9292. Mars 1994
[8]-Nawfal El Bernoussi: " lire n’est pas louer" . in libération. 2 Mars 1994 ; Numéro: 929.
[9] -مدخل لنظرية القراءة: بيان اليوم الثقافي 13يوليوز 1992 العدد:53
[10] - ب.ف.زيما: " من أجل سوسيولوجية للكتابة" ترجمة حسن المودن، العلم الثقافي. 9شتنبر .1990العدد:788
[11] -Moulime ElAroussi. "sclérose ou résistance"; in lamalif: Numéro: 198 Avril 1988
[12] -سورة العلق: القرآن الكريم
[13] -ابن خلدون: المقدمة. دار الرائد العربي، بيروت، ا لطبعة الخامسة82 .19ص:417
[14] -المرجع السابق ص:419-.420
[15] - الطاهر لبيب: سوسيولوجية الغزل العربي (الشعر العذري نموذجا). ترجمة مصطفى المسناوي، دار الطليعة للطباعة وللنشر، لبنان الطبعة الأولى 8719 ص:179
[16] - المرجع السابق.
[17] -ولتر .ج.أونج: الشفاهية والكتابة، ترجمة حسن البنا عز الدين، عالم المعرفة. الكويت 9419 ص: 180
[18] -ابن خلدون: المقدمة سبق ذكره,.ص:419.420
[19] -Ali Omlil: Histoire et son discours. (Voir notamment: écriture et pouvoir), ed: SMER. Rabat, 2eme édition pp: 26-28
-[20]- ibid. p:29. (Voir notamment: Ecriture et divergence)
[21] -بيير بورديو: (حوار). الاتحاد الاشتراكي، عدد:3325 /5شتنبر 1992 ترجمة عبد الكريم العمراني عن مجلة حدث الخميس. عدد:16/10 شتنبر 1992
[22] -ألف ليلة وليلة، المجلد الأول، المكتبة الشعبية للطباعة والنشر، لبنان. ص:5
[23] - المرجع السابق. ص:6
[24] -جمال الدين ابن الشيخ: " نص المتخيل وقضاء الذات" الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد الاشتراكي، 94/2/11
[25]- ألف ليلة وليلة –المجلد الرابع ص:388
[26] -Chafik Moulay Idriss: Shahrazade ou la magie du verbe: une figure de la femme accomplie. in libération (Supp-Hebdo). Numéro:24-25 MARS 1994. P:8
[27]-Edgar Allain Poe: Nouvelles histoires extraordinaires. in https://beq.ebooksgratuits.com/vents/poe-2.pdf
pp. 484 - 484
يمكن الرجوع الى ترجمتنا لهذه القصة:
عبد القادر بوطالب: قصة الظل: والمنشورة في موقع ثقافات، للاطلاع على القصة، راجع: https://thaqafat.com/2024/03/108292
[28] -فيليب سولزر:"تأملات في المسألة السير-ذاتية" العلم الثقافي،19 فبراير 1994
[29] -والتر.ج.أونج: الشفاهية والكتابة. مرجع سابق، ص:161-162
[30] -Fatima El Mernessi: Shahrazade n'est marocaine. édition le fennec. 1988
[31] - جدل حول المدرسة. الاتحاد الاشتراكي. عدد:11/769 شتنبر 1985
[32] -بول باسكون: (حوار). مجلة بيت الحكمة، العدد:3 السنة الأولى، أكتوبر 1986
[33] -محمد بوبكري: "ملاحظات حول الإنتاج التربوي لوزارة التربية الوطنية. جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد: 3880-25مارس 1994