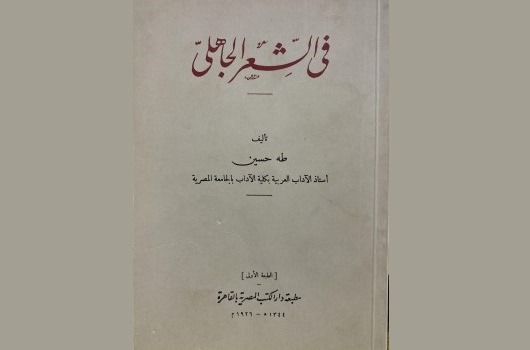لكل لغة اربعة مستويات: استهلاكي، ابداعي، علمي، رسمي. وتتسم اللغة الادارية الرسمية بالاتي:
الوضوح: فأدنى سوء فهم يؤدي الى الوقوع في خطأ التفسير، ومن ثمّ الخطأ في العمل. فهو يحرص على الإبلاغ دون (البلاغة) التي تعنى بجماليات ومهارات الكلام.
المباشرة: يقصد بها الخلو من الدلالات الإيحائية، والحرص على نقل المعلومات بدقة متناهية.
الإيجاز: هو استعمال اقل عدد من الكلمات لإيصال فكرة الكتاب، الا اذا اقتضى موضوعه التطويل.
الموضوعية: وهي طرح القضايا بشكل غير ذاتي. فالكاتب يكتب باسم الإدارة لا باسمه الخاص، لكي لا يقع في الذاتية والانفعال العاطفي. وترتبط بها المسؤولية؛ فالكاتب مسؤول عن كل كلمة يكتبها.
احترام السلم الإداري: هو جعل الكتاب مناسباً لمقتضى حال المرسل إليه، فخطاب الجهة الاوطأ يختلف عن خطاب الجهة الأعلى، وخطاب هذه بدورها يختلف عن خطاب الجهة الأكثر علواً.
الكليشهات (العبارات الجاهزة): هي عبارات وصيغ جاهزة تستعمل في بعض الكتب. ولكنها ليست عامة في كل الكتب، فالى جنبها استعمالات جديدة يكون فيها تصرّف.
غلبة الجمل الاسمية: سببها أن الجملة الاسمية تدلّ على الثبوت، في حين تدلّ الجملة الفعلية على التجدد والحركة. ففي قوله (تعالى) (وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (الكهف: 18) تؤدي لفظة باسط معنى الثبوت والبقاء على هذه الحال. ولو قال: (يبسط) لدلَّ على احتمال تغيير الكلب حالة بسط ذراعه. وتعتمد الكتب الادارية تبعاً لموضوعها الجمل الفعلية أيضاً.
عرف الجاهليون المستوى الاستهلاكي (الحديث اليومي) والابداعي (الشعر). وحين جاء الاسلام طرح القرآن المجيد (المصطلح) واضعا الاساس للمستوى العلمي الذي تحقق بنشأة العلوم في العصر العباسي (النحو، الصرف، البلاغة، العروض، علوم القرآن والحديث..) بصناعة مصطلحات مماثلة للصلاة والصوم والزكاة وغيرها. وهذا المستوى يتجسَّد الان بدراسة علوم الطب والحاسوب والهندسة وغيرها.
أما المستوى الرسمي (لغة الادارة) فيوجد عادة مع قيام الدول؛ فالإدارة تعني فلسفة الدولة والنظام والعقل المدبر لشؤونها بلغة ذات طابع خاص. ونجد الدول القديمة كلها تتخذ لها عواصم وهو اول اجراء اداري، ويكون فيها سجلات دقيقة وارشيف هائل وقوانين مكتوبة ومكتبات. وفي اوغاريت المدينة السورية التي كانت بمقام دولة تكتب الرقم الطينية بسبع لغات، وتسجل حتى الارامل واليتامى ومقادير رواتبهم.
ام بعرف العدنانيون الكتابة لانهم لم يقيموا الدول، بينما عرفها اخوانهم القحطانيون لإقامتهم الدول كالسبئية والمعينية والقتبانية والحميرية، وقد عثر على كتابات ادارية توثيقية كثيرة كعقود البيع والشراء والمخاطبات المختلفة، حتى كتبوا الديون الشخصية.
وكانت الرسائل عند عرب الجزيرة اكثرها شفهية، وينقلها عدّاؤون قيل (يسبقون الخيل) ومن هؤلاء تأبط شرا وابن اخته الشنفرى. وفي جمهرة رسائل العرب رسالة من عبد المطلب الى اخواله بني النجار يستنجد بهم، كتبت شعرا وحملها احد العدّائين اليهم. وله رسالة اخرى مكتوبة. واكثر ما وصلنا من رسائل مكتوبة من ذلك العهد من حاضرة (الحيرة) وفيها قامت مملكة تابعة لكسرى، وكان الكتاب حيَريين واشهرهم (زيد بن عدي العبادي الشاعر) وابنه (عدي بن زيد)، فيختار النعمان كاتبه بعد مكاتبة كسرى وموافقته عليه. ويكتب الكاتب باللغتين العربية والفهلوية (الكردية القديمة) وكان الملك هو يملي والكاتب يكتب ويترجم.
اما لغة الرسائل فهي تفتقر الى اللغة الادارية وفيها شطحات فنية وقد قتل كسرى النعمان بسبب احدى هذه الشطحات. فحين طلب كسرى الزواج من بنت النعمان كتب الى كسرى (أما في مها السواد وعِين ايران ما يكفي الملك؟). فترجمها عدي انتقاما لقتل النعمان اباه زيدا الى (اما تكفي بقرات العراق وايران الملك) فقتله تجاسرا عليه واحتقارا له. ولو كتب لغة ادارية واضحة لكتب (اما تكفي جميلات العراق وايران الملك).
الاسلام والادارة
اتخذ الرسول (ص) خمسة انواع من الكتاب: كتاب الوحي، وكتابا يكتبون بين يديه، وكتابا يكتبون في شؤون الناس، وكتابا لمخاطبة الملوك. وجعل حنظلة بن الربيع بديلا لمن غاب من جميع الكتاب السابقين لذا لقب بـ(حنظلة الكاتب) وكان الرسول يضع خاتمه عنده. وكان الرسول هو الذي يملي والكتاب يكتبون. وكانت الرسائل تبدأ باسم المرسِل ثم المرسل اليه ثم البسملة ثم نص الرسالة على غرار ما جاء في سورة النمل (إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (النمل: 30). ولكن لم تعرف تلك الحقبة الادارة واللغة الادارية بمعناها المعروف.
بعد معركة القادسية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استعمل أول مصطلح اداري ساساني هو (الديوان) ولو قرأنا مقدمة الجهشياري لكتابه (الوزراء الكتاب) سنطلع الى منظومة ادارية مذهلة مع لغتها الادارية بصورة تفصيلية واضحة. واستخدم الديوان لكتابة اسماء المقاتلة ومقادير رواتبهم وامور اخرى تخص الجيش، باقتراح من بعض الايرانيين الذين اسلموا.
والديوان مصطلح فهلوي (الفهلوية الكردية القديمة) يعني (المجنون) والى الان تستخدم الكلمة بهذا المعنى لدى الكرد والفرس. وذلك انهم تعجبوا من حفظ الديوان للمعلومات سنين طويلة، (والعادة ان ينسب اي شيء عجيب الى الجن والجنون؛ فتعجبوا من قدرة الشعراء على القول الجميل دونهم فجعلوا لكل شاعر جنا يملي له، وحين اشترط المتنبي على سيف الدولة أن ينشده قاعدا على خلاف المتعارف نسبوه الى الجنون).
يتفق على ان اول دولة اسلامية في عهد عبد الملك بن مروان؛ فقد سك العملة وصنع (السنجة) وهي قالب سك العملة باقتراح الامام محمد الباقر. بعد تهديد الروم بطبع عملة تسيء للإسلام والرسول لان العرب لم يعرفوا استخراج المعدن فصهروا الدنانير الرومية واعادوا سكها في سنجة تحمل كلمات اسلامية. كما استخدم عبد الملك وخلقاؤه كتابا روميين نقلوا الكتابة الادارية (غير الابداعية) لتكون لغة الدواوين والدولة، واهم الكتاب سالم وابنه وعبد الحميد الكاتب الذي قيل فيه (بُدئت الكتابة بحمد الحميد وانتهت بابن العميد) وابن المقفع وغيرهم، فكونوا مدرسة سادت مع الوقت وهي تجعل الثقل الأكبر للمعنى وتكون المعاني غزيرة، والالفاظ مساوية للمعنى وغير جزلة بعكس مدرسة النثر العربية التي مثلها الجاحظ .
كان الجهد الاعجمي قليلا في العصر الاموي لتشدد الامويين في العروبة. وحين جاء العباسيون انفتحوا على الفرس فنقلوا كل ما استخدمه الاكاسرة من مظاهر ولغة ادارية، كالمراسيم الادارية والزي الاداري ووسعوا في الدواوين فكثرت المصطلحات الادارية الاعجمية في الوهلة الاولى ثم عربوا منها ما أتيح وامكن لهم.
ان الكتاب الاداريين العرب والمستعربين في العصر العباسي قاوموا الامواج العاتية للافاظ والاساليب الادارية الاعجمية، وقليلا ما نقلوا الالفاظ نفسها والاكثر انهم عرّبوا تلك الالفاظ فاخذت القياس العربي. كما انهم اجتهدوا في صنع (لغة ادارية) مختلفة عن المستويات الاخرى للغة وفي ذلك يقول قدامة (وان كان بعض ذلك لا يوافق ما عليه مجرى اللغة) بمعنى بعض ما يكتبه الكتاب يخرج عن مذهب اللغة. ومن ذلك: الايغار: الاستيفاء، الحطيطة: تنزيل السعر. واستعملوا (الفرس الكمتاء مقابل الحصان الكميت) وهو خلاف اللغة. وسموا المساحة الصالحة للزراعة (الجريب) واصل الجريب هو الوادي. وقاموا بتعريب كثير من المصطلحات التي استعملوها اولا مثل الديوان عربوا الى (الجريدة أو الجريدة السوداء)، وانجيذج عربت الى الجزية.
مصطلحات الدواوين الفارسية:
ديوان الخراج (الواردات) وقد عربت مصطلحاتها ولم تستعمل كما في اصلها الفارسي ومنها: (أوراج) أي ديوان الخراج الكبير. (انجيذج) (الجزية) من گريت (التخمين) من همانا، ويقابلها في العربية الخرَص. ويسمى المخمن للثمار في البساتين (خاروص). وما يخص هذا الديوان العملة: دينار، درهم، فلس، دانق = قيراطين. ومن اسماء المناطق: كورة = مقاطعة. رستاق= قرية. سمرت: من شمارة = يوم الجباية.
ومن مصطلحات الماء: بست = من اقيسة مستوى الماء. كستبزود: زيادة ونقصان الماء. الهندسة لدراسة المساحات من اندازه وهو المقدار. والى اليوم مستعملة يقولون باندازي أي بقياس. ومنه دروزن للمساحات المزروعة.
ديوان النفقات (المصروفات) (الصك) من چك.. (الطسق) من الاجور. سفتج: السفتجة الحوالة.
ديوان الجيش: من مصطلحاتها (اسكودار) وتعني كتب الصادر والوارد. و(آيين) وتعني العادة والاسلوب والروتين في الكتابة. ومصطلح (عسكر وعسكرية) فارسي من (لشكر) بمعنى الجيش، واستخدموا منه المعسكر.
ديوان الرسائل: مهرق من مهركرد وهو كتاب العهود. البريد من بريدم (بري = مقطوع، دِم ذيل). اسكودار : يقابل ساعي البريد.
ديوان البريد والسكك:
البريد مصطلح فارسي من (بري = مقطوع، و (دِم = ذيل) = الذيل المقطوع؛ لانهم كانوا يميزون بغال البريد بقطع الذنب. وصاروا يطلقون اسم البريد على الرسائل وناقل الرسائل. والفرسخ فارسي ايضا، والميل رومي = 3 فرسخ. واضاف العرب (المرحلة والمنزلة) للمسافات الطويلة وهما بمعنى واحد.
وهكذا لبقية الدواوين: ديوان التوقيعات، ديوان الخاتم، ديوان الفض، ديوان النقود والعيار، ديوان المظالم.
لغة الادارة الحديثة
الادارة بالمعنى الحديث المعمول به (وضع خطوات ثابتة ومحددة لاستكمال المعاملات في الدوائر والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية) ويعبر عنها بالروتين. واللغة الادارية (عبارات محددة يُتَّفق عليها لكل غرض أو معاملة. ولا يترك وضع النص الإداري لأهواء أي شخص، بل يخضع للمؤسسات. وخطابها غير أدبي، له خصائص ومفردات رسمية تتسم بالوضوح وعدم التأويل، وذات بُعد إجرائي وقانوني، وترتبط بالمجتمع ارتباطا فاعلا).
ولابد من التسليم بأن المؤسسة الإدارية جاءتنا برمتها مع المحتلين، فنقلت معها المصطلحات الإدارية التي استعملوها في دوائرهم الى عالمنا العربي. لذا حفلت بأساليب وصيغ مترجمة لعدم وجود استعمال عربي لها.
و(الإدارة) لغة (التحويل) كإدارة العين والكأس والرحى والأثاث. و(المدير: الذي يقوم بذلك). وقد استعملت الادارة للحكم لأنها الجهة الوحيدة التي تحتاج إلى إدارة. فقيل (حسن الإدارة) (الإدارة وتدبير الممالك). واستعمل (يسوس) بمعنى (يدير) ايضاً فقالوا (يسوس الدولة) (يسوس الامور). وهذا يعني ان (الإدارة) ليس لها الخصوصية التي نفهمها اليوم. ولم يصطلحوا على الحاكم والقائم بالأمر (المدير) فبقيت اللفظة (ذات معنى عام). وهكذا مصطلحات الادارة فهي ترجمات ليس لأغلبها جذور عربية. فعلى سبيل المثال (اللجنة) لا وجود لها في لغة العرب. فيوجد من جذرها (اللجِن: الوسخ) و(اللجان) في الابل يقابل الحران في الخيل، وهكذا.
من أهم اصطلاحات الإدارة المترجمة من الإنگليزية:
(الإدارة = Administration)
(المدير = Manager)
(المدير العام = General Manager)
(الموارد البشرية = Human resources)
(رئيس غير رسمي: رئيس عشيرة، رئيس طباخين = Chef)
(رئيس رسمي: رئيس قسم، رئيس فخري = Head)
رئيس مجلس، رئيس لجنة =chairman )
(لجنة: Committee)
(عميد، مدير عام = Dean)
رئيس الجامعة (University's president)
(رئيس قسم = Head of department)
رئيس مجلس الادارة = (chairman of board of directors)
(مدير شعبة = Division Manager)
قسم (department)
شعبة (Division )
مفتش (Inspector)
الوحدة (Unit)
(وحدة طبية = Medical unit)
(وحدة إدارية = Administrant unit)
(إجراءات = Procedures)
(جدول الأعمال = Schedule)
(موظف =Employee )
(موظف بعقد = Contract Employee)
ترقية، ترفيع = (Upgrade)
(الصادر والوارد Exported & Imported = )
(الموارد البشريةHuman Resources = )
(السكرتاريةSecretarial = )
(السكرتيرSecretary = )
(العلاوة = Raise)
(الصادر والوارد = Exported and Imported)
(الذاتية = Self care)
(الحسابات = Accounts)
(اجتماع = Meeting)
(جلسةSession = )
(ندوةSeminar = )
(مؤتمرconference = )
(احصائياتStatistics = )
(دوامOffice hours = )
(سلم الرواتبSalary scale = )
مصطلحات ادارية
(بناءً على/ استناداً لـ = Based on)
(طبقاً، وفقاً لـ = According to)
(إشارة إلى = With reference to)
(نظراً لـ = In view of)
في ضوء (in lite of)
(وعليهAccordingly = )
وكثير من المصلحات المستعملة لها اليوم معنى اداري يختلف عن المعنى العربي الاصلي مثل (موظف/ توظيف) (تعيين)؛ فالوظيفة عربيا ليست العمل المخصص، بل (مقدار الصرف) لذا يقولون (له وظيفة من رزق. أي مقدار مبلغ يصرف له جراء العمل) ولا يقولون (هو موظف) بل (هو موظَّفٌ عليه = يُجرى عليه مبلغ). و(التعيين = تحديد الأجر) قالوا (التوظيف: تعيين الوظيفة = تحديد مقدار الرزق). و(الاستقالة: طلب الشخص الذي يسقط من آخر أن يعينه على النهوض) وقد تستعمل مجازا (عثر في أذيال الردى وما استقال) والتقاعد (Retirement) عربيا تعني التكاسل وهي اهانة لمن قضى عمره يبذل قصارى جهده في العمل. ولفظة (vote = تصويت انتخابي) مشتقة من (voce = صوت) بينما في العربية لا يصح الاشتقاق؛ فـ(التصويت) رفع الصوت (عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى/ وصوّت انسان فكدت أطير) وعفط واطلق الغازات. بمعنى ان المصطلحات الادارية الاجنبية محددة الدلالة لكن المصطلحات العربية المترجمة عنها في اصلها العربي عامة أو لها دلالات بعيدة. ومنها:
- المصطلح الانجليزي (bombs): ترجم الى القنابل وهي تعني الخيول: قال المتنبي:
قَريبٌ عَلَيهِ كُلُّ ناءٍ عَلى الوَرى إِذا لَثَّمَتهُ بِالغُبارِ القَنابِلُ
وقال الجواهري المعاصر بمعنى bombs:
يا معدن الخسة من تقاتلُ وفوق من تساقط القنابلُ
- (Microbe = ميكروب) ترجمت الى الجراثيم. والجراثيم الاصول والعشائر. قال ابو تمام:
خَليفَةَ اللَهِ جازى اللَهُ سَعيَكَ عَن جُرثومَةِ الدِينِ وَالإِسلامِ وَالحَسَبِ
- الرتب العسكرية
(نقيب = Captain)
الباحث عن الماء (رائد = Major)
الذي يقدم على غيره (مقدم = Lieutenant Colonel)
عميد قومه المعول عليه والعاشق (عميد = Brigadier Colonel)
العلم (لواء = Major General)
الزعيم (عقيد = Lieutenant)
المجموعة (فريق = Colonel General)
(أركان حرب = Staff Officer)
الخلاصة ان العباسيين كانت تدفعهم الغيرة على العربية فحافظوا عليهم وبذلوا فوق الجهد لاستيعاب مسميات لم يألفوها، فاستحدثوا مصطلحات عربية ازاءها مثلا في الجيش استحدثوا مصطلح (الاعمدة) وهي الصفات المميّزة بينما استعل الان (العلامات الفارقة) نقلا من الانجليزية (Distinctive features). ولم يأخذوا لفظا اجنبيا كما هو بل عرّبوه فصار بالقياس العربي الا اذا استعصى عليهم وهو ما ندرز
اما لغة الادارة الحديثة فهي نقل الالفاظ الانجليزية كما هي هو وضع الفاظ عربية ازاءها وغالبا ما تكون هذه الالفاظ بمعاني عربية معايرة، فهم يحفرون اللفظ ويرمون معناه العربي ويحشونه بمعنى انجليزي كما تحشى السن. او يضعون ازاءه لفظا عربيا عاما.
***
الأستاذ الدكتور محمد تقي جون