قضايا
حيدر عبد السادة: المثقف الشعبوي
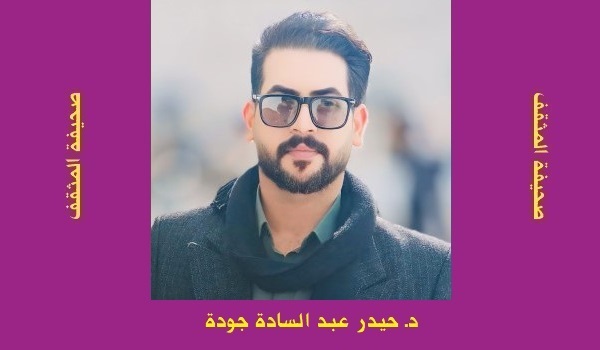
لا سبيل للخلاص من البحث في إشكالية المثقف ما لم يكن المفهوم المشار إليه مضغوطاً بين خيارين، العضوي والتقليدي، الكوني والمختص... أو قد يكون مفهوم المثقف حاملاً لمحمولٍ آخر، كما نقول: مثقف السلطة، المثقف الرأسمالي، المثقف الاشتراكي وغير ذلك الكثير.
وما نُريد البحث فيه لا يخرج عن قماشةِ ما تمَّ ذكره، فنحن بصدد الكشف عن هوية المثقف الشعبوي. لكن لا يمكن لنا أن نبتَّ الرأي فيه ما لم نضعه تحتَ طرفي تضاد مع مفهوم آخر، ولكي تتقعد القواعد نقول المثقف الشعبوي والمثقف الأكاديمي. والأخير عبارة عن تصنيف إجرائي، فلا نريد الإشارة به إلى فئةٍ معينة، لأن كثير من الأكاديميين قد لا يصلحون في أن يكونوا مثقفين شعبويين أصلاً، ولكننا نودُّ من هذا التضاد للتعريف بشخصية المثقف الشعبوي، والإنهاء إلى الشروطِ الواجب توافرها لكي تكون لنا القدرة في ردم هوة الشعبوية بالمثال الأكاديمي.
على إننا، وكما أشرنا، لا نجعل الاكاديمية شرطاً ابداعياً لجعلِ المثقف مثقفاً، فهي قد تنمّي القدرة الإبداعية وتفتح آفاق المعارف أمام العقل لبلوغ غاية الحكمة، إلا إنها ليست صكّاً حقيقياً لمهنة المثقف، فقد يكون المثقف غير أكاديمي، لكنه قد يفوق ما تنتجه الأكاديمية بطوال رحلتها.
المثقف الشعبوي، هو ذلك الذي تتسع في ذاكرته ملكة الاستيعاب والإنصات، وتلقي النصوص وحفظها، أما المثقف الأكاديمي، فهو الذي يمتلك قدرة انتاج النصوص على النصوص المقروءة، فقد يفتقر إلى ملكة الحفظ والتلقي، لكنه مدعوم بملكة الكتابة والتدوين، لذلك فإن عمله مُناط بالقدرة الكتابية وإنتاج النصوص على ركام النصوص الأخرى، بينما يكون عمل المثقف الشعبوي مرهوناً بالشفاهية، ومقيداً بالكيفية التي يتم فيها نقل ما سمعه أو حفظه إلى الغير، وغالباً ما يكون أميناً بنقله، لأنه لا ينقص عمّا سمعه ولا يزيد، وهو بعبارة أخرى: أداة لاستنطاق النص المحكوم على الورق، والعمل على الخروج به، كما ورد تماماً، إلى الآخر. بينما يدخل المثقف الأكاديمي مدخل الصراع مع النص المقروء، لينتهي إلى الإنتاج بعد رحلة عصيبة مع التأويل والتحليل والتركيب والتفكيك.
يستند المثقف الشعبوي في بناء مشروعه وتطوير مهاراته على وسائل الإعلام بمختلف ألوانها وأشكالها، سمعية كانت أو مرئية، لأنه يستند بالأساس على الثقافة الشفاهية، بينما يبقى المثقف الأكاديمي رهين دور النشر، لأنه أكيداً محكوم بالثقافة الكتابية، ولا يمكن له أن يجد ما ينقذه سوى دور النشر المعنية بطباعة الكتب والمجلات. لذلك نجد العقل عند المثقف الأكاديمي، هو الأداة المصدرية في الإنتاج، بينما يعتمد المثقف الشعبوي على اللسان بعدّه الفعل التواصلي الذي ينقل به ما قرأه من نصوص.
وفي طبيعة الحال سنجد أنَّ القاعدة الجماهيرية واسلوب التلقي من المثقف الشعبوي، يفوق كثيراً ما يمكن أن يتلقاه الجمهور من المثقف الأكاديمي، لان القاعدة الجماهيرية في أغلب صورها إنما هي ثقافة سماعية أو مرئية، تودُّ أن تجد من يفكر بالنيابة عنها، وتمنّي النفس في سماع ما قاله الفيلسوف الفلاني في كتابه الفلاني، ونراها تبتعد كل البعد عن ثقافة مطاردة الفكرة المختبئة بين أروقة النصوص الموجودة بين دفتي كتاب.
لذلك تجد الذي أنتج مجموعة كبيرة من النصوص يرتكن إحدى زوايا بيته، يقرأ نصاً معيناً، وبانتظار أن يستفزَّ الأخير عقله لينتج نصّاً على ركام ما قرأه، فيذهب به بعد ذلك إلى أصحاب دور النشر، فتحصل الموافقة بعد الحديث عن الذي لك والذي لي، وأبرز حدثٍ في ذلك إنك ستجد اسم كتابك معروضاً على (غوغل) أو مُمدّداً في شوارع المتنبي أو الرشيد ويباع بثمنٍ بخس.
أما المثقف الشعبوي، فتنهال عليه القنوات والإذاعات، وبعقود عالية ومغرية، وتتقدم له دعوات المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية، لا لمنجزٍ يُذكر، بل لأجل قوله (يقول علي الوردي في كتابه وعاظ السلاطين…). بينما يقتضي أن يُنتِجُ نصاً على ما قرأه، لا أن يبلّغ الآخرين بما قرأهُ.
***
د. حيدر عبد السادة جودة







