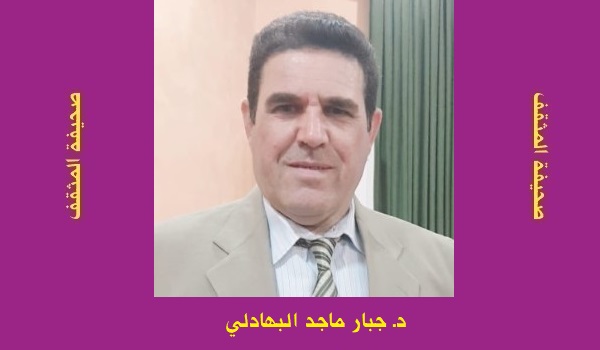تجديد وتنوير
عماد خالد رحمة: نحو عصرنة هيرمينوطيقا النص المقدّس

يُمثّل الفهم والتأويل أحد أبرز الإشكالات الفلسفية والمعرفية التي تصدّت لها الحداثة الغربية بمقاربات عميقة امتدت من النزعة الديكارتية إلى النسيج الهيرمينوطيقي المتطور، فيما بقي العالم العربي والإسلامي أسير دوائر تأويلية مغلقة، تتكرّر فيها آليات الفهم وتُعاد ضمن أطر تقليدية لا تتجاوز حدود التفاسير القديمة والمرجعيات الثابتة. ومن هذا المنطلق، تطرح الحاجة نفسها بإلحاح إلى عصرنة هيرمينوطيقا النص المقدّس بوصفها مدخلاً لاستعادة المعنى وتجديد صلة الإنسان بالنص في ضوء الزمن المتحوّل.
ـ الهيرمينوطيقا الغربية ومأزق اليقين الديكارتي
لقد أسّس رينيه ديكارت لتيار معرفي يقوم على البداهة واليقين، وهو ما مهّد لبروز النموذج العلمي الحديث بوصفه الضامن الوحيد للمعرفة المُحكمة. في هذا السياق، تمَّ تهميش كل ما يتعلّق بالفهم الذاتي والتأويل بوصفه غير قابل للاختبار التجريبي، ومن ثمّ غير جدير بالمشروعية العلمية. إلا أنَّ هذا الرفض للتأويل لم يستمر طويلًا، فسرعان ما جاءت أعمال شلاير ماخر ثم دلتاي لتنقل الهيرمينوطيقا من هامش الفلسفة إلى قلبها، بوصفها فعلًا تأويليّاً لا يستقيم إلا داخل سياقات الفهم الإنساني.
وجاء هانز جورج غادامير، المتأثر بهيدغر، ليُضفي على الهيرمينوطيقا بعداً أنطولوجيّاً عميقاً، حيث لم يعد التأويل أداة لفهم النص، بل أصبح تعبيراً عن وجود القارئ ذاته. في كتابه "الحقيقة والمنهج"، يرى غادامير أن الفهم ليس نشاطًا محايداً، بل هو اندماجٌ للأفقين: أفق النص وأفق القارئ، في لحظة تاريخية مخصوصة. ومن هنا، لم تعد الحقيقة نتيجة تطبيق المنهج، بل نتاج حوار دائم بين الذاتي والتاريخي، بين اللغة والتأويل.
ـ الفجوة العربية: نص ساكن وقارئ غائب..
في المقابل، لا تزال التأويلات الدينية العربية أسيرةَ الموروث التفسيري التراثي، الذي لا يعترف لا بتعددية المعنى، ولا بانفتاح النص على احتمالات زمانية متغيّرة. فقد تمّ تجميد النص المقدّس في قوالب تفسيرية وضعها أسلافٌ عاشوا ضمن شروط تاريخية، اجتماعية، سياسية وفكرية مختلفة تمامًا. هؤلاء، أمثال ابن كثير، الطبري، والجلالين، قدّموا اجتهاداتهم في تأويل النص القرآني ضمن أفقهم الثقافي، لكن تمّت معاملتها بعد ذلك بوصفها حقائق نهائية لا تقبل المناقشة أو التحوير، وكأنّ النص المقدّس توقّف عن الحياة بعدهم.
هذه الممارسة ليست بريئة معرفيًّا، بل هي فعل إقصائي يعطّل النص ويجرّده من حيويّته. فالقراءة التي لا تُحدث قطيعة مع المألوف، هي قراءة ماضوية لا تشتبك مع الحاضر، بل تعيد إنتاجه ضمن منطق الاجترار والتقليد. وبهذا، نصبح أمام نصٍّ يتكلّم بلسان الماضي، وقارئٍ يطلب منه أن يُنقذ الحاضر.
ـ الحاجة إلى تأويل زماني: تحرير النص من إسار الجمود
عصرنة الهيرمينوطيقا تعني أوّلًا استعادة النص المقدّس ككائن حيّ، يعيش ويشتبك مع الحاضر، ويُحدث أثرًا في المستقبل. نحن لا ندعو إلى تحريف النص أو شطبه، بل إلى إعادة تأويله ضمن سياقات معرفية وحداثية جديدة، قادرة على احتضان المغايرة، واستيعاب الحراك التاريخي الذي يعيشه الإنسان المعاصر. فالنص الإلهي، بحسب ما تذهب إليه الهيرمينوطيقا الفلسفية، لا يتكشّف دفعة واحدة، بل يفتح نفسه في كل مرة على أفق جديد من المعنى، بحسب ما يتوفّر للقارئ من أدوات فكرية ووجودية.
ولعلّ أبرز إشكاليات الهيرمينوطيقا العربية، هو تعاملها مع التأويل بوصفه تابعًا للإجماع، وليس كفعل حرّ ينبع من وعي القارئ ومسؤوليته. التأويل الأصيل ليس خيانة للنص، بل فعل إخلاص له، لأنه يحاول أن يستنطقه لا أن يعيد تلاوته.
ـ التأويل المعاصر: من ريكور إلى فاتيمو
لقد فتح التأويل الغربي أفقًا عظيمًا من القراءات الحداثية للنصوص، سواء أكانت دينية أو فلسفية أو أدبية. بول ريكور قدّم نموذجًا فذًا في التعامل مع النص الديني من خلال مفهوم "الرمز"، معتبرًا أنَّ الرمز يُنتج معانيه ضمن أفق التأويل، ولا يُختزل في قراءة حرفية أو دوغمائية. أما جياني فاتيمو، فقد دعا إلى تأويل غير سلطوي للنصوص، ينطلق من ضعف الحقيقة لا من قهرها، ويدعو إلى إنزال النص من مقام القوة إلى مقام الحوار.
في حين بقيت الثقافة العربية المعاصرة في تأويلها للنصوص المقدّسة رهينة نزاع بين خطابين: خطاب سلفي متصلّب، وخطاب حداثي غالبًا ما يتم تهميشه أو تخوينه.
ـ نحو هيرمينوطيقا عربية راهنة
الرهان الآن هو في بناء تأويل عربي يستوعب التراث ولا يتقوقع فيه، يتّصل بالواقع دون أن يبتذله، يستحضر مناهج الغرب النقدية دون أن يغترب عنها. نحن بحاجة إلى تحرير النص من سلطة الحراس الذين منعوا أسئلة الحداثة من الاقتراب منه. فكما أنَّ النص المقدّس وحيٌ، فإنَّ التأويل اجتهاد بشري، ولا يمكن أن يحتكر الإنسان المطلق في فهم ما هو إلهي.
إنَّ عصرنة هيرمينوطيقا النص المقدّس تعني قبل كل شيء: إعادة الإنسان إلى مركز المعنى. فالمعنى لا يكون إلا في أفق الكينونة، والزمن، والمكان، والتاريخ. وكل تأويل لا يحمل قلق الحاضر وأسئلته، هو تأويل ميت، ولو استشهد بألف من المفسرين.
خاتمة:
ليست الهيرمينوطيقا فعلًا معرفيّاً فحسب، بل هي ضرورة وجودية لتجديد العلاقة مع النص. وإذا كان الغرب قد أنجب أمثال ريكور، فاتيمو، دورتي، فلِمَ لا نُنجب نحن نماذج جديدة تحاور النص في أفق العصر؟
لن يكون لهذا ممكنًا إلا إذا تحررنا من الخوف، وامتلكنا الجرأة لنفكر خارج سياق التكرار. فالنص الذي لا يُقرأ من جديد، هو نص ميت.
وعلينا أن نقرر: إما أن نؤوّل، أو نُؤوَّل.
***
بقلم: عماد خالد رحمة – برلين