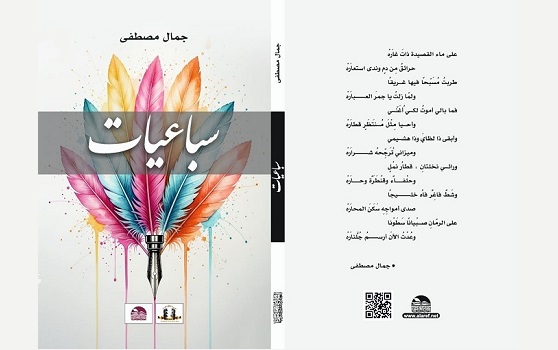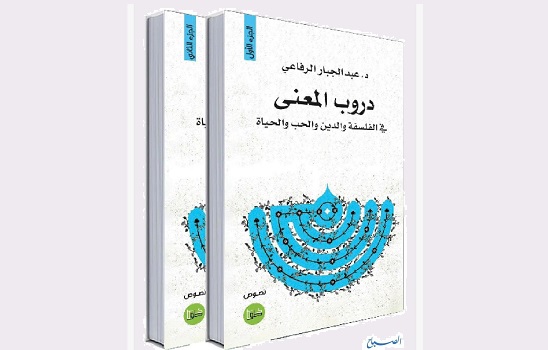قضايا
حيدر شوكان: الكتاب كديكور.. سيرة خراب معرفي

في عالم يُعاد فيه تعريف المعرفة بوصفها إجراءً وظيفيًّا لا تجربة وجودية، يصبح الحديث عن العلاقة بالكتاب حديثًا عن التيه أو الفقد، عن ذلك الوميض الذي كان يشعل فينا رغبة السؤال قبل أن تختنق في ركام المناهج والألقاب. لقد صارت القراءة طقسًا بيروقراطيًّا لا يستبطن القلق، من هنا، تنفتح هذه المقالة المتواضعة على مشاهد صغيرة، لكنها ناطقة، تكشف وهن العلاقة المعاصرة بالمعرفة، وتُعيد مساءلة حضور الكتاب في وجداننا الثقافي، لا كشيءٍ ماديّ، بل كعنوان لضمور المعنى.
في أحد أروقة سوق الحويش، كنت برفقة صديقي د. حيدر حسن الأسدي، نتبادل الحديث عن الكتب والمطبوعات بين رفوف مكتبةٍ قديمةٍ، إذ اعتدنا أن نجد بين عناوينها ما يحرّض فينا دهشة السؤال. جلسنا مع صاحب المكتبة نتسامر، حتى أسرّ إلينا بقصة أثارت في ذهني شعورًا بالدهشة والاغتراب: قال إنّ أحد الأشخاص مرّ عليه ذات يوم، وطلب قائمة طويلة من الكتب ليشتريها، لكنه اشترط شرطًا غريبًا؛ أن يتعهّد صاحب المكتبة بشرائها منه بعد عامين. سألته مذهولًا عن سبب ذلك الشرط، فأجابني بجمود لا يخلو من سخرية مبطّنة: "سأكمل دراسة الماجستير، وعندها لن أحتاج إلى الكتب."
كانت كلماته كالفاجعة، تثير الشفقة قبل السخرية، تذكّرك بأن الخراب المعرفي ليس فرضية بل واقع، وأن العلاقة بالكتاب لم تعد تعني المعرفة، بل هي طقس مؤقت تُؤدّى لاستيفاء متطلبات البيروقراطية الأكاديمية. لقد صار الكتاب عبورًا اضطراريًا، لا شغفًا، ومجرد أداة في مشروع النسيان المنظّم.
هذا المعنى ذاته لامسه قبل مدة وجيزة الكاتب علي وجيه في عبارته الجارحة: "أكثرُ الشعراء والأكاديميين والأدباء لا يقرؤون." عبارة أثارت ضجة في الوسط الثقافي، لكنها ككل الحقائق التي تُقال بصراحة، كانت مؤلمة لأنها صحيحة. لم تكن مبالغته خطأ، بل كانت مقاربة جريئة لحقيقة ساطعة: إننا نعيش زمن الشهادات المعلّقة على الجدران، والعناوين والألقاب لا زمن العقول المشغولة بالسؤال.
ومن المشاهد التي حفرت أثرها في ذاكرتي، ذلك الحديث العابر مع صديقٍ جمعتني به أمنيات مشتركة. أخبرني ذات يوم بعزمه على بيع مكتبته، فسألته مستغربًا عن الدافع وراء ذلك وقد خلتُه يهمّ بترميمها أو استبدالها بأخرى أكثر رحابة. فأجابني ببرودٍ: "لقد أنهيتُ الدكتوراه، ولم أعد أجد في القراءة ضرورة؛ صارت الكتب عبئًا يثقل كاهلي."
كانت كلماته إعلان صريح عن موت الرغبة في المعرفة لحظة انتزاع الشهادة، كأن الغاية لم تكن إِلَّا غلافًا ينتهي دوره عند استيفاء المتطلبات الأكاديمية.
في سنوات اشتغالي ومتابعتي لمسار الدراسات العليا، ترسّخت لديّ قناعة مريرة: تسعون في المئة من أولئك الذين سيصبحون أساتذة لا يقرأون إِلَّا ما خُطّ لهم في كتبهم المقرّرة، ولا يفكّرون إلَّا ضمن جدران صندوق مغلق، إذ تأخذ المعلومة شكلها النهائي دون أن تُسائل أو تُختبر، وكأن المعرفة ليست إِلَّا تمرينًا على التلقين، لا تجربةً مع اللامحدود.
الفيلسوف الماركسي جورج لوكاش ألمح إلى مفهوم "التشييء" (Reification) في كتابه (التاريخ والوعي الطبقي) إذ تتحول الأفكار والرموز الثقافية إلى أشياء مادية جامدة تفقد معناها الإنسانيَّ العميق. الكتب هنا لم تعد جسورًا إلى التأمل الحر، بل سلعًا تملأ الرفوف أو تُباع وتُشترى، مجرد ديكور مؤقت.
وأذكر أني قرأتُ للشيخ حيدر حبّ الله حكاية رواها له أحد أصدقائه من أصحاب المكتبات، مضمونها أن رجلًا دخل عليه يومًا وطلب شراء خمسة كتب "باللون الأزرق". فسأله: تقصد أي كتب؟ فأجاب: لا يهم، المهم أن تكون بالأزرق. فاستغرب الرجل وقال: لم أفهم قصدك. فرد الزبون بهدوء: أريد فقط أن أملأ بها فراغًا في مكتبتي، ليكتمل تناغم الألوان مع الستائر.
في تلك اللحظة، لا تعود الحكاية مجرد طُرفة، بل تتحوّل إلى مرآة تكشف هشاشة المعنى في زمن التشييء، حين يتحوّل الكتاب من حاوية للمعرفة إلى أداة زينة، ومن محرّض على القلق والتساؤل إلى قطعة أثاث. إنها اللحظة التي تدرك فيها عمق ما قصده ماكس هوركهايمر حين أشار إلى "عصر العقل الأداتي"، إذ يُفصل الشكل عن المضمون، ويُختزل الوعي إلى لون، والفكر إلى ديكور.
في مقابل هذا الخراب المعرفي، يقف عبد الجبار الرفاعي كاحتفاء نابض بالحياة؛ يتحدث ببهجة تشبه إيقاع الموسيقى، عن شغفه بالكتابة وولعه الذي لا ينطفئ، وعن تجربته المتقدة بين الصفحات، وعن مكتبته التي تبدو كعالمٍ قائم بذاته. هناك، عند عتبات حديثه، تنبثق شلالات من الجمال، كأنك تعبر إلى فردوس من المعنى، إلى لغة ثانية؛ لغة تستنشق فيها الحروف حياة، وتصير الكلمات جسورًا نحو فضاءات لا حدود لها.
تتجلّى صورة أخرى مترعة بالجمال في حضرة أستاذي د. عبد الأمير زاهد؛ ذلك الذي لم تسرقه مشاغل المنتدى الوطني لأبحاث الفكر والثقافة، ولا إكراهات الجامعة وإدارتها من عناق الكتاب والتأمل،- كما شغلت البعض وأوضاعتهم في زحمة الظهور الزائف- إذ ظلت القراءة عنده كيقين ملازم، لا تنفصل عنه كما لا ينفصل الدفء عن النار. سألته يومًا: "هل سرقتك الإدارة من شغفك بالقراءة ومتابعتك الفكرية؟" فأجابني بثقة العارف: "كلا، لأن جوهر حياتي قائم على القراءة والتفكير، أما العمل الإداري فلم يكن يومًا سوى حاشية عابرة على متن وجودي."
ثمة صورة أخرى، لا تقلّ دلالة عن سابقاتها، نقلًا عن لحظةٍ عابرة لكنها مشبعة بالمعنى: كنت قد نشرتُ في أحد الأيام تنويهًا عن كتاب جاكلين الشابي "ربّ القبائل"، مشيرًا إلى أنه عمل يستحق القراءة، ويستحق التأمّل، ويستحق النقد أيضًا. لم تمضِ سوى دقائق معدودات، حتى تلقيت رسالة من المفكّر العراقي ماجد الغرباوي، يطلب فيها نسخة من الكتاب، حتى وإن كانت بصيغة PDF.
ما كان لهذا التفاعل أن يمرّ مرورًا عابرًا؛ فهو يعكس شغفًا حيًّا لا تنطفئ جذوته، رغم أن صاحبه قد تجاوز السبعين من عمره، ومقيمٌ على بُعد آلاف الأميال، في أستراليا. من لا يعرف الغرباوي، فليعلم أنه من أهم المفكرين العرب- نتاجًا وتحديثًا-، ومن القلائل الذين لا تزال فيهم حرارة السؤال حيّة، أولئك الذين لم يتقاعدوا من التفكير، ولم يتخلّوا عن الملاحقة اليومية لما يصدر، لا بدافع الاستعراض، بل بوصفها نمط وجود، ونبضًا دائمًا للفكر.
هنا، تتجلّى المفارقة: في وقتٍ يتنصّل فيه بعض الشباب من الكتاب بعد أن يظفروا بشهادة، يقف الغرباوي كنموذج مغاير، يثبت أن الفكر ليس محطة عابرة في العمر، بل هو العمر ذاته حين يُعاش بوعي.
***
د. حيدر شوكان سعيد.
جامعة بابل- قسم الفقه وأصوله.