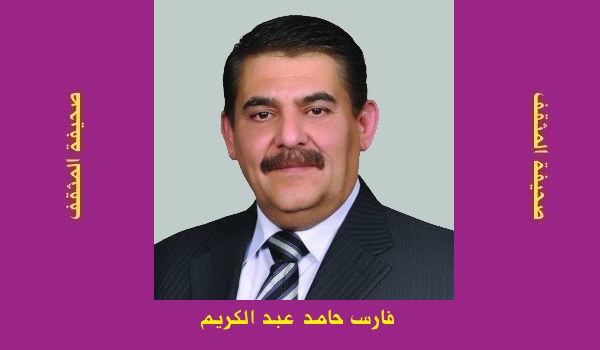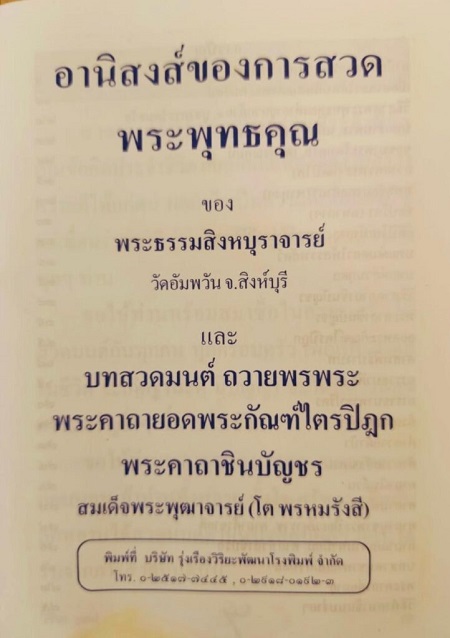قراءة نقدية وبيداغوجية للرؤية الاستراتيجية 2015 ـ 2030
ملخص البحث باللغة العربية:
تركز هذه الدراسة النقدية على تحليل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب 2015–2030، باعتبارها وثيقة محورية تهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتطوير المدرسة المغربية كمؤسسة تربوية حديثة. كما تستعرض الدراسة الركائز الأساسية للرؤية الاستراتيجية، بما في ذلك تحسين المناهج والمقررات وتطوير أداء المدرس والمتعلم والريادة ناجعة وتدبير التغيير، والارتقاء الفردي والمجتمعي للمتعلمين، مع إبراز الإنجازات الملموسة التي تحققت على صعيد السياسات التعليمية.
كما تقارن الدراسة بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015–2030، موضحة التقدمات والإضافات التي أدخلتها الرؤية على صعيد الإصلاحات الهيكلية والبيداغوجية، مع تقييم مدى تكاملها مع أهداف المدرسة المغربية الحديثة.
وتخلص هذه الدراسة إلى أن نجاح الرؤية الاستراتيجية يعتمد على استمرار تطوير السياسات التعليمية وتفعيل التدابير التطبيقية، وحرص جميع الفاعلين على الانخراط الفعّال في العملية التعليمية لضمان تعليم شامل وفعال ومتكامل يواكب تطلعات المجتمع المغربي.
الكلمات المفتاحية:الرؤية الاستراتيجية 2015–2030-إصلاح التعليم - المدرسة المغربية - الميثاق الوطني للتربية والتكوين - الجودة الشاملة - الإنصاف وتكافؤ الفرص - القيادة وتدبير التغيير
Abstract (English(
This critical study analyzes Morocco’s Strategic Vision for Education Reform 2015–2030, considering it a central document aimed at enhancing educational quality, achieving equity and equal opportunities, and developing the Moroccan school as a modern educational institution.
The study examines the core pillars of the Strategic Vision, including curriculum and program development, teacher and learner performance, effective leadership and change management, and the individual and societal development of learners, highlighting tangible achievements in educational policy.
Furthermore, the study compares the National Charter for Education and Training with the Strategic Vision 2015–2030, illustrating the progress and additions introduced by the Vision in structural and pedagogical reforms, and evaluating its alignment with the goals of the modern Moroccan school.
The study concludes that the success of the Strategic Vision depends on the continuous development of educational policies, the effective implementation of measures, and the active engagement of all stakeholders, ensuring comprehensive, effective, and integrated education that meets the aspirations of Moroccan society.
Keywords (English) :
Strategic Vision 2015–2030- Education Reform- Moroccan School National - Charter for Education and Training - Comprehensive Quality - Equity and Equal Opportunities - Leadership and Change Management-
Individual and Societal Development
على سبيل التقديم
شهدت المنظومة التعليمية المغربية منذ الاستقلال سلسلة من المحاولات الإصلاحية التي اتخذت أشكالًا متعددة، تراوحت بين المخططات القطاعية المحدودة والبرامج الاستعجالية، غير أن معظمها لم ينجح في تجاوز الاختلالات البنيوية التي يعاني منها النظام التربوي، مثل الهدر المدرسي، وتدني جودة التعلمات، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية. وقد أبانت هذه التجارب عن محدودية المقاربات الجزئية في إحداث التحول المطلوب.
في هذا المسار، يمكن اعتبار صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 لحظة مفصلية؛ إذ مثّل بمثابة دستور تربوي وضع المبادئ الكبرى والقيم المؤطرة لعملية الإصلاح. غير أن صعوبة التنزيل، وضعف آليات التتبع والتقييم، جعلت نتائجه دون الطموحات المعلنة. أما الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فهي تشكل وثيقة مرجعية جديدة جاءت تحت شعار: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وتطمح هذه الرؤية إلى إعادة بناء المدرسة المغربية وفق منظور شمولي يستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وينسجم مع التوجهات الكونية الكبرى وأهداف التنمية المستدامة 2030.
إن هذه الرؤية لا تُعد مجرد برنامج قطاعي مرحلي، بل هي مشروع مجتمعي متكامل يستهدف إعادة تأسيس المدرسة المغربية على قاعدة ثلاثية: الإنصاف في الولوج وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعلمات وجعل التربية رافعة للارتقاء الفردي والمجتمعي. ومع ذلك، يبقى التساؤل الإشكالي مطروحًا: هل تمكنت الرؤية الاستراتيجية من بلورة قطيعة فعلية مع اختلالات الماضي؟ وهل نجحت في اقتراح نموذج إصلاحي قابل للتنفيذ يضع المغرب على سكة التميز التعليمي في أفق 2030؟
بناءً على هذه الإشكالية، يسعى هذا البحث إلى تقديم قراءة تحليلية نقدية لكتاب الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وذلك من خلال:
أولا- تأطير المفاهيم المرتبطة بالرؤية التربوية والإصلاح التعليمي.
ثانيا - استعراض السياق المغربي الذي أدى إلى صياغة هذه الوثيقة.
ثالثا - تحليل محاورها الكبرى في ضوء الأدبيات التربوية الوطنية والدولية.
رابعا - رصد مواطن القوة والقصور في مضامينها.
خامسا - مقارنتها مع بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال إصلاح التعليم.
وتعتمد هذه الدراسة على مقاربة تحليلية-نقدية تستند إلى الوثائق الرسمية والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، مع توظيف منهج مقارن يسمح بتحديد موقع التجربة المغربية في خريطة الإصلاحات التربوية عالميًا، واستشراف إمكانات نجاحها أو تعثرها في أفق 2030.
المبحث الأول: تعريف الرؤية الاستراتيجية
تُعدّ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015-2030) وثيقة مرجعية ذات طابع
إصلاحي وتوجيهي، صاغها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة دستورية استشارية أحدثها الملك محمد السادس سنة 2014) (1) ( . وقد جاءت هذه الرؤية ثمرة لمسار تشاوري واسع أطلقته وزارة التربية الوطنية ما بين أبريل ويونيو 2014، انخرطت فيه مختلف الفعاليات التربوية والمهنية عبر الحوارات المحلية والجهوية والوطنية، فضلًا عن الاستنارة بالتجارب الدولية) . (2) (
وترتكز هذه الرؤية، من جهة أولى، على التوجيهات الملكية السامية وعلى المرجعيات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الميثاق الوطني للتربية والتكوين) (3) ( ومن جهة ثانية على التقرير الأول للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2015) ، الذي حدّد الاختلالات البنيوية للمنظومة التربوية ورسم معالم التحول المنشود ) (4) ( .
وقد بدأت عملية التفعيل العملي لهذه الرؤية من خلال إطلاق تدابير ذات أولوية) (5) (، قصد إرساء أسس مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي. وهي رؤية شمولية متكاملة، تتوزع إلى أربعة فصول كبرى وتتفرع إلى ثلاثٍ وعشرين رافعة إصلاحية، تروم جميعها إحداث نقلة نوعية في النظام التربوي المغربي وفق أفق يمتد إلى سنة 2030. ) (6) (
المبحث الثاني: الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 بين النظرية والممارسة في إصلاح المدرسة المغربية
تمثل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015-2030) نموذجًا متقدمًا لمحاولة المزج بين النظرية التربوية المعاصرة ومتطلبات التطبيق العملي على أرض الواقع. فقد حرص واضعوها على الاستناد إلى أحدث النظريات في إصلاح التعليم، لا سيما ما يتعلق بالتحول من منطق التعميم الكمي إلى منطق الجودة والإنصاف ) (7) (، واستحضار المقاربات البيداغوجية الحديثة التي تركز على المتعلم محور العملية التعليمية ) (8) ( .
سياق ظهور الرؤية الاستراتيجية
تضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية في إصدار الرؤية الاستراتيجية، إذ كانت تهدف إلى وضع خطة شمولية لمعالجة الاختلالات البنيوية في المنظومة التعليمية.
أولًا: المردودية الداخلية للمدرسة المغربية
شهدت المدرسة المغربية خلال السنوات السابقة مجموعة من الإشكالات الجوهرية، ومن أبرزها:
ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم الأساسية ) (9) ( .
. استمرار تزايد الهدر المدرسي.
ركود البحث العلمي وانخفاضه في السنوات الأخيرة ) (10) ( .
الفشل في تعليم اللغات وتمكين المتعلمين منها، خاصة لغة التدريس الرسمية واللغات الأجنبية، ما قلل من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
ثانيًا: المردودية الخارجية للمدرسة المغربية
شملت التحديات أيضًا البعد الخارجي، إذ شهدت المدرسة مجموعة من العراقيل التي أثرت على اندماج خريجيها في المجتمع وفي محيطهم الاقتصادي والثقافي، ومن أبرزها:
ضعف الاندماج الاجتماعي والثقافي والقيمي بالنسبة للخريجين التربويين ) (11) ( .
ضعف انفتاح المدرسة على محيطها الخارجي وعدم مواكبتها لتحولات البيئة المحلية والدولية) (12) (.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى إعادة طرح إشكالية جودة المدرسة المغربية، ليس فقط على مستوى المسؤولين، بل أيضًا لدى المهتمين بالشأن التربوي والمجتمع المدني، حيث أصبحت المدرسة مجرد هياكل فارغة من المناخ التربوي الفعّال.
وعليه، جاءت الرؤية الاستراتيجية كرد اعتبار شامل لشؤون المدرسة، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في أكتوبر 2014، وبتعيين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 14 ماي 2014 ) (13) ( ، بهدف انتشال المدرسة المغربية من وضعها الهش ومعالجة الاختلالات البنيوية على المستويين الداخلي والخارجي ووضع أسس متينة لإصلاح شامل ومستدام يمتد إلى أفق 2030.
- الرؤية الاستراتيجية بين النظرية والممارسة
تجمع الرؤية الاستراتيجية بين البعد النظري، من خلال اعتمادها على مبادئ إصلاح التعليم الحديثة وإدماج المقاربات البيداغوجية المعاصرة، وبين البعد التطبيقي عبر إطلاق تدابير وأولويات عملية تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز الإنصاف، كما لم تغفل الأبعاد المؤسساتية والهيكلية للإصلاح، بما في ذلك تعزيز الحكامة وتطوير آليات التتبع والتقييم وتنمية الموارد البشرية والتربوية ) (14) ( .
وبذلك، تمثل الرؤية استراتيجية شمولية قادرة على وضع خريطة طريق واضحة للانتقال بالمدرسة المغربية نحو مستويات أعلى من الجودة والإنصاف والارتقاء الفردي والمجتمعي ) (15) ( .
المبحث الثالث: وصف مشروع الرؤية الاستراتيجية
يشكل مشروع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 وثيقة محورية تهدف إلى إحداث تحول شامل ومستدام في منظومة التعليم المغربية. وتعكس هذه الوثيقة الحرص على الجمع بين الأسس النظرية للتربية الحديثة ومتطلبات التطبيق العملي، من خلال مقاربة شمولية تراعي جميع مكونات المدرسة المغربية، سواء على مستوى المتعلم أو الأستاذ أو الإدارة أو المجتمع المدني.
محتويات الكتاب
يتألف الكتاب من أربعة فصول رئيسية، تتضمن ثلاث وعشرين دعامة إصلاحية، بالإضافة إلى ملحقين توضيحيين، ويصل حجم الكتاب إلى خمس وثمانين صفحة ) (16) (. وتقدم هذه الفصول خريطة طريق متكاملة لتحقيق أهداف الإصلاح، بما يضمن تحسين جودة التعليم وتعزيز الإنصاف والارتقاء بالموارد البشرية.
المرجعيات والمبادئ التي تقوم عليها الرؤية الاستراتيجية
مرجعيات الرؤية
اعتمدت الرؤية الاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الأساسية، التي شكلت الأساس القانوني والمنهجي لتحديد أهدافها ومحتواها:
الخطابات الملكية، التي وضعت التوجيهات العليا للإصلاح التربوي وأكدت على أولوية تطوير المدرسة المغربية ) (17) (.
الميثاق الوطني للتربية والتكوين، باعتباره الإطار الدستوري والسياسي المنظم للوزارة ومسار إصلاح التعليم.
تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي قدمت تشخيصًا موضوعيًا للاختلالات التربوية ومقترحات للتحسين ) (18) (.
الدستور المغربي لسنة 2011، الذي ضمن مبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية والالتزام بالتعليم كحق لجميع المواطنين.
الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها، التي تحدد معايير الجودة والمساواة والحقوق التعليمية المعترف بها عالميًا ) (19) (.
الحوارات الجهوية والوطنية، التي ساهمت في تأهيل المدرسة المغربية عبر إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمجتمع المدني ) (20) (.
مبادئ الرؤية الاستراتيجية
تقوم الرؤية الاستراتيجية على مجموعة من المبادئ التوجيهية، والتي تتوافق مع المبادئ الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتشمل:
مبادئ حقوق الإنسان، لضمان تعليم منصف ومتساوي لجميع المتعلمين ) (21) (.
الهوية المغربية، من خلال ترسيخ القيم الوطنية والثقافية في المناهج التعليمية.
اعتماد المقاربة التشاركية في دعم الإصلاح، عبر إشراك جميع الهيئات والفاعلين في المدرسة المغربية وفق اختصاص كل جهة.
نظرة شمولية لمكونات المدرسة المغربية، تشمل المتعلم، الأستاذ، الإدارة، وأولياء الأمور) (22) ( .
احترام وترسيخ الثوابت الدستورية للأمة المغربية، بما في ذلك الدين، الوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي.
إعطاء الأولوية للمتعلم والأستاذ والتعلمات، لضمان تركيز الإصلاح على صميم العملية التعليمية ورفع جودة التعلمات.
تحليل المحاور الكبرى والرافعات الثلاث والعشرين
تقوم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 على أربعة محاور رئيسية، تتفرع إلى ثلاث وعشرين رافعة إصلاحية، تهدف جميعها إلى تحقيق تحول شامل ومستدام في المنظومة التعليمية المغربية) (23) ( .
المحور الأول: تطوير الجودة والإنصاف في التعليم
يركز على رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
يشمل تحسين المناهج والبرامج الدراسية، تحديث طرق التدريس، وإدماج التكنولوجيا الرقمية في التعلمات) (24) ( .
المحور الثاني: تطوير حكامة المنظومة التعليمية
يهدف إلى تعزيز الحكامة المؤسساتية وتفعيل آليات التتبع والتقييم، وضمان الشفافية والمساءلة.
يشمل تطوير القيادة المدرسية وتحفيز فرق العمل التربوي.
المحور الثالث: تنمية الموارد البشرية والتكوين المستمر
يركز على رفع كفاءة الأساتذة والموظفين الإداريين عبر برامج تكوين مستمر.
يشمل تكوين المتخصصين في اللغة والعلوم الأساسية والتقنيات الرقمية ) (25) (.
المحور الرابع: الانفتاح على المحيط وتطوير البحث العلمي
يتعلق بتوسيع انفتاح المدرسة على المجتمع والسوق العالمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار في التعليم) (26) (.
الرافعات الثلاث والعشرون
تمثل أدوات عملية لتنفيذ المحاور الاستراتيجية، وتشمل مجالات متعددة مثل: تحديث المناهج، تطوير البنية التحتية، تحسين التكوين الأولي والمستمر للأساتذة، إدماج التكنولوجيا في التعليم، تعزيز الحكامة، دعم البحث العلمي، وترسيخ القيم الأساسية لدى المتعلمين.
المبحث الرابع: دراسة تحليلية لكتاب الرؤية الاستراتيجية - محور تكافؤ الفرص في التربية والتكوين
الفصل الأول: من أجل مدرسة تكافؤ الفرص
الرافعة الأولىً: تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين
تؤكد الرؤية الإستراتيجية على ضرورة تمكين جميع الأطفال المغاربة من حقهم في التعليم الإلزامي في المرحلة الممتدة من سن 4 سنوات إلى 15 سنة، دون أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو الوضعية الاقتصادية للأسر. وتعمل الدولة على تعزيز آليات الدعم المادي للأسر المعوزة حتى لا تشكل الظروف الاقتصادية عائقاً أمام متابعة الأبناء للدراسة إلى غاية نهاية السلك الإعدادي) (27) (.
وتولي الرؤية الإستراتيجية أهمية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي والتربوي، مع التركيز على استثمار الشراكات المحلية والجماعية لتعبئة الجهود في مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي. كما تؤكد على دور مدرسة الفرصة الثانية التي تهدف إلى إعادة إدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة من خلال برامج تعليمية وتكوينية ملائمة، تمكّنهم من الاندماج السوسيو-مهني.
الرافعة الثانيةً: إلزامية التعليم الأولي وتعميمه
تسعى الرؤية الاستراتيجية إلى تمكين جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع وست سنوات من الولوج إلى التعليم الأولي، اعتماداً على نموذج بيداغوجي موحّد الأهداف ومتعدد الغايات ومتنوع الأساليب، بما يضمن تكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى للعملية التربوية) (28) (.
الرافعة الثالثة: التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص
تسعى هذه الرافعة إلى معالجة التفاوتات المجالية في الولوج إلى التربية والتكوين من خلال مقاربة شمولية تعتمد على الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص. وتستند إلى مبدأ الإنصاف الذي يشكل أحد مرتكزات الرؤية الاستراتيجية، حيث تُولي اهتمامًا خاصًا للمناطق التي تعاني من الخصاص في البنيات التحتية والخدمات التعليمية) (29) (.
فالبرغم أن هذه الرافعة تحمل وعيًا مهمًا بالمشاكل المجالية، إلا أن نجاحها يبقى رهينًا بوجود آليات حقيقية للتنفيذ والمتابعة. فالعديد من الشراكات تبقى حبيسة الخطاب دون التفعيل الميداني، إضافة إلى تحديات الموارد المالية التي قد تعيق التنفيذ الفعلي.
الرافعة الرابعة: تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة
تركّز هذه الرافعة على التربية الدامجة باعتبارها حقًا أساسيًا داعيةً إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية النظامية، مع تكوين الأطر التربوية لتمكينها من الاستجابة لهذه الحاجات الخاصة.
ويُعد هذا التوجه تقدميًا ويستجيب للمواثيق الدولية، لكنه يصطدم في الواقع بضعف الإمكانيات اللوجستية والبشرية، وعدم توفر برامج تكوين معمقة للمدرسين في مجال التربية الدامجة. ويُلاحظ أن مدارس قليلة فقط تتوفر على الشروط الحقيقية لاستقبال هؤلاء المتعلمين، مما يُفرغ هذا المبدأ من محتواه أحيانًا) (30) (.
الرافعة الخامسة: استدامة التعلم وبناء المشروع الشخصي والاندماج
تروم هذه الرافعة إتاحة التعلم مدى الحياة عبر مسارات متعددة تشمل التعليم النظامي والعتيق والتكوين المهني والتعليم العالي، إضافة إلى محاربة الأمية والتربية غير النظامية.
حيث تعكس هذه الرافعة وعيًا بأهمية تنويع العرض التعليمي، لكنها تفتقر إلى آليات تنسيق فعّالة بين هذه المسارات، مما يجعلها مشتتة وغير قادرة على ضمان تكامل حقيقي. كما أن التوجيه نحو سوق الشغل لا يزال ضعيفًا، وهو ما يقلل من قيمة المشروع الشخصي كمحفز للاندماج الاجتماعي والاقتصادي) (31) (.
الرافعة السادسة: تمكين المؤسسات من التأطير والتجهيز والدعم اللازم
تتمحور هذه الرافعة حول تحسين البنيات التحتية وتوفير الأطر التربوية والإدارية المؤهلة، مع إدماج الوسائل الديداكتيكية والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.
ورغم الطابع الشمولي لهذه الرافعة، تواجه المنظومة تحديات على مستوى التمويل المستدام، إذ لا تزال مدارس كثيرة تعاني من الاكتظاظ وضعف التجهيزات كما أن إدماج التكنولوجيا يحتاج إلى تكوين متواصل للأطر وإلى دعم مستمر وهو ما لا يزال بعيد المنال في كثير من المناطق) (32) (.
الرافعة السابعة: إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية
تسعى هذه الرافعة إلى جعل المدرسة فضاءً محفزًا عبر إدماج برامج الدعم التربوي للمتعثرين وتعزيز الدعم الاجتماعي لطلبة التكوين المهني.
وبالرغم من أن هذا التوجه يمثل محاولة لمعالجة ظاهرة الهدر المدرسي وضعف التحصيل، لكنه يحتاج إلى تغيير ثقافة المدرسة نفسها نحو مزيد من الشمولية والتفرد في الاستجابة للحاجات. إذ غالبًا ما يتم الاقتصار على حلول ظرفية دون بناء برامج دعم عميقة وشاملة) (33) (.
الرافعة الثامنة: التعليم الخاص شريك للتعليم العمومي
تعترف هذه الرافعة بدور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التعميم وتحقيق الإنصاف، لكنها تشدد على ضرورة التزامه بمبادئ المرفق العمومي والخضوع لآليات الفحص البيداغوجي والتدبيري المنتظم.
وعليه وبالرغم من أن إشراك القطاع الخاص قد يسهم في توسيع العرض التعليمي، إلا أن المخاطر المتعلقة بتكريس الفوارق الاجتماعية تبقى حاضرة. فالقدرة المالية للأسر تحدد جودة التعليم، مما قد يُعمّق الفجوة بين الفئات، ما لم تُفرض رقابة صارمة ومعايير موحدة للجودة
وهكذا يتضح من خلال تحليل هذه الرافعات أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 حاولت الجمع بين الإنصاف والجودة والتحديث، إلا أن نجاحها يتوقف على إرادة سياسية واضحة وموارد بشرية ومالية كافية وتقييم دوري صارم.
الفصل الثاني: من أجل مدرسة الجودة للجميع
الرافعة التاسعة: تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير
تؤكد الرؤية الإستراتجية على أن جودة التعليم تبدأ بالموارد البشرية، لذا تعطي الأولوية للرفع من جاذبية المهنة عبر تكوين أساس متين وتكوين مستمر وفعال وربط الترقي المهني بالكفاءات والإنجازات. هذا يتقاطع مع ما تؤكد عليه التقارير الدولية حول دور المدرس كعنصر مركزي في أي إصلاح تربوي ) (34) (.
نقد: الرؤية لم تحدد بدقة آليات جذب الكفاءات، كما لم تعالج إشكالات ضعف الحافزية وهجرة الأطر التعليمية، وهي معضلات معروفة في المنظومة المغربية.
الرافعة العاشرة: هيكلة أكثر انسجامًا ومرونة لمكونات المدرسة وأطوارها
ترى الرؤية ضرورة إحداث مسار للتعليم المهني ينطلق من الإعدادي، ودمج التعليم الأولي مع الابتدائي لتوحيد التوجه التربوي.
إذ على الرغم من أهمية هذا الدمج في بناء مسار تعليمي متكامل، فإن غياب البنيات التحتية الكافية وضعف تكوين الأطر المتخصصة في التعليم الأولي والمهني يمثل عائقًا أمام التنزيل الفعلي.
الرافعة الحادية عشرة: مأسسة الجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتكوين
تتمثل هذه الرافعة في تطوير آليات التنسيق بين القطاعات التعليمية المختلفة وتحديث نظام التوجيه والممرات البيداغوجية. كما تستهدف تطوير منظومة التوجيه المدرسي والتكوين المهني، مع إعادة هيكلة الممرات البيداغوجية التي يسلكها المتعلم داخل المنظومة التعليمية. فالممرات البيداغوجية تُعرَّف على أنها المسارات التعليمية المنظمة التي توجه المتعلم من مرحلة إلى أخرى، وتتيح له اختيار خيارات تعليمية وتكوينية مناسبة وفق ميوله وقدراته ) (35) (. وتشمل هذه المسارات التعليم النظامي والتكوين المهني والتعليم العالي وكذلك التعليم غير النظامي ما يضمن استدامة التعلم وتمكين المتعلم من بناء مشروعه الشخصي والاندماج الفعّال في المجتمع
حيث تركز هذه الرافعة على جانبي التوجيه والتخطيط للمسار التعليمي، ما يجعلها أكثر شمولية من الاكتفاء بتحديث نظام التوجيه فقط. فهي لا تقتصر على تقديم الاستشارات الأكاديمية للمتعلمين، بل تشمل تنظيم المسارات التعليمية بمرونة واستجابة لحاجياتهم المتنوعة، وهو ما يُعد من الركائز الأساسية لضمان فعالية التكوين ونجاعة التعليم في تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030
لكن وبالرغم من كل هذا يظل التحدي الأكبر هو غياب قاعدة بيانات موحدة، وضعف التنسيق المؤسسي بين وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، ما يجعل التوجيه غالبًا شكليًا لا استشرافيًا ) (36) (.
الرافعة الثانية عشرة: تطوير نموذج بيداغوجي قوامه التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار
تركز الرؤية الاستراتيجية هنا على تحديث المناهج والبرامج وتبني المقاربات البيداغوجية الحديثة، ووضع المتعلم محور العملية التربوية، والمدرس ميسر ومشرف على التعلمات ) (37) (.. كما تؤكد على تطوير الوسائط التعليمية والمكتبات المدرسية وإدماج التكنولوجيا وتخفيف كثافة البرامج وإعادة النظر في الإيقاعات الزمنية.
فالبرغم من أن هذا التوجه متقدم وينسجم مع نظريات التعلم البنائي والابتكار التربوي. غير أن الإشكال يبقى في غياب خطط تكوين فعالة للمدرسين وضعف الوسائل التقنية في المؤسسات خصوصًا بالعالم القروي.
تعكس هذه الرافعات وعيًا استراتيجيًا بأهمية الموارد البشرية والهندسة البيداغوجية والانفتاح على التكنولوجيا. غير أن تنزيلها يتطلب إرادة سياسية قوية وتمويلًا مستدامًا وتأطيرًا مؤسساتيًا فعالًا.
الفصل الثالث: من أجل مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع
يسعى هذا الفصل إلى تقديم قراءة نقدية وتحليلية للفرص والإمكانات التي توفرها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب (2015-2030) من خلال الرافعات 16-21، مع التركيز على تعزيز جودة التعليم وتمكين الفرد وتحقيق التكامل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ) (38) (.
الرافعة السادسة عشرة: ملائمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من الإدماج
تركز هذه الرافعة على مواءمة التعلمات والتكوينات مع متطلبات سوق الشغل واحتياجات التنمية الوطنية والعالمية ) (39) (.، بما يمكن المدرسة من تطوير كفايات عملية وابتكارية لدى المتعلمين.
فبينما تؤكد الرؤية على ربط التعليم بالاقتصاد، يظل التحدي الرئيسي في تحديد الأولويات بدقة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات التعليمية، خصوصًا بين الحضرية والقروية ) (40) (.
الرافعة السابعة عشرة: تقوية الاندماج السوسيو-ثقافي
تهدف هذه الرافعة إلى تعزيز الانفتاح الثقافي للمدرسة، وضمان نقل التراث الثقافي والحضاري المغربي مع الانفتاح على ثقافات أخرى ) (41) (.
حيث أن نجاح هذه الرافعة مرتبط بقدرة المدرسة على تجديد المناهج لتكون شاملة ومرنة بحيث تحترم الهوية الوطنية وتتيح التفاعل مع الثقافات العالمية ) (42) (.
الرافعة الثامنة عشرة: مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة
تؤكد هذه الرافعة على أن المدرسة يجب أن تكون فضاء لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، عبر المناهج والبرامج التعليمية ) (43) (.
فنجاح هذه الرؤية يعتمد على تدريب الأساتذة على مقاربة قيمية شاملة وربط التعليم بالقيم اليومية
للمتعلمين، إضافة إلى ضرورة وجود متابعة وتقييم مستمر.
الرافعة التاسعة عشرة: تأمين التعلم مدى الحياة والمساواة
تشجع هذه الرافعة على التعلم المستمر لكل الفئات العمرية مع التركيز على التعليم الحضوري والتعلم عن بعد والتكوين المهني والتقني، غير أن التحدي الرئيسي يكمن في كيفية توفير الموارد البشرية والمادية الكافية وفي كيفية ضمان جودة التعلم عن بعد خاصة في المناطق النائية ) (44) (.
الرافعة العشرون: الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة
تركز هذه الرافعة على تهيئة المدرسة لتكون فاعلة في اقتصاد المعرفة من خلال أربعة محاور رئيسية وهي كالآتي:
المحور الأول: تكنولوجيا الإعلام والتواصل
المحور الثاني :اللغات الأكثر استعمالًا عالمياً
المحور الثالث: البحث العلمي والابتكار التقني
المحور الرابع: التفوق والتميز الدراسي والتكويني ) (45) (.
غير أن التطبيق الفعلي لهذه الرؤية يحتاج إلى استثمارات في التكنولوجيا وتطوير مهارات المعلمين وتعزيز ثقافة البحث والابتكار منذ المستويات الأولى.
الرافعة الواحدة والعشرون: تعزيز توقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة
تسلط هذه الرافعة الضوء على ربط المدرسة بالنمو الاقتصادي الوطني عبر:
تعزيز الاستثمارات في التربية والتكوين ) (46) (.
إدماج التكنولوجيات الحديثة
التأهيل السوسيو-ثقافي والقيمي
تحقيق الإدماج الاقتصادي للمؤسسات التعليمية
إن التطبيق الناجح يتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تربط المدرسة بالاقتصاد، وتشجع الابتكار والاستثمار في الإنسان.
خلاصة الفصل الثالث: من أجل مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع (من الرافعة السادسة عشرة إلى الرافعة الواحدة والعشرين)
وكخلاصة يؤكد هذا الفصل على أن المدرسة المغربية مدعوة إلى الاضطلاع بدور مركزي في تحقيق النهضة المجتمعية والاقتصادية، من خلال جعل التعلمات والتكوينات في انسجام تام مع حاجات البلاد التنموية، بما يضمن تهييئ المتعلمين للانخراط المنتج في سوق الشغل وفي ديناميات التنمية. وفي السياق ذاته، تسعى المدرسة إلى تعزيز الاندماج السوسيو-ثقافي عبر جعلها فضاءً لترسيخ قيم الانفتاح والتعايش واحترام التنوع الثقافي واللغوي، بما يعزز الانتماء الوطني والهوية المغربية في تفاعلها الإيجابي مع القيم الكونية.
كما يبرز هذا الفصل أهمية إرساء مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة عبر إشاعة ثقافة الحقوق والواجبات وتربية الناشئة على مبادئ العدالة والحرية والمسؤولية المشتركة. ويوازي ذلك إرساء مفهوم التعلم مدى الحياة، بوصفه ركيزة أساسية لتجديد الكفايات وتطوير القدرات لمواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة.
ومن جهة أخرى، يتم التركيز على ضرورة الانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة، عبر تمكين المدرسة من مقومات الابتكار والإبداع والبحث العلمي، مما يجعلها قاطرة لإنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية. كل ذلك من شأنه أن يعزز تموقع المغرب ضمن البلدان الصاعدة، ويجعل المدرسة الوطنية أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالفرد والمجتمع على حد سواء.
الفصل الرابع: من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير
الرافعة الثانية والعشرون: تعبئة مجتمعية مستدامة
تشير الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 إلى أن نجاح أي إصلاح تعليمي رهين بتعبئة وطنية شاملة، حيث تم إعلان الفترة الممتدة بين 2015 و2030 كمدى زمني مخصص لتجديد المدرسة المغربية. هذه التعبئة تتطلب إشراك كل الفاعلين: الدولة والجماعات الترابية ومؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والأسرة والمجتمع المدني والمثقفين والفعاليات الفنية والإعلامية. ويظهر هذا التوجه في تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي اعتبرت المدرسة قضية مجتمعية لا يمكن فصلها عن التنمية الوطنية ) (47) (.
وبالرغم من أهمية هذا التوجه، تبرز تساؤلات حول مدى جاهزية المجتمع المدني والقطاع الخاص للانخراط الفعلي خاصة في ظل التفاوتات المجالية والبشرية بين الوسط الحضري والقروي. وتجارب التعبئة السابقة مثل برنامج "مدرسة النجاح" سنة 2009 أظهرت أن غياب رؤية تشاركية واضحة يحدّ من الفعالية ) (48) (. لذا فإن نجاح التعبئة يتطلب إرادة سياسية وآليات تحفيزية قوية لضمان الاستمرارية، لا الاكتفاء بالشعارات.
الرافعة الثالثة والعشرون: ريادة وقدرات تدبيرية ناجعة
تؤكد هذه الرافعة على ضرورة إرساء حكامة رشيدة في المنظومة التربوية، من خلال تعزيز القدرات التدبيرية والقيادية في مختلف مستويات المدرسة. ويستدعي هذا اعتماد آليات ريادة فعالة ومقاربات استباقية، وترجمة الرؤية إلى واقع ملموس. ويأتي هذا في انسجام مع ما نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل 31 بخصوص الحق في التعليم وواجب الدولة في تعبئة الوسائل الملائمة ) (49) (.
بالرغم من وضوح التوجه، يبقى التحدي في تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات عملية. إذ ما زالت بعض المؤسسات تعاني من البيروقراطية وضعف التنسيق، كما بيّنت تقارير المجلس الأعلى في تقييم برنامج إصلاح التعليم 2000-2013 ) (50) (. كما أن مفهوم الريادة يحتاج إلى تأهيل الكفاءات وتحفيز الموارد البشرية وضمان المرونة في اتخاذ القرار وهو ما تؤكد عليه أيضًا تجارب دولية مثل فنلندا وسنغافورة حيث ربطت جودة القيادة التعليمية بتحسن النتائج الدراسية.
وكخلاصة أولية يتضح أنه ومن خلال هاتين الرافعتين، يتضح أن الرؤية الاستراتيجية تراهن على الجودة والارتقاء بالمدرسة المغربية شكلًا ومضمونًا عبر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. لأن الهدف ه كله من هذا هو بناء منظومة تربوية حديثة وفعالة قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل معا مع اعتماد منهج التدرج بين المدى القريب والمدى البعيد. غير أن السؤال الجوهري الذي يفرض ذاته يظل قائمًا: ما موقع الميثاق الوطني للتربية والتكوين في هذه الإصلاحات؟ وما طبيعة العلاقة بين دعاماته ورافعات الرؤية الاستراتيجية ؟
كما تجدر الإشارة إلى أهمية الملحقين المرفقين بكتاب الرؤية الاستراتيجية: الأول يتناول مقتضيات الدستور المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والثاني يشرح المفاهيم المفتاحية.
الفصل الثاني: الإصلاح التربوي في المغرب بين الميثاق الوطني والرؤية الاستراتيجية
مقاربة تحليلية نقدية
يمثل الميثاق الوطني للتربية والتكوين إطارًا مرجعيًا شاملاً لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب، إذ يجسد توافق مختلف القوى الاجتماعية الحية على مشروع مجتمعي يسعى إلى تطوير منظومة التربية والتكوين وتجديدها على جميع الأصعدة والمستويات. ووفق قراءة تحليلية مقارنة، يمكن اعتبار الميثاق منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل مكونات وآليات ومعايير تهدف إلى إرساء مؤسسة تعليمية مؤهلة، قادرة على المنافسة والانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، مع مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتكييف التعليم مع الواقع الموضوعي الوطني والدولي ) (51) (.
حيث صدر الميثاق عن اللجنة المكلفة بالإصلاح في سنة 1999، وخصصت له عشرية كاملة لتحقيق الإصلاحات المقررة، مما أدى إلى تسمية الفترة بعشرية الميثاق الوطني. ويضم الميثاق ثلاث وثمانين صفحة مقسمة إلى قسمين أساسيين:
القسم الأول: والذي خصص للمبادئ الأساسية، حيث يشمل المرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين والغايات الكبرى المتوخاة منه وحقوق وواجبات الشركاء وسبل التعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح ) (52) (.
القسم الثاني: الذي خصص لمجالات التجديد ودعامات التغيير، حيث يضم هذا الأخير ستة مجالات رئيسية تتفرع إلى تسعة عشر دعامة للتغيير والتي تتناول مختلف جوانب تطوير التعليم من البنية التربوية إلى الموارد البشرية والتسيير والشراكة والتمويل.
ويهدف هذا التمهيد إلى تقديم قراءة تمهيدية تحليلية للمحتويات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، تمهيدًا لإجراء مقارنة دقيقة بينه وبين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، مع التركيز على أوجه الاختلاف والتقاطع بين كل منهما في سياق تطوير منظومة التربية والتكوين بالمغرب.
المبحث الأول: الإصلاحات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين
أولا- على سبيل التقديم
يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة أساسية لإصلاح النظام التعليمي بالمغرب، إذ يمثل تعاقدًا بين مختلف القوى الاجتماعية الفاعلة، بهدف وضع مشروع مجتمعي شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتمكين المؤسسات التربوية من الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي. ويعرف الميثاق بأنه منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل مكونات وآليات ومعايير صالحة لتجديد التعليم على جميع الأصعدة والمستويات بما يجعل المدرسة المغربية مؤهلة للمنافسة محليًا ودوليًا ومواكبة كل التطورات المعرفية والتكنولوجية ) (53) (.
وقد صدر الميثاق عن اللجنة المكلفة بالإصلاح التربوي عام 1999، وتم تخصيص عشرية كاملة لتنزيل إصلاحاته وأصبح ما يُعرف بعشرية الميثاق الوطني. ويضم الميثاق ثلاث وثمانين صفحة مقسمة إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول: المبادئ الأساسية، ويشمل المرتكزات الثابتة للمنظومة، الغايات الكبرى، حقوق وواجبات الشركاء، وآليات التعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح.
القسم الثاني: مجالات التجديد ودعامات التغيير، ويشمل ستة مجالات متفرعة إلى تسعة عشر دعامة للإصلاح.
تهدف هذه الوثيقة إلى تحليل شامل لكل هذه العناصر في ضوء التوجيهات السامية مع مقاربة مقارنة لاحقة مع الرؤية الاستراتيجية لإظهار أوجه التشابه والاختلاف في آليات الإصلاح والتجديد.
ثانيا - المبادئ الأساسية
أ. المرتكزات الثابتة
تشمل المرتكزات الثابتة مجموعة من القيم والمعايير التي يجب أن تقوم عليها منظومة التربية والتكوين، من أهمها:
- قيم العقيدة الإسلامية، باعتبارها إطارًا ثقافيًا وروحيًا.
- مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، كقيم كونية تضمن إشراك جميع الفاعلين واحترام الحريات الأساسية.
- مبادئ الملكية الدستورية بما يضمن التوافق مع النظام السياسي المغربي.
- مبادئ الهوية المغربية والأصالة والمعاصرة، لضمان حماية التراث الثقافي ومواكبة المستجدات العالمية.
- القيم المعرفية والأخلاقية، حيث يُلزم الأستاذ باحترام المعرفة ومراقبة الجودة والالتزام بأخلاقيات المهنة.
ب. الغايات الكبرى
تهدف الغايات الكبرى للميثاق إلى:
- تكوين مواطن صالح ومنتج، قادر على خدمة وطنه ومجتمعه.
- جعل المتعلم مركز العملية التعليمية، مع تعزيز قدراته المعرفية والمهارية.
- انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، لضمان تكامل التعلم مع الواقع المعيشي.
- التعليم والمعرفة: تزويد المتعلم بالمعارف الأساسية والضرورية للتأهيل الاجتماعي والاقتصادي.
- مواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي بما يتيح اندماج المدرسة في السياق الدولي المعاصر.
- التشبع بالقيم : ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية لتكوين شخصية متكاملة.
- إتقان اللغتين الرسميتين والانفتاح على اللغات الأجنبية، لتعزيز التواصل والتنافسية الدولية.
- تيسير سبل الانفتاح الثقافي، بما يضمن التعرف على ثقافات متعددة واحترام التنوع.
ثالثا- الترويج لإنجاح الإصلاح والتوجيهات السامية
تجسدت استراتيجية الميثاق في ترويج الإصلاح على كل المستويات الوطنية والدولية عبر:
- تخصيص عشرية كاملة لإصلاح التعليم وهو مؤشر على أولوية هذا الإصلاح وطنياً.
- وضع إصلاح التعليم كثاني أولوية بعد قضية الوحدة الترابية ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع التربوي.
- الترويج للمشروع في الملتقيات الدولية والمحلية لضمان مصداقية الإصلاح وتشجيع المشاركة الواسعة من مختلف الفاعلين.
- التوجيهات السامية الصادرة عن الملك التي توفر الإطار السياسي والتوجيهي لتنفيذ الإصلاحات وضمان انسجامها مع السياسات الوطنية العليا ) (54) (.
هذه التوجيهات السامية تمثل خريطة الطريق للإصلاح، وتضمن متابعة دقيقة لآليات التنفيذ وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يعزز جدية العملية الإصلاحية على الأرض.
رابعا- حقوق وواجبات الشركاء
يولي الميثاق الوطني أهمية خاصة للشركاء التربويين وخصوصًا المدرسين، حيث تحدد الوثيقة حقوقهم وواجباتهم بما يضمن:
- توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة.
- احترام أطر التشريع المدرسي.
- الالتزام بالمعايير التربوية والأخلاقية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خامسا- مجالات التجديد ودعامات التغيير
تنقسم مجالات التجديد في الميثاق إلى ستة مجالات رئيسية تغطي تسع عشر دعامة أساسية:
- المجال الأول: نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي
دعامة 1: تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب.
دعامة 2: التربية غير النظامية ومحاربة الأمية.
دعامة 3: السعي إلى أكبر تلاؤم بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي.
المجال الثاني: التنظيم البيداغوجي
دعامة 4: إعادة هيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين.
دعامة 5: التقويم والامتحانات.
دعامة 6: التوجيه التربوي والمهني.
المجال الثالث: الرفع من جودة التربية والتكوين
دعامة 7: مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية.
دعامة 8: تنظيم الفضاءات المدرسية والإيقاعات الزمنية.
دعامة 9: إتقان اللغتين الرسميتين والانفتاح على اللغات الأجنبية.
دعامة 10: استعمال التكنولوجيا ووسائل الإعلام.
دعامة 11: تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي.
دعامة 12: إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية والموازية.
المجال الرابع: الموارد البشرية
دعامة 13 و14: تحفيز الموارد البشرية وإتقان تكوينها وتحسين ظروف العمل ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والتربية.
المجال الخامس: التسيير والتدبير
دعامة 15: إقرار اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين.
دعامة 16: تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين المستمر.
دعامة 17: تنويع أنماط البنايات والتجهيزات، ملاءمتها لمحيطها، ترشيد استغلالها وحسن تسييرها.
المجال السادس: الشراكة والتمويل
دعامة 18: حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معايير وتسيير الاعتمادات.
دعامة 19: تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها.
سادسا- قراءة تحليلية للمبحث
فمن خلال قراءة نقدية للمبادئ والدعامات يمكن استخلاص ما يلي:
- التكامل بين المبادئ والغايات: جميع المبادئ والغايات الكبرى متكاملة حيث تربط بين التعليم
و التأهيل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي ) (55) (.
- الربط بين التوجيهات السامية والتنفيذ: يضمن وجود التوجيهات السامية متابعة دقيقة لتنفيذ الإصلاحات وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما يقلل من الهفوات السابقة في التخطيط والتنزيل.
- الشمولية والتدرج: يشمل الميثاق الوطني جميع المستويات من التمدرس والجودة والموارد البشرية والتسيير والتمويل مما يعكس رؤية متكاملة للإصلاح.
- الإطار التحفيزي للشركاء: من خلال تحديد الحقوق والواجبات وتحفيز الموارد البشرية حيث يضمن الميثاق التزام الفاعلين بتحقيق النتائج المرجوة.
. المبحث الثاني: مقارنة بين إصلاح الرؤية الاستراتيجية والميثاق الوطني للتربية والتكوين على مستوى التخطيط والتجديد
بعد استعراضنا للمرتكزات والمبادئ الأساسية التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يظهر جليًا أن العديد من الدعامات التي يؤطرها الميثاق تتقاطع مع رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح. فالغاية النهائية لكليهما تكمن في تعزيز الجودة والارتقاء بالمدرسة المغربية فضلاً عن إصلاح كل ما يتعلق بقطاع التربية والتعليم. ومع ذلك، فإن الفارق بينهما يظهر جليًا على مستوى التخطيط، ومنهجية التنفيذ وآليات التجديد وهو ما يتطلب تحليلًا نقديًا متأنيا.
أولًا: أوجه التشابه
الأساس الملكي للإصلاحات:
كلا الإصلاحين لكل من الميثاق الوطني والرؤية الاستراتيجية يستندان إلى خطاب ملكي سامٍ كمرجعية أساسية لتحديد الأولويات الوطنية. فقد جاء الميثاق استجابةً للخطاب الملكي بتاريخ فاتح الدورة التشريعية الثالثة سنة 1999، بينما تأسست الرؤية الاستراتيجية على عدة خطابات ملكية منها خطاب ثورة الملك والشعب (2012 و2013) وخطاب افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2014. ويُظهر هذا التشابه أن كلا الإصلاحين يعتمدان على السلطة العليا للبلاد لتحديد الأولويات، ما يضمن انسجام الإصلاحات مع الرؤية الوطنية الشاملة للبلاد ) (56) (.
الاهتمام بالجودة والارتقاء بالمدرسة المغربية:
يركز كل من الميثاق والرؤية على تحقيق مدرسة ذات جودة عالية، قادرة على تلبية متطلبات التنمية الشاملة. إذ يعتبر ضمان الجودة محورًا مشتركًا يربط بين التخطيط الاستراتيجي للميثاق والرؤية، ويعكس إدراك صناع السياسة التعليمية لأهمية تطوير الموارد البشرية والبنية التربوية ) (57) (.
الإصلاح كأولوية بعد الوحدة الترابية:
يظهر الاهتمام بإصلاح نظام التربية والتكوين باعتباره من الأولويات الوطنية الأساسية بعد استكمال الوحدة الترابية، وهو عامل مشترك بين الميثاق والرؤية. هذا الانسجام يعكس التوجه السياسي الوطني نحو الاستثمار في العنصر البشري كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيًا: أوجه الاختلاف
الإطار الدستوري والمرجعية القانونية:
أبرز الفروقات تكمن في السياق القانوني الذي أُنشئت فيه كل من المبادرتين. فالرؤية الاستراتيجية استفادت من مقتضيات دستور 2011، الذي يُعد المصدر الأعلى للتشريع في المغرب مما منح الإصلاحات الجديدة ميزة في التجديد والالتزام القانوني غير أنه وفي المقابل صدر الميثاق الوطني قبل دستور 2011، وبالتالي اعتمد على أسس قانونية أقدم ما حد من قدرته على تجاوز بعض الإشكالات البنيوية في القطاع التعليمي ) (58) (.
التخطيط الاستراتيجي وآليات التنفيذ:
تميل الرؤية الاستراتيجية إلى منهجية أكثر شمولية وديناميكية مقارنة بالميثاق. فهي لا تكتفي بوضع الأهداف العامة، بل تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، وآليات متابعة وتقويم دقيقة، وهو ما لم يكن متاحًا بشكل كامل في الميثاق. هذا التباين يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التخطيط الاستباقي والتنفيذ المبني على بيانات ومعايير علمية ) (59) (.
تجاوز الهفوات السابقة:
تحاول الرؤية الاستراتيجية معالجة النقائص التي أظهرها الميثاق سواء على مستوى التخطيط أو على مستوى تنزيل البرامج على أرض الواقع مما يشير إلى أن الرؤية ليست مجرد استمرارية للمبادئ السابقة بل محاولة نقدية لتطوير نموذج إصلاحي أكثر فعالية واستجابة للتحديات المعاصرة ) (60) (.
حيث يمكن القول إن الرؤية الاستراتيجية، بفضل سياقها الدستوري ومقترحاتها الأكثر دقة في التخطيط والتنفيذ تمثل محاولة للإصلاح الذكي والفعال الذي يستفيد من تجارب الميثاق الوطني السابقة. ومع ذلك، يبقى التحدي في مدى قدرة كل من الميثاق والرؤية على ترجمة الأهداف النظرية إلى نتائج ملموسة على مستوى التعلمات والمردودية المدرسية وهو ما يستدعي تقييمًا دوريًا مستندًا إلى مؤشرات الأداء النوعية والكمية. كما يبرز جليًا أن اعتماد الإصلاحات على الخطاب الملكي وحده، رغم أهميته الرمزية والسياسية لا يكفي لضمان الاستدامة إذا لم يُواكب بتقنيات التخطيط والتنفيذ العلمية والمبتكرة.
المبحث الثالث: تقييم وإعادة النظر في أوجه التشابه والاختلاف بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015–2030
إن مقارنة الإصلاحات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999) مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030 تظهر تفوقًا واضحًا للرؤية الاستراتيجية من حيث قابلية التنفيذ والمرونة الزمنية في الأهداف كما تكشف عن تقدم في أطر التخطيط والتجديد البيداغوجي وتنظيم منظومة التعليم برمتها.
أولا - الإطار الزمني وأولويات التنفيذ
تميزت الرؤية الاستراتيجية بوضع أهداف زمنية متدرجة:
المدى القريب (2015–2018) ،
المدى المتوسط (2018–2021) ،
المدى البعيد (بعد 2021) ،
وقد رافق هذا التقسيم صدور وثائق تحدد الأولويات والإصلاحات الأساسية لكل مرحلة ) (61) (. بالمقابل، جاء الميثاق الوطني في صياغة عامة وواسعة ولم يتمكن من تحقيق أهدافه إلا بعد صدور تقرير 2008 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أفضى إلى وضع المخطط الاستعجالي لإجرائه ) (62) (.
ثانيا - المتعلم والمدرس والمادة التعليمية
المتعلم: انتقل من كونه متلقيًا سلبيًا إلى محور العملية التعليمية، مشاركًا في بناء التعلمات، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في الرؤية والمثاق على حد سواء ) (63) (.
المدرس: أصبح موجهاً ومشاركًا في وضع البرامج الدراسية، وأحد عناصر المثلث الديداكتيكي ) (64) (.
المادة التعليمية: عمل الميثاق الوطني على ضبط معايير الكتب المدرسية وفق دفتر التحملات، مع فتح باب التباري بين لجان التأليف المختلفة، بينما عملت الرؤية الاستراتيجية على تنويع محتوى البرامج وتحسين جودة التدريس وفق معايير علمية وحديثة.
البيداغوجيا: تم الانتقال تدريجيًا من بيداغوجيا الأهداف التقليدية إلى بيداغوجيا الكفايات، وهو ما عززه الميثاق، فيما الرؤية استكملت هذا المسار بتطوير المناهج وتكييفها مع حاجيات القرن الواحد والعشرين ) (65) (.
ثالثا- إلزامية التعليم
نص الميثاق الوطني على إلزامية التعليم من سن ست سنوات إلى الخامسة عشرة، في حين وسعت الرؤية الاستراتيجية هذا الإطار ليشمل التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، مع التأكيد على ضرورة إعداد متعلم متكامل ) (66) (.
رابعا - اللغات في التعليم
اعتمد الميثاق اللغة العربية كلغة إلزامية مع مراعاة اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي، في حين أكدت الرؤية الاستراتيجية على إلزامية اللغتين العربية والفرنسية، وجعلت الأمازيغية لغة ثانية كما نصت على تنويع اللغات في التدريس لتحسين التحصيل الدراسي ) (67) (.
خامسا- تكوين الأطر والتنظيم البيداغوجي
أعادت الرؤية الاستراتيجية النظر في تكوين الأساتذة والمفتشين وتجديد مهن التربية والتكوين وتحديد الأدوار، في حين لم يولي الميثاق الوطني هذا الجانب اهتمامًا كافيًا ) (68) حيث أن الأطر التربوية، من مدرسين وإداريين تعد الفاعل المحوري في إنجاح مشاريع الإصلاح التربوي، باعتبارها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الارتقاء بجودة المدرسة وتجويد منظومة التعليم برمتها.
سادسا - اللغة القانونية في الوثيقتين
اتسمت لغة كل من الميثاق الوطني والرؤية الاستراتيجية باللغة القانونية الواضحة والدقيقة وهي لغة:دقيقة وواضحة وشاملة للمعلومات ومتوافقة مع النصوص القانونية السارية، ومحدودة الحجم لتكون مفهومة للمخاطب العادي، ومقيّدة لمعاني الجمل لتجنب التأويلات الخاطئة) (69) (.
وقد أشار ميشال ريفاتير إلى أن اللغة القانونية تنفصل عن اللغة العادية بوظيفتين أساسيتين: الأولى عملية للإشارة إلى الواقع، والثانية تركّز على الرسالة بوصفها غاية في ذاتها ) (70) (
وهكذا واستنتاجا لما سبق يمكن القول بأن الرؤية الاستراتيجية قد تجاوزت أغلب محدوديات الميثاق الوطني، سواء على مستوى الإطار الزمني أو التخطيط المرحلي أو تجديد المناهج أو اللغات المستخدمة، بالإضافة إلى الاهتمام بتكوين الأطر التعليمية. كما ساهمت لغة الرؤية الاستراتيجية القانونية الدقيقة في جعل الإصلاح أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ. هذا التقدم يعكس تحولًا نوعيًا في فهم الدولة المغربية لضرورة ربط الإصلاح التربوي بالحقوق والجودة والإنصاف، وهو ما لم يكن متحققًا بالشكل الكافي في الميثاق الوطني.
المبحث الثاني: مرتكزات الرؤية الاستراتيجية ومقارباتها المقارنة
أولا - تشخيص الواقع التعليمي المغربي وانبثاق الحاجة إلى إصلاح جديد
لقد شكّل التعليم في المغرب منذ الاستقلال إحدى القضايا المركزية التي ظلت حاضرة في الأجندة السياسية والاجتماعية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالتنمية الشاملة وبناء الدولة الحديثة. غير أنّ محاولات الإصلاح السابقة وفي مقدمتها الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999) والمخطط الاستعجالي (2009-2012) ، لم تُفض إلى النتائج المرجوة بسبب صعوبات التنزيل وضعف الحكامة، وغياب التتبع والتقييم الصارم للسياسات العمومية في هذا القطاع الحيوي) (71) ( .
وانطلاقًا من هذا التشخيص عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على إعداد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي جاءت استجابة لمجموعة من التحديات التي واجهت المدرسة المغربية في بدايات الألفية الثالثة. وقد ارتكزت هذه الرؤية على تقارير وطنية ودولية تؤكد تراجع المغرب في مؤشرات الجودة والإنصاف والمردودية، الأمر الذي استوجب صياغة استراتيجية بعيدة المدى تعالج الإشكالات البنيوية وتفتح آفاقًا جديدة للتطور.
ثانيا - مرتكزات الرؤية الاستراتيجية: الإنصاف، الجودة، والارتقاء
انطلقت الرؤية الاستراتيجية من ثلاثة مرتكزات أساسية ) (72) ( :
الإنصاف وتكافؤ الفرص: ضمان تعليم جيد لكافة الفئات، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الهشة والمناطق القروية.
الجودة للجميع: تحسين المناهج وتكوين الأساتذة وتجويد التعلمات وتوفير بيئة مدرسية محفزة.
الارتقاء الفردي والمجتمعي: اعتبار المدرسة فضاءً لبناء المواطن الفاعل والارتقاء بالمجتمع ككل.
وقد حسمت الرؤية الاستراتيجية في مسألة التناوب اللغوي، من خلال الجمع بين اللغات الرسمية (العربية والأمازيغية) والانفتاح على اللغات الأجنبية، معتبرة أن التعددية اللغوية خيار استراتيجي يواكب الانفتاح الحضاري للمغرب. هذا من جهة ومن جهة ثانية أكدت الرؤية أيضا على أهمية القسم الدراسي باعتباره النواة الصلبة للعملية التعليمية التعلمية، حيث يتم التفاعل بين المدرس والمتعلم والمناهج، لأجل تحديد مخرجات أي إصلاح تعليمي.
ثالثا - آليات التنزيل ومأزق التنفيذ
من أجل تجاوز عثرات الماضي، أحدث المجلس الأعلى للتربية والتكوين آلية مؤسساتية تضم رئاسة المجلس وأمانته العامة ووزراء القطاع ورؤساء اللجان الدائمة، مهمتها تتبع تنزيل الرؤية الاستراتيجية وتقييمها بشكل دوري. إلا أن أبرز تحدٍّ ظل مطروحًا هو الفجوة بين التصور والتنفيذ، حيث أن الإصلاحات غالبًا ما تبقى حبيسة الوثائق الاستراتيجية دون أن تصل إلى فضاء القسم حيث يوجد المتعلم. ولذلك، ركزت الرؤية على ضرورة مأسسة الإصلاح عبر تحويلها إلى قانون إطار ملزم لكافة الفاعلين، بغض النظر عن تغير الحكومات أو الوزراء) (73) ( .
رابعا - المقارنة مع التجارب الدولية
التجربة الفرنسية
تتميز فرنسا باعتمادها منذ عقود على مركزية القرار التربوي مع وجود وزارة قوية تشرف على البرامج والمناهج والتكوين. غير أن هذه المركزية أدت أحيانًا إلى بطء التكيف مع التحولات المجتمعية. في المقابل، استفادت الرؤية المغربية من التجربة الفرنسية في مجال توحيد المناهج والصرامة في تكوين المدرسين، لكنها حاولت تجاوز عائق المركزية المفرطة باعتماد المقاربة التشاركية والمشاورات الجهوية.
التجربة الأمريكية
تُعتبر الولايات المتحدة نموذجًا مغايرًا، حيث يسود اللامركزية التعليمية، إذ تمتلك كل ولاية صلاحيات واسعة في وضع المناهج وتنظيم الامتحانات. فما يمكن للمغرب أن يستفيد منه هنا هو تجربة المساءلة والتقييم المستمر للأداء المدرسي، وربط الدعم العمومي بنتائج المؤسسات. غير أن هذه التجربة تعاني من فجوات حادة في الإنصاف وهو ما حاولت الرؤية الاستراتيجية المغربية معالجته بجعل تكافؤ الفرص في صميم الإصلاح.
التجربة الفلندية والسويدية
تُعد فنلندا والسويد من أبرز النماذج الناجحة عالميًا، حيث تقوم أنظمتهما التعليمية على:
- جعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، مع منح استقلالية واسعة للمدرس.
- المساواة والإنصاف باعتبار التعليم حقًا أساسيًا للجميع.
- التقويم التكويني المستمر بدلًا من الامتحانات الموحدة الصارمة.
إن ما يميز هذه التجارب هو الثقة في المدرس، إذ يخضع لتكوين عالٍ ويُنظر إليه كفاعل مركزي في الإصلاح. وقد حاولت الرؤية الاستراتيجية المغربية الاقتراب من هذا النموذج عبر التشديد على أهمية تأهيل المدرس وإعادة الاعتبار له.
وهكذا ومن خلال هذه المقارنة يتضح أن الرؤية الاستراتيجية المغربية حاولت الجمع بين خصائص متعددة ولعل من أهمها: صرامة التكوين الفرنسية ومرونة التسيير الأمريكية، وإنصاف التجارب الاسكندنافية. غير أن التحدي الأكبر يظل متمثلًا في التنزيل الفعلي وتجاوز الهوة بين الوثيقة الإصلاحية والواقع الميداني.
فالمدرسة المغربية مطالبة اليوم ليس فقط بتلقين المعارف بل أيضًا بتربية المتعلمين على القيم ونبذ العنف ومواجهة الظواهر السلبية المنتشرة داخل المؤسسات، وهو ما يقتضي إعادة جاذبية المدرسة وتعزيز ثقة المجتمع فيها.
المبحث الثالث: خلاصات واستنتاجات
انطلقت الرؤية الاستراتيجية 2015–2030 من خلال تشخيص دقيق وتقييمي قامت به الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعدت تقريرًا مفصلًا عن المجهودات والمكتسبات التي تمت خلال عشرية الإصلاح (2000–2013) ، والتي شملت الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي، باعتباره محاولة لإصلاح التعثرات والصعوبات التي شابت هذه الفترة ) (74) ( .
وقد شكل هذا التقرير مرتكزًا أساسيًا لإعداد الرؤية الاستراتيجية، إلى جانب استماع المجلس الأعلى لمجموعة واسعة من التشاورات والاقتراحات لكافة الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، من أحزاب سياسية وشركاء ومؤسسات مدنية وجمعيات وهيئات المجتمع المدني، لتحديد الأولويات والإصلاحات المطلوبة.
أولا- السياق الوطني والدولي
ظهرت الرؤية الاستراتيجية في مرحلة دقيقة على المستوى الوطني والدولي، حيث شهد العالم أحداث ما يسمى بالربيع العربي (2011) ، بينما حافظ المغرب على استقرار سياسي واجتماعي بفضل حنكة القيادة الملكية والإجماع الشعبي، ما أتاح التركيز على الإصلاحات الداخلية المهمة خاصة في قطاع التعليم. كما شكل دستور 2011 قطيعة مع الماضي وأسس لمجموعة من المبادئ الجديدة المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ما فرض على المجلس الأعلى إعداد خريطة طريق واضحة للإصلاح، لتتمكن المملكة من تحسين ترتيبها الدولي في المجالات التعليمية والعلمية) (75) ( .
ثانيا- المقومات الأساسية للرؤية
انطلقت الرؤية الاستراتيجية على أساس أربعة مرتكزات رئيسية:
الإنصاف وتكافؤ الفرص: يشكل مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص أحد المرتكزات الجوهرية للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين. وفي هذا السياق، يقتضي الإصلاح ضمان وصول التعليم الجيد إلى جميع الفئات الاجتماعية دون استثناء، بما في ذلك الفئات الهشة والمناطق القروية، باعتبارهما الفضاءين الأكثر عرضة لتفاوتات بنيوية تحول دون تحقق العدالة التعليمية. ومن ثَمّ، فإن تجاوز مظاهر الإقصاء والحرمان يستلزم سياسات عمومية مندمجة قادرة على رفع العوائق السوسيو اقتصادية والجغرافية التي ما زالت تحد من تعميم الإنصاف في الولوج إلى فرص التعلم. ) (76) (
الجودة الشاملة: تُعتبر الجودة الشاملة ركيزة مركزية ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إذ تهدف إلى رفع مستوى التعليم من خلال تطوير المناهج والمقررات الدراسية، وتحسين أداء المدرس والمتعلم على حد سواء. ويستلزم هذا التوجه اعتماد معايير علمية دقيقة وتطبيق استراتيجيات تربوية حديثة، بما يضمن تحقيق نتائج تعليمية فعالة ومستدامة، ويعزز قدرة النظام التعليمي على الاستجابة لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ) (77) (
الارتقاء الفردي والمجتمعي: يشكل الارتقاء الفردي والمجتمعي ركيزة أساسية ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث يركز هذا التوجه على تطوير مهارات المتعلم وتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع. ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة تشجع على التفكير النقدي والإبداعي، وتزود المتعلم بالأدوات والقدرات اللازمة لمواجهة تحديات الحياة والمساهمة بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يعزز هذا التوجه دور التعليم في بناء مواطنين مسؤولين وفاعلين قادرين على المشاركة الإيجابية في مجتمعهم والمساهمة في رقي وازدهار وطنهم مما يضمن تكامل الإصلاحات التعليمية مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أثر ملموس على الفرد والمجتمع على حد سواء ) (78) (
ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير: تشكل هذه الأخيرة ركيزة أساسية ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث تهدف إلى ضمان فعالية الإصلاحات وكفاءتها عبر اعتماد مقاربة تشاركية واستراتيجية لتسيير الموارد والإصلاحات. ويعتمد هذا التوجه على إشراك جميع الفاعلين المعنيين، من أساتذة وإداريين ومجتمع مدني، في صياغة وتنفيذ السياسات التعليمية، بما يعزز الالتزام المشترك ويضمن استدامة النتائج. كما يُسهم التدبير الجيد للتغيير في تحسين كفاءة الموارد وتنسيق الإصلاحات، بما يتيح تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الابتكار والمسؤولية على مستوى النظام التربوي ككل) (79) (
ثالثا- التحليل النقدي لإكراهات التنزيل
رغم وضوح الرؤية الاستراتيجية وتفصيل أهدافها إلا أن تنزيل الإصلاحات على أرض الواقع واجه عدة إكراهات لعل من أهمها ما يلي :
ضعف الربط بين التخطيط والتنفيذ: حيث تبقى معظم المشاريع الإصلاحية على مستوى التصورات والوثائق، ولا تصل إلى الفصول الدراسية وبالتالي لا يستفيد منها المتعلم بشكل كامل) (80) (
تفاوت التوزيع الجهوي والموارد: بعض الأكاديميات والجهات تواجه نقصًا في الموارد البشرية والمادية، الشيء الذي يحد من قدرة المؤسسات على تطبيق الإصلاحات) (81) (
الفصل الدراسي كالنواة الأساسية: بالرغم من أن الرؤية أولت اهتمامًا كبيرًا بالثالوث التربوي (المعلم، المتعلم، المنهاج) ، إلا أن التطبيق العملي يتطلب تأهيل المدرسين بشكل مستمر وتوفير وسائل التدريس الحديثة) (82) (
الأوضاع السلوكية في المؤسسات التعليمية تشير الأوضاع السلوكية الراهنة في المؤسسات التعليمية إلى انتشار بعض الظواهر السلبية، بما في ذلك العنف والمخدرات والنزاعات بين التلاميذ داخل الفصول، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في البيئة المدرسية والعمل على استعادة جاذبية المدرسة المغربية وتعزيز مكانتها وقيمتها وهيبتها وسمعتها المرموقة. ويتطلب ذلك تبني استراتيجيات فعّالة لتقويم السلوك التربوي وتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، قادرة على دعم التعلم الفعّال وتعزيز الانضباط والمسؤولية الفردية والجماعية) (83) (
رابعا - التدابير والإصلاحات المقترحة
استجابت الرؤية الاستراتجية لهذه الإكراهات عبر مجموعة من التدابير:
- تطوير تكوين الأطر التربوية، وإعادة النظر في الأدوار والوظائف داخل المنظومة.
- اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين في الميدان، من أكاديميات ولجان وهيئات المجتمع المدني.
- اختيار اللغات: اعتماد الرؤية الاستراتيجية اللغتين العربية والأمازيغية كلغات رسمية، والانفتاح على اللغات الأجنبية بمبدأ التناوب اللغوي وهو تقدم نوعي مقارنة بالميثاق الوطني.
- التركيز على المتعلم كمحور العملية التعليمية التعلمية، لضمان مشاركة فاعلة وتمكينه من تطوير مهاراته الفردية) (84) (
- آليات التقييم والمتابعة: إحداث لجنة دورية تضم رئيس المجلس الأعلى والأمين العام والوزراء ورؤساء اللجان، لتقييم ما تم انجازه ومعالجة مواطن الخلل) (85) (
- الضمان القانوني للرؤية: اقتراح تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى قانون إطار لضمان استمراريتها مهما تغيرت الحكومات) (86) (
واستنادًا إلى ما تم عرضه أعلاه تتضح مجموعة من الخلاصات الرئيسة والجوهرية التي يمكن استخلاصها من هذا المبحث.:
أولا- الرؤية الاستراتيجية تستند إلى تشخيص دقيق للمرحلة السابقة، وتعمل على تجاوز ثغرات الميثاق والمخطط الاستعجالي، مع التركيز على الجودة والإنصاف والتطوير المستدام.
ثانيا- المقاربة التشاركية واعتماد الرقمنة وتكوين الأطر المتواصل يمثل عامل نجاح أساسي - للرؤية في تحسين التعليم المغربي ورفع مكانته دوليًا.
ثالثا- نجاح الرؤية الاستراتيجية في دمج البعد القيمي والسلوكي للمدرسة، مع التأكيد على التعليم على القيم ونبذ كل أشكال العنف والظواهر السلبية داخل المؤسسات التعليمية.
رابعا- تحديات التطبيق العملي ما زالت قائمة وتتطلب تكثيف الجهود لضمان أن تصل الإصلاحات إلى الفصول الدراسية وتحقق الفائدة المباشرة للمتعلم.
وهكذا يمكن اعتبارهذا المبحث بمثابة خلاصة نقدية للرؤية الاستراتيجية التي تجمع بين التشخيص والتحليل واستشراف مستقبل الإصلاح التربوي وتوضح مدى قدرة الرؤية على تجاوز ثغرات الميثاق والمخطط الاستعجالي مع إبراز أهم نقاط القوة والضعف، وإتاحة قاعدة صلبة للانتقال إلى الخاتمة التي ستلخص كل نتائج هذا البحث وهذه الدراسة النقدية وتبرز أهم الاستنتاجات والتوصيات العملية للارتقاء بالمنظومة التعليمية المغربية.
على سبيل الختم
نخلص في نهاية البحث إلى أن الرؤية الاستراتيجية 2015–2030 جاءت لرد الاعتبار إلى المدرسة المغربية والنهوض بقطاع التعليم، باعتباره المجال الخصب الذي تتكامل فيه باقي المجالات الأخرى
لاسيما التعليم الابتدائي حيث أنه في هذه الصفوف الابتدائية يُصاغ مستقبل الأستاذ والطبيب والمهندس والقاضي والعالم والفيلسوف، فالتعليم هو بؤرة الإبداع ومركز المواهب والطاقات التي تساهم في تقدم المجتمع. لذلك، كان من الضروري لكل غيور على مستقبل بلاده، ولكل من يأمل في التطور، أن يسعى إلى تعزيز مكانة التعليم وإعطاء قيمة للمعلم، فهو المربي والمرشد والقدوة والموجه والذي يحمل رسالة علمية وتربوية وأخلاقية تهدف إلى غرس قيم المواطنة والخلق السليم. فنجاح المعلم يعكس نجاح المجتمع وفشله يؤدي إلى فقدان جيل جديد قادر على العطاء والإبداع، مما يجعل المدرسة المغربية مركزًا استراتيجيًا للإصلاح المجتمعي.
وقد عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين على تجاوز عقبات الإصلاحات السابقة والاستفادة من هفوات الميثاق الوطني والمخطط الاستعجالي، ليخرج لنا رؤية استراتيجية تمكننا من استشراف واقع التعليم بمنظار جديد يجعلنا نتطلع لغد أفضل. لكن يبقى السؤال المطروح: هل ستكرر التجارب السابقة نفسها أم أن هذه الرؤية تحمل شعلة التغيير لإعادة المدرسة المغربية إلى جاذبيتها ورونقها وقيمتها التي اندثرت على مر السنين ؟
وبالمقارنة مع التجارب الدولية نخلص إلى ما يلي:
أولا - فنلندا والسويد:
ركزت هذه الدول على التعليم الشامل والمجاني والجودة العالية للمعلمين مع منحهم استقلالية كبيرة في إدارة الفصول الدراسية، ما انعكس إيجابيًا على تحصيل المتعلمين ورضاهم الدراسي.
ومن خلال المقارنة مع الرؤية الاستراتيجية المغربية، نجد أن المغرب بدأ يتحرك نحو هذا النموذج الأوروبي عبر تعزيز تكوين المعلمين، وتبني مناهج حديثة، وتشجيع البيداغوجيا النشطة التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية .
ثانيا - فرنسا:
التعليم الفرنسي يعتمد على مناهج موحدة ودقيقة مع رقابة مركزية صارمة حيث يولي اهتمامًا خاصًا لتطوير المعرفة العامة والثقافة الأكاديمية.
حيث استعادت الرؤية الاستراتيجية المغربية هذا المبدأ جزئيًا من خلال تنظيم المناهج الدراسية ووضع معايير دقيقة للكتب المدرسية، لكنها أضافت عنصر المشاركة المحلية والجهوية، ما يجعلها أكثر مرونة مقارنة بالنموذج الفرنسي التقليدي.
ثالثا - الولايات المتحدة الأمريكية:
يعتمد النظام الأمريكي على التقييم المستمر والابتكار التعليمي والتكنولوجيا التعليمية، مع منح حرية كبيرة للولايات في وضع سياسات التعليم.
و تحاكي الرؤية المغربية هذا النموذج جزئيًا من خلال آليات المتابعة والتقييم الدورية واعتماد المقاربة التشاركية بين جميع الفاعلين، لكنها تواجه تحديات تنفيذية أكبر نظرًا للفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة.
وكاستنتاج نهائي لهذه الدراسة والقراءة النقدية والتحليلية لكتاب الرؤية الاستراتيجية يمكن القول إن الرؤية الاستراتيجية المغربية تمثل محاولة جادة لتجاوز أخطاء الماضي وجعل المدرسة المغربية مركزًا للإبداع والتربية على القيم، مع الاهتمام بجودة التعلم وإنصاف الفرص. ومع ذلك، يبقى التنفيذ العملي على الأرض هو المقياس الحقيقي لنجاح هذه الرؤية، فالرؤية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع سياسات داعمة واستثمارات مستمرة في الموارد البشرية والمادية.
وهكذا نأمل أن يكون هذا البحث قد أضاف لبنة جديدة في الدراسات المتخصصة حول إصلاح التعليم في المغرب وقدم تحليلًا نقديًا ومقارنًا مع التجارب الدولية، ليكون مرجعًا للمطلعين والباحثين على حد سواء، مع إبراز مسار الإصلاح المغربي المتميز ضمن السياق العالمي.
***
د. منير محقق - كاتب وناقد وباحث جامعي
................................
الهوامش
(1) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير إنشاء الهيئة الدستورية الاستشارية، الرباط، 2014.
(2) وزارة التربية الوطنية، محضر المشاورات الوطنية حول الرؤية الاستراتيجية، الرباط، 2014.
(3) الملك محمد السادس، التوجيهات الملكية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، 2010.
(4) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التقرير الأول حول الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الرباط، 2015.
(5) وزارة التربية الوطنية، تقرير حول التدابير ذات الأولوية لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، الرباط، 2016.
(6) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، الرباط، 2015.
(7) UNESCO, Education for All Global Monitoring Report, Paris, 2015.
(8) وزارة التربية الوطنية، التقرير الأول للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الرباط، 2015.
(9) وزارة التربية الوطنية، التقرير التشخيصي حول مستوى التمكن من اللغات والمعارف والكفايات الأساسية في المدارس المغربية، الرباط، 2014.
(10) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير حول ركود البحث العلمي في المغرب، الرباط، 2014.
(11) وزارة التربية الوطنية، تقرير حول اندماج الخريجين التربويين في المجتمع، الرباط، 2014.
(12) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير حول انفتاح المدرسة المغربية على محيطها المحلي والدولي، الرباط، 2015.
(13) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، الرباط، 2015.
(14) وزارة التربية الوطنية، خطة التدابير ذات الأولوية لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، الرباط، 2016.
(15) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، الرباط، 2015.
(16) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، الرباط، 2015.
(17) Mohammed VI, Discours Royaux sur l’Éducation, Rabat, 2014.
(18) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقارير المجلس الأعلى حول التشخيص التربوي، الرباط، 2014-2015.
(19) UNESCO, Convention on the Rights of the Child, Paris, 1989.
(20) وزارة التربية الوطنية، تقرير حول الحوارات الجهوية لتأهيل المدرسة المغربية، الرباط، 2014.
(21) وزارة التربية الوطنية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، 2000.
(22) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الرباط، 2015.
(23) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، الرباط، 2015.
(24) وزارة التربية الوطنية، تقرير تطوير المناهج والبرامج الدراسية، الرباط، 2015.
(25) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برنامج تكوين الأساتذة في اللغات والعلوم الأساسية، الرباط، 2016.
(26) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير حول الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، الرباط، 2015.
(27) العربي السليماني، المعين في التربية، ص. 80.
(28) المصدر نفسه، ص. 81.
(29) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. (2015) . الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. الرباط: CSEFRS، ص. 41-42.
(30) (SNRT News. (2023. التربية الدامجة: التحديات والرهانات. استرجع من
https://snrtnews.com/article/37854
(31) مجلة المعارف التربوية. (2022) . التكوين المهني ومسارات التعلم مدى الحياة.
(32) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرجع نفسه، ص. 49-.51
(33) المرجع نفسه، ص. 54
(34) OECD. Education Policy Outlook 2019: Working Together to Help Students Achieve their Potential. Paris: OECD Publishing, 2019
(35) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. (2015) . الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. الرباط: CSEFRS، ص. 60-61.
(36) Fullan, M. The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press, 2016
(37) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. الرباط، 2015.
(38) Ministère de l’Éducation Nationale, 2015, p. 42
(39) UNESCO, 2015, p. 88
(40) Ministère de l’Éducation Nationale, 2015, p. 44
(41) Bourdieu & Passeron, 1977, p. 23
(42) Ministère de l’Éducation Nationale, 2015, p. 51
(43) Ministère de l’Éducation Nationale, 2015, p. 63
(44) UNESCO, 2015, p. 95
(45) Bourdieu & Passeron, 1977, p. 45
(46) Ministère de l’Éducation Nationale, 2015, p. 80
(47) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، الرباط، 2015، ص. 10-12
(48) وزارة التربية الوطنية، تقرير تقييم برنامج مدرسة النجاح 2009-2012، الرباط، 2013.
(49) المملكة المغربية، دستور 2011، الفصل 31.
(50) المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقرير التقييم المرحلي لإصلاح التعليم 2000-2013، الرباط، 2014.
(51) وزارة التربية الوطنية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، 1999، ص. 12
(52) حمداوي، ج.، مدخل إلى الإصلاح التربوي بالمغرب: قراءة تحليلية مقارنة، الرباط، 2005، ص. 45.
(53) حمداوي، ج.، مدخل إلى الإصلاح التربوي بالمغرب: قراءة تحليلية مقارنة، الرباط، 2005، ص. 45.
(54) المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقرير تتبع تنفيذ الميثاق الوطني، الرباط، 2003، ص. 14-18
(55) بلحاج، م.، الإصلاح التربوي بين النظرية والتطبيق: تجربة المغرب، الدار البيضاء، 2010، ص. 102-110.
(56) الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الثالثة، أكتوبر 1999؛ خطاب ثورة الملك والشعب، 2012 و2013؛ خطاب افتتاح الدورة التشريعية 2014.
(57) وزارة التربية الوطنية المغربية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، 1999..
(58) دستور المملكة المغربية، 2011، الفصول المتعلقة بالتربية والتكوين.
(59) . Benmoussa, R. (2017) . Planification stratégique et gouvernance de l’éducation au Maroc. Rabat: Publications du Ministère.
(60) . Ministère de l’Éducation nationale (2015) . Vision stratégique de réforme du système éducatif 2015–2030. Rabat: Éditions officielles
(61) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2015، ص. 12–15.
(62) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير 2008 حول تقييم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، 2008، ص. 34–36
(63) وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرباط، 1999، ص. 22–25.
(64) سعيد حليم، تطوير الكتب المدرسية والمعايير البيداغوجية، الدار البيضاء: دار المعارف، 2010، ص. 78–80.
(65) لحسن اللحية، بيداغوجيا الكفايات وإصلاح التعليم بالمغرب، الرباط: مطبعة النجاح، 2012، ص. 41–44.
(66) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرجع نفسه، ص. 60–62
(67) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المرجع نفسه، ص. 70–73.
(68) يونس محمد، إصلاح التعليم بالمغرب: رهانات وتحديات، الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 2018، ص. 45–47.
(69) رامان سلدن، ميشال ريفاتير، النظرة الأدبية المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر، 1998، ص. 179.
(70) المرجع نفسه، ص. 180–182.
(71) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير تقييمي لعشرية الإصلاح 2000-2013.
(72) المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
(73) كلمة عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أمام جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تقديم الرؤية الاستراتيجية
(74) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقرير عشرية الإصلاح 2000–2013، الرباط، 2014، ص. 5–12
(75) عبد اللطيف جراد، الربيع العربي والسياسات التعليمية في المغرب، الدار البيضاء: مطبعة النجاح، 2015، ص. 34–36.
(76) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015–2030، الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2015، ص. 12–15.
(77) المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015–2030، الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 2015، ص. 22–25.
(78) يونس محمد، إصلاح التعليم بالمغرب: رهانات وتحديات، الدار البيضاء: دار النشر المغربية، 2018، ص. 41–44.
(79) المرجع نفسه، ص. 50–52.
(80) المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقرير تقييم الرؤية الاستراتيجية 2018، الرباط، 2018، ص. 33–36.
(81) المرجع نفسه، ص. 38–40.
(82) سعيد حليم، تطوير الأداء التربوي في المغرب، الرباط: دار المعارف، 2016، ص. 60–63.
(83) مقابلات مع أطر تربوية من أساتذة وإداريين، الرباط، 2019.
(84) المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية 2015–2030، ص. 33–35.
(85) المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقرير المتابعة السنوي للرؤية 2017، الرباط، 2017، ص. 12–15.
(86) كلمة السيد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في تقديم الرؤية لصاحب الجلالة، الرباط، 2015.