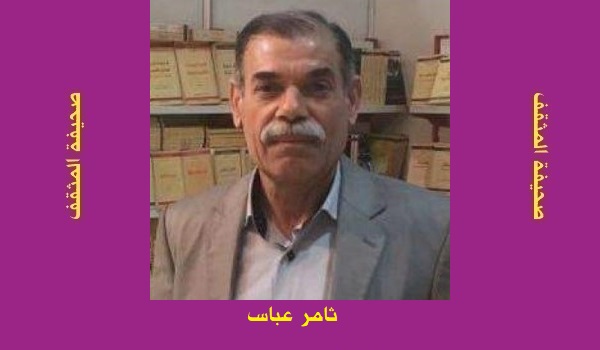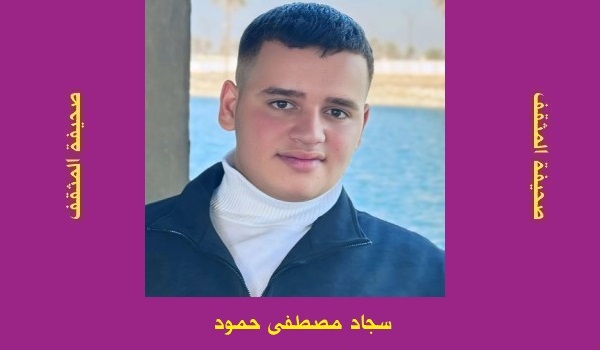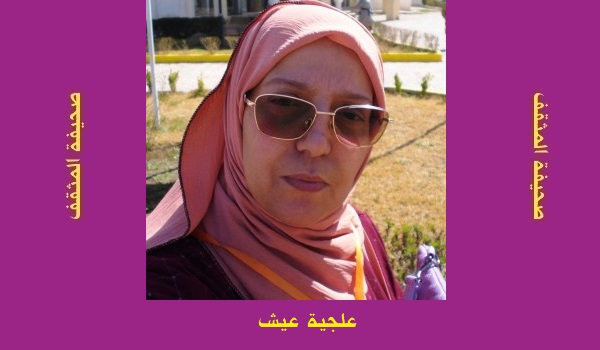تأطير الإشكالية الفلسفية: يُعدّ التحول من الثقافة الشفوية إلى الثقافة المكتوبة أحد أبرز التحولات التي شهدها تاريخ الفكر الإنساني، وهو تحول لا يقتصر على كونه مجرد تطور تقني في وسيلة حفظ المعلومات ونقلها، بل هو تحول جوهري في بنية المعرفة، ودور الذاكرة، وطبيعة السلطة. يهدف هذا التحليل إلى تتبع الخط الزمني والفلسفي لهذه الظاهرة، وإظهار تأثير الانتقال من السرد الشفوي المرن إلى النص المكتوب الثابت الذي منح النص سلطة مرجعية جديدة، وحوّله إلى "كيان مقدس". نتيجة لهذه السلطة، ظهر مفهوم "الجهل المقدس" كآلية لحماية النص من النقد والتحليل، في علاقة جدلية تترسخ مع تزايد سلطة النص المكتوب.
الفرضية الأساسية التي تقوم عليها هذ المقالة هي أن عملية التدوين ليست محايدة، بل هي عملية تقنين وتثبيت للمعلومة، مما يمنحها قوة وسلطة لم تكن تمتلكها في الحالة الشفوية. هذا التثبيت هو الذي يجعل النص المكتوب مرجعًا نهائيًا، ويُحْدِث تحولًا جذريًا في طبيعته من عملية حية وديناميكية إلى كيان ثابت ومُقنَّن.
الجدل التاريخي الذي يدور حول تأليف ملحمتي الإلياذة والأوديسة. هو ليس مجرد خلاف حول هوية المؤلف، بل هو انعكاس عميق للصراع الفلسفي بين الفكرة الفردية للعبقرية والتراكم الجماعي للمعرفة.
الوحدويون: هم من يعتقدون أن الملحمتين هما عمل مؤلف فردي عبقري واحد، وهو الشاعر "هوميروس". يشددون على أن الوحدة الدرامية والوحدة الفنية والنفسية للنص لا يمكن أن تكون إلا نتاج عقل واحد. كما يجادلون بأن هذه الملاحم لم تكن أقدم المؤلفات المكتوبة في بلاد الإغريق. هذا التوجه يميل إلى تقديس المؤلف الفردي ويمنح العمل الأدبي سلطة وقداسة نابعة من عبقرية مبتكره.
المحللون (السياقيون) يذهبون إلى أن الملحمتين هما حصيلة تراكم سردي شفوي طويل الأمد، تطور على يد مجموعة من الشعراء الرواة (الآيدوس) على مر العصور قبل أن يُدوّن في صيغته النهائية. يرى هذا التيار أن "هوميروس" قد يكون اسمًا جماعيًا يمثل هذا التراث الشفوي، أو اسمًا للشخص الذي قام بتجميع هذا الإرث الأدبي الهائل وتنظيمه في شكله الحالي، وليس مبتكرًا له من العدم. كان المحللون ينظرون إلى النصوص الأقرب زمنيًا للأعمال الهومرية على أنها المصادر الأولية التي عمل منها "هوميروس". (جدلية الشعر الجاهلي وقضية امرؤ القيس)
إن وجود هذا الجدل الحاد يعكس الصراع بين الرغبة في نسبة الإبداع إلى عبقري فردي، مما يمنح النص سلطة وقداسة خاصة، والوعي بأن المعرفة هي نتاج تراكم جمعي ومستمر. هذا الصراع يمثل تمهيدًا لفهم "سلطة النص" في السياقات اللاحقة، خاصةً الدينية منها، حيث يصبح النص المدوّن هو المرجع الأوحد للنقاء والصدق.
الشفاهية والكتابة في السياق الهومري
في الثقافة الشفوية، كان السرد مرنًا، وقابلًا للتغيير والتكيف مع كل عملية أداء، ولم يكن التركيز على "النص" في حد ذاته بقدر ما كان على "القصة" وكيفية روايتها. كانت الذاكرة الشفوية "نشطة" و"إبداعية"، تعتمد على التذكر وإعادة البناء في كل مرة، وكانت جزءًا حيًا من الهوية الجمعية. دخول الكتابة، أحدث تحولا جذريا، حوّل الكتابة من السرد المرن إلى نص ثابت ومُقنَّن، مما منحه سلطة جديدة كـ "مرجع نهائي". هذا التثبيت منح النص سلطة لم يكن يمتلكها من قبل، وجعله يفرض نفسه ككيان مستقل، لكنه في الوقت ذاته أفقده خاصية التفاعل الديناميكي مع الذاكرة الجمعية.
الرموز والتحليل في الإلياذة
تختلف النصوص الهومرية عن النصوص المقدسة في معالجة الرموز. فالرموز في الإلياذة تركز بشكل أساسي على التجارب الإنسانية والسرد القصصي. تحتوي الإلياذة على رموز تتعلق بقيم إنسانية عميقة مثل الشجاعة، الشرف، والفداء، تعكس تأملات فلسفية حول الوجود والمصير. الفلاسفة مثل أفلاطون ناقشوا هذه النصوص من منظور أخلاقي وديني، مشيرين إلى تأثيرها على المجتمع اليوناني.
التحليل الفلسفي للرموز في الإلياذة كان يُنظر إليه كجزء من التجربة الإنسانية؛ حيث يعتبر عدم القدرة على الفهم الكامل دافعًا للتفكير والتأمل حول التحديات الوجودية. هذا يختلف عن "الجهل المقدس" الذي يرتبط بالنصوص الدينية، والذي يفضل القبول على الفهم، ويرفض التحليل النقدي.
نظريات التحول: والتر أونج وإريك هافلوك*
يُعتبر التحول من الشفاهية إلى الكتابة محور دراسات العديد من الفلاسفة والمفكرين. فقد وصفه إريك هافلوك بأنه "ثورة صامتة غيرت العالم"، حيث أدت إلى تحول الذهن البشري من التعود على التلاوة الشفوية إلى التأمل الصامت في النص المكتوب. كما يرى والتر أونج في كتابه "الشفاهية والكتابية" أن الكتابة هي "تقنية الكلمة" التي غيرت أنماط التفكير بشكل جوهري. ويوضح أونج أن الثقافات الشفوية تعتمد على أنماط محددة اذ يميل التفكير إلى أن يكون منظمًا في أنماط تذكيرية، مثل الإيقاعات المتوازنة، والتكرار، والجناس، والأمثال وعطف الجمل، والأسلوب التجميعي، بينما تبرز في الكتابة الذاتية المعرفية والفنية.
الذاكرة: من الإبداعية إلى السلبية
الفرق بين الذاكرة في الثقافتين جوهري. فالذاكرة الشفوية هي "ذاكرة إبداعية ونشطة" تعتمد على التذكر وإعادة البناء في كل مرة، وهي جزء لا يتجزأ من هوية المجتمع. أما الذاكرة المكتوبة فهي "ذاكرة سلبية وثابتة" تعتمد على الاسترجاع من مصدر مرجعي ثابت، وتعمل على ترسيخ المفاهيم بدلًا من بنائها. هذا الانتقال هو تحول من "الحقيقة" كعملية إبداعية جماعية مستمرة، إلى "الحقيقة" ككيان موضوعي ثابت ومستقل عن المبدع والمفسر.
سلطة النص المكتوب
منح التدوين للسرديات سلطة رسمية وجعل النص المكتوب هو المرجع النهائي. هذه السلطة لا تقتصر على محتوى النص، بل تمتد لتشمل طبيعته كوعاء ثابت للمعرفة. التحكم في هذا النص المكتوب يمنح سلطة تحديد ما هو صحيح وما هو خاطئ. هذه السلطة هي أساس تحول السرد إلى كيان مقدس مستقل بذاته، وتصبح تلاوته والتمسك به طقسًا تستخدمه المؤسسات الدينية لترسيخ نفوذها الاجتماعي والسياسي. في هذه الحالة، يمكن استخدام سلطة النص لمنع التنوع والحد من التفسيرات التي كانت ممكنة في العصر الشفوي.
سلطة النص والجهل المقدس: علاقة جدلية
مفهوم الجهل المقدس
الجهل المقدس" هو مصطلح يُستخدم في علم الاجتماع لوصف التدين الذي يرفض المعرفة العلمية ويعتقد في الديني الخالص الذي يُبنى خارج نطاق الثقافات. هذا المفهوم لا يمثل مجرد جهل، بل هو موقف إيماني يفضل "القبول" على "الفهم"، ويعتبر الإيمان أعلى مرتبة من العقل. في كثير من الأحيان، يُستخدم هذا المفهوم كأداة لاضطهاد فلاسفة التنوير والنقد.
سلطة النص كآلية للجهل المقدس
ترتبط "سلطة النص" ارتباطًا وثيقًا بظهور "الجهل المقدس". فعملية تدوين السرديات المقدسة وتجميدها هي التي أتاحت ظهور سلطة النص كمرجع مطلق. هذه السلطة بدورها أدت إلى ظهور الجهل المقدس كآلية لحماية هذا النص من التساؤل والشك. فإذا كان النص مقدسًا ومطلقًا، فإن أي محاولة لتحليله أو نقده تُعتبر شكًا أو كفرًا.
هذه العلاقة جدلية ومتبادلة؛ فكلما زادت سلطة النص المكتوب كمرجع مطلق، زاد الاعتماد على "الجهل المقدس" كأداة لحمايته من النقد. التحول من "الحوار" الشفوي القابل للتأويل وإعادة الصياغة إلى "التلقين" المكتوب هو ما يميز العصر المدوّن. التحكم في النص المكتوب يمنح سلطة المعرفة، ويصبح النص هو الجهة التي تملك حق الحفظ والتفسير والتأويل، مما يمنحها قوة اجتماعية وسياسية.
تحولات النص في العصر الرقمي
يُمثل العصر الرقمي اليوم تحولًا جديدًا، يعيد طرح الإشكاليات الفلسفية ذاتها في سياق معاصر. لقد غيرت التكنولوجيا الرقمية طريقة الكتابة والتواصل، وظهرت أشكال جديدة من النصوص الرقمية التفاعلية. لم يعد النص كيانًا خطيًا ثابتًا، بل أصبح متعدد الوسائط، يجمع بين النص، الصورة، الصوت، والفيديو.
يؤدي هذا التحول إلى عودة بعض خصائص الثقافة الشفوية التي تناولها والتر أونج، واستخدام الرموز التعبيرية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المحادثات اليومية. هذا يفتح المجال لفهم أننا نعود إلى حالة من "الشفاهية" ولكن بأدوات تقنية جديدة.
سلطة المحتوى في العصر الرقمي
إذا كانت الكتابة قد خلقت "سلطة النص" الموحدة، فإن العصر الرقمي قد أدى إلى "تفكيك" هذه السلطة. فقد انتقل التحكم في المحتوى من المؤسسات التقليدية إلى المنصات الرقمية التي تتيح للجميع إنتاج ونشر المحتوى. هذا التفكيك له فرص وتحديات.
العصر الرقمي يمثل انقلابًا جديدًا؛ فبينما فرضت الكتابة نوعًا من "الجهل المقدس" عن طريق تثبيت النصوص، فإن العصر الرقمي يغرق الأفراد في "فوضى المعرفة"، حيث تتوافر المعلومات بكثرة دون وجود مرجعية مركزية لتصنيفها أو التحقق منها. هذا يفتح أسئلة جديدة حول مرجعية الحقيقة في عالم متغير.
تأملات ختامية
ان دراسة التحول من الشفاهية إلى الكتابة، بدءًا من القضية الهومرية وحتى العصر الرقمي، تظهر أن هذه العملية هي أكثر من مجرد تطور تقني. لقد أحدثت الكتابة تحولًا جذريًا في طبيعة المعرفة والذاكرة، مما منح النص سلطة لم تكن موجودة في الثقافة الشفوية. هذه "سلطة النص" هي التي أتاحت ظهور "الجهل المقدس" كآلية لحماية النص من النقد والتحليل.
يواجه الصراع القديم بين مرونة الشفاهية وثبات الكتابة اليوم تحديات جديدة في ظل الثورة الرقمية. فإذا كانت الكتابة قد قننت المعرفة، فإن العصر الرقمي قد فككها. هذا التفكيك يثير تساؤلات حول طبيعة الحقيقة، والسلطة، ومرجعية المعرفة في عالم لم يعد فيه النص كيانًا ثابتا، بل محتوى مرنًا وقابلًا للتعديل والتفاعل.
***
غالب المسعودي
........................
* majalla.com
كتاب يروي قصة اختراع الكتابة وولادة المكتبة - مجلة المجلة
* iqra.ahlamontada.com
182 الشفاهية والكتابية - والتر ج.أونج
alfaisalmag.com*
التحول من الشفاهية إلى الكتابية لدى كتاب القرون الوسطى | مجلة الفيصل
* koha.birzeit.edu
الشفاهية والكتابية تأليف والتر ج. أونج؛ ترجمة حسن البنا عز الدين؛ مراجعة محمد عصفور
* asjp.cerist.dz
* الأنثرومورفيزم والتأويلات الناسوتية للآلهة من خلال الإلياذة Anthromorphism and humanistic interpretations of the gods through the Iliad | ASJP (“الأنثرومورفيزم والتأويلات الناسوتية للآلهة من خلال الإلياذة ...”)
* hindawi.org
المقارنة بين الإلياذة والأوديسة | الإليَاذة - مؤسسة هنداوي
* Walter J. Ong | Research Starters - EBSCO
* Eric A. Havelock - Wikipedia
* Walter J. Ong - Wikipedia