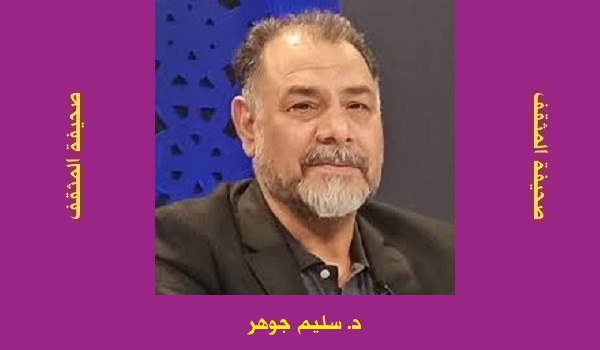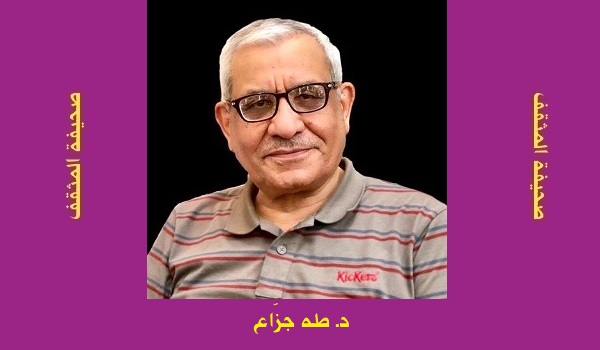قضايا
أحمد بلحاج: في حرية الكاتب

ما أحوجنا إلى قذائف الإبداع الباعثة على الحياة.
1- مفهوم الثقافة:
الثقافة؛ في هذا العصر المتناسلة قضاياه، والمتفجرة مشاكله؛ تتخذ عدة أبعاد وألوان، ومن ثمة يصعب حصر ماهيتها في مفهوم قار ووحيد. ولذلك سنقتنع بالتعريف الذي اعتمده المؤتمر الدولي للسياسات الثقافية الذي كان قد عُقد في المكسيك، فهو تعريف شامل للثقافة ينص على "أن الثقافة بمعناها الأوسع هي مجموع السمات التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وأنها تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة والإنتاج الاقتصادي كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات"(1).
وهذه المجموعة من السمات المشكِّلة للشخصية الثقافية لا تتجلى معالمها وقسماتها بوضوح في كيان مستقل ومتميز إلا بتوالي الحقب. وعند ذلك يتكون الإنسان المثقف الذي سماه بعض مفكري الهند بإنسان النسق الأخلاقي(2).
2- ميزة الثقافة المغربية:
إن الثقافة المغربية؛ وهي مكون من مكونات الثقافة العربية لم تكن في أي زمان منعزلة أو معزولة عن الثقافات الإنسانية، فقد عايشت ثقافات الأمم الأخرى منذ عصور موغلة في القدم، وصمدت في وجه إعصاراتها، وتفاعلت معها تفاعلا إيجابيا، وتثاقفت معها في فترات مدها وجزرها. أخذت منها وأعطت لها، اغتنت بها وأغنتها بحيوية وانفتاح واقتدار دون عُقد ودون أن يؤثر ذلك في ملامح هويتها أو في مقومات ومكونات أصالتها، وكانت في لقائها الخصب مع تلك الثقافات تتواصل وتتفاعل بحيوية من موقع الثقة بالذات، ومن موقع التميز، لا تمثل لما تأخذ وإنما تَتَمَثَّلُهُ، ولهذا نجدها ثقافة ذات نزوع إنساني غير متزعزعٍ وذات استقلالية وتَجَدُّدٍ، فهي لم تكن في أي يوم من الأيام تابعة ذلولا، ولا متعالية قتولا.(3)
3- في معنى حرية الكاتب:
ولا تكون الثقافة هكذا إلا إذا ترعرعت في مناخ حر، فالحرية هي رئة الوجود الثقافي؛ إذ لا ثقافة حية وحقيقية إن لم توجد هذه الرئة. فالكاتب لا يكتب إلا إذا تنفس بها، فهي شرط وجود إبداعه، وحريته ليست حرية كلام فقط، وإنما هي حرية وجود، توفر لممارسها مقومات العيش الحر والتصرف الحر، وتضمن له الكرامة، إنها تتصل لدى الكاتب بالاطمئنان والاستقرار النفسي والاجتماعي، وتتصل كذلك بتوافر حَدٍّ أدنى من شروط العيش والعمل، ومن الضمان الصحي والاجتماعي، ومن إحساس بالطمأنينة لا يشعر معه الكاتب بأنه مراقب باستمرار من طرف عيون خفية، وبأنه محل شكوك، وبأنه مهدد في مصدر عيشه وحياته وأهله – بأي شكل من أشكال التهديد – إذا مارس حريته الإبداعية، أو إذا حاد عن السبيل المرسومة للتفكير والتعبير والإنتاج. فالكلمات هي سلاحه للحرية والتغيير في معركة الوجود الحضاري، وهذا السلاح – حسب بريسباران Briceparain – ما هو إلا "مسدسات عامرة بقذائفها" التي تُحْيِي القَتْلَى(4)، فكيف إذن يمكن للمبدع أن يُطْلِقَ هذه القذائف إذا كانت أصابعه مشلولة أو مغلولة؟! إن شرط استخدام الجندي لسلاحه هو امتلاكه للسلاح وجاهزيته، ونحن ما أحوجنا إلى قذائف الإبداع الباعثة على الحياة.
فشهداء حرية الإبداع ما تزال شمسهم تضيء التاريخ، حيث أن المبدعين الكبار في العالم كانوا كذلك كبارا في الدفاع عن الحرية، ابتداء من هوميروس الذي كانت الحرية دَيْدَنَه ودِينَه، ومرورا بسقراط الذي تَجَرَّعَ السم في سبيل حرية القول والكلمة، وبابلو نيرودا، ولوركا. وطرفة والمتنبي وأبي العلاء المعري والحلاج والسهروردي، وانتهاءا بابن حزم، وابن الخطيب وابن بَرَّجَان، وابن سبعين، وغيرهم. فكلهم أدركوا أن الحرية حالة نفسية لا يتأتى العيش والإبداع إلا بها. فهي من هذه النقطة بالذات تبدأ، من كونها حالة نفسية، وإلا فلن تبصر النور وتصبح واقعا معيشا ومُجَسَّدا، فالمرء قبل الشروع في ممارسة حريته عليه أن يشعر بها، وأن يعتنقها في قرارة نفسه، أي أن يقتنع أولا بأنه كائن حر.
وإذا نظرنا إلى الوراء، إلى الإنسان البدائي، فإننا سندرك أنه لم يكن حرا وطليقا؛ كما كنا نتصور، وكما يحلو لنا أن نرسمه؛ فعلى الرغم من أنه لم تكن تحيط به مؤسسات سياسية أو اجتماعية أو لاهوتية تَحُدُّ من حريته فإن ثمة قانونا خفيا خضع له دائما، وهو (قانون الطابو)؛ الذي هو فكرة عبقرية أوجدها المجتمع البدائي ليحمي بها لَأْمَةَ المجتمع والجماعة، ويكفل لهما السلام الروحي والعقلي. فقد كان تعريض أمن القبيلة للخطر من أشد الجرائم على الإطلاق، وفي الواقع لم تكن هناك فرصة لارتكاب الجرائم ضد المجموع ثم العقاب عليها إلا نادرا، لأن فكرة الطابو تتولى منع الجرائم قبل أن تقع، فهي كبول تمنع ولادة الجريمة، وبالتالي الحركة خارج تفكير الجماعة.
من هنا يمكن أن نعتبر أن (قانون الطابو) كان بمثابة القيد الذي كبل الإنسان البدائي وحد كثيرا من حريته، وما يزال يكبل ويحد من حرية الإنسان المعاصر. ولا نغالي إذا قلنا إن الردع الذي قام به (قانون الطابو) في الأزمان الغابرة كان أشد قمعا وأكثر صرامة من أشد القوانين الحديثة التي نعرفها اليوم، فتحت وطأة هذا القانون أو هذه الفكرة المستبدة لم يكن الإنسان الأول ليتمتع ولو بقدر يسير من الحرية، حتى أن ما نسميه اليوم تسامحا لم يكن معروفا لدى المجتمعات البدائية، فكل من يتمرد على (قانون الطابو)؛ باعتباره رادعا دينيا داخليا؛ كان يعاقب بالموت أو بالطرد من القبيلة، وهو موت مدني وبدني معا.
إن (قيود الطابو) كبلت الإنسان فترة طويلة من الزمن على هذه الأرض حتى أن 98% من حياة الإنسان على الكوكب الترابي لم تكن سوى حياة خضوع بالكلية إلى فكرة الطابو.(5)
4- ضرورة استيلاء المبدع على حريته:
وذلك لأنه كان محروما من الحرية؛ التي هي جوهر يؤخذ ولا يعطى. فعليه إذن؛ وبخاصة المفكر والمبدع؛ أن يستولي على حريته ويتعانق معها تعانق عشق في هذا العصر المتشظي والمرعب.. عصر الاستلاب المنظم، عصر الفساد والإفساد، عصر التقنية المستعبِدة. وعليه أن يحافظ على حيويته في تصور آفاق حريته وتجديد تلك الآفاق وتطويرها بما يبقي على أنسنتها. فحرية المبدع بالذات هي حرية مغامرة الكينونة ووقوفها ضد التفسخ، لا تحد آفاقها إلا الحدود التي وصل أو يمكن أن يصل إليها وعي المبدع لماهية الحرية ومفهومها والتزاماتها وشروط ممارستها، ضمن حدود المسؤولية في الحياة وعنها، وما يفرضه وجود الجماعة والعيش معها والحفاظِ على حرياتها ووجودها وسلامة بنيتها ومصالحها، والحفاظ أيضا على مواصفات المجتمع المتمدن وقيمه ومواضعاته المثلى في زمَكَانٍ محدَّدٍ، مع فتح أفق استشراف المستقبل عن طريق التحرك والتطلع ضمن هوامش أعلى من الواقع الممكن، وأبعد من تطلعات إنسان ذلك الواقع وطموحاته. ففضل الإنسان وميزته يكمنان في كونه يأمل ويحلم بالأفضل، ثم يعمل لتحقيق آماله وأحلامه تلك.(6)
5- حرية مطلقة.. خوف مطلق:
وإنجاز الآمال لا يتحقق إلا في مناخ الحرية. والحرية حريات، فهي ليست مرتبة واحدة، بل مراتب عدة. فكل منا يسعى إلى نوع محدد من الحرية، فهناك حرية القول والتعبير، وحرية الانتخاب، وحرية الانتماء إلى معتقد أو هيئة حزبية أو نقابية، وحرية التجول، وحرية العمل، وحرية العقيدة، وحرية التصرف بطلاقة دون قيود، وحرية النشر، وحرية الاختلاف، وهناك حرية الانمحاق أو الذوبان أو الفناء التي ينشدها الصوفي؛ والتي عبر عنها الجرجاني بقوله: "الحرية في اصطلاح أهل الحقيقة (= الصوفية) هي الخروج من رق الكائنات، وقطع جميع العلائق والأغيار. وهي على مراتب، حرية العامة عن رق الشهوات، وحرية الخاصة عن رق المرادات لفناء إرادتهم في إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم في تجلي نُورِ الأنوار"(7). ومن هذه الزاوية يمكن أن نرى إلى الكون وإلى الحرية. فالكون ليس ماديا وفكريا فحسب، بل هو روحي وشعري أيضا. والحرية حق، والحق لا يبحث عنه إلا في (الكل) وليس في (الجزء) حسب هيجل (1770م-1881م)؛ الذي كان شعاره "الحق هو الكل". والكتابة وجود له وجهان: فكري وشعري، فالفكر فعل سلطوي يهدف إلى فرض نوع من السلطة على الآخر، بينما الشعر فعل جمالي غير سلطوي يرمي إلى حالة مزدوجة من الالتقاء والارتقاء: الالتقاء مع الآخر، والارتقاء بمشاعره وأحاسيسه وخلجاته ونظرته الجمالية وشعوره بالوجود، ولذلك كان الفعل الشعري نزاعا إلى الحرية أكثر من الفعل الفكري.
إن قضية الحرية هي قضية الصراع من أجل الحرية، ووظيفة المبدع الأساسية هي تحقيق حرية القارئ، الحرية بمعناها العميق، أي تفكيك الأصفاد الداخلية التي يرسف فيها، ثم تفكيك الأصفاد الخارجية المفروضة عليه من قبل مختلف السلطات.(8) وليس الحرية بمعناها الدِّيمُوفَوْضَوِي، فالحرية المطلقة في العمق هي حجابُ مايا Maya وقناعُ الفوضوية المحدِّق في الكَاوْسْ، اللذان يسلبان الفرد الأمن والاطمئنان، ويقذفان به في متاهة الخوف، فالحرية المطلقة إذن هي الخوف المطلق. لكن الحرية المنظَّمة هي المجتمع المنظم الذي يحفظ لمواطنيه حريتهم. فكل حرية مطلقة ما هي إلا خوف الناس جميعا من الناس جميعا، ودعوة القادر على أن يبقى الحر الوحيد بين ضعفاء يحكمهم العجز والعبودية.
إن الحرية تقوم على أساس حفظ الذات وحفظ الآخر وحفظ الجماعة، وعلى حفظ التوازن بين مكونات المجتمع، إذن بها تتحقق الديمقراطية التي هي هاجس الإنسان العربي، وتتجذر فهما وسلوكا. لأنه لا سياسة ثقافية حية دون ديمقراطية حية، ومن أهم انشغالات الديمقراطية التي بهذا الوصف هندسة ثقافية تستند إلى أحكام جمالية وأخلاقية وعلمية، وإلى ميكانيزمات الهوية وإواليات الشرط الإنساني. وتقوم على احترام الآخرين وثقافتهم، بحيث يستشعر معها المواطن أنه سائر في طريق الموافقة والتوافق بإرادته لا بإرادة القوة والعسف. وتأتي في مقدمة هذه الهندسة استراتيجية الكتاب؛ التي ترمي إلى تكوين الوعي وترسيخه، وإلى دفع المواطن إلى حل مشاكله انطلاقا من وعيه بها وبقدراته وطاقاته.(9)
6- الكتاب مشروط بشرط الحرية:
ومن ضمن ما تتوخاه هندسة الثقافة من استراتيجية الكتاب تداوله وتفعيله في الحياة العامة. وإن حيوية الكتاب وفاعليته وازدهاره كلها مشروطة بشرط الحرية، وبمناخات الحوار والاختلاف غير الملوثة بأكسيد الخلفيات. فالحرية قد تُضْمَنُ كمبدأ في الدساتير والتشريعات والتصريحات والبيانات... ولكنها ليست من ذلك النوع الذي يحدد نهائيا في إطار أو يحنط في دثار، لأنها مرتبطة بالإنسان الحي، مبدعا كان أو غير مبدع، ولأنها دليل حيوية، وهاجس أساسي يشغل الكائن الإنسان، وأساس جوهري يمكنه من تطوير نفسه وتطوير الحياة، فلا غرابة أن تكون دائما في تجدد، وأن يكون أفقها في اتساع مستمر، وفهمها مرتبطا بالوعي المعرفي؛ الذي يفتق في سمائها الآفاق وهي تدفع إلى التعمق في مجالاته، وتعتمد عليه أساسا في تجديد الانعتاق.
ولذا فإن الإنسان في نمو وعيه وتطور مداركه، وتقدمه في مراقي المعرفة والعلم والرقي يأخذ الحرية التي تنقصه، أو تدفعه الحرية إلى القيام بمسؤوليات إنسانية، وتفرض عليه امتلاك إدراك ينقصه. ومن هنا ينشأ نوع من الصدامية بين مفهوم ومفهوم للحرية، ينعكس في توترات وصراعات بين المحافظة والتحرر، بين التخلف والتقدم، بين عقليات منغلقة وعقليات منفتحة، كما ينشأ حولها نوع من السجال والحوار السياسي والفكري يؤدي إلى التقابل والتصادم بين الأدب والسياسة / المثقف والسياسي. ومن المعروف أن حرية التعبير هي الشرط الأول لانطلاق الثقافة ونمو الأدب وازدهار الفكر، وانتعاش سوق الكتاب وصناعته. وكما أن الحرية أساس حياة الأفراد والمجتمعات والأمم وتقدمها وشعورها بمعنى الكرامة والعيش، فإنها كذلك بالنسبة للكتاب؛ الذي هو خزان المعارف والثقافات والفنون والآداب. إن حرية التعبير هي الركيزة التي يستند إليها الإبداع وينبثق منها، وهي عند المبدع لا تنفصل عن الحريات والحقوق العامة الأخرى للإنسان، وذلك لأن هدف التعبير هو إحداث التحرير والتغيير... تحرير العقل والإرادة وتغيير البنى والعلاقات والقيم والأنساق الجامدة. فغاية الكتاب ليست شبيهة بغاية الآلات، فإذا كانت غاية هذه هي تسريع وتيرة الإنتاج وتكثيره وتغزيره وخدمته، فإن غاية ذاك هي فك القيود عن حرية القارئ، وتكوين وعيه، وإنماء معرفته، وتفجير طموحاته الخلاقة، وإمتاع روحه وذاكرته، وترميم انهياراته، وإعادة الانسجام إليه مع الذات والكون. إذ بمقدار ما نسهم في تفعيل قيم الديمقراطية، وقيم الحضارة، وقيم الإنسانية العليا. وكذلك بمقدار ما يحترم الكاتب والكتاب حرية الآخر، ويشركانه في المسؤولية، ويقدّمان إليه إبداعا ناضجا أصيلا، متصلا بالواقع، شامخا منه وبه، صوب رؤية جديدة لواقع أفضل مأمول ومرتاد، لا يتملق الغرائز الدنيا، ولا المكبوتات التي تراوح في الرمادية من غير هدف، بمقدار ما يؤثر الإبداع في الحياة والناس، ويتصل بأهم انشغالاتهم الوجودية، ويكون فعالا بإيجابية بناءة في المجتمع والحضارة.(10)
***
د. أحمد بلحاج آية وارهام
........................
الهوامش
1- أورده علي عقله عرسان، في كتابه دراسات في الثقافة العربية. منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، د.ت، ص: 8.
2- علي عقلة عرسان، المرجع السابق، ص: 7.
3- المرجع السابق، ص: 43.
4- نفسه، ص: 98.
5- محمد العزب موسى، حرية الفكر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1979م، ص.ص: 13،14.
6- علي عقله عرسان، مرجع مذكور، ص: 75.
7- عبد القاهر الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق: عبد الحميد جوهر، دار التراث، بيروت 1970م، ص: 90.
8- سمير أبو حمدان، كمال جنبلاط في بعده الآخر، ط 1، منشورات دار عويدات الدولية، بيروت / باريس 1991م، ص.ص: 40،45.
9- علي عقلة عرسان، مرجع سبق ذكره، ص: 47.
10- المرجع السابق، ص.ص: 96،97