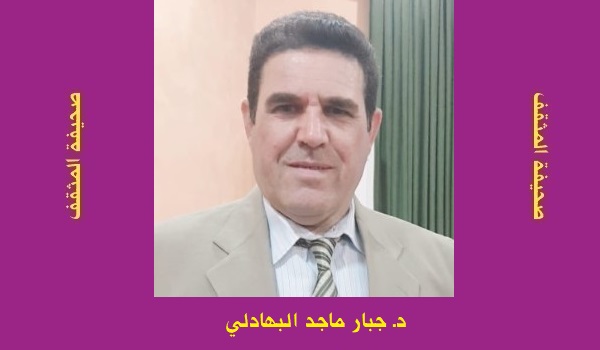قضايا
عصمت نصار: من أين نبدأ؟ (3)

سؤالُ يصعب علينا تجاوزه واجتيازه
حول قضايا الإيمان والإلحاد كتب أحمد زكي أبو شادي كتاب (لماذا أنا مؤمن)، وكتب إسماعيل أدهم كتاب (لماذا أنا ملحد)، وكتب محمد فريد وجدي مقال (لماذا هو ملحد)، وكتب عبد المتعال الصعيدي كتاب (لماذا أنا مسلم)، وكتب عبد الرحمن العيسوي كتاب (لماذا أنا مسلم).
وحول قضايا السياسة والاجتماع والإسلام كتب عبد المتعال الصعيدي كتاب (من أين نبدأ)، وكتب خالد محمد خالد كتاب (من هنا نبدأ)، وكتب محمد فريد وجدي كتاب (ليس من هنا نبدأ)، وكتب محمد الغزالي كتاب (من هنا نعلم) وكتاب (الطريق من هنا)، وكتب سيد قطب كتاب (معالم في الطريق)، وكتب علي ابن نايف كتاب (هذا هو الطريق)، وكتب أبو مصعب مجدي كتاب (أختاه.. أين تذهبين؟ هذا هو الطريق)، وكتب أحمد مصطفى راغب كتاب (الطريق هو الطريق).
ونخلص من ذلك كله إلى أن السؤال الفلسفي كان بمثابة حجر الزاوية الذي يربط بين العصف الذهني والتساجل من ناحية، وحرية الفكر والنقد والتناظر من ناحية أخرى، وذلك لإيجاد أصوب الحلول وأقرب الرؤى والتصورات للتطبيق والعمل على حل المشكلات والقضايا كما أشرنا فيما سبق، الأمر الذي يُثبت أصالة السؤال الفلسفي في بنية التفلسف منذ نشأته.
(5) عودُ على بدء، حيث السؤال الفلسفي الذي عنونا به هذا المقال وبيّنا أنه من العسير تجاوزه أو اجتيازه، وكررنا عبارة (الخطب جلل) وذلك للتفسير والتبرير.
فنحن اليوم أمام قضية وجودية مفادها: نكون أو لا نكون، وقد آن الأوان لمصارحة أنفسنا بالضعف والوهن والتردي الذي آلت إليه مُجتمعاتُنا، بداية من هُويتنا الضبابية، وانحطاط قيمنا الأخلاقية، وهشاشة عقائدنا، وتفكك وحدتنا، وفساد أحوالنا الاجتماعية والسياسية، وبرامجنا التعليمية، وباتت ثرواتنا وأراضينا وأوطاننا لقمة سائغة أمام الطامعين من الأغيار الذين استهانوا بقوميتنا الغائبة، وهويتنا الزائفة، فبتنا حيارى تتقاذفنا أهواء بعضنا، وتخدعنا الأنانية، ومؤامرات الأغيار، وخيانات المؤجّرين، وأوهام الحالمين.
وبات حال معظمنا قريب الشبه من حديث عبد الرحمن بن خلدون في وصفه للأمم المحتضرة التي أوشكت على الموت والفناء، فجاء في مقدمته إذ يقول: "إذا فسد الإنسان في قدرته على الأخلاق، فسد في جميع شؤونه، وإذا فسدت الدولة في سياستها، فسد الناس في معاشهم وأخلاقهم، وانحدروا إلى حضيض الجهل والذل والمهانة".
وفي موضع آخر يقول: "إن المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب، في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده".
وهذا النص يشير إلى أن فساد المجتمعات لا يكون فقط داخليًا، بل أيضًا حين تفقد الأمة هويتها وتُقلّد غيرها من دون وعي أو حكمة.
كما يُحذّر ابن خلدون من أن الترف والركون إلى الراحة يؤديّان إلى زوال الثقافات، وذلك في قوله: "إذا بلغ الترف بالناس مبلغه، أفسد أخلاقهم، وأوهن عزائمهم، وجعلهم عالة على غيرهم، فتنهار الدولة وتضمحل الحضارة".
إنّ الأمة إذا غُلِبَت وصارت في مُلك غيرها أسرع إليها الفناء، والسبب في ذلك - والله أعلم - ما يحصل في النفوس من التكاسل إذا مُلِك أمرها وصارت بالاستعباد آلة لسواها وعالة عليهم، فيقصر الأمل ويضعف التناسل، والاعتمار إنما هو عن جِدة الأمل وما يحدث عنه من النشاط في القوى الحيوانية، فإذا ذهب الأمل بالتكاسل، وذهب ما يدعو إليه من الأحوال، وكانت العصبية ذاهبة بالغلب الحاصل عليهم، تناقص عمرانهم، وتلاشت مكاسبهم ومساعيهم، وعجزوا عن المدافعة عن أنفسهم بما خَضَدَ الغلبُ من شوكتهم، فأصبحوا مغلوبين لكل متغلب، وطُعمةً لكل آكل، سواء أكانوا قد حصلوا على غايتهم من الملك أم لم يحصلوا.
وفي هذا السياق يقول الإمام الحافظ أبو يوسف ابن عبد البر القرطبي: (أعجب لهذا الزمان، النساء ترجلت، والرجال تأنثوا، والأخلاق فسدت، والصلاة تُركت، وطاعة الله نُسيت، ولحظة الموت اقتربت، وعلامات الساعة ظهرت، والمساجد أُخليت، والملاعب مُلئت، ودُول الإسلام تفرقت، والأمانة فُقدت، والفتن انتشرت، والحرب ازدادت، والقيم أُهملت، والمبادئ نُسيت، والعلاقات تشتت، والمساوق كثرت، والحياة أصبحت كألغاز لا يُدرى مآلها).
وبين فحيح الأفاعي وأشباح الموت، آنَ لنا أن نستمع لنحيب عقولنا، يهمس بسؤالٍ عجز اللسان عن النطق بالمسكوت عنه فيه: (من ذا الذي يسأل عن البداية وهو يجهل مقصد الطريق وعلامات النهاية، وفاته أن يسأل: كيف؟ متى؟ لماذا؟ وأين الجماعة؟)
وإذا أردت الجواب، عُد من حيث كنت، وكان كتابك وقلمك، لتعي وتعلم أن جواب السؤال عندك، فابحث عنه في داخلك!!
فعمد رواد النهضة العربية الحديثة إلى تجديد أسلوب الخطابة، وتحديث فن المقامة، وتطويع المسرح والقصة والرواية لخدمة مقاصدهم التنويرية؛ ذلك فضلًا عن تنظيمهم المجالس الأدبية، والحلقات العلميّة، والمساجلات الفكريّة، لتعينهم على تخطيط مشروع النهضة، وانتخاب آلياته، وتوعية الرأي العام، وإيقاظ العقل الجمعي للتنفيذ والتطبيق.
وكان السؤال الفلسفي هو نقطة الانطلاق المركزيّة في جل هذه الأعمال، بدايةً من الاعتماد على الحوار الفلسفي في المدارس والمعاهد التعليمية، ومنابر التثقيف، وصحافة الرأي، وتحرير المقالات والأبحاث، ومعظم المصنفات الأدبية والسياسية والاجتماعية، ناهيك عن الكتب التي حملت عناوينها هذا المنحى التحريضي على النقد والعصف الذهني والتفكير الفلسفي، نذكر منها:
كتاب "لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟" لشكيب أرسلان، وكتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟" لأبي الحسن الندوي، وكتاب "أسئلة التنوير والعقلانية في الفكر العربي المعاصر" ليوسف بن عدي.
والجدير بالإشارة في هذا السياق، الحديث عن الاستفتاءات الصحفية التي انتحلت الخطاب الفلسفي لطرح القضايا والمشكلات على النخب الواعية من قادة الرأي لإيجاد الحل والاسترشاد بآرائهم وتوجهاتهم لمعالجة القضايا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، لترقية الرأي العام، ونقد الفاسد من عاداته وسلوكياته، وتوحيد الرؤى والتصورات للتصدي لمزاعم الأغيار وطعونهم، والحملات التغريبية التي ترمي إلى هدم المشخصات وثوابت الهويّة.
ولعل مجلة الهلال، والمقتطف، والرسالة، والثقافة؛ من أهم الدوريات التي اضطلعت بهذه الرسالة.
ومن أهم القضايا التي تناولتها النهضة الشرقية الحديثة، كان السؤال عن موقف نهضة الشرق العربي وموقفه بإزاء المدنية الغربية، وذلك في عام (1922م)، وقد شارك في هذا الاستفتاء: مخائيل نعيمة، سلامة موسى، محمد لطفي جمعة، طه حسين، وغيرهم...
واستفتاء الهلال أيضًا عن مستقبل اللغة العربية، واستفتاء عن المرأة الشرقية: ماذا يحسن أن تستبقي من أخلاقها التقليدية، وماذا يحسن أن تقتبس من شقيقتها الغربية.
واستفتاء المقتطف عن موقف الفكر العربي من البرامج التعليمية الغربية الحديثة عام (1936م).
ولا يفوتنا ذكر أهم الكتب التي أثارت أخطر القضايا العقدية والسياسية في العصر الحديث، نذكر منها: مقال "لماذا أنا ملحد؟" لإسماعيل أدهم؛ ذلك المقال الذي تبعه عشرات الردود الفلسفية الواعية لأكابر المفكرين العرب. نذكر منهم: مقال "لماذا أنا مؤمن؟" لأحمد زكي أبو شادي، مقال "لماذا هو مؤمن؟" لمحمد فريد وجدي، كتاب "لماذا أنا مسلم؟" لعبد المتعال الصعيدي، وكتاب "لماذا أنا مسلم؟" لعبد الرحمن العيسوي.
ومن أهم القضايا السياسية: كتاب "من أين نبدأ؟" لعبد المتعال الصعيدي، وذلك ردًا على كتاب "من هنا نبدأ" لخالد محمد خالد، مقال "ليس من هنا نبدأ" لمحمد فريد وجدي، كتاب "الطريق من هنا" وكتاب "من هنا نعلم" لمحمد الغزالي، وكتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب.
ولا ريب بأن هذه الكتابات التي استشهدنا بها تؤكد أهمية السؤال الفلسفي في النهضة العربية الحديثة، ورسالة التجديد التي يعمل على إحيائها المعهد الذي ننتمي إليه في هذه الأمسية الرمضانية.
أجل، إن سؤال اليوم لا يختلف عن ما طالما رددناه في العقود الستة الأخيرة التي تعيشها أمتنا من أزمات وكآبات وانكسارات وإخفاقات. فعلينا أن نعيد السؤال: "من أين نبدأ؟" فكل الاختيارات لا يميز بعضها عن بعض سوى ترتيب مكانتها في درك الهزيمة والانكسار والركود والانحطاط واليأس.
علينا الاختيار بينها ما دمنا في وهن وحيرة وعماء وجهل، وما زلنا نسأل: "من أين الطريق؟".
الأول هو: طريق صاعد لا يخلو من المخاطر والمعوقات، وهو طريق أرنولد توينبي، وهو طريق التحدي والاستجابة (لإزالة المعوقات وتهيئة الرأي العام لحمل مسؤولية اتخاذ القرار). فقد حان الوقت لتصبح الشعوب العربية هي سيدة القرار، وتبيت أمتنا هي التي تملي على قياداتها رغبتها للطاعة، وعمل ما يلزم للتنفيذ.
غير أن ما يمنعنا من السير فيه إلا عجزنا وعجزنا وغياب آليات المجاهدة والصعود، فليس لدينا شجاعة التحدي، ولا نبل وإخلاص الاستجابة، ولا حسم القائد، ولا إرادة اتخاذ القرار الموحد.
أما الطريق الثاني فهو: طريق منحدر يؤدي إلى الفناء والهلكة والمذلة، وهو سبيل الراقدين الذين استملحوا الذل والمهانة.
وهذا عسير أيضًا، لأن عظام أسلافنا وما تبقى من أصولنا تأبى السير فيه وترفضه بعين الحسرة والمذلة والأسف على جيل الأسافل الذين راق لهم اليوم الرقص والغناء على أنقاض دورهم، وسكتوا على سفك دماء نسائهم وأطفالهم.
والطريق الثالث هو: طريق الخيانة والأنانية والشتات الذي استلهمه رواده من فلسفة مكيافيلي وأصحاب الفلسفات المادية النفعية حيث الجموح والشتات، وهو أيضًا عصي على عوام شعوبنا التي ما زالت تحلم بالخلاص على يد المهدي المنتظر، وتطلب الخلاص من الله ليزول الغمة، ويرتفع النقمة، ويقتص من الظالمين.
أما الطريق الرابع والأخير، فهو: درب اللاعودة الذي تحدث عنه ابن خلدون في وصفه لاندحار الثقافات وانكسارها، وموت الحضارات وفنائها قبيل اندثارها وتلاشيها من الوجود، أعني تلك الحالة التي نعيشها الآن.
فهل في إمكانكم وأنتم عقول تلك الأمة المنكوبة الإجابة عن سؤالي: "من أين نبدأ؟".
(وليس للحديث بقيّة)
***
بقلم: د. عصمت نصار