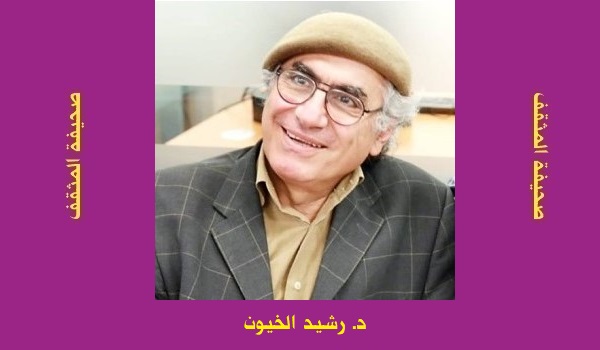قضايا
عباس القسام: الوعي وأفق الحياة

لا شكّ أنّ كلّ شخص يرى المقاييس التي تقود لاستقراره بناء على معطياته التي لا إرادة له بها؛ كونها مصدر البيئة التي تولّد بها وهو ما لا إرادة له في اختياره. فالّذي يعيش الفقر اللاذع يرى الحياة في المال والذي يعيش مُهانًا يرى الحياة في كرامته، والذي يعيش مع الآخرين مرغما عليهم يرى الحياة في راحة البال.
لكن هناك حقيقة واحدة، أثبتتها حياة البائسين من الناس، حقيقة صامتة يخمدها الأفلاطونيون، حقيقة لا تُغنَّى في الأغاني، ولا تُكتب في الروايات، نعيشها بلا وعي، وهي أنَّ كلّ الفقراء يمكنهم الاِستغناء عن الضمير أو المبدأ أو الكرامة أو الحبّ -أو على أقل تقدير فكرة معينة تمسّكوا بها- مقابل المال، لكن ليس كلّ الذين يملكون المال يمكنهم الاستغناء عن أموالهم مقابل الضمير أو المبدأ أو الكرامة أو الحب.
و قد رأينا عبر التاريخ أن أغلب الذين باعوا قضيتهم ومبادئهم وحبّهم هم الفقراء، الذين أرادوا أن يريحوا أجسادهم على حساب ضميرهم، فأيّ ضمير هذا الذي يحرمني من ملذات الحياة والعيش الكريم.
حينما تُحاصر نوائب الحياة الفقراءَ وتنكثهم وتجشّمهم بين لوعات القدر تبدو الحياة لهم كأنّها كذبة لا تصلح للعيش، ونلاحظ هذه الفكرة المرسومة في أذهانهم عندما نقترب منهم أكثر، فترى التنافر بين شخصيتين الأولى -و هي الاجتماعية- تتماثل مع معتقدات المجتمع، والثانية -الخاصة- تتذمّر بروح التساؤل والغيظ من القدر المكتوب، والنفور من كل نصّ دستوري وديني ومن ينقل ذلك النص للعامّة ويدعوهم للقناعة والزهد من قصره السامق.
وقد شهدنا ذلك عبر التاريخ مثل حركة التنوير وحركة الإصلاح الإسلامي والإصلاح الديني للكنيسة الكاثوليكية وحركة حقوق المدنيّين في الولايات المتّحدة، وغيرها الكثير من الحركات التي نبعت -باختلاف نتائجها وغاياتها- من احتدام الروح المعارضة وإشعال نار الإباة والرفض على حساب الكرامة، وهو ما نتج من إيقاض هذه الشخصية المتمرّدة على تناقض المجتمع فخلقت المعارضة الجماعية التي بدورها العدوّ الأكبر للمستبدّين.
ولم نشهد عبر التاريخ ثورة للأغنياء والنبلاء على الفقراء وأصحاب الطبقة العاملة؛ لأن هدف الثورات أساسًا هو المساواة وعدم حصر المال والسلطة عند فئة دون أخرى.
و ها هي الثورات العلمية التي كان وقودها عبر التاريخ هو العقل الواعي والحذاقة والإحساس بأهمية العلم.
و مثل تلك الثورات لم ولن يدخل السلاح بين يدي معارضيها، لأنّ غايتها عامّة حتى بعد تحققها، فلا يتقاسم أصحاب الثورة كعكة المنصب بعد نيله. فلا وجود لأي منصب في هذا النوع من الثورات، ولذلك عرفت الثورة العلمية بإخلاص ثوّارها، لأن ما عداها من الثورات تكشف نوايا الثوّار بعد تحقق الثورة.
ولو اطلعنا بحدق ساخر على ما يسعى إليه الإنسان عبر العصور لاستنتجنا أنه يسعى للمال، ولو قلنا السلطة فإن السلطة بلا مال مثلها مثل مركبة بلا وقود وما هو غير معقول.
و يشذّ عن ذلك المسعى أصحاب الضمير الإنساني الذين خلقوا كي يشعلوا منارة العلم والإرادة والوعي الإنساني.
و هذا لا يعني أنّ السمو للمال ليست غاية من غاياتهم، إنما شيء مكمّل أو ممهد وليس الهدف الأساسي.
يقول لي أستاذ الحقوق الدكتور محمد راضي -ويلحّ بقوله- أن السلاح الأول والأهم وهو بمثابة مفتاح لنهوض هذا الجيل بالتالي البلد هو "الوعي".
وأنا أتفق معه نسبيًا، لأنّ العقل المعاصر نتاج ايدولوجيا تراكمية عبر التاريخ، تسببت بإنهاك العقل بالتالي خموله.
إذا كان الوعي في العهود الماضية تمثيلا لتهديد السلطة المستبدة والفكر التعسفي فاليوم لم يعد الوعي بهذه القوة؛ بسبب النخب المؤدلجة والحداثة التي عجز العقل الشرقي عن التعامل معها ولا شكّ بعد حين سيكون الوعي سيفًا في زمن الأسلحة النارية.
الفائز الوحيد في النهاية هو صاحب المال، أما صاحب الوعي والفكر "ريشةً في مهبّ الريح".
و قد دعتني عبارة أحد الأصدقاء للتفكّر بها حينما قال لي "المال أقوى كائن على وجه الأرض، لأنه يستطيع أن يغيّر القدر ".
شئنا أم أبينا فإن الواقع المعيشي ينحدر بهذا الاتجاه.
المال دون علم حياة، والعلم دون مال ضربة حظ متعجرفة.
كان لي صديق في أيام الثانوية يقول: عندما توفي عمّه - الولد الثاني لجدّه- قال جده بعد حين: "لا يهم، الإنسان يعوَّض، أما المال فلا".
ذلك قول يخلو من أي تمثيل إنساني، دنيء يدل على موت ضمير صاحبه، إلا أنّه نطق بحقيقة مخبَّأة في العقل الباطن للعامة، لا قيمة للناس أمام المال.
حتّى ولو جمعنا حبّ الكون كلّه بين أيّ حبيبين، سيقتل الواقع حبَّهما؛ لأنّ الحب بمفرده لا يساوي شيئا، قد يكون تعبيرا عن راحة داخلية لكنّ استمراره يعتمد على الظروف الخارجية.
وهناك مقولة أوغندية أعتقد أنها اختصرت كلّ شيء:
الرجل الوحيد الذي يحبّ المرأة الفقيرة هو .. والدها.
المرأة الوحيدة التى تحب الرجل الفقير هي .. والدته.
لله من عبارة بليغة، فحبّ الأم وحبّ الأب حبّ فطري بحت، حبّ دون مقابل، لا يشوبه أيّ شيء (يعززه أو يقلله)، قد يظهر أنه متخلخل بين الابن ووالديه، ذلك بسبب التفاوت العقلي واختلاف الظروف، وإلا هو جوهريا كما هو.
عداه فإنّ كلّ حبّ في الكون بُنِيَ على الفطرة بمفردها آل للفشل الذريع؛ لأنّه حبّ يحتاج لمكمّل له، فهو ليس فطريّ بحت كما يتصور صاحبه، إذ أنّه إسقاط لتولّد غاية غريزيّة تبحث عن الاستقرار والسكون لسدّ النقص في النفس.
وكما يقال لو تزوّج قيس ليلى لطلّقها بعد ثلاثة أيام!
وكلّ ما ذكرت من تحديد دقيق لغايات النفس البشرية ليس شيئا مستحدثا، أو نتاج ايدولوجيا أو اتجاهات فكرية معينة، إنما فطرة مفطورة من الله تعالى.
لكنّ الكيفية التي تقود للتوازن العقلي والتمسّك بخيط الحقيقة تباينت بشدّة بين العقل القديم والعقل المعاصر.
فبدأ الإنسان المعاصر بالتأثّر الشاسع بمجرد أنّه لمح أُدُمَ وعنوانات المفاهيم دون التعمّق بموضوعاتها، كونها متعبة ومنهكة لعقله الذي تعوّد على السرعة، وهو ما قاده لإيقاض غرائزه وغاياته الزائلة؛ كونه لم يدرك الالتزام والمسئولية والإخلاص. باتت تلك المفاهيم يوما بعد يوم شيئا عابرا وثانويّا وليست مقاييسًا لعيش حياة كريمة، بل هناك اشياء أهم بكثير، فعلى الإنسان أن يسير للأمام ويترك القواعد والقوانين التشريعية والدينية المستهلكة -حسب وصفه-.
و كما عجبت من أحد الأصدقاء عندما ترك معلقة زهير بن أبي سلمى في منهجه الدراسيّ ولم يحفظها معللًا أننا في زمن الحداثة والتقدم، ما فائدة هذه الخزعبلات، وما لي سوى أن ضحكت بتحسّر وتعجّب ... فنحن في زمن السرعة والتقدّم، وقد فشل الإنسان المعاصر في التعامل مع الحداثة.
صار آلةً مبرمجة تخلو من العواطف والمشاعر، يسير ولا يعي وجهته، يتخبّط بالعابرين وينسى أنّ نصيحة المتأنّي -الذي يستخفّ به- خير من الركض بلا دراية.
***
عباس القسام