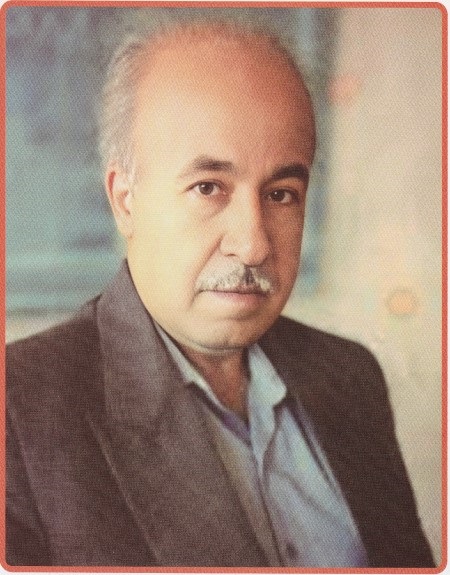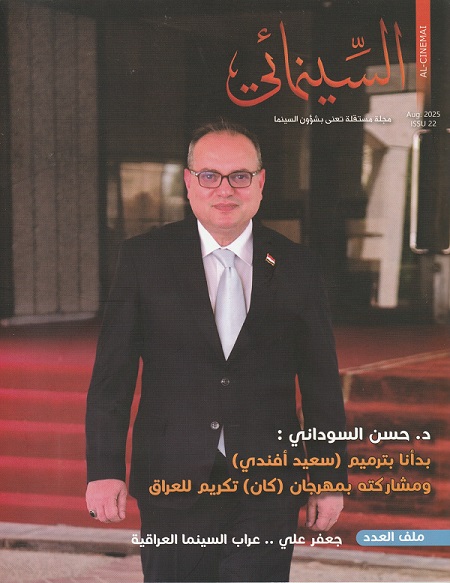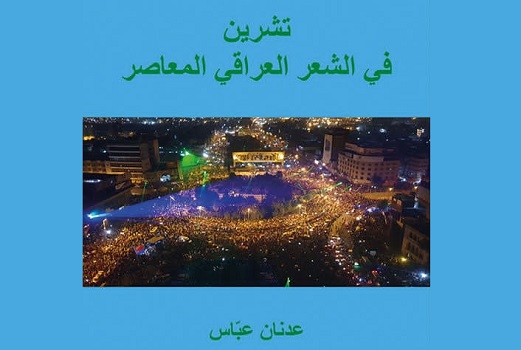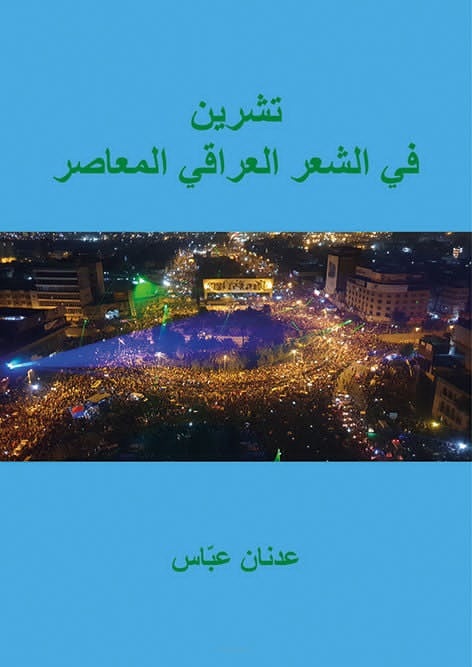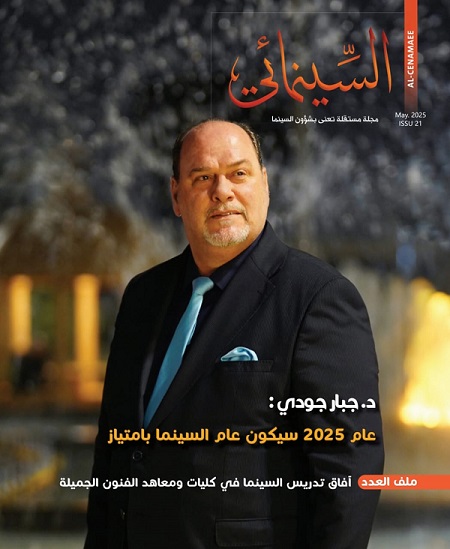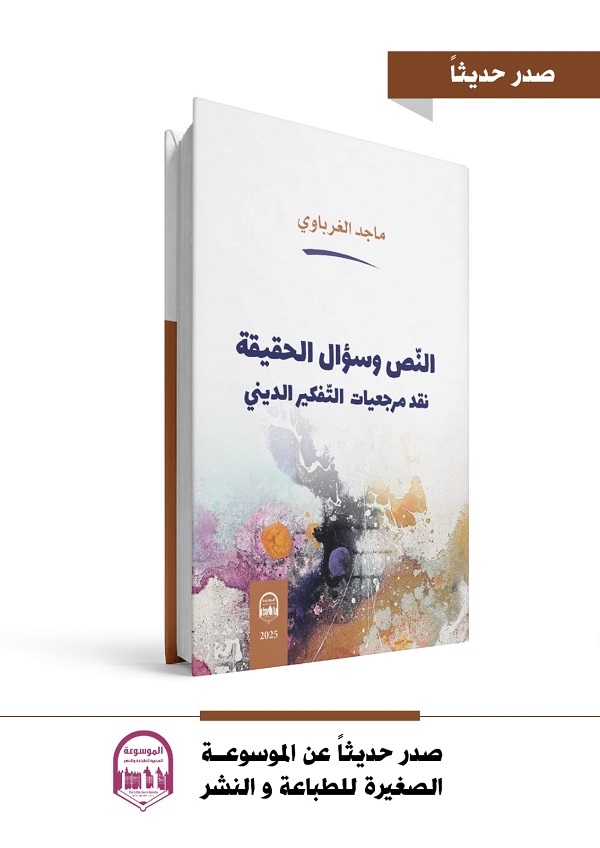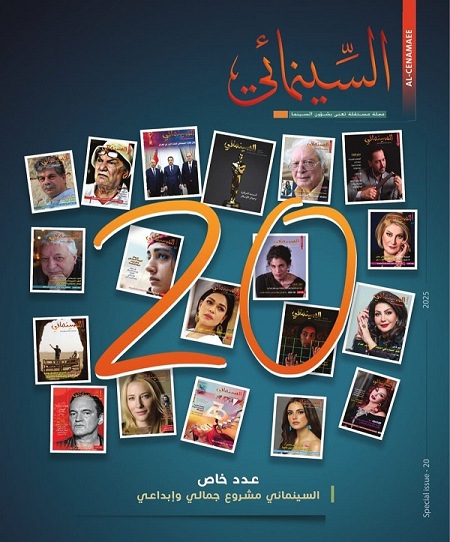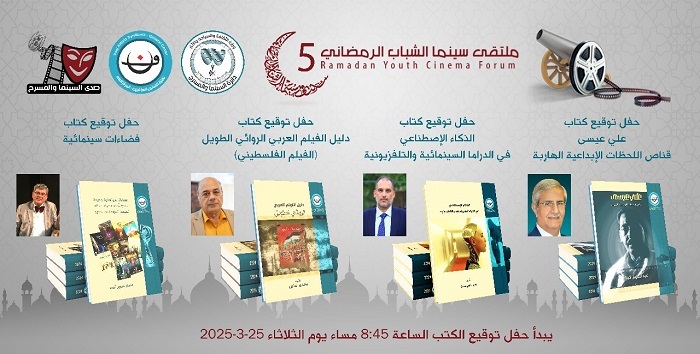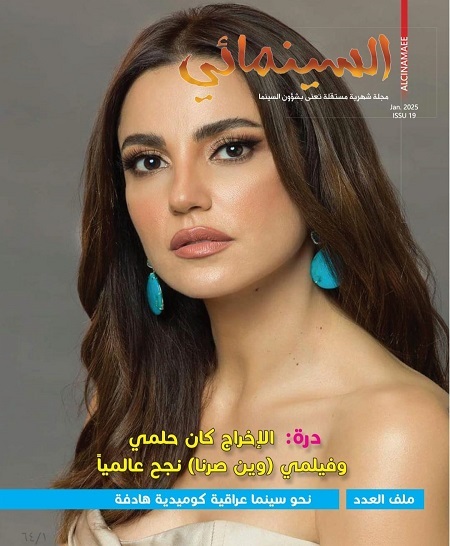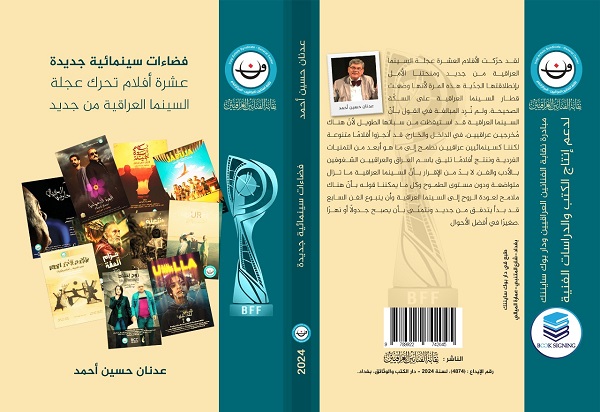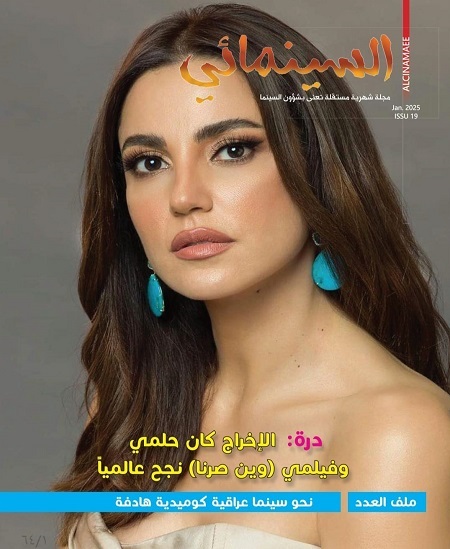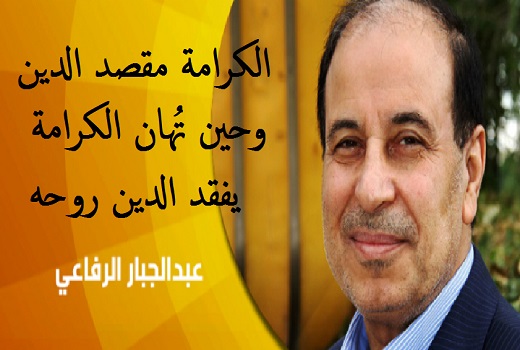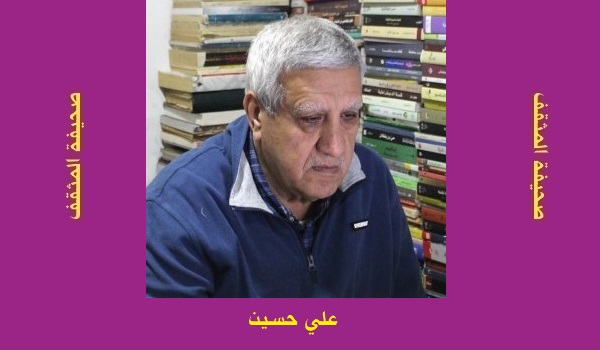صدر عن وكالة الصحافة العربية (ناشرون) الكتاب السادس والثلاثين للكاتب المصري بليغ حمدي إسماعيل أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بكلية التربية جامعة المنيا بعنوان " توجهات معرفية معاصرة في تعليم التربية الدينية والإسلامية"، ويتناول هذا الكتاب قضية مهمة وهي تعليم التربية الدينية الإسلامية، حيث يتميز عالم اليوم بالتقدم الهائل في المعارف الإنسانية والمكتشفات العلمية، وانفتاح المجتمعات بعضها على بعض، وظهور ما يسمى بالعولمة، وكثرة المذاهب والتيارات الفكرية.وهذا التطور والتغير السريع في نواحي الحياة كافة، وبخاصة النواحي المادية ووسائل الحياة المعاصرة لم يواكبه اهتمام مماثل بالنواحي الروحية والوجدانية،مما ترتب عليه كثير من المشكلات المتنوعة كالإدمان، والتطرف، والانحلال الخلقي،والتلوث البيئي، وانتشار الجرائم وغير ذلك من مشكلات أساسها اختلال التوازن في جوانب شخصية الفرد.
ويؤكد المؤلف على أنه في ظل هذه الظروف تأخذ التربية الإسلامية أهميتها القصوى في بناء الأفراد والمجتمعات، باعتبارها من أقوى المؤثرات في إعداد الفرد إعداداً شاملاً روحياً وعقلياً واجتماعياً وتنشئته في ظل المبادئ والتعاليم الإسلامية، وحمايته من الظاهرات السلبية، وفي الوقت نفسه تعد التربية الإسلامية خير ضمان لتنمية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وتأكيد ذاتيته وهويته، وتحقيق الضبط الاجتماعي بين أفراد المجتمع..
كما يشير بليغ حمدي إسماعيل في كتابه إلى أن المجتمع العربي الذي يواجه مشكلات عديدة في حاجة ماسة إلى شئ من التوازن بين التقدم المادي والتقدم الروحي، وبين ما ينشده من رقي مادي وملاحقة التطورات العصرية وما يحفظ هويته وذاتيته الثقافية، وذلك حتى يتمكن المجتمع العربي من التطور في شكل أكثر استقراراً واتزاناً، والتربية الإسلامية هي المصدر الذي يمكن أن يتحقق كل هذا من خلاله..
فالتربية الإسلامية تكفل نهضة المجتمع وتقدمه، وحمايته واستقراره، وذلك بما تبثه من مبادئ إسلامية في نفوس أفراده، وتحثهم على العمل والإنتاج، وتربط الإيمان بالعمل الصالح وذلك في كثير من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وذلك في إطار الإخلاص، والإتقان.مما يعمل على نهضة المجتمع وتقدمه، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في كثير من الآيات كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً (الكهف 107).
كما تهيئ التربية الإسلامية أفراد المجتمع للدفاع عن أوطانهم، وحماية مقدساتهم، ومجابهة أعدائهم، بتربيتهم على أخلاق الجهاد في سبيل الله، وما يتصل بذلك من القوة الجسدية والعقلية والاجتماعية، وذلك كله مما يدخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة (الأنفال - 60)، وما هذا الإعداد إلا خطوة لحماية الوطن، وتحقيق السلام،وتنمية المجتمع، وعمارة البلاد.
وتظهر حاجة المجتمع واضحة للتربية الإسلامية؛إذ تفتح أمامه مجالات الإبداع،لإنهاء حالات الضعف الحضاري التي وقع فيها، وتهتم بإعداد وتأهيل القوى البشرية اللازمة لكافة قطاعات العمل والإنتاج، وتعمل على إكساب أفراد المجتمع القدرة على التكيف الاجتماعي الإيجابي مع التغيرات الصحيحة واستيعابها، والمساهمة الإيجابية في إحداثها في إطار الأهداف الإسلامية، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه التربية الإسلامية من وحدة فكرية تربط بين أفراد المجتمع أساسها وحدة العقيدة،التي تشكل وحدة عضوية تحقق الانسجام بين أعضاء المجتمع.
ويحرص الكتاب على تأكيد حقيقة مهمة مفادها إذا كان المجتمع عبارة عن مجموع أفراده، فإن التربية الإسلامية توجه الاهتمام الأكبر إلى تنمية الأفراد روحياً ونفسياً وعقلياً وسلوكياً.فمن الناحية النفسية تعد التربية الإسلامية وسيلة لإشباع الحاجات النفسية والروحية، وحاجته إلى الأمن والحب والولاء والعطف، والتربية الإسلامية وسيلة لضمان الراحة النفسية، وبخاصة إذا ما أحاطت بالفرد المتاعب، ونزلت به المصائب والمشكلات،كما أنها تعطي الفرد إحساساً بالذات، وشعوراً بأهميته الاجتماعية، فيزداد ثقة في نفسه،وإيماناً بقدرته.
ويعضد الكتاب حاجة مجتمعاتنا العَربيَّة والإسلاميَّة إلى خطابٍ إسلاميٍّ جديدٍ، وليس مجرد التَّطوير في مظهرِه القَائم على فِكرةِ الطلاءِ الخَارجيِّ، وإنما يتطلب فعل التَّجديدِ تغييرا نوعيًّا في بنيةِ الخِطابِ وأولوياتِه، وموضُوعاته، ومن ثمَّ إعادة صيَاغةِ أطروحاتِه، وتجديد وتحديث تقنيات هذا الخطاب ووسائله، والأهم من ذلك تَطويرِ قُدراتِ حَامِلي هذا الخِطَاب ومنتجيه أيضا؛ من أجل تلبيةِ احتياجات الفردِ والمجتمعِ في ظل الظروف الآنية، والإحداثيات المتسارعة الراهنة، واستجابة للتَّحديات التي تواجه المجتَمعَات العربيَّة، في سياقِ حركةِ تفاعلها مع ما يَجري حولها وفق مُعطَياتِ التَّثوير التُّكنُولُوجي من نَاحية، والتَّوجُّهَات المعرفيَّة المعاصرة من ناحيةٍ أخرى.
ولهذه الأسباب، يؤكد بليغ حمدي إسماعيل في كتابه أن الحاجة دَعت إلى خطابٍ دينيٍّ بنائيٍّ وليس إنشائيا؛ يدفع حركةَ المجتمع عبر الفرز بين قيم التحلِّي وقيم التخلِّي، ويسعى - هذا الخطاب الديني - إلى إدراك سنن التغير الحضاريِّ، بحيث يعيد للإنسانِ المسلم دوره وفاعليته وحضوره في حَركةِ المجتمعِ. وهذا الخطابُ ينبغي أن ينبعَ أولا من طبيعةِ الإسلامِ الذي ينطوي على دعوة مستدامة إلى التجديد، وهذه الدعوة تستمد مشروعيتها من الحديثِ النبويِّ الشريف.
وأكد بليغ حمدي إسماعيل في مقدمة الكتاب على أن التَّجديدُ لا يعني تغيير جوهر الدين أو أصوله، وإنما يعني إعادته إلى النَّقاءِ الذي كان عليه يوم نشأته؛ حيث الأصالة الفكرية لأركانِهِ وثوابتِه، عن طريق تجديدِ الإيمان به والالتزام بتعاليمه الصحيحة بعيدًا عما قد يعتريها من لغطٍ وشوائب، فضلا عن قدرته على استيعاب مستجدات العصر وتوجهاته المعرفية المعاصرة، وما تحمله من قضايا لم تكن معروفة من قبل، وهي بذلك بحاجة إلى بيان وتوضيح موقف الدين منها.
وحرص المؤلف إلى الإشارة إلى أن المقصود بالتجديد هنا هو تجديدِ الخطاب ِوالفكر الإسلاميِّ، ويحسن التمييز بين النص الديني من ناحية، والفكر والخطاب الديني من ناحية أخرى. فالنص يتمثل في القرآن الكريم والحديث الشريف الصحيح والثابت وهما أصلان يتسمان بالثبات المطلق والأصالة، وهو نص يحمل بين طياته التجدد التلقائي، الأمر الذي يسمح له بالوفاء بالاحتياجات الطارئة والمستقبلية. أما الخطَاب الديني، فهو ما يتعلق بالفكر الذي اجتهد في استنباط أحكامه من النص الثابت، وهذا الخطاب هو أولى بالتجديد نظرًا لعوامل أعاقت تجديده وتطويره.
ولا شك أن قضيةَ تجديدِ الخطابِ الدينيِّ تحتل أهمية بالغة في وقتنا الراهن؛ نتيجة لما يرتبط بهذا الخطاب من التباس، وبما يكتنف بعضه من غموضٍ قد يخرجه - أحيانا - عن جادةِ الصوابِ، من قبل فريقٍ يسعى جاهدا بأدوات فقيرة استغلال قضية تجديدِ الخطابِ الدينيِّ للعبث بأصول الدين وثوابته وأعمدته الرئيسة، وفي مقابل هذا الفريق نرى فريقا آخر يجلس على الشاطئ المقابل يرى أن أية محاولة لفتح باب التجديد هو خروج عن الإسلامِ ويجب مقاومته والتصدي له.
ويبرر بليغولأهمية وضرورة تجديد الخطاب الديني المعاصر،فقد تعددت صور المحاولات الرسمية للمساهمة في تجديد الخطاب الديني وتطويره، فجاءت وثيقة الأزهر الشريف في الحادي والعشرين من يونيو عام 2011م لتؤكد على ثمة مبادئ رئيسة في تجديد الخطاب الديني منها الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والطفل والمرأة، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية واعتبار المواطنة مناط المسئولية في المجتمع، كما أكدت وثيقة الأزهر على ترسيخ قيم حب الوطن والوحدة الوطنية والدفاع عن الأرض وتأكيد العزة الوطنية، وإعادة بناء المسلم المعاصر ليكون إنسانًا حضاريا فاعلا في مجتمعه ومنتجًا؛ يفهم حقيقة الإسلام ومهمته وهي عبادة الله وتعمير الأرض، كما ركزت الوثيقة على نبذ العنف،وتأكيد قيمة الحوار وترسيخ أدب الاختلاف في الرأي بحيث يتم التمسك بالطرق السلمية في التغيير، والتحول من فكرة تفجير الجسد إلى تفجير طاقات العقل.
كما سعت الدولة المصرية إلى المشاركة بصورة رسمية في محاولات التجديد، وكان دليل هذا الاهتمام هو صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم (51) لسنة 2014م بتنظيم ممارسة الخطاب الديني في المساجد وما في حكمها، وينص هذا القانون على بحث ودراسة كل ما يتصل بالبحوث والدراسات الإسلامية، والعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي وتحليتها في جوهرها الأصلي الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة. كما نص القانون على ضرورة تتبع كل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج والانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد، وكذلك بحث ودراسة كل ما يستجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بالعقيدة أو غيرها، وبيان الرأي الشرعي فيها (رئاسة الجمهورية، 2014: 64 -66).
وفي نفس الصدد، استجابت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المصرية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد الخطاب الديني المعاصر؛ فقدمت بالتنسيق مع المثقفين ورموز السياسة والفكر وعلماء الدين وثيقة وطنية لتجديد الخطاب الديني في مايو 2015م، جاء في نصها " تجديد الفكر الديني يعني تجريده مما علق به من أوهام أو خرافات أو فهم غير صحيح ينافي مقاصد الإسلام وسماحته وإنسانيته وعقلانيته ومصالحه المرعية ومآلاته المعتبرة، بما يلائم حياة الناس ويحقق المصلحة الوطنية، ولا يمس الأصول الاعتقادية أو الشرعية أو القيم الأخلاقية الراسخة ".
وأكدت الوثيقة على ضرورة أن يتجه الخطاب الديني المعاصر إلى الأخذ بالتوجهات المعرفية مثل إعمال العقل، وتنمية الإبداع، وتعزيز المشتركات الإنسانية، وترسيخ المعاني الوطنية وإشاعة روح التسامح والمودة بين أبناء الوطن جميعًا، واحترام حق التعددية الاعتقادية والفكرية، فضلا عن تأكيد الوثيقة على ضرورة بناء مناهج التربية الدينية الإسلامية على معايير ومؤشرات تعزز الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وضرورة الإلمام الجيد بالثابت والمتغير وتطبيقه على الواقع المتغير (وزارة الأوقاف،2015).
كما عقد الأزهر الشريف عِدَّة جلسات برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر جمعت هيئة كبار العلماء مع نخبة من الكُتَّاب، تم فيها جمع الأفكار التي طرحها المشاركون، وصياغتها، لإصدار وثيقة الأزهر لتجديد الخطاب الديني والتي صدرت في 26 يونيو 2016 م، حيث دعت هذه الوثيقة إلى رفع راية الاجتهاد ووجوب إعلان انتهاء عصر التكفير وبداية عصر التفكير، وضرورة احترام الاختلاف في الرأي، وتضمنت الوثيقة تحديد مفهوم التجديد باعتباره سنة الله التي فطر الناس عليها، إذ استخلف الإنسان في الأرض وحمله رسالة عمرانها وصنع الحضارة فيها، كما ورد في محكم الآيات: «هو الذى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» وكما أكدت السنة النبوية الشريفة فى الإشارة إلى من يبعثهم الله على رأس كل مائة عام لتجديد الدين، وكما تقتضى طبيعة الحياة التي تناقض العقم والجمود والموات.
ونصت وثيقة الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني على ما يلي: " لأن التجديد لا يتم بالطفرة التي تقفز على الواقع ولا بالقطيعة التى تنفصم عن الماضي فإنه يجب الاعتداد بما انتهى إليه فكر كبار المجددين في الإسلام، خاصة في العصر الحديث، ابتداءً من الرائد الشيخ رفاعة الطهطاوي وامتصاصه الحكيم لصدمة الحداثة، إلى الإمام محمد عبده الذى أبرز عالمية الإسلام وسبقه إلى أعظم القيم المعاصرة والشيوخ الكبار مصطفى وعلى عبدالرازق وعباس محمود العقاد وطه حسين والشيخ شلتوت وغيرهم من أعلام الدين والفكر والثقافة والنهضة حتى اليوم واعتبار ما أسفر عنه هذا التراث البناء القريب خطوات صائبة في التطور والتحديث، بما تهدف إليه من ترسيخ العقائد الثابتة، وتطوير التشريعات.
ويبرر بليغ حمدي إسماعيل في مقدمة كتابه إلى أن هناك ثمة عوامل وأسباب تدفع بضرورة الجدية في تجديد الخطاب التربوي الديني، يمكن حصرها فيما يلي:
1- الفهم الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة، وتصدر اشباه المثقفين للفتوى، والتسرع في إصدار الأحكام الشرعية دون روية.
2 - ظهور خطاب ديني متشدد يعتمد التكفير منهجا له وعقيدة وسلوكًا يسعى إلى نشره، والترويج له بشتى الطرق والوسائل.
- تكاثف المستجدات الاجتماعية التي صارت بحاجة إلى قول فصل لحسم النزاع بشأن هذه المستجدات والروافد الاجتماعية المعاصرة.
3 - عدم مراعاة ومناسبة لغة الخطاب ونوعه من حيث الاعتماد على الجوانب النقلية والعقلية للفئة التي يتم التعامل معها.
4 - الانشغال بالدفاع دون محاولة إنتاج فكر ديني جديد أو حتى إعادة الأفكار الأساسية للدين للظهور مرة أخرى.
5 - ما أصاب المؤسسة الدينية من أزمة في علاقتها بالعصر، والمعارف الحديثة؛ حيث انغلقت على نفسها، وانشغلت بالعلوم القديمة والتقليدية وقطعت جسور التواصل مع مجتمعاتها.
7 - بث الثقافة الحزبية والحركية على أنها الخطاب الأمثل المعبر عن الدين الإسلامي دون سواه.
8 - إفراز العولمة بتغيراتها الاجتماعية والاقتصادية مجموعة من الأخلاقيات الجديدة انحازت في معظمها إلى جانب القيم والقضايا المادية الاستهلاكية بعيدًا عن القضايا الإنسانية والروحية.
9 - افتقاد الوعي بموقفنا الحضاري، وإسراف العقل العربي في الجمود والتقليد الأعمى للسلف والمحاكاة بغير إعمال للعقل في تأويل هذه المحاكاة.
10 - محاصرة الشباب المسلم بمصادر الثقافة والإعلام الغربي التي باتت تهدد عمق الشخصية المسلمة .
11 - القطيعة في مجال إنتاج وإعادة إنتاج القيم الدينية وبروز فئات ونخب جديدة عملت على منافسة السلطات الدينية والرسمية، وهي تيارات فكرية بعيدة عن تعاليم الأديان السمحة.
12 - تصاعد موجات الإرهاب الدامي وحفلات القتل الجماعي باسم الدين، والأعمال العنيفة التي واجهها بعض الدول العربية والإسلامية.
13 - وجود أعداد لا يستهان بها من أهل الدين المهمومين بمصالح الأمة ومستقبلها تطالب بتجديد الخطاب الديني على نحو ينسجم مع الذائقة الثقافية، كما ينسجم مع المفاهيم والأوضاع الجديدة التي بثتها العولمة وإفرازاتها الثقافية.
والكتاب يقع في ٣٩٤ صفحة من القطع المتوسط وهو صادر في يناير ٢٠٢٦ عن وكالة الصحافة العربية ناشرون بالقاهرة.
الكتاب: توجهات معرفية معاصرة في تعليم التربية الدينية والإسلامية
المؤلف: اد. بليغ حمدي إسماعيل
الناشر: وكالة الصحافة العربية ناشرون
سنة النشر: ٢٠ يناير ٢٠٢٦.