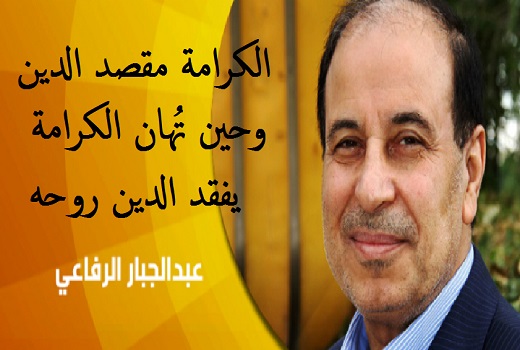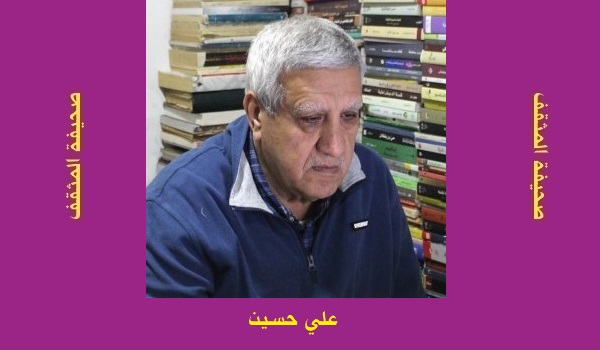كتب واصدارات
احمد المغير: عرض لكتاب "التفكير العلمي" للدكتور فؤاد زكريا

في سلسلة قادمة سنقوم أن شاء الله بتلخيص كتب مهمة عربية واجنبية ونخصص مقالة قصيرة بما لا يزيد عن عدة صفحات لكل كتاب نستعرض فيها اهم ما جاء في الكتاب.
في هذه المقالة سنحاول أن نعرض تلخيصاً شديدا لكتاب (التفكير العلمي) الذي صدر عام 1978 ضمن منشورات سلسلة (عالم المعرفة) التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، وهو من تأليف د. فؤاد زكريا، وهو باحث يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة من جامعة عين شمس.
يتألف الكتاب من مقدمة وسبعة فصول وخاتمة وعرض الكاتب فيه بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التفكير العلمي وسماته، العقبات التي يواجهها، نقاط التحول الرئيسية في تاريخ العلم، العلاقة بين العلم والتكنولوجيا ووضع العلم في القرن العشرين والتطور الذي حدث للعلم بعد الاندماج النظري والتطبيقي في مجال التكنولوجيا، كما تعرض الكتاب إلى العلاقة بين العلم والمجتمع، وأخيراً تطرق المؤلف إلى قضية مهمة وهي سمات العلماء والعناصر الأخلاقية لشخصية العلماء وثقافتهم كعامل هام في التفكير العلمي.
في الفصل الأول يعرض المؤلف أنّ التفكير العلمي مرّ بمراحل طويلة وعقبات كثيرة اكتسب خلالها سماته الخاصة، وبلغ نتائجه النظرية والتطبيقية بعد ان غير العقل أساليب التفكير القديمة بخصائص وسمات تتسم بها المعرفة العلمية باختلاف مجالاتها والتي تعتبر مقياس الحكم على نمط التفكير الذي يقوم به الإنسان ومنها:
التراكمية: باعتبار أن العلم حركة مستمرة. التنظيم: ويعني ضبط المعرفة العلمية وترتيبها لإبعاد المعرفة العلمية عن التلقائية والعفوية. البحث عن الأسباب: أي البحث عن الظواهر وفهمها وتفسيرها سعيا إلى فهم أعمق لها ولمعرفة أسبابها. الشمولية واليقين: لأنّ المعرفة العلمية شاملة وتجري على في جميع أجزاء الظاهرة التي يبحثها العلم. الدقة والتجويد: التفكير العلمي ينهج الدقة في معالجة الظواهر ويبتعد عن الغموض.
عقبات في طريق التفكير العلمي التقاليد الموروثة مثل (الأسطورة والخرافة) التي ظلت تحتل مكاناً كبيراً طوال فترة طويلة من تاريخ البشرية؛ فالأساطير القديمة كانت الوسيلة الوحيدة لتفسير الظواهر قبل ظهور العلم. (الخضوع للسلطة) أو التحرر من سلطة عالم أو مفكر ما، والتي شكلت بدورها عقبة كبيرة أمام العلماء في العصر الحديث إذ كانت آراء أرسطو حول (مركزية الأرض) تسيطر على تفكير الناس خلال فترة طويلة الى حد يشبه التقديس، وكان لهذه الآراء سلطة على فئة من العلماء، مما ادى لانتشارها بين عامة الناس لدرجة الدفاع عنها دون تفنيد صوابها أو خطأها. (إنكار قدرة العقل) وهي عقبة لا تزال في طريق تقدم العلم، إذ أن هناك من يؤمن بقوة الحدس أكثر من قوة العقل في تفسير العلاقات بين الظواهر، لذلك نجد الكاتب يدافع عن العقل ويرى بأن العقل قدم انجازات للبشرية خلافاً لأنصار (الحدس) الذين شنوا هجوما على العقل. (التعصب) الذي يتخذ شكل حماس عالي لرأي يقول به شخص أو لعقيدة أو ايديولوجية يؤمن بها، بل الأخطر من ذلك أن يقف هذا التعصب في طريق العلم حين ينكر الفرد فضائل الآخرين ويهاجمها. (الإعلام المضلل) ذلك لأن وسائل الإعلام اقتحمت كل البيوت، وأصبحت تخاطب كافة أفراد الأسرة عبر تقديم مواد الترفيه والتسليه. على أنّ دورها أصبح حاسما ومؤثرا إذ أنها يمكن أن تلعب دوراً مهماً في نشر قيم التفكير العلمي أو هدمها من خلال برامجها.
المراحل الرئيسية في طريق العلم يشير المؤلف الى مراحل التحول الكبرى في تاريخ العلم حيث عرض ثلاث مراحل في تطور العلم
1-مرحلة العالم القديم وبدأ الحديث فيها عن الحضارات القديمة في الشرق خاصة الحضارة الفرعونية، إلا أنّه يشير إلى أنّ الحضارة اليونانية القديمة تميزت خلافاً للحضارات الشرقية بتوافر القدرة التحليلية التي تعتمد على البراهين المقنعة والعقل، وهنا نجد الكاتب يبين أنّ العلاقة بين الحضارات الشرقية القديمة والحضارة اليونانية القديمة تمثل في أنّ الأولى ركزت على الخبرة العملية بينما ركزت الثانية على ميدان البحث العلمي النظري. أي أنّ المؤلف لا يتفق مع رأي الكتاب الغربيين من أنّ العلم نشأ في العالم الغربي على الرغم من عدم إنكاره لدور اليونانيين والحضارة اليونانية في العلم النظري والهندسة. وعليه يرى المؤلف بأنّ اليونانيين لم يستطيعوا الجمع بين العلم النظري والتطبيق، بل ركزوا على الجانب النظري، ويرى المؤلف أنّ الحضارتين الشرقية والغربية أدى كل منهما دوراً هاماً في تشكيل معنى العلم خلال هذه المرحلة.
2-مرحلة العصور الوسطى، وهنا يفصلها إلى عصور وسطى في أوروبا وعصور وسطى في العالم الإسلامي، وذلك للتفاوت الهائل في العلم بين كل منهما. فالعصور الوسطى في أوروبا شهدت عصر التخلف والركود الفكري، بينما العصور الوسطى في العالم الإسلامي شهدت ازدهار الحضارة الإسلامية. ويرى المؤلف بأنه طوال فترة العصور الوسطى في أوروبا لم يحرز العلم تقدماً هاماً في أي مجال، ولم يظهر جديد في العلم، بل احتفظت هذه المرحلة بأسوأ عناصر المفهوم اليوناني للعلم ولعبت دورا في تجميدها وتحويلها إلى ما يمكن تسميته بالعقيدة وذلك بسبب عقبة (الخضوع للسلطة) التي سبق الحديث عنها بعد أن توطدت العلاقة بين معتقدات الكنيسة المسيحية وآراء علماء العصر القديم أمثال أرسطو، لدرجة أنها أصبحت آراء مقدسة، وصار الاعتراض عليها ونقدها خروجا ونوعاً من الضلال، وهو ما انعكس على مفكري ذلك العصر الذين لم يضيفوا جديدا للعلم. وفي المقابل، اختلف الحال في العصور الوسطى في العالم الإسلامي التي كانت مختلفة تماماً عن أوروبا، إذ ظهرت حضارة جديدة اتسمت بالإيجابية والتوسع والانفتاح على العالم، وبوجه خاص الانفتاح الفكري لدى العلماء المسلمين في العصر العباسي الذي ترجموا ونقلوا معارف الأمم الأخرى، وظهرت مجموعة كبيرة من العلماء المسلمين في مجالات العلم المختلفة أمثال جابر بن حيان وابن الهيثم وغيرهم. وأضاف المسلمون إلى مفهوم العلم معنى جديداً هو الجمع بين العلم النظري والتطبيقي، بمعنى استخدام العلم من أجل كشف أسرار العالم الطبيعي وتمكين الإنسان من السيطرة عليه عبر وضع أسس علم الحساب والتفوق في الهندسة التحليلية وحساب المثلثات والكشوف الفلكية والأبحاث الطبية. و يؤكد المؤلف أنّ الاكتشافات العلمية للعلماء المسلمين كانت من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور النهضة الأوروبية الحديثة.
3- مرحلة العصر الحديث الذي شهد تفوق الحضارة الأوروبية، والتغير الذي حدث للعلم خلال هذه المرحلة بعد انفصاله عن الفلسفة. وبرزت خلال هذه المرحلة منهجية جديدة في التفكير العلمي لمعالجة الظواهر وهي (الملاحظة)، كما ظهر خلال هذه المرحلة في أوروبا مجموعة من العلماء الذين نادوا بإبعاد النظرة التفسيرية الفلسفية للعالم واستخدام (المنهج التجريبي) أمثال العالم الإنجليزي (فرانسيس بيكون)، وعلماء آخرون نادوا بتطبيق الجانب الرياضي العقلي للعلم العملي أمثال الفيلسوف الفرنسي (ديكارت)، إلا أنّ الميزة الهامة لتطوّر العلم خلال تلك المرحلة تمثّل في ظهور مبدأ (العمل الجماعي) وذلك خلافاً للعصور السابقة التي كان جهد العلماء فيها عبارة عن (أعمال فردية) تختفي مع اختفاء العالم، ومن ثم بدأ العلماء بإيجاد وسيلة (الرسائل المتبادلة) وتغييرها لاحقاً الى تأسيس (الجمعيات العلمية) بهدف تبادل الأبحاث والرسائل العلمية، وكانت أول جمعية تأسست هي جمعية فلورنسة في إيطاليا عام 1657، والجمعية الملكية في لندن عام 1662، وغيرها من الجمعيات التي تأسست لاحقاً في فرنسا وألمانيا وساهم تأسيس هذه الجمعيات في دعم الأبحاث العلمية.
العلم والتكنولوجيا يعرض المؤلف الى العلاقة بين العلم والتكنولوجيا وهي ظاهرة جديدة تميز بها العصر الحديث عن غيره من العصور. فقد عرض المؤلف معنى التكنولوجيا وصلتها بالعلم منذ مراحله الأولى. ويؤكد المؤلف أنّ التكنولوجيا في مفهومها البسيط تعني التطبيق العملي للمعرفة العلمية. ويرتبط مستوى التكنولوجيا مع حاجة المجتمعات لأنّ الاختراع العلمي لا يظهر إلا إذا كانت الظروف الاجتماعية مهيأة لظهوره.
لمحة عن العلم المعاصر انتقل المؤلف هنا للحديث عن حالة العلم والوضع الذي وصل إليه حتى القرن العشرين، وكما هو معروف فإنه حدثت في القرن العشرين ثورة كمية وكيفية هائلة في اﻟﻤﺠالات العلمية وهذه الثورة العلمية اتسع معها نطاق العلم إلى حد كبير، وحظيت الإنجازات العلمية التي تحققت بأهمية كبرى. وتحققت أهم الإنجازات العلمية خلال القرن العشرين وأهمها
1-إنجاز الطاقة الذرية علي يد العالم ألبرت آنشتاين ومعاونيه وهو ما عرف بـمشروع مانهاتان ونتج عنه ظهور السلاح النووي والقنبلة الذرية التي أستخدمت في الحرب العالمية الثانية، بل إنّ نجاح هذا المشروع أحدثا تغيراً في المنظومة الدولية، فتطورت الأسلحة في الميدان العسكري من القنابل الذرية إلى القنابل الهيدروجينية، وهكذا نشأ ميزان الرعب النووي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي.
2- ظهور علم السبرنطيقا على يد العالم نوربرت فينر الذي كانت أبحاثه هي الأساس الأول لاختراع العقول الإلكترونية، وشكّل ظهور هذا العلم خطوة جبارة في طريق التقدم العلمي.
3-الإنجاز العلمي الثالث تمثل في غزو الفضاء وهو انجاز ارتبط بإنجاز الطاقة الذرية والعقول الالتكرونية – وكان الاتحاد السوفيتي هو الذي افتتح عصر السفن الفضائية التي تطلقها صواريخ قوية من قواعد أرضية وكان اهمها إطلاق القمر الصناعي سبوتنيك 1 في عام 1957 و إنزال أول إنسان على القمر في عام 1969.
الأبعاد الاجتماعية للعلم المعاصر يشير المؤلف هنا إلى أنّ العلم يتفاعل مع المحيط والمجتمع الذي يظهر فيه وبعبارة أخرى فإنّ هناك بعد اجتماعي يؤثر على العلم، وهناك تأثير متبادل بين العلم وبين أوضاع المجتمع الذي يظهر فيه. وهناك حقيقة مهمة يؤكد عليها المؤلف وهي أنّ العلم أو الاختراع العلمي يحتاج إلى تضافر عاملين هما الحاجة الاجتماعية والعبقرية الذهنية. على أنّ نجاح العبقرية مرتبط بالحالة الاجتماعية، أي لابد أن يكون المجتمع مهيأ للقبول حتى يكتب لها النجاح. ونجد ذلك في حالة ابن خلدون الذي أشار في (مقدمته) المشهورة إلى المقومات الرئيسية للدراسة العلمية للمجتمع البشري والتي أسماها بـ (علم العمران)، إلا أن نبوغ ابن خلدون لم يجد مجتمعاً يستجيب له، ولم تستمر حركة العلم الجديد الذي توصّل إليه عبر تلاميذ نقلوا منه علمه أو على الأقل عبر علماء أكملوا مسيرته، لدرجة أن نبوغ ابن خلدون لم يكتشف إلا بعد مرور قرون عديدة. العلم اكتسب أهمية كبرى قي حياتنا، وأصبح عامل حاسم في تحديد مصير البشرية. من هذا المنطلق تناول المؤلف قضايا هامة ومصيرية تواجهها البشرية في المستقبل، ومن هذه القضايا مشكلة الغذاء والسكان، مشكلة “البيئة والوعي بالأضرار التي لحقت بها، مشكلة الموارد الطبيعية المتعلقة بأزمة الطاقة وعلى رأسها النفط، مشكلة الوراثة والتحكم في صفات الإنسان، ومشكلة التسلح التي تعتبر مشكلة مصيرية يمكن أن تهدد حياة البشرية.
شخصية العالم هناك سمات محددة لشخصية العالم، وهي صفات تتوفر في عدد كبير من العلماء المبدعين. ومن هذه السمات نجد (سمة الروح النقدية) التي يقصد بها عدم تأثر العالم بالمسلمات الشائعة، وقدرته على نقد نفسه وتقبّل النقد من الآخرين، واختبار آراء الغير بذهن ناقد. السمة الثانية فهي (النزاهة) وتعني استبعاد العالم للعوامل الذاتية من عمله العلمي، والتحلي بالموضوعية بطرح مصالحه وميوله واتجاهاته الشخصية. السمة الثالثة فهي (الحيادية) وتعني أنّ العالم يجب أن لا ينحاز مقدماً إلى طرف من إطراف النزاع الفكري أو الخلاف العلمي، وإعطاء كل رأى من الآراء المتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسه، ووزن كل الحجج التي تقال بميزان يخلو من التحيز. وأخيراً (البعد الأخلاقي) إذ يؤكد المؤلف على أنه هناك علاقة وثيقة بين العلم والأخلاق، ولذا يجب توفر حد أدنى من السمات الأخلاقية في شخصية العالم، وعليه أن يكون واعياً بالقضايا المحيطة به، كما أنه يجب أن يتحلى بثقافة تجمع بين المستوى الإنساني كونه إنسان يمارس حياته كالاخرين والمستوى العلمي كونه عالم يتمتع بصفات لا تتوفر لدى عامة الناس.
***
تلخيص وعرض د احمد المغير