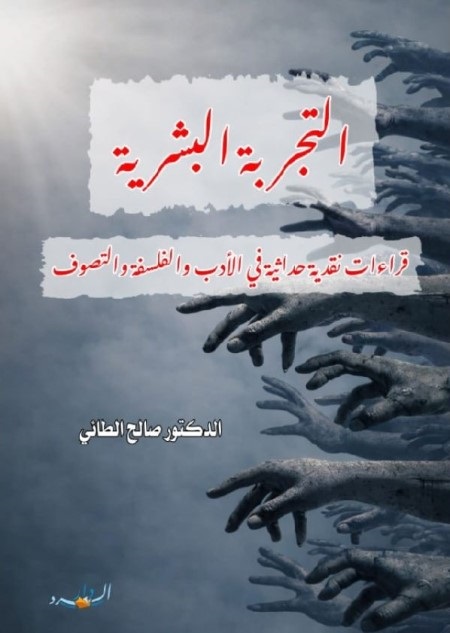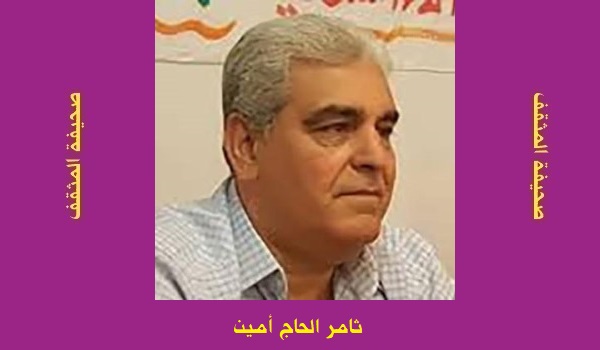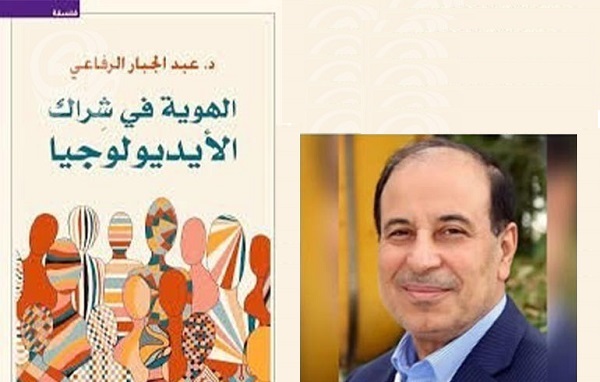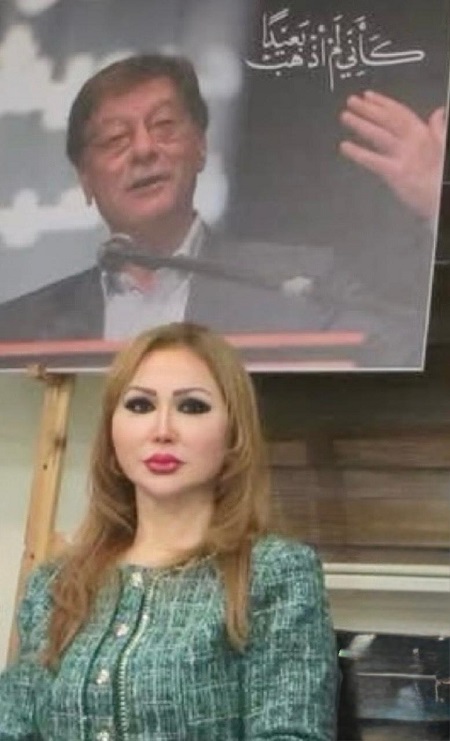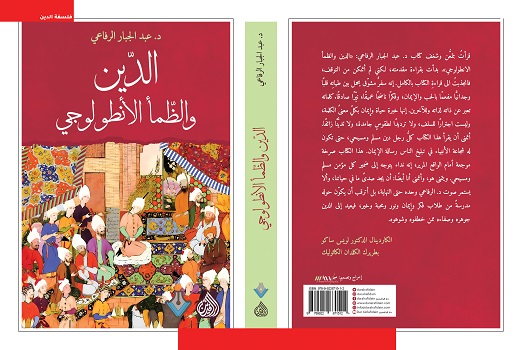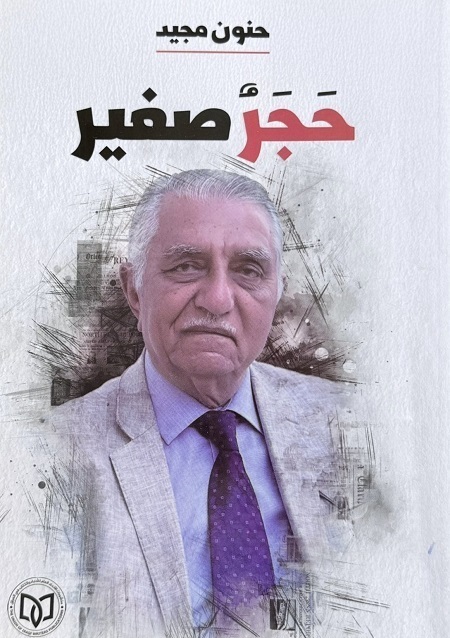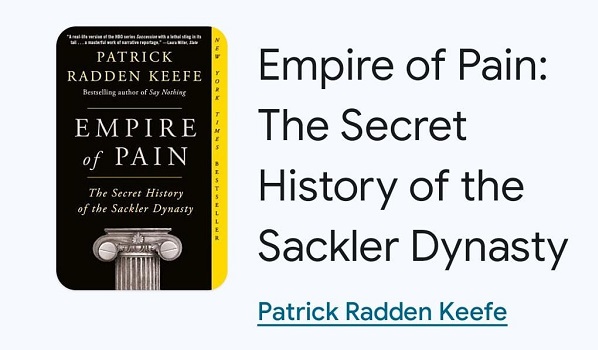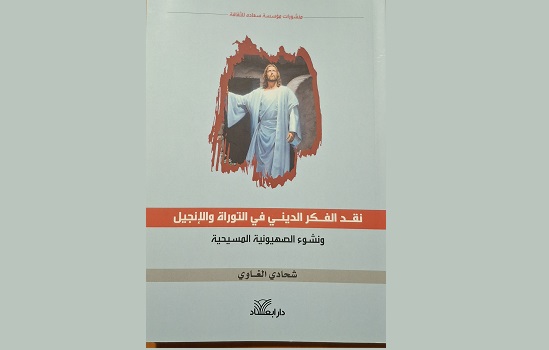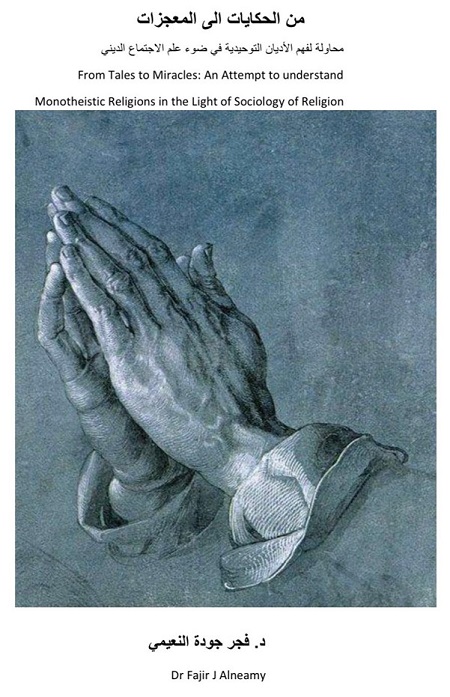"شبابيك اعتراف رقمية لصالح الكولونيالية الجديدة"
صدر حديثاً عن مؤسسة دار الصادق الثقافية كتاب بعنوان الإعلام الجديد ووسائل التواصل: شبابيك اعترافات رقمية لصالح الكولونيالية الجديدة للبروفسور الدكتور محمد كريم الساعدي، والصادر برقم معياري دولي: (ISBN: 978-9922-757-95-7)، وقبل الولوج في مضامين هذا المنجز العلمي، تقتضي الضرورة توضيح المفهوم الذي يرتكز عليه الساعدي وهو مفهوم الكولونيالية التي عرفها في أحد كتبه السابقة والذي يحمل عنوان (الإشكالية الثقافية لخطاب ما بعد الكولونيالية): بوصفها الشكل المحدد للاستغلال الثقافي الذي تبلور بالتزامن مع التوسع الأوروبي خلال القرون الأربعة الماضية. وعلى الرغم من أن حضارات عديدة سبقت أوروبا امتلكت مستعمرات خارج حدودها، فإن تلك الحضارات كانت تنظر إلى علاقتها بمستعمراتها بوصفها علاقة بين قوة مركزية كبرى وبين هوامش ثقافية محلية توصف عادة بالهامشية أو عدم التحضر.
لا شك أن التطورات التي أتاحتها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ومن ضمنها الإعلام الجديد وسائل التواصل قد أسهمت في إعادة تشكيل أنماط النظر والفهم والتحليل تجاه القضايا السياسية والاقتصادية الاجتماعية والعلمية والتعليمية والدينية، بما يعكس القدرة التحويلية العميقة لوسائل الإعلام الجديدة. وفي هذا السياق، يشير الدكتور محمد كريم الساعدي في كتابه (الإعلام الجديد ووسائل التواصل: شبابيك اعتراف رقمية لصالح الكولونيالية الجديدة (إنَّ تحول الصراع من الخارج إلى الداخل هو، في الأصل، لعبة غربية كولونيالية يقوم بها الغربي وعلى رأسهم أمريكا وهذه العملية هي مكملة لما حدث في القرن الماضي. فقد كان القرن الماضي قائماً على التقسيم وزرع بذور الخلافات على الحدود بين الدول. هذه السياسة البريطانية القديمة، التي اعتمدت مبدأ (فرق تســد).
كما أشار الكتاب إلى أن وسائل الإعلام الجديدة عامة ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة، تمارس نفوذاً قوياً في حياة الإنسان اليومية وتصوراتهم للواقع المعاش. ويشير المؤلف أيضا إلى أن تصوير وسائل الإعلام للواقع يمكن التلاعب به لخدمة أجندات سياسية أو أيديولوجية معينة.
هذا يكشف عن وجهة نظر عاقلة بشأن قوة وسائل الإعلام وتأثيرها. وينظر المؤلف في كتابه بوضوح رؤية إلى تأثيرات وسائل الإعلام الجديدة على أنها قوى ناعمة أعادت تشكيل الاتصال والمجتمع والسياسة، رغم الاعتراف بجوانبها التمكينية، إلا أنه يؤكد أيضا على الحاجة إلى تحليل ناقد لتأثيرها وقدرتها على التلاعب وتأثيرها على المواطنة والهوية. لذلك يتصور الدكتور محمد الساعدي بأن المنفذ الأول للكولونيالية الجديدة هي الولايات المتحدة الامريكية جعلها الفاعل الأول في منطقة الشرق الأوسط الجديد حيث يقول "بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام (۲۰۰۱) وظهور الأسباب المباشرة المتمثلة في فكرة الإرهاب وربطه بدول معينة، سبق ذلك عملية وصول الولايات المتحدة الأمريكية إلى سواحل الخليج العربي من خلال التدخل العراقي في الكويت والسيطرة المباشرة على مقدرات الشعوب في هذه المنطقة. هذا التدخل جعل من أمريكا الفاعل الأول في منطقة الشرق الأوسط وما حولها، من خلال فرض سطوتها بشكل مباشر على المنطقة، مما أوجد مفهوما مكملاً للكولونيالية القديمة، المتمثلة في الاستعمار القديم (فرنسا وبريطانيا)، وتوزيعهما لمنطقة الشرق الأوسط حسب اتفاقية (سايكس بيكو) ".
حيث يبين في هذا الكتاب موضوع في غاية الأهمية هو عملية تطبيق الولايات المتحدة الامريكية لمشاريعها التوسعية من خلال تطبيقين رئيسين هما:"
الأول: تطبيق خططها الجديدة دون أن تكون هي المبادرة بهذا التطبيق بشكل مباشر، كما حدث في العراق وأفغانستان. بمعنى آخر، جعل الدول المستهدفة نفسها تقدّم المبررات للتدخل والتحشيد الأممي لذلك، من خلال مؤسسات مثل مجلس الأمن الدولي.
الثاني: التحول في الصراع من الخارج إلى الداخل، بهدف شرعنة خططها في المنطقة، وجعل كل كيان قائم على صفة فئوية أو جهوية أو عرقية يأخذ دوره في هذا الصراع. والقصد هنا هو منح هذه الكيانات الدينية والعرقية والعنصرية مبررات لإظهار وجودها في هذه المنطقة ".
من خلال ذلك يمكن إن يمثل المبدأ الأول في سعي القوى الدولية إلى تنفيذ استراتيجياتها الجديدة دون الاضطرار إلى تحمّل كلفة المبادرة المباشرة بالتطبيق، وهو أسلوب شاع بصورة لافتة في العقود الأخيرة، كما تجسّد في التجربتين العراقية والأفغانية. ففي هذين النموذجين، لم يعد التدخل العسكري أو السياسي يُقدَّم بوصفه قراراً أحادياً تصدره القوة المتدخلة، بل بوصفه استجابة مشروعة لأزمات داخلية متفاقمة في الدول المستهدفة، أزمات يسمح لها بالتضخم، أو يسهم في تأجيجها بحيث تبدو كأنها تنتج مطالب التدخل لا رافضة له. وبهذا المعنى، تدفع الولايات المتحدة الامريكية، عبر ضغوط سياسية أو اقتصادية أو بنيوية، إلى إنتاج المبررات الذاتية للتدخل؛ مبررات يجري تدويلها عبر قنوات رسمية مثل مجلس الأمن الدولي، حتى يظهر التدخل الخارجي بمظهر الاستجابة الإنسانية أو الإجراء الوقائي لحماية السلم الدولي.
أما المبدأ الثاني فيرتبط بتحول أكثر عمقا في بنية الصراع، يتمثل في نقل مركز المواجهة من المستوى الدولي إلى قلب البنى الاجتماعية للدول المعنية. فبدل أن يجري الصراع بين دول وأنظمة سياسية واضحة المعالم، يعاد تدويره ليصبح صراعا داخليا متشظياً تتصارع فيه المكونات الطائفية والجهوية والإثنية على الشرعية والتمثيل والسلطة. ويهدف هذا التحول إلى إضفاء الشرعية على الخطط الإقليمية للقوى الكبرى من خلال تحويل تلك المكونات الداخلية إلى أطراف ممثلة لواقع اجتماعي منقسم، بحيث تبدو هذه القوى وكأنها لا تتدخل في شؤون دولة موحدة، بل في ساحة تتوزعها هويات متنافسة. وبهذه الطريقة تمنح الكيانات الدينية والعرقية والفئوية فرصة منظمة لإبراز وجودها السياسي والعسكري، ليس بوصفها حالات استثنائية أو طارئة، بل كعناصر طبيعية في المشهد الإقليمي، الأمر الذي يُعطي التدخل الخارجي مبرراً إضافيا يتمثل في إدارة هذا التنوع المتفجر أو احتواء تداعياته.
ويذكر الساعدي مثلاً حياً حول دور الولايات المتحدة الامريكية عن ذلك إذ يقول: " نجحت أمريكا في تصوير الصراعات الداخلية التي اندلعت لاحقا في العراق، وكأنها ليست مسؤولة عنها بشكل مباشر، بينما في الحقيقة هي التي زرعت بذور التفرقة عبر هذا المجلس. هذه التفرقة مع مرور الوقت، تضخمت مثل كرة الثلج حتى كبرت وأصبحت عائقاً كبيرًا أمام نهوض العراق وشعبه. إضافة إلى ذلك، استغلت هذه الطريقة كذريعة لنهب ثروات العراق تحت شعار (توزيع الثروات) الذي هو غطاء لنهب هذه الثروات عبر رجالاتها المتنفذين والمخفيين الذين ساهموا في إدارة العملية الانتقالية في العراق ".
من خلال ذلك يلقي الدكتور محمد الساعدي رؤية نقدية حذرة إزاء الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام الجديدة، ولاسيما شبكات التواصل الاجتماعي، في سياق العصر الرقمي وعالم ما بعد الحداثة. وهو يقر بالقدرة الاستثنائية التي تمتلكها هذه الوسائل في نقل المعلومات والأفكار وتوزيعها بسرعة وشمولية غير مسبوقة، غير أنه يشير في الوقت ذاته إلى أن هذه القدرة نفسها قد تفتح المجال لانحرافات معرفية وثغرات بنيوية تؤثر بصورة عميقة في الرأي العام والبنية الاجتماعية.
فإن كانت وسائل الإعلام الجديدة قد وفرت فضاءات واسعة للتعبير والمشاركة، فإنها على الجانب الآخر قد أصبحت قناة خصبة للتلاعب بالمعلومات، ونشر التضليل، وتعزيز الانتشار السريع للأخبار غير الدقيقة. وبذلك تغدو هذه الوسائل فاعلاً رئيسياً في تشكيل الرأي العام وصياغة النقاشات العامة، الأمر الذي يستدعي دراستها بعمق، والتعامل معها بوعي نقدي وحذر من قبل الجمهور والباحثين على حدّ سواء.
وتتجلى أهمية هذه الشبكات بوصفها امتداداً مؤثرًا للإعلام الجديد في كونها أحدثت تحولاً جذرياً في أنماط التواصل الاجتماعي، حتى باتت أشبه بـ(فضاء عالمي مفتوح) يتيح لملايين المستخدمين التفاعل في الوقت نفسه. ويكفي أن يتصفح المرء منصات مثل (أكس/ تويتر سابقاً) ليدرك حجم التغير في طبيعة الحوار العام، إذ يبدو العالم وكأنه ينقسم إلى جماعات متفاعلة، لكل منها خطابها وقضاياها.
وما تزال هذه الوسائل، التي تتوسع باطراد، تمارس دوراً محورياً في نقل الوقائع والأحداث لحظة بلحظة، وأصبحت مصدراً إخبارياً أساسياً تتكئ عليه وسائل الإعلام التقليدية. فقد يصل الخبر إلى الجمهور عبر هذه المنصات قبل أن تبثه وكالات الأنباء، وقد يكون الخبر صحيحاً أو مشوباً بدرجة من الخطأ أو الخداع، تبعاً لطبيعة مصادره وسياقات تداوله.
وتؤكد هذه التحولات المقولة الشائعة بأن الإعلام يمثل (السلطة الرابعة)، إذ يملك القدرة على التأثير في السياسات وتوجيه الثقافة وصياغة الوعي، وعلى رفع شأن أشخاص أو أفكار أو أحداث أو التقليل من شأن غيرها. ومن هنا تتضح أهمية فهم الأدوار الجديدة التي بات الإعلام الاتصالي يؤديها في عالم معقد ومتشابك، حيث يتقاطع الاتصال مع السياسة والمعرفة وتشكيل المجال العام.
وتتسم المقاربة العامة التي يعرضها الكاتب الاعلام الجديد ووسائل التواصل بأنها مقاربة نقدية بناءة، لا تسعى إلى الهدم أو المصادرة، وإنما إلى استثمار الإمكانات التقنية مع الوعي بالمخاطر الملازمة لها. وفي هذا السياق، يتناول الكتاب عدداً من النقاط الجوهرية؛ إذ يقارن بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، مع التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي، بما يعكس إدراكا للتغيرات العميقة التي يشهدها حقل الاتصال.
ويناقش الدكتور محمد الساعدي قضايا مركزية بصياغة تحليلية نقدية اكاديمية، مثل تأثير وسائل الإعلام في تشكيل الوعي، والإشكالات البنيوية التي تفرزها البيئة الرقمية، وعلاقة الإعلام بالرأي العام والمواطنة. كما يبرز دور الإعلام في الحراك الاجتماعي وفي عمليات التلاعب بالعقول، متبنياً منظوراً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً ودينيناً في تحليل ظاهرة الإعلام، بعيداً عن القراءة التقنية أو الصناعية البحتة. وهو يؤكد أن الإعلام يمتلك قدرة تحولية تعيد صياغة المجتمع والسياسة، لكنه في الوقت ذاته يحمل تهديدات تتصل بالحقيقة والمعرفة.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن تحليل الدكتور محمد يقدم رؤية عميقة ومتوازنة لدور الإعلام الجديد ووسائل التواصل، مستمدة من خبرة مهنية وممارسة واقعية للحقول الإعلامية، لا من منظور نظري أكاديمي مجرد. وتبرز أهمية هذه الرؤية في قدرتها على لفت الانتباه إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين مواكبة التطور التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية والمعرفية الأساسية. ولا يفوتني الإشارة إلى أن الدكتور محمد الساعدي يوظف المنهج التاريخي في تحليل جملة من الأحداث السياسية التي مرّت بها منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما ما يتعلق بالتدخلات الخارجية في تشكيل سياساتها واتجاهات الرأي العام فيها. وقد أبرز، في هذا السياق، الدور المحوري الذي أدته وسائل الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في إعادة صياغة المشهد السياسي، خصوصاً خلال مرحلة الربيع العربي، حين أصبحت هذه الوسائل أداة فاعلة في الحراك الاجتماعي ومسارات التغيير السياسي.
ويهدف كتاب الإعلام الجديد ووسائل التواصل شبابيك اعتراف رقمية لصالح الكولونيالية الجديدة في فصوله الثمان المتنوعة وحسب الفهرس الأتي:
المقدمة لعبة السلطة الكولونيالية الجديدة في السيطرة على الوعي بين الإعلام الجديد ووسائل التواصل
الفصل الأول: الإعلام الجديد على وفق الرؤية
- الكولونيالية الجديدة
- الإعلام والوظيفة الإعلامية.
- وسائل التواصل والإعلام الجديد
- التصورات الإعلامية في الإعلام الجديد في ظل
- الكولونيالية الجديدة
- الوظائف الإعلامية في ضوء السلطة الكولونيالية الجديدة
الفصل الثاني: السلطة الكولونيالية الجديدة وتشكيل
- شبابيك الاعتراف الرقمية
- الذات المؤسسة والسلطة
- الخطاب وما يساق من خلاله من أهداف وغايات للسلطة
- مجال الخطاب وتطبيقاته
-. شبابيك الاعتراف بين المرجعية الواحدة والمصاديق
- المتعددة
-. المعرفة المتحصلة من هذه الشبابيك
الفصل الثالث: الإعلام الجديد ووسائل التواصل
- والجاسوسية الرقمية
-. الإعلام الجديد ووسائل التواصل والجاسوسية الرقمية
-. الجاسوسية الرقمية أداة كولونيالية
-. أثر الجاسوسية الرقمية في الكولونيالية الجديدة
- على الأفراد في المجال الرقمي
الفصل الرابع: الأنثروبولوجيا الرقمية والكولونيالية الجديدة
- الأنثروبولوجيا وتمدين الإنسان البدائي
- الأنثروبولوجيا الرقمية أداة في يد الكولونيالية الجديدة
الفصل الخامس: الإيحائية الفرويدية في المجالات الرقمية
- ووسائل السيطرة التابعة للكولونيالية الجديدة
- مجالات الكولونيالية الجديدة والسيطرة الرقمية.
- الإيحائية الفرويدية في الإعلام الجديد ووسائل التواصل.
- اشتغالات السلطة الكولونيالية الجديدة على وفق
- الإيحائية الفرويدية
الفصل السادس: الشبكة العنكبوتية
- ولعبة العالم قرية صغيرة، يصممها من يريد تسويق
- السطحي من أجل ربح وفير
- الكولونيالية الجديدة والثنائيات الرقمية
- الكولونيالية الجديدة وتسويق السطحي
- في المجال الرقمي.
الفصل السابع: الإعلام الجديد والفن الإعلام الدرامي
- وصناعة الثقافة الإعلامية الجديدة
- الفصل الثامن: الإنسان والإعلام الجديد، من الفرد العارف
- إلى القطيع الجاهل
- الآخر الرقمي في الكولونيالية الجديدة
- الآخر الرقمي وغياب الهوية الوطنية
- الخاتمة
- المصادر
أن يطرح أسئلة حول ماذا نعني بالتحول في الصراع من الخارج إلى الداخل؟ وكيف يتم بلورة هذه الأفكار الأمريكية الجديدة في عملية التغيرات الجيوسياسية في المنطقة العربية خاصة والعالم بصورة عامة؟.
وفي ختام الكتاب يبين الدكتور محمد الساعدي بأن الكولونيالية الجديدة استفادت من مختلف هذه الوسائل إلى غايتها المنفتحة في عدة مجالات من ضمنها: "المجال السياسي تستخدم الكولونيالية الجديدة هذه الوسائل والتقنيات الرقمية للترويج للنظام السياسي الغربي الذي تعتقد أنه النظام الأفضل للعالم، من أجل تحقيق هدفها العالمي في قيادة العالم حسب تصوراتها وعقيدتها السياسية التي تفرضها بمختلف الطرق على الأنظمة الأخرى التي تقع خارج منظومتها الغربية. والمجال الاقتصادي تستفيد الكولونيالية الجديدة من المجال الرقمي في ثلاث قضايا مهمة في المجال الاقتصادي، وكذلك في المجال الاجتماعي تستفيد الكولونيالية الجديدة من النظام الرقمي العالمي ومجاله التقني في تغيير النظم الاجتماعية ومنظوماتها الاخلاقية القارة والثابتة في المجتمعات التقليدية، من خلال بث قيم جديدة تتلاءم مع سياساتها الاجتماعية ومنظوماتها الأخلاقية الخاصة بهذه النظم الاجتماعية الغربية. والمجال العلمي، تستفيد الكولونيالية الجديدة من التقنيات العلمي التي أنتجتها في استحداث فضاء رقمي ومجال تقني تستطيع من خلاله التفوق عالمياً على كافة القوى المنافسة لها على صعيد العالم. والمجال التعليمي تستفيد الكولونيالية الجديدة من خلال تغيير أنظمة التعليم في مختلف المستويات للصغار والكبار من خلال تغيير المنظومات التعليمية في المدارس والجامعات، والعمل على بث أنظمتها التعليمية وقيمها التعليمية ومعاييرها التي تربطها بالنظام التعليم العالمي للوصول إلى منظومة تعليمية عالمية وفق القيم الغربية. والمجال الديني إذ تسعى الكولونيالية الجديدة إلى تجاوز المنظومات الدينية المحلية الخاصة بكل شعب من الشعوب، والترويج لفكرة دين عالمي جديد وموحد يدمج بين الأديان السماوية، وفرضه بالقوة الناعمة على أتباع الديانات السماوية، ليصبح الدين الجديد الذي يتماشى مع المنظومة الكولونيالية الجديدة".
وعلى الرغم من الطابع الحذر الذي يتبناه الدكتور محمد الساعدي في مقاربة ظاهرة الإعلام الجديد ووسائل التواصل، فإنه لا يتجه نحو رفضه أو التقليل من قدرته على تمكين المجتمع. بل يطرح رؤية توفيقية وواقعية تستوعب ما تقدمه هذه الوسائل من إمكانات إيجابية، بالتوازي مع التحذير من الإشكالات البنيوية التي تطرحها على البنية الاجتماعية والثقافية. ويؤكد مضمون كتابه على ضرورة إرساء معادلة توازن بين توظيف مزايا التكنولوجيا الحديثة وبين مراقبة تأثيراتها المتسارعة والحد من انعكاساتها السلبية. فهذا التوازن، في نظره، يمثل السبيل الأمثل لضمان توظيف الإعلام الجديد بطريقة عقلانية ومسؤولة تدعم الحقيقة وتعزز الحياة المدنية.
ومن خلال هذه القراءة، أدعو الباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على هذا المنجز العلمي، الذي يمثل دراسة أكاديمية وبحثية مهمة تتناول الهجمة الأمريكية–الصهيونية على الثقافة العربية الإسلامية، وذلك بطرق متنوعة وبالتركيز على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا السياق. وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تقديم قراءة مختصرة وموجزة لهذا العمل العلمي للأستاذ الدكتور محمد كريم الساعدي.
***
ا. م. د. حميد ابولول جبجاب
جامعة ميسان / كلية التربية الأساسية