قراءة في كتاب
سفيان بامحمد: قراءة وصفية في مؤلف "البرلمان في ضوء مستجدات الدستور"

تقديم: يأتي كتاب "البرلمان في ضوء مستجدات الدستور" ضمن الإسهامات الحديثة في مجال الدراسات البرلمانية والدستورية. وقد صدر في طبعته الأولى سنة 2019 عن مطبعة شمس برينت بمدينة الدار البيضاء، في 104 صفحة. يتميز هذا العمل بالتركيز والاختزال، ويعكس تجربة مؤلفه الغنية في العمل البرلماني والممارسة الدستورية، كما يندرج ضمن سلسلة من الكتابات التي تعالج تطور المؤسسة التشريعية في المغرب في ضوء التحولات الدستورية والسياسية. كما يعد هذا العمل مصدرا قيما كونه يقدم تحليلا مباشرا من فاعل داخلي للمؤسسة التشريعية، مما يمنحه بعدا عمليا فريدا في فهم النص الدستوري الجديد.
ومؤلف الكتاب هو الأستاذ رشيد المدور، برلماني مغربي سابق، تقلد عدة مناصب في مجلس النواب، من بينها عضويته بين 1997 و2008، وأمانة المجلس ونائب رئاسته في فترات مختلفة. كما شغل عضوية المجلس الدستوري بين 2008 و2017، وشارك في هيئات قانونية مغاربية، ويشغل حاليا عضوية اللجنة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويشتغل أستاذا بكلية الحقوق بالمحمدية.
وللمدور إسهامات متعددة في القانون البرلماني والدستوري، من أبرزها كتاب "العمل البرلماني في المغرب: قضايا وإشكالات"، و"القضاء الدستوري والأنظمة الداخلية للبرلمان"، إلى جانب دراسات منشورة في مجلات متخصصة. كما أن له مؤلفات في العلوم الشرعية، من بينها "معلمة القواعد الفقهية عند المالكية"، وتحقيقه لكتاب "النظائر في الفقه على مذهب الإمام مالك" لأبي يعلى أحمد العبدي.
وعليه، يمثل هذا الكتاب امتدادا لمسار بحثي يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، ويقدم قراءة تحليلية لموقع البرلمان المغربي في ظل دستور 2011، من خلال رصد المستجدات وتفكيك الإشكالات المرتبطة بوظائفه التشريعية والرقابية والتقييمية.
وفي هذا الإطار، تنطلق هذه القراءة من الطبعة الأولى للكتاب، حيث تسعى القراءة الوصفية إلى تفكيك محتوى المؤلف وتصنيفه بشكل يسهل على القارئ الإحاطة بالإطار الفكري والمنهجي للكتاب، وذلك قبل الانخراط في أي عملية نقد أو تقييم لاحقة.
وينطلق الكتاب من إشكالية مركزية تتعلق بالمستجدات التي عرفتها الوثيقة الدستورية لسنة 2011، خاصة في ما يتعلق بالسلطة التشريعية. ويعتبر المؤلف أن دستور 2011 يمثل الدستور الثاني للمملكة، بالنظر إلى حجم التعديلات الجوهرية التي أدخلت عليه، سواء على مستوى نظام الحكم، أو في تنظيم العلاقة بين السلط، أو في توسيع اختصاصات البرلمان وتعزيز مكانته داخل البناء الدستوري.
ولمعالجة هذه الإشكالية، قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة مباحث رئيسية، تناول في أولها مظاهر تقوية البرلمان، من خلال دسترة التداول الديمقراطي، وتحويل البرلمان إلى سلطة تشريعية، وتوسيع وظائفه لتشمل تقييم السياسات العمومية، والمساهمة في تشكيل المحكمة الدستورية. أما المبحث الثاني، فقد خصصه لدراسة مظاهر تخفيف قيود العقلنة البرلمانية، من خلال مراجعة الأنصبة، وتوسيع مجال القانون، وتعزيز صلاحيات البرلمان في مجال المعاهدات والرقابة. في حين تناول المبحث الثالث مقومات النظام الجديد للثنائية البرلمانية، من خلال مقارنة أدوار مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتحديد الفوارق في التعيين، التشريع، الرقابة، عدد الأعضاء، الولاية، ورئاسة الجلسات المشتركة.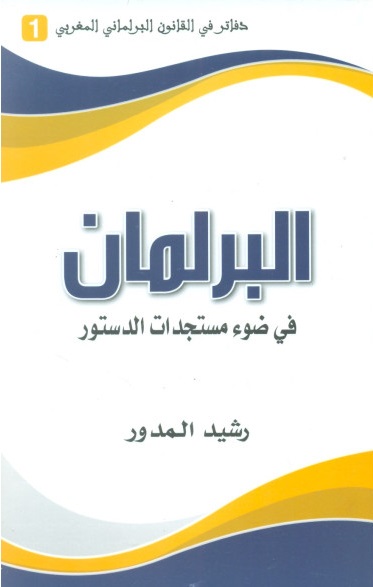
وعليه، تسعى هذه القراءة إلى تقريب القارئ من محتوى الكتاب، وتوفير أرضية أولية لفهم التحولات التي عرفها البرلمان المغربي في ضوء دستور 2011، من خلال الطبعة الأولى لهذا العمل المرجعي.
المبحث الأول: مظاهر تقوية البرلمان
تم تقسيم هذا المبحث إلى مطالب؛ مطلب حول دسترة التداول الديمقراطي على السلطة على أساس نتائجها، ومطلب ثان حول انتقال البرلمان من مجرد مؤسسة إلى سلطة تشريعية، ومطلب ثالث حول الوظيفة الجديدة وهي تقييم السياسات العمومية، ثم تقوية دور البرلمان في تشكيل المحكمة الدستورية.
المطلب الأول: دسترة التداول الديمقراطي على السلطة على أساس نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب المباشرة
في سياق تفعيل هذا التداول، يستعرض الكتاب أبرز مستجدات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، حيث تم الانتقال بوظيفة الأحزاب إلى التأطير والتكوين. وهي أول مرة يتم فيها التنصيص على الأحزاب منذ أول دستور، وبهذا التنصيص أصبحت الأحزاب السياسية تتميز عن باقي التنظيمات الأخرى، إذ أصبحت تعمل على إدماج المواطنين في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام. كما يعد وضع قانون تنظيمي خاص بها، بعدما كانت تنظم بقانون عادي لا يخضع لرقابة القضاء الدستوري، من معالم الارتقاء بالأحزاب.
وفي نفس السياق، تطرق الكتاب إلى مسألة دسترة المعارضة كمستجد دستوري، وضمان حقوقها في المشاركة بعدما كانت مهمشة، وكان يُنظر إليها على أنها معارضة للنظام. وقد منحها الدستور الجديد مجموعة من الحقوق كحرية الرأي، والاستفادة من التمويل العمومي، وأصبحت تشارك في وظائف البرلمان، سواء في التشريع أو الرقابة أو التقييم، وضمن لها الفصل العاشر المساهمة في تجويد العمل البرلماني.
ومن بين المستجدات الأخرى، تم دسترة منع الترحال السياسي، باعتباره من الظواهر السلبية التي عانى منها البرلمان، حيث كان من حق النواب تغيير انتمائهم أثناء فترة الانتداب. وفي محاولة لمعالجة هذه الظاهرة، عمل المشرع من خلال الدستور وقانون الأحزاب السياسية، فجاء الفصل 61 ليقرر تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي من صفة برلماني.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة، نص الفصل 47 على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات، ويعين الملك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما مكن رئيس الحكومة من أن يطلب إعفاء الوزراء، إما بطلب منه أو بناء على استقالتهم، ونص أيضا على أن استقالة رئيس الحكومة تسقط الحكومة كاملة.
ولتكريس مبدأ الديمقراطية، نص الفصل 88 على أن الحكومة لا تعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة النواب، من خلال التصويت لصالح برنامجها بالأغلبية. ويشير المؤلف الى انه تم الانتقال من مؤسسة الوزير الأول إلى رئيس الحكومة الذي أصبح يتمتع بصلاحيات عديدة، منها حق حل مجلس النواب، وحق ترؤس المجلس الوزاري، وأصبح رئيس الحكومة فعليا رئيسا للسلطة التنفيذية.
المطلب الثاني: البرلمان من مجرد مؤسسة تمارس التشريع إلى سلطة تشريعية
بالإضافة إلى تقوية دوره السياسي، أحدث دستور 2011 تحولا في مكانة البرلمان، حيث عنون الباب الرابع باسم السلطة التشريعية، وخصص الباب السادس للعلاقة بين السلط. فوضع في الفرع الأول العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية، وفي الفرع الثاني العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذا يخالف ما كانت عليه الدساتير السابقة التي كانت تسمي الباب الثالث بالبرلمان، وتفصل العلاقة بين الملك والحكومة والبرلمان بشكل مختلف.
كما أكد المؤلف على أن الانتقال من مؤسسة تمارس التشريع إلى سلطة تشريعية تم تكريسه في الفصل 70، حيث أصبحت ممارسة السلطة التشريعية اختصاصا شبه حصري للبرلمان، بعدما كان الملك يشارك في هذه السلطة، وأصبح البرلمان مصدرا أوليا للتشريع.
وفي مجال التشريع، تم إنصاف المبادرة البرلمانية وضمان برمجتها في الجلسة العامة، حيث نص الفصل 82 على أن البرلمان هو من يضع جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
ولإعادة التوازن، أعاد المشرع التوازن بين البرلمان والحكومة في المسطرة التشريعية. بعدما كانت الحكومة تملك حق طلب التصويت الإجمالي على أي نص، مما كان يفرض على البرلمان القبول الكلي أو الرفض، لكن الفصل 83 منح البرلمان حق الاعتراض، وأعاد جزءا من التوازن بين السلطتين.
وبخصوص مناقشة مشروع قانون المالية، أصبح البرلمان مسؤولا مع الحكومة على توازن الميزانية. وبعد أن كانت الحكومة ترفض التعديلات دون تبرير، جاء دستور 2011 ليُلزمها بتقديم الأسباب التي دفعتها إلى الرفض.
ومن المؤشرات الأخرى على أن البرلمان أصبح سلطة، هو تعزيز مكانة القانون، ومنح البرلمان صلاحيات تشريعية في مراجعة الدستور، حيث يمكنه اتخاذ المبادرة بالتصويت بالثلثين داخل المجلسين، ثم عرض المشروع على الشعب. كما يمكنه المصادقة النهائية على مشروع مراجعة الدستور الذي يتخذ بمبادرة من الملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، ويعرض بظهير على البرلمان.
المطلب الثالث: إعطاء البرلمان دورا أكبر في رسم السياسات العمومية
بالإضافة إلى ما سبق، واستجابة لمذكرات الأحزاب، تم الرفع من وظائف البرلمان بإضافة وظيفة جديدة، وهي تقييم السياسات العمومية، إلى جانب التشريع والرقابة، وتم التنصيص عليها في الفصل 70، على غرار ما جاء في دستور فرنسا لسنة 2008. ولتفعيل هذه الوظيفة، تم اعتماد آليات دستورية، مثل الحصيلة المرحلية، والجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية (الفصل 101)، وطلب استماع اللجان البرلمانية لمسؤولي الإدارات (الفصل 102)، وعرض قانون التصفية لأول مرة في الدستور المغربي (الفصل 76)، وهو وسيلة لمراقبة تنفيذ الميزانية، بالإضافة إلى الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
المطلب الرابع: تقوية دور البرلمان في تشكيل المحكمة الدستورية
ختاما لمظاهر التقوية، يشير المؤلف هنا إلى انتقال المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية بموجب دستور 2011، وتتألف من اثني عشر عضوا. يعين الملك نصفهم، وينتخب البرلمان النصف الآخر، ثلاثة من مجلس النواب، وثلاثة من مجلس المستشارين، وهذا خلافا لما كان عليه الأمر سابقا، حيث كان التعيين يتم فقط حتى بالنسبة لأعضاء البرلمان.
ويلاحظ المؤلف أنه تم الجمع بين التعيين والانتخاب، ويمكن أن يكون رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء المنتخبين من البرلمان، وهو في نفس الوقت رئيس مجلس الوصاية، مما يعزز دور البرلمان في تشكيل هذه المؤسسة الدستورية.
المبحث الثاني: حول التخفيف من قيود العقلنة البرلمانية
تطرق صاحب الكتاب في هذا المبحث إلى تعريف العقلنة البرلمانية، مستندا إلى بوريس ميركن غوتزيفيتش، الذي اعتبرها مجموعة من الآليات الدستورية التي تهدف إلى ضمان استقرار السلطة التنفيذية، كما أشار إلى بعض الفقهاء الذين تناولوا مفهوم العقلنة البرلمانية ونظرتهم إليها، وظهرت هذه الفلسفة في الحكم مع الجمهورية الفرنسية الخامسة في عهد شارل ديغول.
وبالنسبة لحالة المغرب، فقد ولد البرلمان المغربي معقلنا منذ أول دستور سنة 1962، وكان أول برلمان سنة 1963، مما يدل على أن العقلنة البرلمانية كانت حاضرة منذ البداية. وفي هذا الإطار، تناول صاحب المؤلف مجموعة من المطالب التي تعكس مظاهر تخفيف بعض قيود العقلنة البرلمانية.
المطلب الأول: رفع مدة انعقاد الدورات العادية
من أبرز هذه المظاهر، يذكر المؤلف رفع مدة انعقاد الدورات العادية. ففي الدساتير السابقة لسنة 2011، أي دساتير 1962 و1970 و1972 و1992، كانت مدة انعقاد الدورات محددة في شهرين فقط، ثم جاء دستور 1996 ليزيد هذه المدة إلى ثلاثة أشهر. ومع دستور 2011، تم رفع مدة كل دورة إلى أربعة أشهر على الأقل، وهو ما يعكس رغبة في تعزيز الحضور البرلماني وتوسيع زمن الاشتغال التشريعي.
المطلب الثاني: تخفيض نصاب طلب البرلمان في عقد دوراته الاستثنائية
كما عولج نصاب طلب عقد الدورات الاستثنائية بالتخفيض. ففي دستور 1962، كان مجلس النواب وحده يملك حق طلب عقد دورة استثنائية، وكان النصاب المطلوب هو ثلث أعضاء المجلس، أما في الدساتير التي اعتمدت نظام الغرفة الواحدة حتى دستور 1992، فقد تم تحديد النصاب في الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ومع دستور 1996، وبعد العودة إلى نظام الغرفتين، تم الحفاظ على نفس النصاب، أي الأغلبية المطلقة لأحد المجلسين، لكن دستور 2011 جاء بتعديل جديد، حيث حدد النصاب في ثلث أعضاء مجلس النواب، أما بالنسبة لمجلس المستشارين فبقي النصاب هو الأغلبية المطلقة، مما يعكس نوعا من التيسير في تفعيل الدورات الاستثنائية.
المطلب الثالث: توسيع مجال القانون
يقصد بمجال القانون ذلك المجال الذي يختص فيه البرلمان بالتشريع، وهو مجال تقليدي ومحدد ضمن قوائم نص عليها الدستور. وقد سجل دستور 2011 طفرة نوعية في هذا الجانب، حيث انتقل عدد المجالات التي يحق للبرلمان التشريع فيها من تسعة في الدستور السابق إلى ثلاثين مجالا، كما نص على ذلك الفصل 71، بالإضافة إلى مواد أخرى.
ويؤكد المؤلف أن هذا التوسيع لا يقتصر فقط على القوانين العادية، بل يشمل أيضا القوانين التنظيمية، مما يعكس رغبة واضحة في تعزيز الدور التشريعي للبرلمان وتوسيع نطاق تدخله في السياسات العمومية.
المطلب الرابع: توسيع صلاحيات البرلمان في مجال المعاهدات
على صعيد الاختصاصات الدولية، كانت الموافقة على المعاهدات بقانون في الدساتير السابقة تقتصر فقط على تلك التي تكلف ميزانية الدولة، لكن الفصل 55 من دستور 2011 وسع هذا المجال ليشمل:
* معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود
* معاهدات التجارة
* المعاهدات التي يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية
* المعاهدات التي تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين العامة أو الخاصة
* المعاهدات الأخرى التي يختار الملك أن يعرضها على البرلمان قبل المصادقة عليها
وبهذا التوسيع، أصبح للبرلمان دور أكبر في مراقبة الاتفاقيات الدولية، كما يمكن للملك أن يعرض أي اتفاقية أو معاهدة أخرى على البرلمان قبل المصادقة عليها، وقد تم حصر عدد المعاهدات التي يوافق عليها البرلمان بقانون في ستة أنواع.
المطلب الخامس: التخفيض من نصاب توقيع ملتمس الرقابة
يعتبر ملتمس الرقابة آلية رقابية مهمة، تمر بعدة مراحل، وتؤدي إلى نتيجة حاسمة وهي إسقاط الحكومة، وهي من الوسائل التي تثير المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان. ونظرا لخطورة هذه الآلية، فقد نص أول دستور على أن يكون نصاب التوقيع عليها هو العشر، وتم تفعيلها في نفس الولاية لإسقاط حكومة باحنيني، لكن سرعان ما ساءت الأوضاع وتم الإعلان عن حالة الاستثناء، مما دفع إلى مراجعة دستورية رفعت النصاب من العشر إلى الربع، وهو نصاب كرسته جميع الدساتير اللاحقة. أما دستور 2011، فقد خفض النصاب إلى الخمس، ولا يقبل الملتمس إلا إذا وقعه خمس أعضاء مجلس النواب، أي 79 نائبا، وهي آلية يتمتع بها مجلس النواب فقط حسب هذا الدستور.
المطلب السادس: تخفيض النصاب الواجب لملتمس المساءلة
ملتمس المساءلة هو آلية رقابية يتمتع بها مجلس المستشارين، وهي آلية لا تنتج أي آثار سياسية مباشرة، وكان يسمى سابقا بملتمس توجيه تنبيه. وقد تم تخفيض النصاب المطلوب لتقديم هذا الملتمس من الثلث إلى الخمس، حسب ما نص عليه الفصل 106.
المطلب السابع: تخفيض نصاب تشكيل لجان تقصي الحقائق
لم يتم دسترة لجان تقصي الحقائق إلا مع دستور 1992، الذي نص على أن تشكيلها يكون بمبادرة ملكية أو بطلب من أعضاء مجلس النواب، وكان النصاب المطلوب هو أغلبية الأعضاء، وهو ما كرسه دستور 1996 بعد العودة إلى نظام الغرفتين، حيث أكد على نفس النصاب، مع منح المبادرة للمجلسين معا.
أما دستور 2011، فقد منح المبادرة للملك، وللثلث من أعضاء مجلس النواب، والثلث من أعضاء مجلس المستشارين، وهي أيضا آلية لا تنتج مسؤولية سياسية، لكنها تساهم في كشف الحقائق وتعزيز الرقابة البرلمانية.
المطلب الثامن والتاسع: توسيع مجال المراقبة الدستورية القبلية الاختيارية وتخفيض نصاب ممارستها
يستعرض المؤلف في مطلب مزدوج، توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الاختيارية ليشمل، إلى جانب القوانين العادية، المعاهدات الدولية التي وافق عليها البرلمان. كما تم تخفيض نصاب الإحالة الاختيارية للقوانين العادية من طرف النواب من الربع إلى الخمس، مما يسهل تفعيل هذه الرقابة ويجعلها أكثر واقعية.
المطلب العاشر: فتح المجال أمام اللجان لعقد اجتماعات علنية
أخيرا، ضمن الفصل 68 من دستور 2011 أن النظام الداخلي هو من يحدد الحالات التي تعقد فيها الاجتماعات بشكل علني، وهو ما يعتبر خطوة نحو تعزيز الشفافية داخل المؤسسة التشريعية. بالإضافة إلى ذلك، تم دسترة الاجتماعات التي تعقد فيها غرفتا البرلمان مجتمعتين، والخاضعة للنظام الداخلي، حيث تكون رئاسة الجلسة من اختصاص رئيس مجلس النواب، مما يعكس نوعا من التنظيم الداخلي والتوازن بين الغرفتين.
المبحث الثالث: مقومات النظام الجديد للثنائية البرلمانية
تناول هذا المبحث تطور الثنائية البرلمانية في المغرب، منذ تبنيها في دستور 1962، ثم توقفها بعد حالة الاستثناء، إلى أن عادت في دستور 1996 مع إحداث مجلس المستشارين. وقد اعتبر الملك الحسن الثاني هذه الغرفة تقريرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وفي هذا الإطار، قسم المؤلف هذا المبحث إلى خمسة مطالب، أبرز فيها التفاوت بين مجلس النواب ومجلس المستشارين في عدة جوانب، يمكن إجمالها فيما يلي:
* على مستوى تعيين وتنصيب الحكومة: يتمتع مجلس النواب بالاختصاص الحصري، سواء في تعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج انتخابه، أو في منح الثقة للحكومة، أو في تفعيل ملتمس الرقابة، بينما يقتصر دور مجلس المستشارين على ملتمس المساءلة دون أثر سياسي.
* في العمل التشريعي: رجح المشرع كفة مجلس النواب، حيث تودع مشاريع القوانين لديه، باستثناء بعض المجالات الترابية والاجتماعية، كما يتمتع بحق التصويت النهائي في حالة الاختلاف بين المجلسين.
* على مستوى الأنصبة: تم اعتماد منهج التيسير مع النواب، والتشديد مع المستشارين، سواء في طلب الدورات الاستثنائية، أو الإحالة الاختيارية للقوانين والمعاهدات، أو تقديم الحصيلة المرحلية.
* في مسألة حل أحد المجلسين: تعتبر الأغلبية في مجلس النواب هي المرجع، كما أن المعارضة فيه تحظى بالأولوية، حسب الفصل 10، مما يعكس مكانة النواب في الحياة البرلمانية.
* على مستوى عدد الأعضاء والولاية: يتميز مجلس النواب بعدد أكبر وولاية مغلقة، كما أن رئاسة الجلسات المشتركة تمنح له، مما يعزز تفوقه المؤسسي على مجلس المستشارين.
الخاتمة
في ختام كتابه، عبر رشيد المدور عن تفاؤل بخصوص التطور الذي عرفه البرلمان المغربي في ضوء دستور 2011، مشيرا الى ان المؤسسة التشريعية استفادت من اختصاصات واسعة، سواء في وظائفها التقليدية او الحديثة، وان هذه الوظائف تم تدعيمها دستوريا بشكل يعكس ارادة اصلاحية واضحة. غير ان المؤلف نفسه نبه الى ان النص الدستوري، مهما بلغت دقته، لا يكفي لضمان النجاعة، بل يتطلب ارادة سياسية ومهنية مؤهلة داخل المؤسسة البرلمانية.
وبذلك، ينجح المؤلف في إبراز الهوة القائمة بين النص الدستوري الطموح وواقع الممارسة البرلمانية، وهو ما يفتح الباب أمام الباحثين والمهتمين لدراسة الأسباب غير النصية (السياسية والثقافية وغيرها) التي ما تزال تعيق التفعيل الكامل لهذه المستجدات.
بيد ان الممارسة العملية للعمل البرلماني ، كما يظهر من خلال البحث والملاحظة، يكشف عن تحديات ملموسة على مستوى الممارسة، فالمبادرة التشريعية لا تزال تميل الى هيمنة المشاريع الحكومية، في مقابل ضعف المقترحات البرلمانية، مما يطرح سؤالا حول مدى استقلالية المؤسسة التشريعية في اداء وظيفتها ،كما ان الرقابة البرلمانية، رغم تنوع ادواتها، لا تفعل بالشكل الكافي، اذ يغيب استعمال بعض الاليات المهمة مثل ملتمسات الرقابة واللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، في حين يكتفى غالبا باداة واحدة لا تحقق الاثر السياسي المطلوب.
اما التقييم البرلماني، باعتباره مستجدا دستوريا، فلا يزال يفتقر الى تصور واضح، سواء من حيث التعريف او من حيث اليات التفعيل، وهو ما يحد من امكانياته في تحسين الاداء المؤسساتي.
وفي ظل هذا الواقع، يطرح سؤال جوهري نفسه. هل يمكن للسنوات القادمة ان تفرز جيلا جديدا من النخب البرلمانية القادرة على كسر القاعدة التقليدية، وتجاوز منطق التقييد المؤسساتي. فالقانون موجود، والدستور منح امكانيات مهمة لكن تفعيلها يظل رهينا بوجود نخب سياسية تمتلك الجرأة والكفاءة، وتضع المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة.
لا يمكن انكار ان بعض هذه النخب موجودة فعلا، وتبدي استعدادا للتغيير، لكنها تصطدم احيانا بتركيبات حزبية مغلقة، وبثقافة تنظيمية تحد من المبادرة، وتكبل الفاعل البرلماني داخل منطق الولاء اكثر من منطق الفعالية. ومع ذلك، يبقى الامل قائما، والتفاؤل ممكنا، ما دمنا نؤمن بان الدستور ليس مجرد وثيقة، بل تعاقد سياسي واخلاقي، نضع انفسنا في صفه، ونسعى الى ترجمة روحه في الممارسة.
***
سفيان بامحمد - باحث في العلوم السياسية والقانون العام







