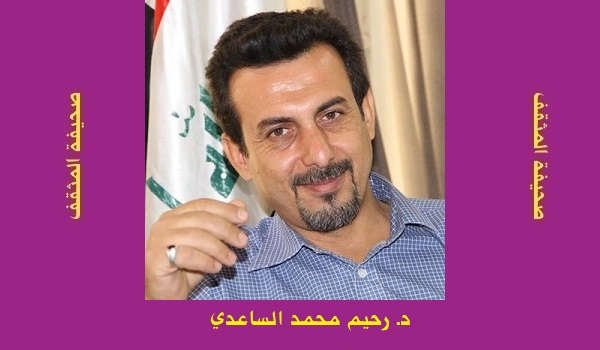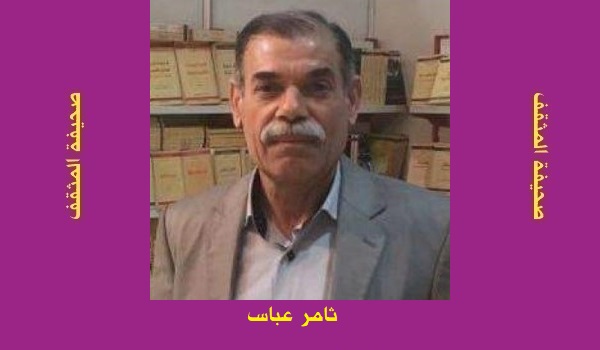قراءة في كتاب
حميد بن خيبش: نحن البشر

إلى جانب قلمه السيال، وأسلوبه الرشيق والممتنع، اشتهر الكاتب المصري خالد محمد خالد بشجاعته الأدبية، وجرأته في الاعتراض على الأوضاع الخاطئة. ولعل الذاكرة الثقافية المصرية لا تزال تحتفظ له باعتذاره الشهير عن كتابه (من هنا نبدأ)، والذي أحدث خصومة فكرية بينه وبين الأزهر وباقي مكونات المشهد الإسلامي في مصر، بسبب دعوته الصريحة إلى فصل الدين عن الدولة. لكنه تراجع عن رأيه بعد أن أثار استغرابه الاحتفاء الذي قوبل به كتابه في الغرب، وترجمته إلى أكثر من لغة. وبعد سنوات من مراجعة منطلقاته أعلن، وهو الكاتب الكبير آنذاك، رجوعه عن هذا الرأي، وأصدر كتابه (الدولة الإسلامية) ليفنّد آراءه السابقة.
مزج الكاتب ثقافته الأزهرية بالثقافة الغربية، إيمانا منه بأن الحكمة ضالة المؤمن، وأن عالمية الرسالة المحمدية تستوجب حرية التعلم والبحث والتقصي، وجرد المكتبة الإنسانية بكل ذخائرها. غير أنه لم يكن من طينة المثقفين الذين يُشرفون على القضايا من أبراجهم العاجية، بل كانت قدماه مغروزتان في الواقع اليومي لبلده وأمته. ومن الطبيعي والحال هذه أن يُناوش السياسة وتناوشه، وأن يكتوي بهمومها، ويصدح بعيوبها، ويسهم بقلمه في توجيه الوعي الإنساني نحو مسارب الحرية والعدل والفضيلة.
في كتابه (نحن البشر) يكشف المؤلف عن نزعة إنسانية عميقة، متحررة من الجغرافيا والدين والهوية؛ حيث العالم قريته والبشرية أسرته، ولم يعد لأحد الحق في بناء مجده الامبراطوري بينما تثابر سواعد الجميع لميلاد مجتمع إنساني ودود.
وباستقراء أحداث التاريخ العالمي يخلص المؤلف إلى أن التخلف والنزاعات والحروب التي تفتك بالإنسان ترجع إلى أربعة أسباب، قد يسهم الوعي بها في تصحيح نظرتنا للكون والحياة، وتحديد الأخطاء التي يؤدي ارتكابها مجددا إلى انقلاب الجغرافيا الإنسانية.
تشكل أوروبا في تقدير المؤلف عصب العالم الحديث، حيث برزت على مسرح الأحداث كقوة سياسية عالمية منذ الحروب الصليبية التي اندلعت خلال القرن الحادي عشر. تلك الحروب التي قوضت الإخاء الإنساني، واستُغلّ فيها الدين استغلالا خبيثا لتبرير أهداف اقتصادية عدوانية.
على هذا المنوال ستمضي أوروبا في معالجة أزماتها وتنمية ثرواتها بالحروب، ويصبح للشركات والمصارف، وأحيانا لفرد واحد مثلما حدث في حرب المئة عام، دور في جرّ البشرية إلى الاقتتال وإفناء بعضها البعض لحل مشكلة اقتصادية، أو استئناف علاقات تجارية.
لم تكن التجارة في حد ذاتها خطيئة، إلا أن أوروبا حولتها إلى قوة احتكارية طاغية. فكان لزاما أن تتبنى سياسة الأحلاف لحماية مصالحها، وإرساء قواعد متفق عليها لنهب ثروات الشعوب والدول الأخرى. غير أن تزايد الأحلاف ولّد صراعات أفضت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية وهلاك الملايين.
قدّمت أوروبا ضريبة ثقيلة من تركيبتها الديموغرافية، وذاقت ويلات احتلال شعوب العالم الذي صنّفته ثالثا في قائمتها العنصرية. لكن ذلك لم يكن كافيا برأي المؤلف، إذ جدّدت سعيها الدائم للهيمنة، لكن تحت غطاء مفاهيم حديثة، تم الترويج لها كمظلة حامية للسياسة العالمية.
نحتت الدول الكبرى تعبير (حفظ التوازن) لتأكيد حقها في السيادة والتفوق والتأله، فكان ذريعة لوأد التجارب الديموقراطية عبر العالم، ودعم الشروط التاريخية التي تُبقي على الدول الصغيرة صغيرة. وخدمة لهذا التمايز لم يُسمح للصين الشعبية، على سبيل المثال، أن تأخذ مكانها بين الأربعة الكبار، لمجرد أن نهضتها أربكت السياسة الأمريكية في آسيا.
في ثنايا المؤامرات والعمل الدؤوب للإبقاء على هيمنة الدول الكبرى، تشكّل ضمير سياسي منحرف ومراوغ، يتغذى على الإفرازات الضارة لتواطؤ المال وسياسة الأحلاف..
ضمير يتاجر بكل شيء؛ بالدين والقيم والمواثيق الإنسانية.
وضمير يُقدم المنفعة على المبدأ، والخوف على الواجب، والباطل على الحق.
وضمير يستغل عوامل الوحدة داخل البلد لتمزيق أواصره، وإشعال الحرائق بين أبنائه من أجل الحصول على صفقة.
أمام وضع بهذا الانشطار والوصولية لن يتمكن الضمير السياسي من أداء واجبه نحو المبادئ الإنسانية الرشيدة إلا حين تتطهر السياسة من أكاذيبها، وتتحرر الهيئات العالمية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، من قوى الشر التي تتسلل إليها وتتحكم في قراراتها.
مسترشدا بعشرات الأحداث والقرارات السياسية التي عصفت بالاستقرار العالمي، يحدد المؤلف أربعة مصادر للتمزق وللظلم الذي تتجرعه شعوب الأرض:
أولا؛ هناك التجارة التي تحولت إلى رأسمال متحكم في القرار الدولي.
وثانيا؛ المبدأ الجهنمي الذي تتشكل في ظله الأحلاف والتكتلات، والذي لا يؤمن بغير الحرب والدمار لضخ مزيد من الغنائم.
وثالثا؛ النظام الطبقي الذي يقسم الكيان الدولي إلى دول كبرى لها كل شيء، ودول صغرى ليس لها من الأمر شيء.
ورابعا؛ انحراف الضمير السياسي عن المبادئ الإنسانية التي يجب أن يحرسها.
ظهرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 1959، حين كانت أعصاب العالم مشدودة إلى الصراع بين أمريكا والاتحاد السوفياتي. لذا اعتبر لمؤلف أن حل قضية الإخاء البشري رهين بإيجاد مساحة مشتركة بين الدولتين، وتصفية الموقف بين الرأسمالية والشيوعية وفق مبادئ تخدم المصير الإنساني المشترك.
في ترجمته لحياة المؤلف وفكره، يخلص الدكتور محمد الجوادي إلى أن الأستاذ خالد محمد خالد نموذج فريد في الفكر العربي المعاصر، حيث قدّم فكرا سياسيا مميزا على مستوى الفهم، وعلى مستوى التطويع، وعلى مستوى الجدل والمناقشة. وتمتع بقدرة غير محدودة على اختراق غيوم الحاضر ليرى المستقبل، ويأخذ بيد أمته ليريها هذا المستقبل (1).
وفي المفاتيح الأربعة لقضية الإخاء البشري والقرية الكونية الواحدة، يعبّر المؤلف عن إحدى الرؤى المتقدمة على عصرها، كما يعكس إيمانا بازدهار الأمل في عالم لا غلّ فيه ولا تأثيم، يسعنا جميعا نحن البشر!
***
حميد بن خيبش
....................
1. د. محمد الجوادي: مصريون معاصرون. ص93