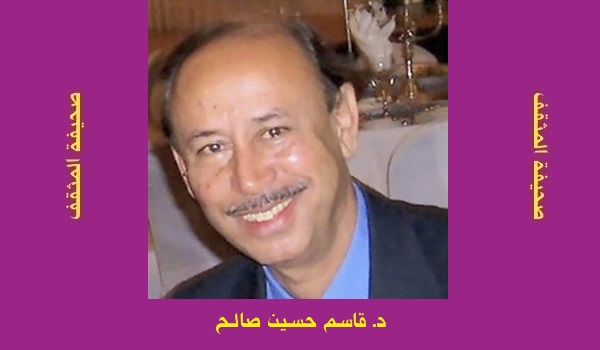قضايا
محمد الدسوقي: الفلسفة رحم الأفكار عند الفلاسفة الكبار

كان سقراط يقول إن والدته تعمل قابلة تساعد النساء على الولادة، وهو بدوره يساعد على توليد الأفكار في عقول تلاميذه. نستهل مقالنا بهذا التشبيه البليغ، فكما أن الرحم هو بداية انطلاق الحياة، فإن الفلسفة هي بداية طرح الفكرة في شكل تساؤل. ومن وجهة نظرنا، تسير الحياة والفلسفة في خطين متوازيين؛ بدأت الحياة وبدأت معها الفلسفة، منذ بداية الإنسان القديم وتفكيره في كيفية توفير سُبل العيش، وهذه هي نقطة انطلاق الفلسفة: كيف يعيش الإنسان؟
وبناءً على فكرة “الصيرورة” للفيلسوف اليوناني هيراقليطس، التي تعني أن لا شيء يظل على حاله وأن كل شيء في تغير مستمر، أخذت الحياة تتطور، ويطور معها الإنسان طرق العيش. فتمت ترقية السؤال من “كيف يعيش الإنسان؟” إلى “ما هو أصل الأشياء؟”، بعقل الفيلسوف طاليس المليطي.
بدأ ميلاد الفلسفة بالأسئلة الكبرى، فتحول هم الإنسان من التفكير في تلبية احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتزاوج، إلى الغوص في أسرار الحياة. فها هو أفلاطون يتصور عالم المثل، وأننا قبل تشكيل أجسادنا كنا في عالم الأرواح، ولهذه الأفكار صدى في الإسلام، وبشكل أكثر دقة في سورة الأعراف، آية ١٧٢:
“وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا”
ويأتي أرسطو وطاليس بنظرية العلل، متأملًا ومتسائلًا في الكون، مؤمنًا بأن له خالقًا وأن الكون لم يُخلق صدفة أو هباءً منثورًا، فهناك محرك للكون لا يتحرك، لأنه لو تحرك سنظل نبحث في دائرة مفرغة عن مسبب الحركة، وهو المحرك الأول.
وفي العصور الوسطى، ارتبطت الفلسفة بالدين، فأصبحت ذات صبغة دينية بحتة. فنجد أفكار الفلاسفة المسيحيين:
أنسلم قال: “آمن لكي تفهم”
توما الأكويني قال: “الفهم يقوّي الإيمان”
وعند الفلاسفة المسلمين:
الفارابي رأى أن العقل أداة للوصول إلى معرفة الله.
ابن سينا استخدم الاستدلال العقلي لفهم ما جاء به الوحي.
ابن رشد اعتبر أن الفلسفة واجبة على العلماء لفهم الله والكون، وأكد على إعمال العقل في النص الديني.
وأخيرًا، ننتقل إلى أفكار فلاسفة العصر الحديث والمعاصر. نجد ديكارت ونقده البناء، وعقله المتوهج في إعادة توجيه مسار الفكر والتخلص من شوائب الأفكار التقليدية، وأثبت بمقولته الشهيرة: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. لماذا قال “أنا” ولم يقل “نحن”؟ لأن الفلسفة نسبية، ومقياس التفرد فيها هو إمكانية تفرد الإنسان وعدم اتباع أي فكرة دون فحصها وتحليلها.
كمثال على فلاسفة معاصرين وأفكارهم: نيتشه وأفكاره حول الإرادة وفلسفة القوة والإنسان الأعلى، ونقد التقليد وتحطيم الأفكار الجاهزة، ودعوته الدائمة لتفرد الإنسان وقدرته الخارقة على التغيير، وأن يجعل لنفسه قيمة. وهذا يذكرنا بفلسفة أحد المفكرين المصريين، مصطفى محمود، ومقولته:
“قيمة الإنسان هي ما يضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته.”
وبهذا نختم مقالنا: فهل نرضى بأن نكون عبئًا على الحياة؟ أم آن الأوان أن نعيد اكتشاف أنفسنا وفهمها وفهم الدور الذي وُلدنا من أجله؟
***
محمد أبو العباس الدسوقي