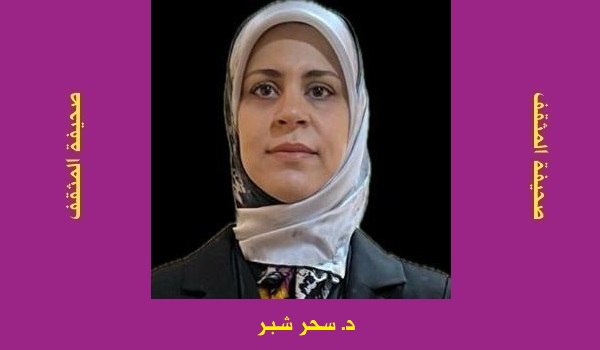قضايا
عبد الله الفيفي: كثرة الوِفاق: نِفاق!

في المساقات الماضية ناقشْنا مع (ذي القُروح) محطَّات في رحلة الثقافة العَرَبيَّة من الشِّفاهيَّة إلى التدوين، مشيرين إلى بعض تقنيات الطَّورَين الشَّفوي والكتابي، وما اعترى جدليَّاتهما من عقبات وعثرات. ثمَّ قلت له:
ـ قلتَ لنا، يا (ذا القُروح): إنَّه قد يُطلَق مصطلح «كِتاب» في التُّراث العَرَبي على المكتوب عمومًا، وإنْ كان رسالةً في بضع صحائف، أو حتى في صحيفة واحدة. ومثَّلت على ذلك بكتابٍ مخطوطٍ منسوبٍ إلى (الجاحظ)، عنوانه «مئة كلمة من كلام أمير المؤمنين عَليِّ بن أبي طالب»(1)، وقد يُعَدُّ في جملة مصادر «نَهْج البلاغة». ومع هذا فقد ذكرتَ أنَّه لا يعدو، في مخطوطه، نحو 7 صحائف! ولقد وجدتُ هذا الذي سُمِّي كتابًا مضمَّنًا في كتاب (الثعالبي)، «الإعجاز والإيجاز»(2)، في أقل من ثلاث صحائف!
ـ أفادك الله! ولو حذفتَ حواشي الشارح لصار في صحيفتين!
ـ لكن بعيدًا عن هذا، ألا ترى كيف جاء اختيار عنوان «نَهْج البلاغة»، في ذاته، دالًّا على أنَّ (الشَّريف الرَّضِي) إنَّما أراد أن يقول إنَّ تلك مدرسة (عَليٍّ، كرَّم الله وجهه) في الخطابة، وذلك نَهْجه في التعبير، فسَمَّى كتابه «نَهْج البلاغة»؛ لمن أراد أن يحذو حذو الإمام في النَّهْج المأثور من خطابته. ولو كان موقنًا أنَّ ما ضمَّنه كتابه هو من كلام عَليٍّ، بلا شَكٍّ، لسمَّاه «خُطَب أمير المؤمنين ورسائله ووصاياه وحِكَمه»، في عَزْوٍ صريح إليه؟
ـ نعم، وقد ألمحتُ إلى هٰذا في المساق الماضي. لقد بدا (الشَّريف) حريصًا على أن يَظهر بمظهر الراوي، تاركًا العُهدة على من أخذ عنهم. وهذا ما نَصَّ عليه شارحه (ابن أبي الحديد)(3)، حيث قال: «إنَّ الرَّضِىَّ، رحمه الله تعالى، نقلَ ما وجدَ، وحكَى ما سمعَ، والغَلَط من غيره، والوَهْم سابقٌ له.» لولا أنَّه، في الوقت نفسه، كان ينازعه شغفٌ قَهريٌّ، نفسيًّا ومذهبيًّا، لإثبات تلك النصوص، على أنَّها لـ(عَليٍّ)، ولو تخيُّلًا ومحاكاة. ولقد ذكر ابن أبي الحديد(4)، بشأن الخطبة السادسة عشرة- من خُطَب «النَّهْج» المنسوبة إلى عَليٍّ، التي قيل إنها خطبته لمَّا بُويع في (المدينة المنوَّرة)- أنَّها كانت فيها «زياداتٌ حذفَها الرَّضِيُّ، إمَّا اختصارًا، أو خوفًا من إيحاش السامعين.»
ـ ومَن هذا شأنه، فحَريٌّ أن يُضيف كذلك، ومَن هذا شأنه، فليس بأمين في نقله!
ـ وما اتِّهام الأُمَّة العَرَبيَّة والإسلاميَّة، من السَّلَف والخَلَف، بأنَّهم حاسدون حاقدون متعصِّبون، بل ربما نواصب، حينما يثيرون مثل هذه التساؤلات العِلميَّة المشروعة، إلَّا عَين النَّصب والتعصُّب، ودَسِّ الرؤوس في الدُّغمائيَّة المذهبيَّة، حتى لكأنَّ الشاكَّ في صِحَّة نِسبة «النَّهْج» بحذافيره إلى عَليٍّ- الذي عاش قبل نهاية النِّصف الأوَّل من القرن الأوَّل للهجرة بعشر سنوات- قد شكَّ في نسبة «القرآن» إلى الله سبحانه! مع أن «كثرة الوِفاق نِفاق، وكثرة الخِلاف شِقاق»، كما تعلِّمنا الحِكمة المنسوبة إلى (عليِّ بن أبي طالب) نفسه. أ فيريد هؤلاء أن ننافق، موافقين على ما نسبه (الشَّريف) إلى عَليٍّ، مغمضي الأعين والعقول، لنترنَّم معهم بأنَّ كل ما في «النَّهْج» صحيح النِّسبة إلى من نُسِب إليه، مئة بالمئة؟!
ـ توارُث الغُلُوِّ قد يبلغ مبلغه، حتى ينتهى- كما رأينا عن (القبانجي)- إلى القول بتفضيل بلاغة «النَّهْج» على بلاغة «القرآن»، هكذا، بغير عِلْمٍ ولا هُدًى ولا كِتابٍ مُنيرٍ. والغُلُوُّ يُعمِي ويُصِمُّ أكثر من الحُب؛ فكيف إذا أصبح تراث دِينٍ متوارثًا؟!
ـ ومن طرائف الغُلُوِّ عن (الشَّريف الرَّضِي)، في هذا السِّياق، ما رواه (ابن خلِّكان)(5) في ترجمته- وهي طُرفة ذات دلالةٍ بليغةٍ على تشرُّب هذا النَّهْج في نفسه منذ نعومة أظفاره- قال: «وذكر أبو الفتح ابن جِنِّي النحوي... في بعض مجاميعه أنَّ الشَّريف الرَّضِي المذكور أُحضِرَ إلى ابن السيرافي النحوي، وهو طفلٌ جِدًّا، لم يبلغ عمره عشر سنين، فلقَّنه النحو، وقَعَدَ معه يومًا في حلقته، فذاكره بشيءٍ من الإعراب على عادة التعليم، فقال له: إذا قلنا: «رأيتُ عُمَر»، فما علامة النَّصْب في عُمَر؟ فقال له الرَّضِي: بُغْضُ عَليٍّ! فعَجِب السِّيرافي والحاضرون من حِدَّة خاطره. وذُكِر أنه تلقَّن القرآن بعد أن دخل في السِّنِّ فحفظه في مُدَّةٍ يسيرة».
ـ الحقُّ أنَّ هذه ليست بحِدَّة خاطر، بل هي حِدَّة انغلاقٍ تربويٍّ تلقينيٍّ، تَعرَّض لها هذا الطفل منذ نعومة أظفاره، وهو دون العاشرة. فلقد لُقِّن أنَّ اسم (عُمَر) إنَّما هو (عُمَر بن الخطَّاب)، وأنَّ عُمَر هذا وَحْشٌ شَبَحيٌّ كاسِر، وكان يُبغض (عَليَّ بن أبي طالب)، هكذا ضربة لازب، وأنَّ «النَّصْب» لا معنى له إلَّا معناه الاصطلاحي الطائفي، من العداء لعَليٍّ وآل البيت! فما لهذا الطفل، المبرمَج عقلًا وروحًا، ولمسائل النحو والإعراب؟!
ـ مع أنَّ هؤلاء مطمئنون- تحت الشعار الوارد في «النَّهْج»(6): «اسْأَلُوني قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ فِيَما بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ... إِلَّا نَبَّأْتُكُمْ»- أنَّ (عَليًّا) هو واضع عِلم النَّحو! كيف لا، وقد زعموا أنه كان منبع العلوم كلِّها؛ فهو «باب مدينة العِلْم»، حسب الحديث الموضوع. ولذا زعموا أنَّ (أبا الأسود الدؤلي) إنَّما نحا ذلك النحو من وضع اللَّبِنات الأُولَى لعِلم النحو بتوجيهٍ من عَليٍّ. بل إنه قد أملى عليه مباشرةً جوامع النحو وأصوله، وأقسام الكلام وأبوابه، ومنها التعريف والتنكير، وتقسيم وجوه الإعراب إلى: الرَّفع، والنَّصْب، والجَرِّ، والجَزْم!(7) فأنَّى لهذا الطفل- يا (ابن السِّيرافي)- أن يرى (عُمَر) أو (عَليًّا) على حقيقتيهما، دون خيالات مؤدلِـجة مسيِّسة، تنامت في سراديب التعصُّب، التي قُذِف فيها المسكين من قِبل أبويه وعشيرته الأقربين. وإذا كان هذا الخاطر الحادُّ قد طفحَ منه، وبراءة الأطفال في عينَيه، فكيف ستكون حِدَّته لمَّا يكبر، وتُصبح في يده نقابة الطالبيِّين، ويؤلِّف لهم «نَهْج البلاغة»، أو يُشارك في تأليفه أخاه (المرتضَى)، الذي لا بُدَّ أنَّه كان لا يَقِلُّ عن أخيه حِدَّة خاطر؛ فالمرتضَى كان أكبر منه سِنًّا، وقد عاش أطول عمرًا. أمَّا بعد، فأمامنا كتاب عنوانه «نَهْج البلاغة: نسخة جديدة محقَّقة وموثَّقة تحوي ما ثبتت نسبته للإمام عَليٍّ (رضي الله عنه وكرم الله وجهه) من خُطَب ورسائل وحِكَم»، تحقيق وتوثيق: صبري إبراهيم السيد، (الدوحة: دار الثقافة، 1986).
ـ ماذا عنه؟
ـ هو دراسة أصلها أطروحة دكتوراه. بذلَ فيه المؤلِّف جهدًا ملحوظًا. ونَجِد، بعد تقديم المحقِّق المشهور (عبد السَّلام محمَّد هارون) للكتاب، ومقدِّمة مؤلِّف الكتاب، تمهيدًا حول «نَهْج البلاغة» وما يحيط به من شُبهات، وما قيل في الردِّ عليها، وملحوظات على ما يشار إليه من مصادر «النَّهْج»، وما كُتبت له من شروح. ليُقدِّم المؤلِّف بعدئذ توثيقه لنصوص النَّهْج، بدأً بالقِطع والخُطَب، ثمَّ الرسائل والوصايا، ثم الحِكَم والغريب.
ـ الزُّبدة، يا (ذا القُروح)؟
ـ لقد ذكرَ المؤلِّف أنه توصَّل، في نتائجه لتمحيص ما يمكن أن تثبت صحَّته للإمام (عَليٍّ)، إلى أنَّ النصوص التي اتَّفق جُلُّ علماء المسلمين، سُنةً وشيعةً، على صِحَّة نسبتها إليه من الخُطَب هي أقل من النِّصف، ولا تعدو: 44.5%، ومن الرسائل: 65.8%، ومن الحِكم: 26.9%، ومن الغريب: 44.4%. على أنَّ ثمَّة نصوصًا منسوبة إليه لم يَرْوِها أحد، ولم تَرِد في أيِّ كتاب. ثمَّ ذكرَ المؤلِّف النصوص المشكوك في صِحَّة نِسبتها، والنصوص التي ثبتت نِسبتها لآخَرين. ويخلص من ذلك إلى القول: «إنَّ نِسبة تدخُّل أقلام أخرى في النصوص الواردة بالكِتاب تعلو في الحِكَم، ويليها الغريب من الكلام، ثم الخُطَب، وتأتي الرسائل في نهاية الخطِّ البياني.»
ـ تُرى لماذا كانت الرسائل في نهاية الخطِّ البياني؟
ـ طبعًا لأنها موثَّقة كتابيًّا، فلا مجال للتلاعب فيها، غالبًا، بخلاف الأقوال الشفويَّة. عَقِب هذا يَعرض المؤلِّف كشفًا يُحاكِم فيه كلمات النصوص على المعجم الموثَّق لكلمات الإمام.
ـ أراك راضيًا عن الكتاب! وهذا نادرًا ما أجده منك!
ـ ومع هذا، كُلٌّ يُؤخَذ من كلامه ويُرَد.
ـ هاتِ ما لديك!
ـ ممَّا يُلحَظ على هذا العمل أنه كثيرًا ما يعتمد على تقميش المقولات من هنا وهناك، بلا تمحيص، أو تأصيل. ومن عاقبة هذا أن تجده، مثلًا، ينسب كلام الأوَّل السابق إلى المتأخِّر اللَّاحق، بل التَّابع المردِّد.
ولكن «ضاق فِتْرٌ عن مَسِيرِ».. فسوف أُنبِّئك برأيي في الكتاب في المساق المقبل، بعون الله!
***
أ. د. عبد الله بن أحمد الفَيفي
..............................
(1) منه نسخة مخطوطة في (مكتبة مكَّة- مخطوطات)، التابعة لوزارة الحجِّ والأوقاف، سُجِّل على غلافها تصنيفًا: أدب 7.
(2) تُنظَر طبعته: (1897)، بشرح: إسكندر آصاف، (مِصْر: المطبعة العموميَّة)، 28- 30.
(3) يُنظَر: (1959)، شرح نَهْج البلاغة، تحقيق: محمَّد أبي الفضل إبراهيم، (القاهرة: دار إحياء الكتب العَرَبيَّة)، 1: 143.
(4) م.ن، 1: 275.
(5) يُنظَر: (1968)، وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان، تحقيق: إحسان عبَّاس، (بيروت: دار صادر)، 4: 416.
(6) (1990)، نَهْج البلاغة، شرح: محمَّد عبده، (بيروت: مؤسَّسة المعارف)، 260.
(7) يُنظَر: ابن أبي الحديد، شرح نَهْج البلاغة، 1: 20.