
خاص بالمثقف: الحلقة الثالثة عشرة مع الدكتور سامي محمد عبد العال، أستاذ الفلسفة في جامعة الزقازيق، ضمن مرايا فكرية، وحوار شامل أجراه معه الأستاذ الباحث مراد غريبي، حول آفاق الفكر الفلسفي، فأهلاً وسهلاً بهما:
***
القسم الثالث: الدين والأخلاق وفلسفة القيم (5)
س35: أ. مراد غريبي: يُقال الفلسفة غالباً ما تكشف الكذب والكبت والنكوص، ترى لهذا السبب يخشى كهنة المعبد من الفلسفة، وماذا عن فلسفة الكذب بإسم الدين وهل الحيل اكتسبت المشروعية والشرعية من هذه الطبخة الكهنوتية؟
ج35: د.سامي عبد العال: علاقة الفلسفة بالكذب علاقة " عتيدة وطريفة " في الآن نفسه مع دوران التاريخ والأفكار على مدار العصور. وليكُّن فهم هذه العلاقة بمثابة الوتر المشدود تجاه جوانب السؤال المتباينة. لأنّ الفَهم تأويلٌ لا يخطئ معنى ما قد يكون مقصوداً. كل كذب يعود على شتى فاعليه بمغامرة الظهور والإنكشاف. وليس كل انكشاف مرفوضاً مثلما أنَّ كل حق قد لا يكون مقبولاً. إن "الكذب ليست له أُرجل " كما يقال ذات عبارة شائعة. ومع ذلك يحتاج إلى فيلسوفٍ قصّاص للأثر. مهمة ضاربة في اعماق السياقات والموروثات، الأثر بصمات رمزية عبر أي فضاءٍ يحتمل فضول الإنسان. ونظراً لكون الفلسفة لا تعادي أحداً، فيجب أنْ يكون الشرح من جنس الفكرة المُحايدة. أي سأحاول طرح فكرة الكذب وتحليل إمكانياته كما هو.
الكذب مادة إنسانية ( هيولى بلغة أرسطو) تدخل في نسيج الأفكار ولحمة الحياة المشتركة. إنه احدى مفارقات الإنسان من حيث هو كائن يقول الحقائق ويطلق الأكاذيب معاً. إشكالية متموضعة بما هي كذلك دون حل. لقد أخذ الكذب حركته من وجود الإنسان لا العكس. جميع ما ينتمي إلينا لا يخلو من سمات كاذبة صغُرت أم كبرت. استعمال الأشياء، الأفكار، التصورات، الاستعارات، اللغة، الأفعال البشرية، الاحلام.. جميعها مسائل راشحةٌ بمعانٍ ليست لها.
الفلسفة- وربما الفلسفة وحدها - تمتلك" ترسانةً فكريةً " لكشف الكذب. جميع ما مرّ من تاريخها كان مُفسراً لماهية الكذب قولاً أو نسقاً. بعبارةٍ يجب أنْ تكون واضحةً: أن الفلسفة كفكرٍ يُشرّع للعقول والمجتمعات الحرة هي محاولة دؤوبة لقول الحقيقة. ولكن الهاجس الدائم هو: أية حقيقة هي المقصودة عندئذ؟ ما الظروف والشروط المؤسسة لها؟ وبخاصة أنَّ الحقيقة تُكتّشف بجهدٍ جهيد. وكذلك قد تكون الحقيقة مُلقاة لدرجة الاهمال بين أشياءٍ كثيرةٍ. الأهم هو كيفية صياغتها أو تقديم أشكالها الأكثر تأثيراً. فلا توجد حقيقة في العراء. وأيضاً لا تدع الثقافة مساحة الظهور أمامها بصورة تلقائية. لعلَّ أية حقيقة حين تبدو واضحة إنما هي مرحلة مؤقتة لن تستطيع التواجد باستمرار. وتخضع لشتى صنوف التغطية والحجب. طبيعة الحقيقة: أنْ تُوجد حيث لا توجد، أن تتجلى حيث تختفي، لكنها- مع ذلك- ما فتئت تطل برأسها حين تشعر بالأخطار.
كان لا بد لكل تفلسف أنْ يدرك ضمنياً: ما معنى الكذب falsehood؟ ما فحوى أنْ يكذب الإنسان؟ وحتى عندما تبحث الفلسفة في الأكاذيب، فهي تتساءل: ما حقيقة الكذب؟ أيتحول الكذب إلى حقيقة أم لا. الحقيقة مبنيةٌ في سرها على التحرش بمقولات الكذب. لأنّ من أسباب الحقائق: أنْ تقول ما حدثَ أو ما يحدثُ أو ما لم يحدث على وجه التحديد. تبقى كل حقيقة مدفوعةً بقول ذاتها اتساقاً مع أصلٍ ما. التفلسف ينقبُ عنها ذات اليمين وذات اليسار باحثاً عن القيود المحيطة بها، ولماذا لا تظهر (أو تتمنع) خلال سياق أو آخر؟!
وفي غير حالةٍ، ربما لا تُعنى الفلسفة بما هو خفيّ إلاّ عندما يكون الكذب طقساً عاماً، حين يصبح نفقاً من جنس الأفكار السائدة، أي إذا كان الكذب أحدَ شعائر الحياة العامة. خلال متون الكذب وحواشيه، تنبت الفلسفة كالأعشاب البرية، مثل نباتات ليلية تتفتح تحت جُنح الظلام. وقد تخرج كنباتات نهارية في وضح الألق والأضواء (لنتذكر الفيلسوف ديوجين اللائرثي الباحث عن الحقيقة في نهارات أثينا اليونانية). الفلسفة تعقد العزم على نقد المُضاد للتفكير الواضح. التفكير الواضح هو ما يقال بجلاء أمام عقول الآخرين. وتستطيع أن تتعايش مع جميع الأجواء، لأن الفلسفة ما وجدت إلاّ لتعلن صوت العقل. والعقل لا يموت، لأنه ضد الفناء، حتى لو خفت تريده في يوم من الأيام.
من جانبٍ آخر، لا تدع الحقيقة نفسها ملكاً لأحدٍ، رغم أنَّ الفلسفة لا تفترض ذلك ولا تطمح إليه. ولكن قد تزعم بعض الفلسفات أو الايديولوجيات امتلاك الحقيقة مباشرة ولا شيء غير الحقيقة. وهي بهذا الزعم تقدِّم دعوةً مفتوحةً لاختبار صدق أفكارها. كأنَّ الفيلسوف يقف أمام قوة العقل كوقوفه أمام قاضٍ لمُحاكمة تاريخيةٍ. ويمتثل لما يُملّىَ عليه من قضايا وموضوعات. أما هيئة المحكمة فهم اشخاص اعتباريون، هم العقول الفلسفية الكبرى ضمن إنسانيتنا الحرة. يتبلور طريق الفيلسوف أثناء البحث عن الحقيقة متبادلاً طرحَ الأسئلة والأجوبة مع العقول الأخرى. لكن عليه في الوقت نفسه أنْ يدحض شيئاً ويرفضه كما يقول أرسطو. شيء يتلقى كافة الحجج والتحليل والتفنيد. وتصبح للتفلسف صفةُ إقامة الحُكم، اتخاذ القرارات وحيثيات البت في المسائل الشائكة... مع ضرورة تقديم القرائن والبراهين إزاء الادعاءات والمزاعم.
أثناء الحوار الفكري يحمل كلام الفيلسوف دلالة "حلف اليمين" وسط شهادة الآخرين، وذلك وفقاً لنظام يضبط آلية المحاكمة فلسفياً على الملأ. إذ ذاك تنحل تجربة الحلف باليمين داخل تفاصيل رؤيته الفلسفية، سيكون مأخوذاً بمهابة (كلية) الموقف وصرامة الردود وصياغة الحجج، منتقلاً بكل حذرٍ من خطوة إلى أخرى، مخافةَ الانحراف ومحاولاً الامساك باللغة قدر المستطاع. فليس هناك شيء مما يطرحه إلاَّ ضمن نسقه العقلي. إنَّه- من ثم- سيناقش موضوعات الفكر بخطاب ضامن ليقينه. اليقين بقدرة الخطاب على الاتساق تبعاً لمعايير التفكير. فليست التقاليد الفلسفية إلاَّ دروباً للأفكار وتدقيقاً للمعاني.
إذن بنفس درجة الحقيقة، الفلسفة معنيّةً بما ليس حقيقياً. لأنَّ الأمر ليس اختياراً بين هذا وذاك (بين الحقيقي والزائف). الحالتان ليستا واضحتين تمام الوضوح. هناك تفكير في شيءٍ ما من حيث حضور النقيض خلال وجوده الخاص. لا شيء منفصل هناك تمام الانفصال دون نقيض. على الأقل من زاوية افتراض معرفة الأشياء بأضدادها كما يُقال. ليس بإمكان الإنسان التعرف إلى الحياة دون الموت، ولا إدراك الواقع دون المثال ولا تأكيد الثابت بخلاف المتحرك ولا الكلام عن الوعي دون الغريزة.
ليس الكذب طرفاً في ثنائية يحضر أحدهما حين يغيب الآـخر، لكنه عمل وآلية وخطاب وممارسات، وأكثر من هذا: إنّه نظام للتفكير يمس رؤى العالم والحياة والتاريخ. وقد يأخذ منحى الحقيقة ذاتها. فيعبر مثلاً عن وجه الحقيقة في ثوب خادع حينما يمثل اساءة طرحها، وحينما يقصد بها التغطية على أشياءٍ أخرى. وبالرغم من كونها حقيقةً صادقةً إن كانت كذلك إلاّ أنها تُطرح وفقاً لمعطيات اللغة خلال المجال العام. أي وجود الحقائق ضمن وسيط تقني يسمح عن قصد بإفراط المعاني أو العكس. فلم تعد الحقيقة حقيقةً إنما هي صورتها، بلاغتها عندئذ. باختصار ليست هي الـ"هي".
إنْ لم تكن هذه بمثابة فكرة الكذب، فما طبيعته ومشروعيته وحدوده؟ أسئلة ذات طابع جذري تتيح ايجاد (مساحة عمل) للفلسفة. مساحة تفلسف تدعونا لممارسة دوره باستمرار. إنَّه يضعنا في قلب توتراته مشدودين بخيوط من حرير مع تصوراتنا. فالفلسفة تجدد مهمتها كلما كانت ثمة ماهية تقتضي التحديد ولا نعرف كيف. أهي تُقلِّب الإمكانيات، أهي تضرب في الجذور، أهي تلتقط المشترك والمستقر تحت الأسطح؟ إنّها كل ذلك.. ولا سيما مع اعتبار الكذب فعلاً إنسانياً له أبعاد كثيرة. كما أنَّه يقدم وجهاً، بل وجوها للحقيقة. فليس الكذب هو معدوم الحقيقة... إنه يوازيها. بل لعلّه فعل يغرقها في أساليبه. ولهذا يختلف عمل الفلسفة عن طبيعة الاعمال الأخرى. لأنّ عملها حفرٌ ومساءلة وتنقيب في اللا مفكر فيه واستقصاء وقياسُ أبعادٍ ومسح وترميم أفكار وفلاحة مفاهيم، كما أنّ التفلسف يُؤصل دون أصالةٍ غير قابلة للتغير. وقد لا تكون تلك الأشياء ذات دلالة كليةً للتفكير إلاَّ من جهة كونها رغبات. ومن زاوية تكشُفها في لحظات إغواء قصوى كما يغوينا الكذب تجاه دروب نوعيةٍ في الحياة.
وقد يقول بعض الفلاسفة كلاماً عن جوهر الحقيقة وسلطتها. غير أنَّ القول يعد قولاً في الكذب أيضاً. لأنَّه ينفي ويثبتُ بالوقت ذاته. يثبت حقيقةً لها مجالها وآفاقها وينفى (يُكذِّب) شيئاً ما ضمن العمل نفسه. هو ينفي ضمنياً اللاحقيقة تبعاً لما يراه من أشياءٍ وآفاق. ويجري الشجب أو الشطب على النقيض الكائن في قلب الأشياء هذا من زاوية. أمّا من الزاوية الأخرى، فالفلسفة تصورات ومفاهيم (تزيّف الدوافع) الحيوية للإنسان. لأنها تستبقي في دلالتها بقايا الغرائز والحريات الأصيلة للكائن الطبيعي. إن بعض الأفكار الفلسفية بمثابة فنون الكذب على النفس بإغراق الذات في لعبة التجريد. نوع من التمهُل حتي ينصرف الكائن عن ذاته نحو بدائل غيرها. الفلسفة قد تمثلُ بلغة نيتشه " كهانة مصطنعة ". وتمتص طاقة الفعل في صورتها الخالية من أي فعل.
لكن إجمالاً، تعدُّ الفلسفةُ في أحد جوانبها كشفاً لآلياتِ الكذب. لأنَّها استعمال نسقي للقدرة على التفكير ونقد الممارسات. أي استعمال سيُظهِر القريب هنا ما خَفِي هنالك على البعد، وسيفسر ضمنياً ما يتفلت من التحديد، وسينتقد التجزيء المقصود تحت غطاء كلي. فالمنطق الذي تفترضه كلُّ فلسفة لا يخضع للتوظيف النسبي إنما يتم بشكل عامٍ. وهذا الأمر بالغ الصعوبة، فلو حدثت أية (مراوغة منطقية)، فقد يتقوض البناء الفكري وتتعرض قواعدُه لخطر الانهيار. وتُسمى هذه الحالة بالجذر اللاتيني مغالطة قائمة على خلط الأشياءfallacia، وتعني استدلالاً بالجزئي على الكلي، وتناول سمة عارضة على أنها جوهرية. لذلك يَنتُج التفلسف عن عملٍ فني متناسق ensemble، ويُنتِج أيضاً دلالةَ الأشياء (ينتج عن وينتج الــــ...) بشكل مُزدوجٍ. أي مجموعة الأفكار التي تُستّوعب ككلٍ مترابطٍ. إنَّه العمل المعماري باختلاف تلويناته. وهو كذلك الأداء المتقارب لتأليف المفاهيم كما تتألف الأنغام الموسيقية وفقاً لقواعد وضوابط خاصةٍ.
وعند وجود ثغرات نسقية، سرعان ما تبرُز كفجواتٍ، ولكنها ستُغطى بغطاء تلفيقي إلى حين. وهذا ما نراه في الخطابات النفعية والبرجماتية طبقاً لاعتبارات المصالح. وبالتالي فإنَّ ما سيبدو لا مرئياً ومُسلّماً به سينالُ قدراً من المراجعة. فالأسئلة لن تكفُ عن ملاحقته هنا أو هناك. والفلسفة بهذا العمل فحص صارم لمنطق التبرير عبر أشكال التواصل، سواء أكانت لغةً أم معرفةً أم علاقةً. ولئن جاء الكذبُ جزئياً ولا يعي متبنُوه انفلاتَّه في جانبٍ أو آخر، ولئن كانوا لا يقدرون أثرَّه عبر مواقف أو نقيضها، فإنَّ تفكيراً نقدياً بإمكانه تقريب المسافة.
هكذا قد يمتلك الفيلسوف جهازاً فكرياً لتعرية عمليات التزييف. إنه عازف اوركسترا من الأفكار والتحليلات التي توضح التباين بقدر ما تبرز تماثلاً بين الأشياء. لذلك سيطرح الأسئلة برؤيته الأكثر انفتاحاً لا مذهبه الجامد... لماذا يتحدث الآخر بمنطق تبريري متهافت؟ لماذا يتسلق الخطاب التداولي على قواعد واهيٍة؟! ما أساس الكذب في استعمال اللغة؟ أهو التاريخ من زاوية كونه استعارات؟ أهي الحقيقة العصية على المعرفة من أولِّ وهلةٍ؟! لكن الفيلسوف سيراجع نفسه قائلاً: اللغة هي مصدر الشرور. لأنَّها تفرز فيروسات الاستعارة والمجاز والتشبيهات. إذن -نتيجة هذا- فإن كل عبارات التواصل بها شيء من الزيف. وتلك الإجابة أيضاً غير مقنعة. لأنَّ الفيلسوف لو عرف خطوتها القريبة لوصف كلامَه نفسه بالوصف السابق. وعندئذ لن يخرج من الدائرة إلا مصاباً بسهام النقد!!
لماذا لا نطرح المسألةَ بالمقلوب؟ أي: لِمَ يُعتبر القول- حين يُطرح- صادقاً؟ أهو قول ارتبط بالواقع أم امتلك مبرراته القوية تعبيراً عن ذاته؟ ربما يكون الرد: أنَّ حجج الكلام تخضع للمناقشة وتحتمل بحثاً عن اليقين... أو هي مبررات تخرج بأقل قدر ممكن من التشوهات عقب المناقشة. هنا أيضاً سيكون الشك بالمرصاد لهذه الإحتمالات. لأنَّ اللغة التي تحدثنا عن فيروساتها لا تُعطي الخطاب يقيناً فورياً. وإنْ ظننا أنَّ الخطاب قد نال هذا اليقين، فسيظل معلقاً بأُطر المجاز وتداعياته. وما لم نأخذ الكلامَ بهذا المضمون، لبطُل عمل اللغة أصلاً. فكلُّ خطابٍ به هذه الفجوة البلاغية في أعماق معانيه وفاعلية أفكاره.
تطرح اللغة وجُوهاً أخرى للتعبير عن مضامين الخطاب. وليس سهلاً معرفة جوانبه إذا كان التركيز منصباً على المعنى المباشر. إذن أتوجد القضية(قضية الكذب) في دائرة الطرح أم في دائرة الفهم؟ بكلمات أخرى، أليس الطرح تخارجاً عبر فعل هو الاستعمال الوظيفي للخطاب؟! وهذا الأخير يكشف المعنى ويميزه. هكذا يخرج بنا السؤال إلى أخلاقيات الخطاب، حيث الأغراض والمآرب والأهواء والغرائز. ويبدو الطرح والفهم على درجة من التوازي، لأنَّ التوظيف لون من سياسات الخطاب واقتصاد اللغة.
من ثمَّ، هل الكذب فلسفياً مشكلة أخلاقية؟ لكن لو كان كذلك، ماذا عنه، أي عن الكذب، في المجال العام وبآليات فكرية ليست ذات طابع أخلاقي فردي؟! وماذا عنه في مجالات تفترض أول ما تفترض لا أقول الصدق إنما الثقة المباشرة مثل: الدين والسياسة والاعلام والاجتماعيات؟ هنا ربما يشار إلى أنها قضايا بعيدة نوعياً عن الفلسفة. بل لا يوجد ما يُسمى في الفلسفة بالثقة الممنوحة مجاناً للمقولات والأفكار. لأنها تفترض التسليم بالكلام دون تأمل، بينما الفلسفة هي ميدان التأمل الفاحص بالأصالة. كما أنَّ الثقة تُزجي المعنى بطريقة فورية كأنه آتٍ من عقولنا إلى عقولنا. كلمة ( الثقة) على تلقائيتها تعتبر غامضة فلسفياً. الثقة في تاريخ الفلسفة تدخل نطاق الايمان واليقين. وهاتان الكلمتان مثلتا إشكاليتين في الدين والمعرفة والحياة.
وإذا ردّدنا كلاماً واقعاً بناء على الثقة، فهذا معناه غياب الفهم. معناه جريان الكلام من وراء التفكير، ومن خلف المعايير العقلانية ابتداء. فالثقة حجب غير مباشر لشكوك العقل وأسئلته. ولكن ما معنى حجب الشكوك؟ الحجب ينجم عن مزيج من العوامل المتشابكة. إن هناك تصديقاً بما يُقال لا صدقاً، إن هناك اعتقاداً في معاني الكلام كما يُطرح، إن هناك تجربة تسليم بوجود الآخر، إن هناك تداخل حالات وليس فرزاً للأفكار، إن هناك تأثيراً ينتظر رد الفعل كما في تمتمات الجمهور وتصفيقه أثناء الخطابات الدينية والسياسية. واخيراً فإن هناك انجذاباً إلى وسيط (كوسائط الإعلام) والانهماك فيه دون مبارحة.
قد تستعمل الثقة بمعناها المنجز سلفاً. وهذا يعني كونّها فردية الطابع وتُمنح بلا مقابل كذلك. لكنها عندئذ تنضح بالبعد الوظيفي، وتُفهم ضمناً. فلو طرحت الثقة صراحة، لكان الفحص والتثبت من حقيقتها حاضراً. وهذا ما يجعل أية ثقة تعود منكمشةً عند التأكيد عليها. فهي فجأة توضع في حجمها الطبيعي، ليس هذا فحسب، إنما تسأل الشكوك عن إمكانيتها. وإذا جرت كسمة عامةٍ للحقائق الاجتماعية، فلأنَّ النظام الاجتماعي يعمل بآلياته العامة لا بأهواء أفراده فقط.
هل يجوز الزعم بأنَّ الكذب أزمة ثقة؟! ليس الموضوع هكذا بالضبط، لكن كل كذب يثير فكرة التلاعب بالثقة. الفارق كبير، انعدام الثقة يدعو عادة إلى التوجس. أما توافرها إلى درجة الاستسلام، فيعطي الخطاب إمكانية التأثير السلبي. وبخاصة كون الثقة تشتبك مع معاني ومضامين الخطاب. يبدو ذلك جلياً إذا كان الخطاب الموثوق به دينياً أو سياسياً. فالثقة في الخطاب الديني هي الالتقاء لدى ضمان قوة أعلى، معنى أسمى. حيث يتم الانتباه إلى سريان الضمان بموجب الكلام على التعبير، بغض النظر عن تحولاته. فيكون التلقي مبذولاً للاستجابة دون مراجعة. وفي السياسة يغدو فائض السلطة وخيالها مجالين أثيرين لتجسيد الثقة.
في تلك الحالة، ليست الثقةُ مثالاً إنما حالة وتجسيداً. أشياء يحملها الكلام الديني والسياسي ويطرحها كما لو كانت مواداً موضوعية. وقد تترسخ لدى ذهنية المتلقي مع العلامات المصاحبة للكلام والسمات الخطابية وقدرات الحضور. لهذا تلقف الاعلام تلك الخاصية اللغوية التصويرية في تشكيل الوعي. كان المقصود منها حشو خلفيته بآراء وتحيزات أيديولوجية. تحديداً جرى الاستحواذ على المشاهد حتى من نفسه. فتجلت الثقة كفضاءٍ أثيري ينقل المعنى بموجب التصديق المطروح إضماراً.
أبرز ما في الثقة هو الاحساس بالاطمئنان الذي يشعر به المتحدث فيتجاوز حدود الحقيقة. عندئذ لن تكون الثقة خالصة إنما ستختلط بنوع من الاستجهال للمتلقي(أي اعتباره جاهلاً). ذلك مع الاطمئنان، لكونه غير قادر على كشفه(أي مغافلته/ استغفاله). ولا يتم ذلك بالقطع إلا تحت ألوان الانحياز، سواء من المتحدث أم من المتلقي لما يغطي مساحة الثقة، أو من كلاهما معاً لتنفيذ المعنى المُبرم سلفاً. ويستمر الكذب كأنّ (المتحدث والمتلقي) في مواجهة طرف ثالث مناوئ. وإزاء استمرار الحالة هكذا، يظل الطرف الثالث كياناً معنوياً ولا يخلو مقعد هذا المناوئ أبداً.
وبدوره ينجذب المتلقي إلى خطاب مغلف بالثقة، حتى يمثل مركز التصديق المباشر له، فالكلمة الألمانية glaube كما ترد عند هيجل والقريبة من الاعتقاد belief تشير إلى الوثوق بــشيء ما، والاطمئنان إليه. وقد تدل على قبول الشيء نظراً لاعتباره حقاً. حتى يمْثُل الشيء في النهاية موضوعاً للاعتقاد. أي أن الثقة أضيق دلالة من سواها، غير أنها ترفد الكلام برصيد مفترض لقبوله.
هنا ينشأ الكذب، حيث تعدى الكلام الكذوب إمكانية أنْ يوجد فقط. لم تكن ثمة مراوحة وتردد في القول بالكذب من عدمه. لقد وُجد فعلاً وغدا الوضع محلاً للمساومة على قبوله بجميع الحيل الممكنة. كيف لا، وهو ذاته حيلة لغوية تروم اسقاط مقتضى الحال على الواقع بالفعل. هذا أقرب وصف للوسيط الإعلامي من خلال بلاغة الصورة، فقد انتقلت الحقيقة بجذورها إلى مستوى القالب المبهر كما سنشير في حينه. ومثلت إغواء الاعتقاد والايمان بحسب رأي هيجل.
كانت الثقة دليلاً إلى ذهنية المتابع، حتى أصبحت لديه "قابلية الاعتقاد" belief ability إزاء ما يشاهد. وهي تسبق التلقي وتشترط النظر تجاه موضوعها بالكيفية المؤدية إلى الهدف منه. وليس هذا الهدف واضحاً للمتابع. إنَّه يسير وراء التغطية معتبراً الخطاب صيغ وفق قناعته. إلاَّ أن هذا الخطاب نوع من الهيمنة على وعيه. أي يصبح وعياً منفعلاً لا فاعلاً، مستهلكاً لا منتجاً، مسلِّماً بما يقال لا ناقداً.
السؤال الحيوي الآن: هل هناك مشروعية لهذا الفعل.. فعل الكذب؟ أليس السؤال مصطنعاً هاهنا؟ كيف تكون ثمة مشروعية لما لا مشروعية له؟ بالعموم حين تُطلق المشروعية فهي غير مكتفيةٍ بذاتها. دوماً تجري مسوغات الكذب وفقاً لمرجعية ما، سواء أكانت قانوناً أم ثقافةً أم مجتمعاً. لكننا سنقف مع الكذب إزاء اكتفاء المشروعية بنفسها. لأنه فعل قائم استناداً إلى مبرراته الخاصة التي قد تتغاير من موقف لغيره.
بهذا المعنى يعتبر الكذب فعلاً وظيفياً تطلعاً إلى مآرب معينة. إي يُطرَّح الكذب من مرحلةٍ لأخرى توطئةً لأهدافٍ تاليةٍ. ومن ثمّ، فالسر كله يكمن في وظيفة هذا الفعل. تلك التي ليست جوهراً بقدر ماهي شكل للاعتقاد السابق. فالكذب يقول: لم لا تصدق شيئاً ليس حقيقياً على أنه حقيقي؟! ويظل القول السابق يطرح بنفس شكل الحقيقة، لاعباً على منوالها وزخمها. فنحن إزاء إثبات فكرة التصديق لا الصدق نفسه. لا يوجد كذب يطرح نفسه مباشرة من أول وهلة. لا بد له من ترسيم خطوات الحقيقة التي تصنعه. وهو لا يبدو مناقضاً لها، لكنه يجادلها ليأخذ المكان الذي تقبع فيه، وإن لم يستطع فعلى الأقل ينتزع الاعتراف به طرفاً موازياً للمواجهة المرتقبة.
وكجانب من المعنى السابق، فهو نوع من التمحُك في الاقوال كونه تبريراً لموقف لا يُبرّر. إنّه موقف يتطلب الانكشاف، فإذا به غير ما يفترضه ذلك الوضع. ويأخذ في تورية حقيقته المفترضة، لأنَّه يصطنع حقيقةً خاصةً به. والتبرير فن مراوغة المتلقي لكيلا يعتقد عكس ما يُطرح عليه. بعبارة شوبنهاور المسألة هي:" فن أنْ تكون دوماً على صواب" أو الجدال المرائي إن صح التعبير. وهو مغلف بالمماحكات اللفظية والتلاعب بما ينال الثقة لدى المتلقين. نوع من التداخل بين الأغراض والمآرب واستعمال اللغة.
بكلماتٍ أخرى حين تسأل صاحب الكذب: لماذا كذبت؟ لم لجأت إلى الكذب وبخاصة أنَّه يتنافى والمرجعية الدينية كما في حالتنا؟ لن يجد تفسيراً سوى التأويل المتعسف لنصوص الدين أو الاصرار على الزعم بصدق الخطاب. عندئذ سنجد المشروعية لا تتجاوز الكذب ذاته. فهو عمل انتهازي لقطف رضى الآخرين أو لنيل غرض قريب. غرض هو الأقرب من إمكانية تحقق معاني الكلام. فالخطاب لا يستطيع العودة من حيث أتى. كيف سيعتذر عما بدر منه؟ فالمسألة أنَّه أحدث فعل الكذب بمبررات غير مشروعة وسط مجال عام أكثر شرعية. حيث يستمد الأخير شرعيته من المجتمع.. إذن ليكن الموضوع كذباً حتى النهاية.. هكذا قد يقال.
في محاورة " كراتيليوس"، رفض أفلاطون اعتبار الأسماء -وهي صيغ لغوية - ذات دلالة اصطلاحية. لأنه يرفض الرأي السوفسطائي القائل بإطلاق الاسماء بحسب اعتقاد الفرد. فإن كانت صحيحة من وجهة نظره، جاءت صادقة، وإذا كانت غير صحيحة من تلك الوجهة أيضاً، فهي كاذبة. لكن إذا حللنا موقف فلان لوجدناه حريصاً على عدم ترك فكرة المصداقية(المشروعية) لأهواء الأفراد. حتى وإن كانوا يتحدثوا عن شيء يخصهم. أليس الاسم يحمله الفرد وحده؟ غير أن المُسمى ينقل مشروعية الحقيقة والقبول والتلقي في الوقت نفسه. وبالتالي ليس من حق الشخص بذاته الانفراد بإطلاق الاسم ليؤدي إلى التلاعب بالمعنى. كان صراع أفلاطون مع السوفسطائية على أشده بسبب خوفه من ضياع شرعية المجتمع والدولة. ربما لم يقُل ذلك صراحةً على وجه الدقة. ولكنه كان يعلم أنَّ من يزيف الأسماء بإمكانه التلاعب بالمسميات، فهذه مرهونة بتلك. والمسميات في حال التلاعب بها لن تتجنب معتقدات المجتمع وسعية للاتفاق حول أشياء بعينها.
فمُسمى الشيء ينسب ضمنياً إلى واضع الاسم. لكن الأخير غير معروف، أي يعبر هذا الأمر عن غياب الواضع. ليس لأنَّه مجهول، بل قد يكون شخص بعينه هو من أطلق اسماً على شيء. غير أن المسمى ينسب إلى مصداقية الدلالة من حيث هي اتفاق عام. ليصبح لدينا واضعان وأكثر للاسم. هناك من يمثل الذي قال بالاسم اتفاقاً وحقيقة. وهناك من وضعه قبولاً بالحقيقة. لأنه أشار إلى صدقيته أمام الآخرين. وهناك نظام اللغة الذي يدمج الاسم في فلك المسميات على نطاق أعم. سوى أن هذا التدرج يعبر عن مشروعية تنتهي إلى تأكيد النظام الرمزي للمجتمع. أي قوانين وآليات التفكير الذي يسود في عصر من العصور. ومن ثم إذا أطلقت أسماء تنافي تلك المصداقية، يرى أفلاطون أنها كلمات كاذبة. ليست المسألة داخلة في دائرة الابستمولوجيا، لكنها عملية خاضعة لسياسة الأسماء.
إذن يعتبر أفلاطون مشروعية القضايا الكاذبة إنما تستند إلى رؤية الفرد. الفرد من جهة كونه معياراً خاصاً لما يزعم ولا ينزه عن الأغراض. وتبدو التفرقة واضحة من وجهة نظره بين ما لا ينتمي إلى الأفراد وبين ما يتصرفون به في ضوء معاييرهم. والأخيرة هي غير الحقيقة. فهذا الأمر الثنائي قائم على تفرقة أصلية بين مشروعية وغير المشروعية، بين الحق والزيف. لكن النقطة التي تحمل مثل هذه التفرقة هي المثال الذي يراه متجسداً فقط مع تطابق اللغة والأشياء.
مشروعة الكذب مشروعية حاملة لنفسها، لا تستند إلى شيءٍ. وإن استندت إليه فهي تعيد تأويله –أو مغافلته- من أجل تحقيق مصالحها. أي مشروعية تبرر نفسها بنفسها. وهي تأخذ الخطاب كوسيط. لاستعماله كما نستعمل المناديل الورقية، بكل ألوانه وأنسجته الرقيقة ومرونته وطبقاته الملتفة. وبإمكان الكذب صناعة مشروعيته طالما يستطيع فاعلوه خطف المنطق التوظيفي للغة. ومادامت المواقف تعاش كحالةٍ للهيمنة على عقول المتلقين.
إلى أي مجال تنتمي هذه المشروعية؟ إنها خليط من المجالات. ليست تلك هي القضية إنما الموضوع برمته يكمن في كيفية توظيف الخطاب ضمن أي مجال من المجالات. المسألة الكذوبة تموقع نفسها على مفترق طرق. جميعها طرق مؤدية إلى تغذية الحالة بالمبررات، بحيث إنْ عدمت مبرراً سرعان ما تستل مبرراً آخر. على الأقل من جهة صانع الخطاب إذْ يرى الفرصة مواتية لقصف وعي المتلقين ولتغييب المعنى وراء التعبيرات والاستحواذ على الموقف. من أجل توضيح الأمر أكثر فأكثر، يمكننا أن نحلل بعض المجالات المهمة على خلفية تلك القضية. ومن خلالها ندرك: من أين وفي أية تربة تنبت بذور الكهانة؟
1. مجال الأخلاق: تتقمص مشروعية الكذب إهاب السلوك الأخلاقي الفضفاض. أي تتوافر بعض الأكاذيب على طقوس أخلاقية خاصة بالشكل وأساليب الطرح والمظاهر الخادعة التي تقاربها مع هذا المجال. لأن مبررها يبدو مشيراً إلى عمل من قبيل التمسح بالقيم السائدة وادعاء حسن الطوية مع كم وافر من التقدير الظاهري. ذلك بالرغم من علم صاحبها: أنه في اللحظة التي يكذب فيها إنما يطوي صفحة الأخلاق. أهي عندئذ مشروعية رجوع إلى معايير ما؟ ... بالقطع لا، لكنها عملية تمويه باسم المعايير الأخلاقية. فإذا كان فعل "قبول الآخر" لوناً من الادعاء، فإنه سيتم بمجرد انتهاء الموقف المُعلن عنه. وربما يتحول الكذب في هذه الحالة إلى سلوك سري. فقبول الآخر كسلوك متظاهر به يصبح مبرراً جديداً (من حيث إعلانه) لمخالفته بشكل غير علني. وبالتالي سيدعو صاحبة الكاذب إلى الإمعان في تصفية الآخر.
ونظراً لأن السلوك الأخلاقي غير واضح، فإنه يأخذ خفاء دوافعه. وهذا هو المنزلق الذي قد ينخدع بسببه الإنسان. فحين يوجد سلوك غير صادق لا يميزه عن غيره، كما لا توجد معايير واضحة لهذا الجانب. وإن وجدت أية معايير، فسرعان ما تخضع لتمويه الفعل، ذلك لأن المشروعية لن نتمكن منها، بل هي تسيّر السوك كما لو كان صحيحاً.
2. مجال الثقافة: لا تبدو مشروعية الكذب منفصلة عن حال الثقافة العامة. لأنَّ الأخيرة عبارة عن مجموعة من الحيل والاستعارات والمراوغات التي " تُسكِّن " بؤر الصراع في المجتمعات. الثقافة بتلك الأساليب تخلق سياقاً للتفلُّت من المراقبة وتسمح بإعادة تسديد الأهداف. وتمارس وجودها القابل للتملك بالنسبة للأفراد، لكنها تبقى عصية على ذلك. حيث سيكون لدى الآخرين نفس الحيل. فهم نتاج الثقافة وهم قاطنون بالتاريخ عبر مراوغاتها.
لعل الثقافة بهذا تحجب الأشياء أكثر مما تظهر. وتمثل جراباً غرائبياً كجراب الساحر. فتخرج منه الألعاب تلو الأخرى دون توقف. ويحاول الأفراد بث غاياتهم عن طريق الجراب ذاته في سيرك الحياة الاجتماعية. حيث يكون الجميع (لاعبون ومتفرجون) حاضرين على مسرح واحد بعضهم أمام البعض. وفي هذا لا تخذل الثقافة أيَّ فردٍ يستطيع اتيان ما لا يستطيع غيره. ولا تنكص عن محاولة ابهاره، فتسبقه بكافة المخزون والمواد التي تهيئ له تأدية دوره بنجاح. فهي مخزون من الأفعال والرؤى تؤدي مساعدة مزدوجةً. اللاعب الثقافي يمتح منها ما تعوزه المواقف. وهي أيضاً توفر الأرضية النفسية والعاطفية لدى الجمهور لتسهيل مهمته. في تلك اللحظة قد نرى ثمة تواطئاً بين الخطاب والثقافة. لكنه خطاب يستثمر الموقف خير استثمار مقتنصاً غاياته القريبة. وهذا يوجد في ممارسات الأديان والسياسة والعادات والأخلاق.
ربما كان "سقراط والسفسطائيون" المثال الأبرز على أهمية الثقافة. فالسفسطائيون كانوا هم الحاذقين في صياغة أفكارهم طبقاً لألاعيب ثقافية. فلقب سفسطائيsophist كان يطلق على الماهر والحاذق في فنه. وماذا كان الفن سوى بلوغ درجة الاتقان في الأعمال. وهذه الأخيرة نتاج ثقافي في دلالتها وأهميتها. أما الفن الأخطر الذي اشتهرت به السفسطائية، فهو" فن القول". طرحوا خطاباً إزاء سيطرة فلسفة أفلاطون والجمود العقلي الذي سببه عالم المثل. فهو عالم خاص بأفلاطون استطاع صاحبه أن يصادر إرادة الإنسان خلاله مقابل رسم صورة للمجتمع والتاريخ والحقيقة والذاكرة والسياسة. فكيف سيرفضه الفرد اليوناني المهموم بالتعبير عن نفسه؟. . كان السفسطائيون واعين بتلك الحيلة الأفلاطونية وأنه لم يكف عن آلية الهيمنة على الواقع.
لم يكن كلام السفسطائي سوى أساليب بلاغية غير معهودة ثقافياً. كثيراً ما لجأ إليها لخلخلة نمط التفكير الأفلاطوني. فهذا النمط يضع العقل بين رحى طرفين متنافرين، المثال والواقع كما نوهنا. لكنه يحسم الصراع لصالح المثال، لا لشيء إنما لأجل إعادة التمكن من الواقع وسلب قدرات الاختلاف. إنه انهاء لعمليات الجدل في صورة طرف متفرد، قطب وحيد. ونفهم ذلك حين نعرف أن عالم المثل له باب أفلاطوني واحد، أفلاطون نفسه هو من يمسك به. وهو من يمتلك فتحه وكشف أسراره. في مقابل زيف جميع الأشياء، أي كذب الواقع. بل الأخير على ما يصفه عالم من الأشباح غير الحقيقية.
إذن المشروعية في تكذيب الواقع مشروعية ميتافيزيقية هذه المرة. وهي الحكم عليه بكونه غير حقيقي. لأنه لم يكن أصلياً إنما يحاكي المثال. وخرج الواقع مشوهاً، كذوباً ومزيفاً كما أراد أفلاطون. واُعلّنت سيادة المثال على كافة الموجودات الأخرى.
كان السفسطائيون مناوئين لهذه السيادة، وبخاصة كون فلسفة أفلاطون أصبحت مذهباً للمجتمع وكان صاحبها فيلسوفاً للدولة. ألم يطرح كافة القضايا من الذاكرة إلى الجمهورية السياسية والهندسة الاجتماعية؟ وكأنَّه يقرر في محاوراته: كيف يعيش اليونانيون وكيف يفكرون وإلى أين تذهب آمالهم؟ والأهم كما أشرنا أن افلاطون فرض نمطاً من الحقيقة على وعى الأفراد. ويبدو من قوة فلسفة أفلاطون أنها وسمت كل فكر سفسطائي بالمغالطة والمماحكة. ونظراً لكون اللغة بمثابة الصيغ التي يتطابق معناها مع الحقيقة. فإن أي تلاعب بتلك الصيغ معناه تلاعب بقوة الحقائق.
هذا وقد طرد أفلاطون السفسطائيين من "دلالة اللغة" المتحدثة عن الحقيقة كما يراها. معتبراً إياهم مجادلين بغير صدق لا مجرد حقيقة فقط. هم مزيفون من حيث تزييف اليقين الأفلاطوني السابق. ونظرية الحقيقة بهذا المعنى ظلت تحاذر السفسطائيين عبر تاريخ المعجم اللاتيني ومعاجم اللغات الأوروبية. فما زالت القضية -من وجهة نظر أفلاطون- قضية امتلاك اللغة عن بكرة أبيها. لأنه حين عرف أن العلاقة بين الاسم والمسمى علاقة غير اصطلاحية أدرك ضرورة الهيمنة على نظام الدلالة في المجتمع. وبذلك تكون مشروعية الصدق والحقيقة هي مشروعية تكذيب الآخرين وجعلهم نموذجاً للجدال غير الهادف.
ليس أقرب إلى فكرة أفلاطون تلك من احتفاظ اللغة الانجليزية واللغات الأوروبية بدلالة التضليل لمصطلح السفسطائية. فالسفسطة sophism تعني قياساً فاسداً. بالمثل تعني مغالطة لا طائل من ورائها سوى المراوغة. وتدل على التكلف في طرح الآراء. أما القائم بذلك العمل فشخص متكلف أو محنكsophisticated. ومع أنه رفيع الثقافة ومطلع إلا أن الوصمة الأفلاطونية مازالت موجودة في جذور اللغة، فهو الشخص الذي يحرف المعاني والذي يُعقِّد الأشياء مضيعاً بساطتها وتلقائيتها.
لنرَ ماذا قال تاريخ الفلسفة حتى نعرف أبعاد الفكرة. أشار مبدئياً إلى السفسطائي بوصفه ذلك الحاذق والمتمتع بمهارات كما لدى الصانع الماهر. ودون قصد سُوقي تشير الـــsophiste إلى ذلك الذي يحترف الحكمة والمهارة (صوفيا). وهو المتمكن من فنه في محاورة الآخرين. بل قال بروتاجوراس– على لسان أفلاطون- السفسطة فن جعل الناس أرفع كعباً مما كانوا عليه، فن تنشئة بشر أرفع.
لكن مع تحول الفلسفة الأفلاطونية إلى مشروع سياسي اقصائي، اعتبرت السفسطائية سُبة ولحقت بها دلالات سُوقية. فأفلاطون كان يريد إزاحة من يفكر بخلاف مذهبه الفلسفي جانباً. ليست المشكلة في السفسطائية، لكنها في خطاب شمولي وحيد الاتجاه. يؤكد الفرنسي أندريه لالاند أنه اعتباراً من عصر أفلاطون وبالأخص أرسطو، صارت تستعمل الكلمة بمعنى ذميم واضح، فالسوفسطائي هو ذلك الذي يستعمل مغالطات على نحو عادي. ونحن نعرف أنَّ أرسطو أكمل مسيرة أفلاطون إن لم تكن في الجانب الفلسفي فعلى الصعيد السياسي.
المهم قد تكون مشروعية الكذب بإيعاز من الثقافة السائدة. وهو ليس كذلك بالمعنى المعروف تحديداً. فالكذب الفلسفي سواء أكان سفسطائياً أو أفلاطونياً إنما يمثل صراعاً حول امتلاك المجال العام. ومن هنا أخذ سقراط أهميته ولقى حتفه مسموماً أيضاً. كانت تهمته إفساد عقول الشباب!! كيف يمكنه تبوؤ مكانة المعلم ورجل الفضيلة ومن أين له بإفساد العقول؟! تكمن القضية برمتها في مشروعية الكلام السقراطي قياساً إلى المعتقدات العامة.
فرغم اعتماد سقراط على طريقة "التهكم والتوليد" في الحوار، إلا أنَّه وقع ضحية المجال العام. هذا المجال الذي أغرقه (أفلاطون) بسلطة المُحرّم فلسفياً. لقد أوجد سلطة متربصة خارج الأفراد، حيث تجسدت المشروعية في مفاهيم تبدو في الظاهر مملوكة للمجتمع. وهي كذلك من حيث تعيش في كنف الوعي الجمعي وتدافع عن نفسها بقوته وسيطرته. وقد تهب فجأة كالإعصار في وجه من يحاول المساس بها متهمةً إياه بالخروج عن النموذج الأصلي. بحيث لا يستطيع فيلسوف الاقتراب دون اتهامه بسرقة المشروعية. خاصة وإن تحدث كلاماً لتغيير الرؤى كما فعل سقراط. إذ سيتهم عندئذ بالكذب (والتكذيب) معاً. كذب على الناس، لأنهم مازالوا مقيدين بمثال الحياة العامة (جمهورية أفلاطون) ومازالوا في دائرة التفكير وفقاً للمقدس (الأساطير والآلهة). والتكذيب لكونه يمس معتقدات لا تتزحزح قيد أنملة. وهو حين يعرضها للمناقشة كمن يحاول تكذيب كلام الآخرين ودحض إيمانهم الراسخ.
وهذا بصدد الخطاب الديني موضوع أكثر بروزاً. حين يكذب أصحابه في شؤون الحياة العامة تعللاً بالتحدث باسم مشروعية المعتقد، وأنه في النهاية سيؤدي إلى مصالح عامة لا يجب خسرانها. ويكذّبون غيرهم خوفاً على تلك المصالح وخوفاً على المجتمع من الانحراف.
3. مجال القانون: طبعاً القانون صيغ منضبطة دلالياً للتعبير عن غايات وأهداف ومشتركات المجال العام. أي ضد التلاعب بها واستغلالها والإضرار بشؤونها، مؤسسات أو نصوصاً. القانون لا يعطي مبرراً لأحد للكذب باسمه ولا باسم غيره، إنه معني بتلك المسألة إلى حد العمل الجاد عليها باستمرار. فما أن يخرج الأفراد إلى خارج ذواتهم إلا وهم في حضرة هذا القانون. إذا مارس فرد كذباً بين المجموع، فقد ارتكب فعلين: أحدهما الفعل الذي يقع عليه مباشرة وينسب إليه. أما الفعل الأخر فيقع على دلالة الصيغ العامة للقانون وعلى كيان المجتمع ككل.
الكذب في تلك الحالة مزدوج بانتهاكه لهذه المشروعية الضمنية. أي يأخذ قوته من مشروعية خاصة متجاوزاً المشروعية الجمعية. ولهذا سيبقى أثر الكذب عالقاً في الحياة العامة بأثر القانون وتنبيهه لمراكز الوعي لدى الأفراد. من جهة وجود فرد، بحيثيته أيا كانت، قد انتهك مجاله المشروع. حيث سيقال أن فرداً قد انتهك هذا النطاق العام داخل نطاقه الإقليمي(الفردي). أما الشيء الواضح أن القانون لا يمتلك إلا مشروعيته حصرياً. ولا يسمح لأحدٍ بامتلاكها سواء على نحو خاص أم عام. بالتالي سيقع فعل الكذب تحت طائلة القانون. لأنَّه سيغتصب مشروعية ليست له. والطائلة هي القوة التي توفر له المساءلة والتحري. من ثم سيفتح باباً للأسئلة تلو الأخرى بحثاً عن الفاعل وحدود فعله وردود أفعال المجتمع.
لكن لماذا يتم الكذب في هذا المجال؟ هذا السؤال قد لا يعدُّ دقيقاً، ولاسيما إذا فُهِم كأنَّ هناك كذباً يتماشى مع القانون. لهذا يعدل إلى الصيغة التالية: لماذا يتم تمرير الكذب؟
قد يكون التمرير بواسطة تأويل معين للقانون، وهذا يعني وجود أوجه متنوعة لفهم الصيغ القانونية. ولا يتم ذلك اعتباطاً، إنما وفقاً لحيثيات القانون ذاته. فإقامة الحجج ومناقشة الآراء والقرارات وكشف التضمينات أمور ملازمة لتلك العلاقة. والتأويل "قوة فهم " لا مجرد تلقي سلبي لموضوع عام. هي قوة تنقل المؤول إلى استعمال القانون لصالحه. يكاد المؤول يقول: إذا كان القانون سيضعني تحت طائلته، فأنا سأجد مخرجاً قانونياً منه. أي عن طريق صيغ القانون، سأهرب من القانون. المشروعية المستثمرة وراء عمله مشروعية قائمة بموجب تلك الحيلة التأويلية.
بالفعل هي حيلة تأويلية صعبة التوصيف. لكن هل القانون يسمح بذلك رغم كونه لا يتيح تلك الإمكانية أم أنه صِيغ متفاوتة تمكننا من فهم إمكانياته؟ أتوجد ثغرات في صياغة القوانين وبالتالي تُرحّل المشكلة كلها إلى اللغة؟ ربما تستعمل عبارات نفعية في هذا السياق من قبيل "التكييف القانوني"، "روح القانون"، "غموض الصيغ القانونية"، "صمت القانون". وهي عبارات تقال حين يتماشى القانون مع المصالح. فإذا عُرفت الأخيرة، يبحث صاحبها عن صيغة ملائمة للتوافق مع القوانين.
وقد يتم تمرير الكذب عن طريق تغييب القانون. لكن هذا يحتاج قوةً تعادل وضع القانون وتنتهكه. وإذا حدث ذلك، فعادةً يكون القانون هامشياً في الحياة السياسية والاجتماعية. ولا ينتظَّر سوى أن يصبح أكثر تهميشاً. فسيادة القانون غير موجودة من الأساس إلا بشكل تجزيئي. وأية مقايسة عليها لن تكون إلا في جانب "مُنتهيك" القانون. والتغييب قد يأخذ معنى الحجب، أي لا يطبق في حالات قادرة على الاطاحة به.
لذلك تُقاس ديمقراطية المجتمعات بمدى فعالية القانون ونفاذ سيادته لا تعطيلهما. ونحن نعرف كون القانون حقَ من لا حق له مباشرة. أي هو حق المجتمع فينا وخارجنا بالتوازي. وإلى وصل الإنسان إلى مفهوم الحق المعنوي هذا قطعت المجتمعات مراحل من الصراع والمقاومة لكافة صنوف الاستبداد وما زالت. لأنه يجسد مشروعية غير قابلة للاغتصاب ولا للتزييف.
ولو تصورنا العكس كما في بعض المجتمعات شرقا أو غرباً، فإن مشروعية الكذب تطغى على أية سيادة أخرى. حتى غدا الكذب أرشيفاً للحياة اليومية، في الأحاديث والعلاقات والعبارات المتداولة. يقال عنه مجاملة بينما هو مقاتلة المغدور به هو الشعب دائما. يقال عنه تسامح وهو ذبح بغير سكين لمن يخالف وينتقد. يقال عنه خجل بينما يعد فضحاً ضمنياً لبنية التفكير الغالب. يقال عنه مداراة بينما هو تصريح بالمراوغة. يقال عنه قبول بالواقع بينما هو اسهام في تدميره حتى النخاع. لقد تراكم الكذب حتى التهم أمخاخ فاعلي الثقافة، وأسس وجوده المتطابق مع المفاهيم وأنماط الحقائق الاجتماعية، بحيث لا يمكننا فهم أي شيء، أية مسألة، دون أخذه احتياطياً دلالياً كحال احتياطي النفط. يجري الكذب هنا كشيء لصيق باستعمال اللغة، في الخطاب السياسي والخطاب الديني و الخطاب الاجتماعي.
تدريجياً باتت مشروعية الكذب تزاحم أية مشروعية أخرى، مشروعيات القانون والحقائق والمؤسسات والأفكار والمعتقدات. ببساطة لأن تلك الأشياء لا توجد من غيره، إنه يمنحها زخمها وآلية وجودها بطريقة من الطرق. فالقانون قانون لكونه غير كاذب، والمؤسسات مؤسسات لكونها غير مراوغة... وهكذا. وإن انكشف الإنسان عارياً داخل مجتمعه الحديث كما ينكشف سلفه الأول متوحشاً في الغابة، فما الجديد؟، ما معنى هذا التراكم؟، كيف ينتقل من عصر إلى آخر بكل سهولة؟! أتصور أن هذا السؤال لهو سؤال المجتمع والإنسان نفسه، استفهام كيانه وماهيته المترحلة عبر التاريخ؟
4. مجال الدين: هل يمنح الدين مبرراً للكذب؟ الإجابة بالنفي على وجه السرعة. إذن السؤال المنطقي: كيف نفهم مشروعية الكذب باسمه؟ القضية- لو نلاحظ- في كونه يعطي أصحابه قوة قادرة على التجاوز. وهذا من زاوية التفكير والإرادة باسمه في عالم الإنسان. فالدين تاريخياً يتحول إلى مشروعية اعتقاد لا يكف عن التطبيق. وهو إيمان ينزع إلى إرادة عملية خارج ذاته، أليس الإيمان عقيدة يصدقها العمل؟ بلى ... ولكننا سنلاحظ أن أصحاب الخطاب الديني لا يستطيعون بلوغاً لهذا التصديق ذاتياً. أي بالاعتماد على قدراتهم الذاتية يصعب ترجمة الإرادة إلى واقع، لا من طريق الدين ولا من طريق خاصتهم. بل فهموا العجز عن ذلك نتيجة غياب إرادة جمعية تتبنى المقولات والأفكار التي تخص الناس.
إذن هم لا ينجزون ذلك دون وجود مدى للتأثير داخل المجتمع. وهذا لا يتأتى بفضل وجودهم فقط إنما استناداً إلى رابطة الإيمان الديني بين كل أصحابه. هناك رغبة للتقارب عن بعد بين" الإيمانات" الفردية (جمع إيمان). التقارب الذي يضمن التصديق المتبادل بين الأفراد. وبالقطع سيتفاعل رجوعاً إلى مرجعية قوة عليا، مرجعية مقدسة. يفترضون فيها -عن طريق نصوص الدين- التدخل غير المباشر(والمباشر) في الحياة. وإن جاءت الوقائع مجانبة لهذا التصور، سيكون التأويل (إذ جعلها بجوار المؤمن) هو نفسه الذي يبرر تحاشيها إياه. أي أن المبرر المتخذ لحال ما يقف مع إمكانية الحال ونقيضها. فالاعتقاد بوقوف الإرادة العليا بجوار المؤمن هو ذاته الذي يبرر تخليها عنه أحياناً.
ولا يعبر ذلك عن شيء بقدر ما يعبر عن تطابق دائرة الإيمان مع دائرة التفكير. فليس ثمة تناقض فيها. إن ما يظهر متعارضاً في جانب ما سرعان ما يوافقه التأويل مع بعضه البعض بدلالة المقدس ووجود القوة العليا (الإرادة الإلهية) خلال جانب آخر. فالقوة العليا هي التي ترفع التناقض ولا تلغيه. الإيمان يحمل صيغة "مع وضد" داخل نطاق الإرادة الإلهية. تلك التي تفسر- على سبيل المثال- لماذا هناك شيء ما (كالخير) لصالح الإنسان ولماذا هناك شيء مغاير (الشرور) ضد هذا الإنسان في الوقت ذاته. ومجال التفسير هو أعمال الإنسان، توافقاً معها وتقصيراً في فهمها أيضاً. بمعنى أن الإنسان، حياته، وأنظمته المتعددة، موضوعات متحققة بفضل الإرادة العليا.
بهذا الوضع يحاول الخطاب الديني العمل على تأكيد اليقين الجمعي باسم اليقين الفردي. لأنَّ الاثنين يقعان في دائرة "مع وضد". هذا التناقض الإيماني أوسع من حركة المجتمع بما هو كذلك، وأبعد من تاريخه. إنه يوفر شعوراً- مع الطابع الشفاهي للخطاب- بالبعد والقرب، بالاختلاف والتماثل معاً. وتلك مسائل يصعب حلها، أي يستحيل إنهاء تناقضها، وإلا قد ينحل الإنسان معها بالمرة. والأحرى سيصبح الإنسان عرضة للتحلل نفسياً في آخرة دنيوية عاجلة. وتظل حركة "مع وضد" تشكل كل تصرفات المؤمن طاويةً التجارب والأفراد المحيطين به. ولا يوجد غير احتمالين لحلحلة التناقض. الاحتمال الأول هو: التوحد بالإرادة العليا ولا يجرى ذلك عادة إلا باتباع خطى النص أو تطبيق الحكم الإلهي أو التصوف. ومن هنا يظل الخطاب الديني مطالباً بحاكمية إلهية ليس إمامه بلوغها إلا بالدنياً. وهذا هو قمة اليقين الفردي والجمعي.
الاحتمال الثاني هو: البحث عن اليقين الجمعي حيث يحتوي ضمناً "الإيمانات" الفردية. في تلك الحالة ليس المهم ما إذا كانت المشروعية لأي عمل صحيحةً أم لا؟ لكن الأهم ايجاد سقف عام يجمعها ويصدق على الجزئيات. حيث يغطي أي تباين بالداخل. وما سيصح على التصور سيصح بالمثل على الواقع والحياة. تلك الخطوة ستعطى دفعة لانتهاك حدود اليقين نفسه والإغارة على مصداقيته بسبب أنه ليس كذلك وأنه لن يختفي" الضد". أي ستكون ثمة حالات ترفض هذا السقف العام. إن اليقين إذا كان موجوداً بالإيمان، فكيف يتحقق بالفعل؟! أي كيف يتحول إلى نظام سياسي وقيمي وثقافي. الكيفية هنا تسلب أية كيفية أخرى من المواقف وتستغل بعضها لفرض نمط من وجودها الخاص.
سيكون الأمر بتلك الطريقة ظلاً موفوراً للحقيقة الناتجة عن الإيمان. هو ظل وجودها خالصة وارتباطه بالتعبير عنها لا الحقيقة في ذاتها. إذا أردنا عبارة واضحة فالوفرة وفرة امتلاك الحقيقة لا الحقيقة بشحمها ولحمها. فمن منا لا يرى امتلاكاً لحقيقة الاعتقاد؟ بل من منا لا يشعر بسريانه كما تسري الطاقة بأنحاء جسده؟ بل بالنسبة لمجال الدين يراه المؤمنون جارياً (الاعتقاد) عبر جميع الأفكار والأفعال. وهذا ما يجعل منظري الخطاب الديني على ثقة مفرطة بالمستقبل. كما جاء بالقرآن إن غداً لناظره قريب. وهو غداً وإن استمر الإنسان منتظره طوال الحياة. لأنَّ غداً لا ينقطع عن الوجود مثلما لا تنقطع حقيقةُ الإيمان من وفرةٍ قادمة لا محالة.
إذن هناك وفرة مفترضة للحقيقة على صعيدي التصديق والتحقق. بمعنى ها هي ستأتي، وها نحن سنحصل عليها. وستكون واردةً مع الكلمات والعبارات بمجرد التلقي. لكن أين هي وكيف ستكون.. ؟، تلك أشياء غير محددة. إن" التنغيم واللحن" أثناء الخطابة الدينية أمران يتحينان وفرة المعاني. هما آليتان صوتيتان لإشباع المستمع بالفيض اللغوي الهادر. كأن المدلولات ستحضر حقاً لا مجازاً، فعلاً لا سماعاً. وليس من شك لدى صائغ الخطاب في إبلاغ المضمون الوفير للكلمات. فهو يتعامل مع الأصوات كمادة طبيعية معرفية. إن مهمته تشبه عملية خلق للمعاني بطقس الإلقاء كما في الأساطير القديمة. فيكون الصوت الجهور والنبرات المشددة والترديد المتواصل أشياء مفهومة بالمغزى السابق. فإذا أعملنا عقلنا نقدياً، سنعرف كم كان الواقع مغايراً لما يقال. نظراً للقفز على مقتضى الحال وهذه هي بذور الكهانة الدينية والسياسية بشتى صورها.
يعنى هذا "اغراق السياق" بين الناس بمعانٍ فضفاضة. ليست معبرة إلا داخل عمليات النطق. هل ذلك نوع من الكذب؟ أليس تناقض الكلام مع الفعل نأياً عن الحقيقة؟ الإجابة بحكم تلك المعاني لن تكون إثباتاً وحسب، إنما ستحمل الفرد على تكرار الحالة. هذا ما اتضح في خطابات الجماعات الدينية بعد الربيع العربي. ظل اغراق السياق في ميادين التظاهر هو السمة الغالبة على التأثير. وباتت المعايير التي نعرف بها الصحة من الخطأ غير واضحة. كما لا تستند لغة الخطاب إلى شيء سوى زخم الحقائق.
من زاويةٍ أخرى، هناك قوة استباق تقفز على الواقع. حين يمتلك الخطاب الديني وفرة ويقيناً، فليس للواقع أي وزن. بل ذلك سبب كاف لاجتياح أي واقع مها يكن. وتلك القوة محصنة ذاتياً ضد المساءلة أو التوقيف. فإمكانيتها – كما يتصور الخطاب- أكبر من أية إمكانية غيرها. بالتالي يعدُّ الواقع مجرد طريق لا أكثر. وهذا يحول القوة الرمزية إلى عنف، لا يرى أمامه ولا يميز المواقف. وقد يقع في محاذير التعدي على الحقوق. يُسمى في بعض الأحيان الدفاع عن الحق وفي أحيان أخرى إبلاغ صحيح الدين. لكنه في الواقع رسم لخريطة الصراع وفقاً لما نخبئه من مآرب ومصالح. فإذا بنا نخرجها في الوقت المناسب بعد تمكننا من مواقعنا. ولسان الحال يردد كما قال الشاعر: ما نيل المطالبِ بالتمني:: ولكن تُؤخذ الدُّنيا غِلاباً.
أما منطق الخطاب الديني، فيقول لا مناص من الاستحواذ على الواقع. السيطرة عليه قبل أنْ يلتهمه الآخرون. فالحياة غالب ومغلوب. فإذا كان المؤمنون هم أولى الناس بها، فإنِّ ضمان الإيمان كفيل بإتمام المهمة. المنطق بها التفكير يمسح أي خطأ بمجرد خطوةٍ إلى الأمام. هو بلاشك يُغطى بكم من القفزات تجاه الأهداف. حتى إذا سُئل الفاعل لماذا فعلت ذلك؟ سيقول بسبب امتلاكي للحقيقة وهذا سبب. أما السبب الآخر، فهو أنني أحق ولست أولى فقط من غيري. والدليل أنني موعود بهذا اليقين. فالأديان في أساسها وعود بالغلبة للمؤمنين تجاه المنكرين له.
حتى أن الكلمات تتمتع بواقع ذاتي. فهي تتشبث به كما لو كانت حصراً له. هكذا تغدو المعاني أفعالاً لا شيء غيرها. بينما المدلولات -كما نوهنا- فائضة إلى درجة الطوفان عن الدوال. القضية أن هذا الاستباق لا يجعل الخطاب محددا في إمكانيته. أهو يسير بخطوات وئيدة أم أنه سيبدل أهدافه كلما سنحت الفرصة؟! الخروج من تلك الأرجوحة لا يتم إلا بالعيش في الحياة. العيش بحسب تجربة واقعية تحول الاعتقاد إلى مجال مفتوحٍ للاختلاف. وهذا نادراً ما يحدث. بذات الوقت يمنح الخطاب أفقاً للتفلت من مشروعية المجتمع بل لا يستند إلى أية مشروعية. على أساس كون المشروعية الأهم من الله فكيف يمكننا انتظار مشروعية غيره. يتناسى الخطاب بهذا أنه سيعبر عن مشروعية إنسانية حتى لو آمن بمشروعية عليا. الفكرة أنه لم يستطع الوعي بتلك النقطة. ولو وعاها لاستطاع فهم تجارب الآخرين ولتمكن من التدرج في الحياة بحسب المقاصد.
وهذا الاستباق يُوقِع صاحبة في وهم امتلاك المصير. أي سيأتي بالأمور من نهاياتها القصوى. فهو بدل السير مع الزمن يضع نفسه لاشعورياً عند نهايته. يقول: ما بالنا بالخطوات تلو الخطوات بطيئة ولا تتفق وضرورة" التمكين" المنتظر؟ هذا المصطلح الذي اشتهرت به الجماعات الإسلامية ولا سيما الاخوان المسلمون. كأنَّ السلطة تحديداً هي الوعد الإلهي لهم، فكان نهمهم التاريخي للحكم بلا حدود. صحيح ليس للتمكين زمن معين، غير أنَّه يحمل مصيراً ما. والمصير يعبر عن نهاية معروفة من جانب أصحاب التمكين بالنسبة إلى أطراف النظام السياسي. فإذا كان أحدها سيُمكن، إذن سيكون مصير الآخرين التهميش (عدم التمكين). وتلك النتيجة ستخرج من الغلبة التي تحكم قواعد اللعب.
ينتقل الاستباق المشار إليه إلى امتلاك الحياة. فالخطاب الديني – لا الدين- يتحدث بنبرة ابتلاع دلالات الحياة، بشراً وحركةً ونظاماً في جميع المجالات. أيضاً تحت مبرر أنهم الأجدر- دون فهم الحياة- بالسيادة عليها. ستكون حركتهم بطريقة المزاحمة حتى فيما لا يمتلكون قدرات فيه. مع أن نظرة بسيطة تعرفنا أن هناك نتاجاً علميا وفكريا وحضارياً ينبغي تجاوزه كي يستحق المطالبون مكانتهم. من ثم كانت معاني الخطاب ضحمة بينما فحواها ضئيل التأثير. من هنا نشأت أفكار التكفير والاقصاء في هذا الخطاب، فالحياة حين لا تخضع لهم يذهبون إلى ملاحقتهم بالتكفير. أمر كهذا أدى بالخطاب إلى تهويم الآخر بالمعنى الشمولي. فهو في مرمى القناص (صاحب الخطاب). وإذا سنحت الفرصة لن يفلت من الاصابة المباشرة بمعاني السيطرة. ويأتي التهويم من كون الخطاب إذ يتحدث عن امتلاك الحياة يجد نفسه محصوراً في زاوية ضيقة منها. لأن الحياة الإنسانية لها قوانينها الصارمة التي لا تسير اعتباطاً. استطاعت الحضارات فهمها، فأبدعت وانتجت، بينما القول بالهيمنة عليها لم يبلغ إلاّ مسامع أصحابه فقط.
سيتوجه الكلامُ إلى أهداف غائمة بقدر العجز عن فهم قوانين الحياة وابداع عالم يعبر عنها ويتفق مع مرجعية الخطاب. لا يمكن التمييز في تلك الحالة بين الخداع والحقيقة إذا أردنا تعبيراً واضحاً عن المقصود. معاني الكلام ستكون قطعاً حاسماً تجاه العالم، بل يمكن القطع بأشياء معينة بناء عليه ولكن لم تفهم آلياته بعد. وأحيانا يفسر البعضُ نصوص الدين خطأ هنا مثل:" ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين". القرآن الكريم يخاطب المؤمنين، إذن ما هو الإيمان، إنه التدفق الداخلي للشعور بالوجود الإلهي وكتبه ورسله والآخرة وأقداره خيرها وشرها. العلو بهذا ليس له معيار إلا صاحبه، فلم يتم اختراع ترمومتر لقياس الإيمان. والعلو يأتي المؤمن من إخلاصه لربه ومن التزامه بذلك، بقدر اتصاله بمسببات العلو. التدفق الشعوري ما لم يسنده عمل يتحول إلى مجرد رصيدٍ نفسي. كما أن الآية تقول" إنْ كنتم مؤمنين"، وهذا لا يقطع بكون الموصوفين بالإيمان كذلك حتمياً. فـــحرف "إن" السابق على كنتم يعطي إحساساً بعدم تملك الإيمان كما نتملك الأشياء المادية. ويفتح باباً للاستزادة والتيقن ولا يمنحه اعتماداً فورياً.
يترتب على ذلك إنّ كان كلام الآية القرآنية تطييباً لنفوس المؤمنين، فهو دافع للتمسك بالإيمان. التمسك به بوصفه معياراً داخلياً إذا احتكمنا إلى واقع متأرجح وإذا كان مصدراً للحزن والوهن. إذن لفتة القرآن الكريم الطريفة هي: "عدم قدرة امتلاك الحياة بقدر ما نمتلك إيماناً". ويصبح الأخير تعويضاً، بل دافعاً للمحاولة تلو المحاولة. وهذا يختلف عن الزعم بأعلويتنا في الحياة لكوننا مؤمنين فحسب. والآية جاءت قصداً بطرح الحزن والوهن في مقابل بقاء الإنسان قوياً بإيمانه. لا تتحتم عليه نتيجة إلا ضمن واقع معيش يؤكده، ويجعل حرف "إن" قابلاً للإثبات. فليس شرطاً إذا كنت مؤمناً أن تعلو في الحياة وعليها. في الوقت نفسه، يمكن لمن لا يمتلك رصيد إيمانك العلو في الحياة. خلال الوضع الأول، أن القرآن استخدم العلو في الإيمان مقابلاً للحزن والوهم. بالتالي فإن مقابلهما سيكونان الفرح والقوة. والكلمتان تأتيان ضمن القرآن بمعان سلبية، فذكر القرآن أن الله لا يحب الفرحين، ولا تمشي أيها الإنسان في الأرض مرحاً. والقوة مرتبطة بالطغيان والجبروت وادعاء الألوهية، سواء بالنسبة لفرعون أم قارون أم النمرود.
لفظ العلو يأتي مع الجانب الإيماني أو الإحساس بالجليل- المقدس. أما الحياة فيرد بشأنها القوة والغلبة. والخلط بين الاثنين تبعاً لمعيار أحدهما ولا سيما الإيمان يدفع بالخطاب إلى التحدث عما لا يعلم. يتحدث بلغة من يتيقن أنَّه يعلم بينما هو عكس ذلك. ماذا يُسمى الإيمان حينئذ؟
هناك سمة أخيرة: توقع الخير. فالخطاب الديني يتحدث عن الخير باستمرار طالما مصدر الأشياء هو الله. ولو وجد شر، فيُحمل في غايته الخفية على أنه خير أيضاً. معنى هذا إما وجود الخير فعلاً وإما هناك مسخ للخير حتى يتجسد شراً. المشكلة في أن هذه الرؤية تمثل مبرراً لخيرية الشر إذا جاء من طرف أصحاب الخطاب. فقد يكون هناك عمل عنيف وهو شر. لكن منطقه كالتالي: أن فعل هذا الشر شر مؤقت من أجل جلب خير مستمر. ونظراً لأنَّ هدف كل شر مؤقت الوصول إلى الخير، إذن لا مناص منه بلوغاً إلى الهدف الأسمى. ولهذا نرى القتل والاغتيال حتى باسم الخير، وباسم الخوف على المقدسات من الانحراف الفكري. وإذا سئل الفاعل لم فعلت ذلك؟، سيقول ما فعلته إلا بسبب الخير الذي أحمله للآخرين.
هكذا يتعيّن التوقُع السابق بنقيض الخير لا من طريقه تحديداً. لأن الغاية تخترق أي فعل نوعي ولو كان شرّاً. وهذا سبب آخر يضاف إلى اعتبار الشرور في طريق الخير خيراً أيضاً. بل تعتبر امتحاناً لتحمل الصعاب ولتمحيص معادن الرجال في طريق الهداية منا يردد المتدينون. وهذا معناه أن مشروعية الكلام المخالف للواقع معقودة سلفاً ولا تحتاج إلى فحص ولا إلى تأكيد. لأن جواز مرورها الخاص كامن فيها. فالتوقع يقين مؤكد ذاتياً، مخزونه الشعوري ضامن لوجوده. تماماً كما يصبغ مخزونه التبريري بلونه الممالئ لبقع الشك التي قد تتقرح في تكوينه. إذن لا يوجد كذب بهذا المفهوم. بل الكذب يمسح نفسه أول بأول كمنظف ومطهر ذاتي قوي. وعليه فلا يوجد أدنى خطأ. هناك آلية خاصة تتخطى السلبيات. صحيحة أم غير ذلك، ليست تلك هي القضية، إنما الأمر المهم أنه لن توجد هناك آثار لما يحدث من نتائج.
5. مجال السياسة: السياسة أقرب المجالات إلى الدين، إن لم تكن ترجمة حرفية للمعاني والمضامين الدينية. وسواء شاء أم أبى، سينزلق رجل السياسة وراء النبرة الدينية تأسيساً وتخريجاً لأقواله وأفعاله. لأن السياسة هي إلباس الدين بتكتم وسرية لباس اللادين. كما أن الدين - بخلاف رقعة الإيمان فقط- منقوع حتى الحُشاشة في ماء السياسة. وتصبح كل سياسة على المدى البعيد بمثابة الدين مقلوباً. الإله بالأرض والشعوب تنتظر السماء، الرأس بالأدنى والأقدام بالأعلى، قلب للعالم ولصندوق الاعتقاد. فإذا بفتحته إلى الأسفل وقاعدته إلى الفوق.
تعتبر السياسة من ثم تقديساً مادياَ بلغة الدنيا. هي دنيوية الدين في طابعه الجذري وهنا مساحة اللاحقيقة. وما لم نأخذ هذا التحول أساساً في فهم الكذب، لن ندرك لماذا يتشابه الخطابان الديني والسياسي. يتشابهان من زاوية طرح المعنى بضمان سلطة الغيب السياسي في الثاني والغيب الديني في الأول. وهو نفسه الضمان الذي يبرر قولاً من غير تحقق، أو تسويفاً دون أجل محدد. وإنه الضمان الذي يوقع "هول التخيل" لدى متداولي هذين الخطابين. ويطرح الخطابان بهذه الصيغة انتظاراً لرود الأفعال. كأنّهما يصران على تلقى ردود الأفعال كما يريدان لا كما تحدث.
***
حاوره: ا. مراد غريبي – صحيفة المثقف
23/10/2024م





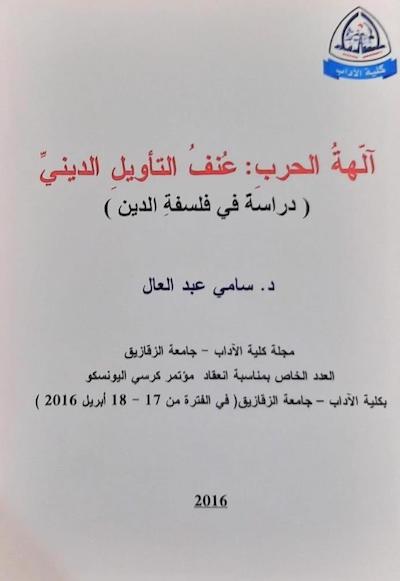



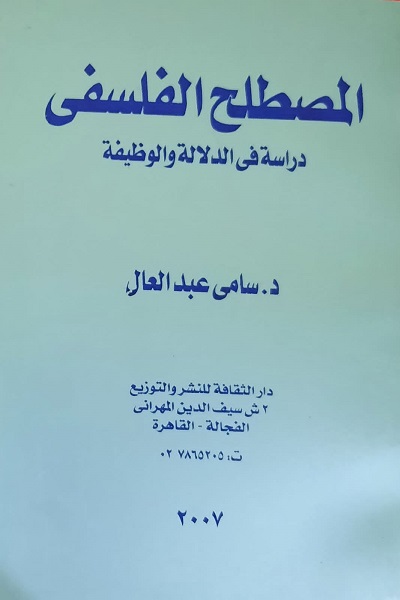





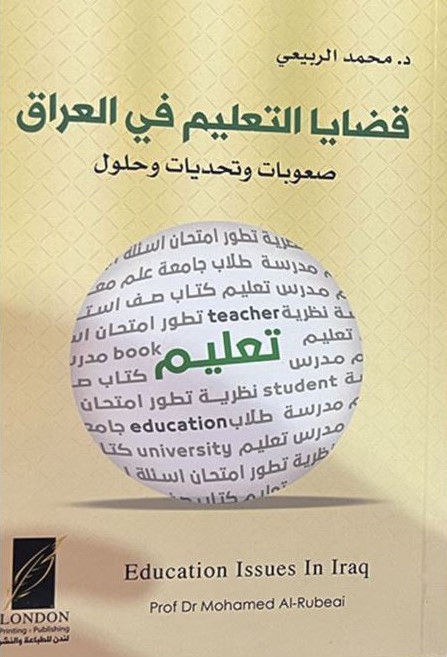

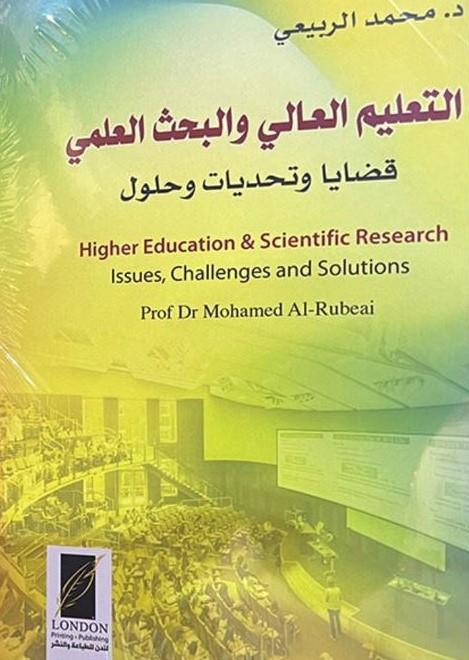






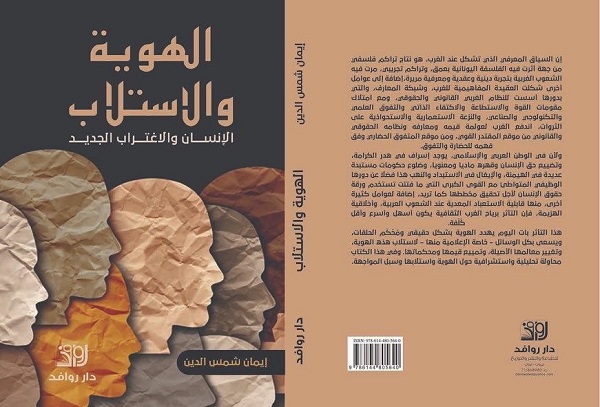
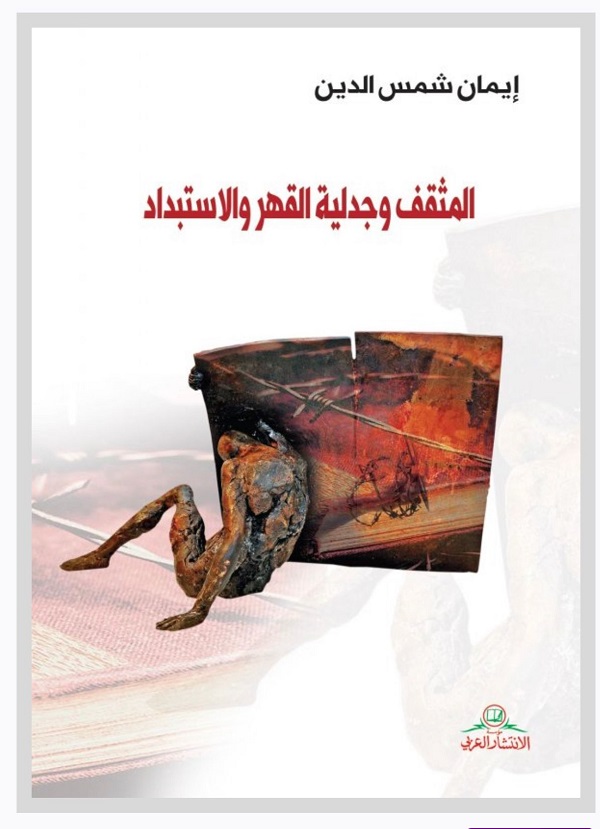
 خاص بالمثقف:
خاص بالمثقف:  المثقف:
المثقف:  خاص: المثقف:
خاص: المثقف: 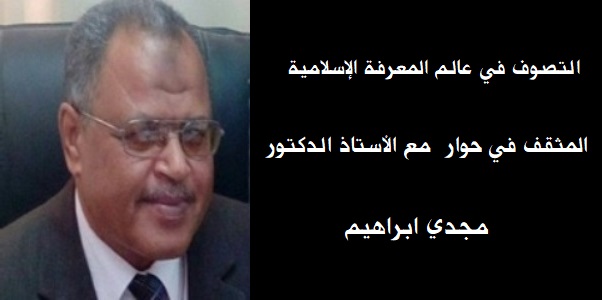

 خاص بالمثقف:
خاص بالمثقف: 




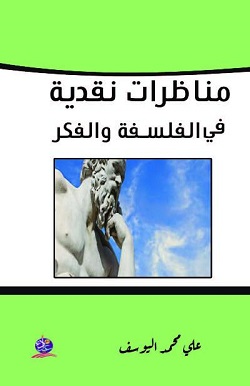 س46: أ. مراد غريبي:
س46: أ. مراد غريبي: 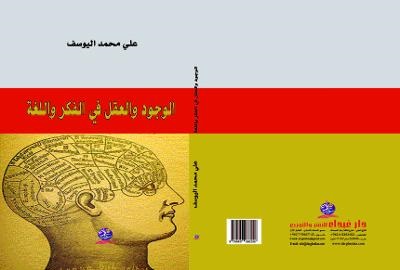



 خاص: المثقف:
خاص: المثقف:  خاص بالمثقف:
خاص بالمثقف: 






