مرايا فكرية
المثقف في حوار خاص مع الدكتور مجدي إبراهيم (4): التصوف ولغة الرمز
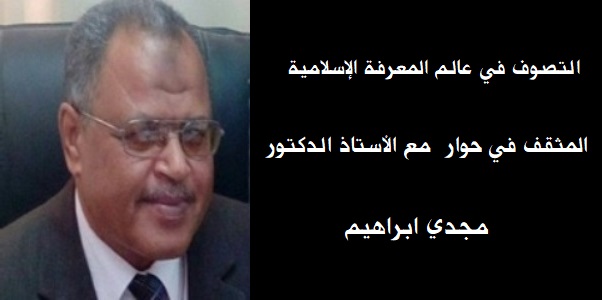
خاص بالمثقف: الحلقة الرابعة من حوار خاص مع أستاذ الفلسفة الإسلامية والتصوف في مصر الدكتور مجدي ابراهيم، ضمن مرايا فكرية، وحوار شامل أجراه معه الأستاذ الباحث مراد غريبي، حول التصوف في عالم المعرفة الإسلامية، فأهلاً وسهلاً بهما في المثقف:
التصوف ولغة الرمز
س12: أ. مراد غريبي: المعجم اللفظي أو التداولي الصوفي مميز بشيفراته وتعقيداته، لماذا الغموض الترميزي والتأويلي.. هل لخصوصية المعارف الروحانية للتصوف أم لغير ذلك؟
ج12: د. مجدي إبراهيم: تقتضي الإجابة على هذا السؤال نظراً عميقاً إلى التراث الصوفي نفسه، بل أستطيع أن أؤكد لك أنّ الصوفية الكبار أنفسهم قد أجابوا عليه إجابة لا تحتاج إلى إعادة تكرار فمثلاً ممّا رواه الكلاباذي (ت380 هـ) أن أحداً من المتكلمين قال لأبي العباس بن عطاء مستفزاً إيِّاه وقاصداً إثارة حفيظته بقوله: "ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظاً أغربتم بها على السامعين، وخرجتم عن اللسان المعتاد، هل هذا إلا طلب للتمويه أو ستر لعِوَار المذهب؟! فأجابه أبو العباس قائلاً:" ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه، لعزَّته علينا، كيلا يشربها غير طائفتنا". تلاحظ هنا أنه إذا كان السؤال مستفزاً فالإجابة رادعة!
ولنلحظ في إجابة أبي العباس بن عطاء كلمتي "الغيرة" و"العزة"؛ فعليهما وحدهما يمكن البرهنة على خصوصية الطريق بمقدار ما يتسنَّى استخلاص السبب الوجيه من وراء الضن بمثل هذه الإشارات ضناً نرجع فيه إلى طبيعة علوم القوم؛ لأنهم تكلموا فيما يقول السَّراج الطوسي في كتاب "اللمع" (في مَوَاجيد القلوب ومواريث الأسرار). ومن المؤكد أن هذه المواجيد القلبية والمواريث السرية مواهبَ لا كسب فيها ولا حيلة تؤتى بالتحصيل وبذل المجهود، ولكنها تؤتى بالصفاء والنقاء وخلوص السريرة مع الله.
بيد أنهم وصفوا علومهم بلغة تعجز عنها إحاطة العبارة العادية وراحوا يستنبطون في ذلك إشارات لطيفة ومعان جليلة واختلفوا بما استنبطوه عن الفقهاء والمحدِّثين والمتكلمين وامتازوا عنهم؛ لأنهم تميزوا بالتجربة الروحية وتذوق علوم الحال، ومن ثم يلزم للذي يريد أن يفهم مسائل المتصوفة ألا يَرْجع فيها إلى الفقهاء أو المحدِّثين أو المتكلمين، وإنما يرجع إلى عارف ممارس لهذه الأحوال مُسْتَبْحث عن علومها ودقائقها؛ لكأنما الإشارة الصوفية قائمة في الأساس على "الحال"، ومؤسسة عليه. والحال يُذَاق ذوقاً ولا يُكيف بلفظ ولا بحرف ولا بلغة. قد تعطي اللغة كما يعطي اللفظ والحرف العبارة العادية، فيجيء المفهوم من ورائها متاحاً لكل قارئ ولأي قارئ؛ لكن عبارة الوجدان يعطيها "الحال"؛ لأنها فيما قال الطوسي (مواجيد قلوب ومواريث أسرار)، فهى من ثم إشارة من بطن التجربة ومن ذوق المعاناة فيها.
ومن هنا صار ما يعطيه "الحال" إشارةً. وصارت كتابة الصوفي أو أقواله إنْ هى إلا "حالات"؛ حالات قد لا ينتظم فيها النسق العقلي ولا تضبطها قوانينه، وهى ليست ممّا يخضع بالمرة لقوانين العقل وحسابات المنطق، ولذلك فهى تقصر وتنضغط بمقدار ما تتفلت من تلك القوانين المنطقية. وأستطيع أن أقول؛ إنها لكذلك تُخفى وتنغلق أمام العقول التي انطمست فيها بصيرة الإدراك الذوقي أو عَقَمَتْ؛ لا لشيء إلا لأنها حالات ليست بحاجة إلى النسق المنطقي الصارم الذي لا يعرف معاناة الشعور، ولا مواجيد القلوب، ولا مواريث الأسرار في عالم التجريب.
الصوفي يصدر عن تجربته فيما يقول أو يكتب، ولا يصدر عن كدِّ الأذهان أو عنت العقول. أقول؛ إذا نحن لاحظنا إجابة ابن عطاء عن السؤال الذي طرحه ذلك المتكلم في استخفاف أو استفزاز، ووضعنا في اعتبارنا عزة الطريق ووعورة السير فيه، أمكننا أن نفهم معنى حَجْبَهُ عن الأغيار، ونقدر بعد الفهم معنى "الغيرة" عليه من أن تناله أَفْهَام القاصرين.
والقاصرون في الفهم سيان في إنكارهم مهما اختلفت الفِرَقْ التي تواردوا عليها وانتسبوا إليها، فليس من منصف فيهم يحسن الظن إزاء (علم الإشارة الصوفية)؛ يقبل بواديها فيرجع إلى نفسه فيحكم بقصور فهمه عنها، أو ترجع إشارة المشير فيما عَسَاهُ يشير إلى سوء الظن بقائلها فينسبه السامع كالعادة إلى الهذيان، ومن أجل ذلك؛ صَدَقَ الكلاباذي لمَّا أن قال:"وهذا أَسْلَم له من رَدّ حق وإنكاره".
ولو أن أحدهم فهم الإشارة وأرتد بها إلى معارف القوم وعلومهم، التي هى كما يقول السراج الطوسي ليست لها نهاية، لأنصف من نفسه فحكم بقصور فهمه عنها وبقلة خبرته أو عدمها في التعامل مع إشاراتهم ومعارفهم، ولعَفى الصوفية، من ثمَّ، من سترها تحت غشاوة الرمز المألوف لديهم أو حُجُب الغموض المتعمد؛ وذلك لأنها في المطلق (أي مثل هذه العلوم والمعارف الصوفية ذات الأذواق والمواجيد العالية) ليست في مقرراتهم سوى إشارات وبوادٍ وخواطر وعطايا وهبات يغرفها أهلها غرفاً من بحر العطاء، وسائر العلوم لها حَدِّ محدود، وجميع العلوم تؤدي إلى التصوف. هكذا قال الكلاباذي صاحب كتاب التعرف ومن حذى حذوه من أهل التجارب الكبرى.
إنما أقوالهم في أحوالهم أسرى؛ فكل إشارة تحتها حكم الحال وإنها لتغمض لغموض الحال وخفائه، وليس لهم حيلة في تحويله من حال إلى حال؛ كما قال قائلهم وهو ينشد:
إذا أهْـــــــلُ العِـــــبَارة سـَـــــائلـوُنَا
أجَبْــنَــــاهم بأعْـلام الإشَـــــــــارَة
*
نُشِــيُر بها فَنَـجْعَلها غُمُــــــوضَاً
تُقَـــــصِّر عَنـْــــــهُ تَرْجَمَةُ العِبَارَة
*
وَنَشْــــــــهَدُهَا وَتَشْــــــهَدُنَا سُرُوَرَاً
لهُ في كلِ جَــــــارِحَة إشَـــــــارَة
تَرى الأقْـوَالَ في الأحْـوَال أسْرَىَ كأسْــرٍ العَارفِينَ ذَوْي الخِسَـارة
وَجَبَ إذن من هنا: أن تكون "الغيرة" لعزة الطريق لها ما يبررها في موقف الصوفية من الضَّن بعلومهم عن أن تُشَاع في غير أهلها بين مَنْ يَفهم وَمَنْ لا يَفْهم، ولعلَّ الباعث الأهم في ممارسة ذلك الموقف واتخاذه على هذا النحو تأكيداً لإجابة أبي العباس بن عطاء السالفة، هو باعث الغيرة على الكيان الآدمي من أن يكون عُرْضة للسير كما السوائم كما تسير السائمة مع القطيع، عُرْضَة للعبودية لغير الله ممّا عَسَاهُ يصيبه من لوثة الأغيار.
الغيرة على كيانك كله: على وعيك وعلى إدراكك، وعلى عقلك، وعلى تفكيرك، وعلى ذوْقك، وعلى شعورك، من أن يصيبه عَطب المفسدين، لاسيما فيما لو كانت بضاعة المفسدين تلك، فضلاً عن عطبها وفسادها، هى من الكساد والفقر وضعف التهذيب بحيث تُرجِع من فورك أصحابها إلى رذائل يتَّصفُ بها الخارجون حتى عن معنى الإنسانية، الساقطون عن القيم في أبسط معطياتها؛ فهؤلاء الذين يتمنَّوْنَ على الدوام أن يفسدوا وأن يشيع في الناس الفساد ليفسد من ثمَّ غيرهم، وأن يفسد بالضرورة غيرهم لفسادهم، هم لا إلى الإنسانية أقرب بمقدار قربهم في الواقع إلى العدميَّة والموات!
ولمَّا كانت أهمية الوازع في اتخاذ هذا الموقف ترتدُ عندنا إلى الغيرة على الكيان الآدمي كُله من أن تلوِّثه أذواق المفسدين، هذا إنْ صح أن يكون للمفسدين أذواق!، صارت هذه الغيرة هى غيرة على" الوعي الذاتي"، أو إنْ شئت قلت: "الوعي الصوفي"؛ كذلك من أسباب التلويث وعوامل التكْدير.
فإنّ الذي يُعطي الوعي حقَّه من الإدراك لهو هو الذي يُعطي لنفسه احترامها، والذي يتنازل عن وعيه يتنازل في الوقت عينه عن احترامه لنفسه؛ إنْ لم يكن يتنازل عن ذاته في المطلق (بعد التطهير) بكل ما فيها من أعلى المدارك وأسمى الصفات. فقد تصطدم بالوعي لديك مع مَنْ لا يعي فتكون في الغالب كارثة، إذْ ليس كل وعي من المطلوب إذاعته ونشره ولا كل وعي يَصحُ تقديمه لمن لا يعرف للوعي قيمة ولا قانوناً، لكنما الوعي الذي يُذَاع ويُنشر ويصحُّ، من ثمّ، تقديمه، هو الوعي فيما يخدم المآرب الرَّبانيَّة العليا لمن يستحقها، ولمن يطلبها، ولمن هو جديرٌ، على استحقاق، بمثل هذه الخدمة الواعية، وبمثل هذا التقديم المأهول، ثم هو، من بَعْدُ، لا يُحجِّر على عقول البشر فيما يريدون من عقولهم أنْ تصيبه على ديْدَن الإدراك فيما لو كانوا هم من أهله وذويه.
س13: أ. مراد غريبي: التصوف متوزِّع على طول خريطة الاجتماع الثقافي الإسلامي بمدارسه الفقهية والأخلاقية والكلامية، هل التصوف يمكن أن يسهم في اللقاء بين الإخوة المسلمين كقاعدة مشتركة لولوج ما يعبر عنه الآن بحوار الأديان أم لكم مُقاربة أخرى؟
ج13: د. مجدي إبراهيم: بالطبع؛ هذه أولى مهماته الأساسية واعتقد أن ما ذكرته في السابق يشهد من الوهلة الأولي على بلوغ التصوف هذا المبلغ، ويزيد. فمع كونه تجربة روحية وعملاً فرديَّاً ذاتياً فريداً؛ فهو ظاهرة حضارية ممتازة جذبت إليها النوابه من كبار العقول والقلوب لا في الإسلام فحسب؛ بل في سائر الحضارات والثقافات والديانات الأخرى؛ لأنه ظاهرة إنسانية بكل المقاييس تتركز فيه وحده دوناً عن سواه: وحدة الروح الحضاري الإنساني؛ فما من حضارة قامت في القديم والحديث إلا وفيها هذا العنصر الروحي الممتاز، حتى إذا ما أردنا أن نركز كلمة جامعة عن وحدة الحضارة الإنسانية؛ قلنا بغير مبالغة في القول ولا شطط هى: (التصوف).
ولك إن شئت أن تسأل: إذا كان مشتركه الفعلي ظاهراً في الإنسان على التعميم، لا يفرق بين شرقي ولا غربي؛ لأنه مساس الروح الإنساني وشوق من أشواق النفس البشرية، فكيف بأبناء الديانة الواحد والعقيدة الواحدة، لا بدّ أن يجمع شملهم ويقوي روابطهم إذا هم تحققوا به وعرفوه حق المعرفة وحق الفهم، وإذا لم يقم فيما بينهم: السطحي والرجعي والغبي والمتخلف وبليد الطبع والحس، وفقير الشعور وضعيف الإدراك، ولا تخلو أمة من أمم البشرية من هذه الأنواع والأصناف، وهم الذين يتخذون من توجهاتهم العلمية أو العرقية أو السطحية عداءً للتصوف وللصوفية وهذا سبب البلاء.
وأنا مضطر أن أذكر لك نصاً "لهاملتون جب" في كتابه "دراسات في حضارات الإسلام" حين لخص بعضاً من مراحل التصوف حيث قال: في التصوف قاعدة فعالة هى قدرته على استثمار التجربة الدينية على نحو منظم. وهو ينشأ كعلم الكلام في مراحل راقية من التطور الديني. ولم يكن في القرن الأول من تاريخ الإسلام متكلمون أو متصوفة، ففي ذلك القرن كانت الجماعة الدينية المسلمة تمثل نوعاً من المجتمع الأخلاقي القائم على المبادئ المحسوسة حول الله واليوم الآخر، وعلى الواجبات الدينية المحسوسة التي وردت في القرآن الكريم، ولكن حين ولَّد تزايد نطاق النشاط الفكري وانتحال المناقشات الفلسفية منبى تشريعياً منظماً أولاً، وعلم الكلام متسقاً من بعد ذلك، أصبح البصر الديني الحدسي على مراحل متوازية". (أ. ه).
ادْرس إنْ شئت كبار العقول الصوفية وانظر فيماذا كانت تبحث؟ لترى أن المشترك الحضاري منطلقها، وأن المطالب الإنسانية وحدها هى مُتوجهها. لكن هذه الرؤية شيء، وأن يتحوّل التنظير الفكري إلى أهواء وتعصُّبات لآراء يجوز فيها الخطأ كما يجوز فيها الصواب، شيء آخر.
وكل تخريف غير علمي، غير عادل، لا يظهر من الحقيقة حقاً على الإطلاق فهو غير مقبول لدينا وغير معقول، وكيف يتأتى له أن يظهر هذا الحق وهو لا يتحرّاه ولا ينشده؟!
ألا فلنسأل، تُرى: هل كان التصوف هو هو الذي يعبد الشكليات أكثر من الحقائق أو يموت من أجل الخرافة أكثر ممّا يحيا في سبيل الحق؟! وإنَّا لنجيب: نعم ولكن أي حق؟ إنه الحق الذي تدَّعي الأنفس الراسخة في الطُهْر امتلاكه على عقول العوام.
س14: أ. مراد غريبي: هل فعلاً هناك مأزق منهجي في فهم التصوف بالنظر إلى كونه (التصوف) مرتكزاً على الولاية السلوكية من جهة وعدم حضور المرجعية التشريعية بشكل واضح مثلما الحال في باقي المذاهب الإسلامية؟
ج14: د. مجدي إبراهيم: عدم حضور المرجعية التشريعية! كيف هذا؟ وكيف تقوم ولاية سلوكية مع عدم حضور المرجعية التشريعية، تقوم، إنْ قامت، على ماذا إذن؟!
اعتقد أن هذا مخالفاً تماماً لطبيعة التصوف في الإسلام ككل، والسُّني منه على التخصيص؛ لأنه لا يقوم تصوف على الإطلاق ولم يوجد فيه حضور للتشريع .. لكن التشريع منزلة من منازل سير الولي إلى الغاية؛ ليأتي بعدها منزلة أخرى وهي (التحقيق) فلا تحقيق بغير تشريع ولا تشريع على الإطلاق بغير تحقيق. وهنالك من مقولات العارفين الذوقية الحكيمة ما يثبت هذا ويؤيده. (الولي لا يأتي بشرع جديد ولكنه يأتي بفهم جديد): عبارة في تقديري عبقرية معجزة، مبلغ الدلالة فيها ينقض كل ما قيل عن تجرّد الصوفية عن ملابسة الشريعة والامتثال لتعاليمها؛ وها هو أحدهم يخلق من الفهم في ميزان الشريعة خلقاً علي غير مثال سابق، ما لم يستطع غيره أن يخلقه. هذا الاعتقاد الصادق في أن الشريعة التي هى ظاهر الدين، ينبغي تحصيله والوقوف عليه لبلوغ الحقيقة التي هى باطن الشرع؛ فلئن كانت الشريعة هى ظاهر الدين؛ فالحقيقة هى باطن الشرع؛ فليس ثمة فصل بين الشريعة والحقيقة ولا تباعد، لأن كلتاهما تؤدي إلى الأخرى وتتمّم الواحدة منهما الأخرى.
حقاً .. لقد كانت كبوة الدكتور محمد إقبال، رحمه الله، حين سئل عن بعض تفسيرات ابن عربي للقرآن فقال:" أنا لا أنكر عظمة الشيخ ابن عربي، ولكن التماسه معان باطنة في "قانون أمة" هو مسخ لهذا القانون". وأنا لا أنكر عظمة الدكتور إقبال، ولكن هذه كبوةً لم يستطع أن يوظفها توجيهاً ودلالة؛ لأن الشريعة نفسها فيها فقه الظاهر، وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال الجوارح. وفيها فقه الباطن، وهو معرفة الأحكام المتعلقة بأفعال القلوب؛ فالتماس المعاني الباطنة من قانون الأمة (القرآن) على حد وصف "إقبال"، لا يعني مُفارقة حكم الباطن عن حكم الظاهر ولا غياب أحدهما عن الآخر، أو استحالة الجمع بينهما؛ بل يعني التكامل والاتفاق في وحدة قائمة تجمع بين مسلك التشريع ومسلك التحقيق. ومن هنا كان للشريعة ظاهرٌ وباطنٌ لا على معنى أن الشارع أظهر حكماً وأبطن حكماً كما يقول "الباطنية"، ولكن على معنى أن للشريعة حكماً على المُكلَّفين من حيث ظاهر أعمالهم، وحكماً عليهم أيضاً من حيث باطن أعمالهم. وهذا هو معنى قول الصوفية إن للشريعة ظاهراً وباطناً. ولم يكن ابن عربي بمعزل عما ينهجه الصوفية في تناولهم لهذا القانون والتماس المعاني الباطنة منه.
ولا بدّ آخر الأمر أن يفترق مسلك التشريع الظاهر عن مشهد التحقيق الباطن من حيث جواز التأويل الروحي؛ ففي الحالة الأولى ليس بجائز، وفي الحالة الثانية، في مقام الشهود، تنتفي المُباينة وتحل الوحدة؛ فيجوز ممّا لم يكن جائزاً في الحالة الأولى. ومحال أن تكون عطايا الباطن كعطايا الظاهر سواء. ولنقف عند العبارة التي ذكرها الشعراني في طبقاته كما أوردناها في السابق:"إنّ الولي لا يأتي قط بشرع جديد؛ وإنما يأتي بالفهم الجديد في الكتاب والسنة. هذا الفهم لم يكن يعرف لأحد قبله، ولذلك يستغربه كل الاستغراب من لا إيمان له بأهل الطريق ويقول على وجه الذم: هذا لم يقل به أحد. وكان الأولى أخذه منه واستفادته من قائله على وجه الاعتقاد".
لا حظ أولاً أن قول الشعراني حيث يردَّ قول من يذم أهل الطريق وينسب إليه عبارة: (هذا لم يقل به أحد)، تجدها عبارة دالة من الوهلة الأولى عن تقليد عند قائلها في تقليد؛ لكأن صاحبها يسوئه أن يرى جديداً ذا فهم جديد، فيعترض ويستنكر، حتى إذا كان التشريع هو بالقطع من عند الله ومقتصر عليه سبحانه وتعالى لا على سواه؛ فلا يمكن أن يأتي الولي بشرع جديد بل بالإمكان الإتيان بالفهم الجديد في التشريع الذي هو من عند الله: قطعي الثبوت قطعي الدلالة.
وهذه النقطة على التخصيص فيما أرى جوهرية؛ لأنها نفسها النقطة التي تمكّن العقل الحداثي في مقابل (العقل التراثي) بوضع الضوابط والمتغيرات لمواكبة الإنسان لتطوراته العصرية وتفتح أمامه السّعة في الفهم والتصرُّف في شئونه الدنيوية كيفما يشاء، وبغير قيود وحدود.
لم يكن الشعراني بالمخطئ بل هو مصيب في تلك الومضة البارقة إصابة لا نظير لها حين ذكر في طبقاته الموسوم بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار: أنّ الولي لا يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي بالفهم الجديد في الكتاب والسُّنة. ولم يكن هذا الفهم ليعرف لأحد قبله، وإنْ قابله الناس ممّن لا إيمان لهم بالاستغراب والدهشة والإذهال والاستبعاد ثم بالإنكار. وتلك أمور لا غرابة فيها لأن الفهم الجديد يقابل بمثل هذا الإنكار ويزيد.
لنلحظ أولاً عبقرية التسمية التي أطلقها عليه بهذا العنوان: "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار"، أو الطبقات الكبرى، فباتجاه النظر إلى العنوان: لواقح الأنوار، يقفز إلى الذهن هذا التساؤل: كيف تتلاقح الأنوار؟ وما علاقة هذا التلاحق بعنوان يحكي تجارب وخبرات بعض السادة من العارفين والأولياء؟ يظهر معنى كلمة لواقح التي ينقلها الشعراني نقلاً ذوقياً مباشراً من الدلالة الحسية الضيقة المباشرة إلى الدلالة المعنوية المفتوحة في أن كلمة (لواقح) بمعنى حوامل، جمع لاقح ولاقحة، ولاقح اسم فاعل من الفعل لقَحَ، وجمعه لواقح، ولقحت الحرب بمعنى اشتدت، وحرب لاقح: شديدة هائجة وهو تشبيه الحرب بالمرأة الحامل التي أوشكت ولادتها. ولقحت الناقة: أي قبلت ماء الفحل، ولقحت النخلة: أي تلقت اللقاح، ومثله لقح الزَّرع، ولقحت المرأة أي حملت.
ولم ترد كلمة (لواقح) في القرآن إلا في آية واحدة من سورة الحجر، الآية (22) "وأرسلنا الرِّيَاح لواقح"؛ بمعنى أن الرياح تلقح الأشجار والسحاب، تلقح السحاب فيدر الماء وتقوم بتلقيح الأشجار فتتفتح أزهارها وتنمو أوراقها. ولننظر؛ من بعدُ، إلى نقل الدلالة من ظاهرها اللفظي الحسي إلى باطنها المعنوي الروحي؛ لنجد فيما تجيزه الاستعارة مقدار ما تجوّزه لغة الإشارة الصوفية، أن ذهن الولي، إذ لا يأتي بشرع جديد، ولكنه يتلاقح مع الشريعة لقحاً أو أن الشريعة هي التي تلقحه فتمده من نورها ليستقر في أعماق وجدانه؛ فإذا هو يفهم مقاصد الشريعة فهماً جديداً قائماً على هذا التلقيح؛ فكما تلقح التجارب عقل الفيلسوف فتمكنه من التفكير العميق كذلك تلقح الشريعة عقل الولي فتزوده من أنوارها تماماً كما تلقح الرياح الشجر كأنها تثمره، أو تلقح الناقة إذ تقبل ماء الفحل، أو تلقح النخلة إذ تتلقي اللقاح أو كما يلقح الزرع أو تلقح المرأة فتحمل وتوشك على الولادة؛ فالرياح هي الحوامل بالخير والعطاء، وكذلك أنوار الولي حوامل بكل خير وعطاء وإبداع على غير مثال مسبوق. وكذلك تلقح أنوار الولي على هذا القياس كل من يمتد إليه بصره بالرعاية والإحاطة والموالاة.
وهكذا تكون مادة (لَقَحَ) دالة من الوهلة الأولى على الفاعلية الجوانيّة الباطنة لا أساس لها في الظاهر السطحي البراني، وإنْ كانت مُشاهدها وآثارها من ظواهر الكون والطبيعة، ولكن الفاعلية نفسها عملية حيوية باطنة.
وبنظرة واحدة إلى الآية الكريمة "وأرْسَلنَا الرِّيَاح لوَاقِح" تجد هذا المعنى دالاً على التفاعل الحيوي بين مرسل ومستقبل دلالة تخليق وإبداع وإثمار نافع جديد ومفيد. دلالة فاعلية حيويّة: وأرسلنا الرياح تسخيراً لتلقيح السحاب؛ ليحمل المطر النافع والخير الوفير؛ فالرياح تلقح السحاب ليمتلئ بالمطر فيعم خيره ويتسع نفعه، وكذلك أنوار الشريعة تلقح باطن الولي: عقله وضميره وقلبه وسريرته؛ لينتج النور ويثمر الهداية ويعم النفع. وبمثل هذا التفاعل الحيوي كحركة باطنة في جوف التجربة يأتي الفهم الجديد والفتح الجديد، ويرسل أشعته الكريمة كما ترسل الرياح لواقحها بمدد من عناية الله، وكما يحدث هذا كله في تلقيح النخل وتلقيح المرآة والناقة والشجر، يحدث في المستوى الأعلى: مستوى النور بالنسبة للأولياء؛ إذْ تتلقى قلوبهم تلقيح الشريعة ظاهرة وباطنة؛ فتنتج النور كما تنتج الأزهار أريجها في مساق الطبيعة.
عملية إبداع أصيلة تحاكي الطبيعة وتماشي السنن الكونية ممّا يتسع له فهم القلوب النظيفة.
وعليه؛ فالولي لا يأتي بشرع جديد ولكنه يأتي بفهم جديد هو نتيجة عمله بالكتاب والسنة. على أن هذا الفهم هو عملية خلق كاملة، إبداع على الأصالة، ولهذا تستغرب علوم الأولياء وتستنكر ممَّن لا حظ لهم لا من الشريعة ولا من الحقيقة، وهى وإنْ تكن علوم تقوم على الوهب والعطاءات الإلهية؛ فإنّ فضل الاجتهاد فيها غير منكور. ولم تكن لفتة الشعراني في هذا السّياق لفتة عارضة وهو وإنْ استوحاها من الآية الكريمة إلا أن دلالتها في سنن الكون الطبيعي ظاهرة بغير جدال. وبقدر ما يكون ذوق المتلقي فاعلاً مستشرفاً على فهم الدلالة هنا أمكنه أن يدرك أن علم التصوف تفرع من عين الشريعة، ولكنه لا يدرك هذا بمحض جهالة وعمى ولكن بمحض تبتل وانقطاع، أو بعبارة الشعراني نفسه بمحض: "تبحُّر في علوم الشريعة" حتى يبلغ منها الغاية فيصير عالماً بمنطوقها ومفهومها وخاصّها وعامها وناسخها ومنسوخها؛ بالإضافة إلى تعمقه في لغة العرب حتى يعرف مجازاتها واستعاراتها.
والخلاصة هى أن كل صوفيّ فقيه وليس شرطاً أن يجيء العكس، أن يكون كل فقيه صوفيّ. وكما يعطى الفقيه قوة الاستنباط في الشرع نظير الأحكام الظاهرة كالواجبات والمندوبات والآداب والمحرمات والمكروهات كذلك يعطي الوليّ قوة الاستنباط الظاهرة والباطنة معاً؛ لأن قوام القوتين اجتهاد من جهة وتوفيق من جهة أخرى. وليس إيجاب مجتهد باجتهاده شيئاً لم تصرح الشريعة بوجوبه أولى من إيجاب وليُّ الله تعالى حكماً في الطريق لم تصرّح الشريعة بوجوبه. وإذا لزم الاجتهاد للفقيه فيما لم تصرح به الشريعة من أحكام الظاهر لزم الاجتهاد للولي فيما لم تصرح به الشريعة من أحكام الباطن. والمعنى من وراء ذلك أنهم كلهم عدول في الشرع، أختارهم الله عز وجل لدينه فمن دقق النظر، على حد عبارة الشعراني، علم أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله عن الشريعة؛ إذ كانت هذه العلوم، كما قال الجنيد، مشيّدة على الكتاب والسّنة.
هنالك يصبح التصوف "عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة؛ فكل من عمل بهما انقدح له من ذلك علوم ومعارف وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسنة نظير ما انقدح لعلماء الشريعة من الأحكام حين عملوا بما علموه من أحكامها. فالتصوف زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة إذا خلا من عمله العلل وحظوظ النفس.
من غير المفهوم إذن بعد هذا كله أن يلغط أكثرهم بمفارقة الصوفية للشريعة؛ إذ ذاك يصبح لغطاً لا يقوم على دليل. وعندي أن إعادة تكرار البحوث والدراسات في إبراز الصلة بين الشرع والتصوف لا يسفر عن جديد بل يسفر عن عقم فكري لأمور تم إلقاء الأضواء عليها حتى أشرقت وقتلت بحثاً وتنقياً في القديم والحديث. ولئن كان هنالك من الفقهاء الجدد من ينكر العلاقة بين الشريعة والتصوف فلا أقل من أن يكون إنكار الجديد كإنكار القديم سواء: يمثل عقماً فكرياً وبصيرة مطموسة قلّ أن تدرك ظاهر هذه العلاقة فضلاً عن باطنها الكامن فيها بغير جدل طويل.
هذه واحدة، أمّا الثانية؛ فلأن نزعة التصوف حديثاً كما كانت قديماً هى نزعة استقلالية ذاتية صرفة على الأصالة، بعيدة عن حركة العمل في مجال الفقه أو في مجال التشيع، وإنْ كانت هذه النزعة قريبة كل القرب من معدن الشريعة. لم يكن رفض الشيعة للتصوف قديماً بالأمر الذي يمر علينا من غير تمحيص أسبابه وتخليص آثاره الباقية، فإنّ الدلالة فيه أظهر من تخفى؛ لأن الشيعة لم يقبلوا التصوف لنزعته الروحية المستقلة بعيداً عن التوسُّل بالأئمة فهو لأجل هذا مستقل ذاتياً عن التشيع. وقد نصّ "ماسينيون" في احدى دراساته فقال: جاءت الشيعة الإمامة الزيدية والإثني عشرية والغلاة في القرن الثالث الهجري فانكروا كل نزوع إلى التصوف؛ لأنه يُحدث بين المؤمنين ضرباً من الحياة الشاذة (صوف، خانقاه) تتمثل في طلب الرضا من غير توسل بالأئمة الإثنى عشر، وطلب إمامة تتناقض مع ما جروا عليه من تقية.
القصد من هذا واضح جداً هو أن التصوف طلاقة روحية في الإسلام لا يلزم عنها الخنوع لقيود الفقه والاستسلام لمقومات التشيع ولا الانقياد لأحد من سائر البشر، ولكنه يستقي أركان معالمه من روافد التجربة الصوفية نفسها كما يستقي الشاعر الأصيل المطبوع شعره من تجربته ومن طبيعته الفنية، ويستكشف ما للحق المطلق بذاته، فكل تجربة صوفية لها أركان ومعالم ربما تختلف عن التجارب الأخرى؛ بل تختلف عن تجارب الصوفيّة أنفسهم فيما بينهم بعضهم مع البعض الآخر.
هذه الطلاقة الروحيّة التي يعول عليها ولا يعول على سواها، هى التي شكلت استقلال الصوفي الأصيل، وتميزه بين أقرانه، ثم تفرده بينه وبين غيره من أبناء جلدته..
***
حاوره: ا. مراد غريبي - المثقف







