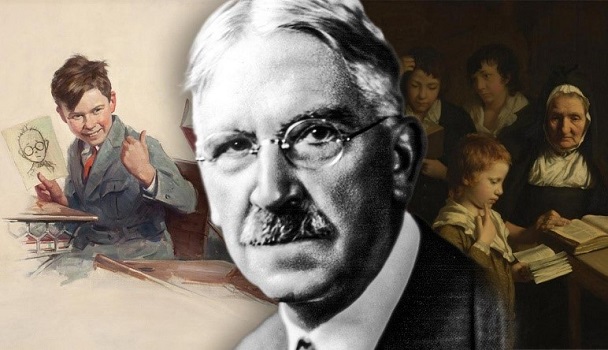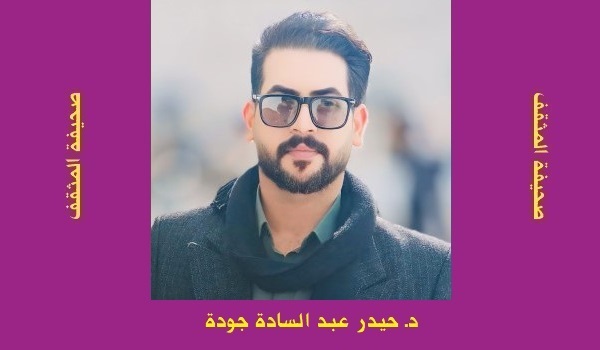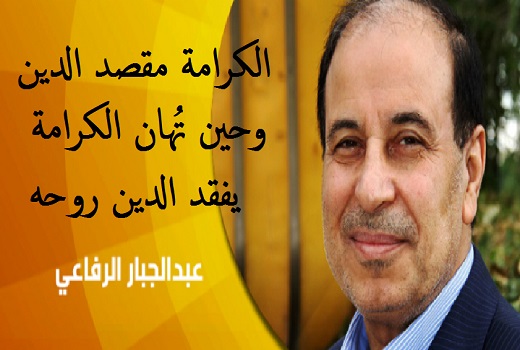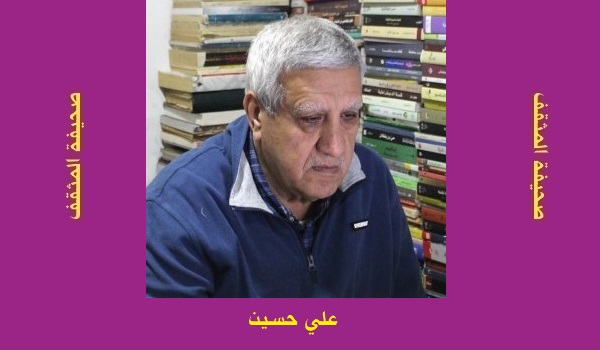قراءة معاصرة في السيميائيات الحديثة وفهم العلامة
يندرج هذا البحث في إطار الدراسات السيميائية المعاصرة، حيث يسعى إلى تقديم قراءة شمولية لمصطلحات وأدوات علم السيمياء من منظور يزاوج بين الامتداد التاريخي والوظيفة التحليلية. فقد تمت مقاربة المفهوم انطلاقًا من التراث العربي الإسلامي كما تجلّى عند ابن سينا وجابر بن حيان وابن خلدون، مرورًا بما أثبته لسان العرب وما أورده الزجاج من دلالات لمفهوم السيماء والسيمياء، وصولًا إلى التحديدات التي رسختها المعاجم الغربية، والتي أفرزت تمييزًا بين الكيمياء والسيمياء من جهة، والسيميولوجيا والسيميوطيقا من جهة أخرى.
كما انفتح البحث على أبرز التنظيرات الحديثة لدى فرديناند دو سوسير وشارل بيرس وشارل موريس ورولان بارت وجاك دريدا وأمبيرتو إيكو، مبرزًا تباين المدارس بين المقاربة الثنائية (الدال/المدلول) والمقاربة الثلاثية (العلامة/المرجع/المؤول). وتم الوقوف عند أهم الأدوات الإجرائية للسيميائيات مثل العلامة، الرمز، الأيقونة، المؤشر، والقرينة، باعتبارها مفاتيح لتحليل الخطاب بمختلف أشكاله.
وخلصت الدراسة إلى أن إعادة تقويم العلاقة بين سيميولوجيا سوسير وسيميوطيقا بيرس تتيح إعادة طرح سؤال المرجع السيميائي وكيفية اشتغال العلامة داخل الخطاب الأدبي والثقافي، بما يمنح السيميائيات راهنيتها كمنهج فعّال لتحليل أنساق العلامات وبُناها الدلالية
الكلمات المفاتيح: السيمياء؛ السيميولوجيا؛ السيميوطيقا؛ العلامة؛ الدال والمدلول؛ بيرس؛ سوسير؛ تحليل الخطاب.
على سبيل التقديم
يعدّ علم السيميائيات من أبرز الحقول المعرفية المعاصرة التي انشغلت بدراسة آليات إنتاج المعنى داخل الخطاب الأدبي وغير الأدبي على السواء. وقد عرف هذا الحقل منذ نشأته مع دي سوسير وشارل ساندرس بيرس، مرورًا بجهود رولان بارت، غريماس، أمبيرتو إيكو وجوليا كريستيفا، تطورات نظرية ومنهجية أسهمت في بناء جهاز مفاهيمي متماسك يُمكّن الباحث من مقاربة النصوص والظواهر الثقافية بوصفها أنساقًا دلالية منتجة للمعنى
غير أنّ ثراء السيميائيات وتعدد اتجاهاتها أفضى إلى تباين واضح في صياغة مصطلحاتها وتوظيف أدواتها، حيث يتجاذبها بين الحقول المختلفة سياقان: سياق التأسيس النظري الصارم من جهة، وسياق الاستعمال التطبيقي المتشعّب من جهة أخرى. ومن هنا تتأتى إشكالية هذا البحث، الذي يهدف إلى رصد أهم المصطلحات والأدوات السيميائية، والكشف عن طبيعتها ووظائفها وحدودها التداولية، قصد بناء رؤية أكثر وضوحًا للباحث العربي في تعامله مع هذا الحقل المعرفي.
ولأجل ذلك، يقوم البحث على تتبّع الخلفيات النظرية لتلك الأدوات، وتبيّن موقعها في التحليل السيميائي الحديث، ثم مناقشة إمكانات تكييفها مع النصوص الثقافية والأدبية في السياق العربي، بما يتيح تجاوز إشكالية الازدواجية الاصطلاحية، ويمهّد لبلورة جهاز إجرائي يساعد في إنجاز قراءة أكثر عمقًا للنصوص والخطابات.
تعريف مصطلح السيمياء وتاريخه
في القديم اقترن مصطلح السيمياء عند العرب بعدد من العلماء أمثال ابن سينا وابن خلدون وجابر بن حيان (200ه ـ 815م)، هذا الأخير الذي كان شديد الثقة بعلمه ولكن لم تساعده أدوات عصره على تحقيق ما كان يطمح إليه من خيال علمي حيثُ كان يسعى إلى تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. ولما لم يستطع تحقيق بعض ذلك الطموح، تحول علم الكيمياء عنده إلي ما عرف بعلم السيمياء. وقد كان مفهوم هذا العلم في ذلك الوقت قريباً من السحر. يقول صاحب كتاب أبجد العلوم: " السيمياء هي اسم لما هو غير حقيقي من السحر"(1).
وقد ورد في لسان العرب: "السومة والسيماء والسيمياء: العلامة، وسوم الفرس: جعل عليه السيمة، وقوله عز وجل: ﴿حجارة مسومة عند ربك للمسرفين﴾(2)؛ قال الزجاج: روى الحسن أنها معلمة ببياض وحمرة، وقال غيره: مسومة بعلامة يعلم بها أنها ليست من حجارة الدنيا ويعلم بسيماها أنها مما عذب الله بها؛ الجوهري: السومة بالضم العلامة، تجعل على الشاة وفي الحرب أيضا، تقول منه تسوم. قال أبوبكر: قولهم عليه سيما حسنة معناه علامة ... والخيل المسومة هي التي عليها السمة والسومة وهي العلامة. وقال ابن الأعرابي: السيم العلامات على صوف الغنم. وقال تعالى: من الملائكة مسومين؛ بفتح الواو، أراد معلمين ...وفي حديث الخوارج: سيماهم التحليق أي علامتهم، والأصل فيها الواو فقلبت لكسرة السين، وقد يجئ السيماء والسيمياء ممدودين ..." (3).
أما المعاجم الأجنبية فقد فرّقت بين مصطلحين: الكيمياء وهي العلم المعـروف Chemistry) وعلم أخر (Alchemy) وهو يرمز إلى ما كان يسمي عند العرب بعلــم السيمياء وهو علم كيمياء القرون الوسطي . وربما سموه (الخيمياء) لقرب اللفظتين لفظاً ومعنى(4).
وتعرف السيميولوجيا بأنها:" علم يدرس العلامة ومنظوماتها أي اللغات الطبيعية والاصطناعية كما يدرس الخصائص التي تمتاز بها علاقة العلامة بمدلولاتها"(5)؛ أي تدرس علاقات العلامات والقواعد التي تربطها أيضاً وهذا التعريف يدخل تحته عدد من العلوم مثل الجبر والمنطق والعروض والرياضيات...
في العصر الحديث
تعددت وجهات النظر في تحديد هوية هذا الحقل المعرفي، حيث اختلفت تحديداته وتنوعت تعريفاته بتنوع المدارس واختلاف الاتجاهات ولكن هذا لم يمنع العلماء من المحاولة إذ يعرفها بيارغيرو بأنها: "العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العلامات: اللغات، والأنظمة والإشارات والتعليمات ..." (6)؛ وهذا التحديد يدخل اللغة تحت مفهوم السيميوطيقا. وقد ترجم بعض علماء اللسـانيات العرب هذا العلم بعلم الرموز أو علم الدلالة. وكان أوائلهم متأثرين بموريس الذي كان يرى أن السيمياء تهتم بمعنى الإشارات قبل استعمالها في قول أو منطوق معين. وقد وضح د. ميجان الرويلي ود. سعد البازعى مفهوم السيمياء في كتابهما دليل الناقد الأدبي حيث يقولان في هذا الصدد ما يلي: السيميولوجيا لدى دارسيها تعني علم أو دراسة العلامات (الإشارات) دراسة منظمة منتظمة، ويفضل الأوربيون مفردة السيمولوجيا التزاماً منهم بالتسمية السوسيرية أما الأمريكيون فيفضلون السيميوطيقا التي جاء بها المفكر والفيلسوف الأمريكي تشارلي ساندرز بيرس. (7) وقد دعا معظم اللسانين العرب إلي ترجمتها بالسيمياء. ورأوا أن هذه المفردة السيمياء مفردة عربية لها حقل دلالي لغوي ثقافي تشاركها فيه كلمات مثل السمة والتسمية والوسام والوسم والميسم والسيماء والسيمياء وكلها تعني العلامة. وأيا كانت أصولها البنيوية التي هي نفسها منهج منتظم لدراسة الأنظمة الإشارية المختلفة في الثقافة العامة.
وقد استعمل"فردناند دو سوسير" مصطلح "سيميولوجيا" واستخدم الفيلسوف الأمريكي "شارل بيرس" مصطلح " سيميائيات"، حيث اعتبرا المؤسسين الفعليين لهذا النوع من الدراسات . يقول دوسوسير معرفا السميولوجيا في كتابه محاضرات في علــم اللغة:" من الممكن ابتكار علم يدرس دور العلامات باعتبارها جزء من الحياة الإجتماعية، ويكون جزء من علم النفس الاجتماعي، وبذلك يكون جزء من علم النفس العام. ونرى تسميته السيمولوجيا، وهو يدرس صيغة العلامات والإشارات والقوانين التي تحكمها. وبما أن هذا العلم لا يوجد بعد فلا نستطيع أن نتنبأ بمصيره، غير أننا نصرح بأن له الحق في الوجود إذ يوجد له سلفا مكانيا، وما الألسنية إلا فرع من فروع هذا العلم العام، وستكون القوانين التي ستكشفها السيميولوجيا قوانين تطبق في اللسانيات كذلك"(8).
وقد كتب دوسوسير هذا النص أواخر القرن التاسع عشر. سنة 1894. ونشر سنة 1916، حيث تصور دي سوسير وجود هذا العلم وبين اشتقاقه وأصله، كما حدد موضوعه، ونادى بحقه في الوجود ووصف علاقة هذا العلم الآتي الذي لم يكن قد ولد بعد، بكل من علم النفس الذي هو الأصل الذي ينتمي إليه العلم المبشر به، وبين علم اللسان الذي سيكون جزء منه. كما بين وظيفته وأهميته في بيان مدلولات الإشارات ومعرفة قوانينها التي تحكمها. لقد اعتبر ف. دوسوسير "اللغة نظام من العلامات التي تعبر عن الأفكـار"(9)؛ حيث اكتشف أن الكلمة تملك بنية سماها دليلا، يتكون هذا الأخير من دال (صورة سمعية) ومدلول(مفهوم). فالدليل إذن علاقة اعتباطية وضرورية بين الدال والمدلول. فهو "لا يملك أي رابطة انتماء مع الشيء المقابل ولا تشابه أو مماثلة، فهو ليس سوى مصوتية فارغة أو شكلا خطيا اعتباطيا ومبهم دون التمثل الذي يملك القدرة على استحضاره والذي يستمد منه مضمونه ودوره ووجوده الواقعي (10).
فقد كان دي سوسير يرى أن اللسان نسق من العلامات التي تعبر عن المعنى، وهو ما يمكن أن يقارن بلغة الصم والبكم والطقوس الرمزية الأخرى دينية كانت أم ثقافية مادامت وسط المجتمع. حيث دعا إلى الاهتمام بالعلامة لمنطلقات لغوية إلى ما سماه بعلم السيمولوجيا أو علم منظومات العلامات، من خلال مفهومه للغة بوصفها منظومة من العلامات تعبر عن فكر ما مع تركيز دائم على العلاقات التي تربط بين الوحدات والعناصر اللغوية كما قرر دي سوسير اعتباطية العلامة اللغوية بينما تقول السيميائية باعتباطية العلامة مما يمنح الدوال مدلولات لانهائية. (11) . وهكذا تلتقي السيميائية واللسانيات في القول باعتباطية الدليل اللساني. وإن رأى البعض أن هذه العلاقة ينبغي وصفها بأنها ضرورية وليست اعتباطية (12).
والدال هو تلك الصورة الصوتية، والمدلول هو ما تثيره تلك الصورة في ذهن المتلقي. وهكذا نجد أن سوسير قد أطلق السيميولوجيا على علم العلامة أو الإشارة، حيث يقول في هذا الصدد ما يلي: "إنه بإمكاننا أن نتصور علما يدرس حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، وبالتالي السيكولوجيا العامة، وهذا العلم هو السميولوجيا الذي يعلمنا كيف تتكون العلامات، وما هي القوانين التي تحكمها"(13).
وهو أيضا من أصر على أن السيميولوجيا أصل، واللسانيات فرع منها، لكنه سيخضع للتعديل والقلب من طرف دارسين آخرين. فقد أكد "بارت" الذي مارس التحليل السيميولوجي على أكمل وجه أن اللسانيات أعم من السيميولوجيا. لأنه لا يمكن تصور إنسان بــدون لباس (علامة) ولا يمكن تصوره بدون لغة.
وأما جاك دريدا وإن اعترف بجهود بارت، فقد اعتبر على أن "النحوية": "الكتابة بوصفها أثرا" هي سمة الإشارة الكبرى، ولابد أن تكون الأصل الذي عنه تتفرع السيميوطيقا واللسانيات. ومهما يكن من أمر التمييز بين البنيوية والسيميولوجيا، فإن هذا التمييز يبقى تمييزا محليا ومرحليا، فالسيميولوجيا تتبع المنهجية البنيوية وإجراءاتها، لكنها تقصر التركيز على دراسة الأنظمة العلاماتية الموجودة أصلا في الثقافة، والتي عرفت على أنها أنظمة قارة قائمة في بيئة محددة. أما البنيوية فتدرس العلامة سواء كانت جزءا من نظام أقرته الثقافة كنظام أو لم تقره. ولعل هذا الفارق هو الوحيد الذي من شأنه أن يميز الحقلين ولئن اعتبرنا التمييز البنيوي بين اللغة النظام (اللسان) واللغة الأداء (الكلام) أساسا للفريق بين البنيوية والسيميولوجيا، فإننا سنقول إن مجال عمل السيميولوجيا هو اللغة النظام دون اللغة الأداء. ولهذا تظل السيميولوجيا ممارسة استقرائية استنتاجية، وهذا ما يجعلها تقوم على أهلية "الذات" المدركة والواعية.
وأما في اللغة الانجليزية فتسمى "سيميوطيقا" وقد أريد بها نفس المعنى الذي عند دوسوسير بواسطة "شارل بيرس" و"شارل موريس" الأمريكيين الذين أسسا للتراث الأمريكي في هذا الميدان من العلوم في الوقت الذي كان فيه دوسوسير يؤسس لهذا العلم في فرنسا وعلى جهل تام من قبله بذلك. وفي هذا الصدد يعتبر بيرس (1839-1914) بأن النشاط البشري بمجمله نشاط سيميائي .وبطبيعة الحال فإن النشاط اللساني هو نشاط سيميائي لأنه جزء من النشاط البشري .يقول بيرس عن نفسه:" إنني وحسب علمي الرائد أو بالأحرى أول من ارتاد هذا الموضوع المتمثل في تفسير وكشف ما سميته السيميوطيقا أي نظرية الطبيعة الجوهرية والأصناف الأساسية لأي سيميوزيس محتمل .إن هذه السيميوطيقا التي يطلق عليها في موضع آخر المنطق تعرض نفسها كنظرية للدلائل وهذا ما يربطها بمفهوم السيميوزيس الذي يعد على نحو دقيق الخاصية المكونة للدلائل"(14).
التسميتان إذا ليستا تفسيرا لغويا من قبل كل واحدة منهما للأخرى، بقدر ما هما نتاجان حدثا في الفترة الزمنية نفسها، لكن الصيغة الثانية "Semiotics" كتسمية لميدان هذا العلم، هي التي أقرت أخيرا، وقد أخذ بها " المجمع العالمي لعلم السيمياء" الذي أسس فيما بعد مجلة " السيميوطيقا العالمية" في كانون الثاني من عام 1969م، لكن الاختلاف بين "علم السيمياء" بمعنى "Sémiologie" و"علم السيمياء " بمعنى "Sémiotics" ليس على ما يبدو اختلافا بسيطا بين كلمتين وليس أيضا محصلة معركة وصراع علم الإصلاحات الفرنسي - الأمريكي بين "سيميوطيقا بيرس" و"سيميولوجيا سوسير"، إنه اختلاف يركز أساسا على التعارض بين نوعين أو بالأحرى بين طرازين من العلامة " Signe" أو الدلالة. ففيما يحدد "سوسير" العلامة ويعرفها على أنها اتحاد بين دال ومدلول. نجد "بيرس" قد أضاف إلى تلك الصيغة مفهوم "المرجع" أي الواقع المعين بواسطة العلامة (أو الدلالة).
ويعرف "بورس " السيميائيات بأنها:" الدستور الشكلاني للعلامات"، حيث عرض نظرية سيميولوجية غاية في التعقيد، لكن نظرته للعلامة وفاعلية وظائفها الدلالية لا تختلف عن الطرح البنيوي اللساني، إذ يرى بيرس على أن العلامات تنقسم إلى دوال ومدلولات وعلاقات تربطها معا، وكما الحال عند دوسوسير، فإن بيرس يبحث عن القانون المنتظم الذي يحكم حركة هذه العلاقات بين الدال والمدلول: فهو بلغة سوسير يبحث عن اللغة النظام التي تحكم حركة اللغة الأداء، وبحسب نظرية بيرس فإن البنية الدلالية العلاماتية تحتوي أربعة عناصر:
العلامة بوصفها ممثلا ينوب أو يحل محل شيء آخر (المادة المشار إليها أو الموضوع) والمحلل (الشخص الذي يدرك ويعني الإشارة)، ثم الطريقة المحددة التي تكتمل بها العملية النيابة الإشارة، وهي التي يسميها بيرس: الأرضية أو الأساس. ويقول بيرس في هذا الصدد ما يلي: " إن العلامة أو الممثل هي شيء ما من شأنه أن يقوم مقام شيء آخر، ويقوم مقامه بطريقة محددة بالنسبة إلى شخص معين"(15). وتحدد لنا هذه العلاقة الرباعية الوسيلة التي من خلالها تؤدي العلامات معانيها. كما أن العلاقة القائمة بين العناصر الأربعة تحدد بدقة متناهية طبيعة العملية السيميولوجية إذ يرى بيرس أن كل عملية سيميولوجية تنطوي على علاقة ثلاثية بالنسبة إلى العنصر الرابع: أي العنصر الإنساني المدرك.
بينما يقول" امبرتو إيكو": إن السيميائيات تعنى بكل ما يمكن اعتباره علامة وإشارة. أما مارتينيه فيعرفها قائلا: " السيميولوجيا: دراسة جميع السلوكيات والأنظمة التواصلية".
جوهر التعريف إذن يركز على اعتبار هذا العلم، علما جديدا زمن نشأته، وأنه يركز على دراسة الدلالة والمعنى؛ لكن هذه الدراسة لم تكن محل توافق وهو ما سيؤدي إلى نشأة مدارس سيميائية مختلفة.
مصطلحات وأدوات علم السيمياء
تتعدد أنواع العلامات والدلالات في ميدان علم السيمياء (علم الدلالة) فنجد إلى جانب العلامة كمصطلح أساسي، الدلالة، الرمز، الشاهد(الدليل) والأيقونة (أي القرين)، والإشارة، إن هذه الكلمات ليست مصطلحات فقط في علم السيمياء، بل هي أدوات هذا العلم، يعمل من خلالها ويستخدمها، وقد أوجد لكل منها تفسيرا أو تعريفا خاصا بها، فإذا وجد مقومات ذلك التفسير ومعطياته في ميادين الأدب واللغة والفن ووسائل التعبير الأخرى كالمسرح مثلا، عين نوع العلامة وقدم الوجهة الفنية في التعبير على أساسها لهذا الفن أو ذاك، إذا هذه المصطلحات كأدوات تختلف باختلاف موقعها في تفسير التعبير، وموقعها منه. من هنا يأتي علم السيمياء كتكملة لمسيرة علم اللسانيات، لكن على نطاق آخر، والدليل على أنه يتخذ علم اللسانيات كمنطلق له، هو وجود مصطلحات ذات سمة مشتركة بين العلمين: فالدليل والعلامة والدال والمدلول هي صيغ علم اللسانيات أساسا، لكن عالم السيمياء استعان بها في ميدان تبيان وتفسير دلالات اللفظ والتعبير الفني، ويقول سوسير في مجال علم اللسانيات بهذا الخصوص أن "الدال والمدلول هما الحدان اللذان بهما تعرف العلامة أي (الدلالة)"؛ ولعل من أهم المصطلحات السائدة في هذا المجال العلمي ما يلي:
- العلامة السيميولوجية: أي الدلالة في علم اللسانيات ليس اجتماع شيء ما مع اسم ذلك الشيء، بل إنها اجتماع مفهوم ما مع صورة سمعية/صوتية. كما يقول سوسير. ويكون سوسير قد ألغى كما ذكرنا سابقا في هذا الإطار مفهوم "المرجع" أي الواقع الذي تعينه الدلالة وتعود إليه عند جمعها للدال والمدلول. بينما هذه الصيغة هي كما رأينا عند بعض السيمائيين أمثال "بيرس" تتمسك بالعلاقة بين العلامة (دال+ مدلول) ومرجعها الذي تعينه ويقترح بذلك نمذجة للعلامات حسب طبيعة هذه العلاقة، وانطلاقا منها، وحيث هذه العلاقة هي بطبيعة الحال، مدعومة بواسطة القرين والرمز والشاهد.
و" يعتبر بيرس العلامة (Signal) كقرينة اصطناعية، أي دليلا من صنع الإنسان يربطه بموقف أو شيء معين بغية تحميله رسالة ما"(16). فالعلامة تؤدي إلى رد فعل ما. وهي لا تحتوي على أية علاقة دلالة. مثال: الجرس هو علامة نهاية الدراسة.
الشاهد أو الدليل: الشاهد (Index) أو (الدليل (Signe Indice/
هو نموذج يعود إلى نمذجة شارل بيرس عام 1978، فالشاهد بالنسبة له علامة أي ترابط أو اتحاد ديناميكي وترابط حيزي أيضا) مع الشيء الفردي من جهة، ومع الذاكرة للشخص الذي يكون بالنسبة لها علامة من جهة أخرى، والكلمة حسب سوسير تملك بنية سماها دليلا، كما سبق وتمت الإشارة إلى ذلك، حيث يتكون هذا الأخير من دال (صورة سمعية) ومدلول (مفهوم) . والدليل حسب سوسير هو علاقة اعتباطية بين الدال والمدلول، فهو "لا يملك أي رابطة انتماء مع الشيء المقابل ولا تشابه أو مماثلة، فهو ليس سوى مصوتية فارغة أو شكلا خطيا اعتباطيا ومبهم دون التمثل الذي يملك القدرة على استحضاره والذي يستمد منه مضمونه ودوره ووجوده الواقعي(17).
فالدخان مثلا شاهد على وجود النار، والاصبع الموجه نحو شيء ما، هو دليل يؤدي إلى تعيين ذلك الشيء. إن الشاهد (أو الدليل) يموضع عناصر وأشياء، وبدونه تبقى هذه الأخيرة معلقة، دون إرساء حيزي وزمني لها، هذا النموذج من العلامات أساسي.
- الرمز: Symbole: ويعني عند اليونان في السابق علامة التعرف أو المعرفة، إنه علامة اتفاقية واصطلاحية، تتعلق بعادة فطرية مكتسبة، سواءا كانت تلك العادة تزيد معنى وتدليلا جديدا على المعنى الأساسي أو تعود إلى المعنى والتدليل الأساسين. والرمز هو علامة قد اختيرت اتفاقيا كي توحي لنا بمرجعها الأصلي: وهكذا فإن نسق الضوء الأحمر /الأخضر/ الأصفر، قد استعمل اصطلاحا للإشارة إلى الأولوية في المرور. ويعرف بيرس الرمز بأنه " دليل يعود إلى الشيء، الذي يدل عليه بفعل قانون يتكون عادة من تداع عام للأفكار ويحدد ترجمة الرمز بالرجوع إلى هذا الشيء"(18).
ويقدم ج. بياجي تعريفا أكثر وضوحا، إذ يقول إن الرمز "صورة مستحضرة ذهنيا أو شيء مادي مختار عن قصائد ليعين صنف أفعال أو أشياء" (19).
وحسب المنهج السوسيري فإن الترميز يكتسب معنى معاكسا لنمذجة "بيرس" وهو بذلك يعتبر مبدأ العلة الطبيعية بين الدال والمدلول. أي أن الرمز لا يكون إلا بين وحدتين من نفس المستوى، أي بين داليين أو مدلولين. فالميزان هو رمز العدالة لأنه يوحي تماثليا بكفتيه المتوازيتين زنة كب من الحسنات والسيئات وبشكل مقصود يمكننا التكلم أيضا عن الرمز المستعمل في الديكور أو في الإخراج.
القرينة (الأيقونة): Identité: إن القرينة هي في نمذجة علامات بيرس العلامة التي تعين مرجعها حصرا، بواسطة خصائص تعود فقط إليه، خارج كل الاعتبارات التي تهم وجود أو عدم وجود المرجع" والقرينة تدل على الوجود المحتمل لشيء ما. و"القرائن هي أحداث قابلة للإدراك حالا وتجعلنا نعرف شيئا بصدد أحداث أخرى ليست كذلك(20).
إن رسم (صورة) يمتلكها شخص ما، يعتبر قرينه أي (أيقونته)، بالقدر الذي يمثل الرسم نموذجه. والدخان قرينة النار، والدخان الكثيف الأسود يدل على الحريق، والغيوم المتلبدة تدل على المطر.
خلاصة:
إن إعادة تقويم لسيميولوجيا سوسير، ولسيميوطيقا بيرس قد تسمح لنا بطرح مسألة مرجع العلامة السيميائية. فالنموذج البيرسي (نسبة إلى بيرس) ذو الشكل الثلاثي، يعتمد على العلاقة بين العلامة ومرجعها وعلى الاستعمال الذرائعي (العملي/ الواقعي) للعلامات، بينما نرى أن ثنائية الدال والمدلول لا تأخذ في حسبانها الشيء المعين بواسطة العلامة، كي تهتم في المقابل بالمفهوم الذي ترتبط به مادية الدال؛ بحيث سيتبلور مفهوم "علم السيمياء" فيما بعد انطلاقا من أعمال "غريماس" وقد اعتمد تسمية "sémiotiques" لهذا العلم على الرغم من أعماله في البحث قد انطلقت من أعمال سوسير وهيلمسلاف، فإن هذه الصيغة تكون أقرب إلى تسمية بيرس لهذا النوع من العلوم منها إلى تسمية "سوسير وهيلمسلاف له. ويقول غريماس وهكذا تتسع الهوة، وتزداد عمقا بين السيميولوجيا التي كانت تستخدم من أجلها اللغات الطبيعية كأدوات من أجل الشرح المسهب في وصف الأشياء الدلالية من جهة وبين السيميوطيقا التي أخذت على عاتقها بادئ ذي بدء، تشكيل وبناء "علم ما وراء اللغة" الذي يحتوي اللغة ويفسرها، أي تصبح ميدان من ميادينه، ويضيف غريماس قائلا: "السيميولوجيا تطرح كمبدأ، أو كمسلمة، بطريقة أو أخرى، توسط اللغات الطبيعية في تطوير سيرورة قراءة المدلولات المنتمية إلى السيميائيات اللغوية واللالغوية كالتصوير، والرسم والهندسة وغير ذلك بينما نرى بأن السيميوطيقا تدحض هذا الادعاء".
***
بقلم: د. منير محقق
كاتب وناقد وباحث أكاديمي مغربي
........................
لائحة المراجع والمصادر
المراجع والمصادر باللغة العربية
- القرآن الكريم.
- صديق القنوجي، أبجد العلوم ج، الطبعة الأولى ص 392
- سورة الذاريات، الآية: 34.
- ابن منظور لسان العرب مادة (سوم)
- إبراهيم صدق، السيميائية اتجاهات وأبعاد، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيمياء والنص الأدبي، ص 77.
- أنور المرتجى، سيميائية النص الأدبي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط1 1987م ص 3.
- د. بشير كاوريربت، مناهج النقد الأدبي المعاصر 139
- بيار غيرو، السيمياء ترجمة: أنطون أبن زيد ط 1، 1984م، منشورات عويدات، بيروت لبنان ص 50.
- فرديناند دي سوسير: محاضرات في اللسانيات العامة، ص 33.
- فرديناند دي سوسير، محاضرات في اللسانيات العامة ص 87
- ميشال أريفية وجون كلود جيرو، السيميائية أصولها وقواعدها، رجمة رشيد بن مالـك مراجعة وتقديم عز الديـن المناصرة ص 28، 29
- فرديناند دي سوسير، محاضرات في اللسانيات العامة
- محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، ص. 8.
- بسام بركة: الإشارة - الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية. ص 50، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 30 -31.
- إبراهيم الخطيب، ترجمة مؤلف "مورفولوجية الخرافة" لفلاديمير بروب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1986م.
- الجلالي الكدية، أنطولوجيا الحكاية الشعبية المغربية، الطبعة الأولى " أنفوبرانت"، فاس، 2014.
- أحمد زياد محبك، الحكاية الشعبية، دراسة ونصوص، مقاربات للنشر والصناعات الثقافية، الطبعة الأولى 2018، فاس، المملكة المغربية.
- مصطفى يعلى، امتداد الحكاية الشعبية، موسوعة شراع الشعبية، طنجة، سبتمبر-دجنبر 1999.
- محمد حجو، الإنسان وانسجام الكون، سيميائيات الحكي الشعبي، الطبعة الأولى، الرباط 2012.
- محمد فخر الدين، الحكاية الشعبية المغربية، بنيات السرد والمتخيل، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى، الرباط 2014.
- محمد فخر الدين، موسوعة الحكاية الشعبية المغربية، دار نشر معهد الشارقة، الطبعة الثانية، 2018.
مصطفى الشاذلي، ظاهرة الحيز في الخرافة الشعبية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ع.10/1984، ص.169-177.
- إدريس كرم، اختيار الزوجة كما تقدمه الحكاية الشعبية المغربية، مجلة التراث الشعبي، ع.6، س.9، وزارة الإعلام، بغداد، 1978، ص.113-129
-حسن السائح، القصة والملحمة في الأدب الشعبي، مجلة التعاون الوطني، ع35/1966.
- صلاح الدين الخالدي، الحكاية المرحة في الأدب الشعبي المغربي، مجلة المعرفة، ع149، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، تموز 1974، ص.86.
- عبد الكبير الخطيبي، صوت الحكاية، في كتاب " الاسم العربي الجريح"، ط.1، دار العودة، بيروت، 1980، ص.153-183.
- عباس الجراري، حكايات من الفلكلور المغربي، مجلة المناهل، ع.5، س.3، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباط، مارس 1976، ص.370-376.
-عبد الله بن شقرون، ما قيمة القصة الشعبية المغربية، هل الخرافة من الأدب؟ مجلة الإذاعة الوطنية، ع.14، س.2/1959.
- عائشة بلعربي، صورة الطفل في الحكاية الشعبية، أعمال ندوة التربية والتغيير الاجتماعي المنعقدة بالمدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس من 28 ماي إلى 2 يونيو 1979، منشورات جامعة محمد الخامس، الرباط ص.86
-محمد الفاسي، الخرافات في الأدب الشعبي، ضمن بحث "نظرة عن الأدب الشعبي بالمغرب، مجلة البينات، ع.4، س.1، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية، الرباط، غشت 1962، ص8-9
- مصطفى يعلي، القصص الشعبي بالمغرب، دراسة مورفولوجية، رسالة لنيل دكتوراه الدولة في الأدب العربي الحديث من كلية اداب الرباط، السنة الجامعية، 1992-1993
- مصطفى يعلى، ظاهرة المحلية في الفن القصصي بالمغرب من أوائل الأربعينيات إلى نهاية الستينيات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بفاس، السنة الجامعية 1983-1984، تحت إشراف الدكتور إبراهيم السولامي.
- الزمخشري، أساس البلاغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.ط.3. ج 1910.
- شحاذة خوري، 2012، أوراق ثقافية، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق.
- علي كريت، موسوعة التراث الشعبي، دار الحكمة (الجزائر)، الجزء الأول 2007.
- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر.ج.3. د.ت بيروت.
- سعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق.
- أحمد زياد محبك، من التراث الشعبي، الطبعة الأولى 1426ه/2005م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- مالكة العاصمي، أنواع الأدب الشعبي بالمغرب، مجلة المناهل، عدد 30، س.11، وزارة الشؤون الثقافية، الرباط، يوليو 1984، ص.360-366.
- عبد القادر زمامة، الأمثال المغربية، دراسات ونصوص، إعداد وتقديم السعيد بنفرحي، 2010، الطبعة الأولى، المطبعة، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط.
- عبد السلام هارون، التراث العربي، دار المعارف. سلسلة كتابه. 30 القاهرة (ج.ت).
- د. أحمد مرسي، مقدمة الفلكلور، ص.5، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1976.
- مجموعة كتاب، 2008، مقدمة في دراسة التراث الشعبي، القاهرة.
- محمد الجوهري، علم الفولكلور، القاهرة 1977.
- د. أحمد مرسي، مقدمة الفلكلور، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة 1976.
- عباس الجراري، في الإبداع الشعبي، مطبعة المعارف الجديدة/ الرباط، ط1988/1.
- إدريس كرم، "الأدب الشعبي المغربي" الأدوار والعلاقات في ظل العصرنة، منشورات اتحاد كتاب
المغرب، ط1.
- عبد الحميد يونس، التراث الشعبي، سلسلة كتابك، دار المعارف، 1979.
- حسين عبد الحميد أحمد رشلان، الفولكلور والفنون الشعبية، مكتبة مدبولي، سنة 1989بتصرف
- ابن سيدة: المحكم والمحيط العظم في اللغة، ت.د. عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ، ط 2، ج3.
- المنجد الأبجدي، دار المشرق، بيروت، ط 5، (د.ت).
- نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار مكتبة غريب للطباعة، القاهرة، ط 1، 1991م.
- عمر أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الأول، عالم الكتاب.
- عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط.1،1968م.
- عبد الرحمن الساريسي، الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني، المؤسسة العالمية للدراسات والنشر، ط 1، 1986م.
- عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، الجزائر، (د.ط) 2007م.
- صفوة كمال، الحكاية الشعبية الكويتية، ط 1، 1986.
- محمود تيمور، فن قصص دراسات في القصة والمسرح، المطبعة اللغوية.
- مصطفى الجوزو، الأساطير العربية وخرافاته.
.
مصطفى يعلى، ظاهرة المحلية في الفن القصصي بالمغرب من أوائل الأربعينيات إلى نهاية الستينيات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب بفاس، السنة الجامعية 1983-1984، تحت إشراف الدكتور إبراهيم السولامي.
- الأستاذ الدكتور عبد الرحمان عبد الهاشمي، أدب الأطفال، فلسفته.أنواعه. تدريسه.
- فردريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها، ترجمة: د.نبيلة إبراهيم، دار غريب للطباعة، القاهرة، (دط)، (دت).
- مصطفى يعلى، القصص الشعبـي دراسة مورفولوجيا، شركة النشر والتوزيع المـدارس، الدار البيضاء، ط. 1، (1999).
- سعيدي محمد، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق.
- بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية 1990.
- جون سكوت، علم الاجتماع، المفاهيم الأساسية، طبعة الأولى بيروت 2009.
- مجمع اللغة العربية، معجم علم النفس والتربية، الجزء الأول، الهيأة العامة لشئون المطابع الأميرية،1984.
- علي بن محمد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، بيروت، 1985.
- عز الدين إسماعيل، التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، ط4، د.ت.
- أبو أديب كمال، جدلية الخفاء والتجلي، دار العلم للملايين، بيروت، طبعة 3، ص. 20.
- اليافي نعيم، الصورة في القصيدة العربية المعاصرة، القاهرة، ص. 2.
- ماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، تحاد كتاب العرب، سوريا، ط. 1، 2011م.
- الدكتور أحمد أوزي، الطفل والمجتمع.
- مصطفى الورياغلي، الصورة الروائية.
- كيليطو، الأدب والغرابة.
- بروب، مورفولوجيا الخرافة.
- د. محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري إستراتيجية التناص، دار السنوبر ط1 1985.
- جوزيف كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ترجمة: د. جمال حضري، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف.
- هامون، سيميولوجية الشخصية.
- لوكاش جورج، دراسات في الواقعية، ترجمة د فايق يلوز، وزارة الثقافة، دمشق.
- يسري شاكر، أجمل حكايات الفلكلور المغربي، ص.4.
- عماد بن صوله، الأصول والبدايات في السرديات الشفوية، الموقع الإلكتروني: الثقافة الشعبية polkulturebh.
- كورتيس، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، ص 208، ترجمة د. جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، السنة 2007.
- غريماس، تقديم لكتاب جوزيف كورتيس مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية.
- المراجع والمصادر بغير العربية
- The American Heritage R Dictionary of the English Language،- Fourth Edition copyright C2000 by Houghton Mifflin company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin company. All rights reserved.
- J. Piaget، La naissance de l’intelligence p.158
، - Charles. Peirce écrits sur le signe. Seuil 1978.p140-141
- Elisséeff (N): Thèmes et motifs des Mille et une Nuits, I.F.D Beyrouth, 1949.
- P. Bowles.whithout stopping: an autobiography/ New york. The Ecco Press ; 1972. Trad. Française. Mémoire d’un nomade. Paris. Quai Voltaire 1989.
– Robert Briatte: Paul Bowles, Collection Biographique, Paris. Ed. Plon ; 1989.
- Black Sparrow Press, Santa Barbara. CA. 1985: The Jealous Lover.
Tambouctou Books. CA. 1985.
- Le petit robert.
– Flament. C. 447: 1989.
– P. Mannoni, 1989.
– G. Thines, et, A. Lempreur, 1975.
– Thines et Lempreur, 1975.
– E.durkeheim: " forme élémentaire de la vie religieuse" puf. Paris 1968.
– Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulations. The Precession of Simulacra.
– La sociologie de A à Z. Frédéric lebaron. paris.2009.p 103.
– Jodolet, D. 1984.
– Langenfeld 2005.
– N. Sillamy ,1980.
– Moscovici, " son image et son publique" édition puf, 1961.
– Yves Alpe, 2005.
– Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale dans Bougnoux, D.
Sciences de l’information,
- Larousse, Paris, 1993, p. 12.
- Gremas, sémiotique structurale.6
- G. Courtes, Introduction à la sémiotique narrative et discursive.
- Analyse sémiotique du texte, p.15, Groupe d entre vernes.
– Le roman à thèse ou L’autorité fictive puf 1983.
الهوامش
(1) ـ صديق القنوجي، أبجد العلوم ج، الطبعة الأولى ص 392
(2) ـ سورة الذاريات، الآية: 34.
(3) ـ ابن منظور لسان العرب مادة (سوم)
(4) - The American Heritage R Dictionary of the English Language، Fourth Edition copyright C2000 by Houghton Mifflin company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin company. All rights reserved.
(5) ـ إبراهيم صدق، السيميائية اتجاهات وأبعاد، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيمياء والنص الأدبي، ص 77.
(6) ـ أنور المرتجى، سيميائية النص الأدبي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط1 1987م ص 3.
(7) ـ د. بشير كاوريربت، مناهج النقد الأدبي المعاصر 139
(8) ـ بيار غيرو، السيمياء ترجمة: أنطون أبن زيد ط 1، 1984م، منشورات عويدات، بيروت لبنان ص 50.
(9) ـ فرديناند دي سوسير: محاضرات في اللسانيات العامة، ص 33.
(10) - J. Piaget، La naissance de l’intelligence p.158
(11) ـ فرديناند دي سوسير، محاضرات في اللسانيات العامة ص 87
(12) ـ ميشال أريفية وجون كلود جيرو، السيميائية أصولها وقواعدها، رجمة رشيد بن مالـك مراجعة وتقديم عز الديـن المناصرة ص 28، 29
(13) ـ فرديناند دي سوسير، محاضرات في اللسانيات العامة
، Charles. Peirce écrits sur le signe. Seuil 1978.p140-141 (14)
(15) ـ محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، ص. 8.
(16) ـ محمد السرغيني، محاضرات في السيميولوجيا، ص. 8.
(17) ـ بسام بركة: الإشارة - الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية. ص 50، مجلة الفكر العربي المعاصر، عدد 30 -31.
(18) - Charles.S. Peirce، écrits sur le signe. Seuil 1978.p140-141
- J. Piaget: la formation du Symbole chez l'enfant, p.159 (19)
(20) - Prieto. Voir Galisson R et Costa D: Dictionnaire de didactique de langue Hachette, 1976.