أقلام فكرية
حيدر عبد السادة: فلسفة اللغة.. بؤرة التفلسف المعاصر
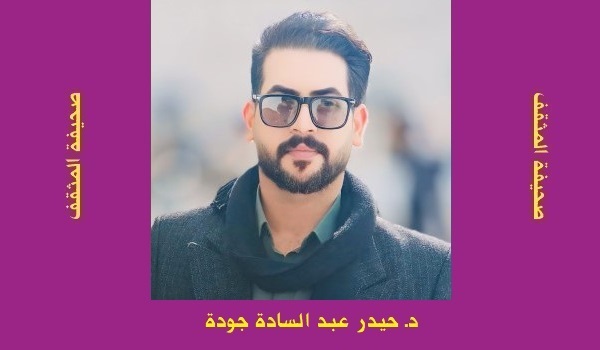
يصف أحد الباحثين، نقلاً عن أحد المؤرخين الغربين، القرن العشرين بـ الطويل، كونه قد شهد حربين كونيتين مدمرتين، وشهد أيضاً أهم الانقلابات الفكرية في الفن والعلم، ونالت الفلسفة فيه أيضاً نصيبها، إذ أتت فلسفة اللغة التي عدت ثورة البحث عن المعنى. وبالتالي توجهت الفلسفة في القرن العشرين نحو اللغة، بل أصبحت فلسفة لغوية. ويشير (عبد الرحمن بدوي) إلى إن أكثر مجالات الدراسة في العلوم الإنسانية نشاطاً في هذه الأعوام الأخيرة علم اللسان العام.
وتعد فلسفة اللغة من الموضوعات الأساسية والمهمة في العصر الحديث، وإلى جانب أهميتها في حقول المعرفة المعاصرة، فلها جانب آخر يترتب على تناولها لأهم انجازات الجنس البشري، أقصد اللغة ذاتها. حيث تعد اللغة من أعظم منجزات الجنس البشري، لأنها تمس فروعاً مختلفة من المعرفة، وتؤدي طوائف عديدة من الأغراض، فهي عمل فسيولوجي لأنها تدفع عدداً من أعضاء الجسم إلى العمل، وهي فعل إنساني لأنها تتطلب نشاطاً إرادياً من العقل، وهي ظاهرة اجتماعية لأنها وسيلة اتصال بين البشر، وهي أخيراً حقيقة تاريخية ثابتة من عصور متباعدة في القدم. واللغة بمثابة البعد الحقيقي الذي تتحرك فيه الحياة الإنسانية، فحيثما تكن اللغة فثمة تجد الإنسانية. فاللغة وجدت بين الناس وللناس، والمجتمع البشري وجوده محال بدونها، فنحن نراها في كل مجتمع، وتستعمل في كل مجال، ولا غنى عنها كوسيلة اتصال أساسية. أو كما يقول بدوي بأنها سبيل الاتصال بين الذوات الوجودية.
ويجب أن نفرق في البدء ما بين اللغة وفلسفة اللغة، فتعرف اللغة على أنها نسق من الإشارات والرموز، تشكل أداة في المعرفة، وفي حفظ واستعادة منتجات الثقافة الروحية والبشرية. ويعرف ابن جني اللغة على أنها أصوات يعبر كل قوم عن أغراضهم. أما فلسفة اللغة، فهي لا تهتم باللغة بشكل رئيسي، بل إنها حديث فلسفي عن اللغة، أو تفلسف حول اللغة. فضلاً عن ذلك يجب أن نفرق ما بين فلسفة اللغة والفلسفة اللغوية، إذ أن الفلسفة اللغوية تكون مرادفة لمصطلح التحليل اللغوي، ولا تقدم سوى منهج لحل مشكلات فلسفية تواجه اللغة العادية، في حين إن فلسفة اللغة تمثل محاولة لتقديم وصف فلسفي لملامح عامة في اللغة من قبيل الإشارة والمعنى والصدق... إلخ. مضافاً إلى أن الفلسفة اللغوية تدرس الميزات العامة لبنية اللغات طبيعياً، وتاريخياً، والذي يسمى بـ (الفيلولوجيا)، من هنا تعالج فلسفة اللغة مسائل تعد كلية بالنسبة إلى جميع اللغات في حين أن علم اللغة يختص بلغة دون أخرى، ومن ثم ففلسفة اللغة تمثل حديث فلسفي عن اللغة وليست دراسة اللغة.
ويطرح (أريك غريلو) مستويين لفهم فلسفة اللغة، أحدهما بالمعنى الواسع ولآخر بالمعنى الضيق للمفهوم، أما المفهوم الواسع لفلسفة اللغة فيشير إلى كل فلسفة تعرضت في أثناء تطورها إلى مسألة اللغة وتناولتها بشكل منفصل، وبهذا المعنى تتحدد فلسفة اللغة مع أفلاطون... أما بالمعنى الضيق للمفهوم فيشير إلى تيار رئيسي في الفلسفة المعاصرة، مهيمن في العالم الأنجلوسكسوني. وإلى ذلك يذهب (الزواوي بغورة) حين يقرر وجود تعريفين لفلسفة اللغة، أحدهما تقليدي أو عام، والآخر حديث أو خاص، أما التعريف العام فهو الذي يرى في فلسفة اللغة مختلف الآراء التي قيلت في طبيعة اللغة، قبل ظهور الأبحاث اللسانية والمنطقية، والتأويلية، أو قبل ظهور الدراسات المنطقية والرياضية والدراسات الوضعية للغة. أما التعريف الآخر وهو الحديث أو الخاص فيشير إلى أنه لم تصبح اللغة موضوعاً مركزياً في الفلسفة الحديثة والمعاصرة إلا بعد تطورات أساسية أهمها ما حصل على مستوى دراسة اللغة كعلم وثانياً ظهور المنطق الرياضي والتحليلات المنطقية والرياضية والممارسات التأويلية الناجمة عن التفسير القديم.
وتذهب الدراسات الفلسفية اللغوية إلى أن اللغة أصبحت موضوع الفلسفة منذ نهاية الفلسفة الحديثة وبداية الفلسفة المعاصرة، وتحديداً منذ (فريدريك نيتشه) والمدرسة التحليلية الانجليزية وما تبعها من اتجاهات وتيارات في الفلسفة الانجلوسكسونية. وتعد اللغة في الفترة المعاصرة بؤرة التفلسف، أي أصبح التفلسف لعبة لغوية لكونها المنعرج الخطير الذي خلص الإنسان من الالتباسات الثيولوجية والتقنية لكونها المنقذ الوحيد للإنسان من تعسف الآلة. وهي مبحث فلسفي حديث، ظهر في بداية القرن العشرين، إلا أن هناك من يعتقد أن فلسفة اللغة قديمة قدم الفلسفة، وترجع إلى مختلف الآراء الفلسفية التي قيلت حول طبيعة اللغة وعلاقتها بالفكر والواقع والتي نقرؤها في نصوص أفلاطون وأرسطو والفارابي و ديكارت ولوك ونيتشه فتجنشتاين وغدامير... وغيره، وبهذا المعنى تعني: مختلف آراء الفلاسفة في اللغة.ولكن هذا الرأي يجعل من فلسفة اللغة عنواناً عائماً ومبثوثاً في جميع تاريخ الفلسفة، أي لا يمكن تناوله بالمعنى الخاص، بل لا يمكن أن يكون له موضوعاً مستقلاً عن المنظومات الفلسفية الأخرى، والأرجح أن فلسفة اللغة تبلورت –مع وجود إرهاصات لها- في مطلع القرن العشرين لتؤسس منظومة فلسفية ومعرفية مستقلة على يد التيارات الفكرية التي انبجست في مطلع القرن العشرين. وبرزت هذه التيارات في فجر القرن العشرين المنصرم من خلال انقلاب في النظر أطلق عليه (المنعطف اللغوي)، والذي كان مطلوباً منه المساهمة في التجديد العميق في مفهوم الفلسفة وفي ممارستها في آن معاً. وأول من استعمل عبارة (المنعطف اللغوي) هو الفيلسوف الوضعي الجديد (غوستاف برغمان) عام 1953م، ثم انتشرت العبارة وذاعت، عندما استعملها الفيلسوف الأمريكي (ريتشارد رورتي)، عنواناً لمجموع النصوص التي جمعها وكت لها مقدمة ونشرت عام 1967م.
ويذهب (أريك غريلو) إلى أن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوفر ليتحقق المنعطف المنشود، وهي:
الشرط الأول: أن يطرح سؤال اللغة والدلالة مجدداً على نحو جذري.
الشرط الثاني: أن يطرح في عبارات جديدة أو حسب متطلبات جديدة.
الشرط الثالث: أن يرتدي طابع الإلحاح المحض بحيث يحشد مفكرين من آفاق مختلفة حول المشكلة نفسها.
وهذه الشروط الثلاث، بحسب غريلو، اجتمعت في منعطف القرن العشرين، وفي أواخر القرن التاسع عشر وقعت سلسلة من التغيرات في حقل المعرفة، بشرت بإعادة تشكيله.
ويشير الباحثين إلى أن (كروتشه) أو من أسس لمصطلح فلسفة اللغة، وإلى هذا يذهب الزواوي بغورة حين يقول: وفي تقديرنا، فإن أول فيلسوف استعمل مصطلح فلسفة اللغة هو الفيلسوف الإيطالي كروتشه. مع ذلك فإن تراكم النقاشات حول مسألة اللغة جعل المعنى العام لها قلق ومتوتر نحتاج فيه إلى مساءلة جادة لتصبح بذاتها ولذاتها منعطفاً شديد الأهمية في الصيرورة الفلسفية انطلاقاً من التأثير الذي ضخته الفلسفة التحليلية. ولعله من المفارقة-كما يقول بغورة- أن يكون هذا الفيلسوف الهيغلي هو أول من طرح هذا المصطلح، إذا علمنا أن الفلسفة اللغوية كما أسسها مور ورسل فتجنشتاين كانت محاولة للقضاء على الفلسفة عموماً، والفلسفة الهيغلية على وجه الخصوص.
***
د. حيدر عبد السادة جودة







