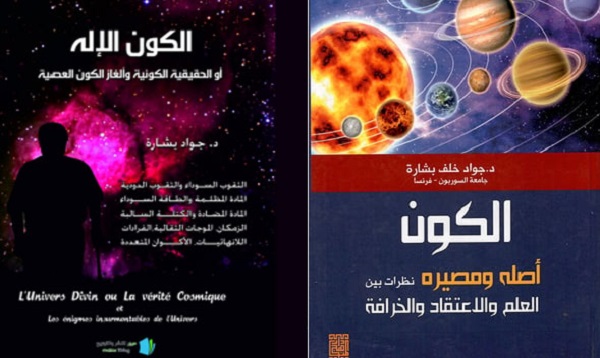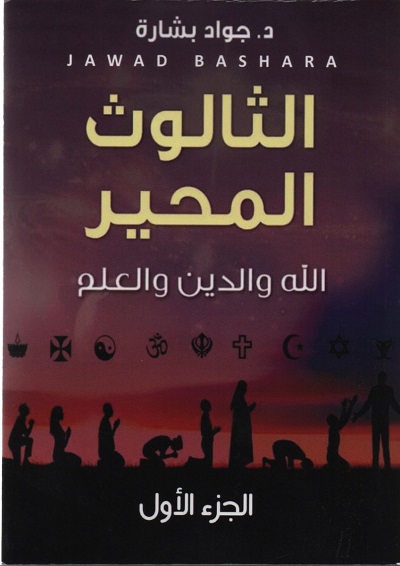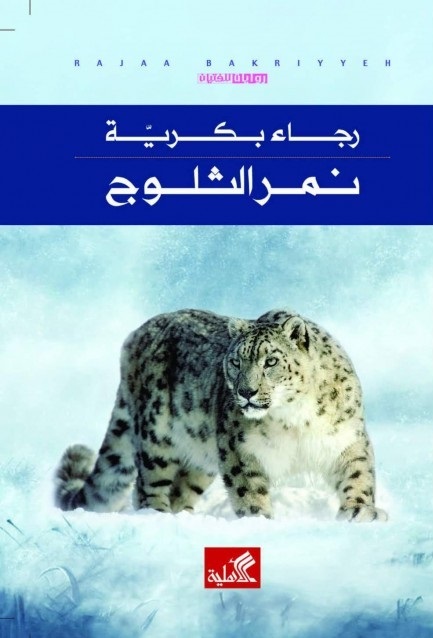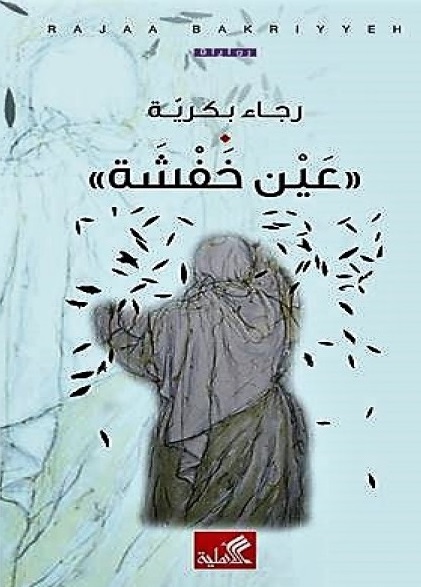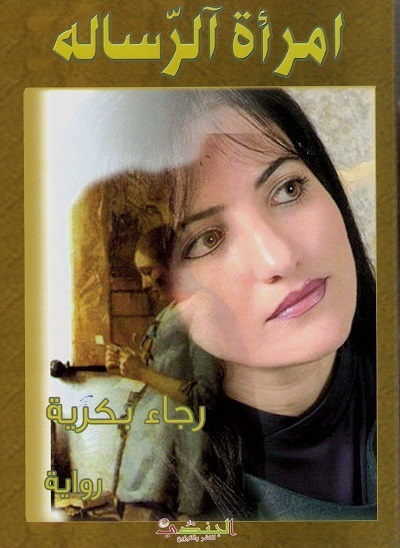غزاي درع الطائي:
- تاريخنا تاريخ حروب، فما انطفأت نار حرب في مكان إلا وشبَّت في مكان آخر
- الشاعر هو أول المتأثرين سلبا أو ايجابا بتبدل السلطة
- اختلطت الأوراق وكتب ما يُسمّى بالشعر من لا يعرف الفرق بين الفاعل والمفعول
***
في حرب رمضان ١٩٧٣ كنا نتابع الأخبار من خلال الصحف الصادرة في حينها وكان الإعلام الحكومي العربي يرسم انتصارات أسطورية للجيوش العربية على جيش إسرائيل حتى تخيلنا أن الجيوش العربية ستحتفل بالنصر في تل أبيب والقدس لكن الإعلام نفسه عاد وأخبرنا أن اليهود تمكنوا من إحداث ثغرة الدفرسوار وتطويق الجيش الثالث المصري وغطت سمعة الجنرال صاحب الثغرة على ما صنع الإعلام من بطولات لقادة عسكريين مثل الشاذلي والجمسي وضاع كل هذا في محادثات الكيلو (101) لكن ما علق في الذاكرة مما نشرته الصحف وقتذاك هو قصيدة حماسية لشاعر شاب اسمه غزاي درع الطائي لفت بها أنظار كل متابعي الأدب متوقعين ولادة شاعر سيكون ذا شأن في سوح الشعر وبمرور الزمن كانت قصائده تتوالد واسمه يكبر وبعد أن ارتدى البزة العسكرية وتعالت نبرة الشموخ في شعره عده بعض النقاد في مصاف الشعراء الفرسان وبعد خمسين عاما بالتمام والكمال ها نحن ندنو من حصون غزاي درع الطائي محاورين عن منجزه على مدار هذه السنين
- هل خلقت محاربا؟.
* لا، أنا أعشق الهندسة، ودرستها في كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة بغداد (الجامعة التكنولوجية حاليا)، وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات، والسنوات الخمس كانت (1970 1975)، تلك كانت رغبتي، أما رغبة والدي (رحمة الله تعالى عليه) فكانت أن أكون ضابطا، وتحقيقا لرغبة والدي ورغبتي معا أخترت أن أكون ضابطا مهندسا في القوة الجوية والدفاع الجوي.
* اشتهرت طي بالكرم لكن اسمك يدل على إعلان حرب -هل هناك سر؟.
* الكرم بوصفه صفة حميدة لا ينفرد وحده، بل يظل محتاجا إلى الشجاعة، والكرم والشجاعة يلتقيان ظهرا لظهر في عملة واحدة، إنهما وجها عُملة واحدة، والجود بالنفس أعلى غاية الجود، أفلا ترى أن تاريخنا تاريخ حروب، فما انطفأت نار حرب في مكان وزمان معينين إلا وشبَّت في مكان آخر وزمان آخر، ودواليب الحرب دائرة بشكل مستمر للأسف، هنا وهناك وفي أماكن متعددة، واليوم على سبيل المثال لا الحصر تشتعل حرب دولية بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عام، وفي الوقت ذاته يشتعل نزاع داخلي في السودان منذ أشهر عدة، وهناك نزاعات في أماكن أخرى وتهديدات في أماكن أخرى.
- ماذا أسررت نهر (خريسان) في صباك وهل استرجعت سرك منه في كهولتك؟.
* ليس (خريسان) نهرا، لا، إنه صديق صدوق، وجليس أنيس، وهو مستودع الأسرار التي لا يمكن تهريبها أو تسريبها، بل هو المؤتمن على الأسرار، وما أودعت مجراه من أسرار حرصت على أن تبقى كما هي، من غير تحريف أو تزييف، ومن غير استعادة، وإذا قرأت نصي الشعري (الفتاة الخريسانية)، فستعرف الكثير، فاقرأ:
(لم يكنِ ارتفاعُ الماءِ في نهرِ خريسانَ
يزيدُ على الخمسينَ سنتيمتراً حين غرقتُ ،
نَعَمْ غرقتُ
كنتُ يومئذٍ واقفاً على ضفةِ النَّهرِ
في انتظارِ صديقٍ
وكانت عيناي تتابعانِ سبعَ بطّاتٍ وديعاتٍ
يسبحنَ في النَّهرِ بمتعةٍ وارتياحٍ
نَعَمْ ...
غرقتُ في حبِّ فتاةٍ خريسانيةٍ
كانتْ تسيرُ بمحاذاةِ النَّهرِ
بصحبةِ سبعٍ مِنْ صديقاتِها
في أمسيةٍ ربيعيةٍ فريدةٍ،
كانتْ ترتدي قميصاً أخضرَ
وتحملُ في يدِها وردةً حمراءْ
وتُعلِّقُ على كتفِها حقيبةً صفراءْ
قلتُ لها:
ليس في الدُّنيا أجملُ مِنْ بعقوبةْ
قالتْ: أدري
فليقلِ الشُّعراءُ في وصفِ جَمالِها
ما يعبِّرُ عن افتِتانِهِمْ
*
بعدَها
أخذ النّاسُ يشاهدونني كلَّ مساءٍ
هناكَ على ضفةِ خريسانْ
معلِّلاً نفسي برؤيةِ تلكَ الخريسانيَّةِ الفاتنةْ
*
بعدَ سبعِ سنواتٍ
صارتْ تلكَ الفتاةُ الخريستانيةُ
زوجتي) .
لماذا تخاف الخريف؟.
* لا أخاف الخريف، وقبولي به أمر محتوم، فهو فصل متكرر كل عام، ولا يمكن محوه، ولكنني أعلل النفس بأن الخريف ممر إلى الربيع، والربيع حبيب الجميع.
* مرة هي لوعة الفقد.. كيف وصفتها وانت تفقد فلذة كبدك؟
* استُشهد ولدي الشَّهيدِ معد (رحمَهُ اللهُ) برصاصِ القوّاتِ الأميركيةِ في بعقوبة في 7/4/2004 وكان طالباً في المرحلةِ الرّابعةِ كلية طب الكندي / جامعة بغداد، وقد كتبت عنه شعرا كثيرا، وصورته حاضرة في روحي أبدا، ومما كتبته عنه:
فارغٌ قلبي كعودٍ مِنْ قصبْ
منذُ أنْ ودَّعَ (مَعْدٌ) وذهبْ
*
فارغٌ نهري ووقتي عبثٌ
لم يعدْ يلمعُ في عيني الذَّهبْ
*
عَجَبٌ موتُكَ يا (مَعْدُ) عَجَبْ
وبقائي دونما موتٍ عَجَبْ
*
نُوَبُ الأيّامِ لم أذهبْ لها
فلماذا عبرتْ نحوي النُّوَبْ
*
موتُكَ الفاجعُ أحنى قامتي
غيرَ أنَّ النخلَ في جسمي انتصَبْ
*
لكَ ربٌّ أنتَ في جنَّتِهِ
ولهذا البلدِ المطعونِ ربْ
- متى يكون الشاعر فارسا؟ وكيف يكتب الفارس؟
* يكون الشاعر فارسا عندما يمتلك صفات الفرسان المعروفة عند العرب من شرف ونُبُل وشجاعة وكرم وأمانة وصدق وخُلُق ومروءة وحفظ العهد والوفاء وغيرها من القيم الأصيلة، ويعبر عن هذه الصفات في شعره، ويحث عليها ويدعو إليها ويشيعها، ويعدُّها رسالة يتحمل مسؤولية نقلها من السلف إلى الخلف.
متى سمعت صوت الشاعر بين جوانحك؟.
* ولدت في عام 1951م في قرية العكر التي تبعد بمسافة عشرين كيلومترا عن بعقوبة، حيث الأشجار والأنهار والأزهار والعصافير والحمام والدُّرّاج، وحيث المضائف والأعمام والأخوال والضيوف المتعاقبون.
القادم إلى العكر لا بد أن يمر بتلول الكريستال، وهي تلول يعود تاريخها إلى عصر دويلات المدن، فيها آثار الغابرين وعلاماتهم الفارقة، وفيها قطع من الذهب تلمع تحت الشمس بعد نزول المطر وانقشاع الغيوم.
أنهيت دراستي الابتدائية في مدرسة القرية واسمها (مدرسة المجد الابتدائية للبنين)، وكنت الأول على المدرسة في امتحانات البكالوريا للصف السادس الابتدائي، أما دراستي الثانوية فقضيتها في بعقوبة (1964 1970)، وفي عام 1970 انتقلت (دراسيا) إلى بغداد، إذ جرى قبولي في كلية الهندسة التكنولوجية بجامعة بغداد.
بدأت بالاهتمام بالقراءة والكتابة وبالأدب بشكل عام وبالشعر بشكل خاص منذ فترة الدراسة المتوسطة، ففي تلك الفترة كنت غاويا لقراءة الكتب والصحف والمجلات، وقد كان لمدرسي في مرحلة الدراسة الإعدادية الدكتور (حاليا) السيد عبد الحليم المدني الفضل في توجيهي وفي الأخذ بيدي في دروب القراءة والكتابة، وفي مرحلة الدراسة الجامعية كنت أشارك بشكل مستمر في المهرجانات الشعرية التي كانت تقام في الكلية وفي الجامعة، وكانت تلك الفترة عاجة بالشعراء الموهوبين من أمثال خزعل الماجدي ورعد عبدالقادر ومرشد الزبيدي وساجدة الموسوي وصاحب الشاهر وريسان الخزعلي وفاضل عزيز فرمان وغيرهم.
- هل كتبت الغزل ولمن كتبت؟.
* لا شك في هذا، بل كتبت الكثير من الغزل، والغزل غرض قديم وأصيل في الشعر العربي منذ نشأته، والقلوب خُلقت للحب في الأساس كما أرى، والحياة من دون الحب أرض جرداء قاحلة، وشعر الغزل مطلوب من الجميع، وهذا بعض من شعري الذي قلته في غرض الغزل:
قولي لأهلِكِ: مجنونٌ ويتبعُني
ونحو هاويةٍ للحبِّ يدفعُني
*
قولي لهم: يسرِقُ التُّفّاحَ مِنْ طبقي
ويقطفُ التّينَ والرُّمّانَ مِنْ فَنَنِي
*
ويُشعلُ النّارَ في مائي وفي حطبي
ويزرعُ الآسَ والرَّيحانَ في زمني
*
ومثلما يقرأُ الأشعارَ يقرؤني
ومثلَ ألفِيَّةٍ في النَّحوِ يشرحُني
*
وحيثما كانَ أرآهُ وأسمعُهُ
وحيثما كنتُ يرآني ويسمعُني
*
يضرُّني كلُّ ما في الأرضِ مِنْ بَشَرٍ
ووحدّهُ بين كلِّ الخلقِ ينفعُني
*
نفسي إلى نفسِهِ تمشي موَلَّهةً
كأنَّهُ وهو في مسرى دمي وطني
- ماذا تعني لك الأنثى في الشعر؟.
* أنا لا أقول: الأنثى، بل أقول: المرأة، والمرأة، هي:
هِيَ الحياةُ وليستْ نِصْفَ ما فيها
في كفِّها خابِطُ الدُّنيا وصافيها
*
منفيَّةً كانتِ الدُّنيا وضائعةً
وهيَ التي أخرَجَتْها مِنْ منافيها
*
يسّاقطُ التِّينُ والزَّيتونُ إنْ رَضِيَتْ
وإنْ جَفَتْنا فويلٌ مِنْ تجافيها
* ماذا تعني لك العروبة.. أهي إرث أم انتماء؟.
* العروبة: إرث وانتماء معا، بل هي أكثر من الإرث ومن الإنتماء، إنها الروح.
- هل مجدت أحدا في شعرك؟.
* نعم، مجَّدت العراق الحبيب وأهله الكرام وبطولاتهم وشهامتهم وجودهم وفاعليتهم الراقية، قديما وحديثا.
- قرأنا في الأدب أن الشاعر لا يعلق على صليب جهة ما أو سلطة لكننا شاهدنا شعراء بارزين صلبوا على غير شاعريتهم فهل عانيت من هذا؟.
* لم أكتب إلا ما يشرِّفني ويشرِّف العراق وأهله الأماجد، وهذا عهد التزمت به منذ أول نص كتبته ونشرته، أنا حر في كتابتي ولم أخضع لريح شرقية ولا غربية.
أيهما وقعت في حبها أولا.. المرأة أم القصيدة؟.
* المرأة سبقت القصيدة وفي الوقت نفسه فإن القصيدة سبقت المرأة، والتأويل لك.
- أين يجد غزاي نفسه أكثر.. في الشعر المقفى أم في الشعر الحر؟.
* ما يهمني دائما هو الشعر وليس شكل الشعر، ولقد كتبت القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، وكانت للتجربة الشعرية وللباعث على القول الشعري الأثر الكبير في تحديد الشكل الشعري للنص، ولقد كان كتابي الشعري (خبز عراقي ساخن) خاصا بشعري العمودي وقد ضم 1500 بيت عمودي، وفي كل الأحوال: أنا أبحث عن الشعر، لا عن شكل الشعر، ولا أحكم على الشعر باعتباره شكلا أو استنادا إلى شكله، فالشعر ليس عنوانا فقط أو هيكلا وحسب أو قامة لا غير، الشعر أكبر من شكله وأوسع من مضمونه وأعمق من موسيقاه، وأكثر ارتفاعا من أي مكوِّن مفترض من مكوِّناته، الشعر لا يمكن تقطيعه مثل ذبيحة، أو فصل أجزائه مثل محرك سيارة، أو تقسيمه إلى رأس وجذع وأطراف مثل جسم الإنسان، الشعر كلٌّ متكامل ومتآلف ومجموع ومشترك ومشتبك ومتداخل ومتمازج، ولا مجال فيه للتقطيع أو الفصل أو التقسيم، ولنا في الماء مثل، فالماء متكون من الأوكسجين والهيدروجين، ولكننا لا نرى الأوكسجين ولا نرى الهيدروجين بل نرى الماء، والماء هو غير الأوكسجين وغير الهيدروجين.
- تبدل الأنظمة هل يضير الشاعر؟.
* الشاعر هو أول المتأثرين سلبا أو ايجابا بتبدل السلطة، ولكن التاريخ يُعلمنا أن السلطات تريد أن يكون الشاعر (عاملا) عندها، يكتب ما يناسبها، فيما يريد الشاعر أن يتمتع بحرية القول الشعري، والصراع بين الشاعر والسلطة قديم ومستمر وسيستمر، وكم من الشعراء قد دخلوا السجون بسبب مواقفهم التي عبروا عنها شعرا، الشعر ليس عبدا للسلطة ولا خادما لها، الشعر سيد ولا يمكن أن يكون عبدا أو خادما لأحد، وإذا كان وأن اصبح الشعر عبدا أو خادما للسياسة في هذا الظرف أو ذاك، وفي هذا الزمن أو ذاك، وتحت تلك الذريعة أو تلك الحجة، فان ذلك إنما كان خطأ ارتكبه السياسيون بحق الشعر والشعراء وحماقة ارتكبها الشعراء بحق الشعر.
- لمن كتبت أول قصيدة؟.
* كانت أول قصيدة منشورة لي هي قصيدة (مطالعات في عودة سعيد بن جبير) وقد نشرتها جريدة الثورة التي كانت تصدر في ذلك الوقت في شباط 1973.
هل ترى أن من واجب المرأة أن تكون ملهمة فقط؟ أم أنك تقبلها شاعرة أيضا؟.
* المرأة ملهمة كبيرة للشاعر، وكم من شاعر كبير وقفت خلف شعره امرأة أحبها، هذا شأن متفق عليه، وكتابة الشعر لا تقتصر على الرجال دون النساء، لأنه أحاسيس وعواطف وهموم وتطلعات وآلام وآمال يشترك فيها الشاعر والشاعرة، ويشهد تاريخ الشعر العربي قديمه ووسيطه وحديثه على بروز شواعر عربيات على أعلى المستويات الإبداعية، مثلما يشهد على بروز شعراء عرب كبار.
- كان أبوك سيد قومه فهل شغلت مكانه أو تخليت عن إرثك العشائري؟.
* كان أبي رحمه الله تعالى شيخ الصوالح النعيرية الطائية، وأنا كنت من الذين تربوا في المضائف، وفي هذا أقول:
بَيْنَ الدِّلالِ كَبُرنا والفناجينِ
وَكَمْ أخذْنا دروساً في الدَّواوينِ
*
باللِّينِ نمضي إلى غاياتِنا أبداً
فأهلُنا علَّمونا الأخذَ باللِّينِ
*
الطِّينُ أصلُ جميعِ النّاسِ فاتَّعظوا
سبحانَ مَنْ خلقَ الإنسانَ مِنْ طينِ
- هل تقدم الشعر في العراق في هذه المرحلة أم تراجع؟.
* الشعر في العراق، بالرغم مما يحيط به، متألق، وضاجٌّ بالإبداع الراقي، ومتجدد، وفي العراق أكبر عدد من الشعراء الكبار، وهناك نقطة مهمة جدا لا يفوتني أن أذكرها هنا هي أن (الزبد الشعري) كثير كثير، ولكن هذا لا يمكث في الأرض، بل يذهب جفاءً.
في السنوات العشرين الماضية، اختلطت الأوراق وكتب ما يُسمّى بالشعر من لا يعرف الفرق بين الفاعل والمفعول ومن لا يعرف الفرق بين البحر والتفعيلة، ومن لا يملك أدنى مستوى من مستويات الموهبة والوعي الشعري، وأرى أن من أسباب هذه (الموجة الصاخبة) قصور النقد عن القيام بواجبه وسهولة النشر ورخص طبع الكتب وتعدد منافذ النشر والطبع التي كان من المفروض استغلالها لتحقيق نهضة شعرية وأدبية شاملة، وفي مقابل كل ذلك، هناك الشعراء المبدعون الذين قدموا وما زالوا يقدمون القصائد ذات الجودة العالية والجمال الأخّاذ .
- ما رأيك بنقاد اليوم؟ وكيف تقيم منجزهم؟.
* تتميز الحركة النقدية العراقية بأنها واسعة وأنها ذات مستويات متعددة، ومازال النقاد الكبار الذين عرفناهم وتعلمنا منهم يحتلون أماكنهم بجدارة، ولم يشاركهم في الجلوس على دكَّتهم المعتادة إلا نقاد جدد قليلون تميزوا بالمثابرة والفاعلية والجدة، وهناك النقد المُجامل الذي يمنح الألقاب الكبيرة من دون استحقاق، وهو مع الأسف كثير، أما النقد الأكاديمي فإنه اليوم حاضر بقوة، ويسعى إلى أن تكون أنواره قادرة على إضاءة عتمة النصوص والكتب، وإلى أن يكون مؤثرا وفاعلا ومتناغما مع كل جديد.
- هل يطربك صهيل الجياد؟.
* لصهيل الجياد معان عميقة تاريخيا وحاضرا، وهو رمز كبير وخالد، إنه يأخذني من يومي إلى ساحات التأمل والتفكر وليس إلى ساحات الطرب.
- ما رأيك بتعاقب الفصول؟ وهل تبغض خلاعة الخريف؟.
* تتعاقب الفصول لتعلن أن الزمان ماض كعادته من دون توقف، والأعمار تتقدم، والفصول تتقلب، والفصول عوالم مختلفة ولا يستحي فصل من فصل آخر، فلكلٍّ خصائصه، ولقد قلت عن الخريف:
(يبدو أنَّ الخريفَ لا يستحي
وإلا فكيفَ يُعرّي الأشجارْ؟
إذا كانَ الليلُ ستراً
فماذا عنِ النَّهارْ؟)).
- الموت ماذا يعني في شعر وشعور غزاي درع الطائي؟.
* أغلب مقالاتك التي قرأتها أقرب لقصيدة النثر.. هل الدربة أم أنك لا تجيد الكتابة في الشأن السياسي؟.
* لست كاتبا سياسيا، ولست معنيا بالكتابة في الشؤون السياسية، ولكني أكتب مقالات في شؤون حياتية متعددة، فيها آراء وتأملات للواقع المعاش وفيها شيء من الشعرية والتأمل الفكري، ومنذ سنتين وأنا أكتب المقالات في جريدة (الزمان) الغراء بطبعتَيها: بغداد ولندن، وأنا أتمتع بهذه الكتابة الخاصة، وهناك من القراء من تعجبهم هذه المقالات وهذا من دواعي سروري.
- هل كتبت شعرا عن الحسين وثورته؟.
* كتبت الكثير، وأنا حريص على أن تكون ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) حاضرة بقوة في شعري، ويمكنك أن تقرأ كتبي الشعرية: (خبز عراقي ساخن) و(وقت من رمل) و(ملح العراق أمانة في زادي)، لتجد قصائدي التي كتبتها وأهديتها إلى جدي الإمام الحسين (عليه السلام)، والكتابة الشعرية عن الإمام واجب وشرف، وآخر ما كتبته في هذا الصدد نشرته جريدة (الزمان) الغراء على صفحتها الأولى وذلك في 30 تموز الماضي، ومما كتبته عن الإمام الحسين (عليه السلام) هذه الأبيات:
نورٌ دماؤكَ يا حسينُ ونارُ
وجراحُكَ النِّسرينُ والنُّوّارُ
*
المجدُ حولَكَ حيثُ كنتَ وأينما
ويلفُّ دارةَ قاتليكَ غُبارُ
*
والضَّوءُ ثوبُكَ حيثُ لُحْتَ لناظرٍ
وثيابُ كلِّ الشّانئينَ القارُ
*
الأرضُ عاريةٌ وأنتَ إزارُها
أفعندَها غيرُ الحسينِ إزارُ
*
الأرضُ عاريةٌ وظلَّتْ هكذا
حتّى قُتلتَ وسالَ مِنْكَ دِثارُ
*
إنْ تَطْلُبِ الدُّنيا عِياراً ثابتاً
فدماكَ فوق فمِ الفراتِ عِيارُ
*
لا تلتفتْ للغادرينَ وغدرِهِمْ
هُمْ دورةٌ دارتْ وأنتَ مَدارُ
*
شتّانَ بين حسينِنا ويزيدِهِمْ
أفيستوي الأبرارُ والأشرارُ
*
شتّانَ بين حسينِنا ويزيدِهِمْ
هذا الفنارُ وذاك عارٌ .. عارُ
وإضافة إلى القصائد كتبت دراسة عن شعر الإمام الحسين (عليه السلام)، وكتبت مقالات متعددة تتحدث عن معاني استشهاد الإمام والدروس التي تطرحها للعرب وللمسلمين وللعالم كله.
- ماذا يعني لك العراق منذ التكوين وحتى اليوم؟.
* العراق نفَسي الذي يصعد وينزل وروحي وحياتي وأملي وألمي، والجاذبية التي تشدني، إنه:
أنا والرِّياحُ أهزُّها وتهزُّني
وأَغشُّها في اللَّعبِ حين تغشُّني
*
وأمدُّ طوقَ الصّابرينَ لغايتي
فلعلَّني أَجدُ النَّجاةَ وليتني
*
لا ينحني رأسي وحقِّيَ مشرقٌ
لا ينحني في الحقِّ رأسُ المؤمنِ
*
أَمّا العراقُ فنبضُهُ في خافقي
والجاذبيَّةُ كم إليهِ تشدُّني
*
قلبي عليهِ وضوءُ إخلاصي لهُ
ولهُ كياسةُ حالتي وتجنُّني
*
ليس المهمُّ سلامتي بل أنْ أرى
سِلماً يشعُّ على سلامةِ موطني
*
لا فرقَ عندي والعراقُ على فمي
إنْ قلتُ يوماً إنَّهُ أو إنَّني
*
فجميعُ ما قد خصَّهُ ويخصُّهُ
في كلِّ أبوابِ الحياةِ يخصُّني
*
بالحبِّ والعرقِ الشَّريفِ أَمدُّهُ
وبكلِّ أسبابِ الحضورِ يمدُّني
*
أّذللتُ نفسي في هواهُ تقرُّباً
وتحبُّباً وتعزُّزاً فأعزَّني
*
كم غلَّلوهُ وكسَّرَ الأغلالَ لم
يرضخْ ولم يكُ للعداةِ بمُذعنِ
*
أهلوهُ عاشوا إخوةً فتراهُمُ
أبداً معاً وترى الفقيرَ مع الغني
*
المُرجِفونَ جَنَوا عليهِ وردُّهُ:
ما عادَ صوتُ المُرجِفينَ يهمُّني
*
يا وَيْحَهُمْ هذا عراقٌ واحدٌ
رغمَ المكائدِ ظلَّ ملءَ الأعْيُنِ
*
الحبُّ ليس بهيِّنٍ وأقولُها:
حبُّ البلادِ المرُّ ليس بهيِّنِ
*
أرضُ العراقِ المستحيلةُ مَسكني
إمّا سكنتُ وإنْ دُفنتُ فمَدفني
*
أنا ما نسيتُكَ موطني يوماً فإنْ
دَنَتِ المنيَّةُ موطني لا تَنْسَني
*
الحبُّ ينشرُني وأنتَ تلمُّني
والشِّعرُ يخذلُني وأنتَ تُعزُّني
*
في مقلتيكَ تألُّقي وتحرُّقي
وعلى يديكَ تحطُّمي وتكوُّني
*
نحوَ اخضرارٍ مذهلٍ أرسلتني
ومع الكرامةِ والنَّقاءِ وَلدتني
*
أنتَ الضِّياءُ إذا ادلهمَّ الملتقى
والنُّورُ في المَخفيِّ أو في المُعلَنِ
*
أرجوكَ دعني في هواكَ مسافراً
أرجوكَ مكِّنّي على المُتَمَكِّنِ
*
دعني أَكُنْ جسراً على نهرِ الضَّنى
لأقولَ : اعبُرْ نحوَ خيرٍ بَيِّنِ
*
لا تحزَنَنْ أبداً فشمسُكَ أشرقتْ
لا تحزَنَنْ فخطاكً بينَ السَّوسنِ
*
ولسوف يجعلُكَ الحفيظُ المُرتجى
عن كلِّ سيفٍ غادرٍ في مَأْمَنِ
هل مازالت ديالى مدينة البرتقال؟.
* ديالى تعني الحب والسلام والكرم والجود وكل المعاني العالية، والبرتقال رمز لها ولأرضها المعطاء، ولكن مما يؤسف له أن بساتين البرتقال تعرضت إلى ما هو غير محمود، فقد جرى تجريف الكثير منها وتحولت إلى أحياء سكنية، لأسباب مختلفة، منها الجفاف وقلة المياه، ولكن الأمل كبير بعودة هذه البساتين إلى سابق عهدها حال انتظام جريان الماء في نهرَي ديالى وخريسان وفروعهما، فالأرض لا تنتج البرتقال من دون الماء.
- متى يبكي غزاي درع الطائي؟.
* أنا أبكي مع نفسي، ولا أحب أن يرى دموعي الآخرون، خاصة من يثقون بقدرتي على التحمُّل، وينظرون إليَّ بعين المحبة والود، أما ما يحملني على البكاء فهو العراق وأحواله وشهداؤه.
لمن ولاء الشاعر؟.
* للعراق الحبيب أولا، ولأهل العراق الكرام، وللقيم والمبادئ العالية التي تربيت عليها وربَّيت أبنائي وبناتي عليها، ونشرتها في أشعاري.
- وأخيرا ماذا بقي مما لم تبح لي به؟.
* لم يبق سوى أن أتوجه بالشكر لك أيها العزيز الأستاذ راضي المترفي، وأنا سعيد بإطلالتك الحوارية هذه معي، مع خالص المودة والتقدير.
- كانت رحلة ممتعة امتدت علي مسار خمسين عام على ضفاف القوافي وبين بيوت الشعر والذكريات الحلوة والمرة وكان الرجل ذا ادب جم وخلق جميل وسعة صدر تريح الجليس وقبول بما طرحت عليه من اسئلة .. امتناني وتقديري للشاعر الكبير غزاي درع الطائي .
***
حوار: راضي المترفي


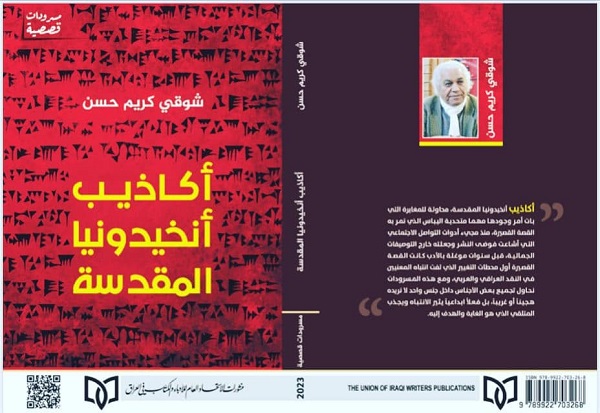
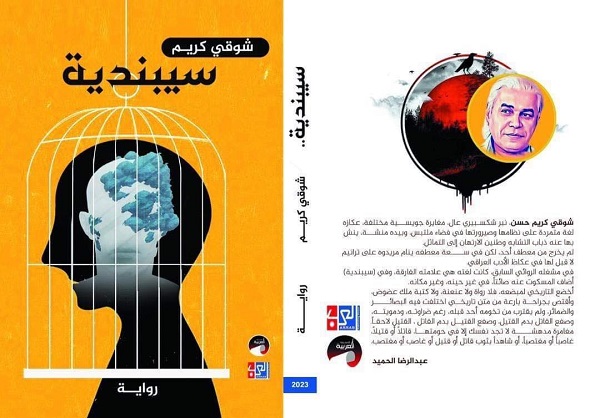







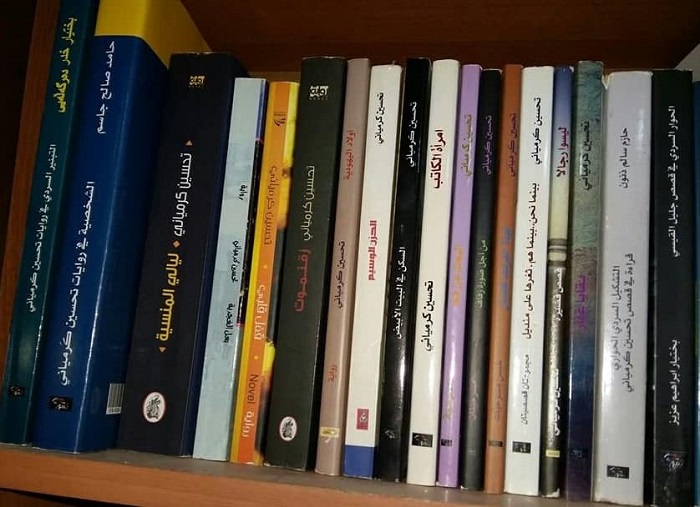







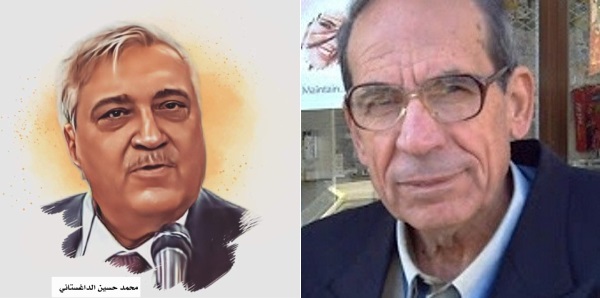



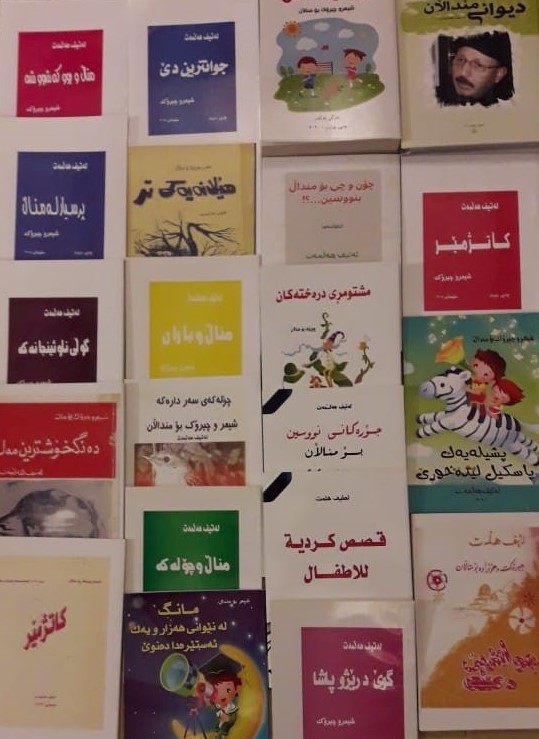


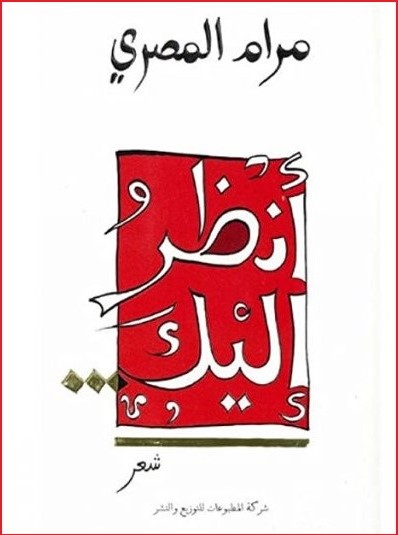
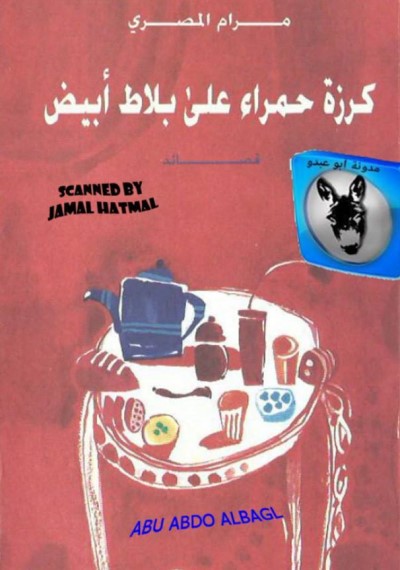









 * اي الأديان أكثر احتراما للمرأة؟
* اي الأديان أكثر احتراما للمرأة؟