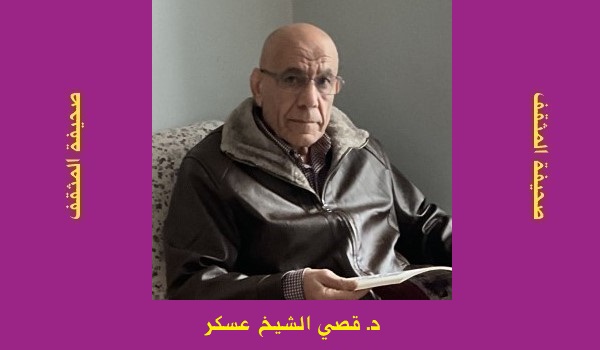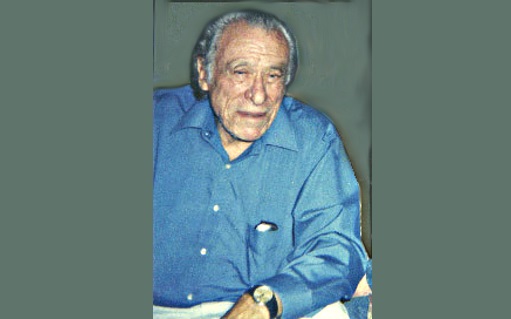ستعرفينه لوحدك ودون إبطاء، فهو الوحيد الذي سيكون دميماً، أحولاً، وبنظارة طبية سميكة وبمظهر لا يعجب النساء، في ذلك المقهى. هل هذا ما قالته سيمون دي بوفوار، لأختها بوبيت، قبل أن ترسلها لمقابلة جان بول سارتر، بدلاً عنها؟ لنفترض هذا، فليست حرفية هذا الكلام هي المهمة، بل المهم هو كيف لشابة جميلة في العشرين، ومن عائلة بورجوازية محافظة، أن يغريها الفكر لوحده في رجل؟
قال صديقي معلقاً وهو يقهقه (رغم أن هذا لا يحدث إلا في أحلام الرجال، عموم الرجال، وليس الدميمين منهم فقط، إلا أن سيمون تلك فعلتها في الواقع، وهذا ما يدفعني للشك في مواصفات سيمون الأنثوية التي خرقت القاعدة)!
كنا نجلس لحظتها قرب البيت الذي عاشت فيه سيمون دي بوفوار، (بعد عودتها من مدينة روان) في الدائرة الرابعة عشر من باريس، وبعد ثلاثين عاماً كاملة من موتها.
لماذا كنا نتحدث عن تلك الحالة الفريدة ونحن الاثنان على أعتاب السبعين؟ ربما بسبب الخيبة؟، لأننا نحن الاثنان فشلنا في الحصول على نساء أو زوجات لعلاقات طويلة أو دائمة ومستقرة، بدل الحياة التي انتهينا إليها بعيش كل منا مع كلب، رغم أن أي منا لم يكن دميماً أو أحولاً، بل، وعلى العكس ربما، كنا في شبابنا وسيمين، كما أخبرتني إحدى زميلات الدراسة في يوم من الأيام؟ قلت لصديقي وأنا أتصنع دور الحكيم:
-لا أوعز سبب عشق سيمون لسارتر، لغير الحقبة التي عاشا فيها، وأنت تعرف ملابسات تلك الحقبة، عندما كانت عموم نساء أوربا يعجزن عن الزواج بغير بائنة مالية كبيرة. رد صديقي وهو يمسح رأس كلبه الذي انتصب واقفاً:
- ولا تنسى أيضاً، وربما هذا هو الأهم، أن سارتر كان مؤمناً إيماناً حقيقياً بالحرية والاستقلالية، وهو وحده من زرع ذلك الإيمان في رأس وتفكير دي بوفوار. ولأني استغرقت في التفكير ولم أعلق على كلامه أضاف متسائلاً: أم تراك لست معي في هذه؟ قلت، وأنا ما أزال أسبح بين نتف أفكاري:
- بل معك في هذه بالذات، ولكني أتساءل: لماذا ذائقة المرأة، وخاصة عندما تكون صاحبتها متعلمة ومثقفة، يمكنها أن تتقبل الرجل غير الوسيم أو حتى الدميم؟ هل الأمر يتعلق بالتفسير الساذج، الذي خرج علينا مؤخراً، في طبيعة عين المرأة وأحاسيسها التي ترى الرجل أجمل بخمسة أضعاف عما هو عليه في الواقع؟ هز صديقي رأسه بطريقة يائسة، دلالة على عدم فهمه للأمر فقلت وكأني أحدث نفسي: الأمر يدعو للحيرة فعلاً.. الأمر بحاجة لتفسير فعلاً. قهقه صديقي كعادته وقال:
- وبم ستخدمك معرفة تفسير هذا الأمر وأنت في هذا العمر؟ عليك التسليم الآن لكونك انتهيت، وهنا رفع طرف عكازه ليشير إلى سيل المارة أمامنا، إلى ذات نهاية الملايين من أمثالنا: العيش مع كلب. وبعد لحظة نهض وأشار لكلبه أن ينهض ليقول: هيا، فلدي في البيت زجاجة كونياك من النوع الجيد؛ وإن شئت فأكمل تحسراتك ونحن نشربها... وأطلق قهقهة جديدة.
كنا أنا وصديقي هذا، ومنذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، جارين ووحيدين. أنا انفصلت عن زوجتي، منذ ما يزيد على الثلاثين عاماً، لأنها وجدتني فجأة مملاً ولا أسعى لتجديد شكل الحياة التي تحياها معي، وهو طرد عشيرته، بعد عشرة أعوام من حياتهما المشتركة، لأنها، وفي ساعة صحو من ضميرها، اعترفت له أن ابنتهما لم تكن منه، بل كانت من رجل عابر، نامت معه من أجل أن تحمل فقط، وكان قصدها منحه الابنة التي كان يحلم بها، بعد أن أثبتت التحليلات أنه عاجز عن الإنجاب. الفرق بيني وبينه، ومنذ أعوام انفصالنا الأولى عن زواجاتنا، هو يحاول العض على جرحه بالصمت والتجاهل، وأنا منهمك في التحليل ومحاولة إيجاد التفسيرات لما انتهينا إليه.
في صالة بيته، وهو أوسع من بيتي بكثير؛ حافظ صديقي على نظام التدفئة القديم. موقد رخامي كبير ومرتفع وتوقد ناره بقطع الخشب. يعجبني ضوء نار الخشب ولهبها ويشعرني بحميمية الطبيعة قبل دفئها. كالعادة توليت أنا إشعال النار في الموقد وتغذيتها بقطع الخشب، بينما انصرف صديقي لتهيئة المائدة القصيرة القوائم، التي كنا نضعها أمام الموقد، لكي نكتفي بلهب النار، إضاءة لليالينا تلك، وتساعد كلبينا على الاستغراق في نوم عميق.
بعد أن أكلنا بعض أجزاء قرص البيتزا، الذي كان جاري قد أعده ظهر ذلك اليوم، ورشف كل منا كأسه الأول، قال صديقي، بجدية، وعلى خلاف عادته في السخرية من كل المواضيع الجادة التي أحدثه بشأنها:
-رغم أني أتفق معك على قضية منح سارتر لشعور الثقة بالحرية لدي بوفوار، إلا أني أرى للأمر جانباً آخر يتعلق بطبيعة تكوين المرأة ذاتها.. وهنا توقف ليملأ كأسينا، قبل أن يكمل: قل إنه يتعلق بكيمياء تركيبة المرأة. وبعد أن رشف كامل كأسه بجرعة واحدة، حدق في وجهي بتركيز وصرخ: هل تستطيع أن تنكر أن المرأة كائن جبار ويفوق الرجل بقدرة التحمل؟ هل فكرت يوماً بقدرتها، بل شغفها بتحمل آلام الإنجاب، أو تحملها لتكرار آلام الدورة الشهرية لما يقرب من نصف عمرها؟ أومأت له برأسي من أجل أن يكمل فكرته، رغم أنه لم يكن بحاجة لتلك الإيماءة من الأساس، لأنه واصل صراخه وكأنه يخطب في قاعة كبيرة مليئة بالحشود الضاجة: قارن قدرة التحمل هذه بقدرات كبار صناع الحروب وعلى مر التأريخ: هرقل، الاسكندر، نابليون، هتلر... كم هي مختلة تركيبة أو كيمياء، أو حتى فطرة ورؤية إنسان يصنع حرباً يقتل خلالها ملايين من البشر الضعفاء؟ ولأنه صمت ليسترد أنفاسه سألته طلباً لشرح فكرته أو أيضاً زاوية ربطها بقضية حب سيمون لسارتر الدميم:
-وهذا يعني...؟ هنا قال بصراخ أعلى حدة:
- هذا يعني ببساطة أن كل من يكون قادراً على صناعة الألم أو يحتمله بمزاجه، تكون زاوية رصده للجمال أو طريقة تأثره به مطاطية، ولكن مطاطيتها تكون في حالة انكماش مزمنة. ولأني لم أفهم مقصده، ملأت له كأسه ووضعته في يده، قبل أن أعيد عليه سؤالي السابق ذاته:
- وهذا يعني...؟ هنا أطلق إحدى قهقهاته وقال:
- عليك اللعنة! ما بك اليوم رأسك معطل ولا تستوعب شيئاً؟ هنا فكرت قليلاً، بينما ذهب هو ليلقم نار الموقد بعض قطع الخشب، وبعد عودته إلى مقعده صرخت أنا هذه المرة:
- هل تعني أن من يصنع الألم أو تكون له قدرة استثنائية على احتماله تضرب عنده معايير الجمال؟ هنا قال بهدوء ليكمل لي فكرتي:
- فهي أما تكون بسقف عالٍ أو تتدنى إلى مستوى الإعجاب بدمامة وحول جان بول سارتر... وهنا غرق في ضحكة طويلة. وبعد أن سكت ومسح دموع عينيه وأعاد ملء كأسينا قلت:
- أنت هكذا تضع نظرية جديدة في معايير الجمال يا صديقي.. سرح بعينيه باتجاه لهب النار الذي أخذ بالتصاعد مرة أخرى، وبعد أن عاد إلى واقع جلستنا قال:
- لا أضع نظرية جديدة ولا غيره، أنا فقط أحاول تفسير معايير ما لا نفهم من شؤون المرأة يا صديقي. ولأني لم أجد ما أعلق به على كلامه أضاف متأملاً: هذا الكائن العجيب الذي يشاركنا الحياة منذ يومها الأول لا يجيد التعبير عن نفسه لانشغاله على الدوام بآلام جسده، والمشكلة أن المرأة لا تريد أن تفهم أن آلام جسدها مبعثها تكوينها الطبيعي أو فطرتها، بل تصر على أن الرجل هو السبب والمسؤول الأول عن كل آلامها. ولأنه وجدني أحدق فيه كالأبله بسبب ما تنزل عليه من حكمة طارئة في تلك الليلة الباردة، ابتسم وسألني: ما بك تحدق بي كقندس غبي؟ أطلقنا ضحكة عالية وقلت:
- بسبب العبقرية التي نزلت عليك فجأة يا محصل الضرائب المتقاعد. من أين جئت بكل هذه التحليلات العميقة هذه الليلة؟ مص جرعة من كأسه وقال بجدية:
- الأمر لا يتعلق بعبقرية ولا بحكمة، الأمر يتعلق بالمراقبة فقط. المرأة لتفهم بعض شؤونها تحتاج لمراقبة تصرفاتها وردود أفعالها فقط، وخاصة في أوقات حاجتها لممارسة الجنس. وهنا ضحكت وقلت:
-وأنت أمضيت عمرك في هذه المراقبة طبعاً...؟ رد بهدوء وصوت منخفض هذه المرة:
- قد لا تصدق هذا، ولكن هذا ما أنفقت الكثير من وقتي فيه، في أيام شبابي الأول، عندما كانت أغلب محاولات تقربي للنساء تبوء بالفشل. وبعد لحظة تفكير أضاف: هل سبق لك أن راقبت دجاجة حقل وهي توشك أن تضع بيضتها؟ ولأني هززت رأسي نافياً قال: أنا سنحت لي عشرات من هذه الفرص في مزرعة جدي. هل تعرف أن الدجاجة تتصرف في، الساعة الأخيرة التي تسبق وضع بيضتها، وكأنها تضع بيضتها الأولى في كل مرة؟ تدور حول نفسها بذهول، تبحث عن مكان استثنائي لا تراها فيه غيرها من دجاجات الحقل، وتحرص على أن تجد وسادة ناعمة لبيضتها، قبل أن تبدأ بإطلاق صرخات ألم الوضع. وهنا قهقهت وسألته:
- وما علاقة هذا بالمرأة أيها الحكيم؟ رد بذات الهدوء:
- لو فكرت أو إنك كنت تعرف أن كل بيضة تضعها الدجاجة، تسبقها عملية اتصال جنسي لكنت فهمت هذا الأمر. وهنا ضحك وصرخ: وقبل أن تكرر لازمتك اللعينة (بمعنى) سأشرح لك: المرأة تريد، ولا أدري، فربما تحتاج هذا الأمر، أن تكون كل ممارسة جنسية لها مستقلة وذات خصوصية متفردة، وتسبقها عملية إغواء دقيقة حتى من الزوج. إنها مثل الدجاجة في هذا الجانب، تتعامل مع الأمر كأنه بيضتها الأولى وما يرافقها من لذة الألم. وبعد لحظة قال وهو يحدق في وجهي وكأنه يتألم: كلا، ربما هذا الكلام ليس دقيقاً ولا ينقل لك الفكرة بتمامها.. كيف أعبر لك عنها؟ هل قرأت سيرة حياة دي بوفوار وما كتب عن حياتها يا رجل؟ وبالتأكيد أنك استغربت من كثرة تقافزاتها بين الرجال والنساء، على حد سواء؟ أومأت له برأسي أن نعم فقال: أتعرف ماذا كانت تفعل دي بوفوار؟ كل مرة وضعت فيها بيضتها، كانت تتبعها بالبحث عن ألم جديد أكثر لذة من سابقه ولهذا فإنها حرصت على التنويع. هل فهمت الآن؟ ولأني لم أفهم مقصده سألته ببلاهة:
- وهل اكتشفت هذا من خلال مراقبتك لزوجتك؟ أجاب وهو يقهقه ويعيد ملء كأسينا:
- نعم أيها العبقري، هي وغيرها ممن حاولت إغواءهن. ويا لغبائي لأني، وكأغلب الرجال، لم أكن أفهم هذا حينها، ولم أكن ماهراً بمنح ذلك الألم، أقصد الألم الذي تقيمه المرأة لنفسها وتعتبره سرها الكبير. أصر على أن نشرب كأسينا هذه المرة نخب خيبتنا. ولأن صاحبي استغرق في التفكير، نهضت أنا لألقم نار الموقد ببعض قطع الخشب، وعندما مررت بكلبينا حمحم كلبي برضا وهو يشم رائحتي فداعبت رأسه وأنا عائد إلى مقعدي فقال صاحبي:
- يبدو أني أفرغت الكثير من سمومي هذه الليلة... فقاطعته وأنا أضحك:
- ومن دون أن توضح لي لم أعجبت دي بوفوار بصاحبنا الأحول الدميم. فرد وهو ينفث حسرة من صدره:
- يبدو أن المرأة، ورغم كل تبجحاتها بشأن وسامة الرجل أو جماله فإنها لا تلتفت لغير ما يستطيع منحها إياه من ألم عميق؛ وبالتأكيد فإن سارتر كان بارعاً في هذا الجانب، قياساً لما تحدث عنه من غوايات كثيرة للنساء، بل وذكرته دي بوفوار ذاتها.
كان الشراب قد بدأ يلعب لعبته الخبيثة في رأسي، لأني رأيت كلبي يقوم من مكانه أكثر من مرة ليغير مكانه أو يعود إليه، وعندما أخبرت صديقي بالأمر أطلق قهقهته المعتادة وقال:
-ما بالك يا رجل؟ قبل قليل كنت بكامل وعيك وتسأل وتكرر الأسئلة كأغلب النساء. كلبك نائم في مكانه ولم يتحرك أبداً. أطلقت همهمة غبية وقلت:
- يبدو إنه أثر الشراب يا صديقي وأنت تعرف أثره اللعين. لكن قل لي وبأمانة، كيف تقيم دي بوفوار كامرأة وليس ككاتبة؟ أطلق إحدى قهقهاته العالية وقال:
- وهل كانت تختلف عن باقي النساء بشيء لأقيمه؟ بل العكس برأيي، فهي كأنثى كانت من بين أفشل النساء، ببساطة لأنها عجزت عن التعامل مع امتيازات ومميزات أنوثتها. إنها، لم تحترم أنوثتها وتعاملت معها كأنها خطيئة أو سبة. لقد عاشت خارج قوس أنوثتها إلا في جانب الغواية والجنس. تخيل أنها اعترفت بغوايتها لإحدى طالباتها وهي ما تزال في السادسة عشرة من عمرها. من حاسبها أو قال عنها إنها أخطأت؟ وأنت تأتي لتسأل كيف كان لها أن تتقبل سارتر الدميم الأحول؟ وهل كانت لها ذائقة طبيعية من الأساس كي تميز بين دمامة سارتر وجمال غيره؟ ولأني كنت أنظر إليه ببلاهة سألني وهو يقهقه: هل فهمت ما أعني أم كعادتك حرنت؟ أطلقت القهقهة أنا هذه المرة وقلت:
- بل حرنت. أطلقنا قهقهاتنا عالية ولحد أنها أوقظت الكلبين من سباتهما الدافئ، بفزع مجنون دفعهما للعراك وعض كل منهما لرقبة الآخر، الأمر الذي دفعنا للهجوم عليهما وسحب كل منهما لجهة، ولكن للأسف كنا قد وصلنا متأخرين، لأن كلبي كان قد أنفذ أنيابه في رقبة كلب صاحبي وأدماها بطريقة مفزعة. انفجر صديقي بنوبة غضب، أخذت تتصاعد مع رؤيته لكل قطرة دم بدأت تلطخ فرو كلبه فصرخ وعيناه تتقدان بالغضب:
- هل ترى ماذا فعل كلبك أيها الأبله؟ هل تحاول أن تخطف مني الكائن الوحيد الذي يعطف عليّ؟ هل تفهم ما معنى هذا؟ أنت تحاول سلبي هذا الكائن الودود الذي يحبني بلا ثمن وبلا نوايا مبطنة. قلت محاولاً تهدئته:
- أرجوك لا تتهمني ولا تحملني المسؤولية، فمن آذى كلبك هو ابن جلدته، كلب مثله وليس أنا؛ ولو ترويت قليلاً وفكرت بهدوء فالكلاب في هذا كالبشر، يؤذي بعضهم البعض. هنا صرخ بجنون:
- أحذرك من تشبيه كلبي بالبشر، فهو لم يخني يوماً ولم يتخل عني في منتصف طريق، هل تفهم هذا؟ قلت مرغماً ومن أجل امتصاص غضبه فقط:
- نعم أفهمه تماماً. والآن أوقف شجارك وهيا نبحث عن طبيب يعالج كلبك المسكين. كان يحمل كلبه ثقيل الوزن وبضمه إلى صدره وهو واقف بلا عكازه الذي لا يستطيع الوقوف من دونه فأجهش بالبكاء وهو يقول:
- هل تفهم معنى أن يموت كلبي؟ معناه أني سأعود إلى وحدة أيام... زواجي بتلك المرأة وهجرها المبطن لي بدعوى نضوبي من الحياة وأنت خير من يعرف هذا، بعد هجر زوجتك لك بذات الادعاء. أومأت برأسي موافقاً وتقدمت لأقبله وأقبل كلبه بحنو وقلت:
- هيا الآن إلى سيارتي وسأحاول الاتصال بطبيب كلبي وأنا في الطريق، ولحسن الحظ هو لا يمانع من استقبال الحالات الطارئة في بيته.
في الطريق إلى بيت الطبيب أخذ الكلب بالأنين فصرخ صديقي:
-هل تسمع أنينه؟ قلت بصبر نافد:
- نعم أسمعه وها نحن اقتربنا وسيعالجه الطبيب وينتهي ألمه. هنا صرخ مرة أخرى:
- لا تكن أبلهاً وخائناً في الوقت ذاته، على طريقة الثنائي سارتر – بوفوار أرجوك؛ فتلك الثنائية هي التي أودت بمشاعرنا النبيلة. تخونه ويخونها ويسامحها وتسامحه ببلاهة، إلى أن سرت عدوى الخيانة في جميع من اقترب منهما، بل وفي جيلهما بكامله. ولأني لم أجد ما أرد به أضاف وهو ينفث ما يشبه أنة استرخاء: على أية حال هذا الغدر انتقلت عدواه إلى الكلاب من البشر. البشر وحدهم من يرتكبون الأخطاء الفادحة وقد تعلمتها الحيوانات منهم. وفجأة توجه إليّ وسألني بجدية: ألم ترتكب أنت الأخطاء؟ ألم ترتكب دي بوفوار الأخطاء؟ لحسن الحظ أني كنت قد زدت سرعة السيارة وكنا قد وصلنا في تلك اللحظة إلى بيت الطبيب فقلت:
-ها نحن وصلنا وسترى أني لم أرتكب ما يشين بحق كلبك.
بعد أن فحص الطبيب كلب صديقي وجد أن جرح رقبته ليس نتيجة عضة، بل كان نتيجة خمشة فقط ولم يكن الجرح غائراً. وبعد أن نظف الطبيب الجرح وحقن الكلب – تحت إلحاح صديقي – بلقاحات احتياطية، عدت به إلى بيته وأنا أتجنب الكلام أو إبداء أي ملاحظة حول الكلب. بعد أن أوصلت صديقي وتوقفت أمام بيته، فتح الباب ونزل كلبه لينتظره أمام باب البيت ثم تبعه هو بالنزول، وبعد أن أغلق باب السيارة نقر على زجاجة الباب وطلب مني أن أنزلها ليقول بهدوء:
-أتعرف يا صديقي لم غضبت كل ذاك الغضب من أجل كلبي؟ غضبت لأنه المخلوق الوحيد الذي أحبني... بل الأدق أن أقول أوفى لي بالطريقة التي أوفى بها سارتر لصديقته دي بوفوار. فهذا الكلب وفي كل مرة أعود إليه فيها يستقبلني بحضن دافئ، كما كان يفعل سارتر مع دي بوفوار، عندما كانت تعود إليه، بعد كل مغامرة جنسية لها. هنا قلت، وبقصد التصحيح له فقط:
- بل أرى أنها ظلت متعلقة به لأن نفسه عافتها، فالمرأة لا تستطيع أن تتجاوز محنة ألا تكون مرغوبة من رجل. كل ما في الأمر هو أن سارتر لم يتركها بطريقة باقي الرجال، بانفعال وهجر، بل ازدرى جسدها فقط وحولها إلى صديقة... لنقل صديقة أفكار. هنا هز رأسه دلالة عدم الفهم أو الحيرة وقال:
- ولكنه بالتأكيد كره لواطها في كل صحن وفي كل مكان وتحت كل سقف. ولأن الهواء كان يدخل إليّ ببرودة مجنونة عبر الزجاجة المفتوحة، أعدت تشغيل محرك السيارة، كدليل على إنهاء الحوار وأنا أقول:
- رغم دمامته. وقبل بلوغ الزجاجة حافة الباب العليا، وصلني كلامه الأخير:
-وهو الدليل على إن أنوثتها كانت أصيلة فيها، وهي التي كانت تدفعها لغيرة النساء والندم والشعور بالخطأ و... و... ولم تكن من صناعة المجتمع، كما ادعت. ولعلك تذكر رسالتها إلى عشيقها (ألغرين)، بعد أن اشترت سيارتها السوداء، التي ابتدأتها (لا تستطيع المرأة أن تعيش بلا شغف، ولما كان الحب محظوراً، قررت أن أقدم لقلبي الدنيء شيئاً ليس خنزيرياً جداً مثل رجل، فقدمت لنفسي سيارة سوداء جميلة)، وأظن أنك تتفق معي على أن توصيف (خنزيرياً مثل رجل) تشمل سارتر ذاته. لماذا وكيف كان سارتر خنزيرياً معها؟ لأنه عاف جسدها لا أكثر.
***
د. سامي البدري