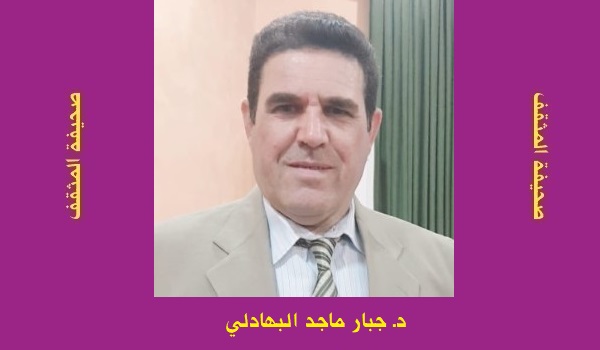قراءات نقدية
صالح الطائي: علي الطائي واصداء البشر

للإلمام أكثر بالمنهج الكتابي للدكتور علي الطائي قمت بدراسة مجموعته القصصية "أصداء البشر" واتخذتها مدخلا لقراءة فلسفية صوفية في مجمل أدبه، إذ نادرا ما ينجح الإنسان في الجمع بين التكامل والتضاد، أو بين عدة متناقضات دون أن يُحدث فوضى، إلا إذا ما كان يمتلك كاريزما تؤهله لذلك، فمثل هؤلاء لا ينجحون إلا من خلال تأطير الأبعاد ببعد وجودي ينبني على أبعاد جزئية، منها البُعد النفسي والفردي، فالإنسان العادي يجد في العادة صعوبة بالغة في التوفيق بين صفات أو أفكار متناقضة داخليا، مثل القوة واللين، أو الصرامة والمرونة، لأن العقل البشري يميل بطبيعته إلى التماسك والتناسق، هذا ما عرَّفه علم النفس باسم التوتر المعرفي، أي صعوبة الدمج بين ما يتناقض في نفس الوقت.
ومن الأبعاد الأخرى البُعد الاجتماعي والسياسي، فالقادة وهم أغلب الشخصيات المؤثرة غالبا ما يواجهون مواقف تتطلب الجمع بين رؤى أو أفعال متناقضة مثل العدالة/ الرحمة، الحزم/ المرونة، وهنا تأتي الكاريزما كعامل حاسم. فهي التي ترجح كفة على أخرى، وتمنح القدرة على الإقناع والتأثير، بحيث يقبل الآخرون التناقض ويرونه تكاملا لا تضادا.
ومنها أيضا البُعد الفلسفي والوجودي، إذ ليس شرطا أن يكون التناقض سلبيا دائما؛ فهناك فلاسفة يرونه شرطا للارتقاء والفهم العميق، ومن أمثلته المتاحة التناقض الصوفي الذي يجمع بين الزهد في الدنيا والحب الشديد للناس، والتناقض الفلسفي الذي يجمع بين الشك واليقين. في هذه الحالات، الكاريزما ليست فقط سحرا شخصيا، وإنما هي قدرة على تحويل التناقض إلى وحدة معنوية أو وجودية، وهذا أمر غير متاح للجميع.
باختصار، أرى أن التناقضات ليست سهلة الدمج، إلا لمن يملك حضورا وكاريزما تمكنه من إضفاء معنى ومقبولية على هذا الجمع الصعب، أقصد جمع التناقضات، وهو ما يجعل الشخصية فريدة ومؤثرة. وربما هذا هو السبب الحقيقي الذي جعل قلة من البشر الذي ينماز بهذه القدرة. وفي الواقع أرى أن هذه الموهبة هي التي خلدتهم ومنحتهم الشهرة.
تاريخيا كان الصوفيون والفلاسفة الروحيون من أشهر الذين تحلوا بهذا الجمع مثل الحلاج (858 ـ 922م)، الذي جمع بين الزهد والتجربة الإنسانية، وبين الحب المطلق لله والحياة اليومية. وهو بالرغم من تناقض أفكاره مع المجتمع الصوفي التقليدي، استطاع أن يؤثر بأقواله وحياته على أجيال لاحقة، وكانت كاريزمته في حضوره الروحي وكلماته الملهمة، لكنه دفع ثمن هذا التناقض بالإعدام.
وابن عربي (1165ـ 1240م)، الذي دمج بين العقل والنقل، بين معرفة الذات ومعرفة الإله، بين الصوفية والفلسفة العقلية. وقد عكست كتاباته قدرته الفائقة على الجمع بين تناقضات فلسفية وروحية عميقة، مع مقدرة على إقناع الناس بأن هذه التناقضات وحدة مترابطة.
غير الصوفيين هناك القادة السياسيون والعسكريون التاريخيون مثل الإسكندر الأكبر (356ـ 323ق.م) الذي جمع بين الحزم العسكري والرحمة الدبلوماسية، وبين القسوة والحكمة، وبين الغزو وبناء المدن. وقد مكنت كاريزمته وجرأته؛ لا جيشه فحسب، بل والشعوب الخاضعة له من قبول تناقضاته كجزء من شخصيته.
وغاندي (1869ـ 1948م) الذي جمع بين المقاومة اللاعنفية والصرامة الأخلاقية، وبين البساطة والفعل السياسي الفعال. فكان هذا التناقض بين العزلة الشخصية والانخراط الاجتماعي العميق محكوما بكاريزمته الروحية والأخلاقية.
ونيلسون مانديلا (1918ـ 2013م)، الذي جمع بين الصلابة والمرونة، وبين المطالبة بالحقوق والمصالحة مع الخصوم. وهو رغم التناقض الظاهر بين الانتقام والتسامح، استطاع بحضوره الشخصي وكاريزمته تحويل هذا الجمع الصعب إلى رمز عالمي للسلام والعدالة، احترمته الشعوب والحومات.
ومن بين الشخصيات الكارزمية التي خلدها التاريخ بسبب جمعها التناقض هناك العديد من الشخصيات الفنية والأدبية، مثل ليو تولستوي (1828ـ 1910م)، الذي جمع بين الحياة العملية والتأمل الروحي، وبين النقد الاجتماعي والفلسفة الأخلاقية، وبين النقد الذاتي والفعل الاجتماعي، وهذا خلد أعماله.
وفنسنت فان غوغ (1853ـ 1890م) الذي جمع بين الجنون والإبداع، والألم والحس الجمالي، ما جعله مؤثرا بعد موته أكثر من حياته من خلال فنّه التناقضي، إذ أضحى مثالا على التناقض الذي يتحول إلى قوة.
إن القدرة على الجمع بين التناقضات مع كاريزما ساندة ومؤثرة تؤهل الآخرين لقبول هذا الجمع الذي يبدو أحيانا فوضويا؛ رغم غرابته ليست شائعة، لكنها تظهر في الشخصيات التي تمتلك وعيا داخليا عميقا بالذات والوجود. شخصيات تستطيع التعبير عن هذا الجمع بطريقة تجعل الآخرين يشعرون بالانسجام بدلا من الصراع، شخصيات لديها حضور وكاريزما تمكنها من التأثير الاجتماعي والسياسي أو الروحي، فحضور مثل هؤلاء يجعل التناقض قوة وليس ضعفا.
سقت هذه المقدمة الطويلة لأمهد للحديث عن رجل معاصر جمع بين مهنة الطب والشعر والقصة والرواية وإدارة مجلس ثقافي وإدارة دار نشر، والتأليف البحثي واللغوي، هو الدكتور الأديب علي الطائي، لأنه يمتلك خصائص وكاريزما مشابهة لأولئك الأشخاص الذين نجحوا في الجمع بين التناقضات بطريقة تؤهلهم للتميز، ولاسيما من حيث تعدد الأبعاد والاختصاصات، كونه طبيب يجمع بين المعرفة العلمية الدقيقة والانضباط والمسؤولية الأخلاقية تجاه حياة البشر. وكونه شاعر وقاص، فهو يتحرك في عالم الإبداع والخيال، حيث الانفعال والحساسية واللغة الجميلة تلعب الدور الأساس. وكونه باحثا علميا ولغويا، ولامتلاكه ديوانا (مجلسا) أدبيا يعكس القدرة على الجمع بين الفكرة والموسيقى اللغوية، وبين الفكر والوجدان، وبين الصرامة في اللغة والانطلاق في المعنى. وهذا الجمع بين العلوم الصارمة والفن الإبداعي هو نوع من التناقض الظاهر، نجد فيه العقل التحليلي مقابل الحس العاطفي، والدقة العلمية مقابل الحرية الأدبية.
فقط ملاحظة جديرة بالاهتمام تقف بينه وبين أن يدخل سجل الخالدين، وهي أن الدكتور علي الطائي متى ما أصبح قادرا على نقل تجربته ونتاجه الأدبي والفكري بطريقة تؤثر على القراء والمتابعين، فهذا يعني أنه يمتلك كاريزما معرفية وروحية حقيقية تسمح للآخرين بقبول هذا الجمع بين الأضداد دون اعتراض، ولا أعتقد أن ذلك سهلا في زمن مأزوم تكاد القيم الحقيقية فيه أن تنسى.
إن الكاريزما التي أتحدث عنها هنا ليست مجرد جاذبية شخصية، بل هي قدرة على إقناع الآخرين بأن هذا التعدد لا يتنافى مع الوحدة الداخلية للشخص، بل يعكس ثراءه الفكري والوجداني. ومع هذا أرى أنه يمكن اعتبار الدكتور الطائي نموذجا حديثا للتكامل بين التعددية الداخلية والكاريزما في التأثير الأدبي والفكري. الاختلاف أن الدكتور علي الطائي يجمع بين العلم، والفن، والأدب، والفلسفة والتصوف، وهو نوع من التناقض الذكي الذي لا يقل تأثيرا عن التناقضات السياسية أو الروحية.
وللإحاطة ببعض الأبعاد التناقضية للدكتور الطائي سأتناول كتابه الأخير "أصداء البشر"، وهو كتاب قصص قصيرة، ليدلنا على منهجه كتجربةً أدبية متميّزة، إذ وجدت أنه لا يكتفي بالسرد القصصي التقليدي أو الشعري السائد، بل يذهب نحو بناء نصوصٍ تنفتح على الفلسفة والروحانية والصوفية، في محاولة لجعل القارئ في مواجهة مباشرة مع أسئلة الوجود والمصير، فنصوص الكتاب ليست مجرد قصص قصيرة أبدا، وإنما هي "أصداء" لإنسان يبحث عن ذاته في مرايا الزمن، ويصغي إلى صوته الداخلي في جدلٍ مع الغيب، يبدو ظاهرا في البنية الفلسفية الصوفية للنصوص ففي تناقضية الحرية والقدر نراه يصرح: "المكان بلا أهل ليس مكانا، بل شاهد قبر على أيام لن تعود" (ص97) فهذا النص ينفتح على إشكالية الحرية والقدر، حيث يُقدَّم الإنسان ككائن متجذر في الغيب، لا كحادث عابر، وهو طرح يقارب بين الرؤية الفلسفية الوجودية والتأمل الصوفي.
وفي عالم البصيرة والكشف يقف ليصرخ في فراغ: "الفرص لا تمنح بعد أن يكسر القلب، ولا يصلح الجسر بعد أن يحرق" (ص38)، وهي عبارة تجسّد فكرة الكشف الصوفي الذي يرى أن الحقائق تُدرك بالبصيرة لا بالبصر.
ومثلها في رسمه لخارطة الفناء والبقاء، كما في قوله: "واليوم، وبعد كل تلك السنين، وأنا في مدينة بعيدة، حيث الربيع لا يشبه ذلك الربيع، وحيث الأشجار مغتربة وسط الأبنية الصامتة، أدركت ما كان يقصده أبي. أدركت أن الربيع ليس مجرد تحول في الطقس، بل هو وعد بالتجدد، رسالة خفية تخبرنا بأن الحزن لا يدون، وأن كل شيء يمكن أن يزهر من جديد" (ص70)، إذ يلحظ المتلقي هنا أن التضاد يذوب بين الموت والحياة في رؤية صوفية تجعل الفناء استمرارا للبقاء.
حتى الحوار الداخلي تحول لدى الطائي إلى وظيفة، فـ: "الحب مثل البخار، إذا لم نغلق عليه الكوب سيتلاشى، وإن تركناه جامدا بلا دفء فقد معناه" (ص52) و "أخشى أ، يأخذنا الزمن بعيدا عن هذا الدفء... لن يأخذنا ما دمنا نحن من نختار الطريق" (ص53). فهذا الحوار الذاتي يكشف عن صراع النفس مع نفسها، على غرار ما يسميه الصوفيون "مكاشفات الباطن".
أما عن الزمن والحضور، فالطائي يرى عمق المعنى: "وقفت عند النافذة، وفتحت عينيها على السكون الذي كان يحيط بكل شيء، بينما دقات قلبها كانت تتناغم مع دقات قلبه. أغمضت عينيها، وأوقفت الزمن في داخلها، ثم رفعت ذراعيها إلى السماء وكأنها تدعو النجوم كي تستمع إلى عزف الأوتار التي طالما كانت تشغل قلبها. كانت تدرك، بل تشعر، أنه قادم"(ص127). هنا يتحول الزمن إلى "آن سرمدي" كما يصفه المتصوفة، حيث يلتقي الماضي بالحاضر في لحظة أبدية بوهيمية تمد أحد ذراعيها إلى الحقيقة والآخر إلى الوهم.
وهو حينما يتحدث عن الاغتراب الوجودي: "لست حزينا يا بني ولكني أفكر في الزمن" (ص13) يحاول تذويب التناقض في اللامعنى، فـ: "السنين لا تسرقنا، بل تكتب تاريخنا" (ص14)، وكأنه أراد التعبير عن عزلة الإنسان واغترابه، وهو ما يجسد معاناة البحث عن المعنى، عن رحلة طويلة متعبة منهكة، ولكنها تعيد المرء الى الطريق الصحيح. فهو لم يعد يهتم بالمال والدنيا، فهما لا يساويان شيئا أمام ما يجد الإنسان من نور الحقيقة، فـ: "الحقيقة ليست شيئا يُلقن، ولا شيئا نتمسك به دون تفكير. الحقيقة شيء نصل إليه بعد بحث طويل، بعد أن نتعلم كيف نشك ونسأل. هل سألت نفسك يوما إن كنت تسير في الاتجاه الصحيح، أم أنك فقط وجدت نفسك منجرفا مع تيار آخر؟" (ص43).
حتى الآخر والهوية وجدا حيزا في عالم التناقض الوجودي: "إن بعض الصداقات تموت ليس بفعل الزمن، بل بفعل العقول التي تأبى أن تتحرر" (ص45)، فهو يرى أن الرحلة ليست في الوصول... بل في التفاصيل الصغيرة التي تجعلنا ما نحن عليه الآن" (ص74). فالجروح لا تحتاج إلى الصراخ كي تبرأ، بل تحتاج إلى صوت صغير نقي يذكرها أن هناك دوما نورا في آخر النفق" (ص83) ليلخص من خلال ذلك رؤيته للآخر والهوية بقوله: "ولكني لم أجد روحا تؤالفني، كأنني غريب في دنيا لا تعرفني" (ص87)، فهو يعتقد أن الآخر هنا ليس مجرد صورة مقابلة، بل مرآة تكشف الذات لنفسها.
ومن أجواء هذا التناقض نراه يبحث عن "أصداء" الموت والبعث الداخلي. إن الرؤية الصوفية تجعل الموت بداية حياة جديدة داخل الوعي: "فبعض الفراق لا يداوى، بل ينساب في الروح كالسكين، باردا، عميقا، وصامتا" (ص102).
وفق جدل التناقضات رسم الطائي عالم المطلق والجزئي حيث يظهر البعد التوحيدي، حينما يتلاشى الفرد في الكل كما تفنى القطرة في البحر. وحينما يتحول الحب من عاطفة بشرية إلى طريق صوفي يوصل إلى المطلق. وبالتالي أرى أن الطائي جمع في كتابه هذا خلاصة فلسفته الحياتية، وقد أراد له أن يكون فريدا في الجوهر والمعنى فملأه حتى فاض. ومن مواطن القوة التي وجدتها فيه عمق الرمزية، والانفتاح على قراءات متعددة فلسفية وصوفية وأدبية وفق أسلوب السهل الممتنع، مع قدرة على المزج بين السرد والتأمل. وإن كان هناك قصورا يمكن تشخيصه فقد وجدت أنه يغلب أحيانا الجانب الفلسفي على البناء الحكائي للنص.
من هنا أرى أن "أصداء البشر" ليس مجرد مجموعة قصصية، بل هو مشروع أدبي روحي يضع القارئ في مواجهة أسئلة الذات والقدر والمطلق، ونصوصه القصيرة تُظهر الإنسان كصدى للحقيقة، وتجعل من القصة القصيرة وسيلة للتأمل الصوفي. إنه كتاب يمزج بين جماليات الأدب وعمق الفلسفة ورهافة التجربة الروحية، مما يمنحه مكانة خاصة في الأدب العربي المعاصر.
صدر الكتاب عام 2025 بواقع مائة وسبعة وستين صفحة، وقد تولي الدكتور الطائي الإخراج الطباعي أما تصميم الغلاف فقد نفذته زوجته السيدة صبا التميمية، وطبع في مطبعة المجلس الثقافي؛ وهو اسم دار النشر التي يديرها الدكتور الطائي، وكأنه أراد التعبير من خلال هذه التوليفة عن عالم التناقضات الذي تحدثنا عنه.
***
بقلم: د. صالح الطائي