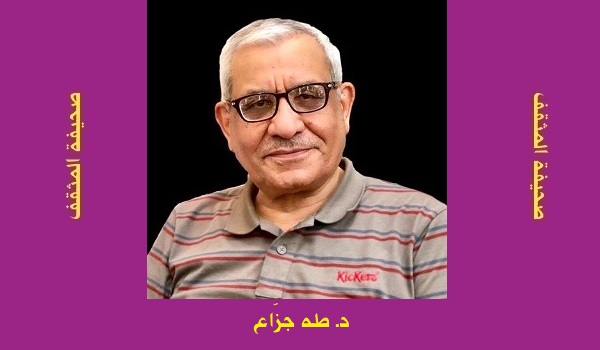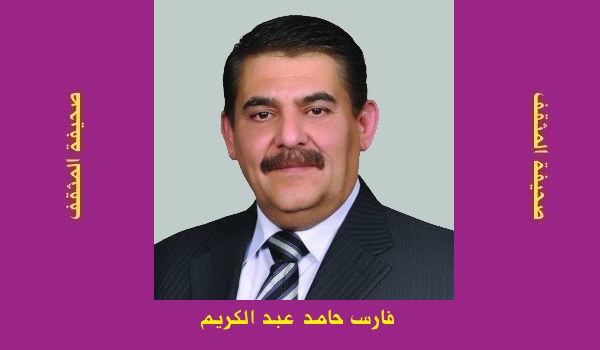قضايا
بدر الفيومي: صحة البدن واستثمار الوقت

منذ بزوغ فجر الفلسفة والإنسان مشغول بالسؤال الوجودي عن الزمن: ما هو؟ وما علاقته بالوجود والفعل الإنساني؟ وقد تباينت المقاربات باختلاف العصور والأنساق الفكرية. فأرسطو (384–322 ق.م) حدَّد الزمن بأنّه «عدد الحركة بحسب قبل وبعد»، أي مقياس للتغير والتحول، وهو تصور يتوافق مع النزعة الطبيعية المادية للفلسفة اليونانية الكلاسيكية. بينما رأى الرواقيون (القرن الرابع، الثالث ق.م) أن قيمة الإنسان تتحدّد بمدى استثماره لأيامه واستيعابه لمحدوديّة العمر، وهي رؤية أخلاقية وجودية تتقاطع مع روح التصوف في تركيزها على الحاضر وتهذيب النفس. أمّا أوغسطين (354–430م) فقد جعل الزمن متصلًا بالوعي والذاكرة الداخلية للإنسان، وهو تصور يكشف عن عمق البعد الروحي والميتافيزيقي في الفكر المسيحي المبكر.
وفي الفكر الإسلامي، نبّه أبو حامد الغزالي (450–505هـ) في إحياء علوم الدين إلى أن العمر هو رأس المال الحقيقي، وأن التفريط في لحظة واحدة خسران لا يعوَّض. وقد عمّق ابن الجوزي (510–597هـ) هذا المعنى حين قرر أن «أنفاس الإنسان هي حياته». ثم جاء ابن تيمية (661–728هـ) ليقرر أن «الوقت هو رأس مال الإنسان الحقيقي»، وأن ضياعه أعظم من الموت؛ إذ إن الموت يقطع الإنسان عن الدنيا، بينما ضياع الوقت يقطعه عن الله والدار الآخرة. كما ربط ابن تيمية بين البعد الفردي والبعد الجماعي، معتبرًا أن إهدار الأوقات يضعف الأمم ويؤدي إلى انحطاطها، وهو ما يتناغم مع ما قرره ابن خلدون (732–808هـ) في المقدمة حول أثر البطالة والترف في سقوط الحضارات. واعتبر ابن القيم (691–751هـ) أن العارف الحق «ابن وقته»، لا يملك إلا لحظته الحاضرة التي إن لم يستثمرها ضاعت منه وفقد وجوده الفاعل، وهو تصور يتناغم مع المسحة الصوفية التي تجعل من الحضور واليقظة شرطًا للسلوك الروحي.
أما في الفلسفة الحديثة، فقد توقف بليز باسكال (1623–1662م) عند عجز الإنسان عن استثمار عزلته وفراغه، معتبرًا هروبه الدائم من ذاته علامة ضعف وجودي. ثم جاء إيمانويل كانط (1724–1804م) ليرى أن الزمان شرط قبلي لتنظيم الخبرة الإنسانية وإدراك الظواهر، وهو تصور يضع الزمن في قلب البنية المعرفية للعقل. وأما هنري برجسون (1859–1941م) فقد أعاد تعريف الزمن باعتباره «مدّة ذات روح وحياة» تتدفق في الوعي الداخلي بعيدًا عن الحسابات الكمية للثواني والساعات، وهو تصور يعبّر عن الفلسفة الحدسية العقلية التي تؤكد الخبرة الذاتية على حساب الكميّة المجردة. بينما جعل مارتن هايدجر (1889–1976م) الوجود الإنساني مرهونًا بوعي الإنسان بفنائه، بحيث يستمد الزمن قيمته من حضوره نحو الموت، وهو تصور يتوافق مع النزعة الوجودية التي تجعل القلق طريقًا إلى الأصالة. وفي المقابل، رأت حنا أرندت (1906–1975م) أن الفراغ ليس بطالة ولا خواءً، بل هو المجال الذي تنبثق فيه الحرية والإبداع. وأخيرًا ذهب ميشيل فوكو (1926–1984م) إلى أن الزمن ليس مجرد إطار محايد، بل هو مجال تتخلله السلطة عبر تنظيم الإيقاعات اليومية وضبط الفراغات بما يخدم البنى السلطويّة.
وتُظهر هذه المقاربات التي سقناها أن الفلاسفة والمفكرين جعلوا من الزمن ميدانًا لجدل أنطولوجي وأخلاقي عميق، وأدركوا خطورة الفراغ والوقت المهدر. غير أنهم – رغم عمق تحليلاتهم – لم يسعفهم النظر الفلسفي في صياغة معيار جامع يوازن بين البعد الفردي والبعد الغائي الوجودي للإنسان. فبقيت رؤاهم متفرقة ولم تنتظم في نسق تكليفي متكامل.
وهنا ينهض الحديث النبوي الشريف بكلماته الموجزة الجامعة: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» ليؤسس لرؤية وجودية ومعيارية للزمن والفاعلية الإنسانية. حيث لا يتعامل مع الصحة والفراغ بوصفهما حالتين جسمانيتين أو عارضتين، بل يرفعهما إلى مستوى المعيار الذي تُقاس به قيمة الإنسان ومسؤوليته التاريخية. فيفتح أمام العقل الإنساني آفاقًا للتفكير في قيمة الصحة بوصفها الطاقة المُمكِّنة، والفراغ بوصفه المجال الذي يمنح الإنسان حرية الاختيار ومجال الفعل. وبذلك يعيد ترتيب أولويات الإنسان، ويؤسس لوعي زمني يجعل كل لحظة فرصة، وكل فرصة مسؤولية، فلا يترك الإنسان أسير العبث واللهو الذي حذّر منه باسكال، ولا ضحية القلق والاغتراب الذي وصفه هايدجر، بل يرشده إلى عيش الزمن بوعي روحي وأخلاقي متكامل.
فالنص النبوي فجعل الزمن أمانة وجودية يُسأل عنها الإنسان: «عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه». وهكذا لم يكتفِ التصور الإسلامي بالموازاة مع تلك المقاربات، بل تجاوزها وأكملها، إذ حوّل الزمن من فكرة فلسفية مجردة إلى معيار عملي ومحاسبة وجودية، فصارت الصحة والفراغ رأس مال رمزي وحضاري يُقاس به وزن الإنسان وفاعليته في العالم، ويُقوَّم به إسهامه في مشروع العمران البشري.
فاستحضار هذا الحديث النبوي في سياق الفلسفة يكشف عن سبق الرؤية المحمدية التي صاغت معيارًا كليًّا للوجود الإنساني يربط بين الدنيا والآخرة، والفرد والجماعة، والصحة والزمن، ليجعل منها جميعًا ميدانًا للاختبار الأخلاقي ومسؤولية وجودية لا تقبل التفريط أو الإهمال.
وتبدوا أهمية هذه الرؤية بجلاء في عالمنا المعاصر الذي تتسارع فيه إيقاعات الحياة على نحو غير مسبوق، وتُستنزَف الطاقات في اللهو الرقمي والاستهلاك المفرط واضطراب سلّم الأولويات، فيتجدّد صدى التحذير النبوي من الغُبن. حيث اتّسع مدلول الصحة في الفكر الحديث ليغدو قدرةً على الإبداع والعطاء، لا مجرد انتفاء العِلّة والمرض، وصار الفراغ ساحةً لتشييد المشاريع الكبرى وصوغ المصائر الفردية والجمعية. ولذلك نرى أن التفريط في هذين الموردين يفضي إلى خسارة الذات على المستوى الوجودي للفرد، وإهدار المستقبل على المستوى الحضاري للأمم.
وعليه، يغدو هذا النص النبوي حجر الزاوية في بناء فلسفة إسلامية للزمن؛ فلسفة تنظر إلى العمر بوصفه رأس مال الكائن الإنساني، وإلى الصحة باعتبارها طاقة للفعل وتحقيق الغايات، وإلى الفراغ باعتباره مجالًا لاستنطاق المعنى وإعادة تأسيس الوعي. وهكذا تلتقي الرؤية النبوية مع هموم الفلاسفة قديما وحديثا في أعمق صورها، غير أنها تتجاوزها بتوجيه الوعي الإنساني نحو الغاية القصوى: عبادة الله وعمارة الأرض، في توازن رفيع بين البعد الأخروي والهمّ العمراني.
***
بقلم: د. بدر الفيومي