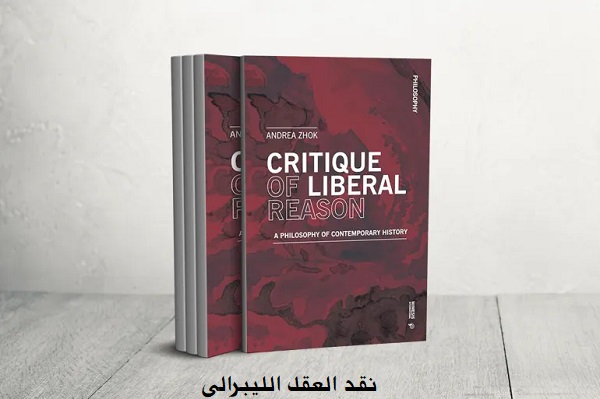الحرب على غزة وصمة عار والإسلام هو الحصن الوحيد لمواجهة العنصرية الثقافية
حوار: أمل بوشارب
***
أندريا زوك (1967)، واحدا من بين أبرز فلاسفة إيطاليا المعاصرين. درس بين إيطاليا، والنمسا واليونان، وبريطانيا، ويعمل حاليا أستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة ميلانو. صدر له العديد من المؤلفات، من بينها "الواجب واللذة – مقدمة في نقد فلسفة الأخلاق المعاصرة" (2021)، "الهوية والإحساس بالوجود" (2018)، "روح المال وتصفية العالم" (2006)، و "نقد العقل الليبرالي – فلسفة التاريخ المعاصر" (2022) المترجم حديثا إلى الإنجليزية عن منشورات (Mimesis international, 2023).
التقينا زوك بعد شهور طويلة من العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو من وقف ضد الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أيامها الأولى، وذلك لمناقشة كتابه الأخير على ضوء اللحظة الفلسطينية والتأمل في تداعيات الفكر الليبرالي على ما تعيشه غزة اليوم:
- قُلت إن الحرب على غزة هي دليل إفلاس أخلاقي يعيشه الغرب. هل لك أن تشرح لنا أسباب هذا السقوط الأخلاقي؟ وكيف وصل العالم إلى هنا؟
* هذه الحرب هي وصمة عار لا يمكن لأي شيء أن يمحوها.
والسقوط الأخلاقي للغرب ليس وليد هذه اللحظة، وإنما له جذور تاريخية عديدة، لكن أعمقها هو ذلك الزعم الثقافي الذي ولد وترعرع خلال الثورة الصناعية وما خلفته من تفوق عسكري خلال القرنين الـ19 والـ20 منح للغرب دورا رياديا في العالم بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وهو ما تُرجم بشكل أو بآخر بأنه دليل على التفوق الأخلاقي للغرب.
المفارقة تكمن في أنه لا وجود لأي تأصيل فلسفي لهذا الزعم في تقاليد الفكر الغربي، بل العكس تماما فالمسيحية مثلا تحذر من القوة ولا تعتبرها ضمانة أخلاقية بل ترى فيها خطرا من شأنه أن يقوض الأخلاق.
هذا الدرس المسيحي للأسف ضاع كليا وبدأنا نرى في العقود الـ3 الأخيرة تحديدا توجها غربيا بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لاعتبار سياسة الكيل بمكيالين شكلا طبيعيا من أشكال التقييم يتم اعتماده على نحو منهجي إذا ما اقتضى الأمر أن نحكم بين أي قوة غربية كانت وأي طرف آخر في العالم يقف في وجهها. ما هو محزن أن الأمر يجري على نحو لا شعوري تماما.
نحن أمام عنصرية ثقافية ولا أجد أي مصطلح آخر يمكن أن نصف به هذه الظاهرة. إنها عنصرية ثقافية إذا ما تمت مواجهة الغرب بها شعر بالإهانة لأنها ظاهرة لم يتم تأصيلها على أنها ضرب من ضروب العنصرية والفوقية ولكنها تُدرس على العكس من ذلك ضمن مباحث حقوق الإنسان، مما يجعلنا نعيش هذه العنصرية كأنها أمر طبيعي لا يقبل النقاش. وهذه المسألة بالمناسبة ذات علاقة وطيدة بالفكر الليبرالي والديمقراطية. لكن ربما قد ترغبين في أن نتحدث عن الأمر ضمن محور آخر في هذا اللقاء…
- طبعا، لكن اسمح لي أن نبقى قليلا هنا ونتوسع أكثر في نقطة "العنصرية الثقافية" وكيفية مواجهتها. ذكرت في مطلع هذه السنة ضمن مؤتمر شاركت به في ميلانو بعنوان "فلسطين وخيانة الغرب لقيمه" أن الإسلام يعتبر اليوم الدرع الوحيد الذي يمكن أن يقف ضد الإمبريالية الثقافية الغربية. كيف ذلك؟
* لن أخوض بالطبع في الشق الروحاني أو العقدي للديانة الإسلامية لأنه مبحث لا يدخل في إطار تخصصي، ولكن بالتأكيد الإسلام يشكل اليوم حصنا في وجه الإمبريالية والعنصرية الثقافية. إن حللنا الأمر من الناحية الثقافية نلاحظ أن الرؤية التي يقدمها الإسلام للعالم آخذة في الانتشار على نحو كبير ومطّرد. طبعا هذا لا يشكل بالضرورة دليل صحة من عدمها لأي رؤية لكنه بالتأكيد معطى مثير للاهتمام لأنه مؤشر على الخصوبة.
نحن هنا إزاء ثقافة حيوية تتمتع بسِمة مهمة تتمثل في قدرتها على تجاوز القوميات وعبور الحدود والقارات. صحيح أن الإسلام دين وُلد ضمن جغرافيا معينة ولكن هذه الجغرافيا ليست هي ما يحدد انتماءه. لذا فنحن أمام دين لا ارتباط عرقيا له عكس الكونفوشيوسية مثلا والتي تلعب دورا مماثلا على صعيد التأثير لكنها محدودة في إطارها الصيني. الإسلام من جهة أخرى يبرز دينا مؤثرا وخصبا على نحو لا يمكن تجاهله، فضلا عن أنه يعبّر عن ثقافة تعد في جزء كبير منها "ما قبل ليبرالية" وهذا لا يعني أنها بالضرورة معادية لليبرالية أو لا ليبرالية ولكن ببساطة ما قبل ليبرالية تماما مثلما كانت عليه الديانة المسيحية قبل أن يتم تدجين جزء كبير منها وإدراجها ضمن ديناميكيات سياسية أخرى.
الإسلام، إلى جانب كونه دينا قويا وخصبا كما أسلفت، فهو يُظهر معارضة لروح الهيمنة الغربية (وهي الآن ليبرالية) وهو ما يجعله اليوم محط اختبار بشكل أو بآخر من الخارج. وكل ما أرجوه هنا هو أن يحصل تشابك مثمر بين الطرفين لا يؤدي إلى أي تصادم
الإسلام في المقابل، إلى جانب كونه دينا قويا وخصبا كما أسلفت، فهو يُظهر معارضة لروح الهيمنة الغربية (وهي الآن ليبرالية) وهو ما يجعله اليوم محط اختبار بشكل أو بآخر من الخارج. وكل ما أرجوه هنا هو أن يحصل تشابك مثمر بين الطرفين لا يؤدي إلى أي تصادم.
آمل بصدق أن يكون التفاعل سلميا بين الإسلام والغرب لأن أي صدام عنيف من شأنه أن يحدث بين الطرفين، بعيدا عن الثمن الإنساني الذي سيخلفه، سيكون من الناحية الثقافية غاية في السوء لأنه سيخلق تصلبا دوغمائيا على الجهتين.
كتاب "الواجب واللذة-مقدمة في نقد فلسفة الأخلاق المعاصرة" (2021) (الجزيرة)
- هل تعتقد أن الغرب اليوم جاهز للحوار مع الإسلام؟ فمن جهة هناك مكون يميني يتشارك فعلا مع المسلمين القيم ذاتها ولكنه يُظهر توجسا من الإسلام، ومن جهة أخرى هناك يسار على الرغم من تفاعله الذي قد يبدو طيبا مع المسلمين، لكنه لا يُبين عن أي فهم لروح الدين… على أي أرضية يمكن أن يتم هذا الحوار برأيك؟
* الإشكاليات في الغرب موجودة بالفعل على اليمين واليسار. على اليمين قد تبدو الإشكاليات أوضح لأن أي حديث عن الإسلام يثير رأسا تلك النعرة القومية، في حين أن الإسلام على اليسار تتم مقاربته ضمن موضوع الأقليات التي تحتاج إلى حماية: اليساري يشعر دوما أنه بحاجة "للطّبطبة" على الآخر لأنه "هش"! العقل اليساري صنع صورة للآخر في ذهنه تتسم حصرا بالضعف والهشاشة، لذا فهو يشعر أنه لابد من أن يأخذ دوما بيد هذا الآخر إلى الطريق القويم! ولكن ماذا لو كان هذا الآخر قويا وخصبا ويقف أساسا على الصراط المستقيم. نحن هنا أمام انسداد عقلي حقيقي لدى اليساريين. والأمر له علاقة بجذور ثقافية عميقة بدأت في عصر الأنوار وترسخت بعد الحرب العالمية الثانية.
المتدينون لطالما تمكنوا من التوفيق بين العقل والروحانيات، حتى المسيحيين منهم، لكن اليساري الذي يتغنى بحب الآخر هو في الحقيقة لا يرى في الآخر ذي الخلفية الدينية سوى كائن قاصر ذا إدراك عقلي محدود بحاجة إلى عناية خاصة
المتدينون لطالما تمكنوا من التوفيق بين العقل والروحانيات، حتى المسيحيين منهم، لكن اليساري الذي يتغنى بحب الآخر هو في الحقيقة لا يرى في الآخر ذي الخلفية الدينية سوى كائن قاصر ذا إدراك عقلي محدود بحاجة إلى عناية خاصة. إنه يعتبر نفسه الأقوى ثقافيا، لذا فهو يقوم بالتربيت على كتفه وطمأنته بأنه سيقوم بتعليمه وتنويره وحمله لجادة الصواب. يقول له بعطف: "لا تقلق سأشرح لك كل شيء. تعال معي وسأعلمك كيف تستخدم عقلك". أما عندما يجيبه الآخر صراحة أنه مرتاح مع نفسه وليس بحاجة لإرشاداته يصاب هذا اليساري بالاضطراب، يبدأ بالتخبط، ويظهر عاجزا عن أي تفاعل حقيقي.
وهذا هو سبب التشوش والبلبلة الثقافية التي يعيشها الغرب اليوم. إنها تراجيديا حقيقية من أشخاص يجردون العقل من أي بعد روحي ويعتبرون الدين سفاهة وضربا من الجنون لا بأس إن أراد للمرء أن يعيشه في الخفاء، لوحده داخل غرفة مغلقة: "نفّس هنا عن مكنوناتك، لا يهمنا ما تفعله في الداخل، لا تنس فقط أن توصد عليك الأبواب والنوافذ بشكل جيد"، هذا ما يقوله عمليا اليساري للآخر حتى يتأكد أنه لن يكون هناك أي امتداد جماعي للدين. هذا النموذج الذي يفتقد للتناغم الحقيقي مع الجماعة، هو ما يقدمه اليسار في التعاطي مع الآخر ذي الخلفية الدينية، وهو ما لا يمكن اعتباره نموذجا بنّاء بأي شكل، بل هو نموذج عقيم وهدام لذاته ولغيره. لكن هذا لا يعني أن الغرب يعدم في العصر الحديث فلسفات يمكن البناء عليها لم تقم على فكرة العداء بين العقل والدين، وأبلغ مثال على ذلك هيغل…
- حتى لا نفقد النقطة التي يظهر فيها التوافق بين التام بين الفكر الليبرالي والحركات اليسارية من حيث الاعتقاد الراسخ بالتفوق الثقافي. لا يزال البعض يرى أن الحركات اليسارية الغربية المعاصرة تناهض الفكر الرأسمالي، في حين أنك في كتابك الأخير "نقد العقل الليبرالي" أوضحت كيف أن اليسار اليوم يشكل امتدادا وفيا لأكثر تمثلات الرأسمالية توحشا وربطتَ ذاك بفكر فوكو تحديدا، مؤكدا أن اليسار في وقتنا الحالي لا يشكل البتة أي تهديد على السلطة. هل لك أن توضح لنا هذه الفكرة؟
* هذا سؤال جميل جدا يحتاج إلى تفصيل في الرد عليه، لكنني سأحاول أن أكون موجزا قدر المستطاع. ما حصل لليسار هو طفرة جينية حقيقية بجميع المقاييس. فإلى غاية حقبة السبعينيات كان الإلهام المباشر وغير المباشر لجميع الحركات اليسارية هو الفلسفة الماركسية مع كل ما يتفرع عنها من قراءات، سواء أكانت علمانية صرفة على طريقة جان بول سارتر أم توافقية مع الديانة المسيحية على طريقة إيرنست بلوك. لكن بعد عام 1968 وهو التاريخ الذي يشكل هزيمة تاريخية كبرى لليسار أو ثورة تم إجهاضها، وجد المكون الماركسي نفسه بجميع أطيافه ينسحب كليا من ساحة الحقوق الاجتماعية المعادية للرأسمالية تاركا مكانه لمكون صغير جدا فيه، هو أيضا ماركسي لكنه يركز بشكل كامل على مسألة الحقوق والحريات الفردية، وقد أصبحت هذه الحركات محط تركيز فلسفي خاص لما يعرف بفلسفات بعد الحداثة التي ازدهرت في فرنسا على وجه خاص.
الأمر المثير للاهتمام هو أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم معادين للرأسمالية ويقولون إنهم يناضلون ضد البرجوازية لكنهم لا يناقشون مطلقا أي موضوع اقتصادي، بل يقومون فقط بما يخالون أنه "ثورة" من أجل تحصيل الحقوق المدنية على اعتبار أنهم أقليات. الطريف في كل هذا (والحقيقة هو أنه لا يوجد أي شيء طريف هنا) هو أن هؤلاء لا يدركون أن مقاربتهم تتناغم على نحو تام مع الفكر الليبرالي وهو ما وضع هؤلاء الأشخاص في قبضة الفضاءات الليبرالية العامة لاسيما في مجال النشر حيث جرى منحهم مساحة كبيرة جدا للتعبير عن أفكارهم بسبب التوافق التام بين الطرفين في "تسويق الأنا" وهو محور الفكر الليبرالي: الفرد هو مركز العالم… لا مرجعية أخرى في هذا العالم سوى أفكارك أنت… أنت وحدك الثورة. وهكذا تصبح الإرادة الحرة للفرد هي إرادة رجل وامرأة السوق. الأحرار في التسوق والتعبير عن تفردهم كل على طريقته. هذا هو التحرر وهذه هي الحرية.
هذا على الصعيد الفردي، أما على الصعيد الاجتماعي فلم يعد بإمكان هؤلاء اليوم أن يفتحوا فمهم بكلمة واحدة. أنت حر في التعبير عن نفسك فقط وعن فردانيتك أما إن فكرت في عمل سياسي لتغيير موازين القوى الاقتصادية مثلا ستصبح عدوا للنظام، وسيتم عزلك. وهكذا جرى حرفيا تدجين اليساريين وتحويلهم إلى خَدم للمنظومة الليبرالية. والحقيقة أن جزءا كبيرا من اليسار الغربي انتهى بين أحضان الليبرالية التي تمكنت من احتوائهم دون حتى أن يشعروا بذلك، فأصبحوا اليوم يتبنون الخطاب الليبرالي ويتكلمون بلغته دون أدنى إدراك منهم بما آل إليه وضعهم، بل يعيشون هذا الحال وهم على قناعة تامة بكونهم مناضلين وثوارا.
- هل تعتقد أن الأمر يتعلق بطبيعة النظام الليبرالي القادر على احتواء كل شيء وتسليعه وهو الذي حول الفكر الغربي ضمن هذه المنظومة إلى شيء أشبه بسلعة معولمة تتكيف بحسب الثقافة المحلية التي تُسوّق فيها وهكذا أصبحنا نجد مثلا ضمن الفكر النسوي: نسوية إسلامية، ونسوية إلحادية، ونسوية نباتية، وأخرى بطعم الكاتشب، بحسب ذوق الزبونة ومتطلباتها، أم أن الأمر يعود إلى طبيعة فلسفات ما بعد الحداثة نفسها ومطاطيتها، وهي القادرة على أن تقول حرفيا كل شيء وعكسه؟
* الأمر هو فعلا كذلك… لكن يا إلهي لا أريد أن أمارس العنصرية الثقافية على زملائي الفرنسيين (يضحك). المسألة بالتأكيد تعود للطبيعة التعبيرية لفلسفات ما بعد الحداثة نفسها، ويؤسفني فعلا القول إن أغلب الفلاسفة الفرنسيين حتى أفضلهم يميل للوقوع في غرام اللغة، يؤخذون بإيقاع الكلمات، يتتبعون وقعها وشكلها وما توحي به من صور، فيُسحرون بها ويَسحرون الآخر معهم، على نحو تصبح فيه الكلمات قادرة على التكيف مع كل قراءة لأنه ببساطة لا معنى محدد لها.
أغلب النتاج الفكري لما بعد الحداثة يترك القارئ منبهرا باستعاراته الأخاذة، لكن عندما تفكر بما خرجت به منه فعليا فلن تجد حرفيا أي شيء
والحقيقة أن أغلب النتاج الفكري لما بعد الحداثة يترك القارئ منبهرا باستعاراته الأخاذة، لكن عندما تفكر بما خرجت به منه فعليا فلن تجد حرفيا أي شيء. وهنا تحضرني مقولة أب البراغماتية تشارلز برس: "إن كنت تريد فهم جملة اسأل نفسك ما هي النتيجة التي تخلص إليها بعد قراءتها: إن لم تخرج منها بنتيجة فهذا يعني شيئين لا ثالث لهما: إما أنك لم تفهم الجملة وإما أن الجملة لا تعني شيئا". والسبب هنا هو أن منظومة المفاهيم في فلسفات بعد الحداثة تتسم بالضعف والهشاشة وعدم الاتساق، مما يجعلها في النهاية قابلة للتلون.
- دعنا لا نبتعد كثيرا عن هذه الفكرة، بعد أشهر من العدوان على غزة أصدر المفكر الجزائري أحمد دلباني كتابا بعنوان "خطيئة الدفاع عن قايين" يرد فيه على فلاسفة غربيين اختاروا التبرير لإسرائيل جرائمها في غزة على غرار هابرماس. الكتاب صدر ضمن ما يمكن وصفه بموجة ردة من الكثير من المفكرين العرب على فلسفة الحداثة وما بعدها غداة هذا العدوان الإسرائيلي. برأيك لماذا انتظر العالم العربي كل هذا الوقت ليدرك أن هذه الفلسفات تعاديه وعندما دقت ساعة الحقيقة ظهر أنها لا تقيم له أي وزن؟
* اتفقنا أن فسلفات ما بعد الحداثة قادرة على أن تسحر الآخر بجهازها التعبيري المراوغ، لكن فيلسوف كهابرماس هو حالة مختلفة تماما، ولا يفترض أن يشكل موقفه من الحرب على غزة أي مفاجأة لأحد. الرجل فيلسوف ليبرالي كلاسيكي وعلاوة على ذلك هو ألماني صاحب أفكار طالما كانت متسقة مع بعضها. هو ابن حقبة بعد التنوير المؤمن بتفوق الحضارة الغربية وهيمنتها والذي سيكون من الطبيعي أن يعتبر إسرائيل حائط صد للدفاع عن هذه الحضارة وبالتالي اعتبار أي هجوم عليها هجوما على الديمقراطية. ثقافيا نعم يمكن الرد بسهولة على هابرماس ودحض ادعاءاته ولكن المشكلة هي أن الرجل مثال حي عن الانبطاح للسلطة المهيمنة.
الأفكار لا تتحرك وحدها. هذا ما تقوله الحكمة الماركسية. كل فكرة هي بحاجة لبنية من حولها تدعمها أو تتركها تتهاوى. وهذا ما تفعله السلطة مع الكثير من الفلاسفة. هناك مثقفون مهمتهم هي ببساطة تجميل وجه السلطة
السلطة هي التي تدعم هذه النماذج. الأفكار لا تتحرك وحدها. هذا ما تقوله الحكمة الماركسية. كل فكرة هي بحاجة لبنية من حولها تدعمها أو تتركها تتهاوى. وهذا ما تفعله السلطة مع الكثير من الفلاسفة. هناك مثقفون مهمتهم هي ببساطة تجميل وجه السلطة. ولكن هذه طبعا ليست كل تقاليد الفلسفة الغربية اليوم. فقد كان هناك محاولات حقيقية لفيلسوف كهربرت ماركوزه وهو سابق لهابرماس من مدرسة فرانكفورت لانتقاد السلطة. وقد كان ماركوزه صادقا في ذلك كما أن أدواته التحليلية كانت أيضا ممتازة، لكن للأسف حاليا ما نشهده في فلسفات ما بعد الحداثة هو أن أكثرها يقوم على المخادعة، والنقد الزائف للسلطة.
- مؤخرا صرح إيلان بابيه في تعليق على إستراتيجية التفاوض التي تعتمدها أميركا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قائلا إنها "جلبت عالم البيزنس إلى الدبلوماسية" وذلك من خلال البدء بالتفاوض دوما من نقطة الحاضر وتجاهل الماضي. "بالنسبة للأميركيين لا وجود للتاريخ". هذا ما يقوله بابيه. وبالتالي لا وجود لحق العودة وكل هذه الأمور التي تنتمي إلى الماضي. في كتابك تحدثت مطولا عن عداء العقل الليبرالي التقدمي للتاريخ والتراث والماضي. ما السبب في ذلك؟
العداء للماضي هو مكون تأسيسي للعقل الليبرالي. يمكن القول إن شهادة ميلاد الليبرالية تم توقيعها عندما تم تحويل السلطة الاقتصادية إلى سلطة سياسية. والسلطة الاقتصادية كما نعلم قائمة على المال. والمال له سمة مميزة هي أن لا ماضي له. المال يمارس سلطته من كونه ببساطة حاضرا. سأعطيك مثالا بسيطا: إن كان معي حقيبة فيها مليون يورو، السلطة التي يمنحني إياها هذا المال تأتي من كوني أملكه في هذه اللحظة، ولا يهم حتى طريقة كسبه سواء أكان ذلك عن طريق النصب، أم لأنني عملت طيلة حياتي بكد، أو ربحته في اليانصيب، أو ورثته عن أبي، أو لأنني اشتغلت في الدعارة، أو بعت أعضائي… هذه كلها أمور لا قيمة لها. القيمة الوحيدة لهذا المال تكمن في قدرته الآنية على الشراء بغض النظر عن ماضيه.
لذلك إن نحن نظرنا إلى الإحداثيات الديكارتية للبيانات الاقتصادية فسنجد فقط محورين: محورا يشير إلى الحاضر وآخر إلى المستقبل. لا وجود للماضي. الماضي مبتور بالضرورة لأن كل شيء يبدأ مع عقد شراء يصبح ساريا بدءا من لحظة توقيعه. هذه الميكانيزمات تدخل بالمناسبة في عالم السياسة لأول مرة في تاريخ البشرية. في الماضي كانت السلطة السياسية تُمنح على أساس محددات شخصية تتعلق بالتاريخ الفردي أو العائلي للشخص: كأن يكون منحدرا من دم نبيل أو لأنه أثبت شجاعته في ساحات القتال. وبالتالي فإن الماضي بشكل أو بآخر هو ما يمنحه السلطة. أما السلطة اليوم فهي ترتبط بلحظة المال لا بلحظة التاريخ.
أعطني قنبلة واحدة لم يفجرها الغرب على رأس أحد في السنوات الأخيرة دون أن يقدم لها دواعي إنسانية
بالحديث عن المال، حذرتَ في كتابك من المنظمات غير الحكومية الممولة غربيا لعدة أسباب أحدها غياب المساءلة بشأن آليات عملها واعتمادها على التلاعب بعواطف الجماهير، ولكن يبقى أخطر ما ذكرته هو تحول هذه المنظمات لأداة في يد القوى الكبرى لتفعيل فلسفة "إرادة القوة". حاليا هناك قلق كبير في العالم العربي من تشجيع عمليات الهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى أوروبا من خلال بناء مرفأ يثير كثيرا من الريبة يقال إنه ذو أغراض "إنسانية"…
* "إنسانية"! (يقاطع بحسرة). أعطني قنبلة واحدة لم يفجرها الغرب على رأس أحد في السنوات الأخيرة دون أن يقدم لها دواعي إنسانية…
من خلال متابعتك لما عاشته إيطاليا في السنوات الماضية من تزايد للهجرة غير النظامية بدعم كبير من المنظمات غير الحكومية، مما دفع بالكثير من المفكرين الإيطاليين على غرار الفيلسوف دييغو فوزارو لتشبيه ظاهرة نقل المهاجرين على سفن هذه المنظمات بعمليات الاسترقاق في القرن الـ17 التي كان يجري فيها تحميل الأفارقة في بطون السفن التجارية وتحويلهم لعبيد والفرق الذي نعيشه اليوم هو تغليف العملية بغلاف "الإنسانية"… هل تتفق مع هذا الطرح؟ وما مصلحة الأنظمة النيوليبرالية اليوم من التشجيع على عمليات الهجرة غير النظامية؟
* مبدئيا المنظمات غير الحكومية تأخذ صفتها بكونها ذات مساعٍ خيّرة أم خبيثة بحسب مموليها وأجنداتهم. ليس لدي شك أن هناك منظمات غير حكومية تعمل وهي مدفوعة بأهداف نبيلة تحت إدارة أشخاص فاضلين، لكن يبقى فقط أن نتعرف على مموليها وأجنداتهم. فإشكالية هذه المنظمات تكمن في أنها مؤسسات معتمة يمكن أن يتسلل إليها بسهولة ممولون غامضون، عند تتبعهم نكتشف أننا ببساطة أمام منظمات بالاسم فقط هي غير حكومية لكنها ممولة من طرف حكومات أو جهات متنفذة لها بدورها علاقات بالحكومات. وكما هو معروف بالنسبة لموضوع الهجرة فقد خلق الغرب منظومة ثقافية جعلته يعاني من أزمة كبيرة في التكاثر لذا هو بحاجة من أجل حلها إما لتغيير نسقه الثقافي الخاص بالعائلة أو ببساطة "لاستيراد" البشر مما يُعرف باسم دول العالم الثالث أو تلك الدول التي لها فائض في اليد العاملة لسد ثغرات السوق. النظام الرأسمالي من أجل أن يحافظ على توازنه لابد له من رفع نسب الاستهلاك على نحو مطّرد وهو أمر لا يتأتى في مجتمع ذي ديمغرافية راكدة.
حالة الركود الديمغرافي هذه سببها عدم التشجيع على تأسيس عائلات، ذلك أن العائلة تقع في مرمى سهام الأنظمة الليبرالية لأن الأسرة تشكل منظومة ما قبل ليبرالية وتمثل بشكل أو بآخر بقايا غير حداثية في هذا العالم، كونها لا تخضع لمنطق السوق ولا تتجاوب مع حسابات الفائدة وغيرها
المشكلة أن حالة الركود الديمغرافي هذه سببها عدم التشجيع على تأسيس عائلات، ذلك أن العائلة تقع في مرمى سهام الأنظمة الليبرالية لأن الأسرة تشكل منظومة ما قبل ليبرالية وتمثل بشكل أو بآخر بقايا غير حداثية في هذا العالم، كونها لا تخضع لمنطق السوق ولا تتجاوب مع حسابات الفائدة وغيرها. وهكذا يصبح استجلاب المهاجر الشاب الذي يأتي جاهزا من بلد آخر عنصرا وظيفيا لسد العجز في المهن "الرخيصة" تحديدا وهذا ما يحافظ على ديناميكيات السوق ويحافظ على بقاء الأسعار منخفضة من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنح الغرب فرصة لعب دور الحضارة "الإنسانية" التي تستقبل الآخر وتنقذه من أهوال الحرب. تعتقد أوروبا أنها تضرب بهذا عصفورين بحجر واحد، ولكن هذه العملية على المدى الطويل سيكون لها أضرار رهيبة سواء على ثقافة الدول الغربية وهويتها أو ثقافة المهاجرين أنفسهم وهويتهم. ذلك أنه عندما يتم تدمير النسيج الهوياتي لأي مجتمع ستتحطم فيه سلطة القانون والوازع الداخلي للالتزام بالشرائع…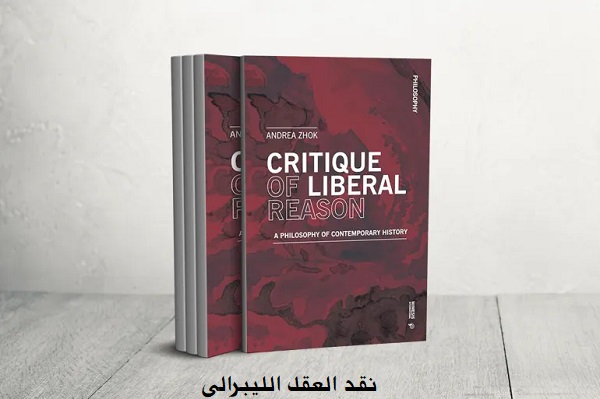 كتاب "نقد العقل الليبرالي – فلسفة التاريخ المعاصر" (2022) لأندريا زوك ترجم حديثا للإنجليزية (الجزيرة)
كتاب "نقد العقل الليبرالي – فلسفة التاريخ المعاصر" (2022) لأندريا زوك ترجم حديثا للإنجليزية (الجزيرة)
هل سيأخذنا هذا إلى ما أشرت إليه في كتابك حول ما يعرف بـ"الإرهاب الإسلاموي" في أوروبا والذي أكدت أن لا علاقة له بالفكر التقليدي للمجتمعات الإسلامية بل هو ابن الفكر الليبرالي؟
تماما، والأمر أيضا ينطبق على المهاجرين الإيطاليين والأيرلنديين واليهود وغيرهم ممن صنع في أميركا مافيات وجماعات جريمة منظمة على أساس القوميات وذلك لدعم بعضهم البعض بعيدا عن سلطة الدولة، بعد فشلهم في تحقيق النجاح في إطار القانون. وفي حالة من يندرجون ضمن مسمى "الإرهاب الإسلاموي" نعم هؤلاء هم أيضا من أبناء الغرب الفاشلين -كغيرهم من الإرهابيين الغربيين- وليسوا أبناء الإسلام.
ما نشهده اليوم هو بالفعل بداية نهاية مسار تاريخي بدأ قبل 3 قرون غيّر وجه الكوكب بداية من الثورة الصناعية مرورا بكل ما وصل إليه العالم من تقدم تكنولوجي. الغرب الذي يملك بين يديه التكنولوجيا اليوم يعاني من أزمة داخلية، وهي لا تتعلق بضياع السلطة التكنولوجية أو الاقتصادية منه ولكنه يعاني أزمة روحية
- في الفصل الأخير من كتابك قلت إن النظام الليبرالي يلفظ أنفاسه الأخيرة بالرغم من تغوّله في العالم، وذكرت بأنه قد ينتهي بمجرد ظهور جيل جديد ينتفض على هذه المنظومة. حتى نبقى في فلسطين، قامت قبل أسابيع منظمة "الشبيبة الفلسطينية في إيطاليا" على نحو غير مسبوق وغير متوقع بوصف المنظمات غير الحكومية الإيطالية المتضامنة مع فلسطين بأنها مؤسسات استشراقية تتستر بغطاء إنساني. هل تعتقد أن موقفا مفاجئا وجريئا كهذا بشأن أحد أهم أذرع الأنظمة النيوليبرالية في العالم يعد أحد إرهاصات الانتفاضة التي بشرتَ بها؟ وكيف ترى عامة الاحتجاجات الطلابية؟ وكل ما يحصل اليوم في فلسطين؟ هل هي بداية النهاية؟
* ما نشهده اليوم هو بالفعل بداية نهاية مسار تاريخي بدأ قبل 3 قرون غيّر وجه الكوكب بداية من الثورة الصناعية مرورا بكل ما وصل إليه العالم من تقدم تكنولوجي. الغرب الذي يملك بين يديه التكنولوجيا اليوم يعاني من أزمة داخلية، وهي لا تتعلق بضياع السلطة التكنولوجية أو الاقتصادية منه ولكنه يعاني أزمة روحية.
هذه الأزمة هي بالعمق والشراسة والتأثير بمكان مما سيؤدي إلى سقوط هذا النظام عاجلا أم آجلا. المشكلة هي أن التاريخ يعلمنا بأن الإمبراطوريات التي تدخل هذا النوع من الأزمات تصبح غاية في الخطورة في نهاية أيامها. الإمبراطورية الرومانية لم تبرز وحشيتها إلا وهي في مرحلة السقوط وهذا ما يحصل في الغرب اليوم…
الغرب يتشبث بالسلطة الآن من خلال هذه المنظومة المالية… من يملك السلطة لا يتخلى عنها طواعية. لذا ما أخشاه هو أننا داخلون على نهاية قد يدوم مسارها عقودا وستُفرض خلالها القيود ويتكرس القمع والمنع والرقابة، وكل ما من شأنه أن "يسيطر على الأرواح"
- تقصد تسليحه لحرب الإبادة الجارية ودفاعه المحموم عن الجرائم الإسرائيلية؟
* تماما، وهذه ليست سوى الأعراض الأولى لما يمكن وصفه أنه أزمة عصبية دخلها الغرب. هو فهم أنه خسر معركته الروحية بعد أن خسر هويته، ولكن علينا ألا ننسى أنه لا يزال يسيطر على التكنولوجيا، بالإضافة إلى حفاظه على تفوق عسكري نسبي، أقول نسبيا لأن ثمة قوى أخرى بدأت تظهر على الساحة، لكن التفوق المالي لا يزال بين يديه وبشكل كامل، هذا أمر لا شك فيه.
الغرب يتشبث بالسلطة الآن من خلال هذه المنظومة المالية… من يملك السلطة لا يتخلى عنها طواعية. لذا ما أخشاه هو أننا داخلون على نهاية قد يدوم مسارها عقودا وستُفرض خلالها القيود ويتكرس القمع والمنع والرقابة، وكل ما من شأنه أن "يسيطر على الأرواح". وعليه سأكون عقلانيا: موازين القوى بين من يملك السلطة ومن ينتقدها في الغرب هي كواحد إلى ألف، لذلك لست متفائلا بأن التغيير سيأتي من الداخل على المدى المنظور. الضغط الحقيقي سيأتي من الخارج، من خلال نظام عالمي متعدد القطبية: من كتلة الدول الإسلامية، أو من الصين أو من روسيا ولكن بالتأكيد ليس من داخل المنظومة الليبرالية نفسها.
وهنا لابد من أن أعلق بمرارة على الدور المخيب الذي تلعبه أوروبا اليوم بالرغم من إرثها الثقافي الراسخ قياسا لأميركا المارة على التاريخ… أوروبا التي "تأمركت" في السنوات الـ30 الأخيرة وكان يمكنها أن تقدم للعالم الكثير…
- إذن أنت لا ترى حتى في تنامي الحراك الطلابي في أميركا اليوم مؤشرا على تغيير قد يحدث من الداخل:
* (يهز رأسه بأسف)، لا. لكنني لن أعدم الأمل، وكما أقول دوما: بمشيئة الله يمكن أن يحصل كل شيء.
المصدر : الجزيرة
16/5/2024|آخر تحديث: 16/5/202407:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)
.................
فيلسوف والكاتب الإيطالي أندريا زوك andrea zhok - الصورة من صفحته على الفيس بوك