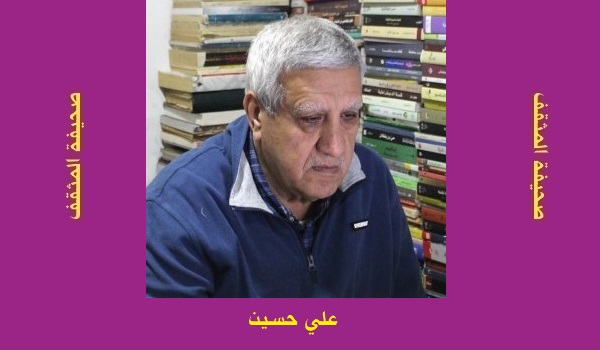اخترنا لكم
هاشم صالح: لماذا يتساقط الشعراء؟

الإنسان الحديث إنسان مُزَعْزَع لم يعد يستطيع أن يستعصم بأي شيء
بما أن العالم القديم لا يمكن أن يموت مرة واحدة، وبما أن العالم الجديد لا يمكن أن يولد دفعة واحدة، فإن الجيل الذي يعيش بينهما يشهد عادة كثيراً من التمزقات النفسية والانهيارات الداخلية. إنه جيل الاحتراق والعبور. عنيت جيلنا الحالي، أو جيل الكتاب الفرنسيين قبل 200 سنة. وهذه التمزقات والانهيارات النفسية هي التي عبّر عنها شاتوبريان بكل وضوح عندما قال: «لقد وجدت نفسي على مفترق قرنين كما يجد المرء نفسه على مفترق نهرين. وقد غطست في المياه المضطربة مبتعداً بحسرة عن الشاطئ القديم حيث ولدت، وسابحاً نحو الشاطئ الآخر المجهول الذي سوف تصل إليه الأجيال المقبلة والذي لن أراه بأم عيني».
هذا تصوير من أنجح ما يكون لعملية النقلة أو القطيعة التي تُمزقنا نحن الآن... ينبغي العلم بأن شاتوبريان ولد وعاش نصف عمره تقريباً في القرن الثامن عشر، أي قبل الثورة الفرنسية، ثم عاش نصف عمره الآخر في القرن التاسع عشر، أي بعد الثورة 1768 - 1848 (80 سنة). وبالتالي فقد شهد كلا العالمين، القديم والجديد. ولم يكن من السهل عليه أن يحدث القطيعة مع العالم القديم الذي ولد فيه وترعرع في أحضانه. من يستطيع أن ينسى طفولته وشبابه الأول؟ وهو عالم مسيحي، كاثوليكي، زراعي، ريفي، في معظمه. هذا في حين أن العالم الجديد ابتدأ يصبح علمانياً، صناعياً، فلسفياً، مضاداً للدين عموماً أو قل للأصولية الدينية لكي نكون أكثر دقة. فالحداثة التنويرية لم تكن ضد الدين في المطلق، وإنما ضد التصور الانغلاقي القديم للدين. الحداثة ولّدت تأويلاً جديداً للدين المسيحي هو التأويل الليبرالي اللاطائفي الذي شاع وانتصر لاحقاً في كل البلدان الأوروبية المتقدمة. ولكن ذلك لم يتم دون مخاض عسير وصراعات هائجة. وهذا المخاض هو الذي ابتدأنا نعيشه نحن الآن في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي فالمسافة الفكرية التي تفصل بيننا وبين الأوروبيين هي 200 سنة على الأقل فيما يخص المسألة الدينية. ما عاشوه وعانوه قبل 200 سنة من حزازات وطوائف ومذاهب وصراعات وحروب أهلية وتمزقات، نعيشه نحن ونعانيه الآن. لذلك قلت وأقول إن الزمن العربي الإسلامي غير الزمن الأوروبي، بمعنى أننا متعاصرون زمنياً، ولكننا لسنا متعاصرين معرفياً ولا فلسفياً ولا سيكولوجياً. بيننا وبينهم يوجد تفاوت تاريخي كبير. وينبغي أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار لكي نفهم ما يحصل حالياً ولكي نستطيع أن نقيم علاقة صحيحة مع الفكر الأوروبي ومع أنفسنا أيضاً... ما أجمل أن تغطس مع شاتوبريان في كتابه الخالد «مذكرات ما وراء القبر»، هناك حيث يرتفع بالنثر الأدبي الفرنسي إلى أعلى عليين أو ينخفض به إلى أسفل سافلين! ليس في كل يوم يظهر كاتب كبير...
مهما يكن من أمر، فإن الإنسان الكلاسيكي كان قد انتهى في عصر الرومنطيقية وشاتوبريان. ونقصد به الإنسان الكامل، الخالد، الثابت، الذي لا يتغير ولا يتبدل. إنه إنسان القناعات المؤكدة واليقينيات الراسخة. إنه إنسان القيم الواثقة ذات الطمأنينة الكاملة التي لا تشوبها شائبة. وأما الإنسان الحديث فهو إنسان مُزَعْزَع، مترجرج، قلق، لم يعد يستطيع أن يستعصم بأي شيء. فالعالم القديم انهار أو كاد، واليقينيات الكبرى التي كان يركن إليها الإنسان القديم انهارت معه. لهذا السبب راح الشاعر الرومنطيقي يشعر بالهلع والجزع أمام العالم الجديد الذي ينفتح أمامه. لهذا السبب راح يلجأ إلى البكاء والنحيب والعويل. وهكذا امتلأ شعره بتلك البحة الغنائية الحزينة، أو النزعة العاطفيّة الفياضة والمؤثرة. لنستمع إلى أحد كبار الشعراء الرومنطيقيين الفرنسيين ألفريد دوموسيه يتحدث عن تلك الفترة:
«وا أسفاه! لقد انتهى الدين. انتهى كل شيء. وغيوم السماء تتساقط مطراً. ولم يعد لنا أي أمل. لم نعد ننتظر أي شيء من الغيب، ولا قطعتين من الخشب تشكلان صليب الأمان بالنسبة لنا. وأما نجم المستقبل فلما يكد يبزغ بعد. إنه لا يستطيع الخروج من رحم الأفق. وإنما يظل مغلّفاً بالغيوم. وكالشمس الشتائية يتبدَّى لنا أحمر كالدم المراق عام 1793 (إشارة إلى الثورة الفرنسية). لم يعد هناك حب، ولا مجد. يا له من ظلام سميك، سميك، يطبق على وجه الأرض! وعندما يطلع الفجر الجديد للعالم سوف نكون قد متنا...».
بمعنى آخر؛ نحن جيل القطيعة، نحن جيل الاحتراق والعبور. نحن جيل الموت والولادة في آن معا. نحن جيل التمزق بين جيلين. سوف نشهد موت العالم القديم حتى النخاع دون أن يتاح لنا أن نكحل أعيننا بولادة العالم الجديد... هذا هو قدرنا ومصيرنا... نحن جيل التضحية والفداء. والعالم الجديد لن ينبثق إلا على أنقاضنا. لا أعرف لماذا أتذكر الآن تلك الأبيات الجميلة لخليل حاوي...
يعبرون الجسر في الصبح خفافاً
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد
من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق
إلى الشرق الجديد
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيد
هل تنبأ خليل حاوي بتلك القطيعة الإجبارية التي ستفرض نفسها علينا إذا ما أردنا الانتقال من عصر الظلمات إلى عصر الأنوار، أو من عصر العبودية إلى عصر الحرية؟ على الأقل فإنه أحس بخطورة المسألة ورعبها، وربما لهذا السبب انتحر... فما بالك لو أنه عاش وشهد ما يحصل في غزة حالياً؟ كان قد انتحر 10 مرات... ولكنه - وهنا تكمن شهامته - قبل بأن يكون الضحية وخشبة الخلاص للأجيال القادمة. قال ما معناه؛ ليمشوا على أضلعي، ليدوسوا على جسدي، ليتخذوه جسراً تحت أقدامهم ونعالهم، إذا كان ذلك سيساعدهم على العبور إلى الضفة الأخرى؛ ضفة الإنقاذ والخلاص. ولكن ما كان ينبغي عليه أن ينتحر لأنه فقد بذلك إمكانية التحول إلى قدوة عليا، إلى منارة، للأجيال القادمة. الانتحار ليس حلاً. الانتحار هزيمة غير مقبولة أياً تكن خشونة الواقع. الانتحار خور، جبن. الانتحار عيب بل عار. الانتحار لا يليق بالرجال. المتنبي لم ينتحر وإنما سقط مضرجاً بدمائه! هذه ميتة حقيقية، ميتة عزّ وشرف لا تليق إلا بأعظم شاعر عربي. ولكنه ليس الوحيد. معظم العباقرة الكبار سقطوا بطريقة أو بأخرى تحت ضربات القدر. سقراط، ديكارت، سبينوزا، جان جاك روسو، جمال الدين الأفغاني، عبد الرحمن الكواكبي. نعم. نعم. لقد قتلت الأخيرين السلطنة العثمانية البائدة بالسم الزعاف (العملية سهلة وبسيطة جداً، فنجان قهوة فقط!). هذه السلطنة التي يحن إليها البعض حالياً ويريد إعادتها مجدداً. ولكن الشعب التركي الكبير والمستنير لن يقبل بالعودة إلى الوراء. يقول لنا الفيلسوف الفرنسي الراحل ميشيل سير؛ لقد درست حياة مثقفي فرنسا على مدار 400 سنة فوجدت أنهم كانوا جميعاً مهددين. ولا واحد منهم عاش مرتاح البال. كلهم كانوا ملاحقين من قبل الأصولية والأصوليين، الظلامية والظلاميين. لماذا؟ لأنهم خرجوا على كهنة الماضي الذين تقدسهم الجماهير وفتحوا ثغرة في جدار التاريخ المسدود. لأنهم حاولوا - ونجحوا! - في فك الاستعصاء التاريخي. لأنهم دشنوا القارات البكر للفكر، هذه القارات التي لا تخطر على البال. فكان جزاؤهم الاغتيالات والملاحقات. ولكن نيتشه نبهنا منذ زمن طويل إلى هذه الحقيقة؛ كل فكر لا يقف على حافة الخطر لا يساوي قشرة بصلة. الفكر والخطر صنوان! وفولتير، أستاذ نيتشه، نبهنا إلى حقيقة أخرى؛ وهي أن الذين يزرعون بذور التنوير غير الذين يحصدون. قال؛ لن أرى بأم عيني نتائج فكري ومؤلفاتي، وهذا لا يزعجني أبداً أبداً. على العكس، أشعر بالسعادة القصوى لأن الأجيال القادمة هي التي ستقطف الثمار. وقد قطفتها. فلولا جهوده وجهود سواه من فلاسفة الأنوار لما تحررت فرنسا من تلك العصبيات الطائفية الكاثوليكية - البروتستانتية التي مزقتها طويلاً ودمرت وحدتها الوطنية.
ولكن بعد أن تحررت الأجيال الفرنسية من الأصولية والطائفية ما عاد مفهوماً استمرار معاداة الدين والقيم الروحية كما يفعل ميشيل أونفري بكل حماقة وتهور في فرنسا حالياً. لماذا يثقب هذا الشخص أبواباً مفتوحة؟ لطالما طرحت على نفسي هذا السؤال وأنا أقرأ كتبه الشيقة والمبدعة في قسم منها. هل فعلاً أن الأصولية المسيحية هي التي تهدد فرنسا حالياً أم الإباحية الجنسية المنفلتة كلياً من عقالها؟ ولذلك أقول؛ لا مصلحة للمثقفين العرب في تقليد التيار الإلحادي المادي الشذوذي المطلق السائد في الغرب حالياً. بل نحذر منه كل التحذير. فنحن ليست مشكلتنا مع الدين وسموه وتعاليه وإنما مع الظلامية الدينية. نحن مشكلتنا مع الطائفية التي تمزقنا وتمنع تشكيل الوحدة الوطنية العزيزة الغالية فيما بيننا. أقول ذلك وأنا أتذكر عبارة جبران خليل جبران الرائعة؛ ويلٌ لأمة كثرت فيها الطوائف وقل فيها الدين!
***
د. هاشم صالح
عن صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، يوم: 21 يناير 2024 م ـ 09 رَجب 1445 هـ