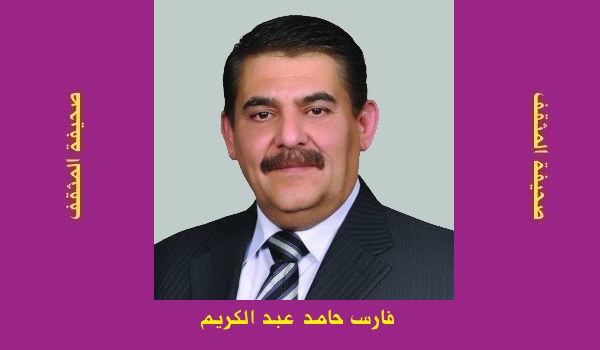قراءات نقدية
إحسان ناصر الزبيدي: السرد الحر.. تحولات ما بعد الحداثة

وخروج النص الروائي من عمود السرد التقليدي... روايات كاظم الشويلي انموذجا
منذ أن وصل السرد العربي الكلاسيكي إلى مرحلة الاستقرار في أنماطه المألوفة – بدءًا من المقامة ومرورًا بالحكايات الشعبية وانتهاءً بالرواية الواقعية التقليدية المتأثرة بالثقافة الأوربية – كان يلتزم بما يمكن أن نطلق عليه (عمود السرد) والذي أشارت له الدكتورة (بشرى موسى صالح) في كتابها عمود السرد ما بعد الحداثي(1) وأعني به مجموعة من الأعراف التي تضبط نسقه، مثل: الخطية الزمنية، والحبكة المترابطة، والبطل التقليدي، واللغة الإنشائية المتزنة والبليغة، والراوي العليم الذي يتدخل مباشرة في ربط الأحداث، والعمل على إقناع المتلقي بواقعية الرواية، فضلاً عن الموضوعات المكرّرة والموروثة ذات الأفق الأخلاقي القيمي أو الترفيهي. لقد كان هذا العمود بمثابة القانون الضمني الذي يمنح السرد شرعيته ويحدّد ملامحه، غير أن هذا الإطار الصارم بدأ يتعرض لهزات كبرى مع صعود الحداثة، ثم جاءت ما بعد الحداثة لتعلن تحرّر السرد من (العمود) وخروجه عن سلطته إلى فضاءات الانفتاح والتجريب، فأخذ منحى مغايرًا قوامه كسر خطية الزمن، وتفكيك التسلسل إلى شذرات متفرقة، وتجريد الراوي العليم من سلطته وفتح المجال لأصوات متعددة، وعدم التحرّج من استعمال لغة متداخلة بين الفصيحة والعامية، بين النثر والشعر، بين الجد والهزل، فأصبحت اللغة نفسها موضوعًا للتساؤل والتشظي لا مجرد وسيلة للحكي، فضلا عن البطل الإشكالي، وتسليط الضوء على موضوعات كانت تمثّل تابوات في السرد التقليدي مثل: الجنس والسياسة والدين والهوية، وأيضًا العناية بالهامشي واللامألوف، والنصوص الموازية، والتناص، والعجائبي وتمظهراته المختلفة، والتداخل الأجناسي، والعمل على جعل القارئ شريكًا في إنتاج المعنى، إذ يعتمد النص على الفراغات والفجوات، ويترك له حرية التأويل، فيتحول النص إلى فضاء مفتوح لا نهائي، وتحطيم الحدود بين الواقع والمتخيل عبر تقنيات ما وراء السرد (Metafiction) وهي تقنيات كتابية يتم توظيفها في "روايات وقصص تلفتُ الانتباهَ إلى وضْعها الخيالي وإلى وقائع تأليفها"(2) حيث يُفصح النص عن أنّه مجرد حكاية متخيّلة، ويسلّط الضوء بشكل مباشر على طرائق كتابته عبر التعليق بأسلوب نقدي تحليلي على بنيته الأدبية، ممَّا يسهم في التلاعب بالحدود الفاصلة بين الوهم والحقيقة، ويعري لعبته السردية أمام القارئ الذي يجد نفسه جزءًا من عالم الرواية، وإقحام الروائي لاسمه وصفاته والكثير من تفاصيل حياته في المتن الحكائي، فيغدو الروائي كاتبًا وشخصية وموضوعًا في آن واحد، ممّا يتيح للقارئ الاطلاع على عملية الكتابة من داخلها، وهذا ما عمل عليه (كاظم الشويلي) في رواياته القصيرة الثلاث: (نيران ليست صديقتي، ومواسم الثلج والنار، وروايتي الفائزة بالجائزة) فالشخصية الرئيسة التي تتولّى سرد الأحداث في هذه الروايات التي تشبه المتوالية، هي شخصية (كاظم الشويلي) الذي يظهر داخل النص بصفته المرجعية كاتبًا وناشرًا، ففي روايته (نيران ليست صديقتي) يقحم شخصيته الحقيقية في نضالاتها كـأسير حرب عراقي ضمن الإطار الروائي(3) الأمر الذي يكسر من خلاله ما يُعرف بـعقد القراءة التقليدي. إذ لم يعد القارئ يتعامل مع شخصيات من ورق، بل مع شاهد على التاريخ يحمل ثقل تجربته الحقيقية. وفي هذا النوع من التقنيات السردية، تتفوق سلطة الواقع على سلطة التخييل، ويصبح الهدف الأساس للنص ليس الإمتاع الفنّي فحسب، بل الشهادة، والتوثيق، ويتم استخدام الأدوات الروائية كالبنية السردية واللغة؛ لتعزيز مصداقية الحقيقة المسرودة، وتصبح مهمة الراوي مضاعفة، فهو لم يعد يخلق عالمًا متخيّلاً، بل يعيد إنتاج عالم عاشه بالفعل.
تنتمي رواية (نيران ليست صديقتي) بامتياز إلى تيار أدب الذاكرة وأدب الحرب مع تركيز خاص على تداعيات (الحرب العراقية-الإيرانية) وتأثيرها الممتد إلى الأجيال اللاحقة، فهي تجربة سردية متجاوزة؛ لأنَّها تستثمر في سلطة الواقع لتوثيق صفحة منسية من تاريخ الحرب، لم يسبق لروائي عراقي أن خصّص لها رواية "يا كاظم... أنت تؤرشف تاريخ لا نعرفه ولا نعلمه، وقد دثرته الحروب الكثيرة لبلدنا بالنسيان والإهمال...هل تعلم يا كاظم انك اول كاتب يتناول رواية عن الاسرى العراقيين"(4). إن استخدام الراوي إطارًا سرديًّا مُفلترًا عبر شخصية (نيران) -التي مثّلت مستودع الذاكرة المؤلمة التي تروي قصص الحبّ والفقد في زمن الحرب والشتات-والتواصل معها عبر (الماسنجر) يحوّل كاظم الشويلي -بصفته أسيرًا حقيقيًّا- إلى علامة للذاكرة الجماعية لجيل كامل من الأسرى العراقيين، فالرواية لا تسرد قصته هو فحسب، بل تُقِرّ بوجود قصص لآلاف من الضحايا الذين لم تُروَ حكاياتهم.
تعتمد الرواية على الحكاية المضمَّنة التي تخص مصير الأسرى العراقيين (كاظم الشويلي، والضابط مرتضى) وتفاصيل معاناتهم، وعلى الحكاية الإطارية (حكاية الحب التي جمعت نيران وكاظم الشويلي) عبر وسيط حديث وهو التواصل الرقمي (الماسنجر/الدردشة)(5)؛ لـتذويب مرارة الحقيقة في نسيج يمكن للقارئ الحديث التفاعل معه. هذا الدمج بين الشخصيات الحقيقية والآلية السردية الحديثة (الإنترنت) يؤكد أن الذاكرة في العصر الرقمي لا تُستعاد إلا عبر جسور معقدة تصل الماضي الوثائقي بالحاضر الافتراضي. كما أنَّ اختيار الماسنجر كآلية لسرد الماضي ليس مجرد اختيار شكلي، بل هو تعبير عن إشكالية الذاكرة في العصر الحديث، إذ يصبح الفضاء الرقمي مختبرًا لإعادة بناء التاريخ الشخصي والجماعي، حيث تتيح هذه التقنية البوح بأسرار ظلَّت مدفونة لعقود.
تتقاطع في النص مجموعة ثيمات عميقة تشكّل جوهر الخطاب الروائي، من بينها صدمة الأسر والهوية، إذ يتجلى الموضوع الأهم في مصير الأسير العراقي كاظم الشويلي وذكره المتكرر، تجاوز السرد الجانب العسكري والسياسي والغوص في الجانب الإنساني عبر التركيز على تفاصيل الأسر، وصورة الأسير، والشوق إلى رؤية الأهل، ممَّا يجسّد الكيفية التي حوّلت الحرب إلى ندوب شخصية لا تُمحى "اظن كان دخولنا لهذا المعسكر بتأريخ 22/ 6/ 1987 أحسست حينئذ بشعور غريب يداهمني ويحيلني إلى قطعة من الحزن العميق، وامتزج الحزن بالفرح برغبة عارمة بالبكاء، لأول مرة اشعر بالغربة عن الوطن والحنين إلى الأهل والرغبة بالموت او النوم دون استيقاظ"(6)
أمَّا رواية (مواسم الثلج والنار)(7) فقد قدّمت مادة سردية ثرية تتقاطع فيها المحاور الشخصية والوطنية والاجتماعية، مُوظفة تقنيات الحوار والتناوب في السرد للكشف عن عمق الأزمة النفسية والوجودية للشخصيات، وتداعيات الأوضاع السياسية والاجتماعية على الفرد العراقي، خاصة ثيمة الحرب، والشتات والصراع الطائفي، واغتراب الذات. استخدمت الرواية لغة مباشرة وحوارات سريعة لتكثيف التوتر، جاعلة من العلاقة بين كاظم و وداد مجازًا لتمزق الذات العراقية بين الانتماء إلى الوطن المثقل، والانسحاب إلى الذات أو الفضاءات البديلة.
اعتمد السرد فيها على تتابع حوارات مكثفة ومواقف درامية تتخللها مونولوجات داخلية، يظهر ذلك بوضوح في تبادل الحوارات بين كاظم الشويلي (الراوي المحوري/الشخصية الرئيسة) ووداد المهندسة، وبين كاظم وزوجته، ممَّا يكشف عن التوتر المستمر في العلاقات. هذه الأصوات تشكل نسيجًا صوتيًّا يكسر سلطة صوت الراوي الأوحد، الأمر الذي يعزّز واقعية الحدث وتعدّد زوايا النظر للأزمة.
تضمّنت الرواية ثيمات رئيسة تبرز من بينها بقوة ثيمة الاغتراب، اغتراب الشخصيات عن محيطها الاجتماعي (كاظم وزوجته)، واغترابها الجغرافي (وداد)، واغترابها الروحي (كاظم وعلاقته بالفيسبوك/الصور المثالية). هذا يتقاطع مع سياق الرواية العراقية التي تتناول تشتت العراقيين وضياع هويتهم. أمَّا صراع الأزواج فهو الآخر شكّل ثيمة واضحة إذ استطاع الراوي أن يصوّر الصراع بين كاظم وزوجته بطريقة درامية (تتبعها، تنصتها، تصنع عدم المبالاة)(8) وظهرت الزوجة (ام علاوي) وهي تمثّل قيود الواقع البغدادي المحافظ (9)، بينما مثّلت (وداد) إغراء التحرّر والهروب من هذا القيد(10).
الأمكنة في هذه الرواية مأزومة مثل: بغداد، الكاظمية، ساحة عدن، العلاوي، هي الأخرى ثيمة مهمة، فهذه الأماكن ليست مجرد خلفيات، بل هي أطراف في الصراع الطائفي الذي شهده العراق بعد 2003، فقد طلبت وداد من سائقها كاظم اللقاء في ساحة عدن في مدينة الكاظمية، فأجابها: "أخاف من الطائفية أن تأكلنا!"(11) هذا الجواب يُحوّل المكان إلى فضاء سياسي-اجتماعي ملغّم، حيث يصبح اللقاء العادي محفوفًا بخطر الهوية والاقتتال.
لقد مثّل الفيسبوك في نهاية الرواية ثيمة أخرى ونقطة تحول درامي، إذ يشي بانتقال الصراع من حيز الواقعي الملموس إلى الحيز الافتراضي الذي يخلق صداقة مع حورية مغتربة(12)، ممَّا يعكس محاولة البطل اليائسة لتصنيع بطلة سحرية تهزمه وتنقذه في آن واحد.
امَّا رواية (روايتي الفائزة بالجائزة) فيبدأ السرد بـتشخيص الطبيب لحالة (كاظم) وكان هذا التشخيص بمثابة صدمة قاسية "يا كاظم، سوف تموت بعد اقل من ثلاثين يوماً"(13) ممَّا يشكل نقطة الانطلاق الدرامية، فالأحداث التي تلت هذه البداية القاسية، مثل التبرع بالأموال والتخطيط للسفر والعلاج، كلها تخدم فكرة مواجهة الموت(14) لقد اعتمدت الرواية على بناء سردي معقّد يزاوج بين السيرة الذاتية المتخيلة (رحلة الموت الوشيك) والرواية الفنية (الرواية الداخلية) لتطرح تساؤلات جوهرية عبر الفن حول الموت/ الخلود، وحول صراع المادة/ الروح، وقيمة العمل الإبداعي. إنّها رواية فكرية تتخفى في ثوب القصة، وتتّسم بلغة غنية، وقدرة على الغوص في أعماق الشخصية الرئيسة.
تكشف الرواية عن واحدة من أهم تقنيات ما وراء السرد، وهي تقنية (الرواية داخل الرواية) فالنص يقدم سردًا أساسيًا بضمير المتكلم لـ (كاظم) الذي يتلقى صدمة الحكم الطبي بقرب الأجل، ويتوازى معه سردٌ آخر يُكشف لاحقًا أنه من كتابة (كاظم) بعنوان "روايتي الفائزة بالجائزة"(15) هذا التداخل يثير تساؤلات حول علاقة الراوي بكتابته، وهل الرواية الداخلية هي محاولة للمقاومة أو الخلود أو مجرد انعكاس لحالته النفسية؟.
سيطرت على النص أسئلة وجودية وفلسفية حول الموت والحياة والتحولات الروحية إذ يُعدّ المشهد العجائبي الخاص بالمقبرة، والذي صوّر لقاء روح (كاظم الشويلي) وجسده نقطة تأمل ميتافيزيقية عميقة حول كينونة الإنسان. كما يمثّل تأكيدًا لـما طرحه الراوي من أفكار تتعلّق بكتابة الرواية وأهميتها، والعناصر الفنية التي يجب أن تتوافر فيها، والأهداف المرجوة من وراء كتابتها(16).
وممَّا يلحظ على الرواية استخدامها لغة ذات نبرة عاطفية عالية وشاعرية(17)، خاصة في وصف مشاعر الراوي الداخلية(18) وأيضًا غلبة أسلوب السرد التأملي الداخلي على النص، الأمر الذي كشف عن صراعات الراوي وأفكاره العميقة(19) وزاد من عمق التجربة النفسية للشخصية الرئيسية.
تكشف الصفحات الأخيرة عن انعطافة سردية وتحوّل جذري في مسار الرواية، فبعد الصدمة الأولى المتمثلة بقرب الموت وحتميته، يأتي الخلاص بفضل نجاح عملية القلب(20) هذا التحول يعكس انتقالاً من صراع الإنسان مع الموت إلى صراعه مع ذاته. كما أنَّ سؤال كاظم للطبيب غسان عن سبب "التورم في القلب وكيف هو استأصله وعن كيفية رفع القلق والتوتر"(21) يرمز إلى أن المشكلة الحقيقية لم تكن جسدية محضة، بل نفسية وجودية. هذا يوجه الرواية نحو مغزى أكثر عمقًا يتجاوز التشخيص الطبي.
وممَّا يلفت نظر القارئ في هذه الرواية أن البنية المتداخلة للراوي/الكاتب تمنح النص عمقًا ماورائيًّا، وتسمح للكاتب بطرح أسئلة وجودية وفلسفية حول قيمة الإبداع في مواجهة الفناء. إنّها رواية تصف رحلة البطل من صدمة الموت إلى صفاء الروح، لتؤكد أن النصر الحقيقي يكمن في التصالح مع الذات وتحقيق الرضا الإلهي لا مجرد الظفر بـجائزة أدبية "ليس من المهم أن تفوز روايتي بجائزة ما، إنما أطمح فقط أن تفوز روايتي عند الله، وهذا الفوز يكفيني وأملي الوحيد أن أظفر بالرضا الرباني"(22).
لقد استطاع الراوي ومن خلفه الروائي الواقعي في الروايات الثلاث-عبر توظيف تقنية ما وراء السرد وتنويعاتها- التمرد على تقاليد الكتابة التقليدية والتحرر من قيودها الجمالية، فعمل على كسر الإيهام السردي وتفكيك وهم الحكاية التقليدية عبر حديثه بصورة مباشرة مع القارئ المفترض(23) ممَّا يعيد للقارئ وعيه النقدي يجعله مشاركًا في انتاج المعنى، ومن تنويعات ما وراء السرد التي وظّفها (الشويلي) أن ظهر الراوي حاملا اسم الروائي الواقعي والكثير من السمات الشخصية التي تنطبق عليه "كاظم الشويلي، قاص، روائي، ناقد، ناشر..."(24)، وعضو اتحاد أدباء العراق، وعضو نقابة الصحفيين، وباحث، وكاتب لمئات المقالات النقدية والثقافية(25) الأمر الذي أحدث تداخلاً بين الواقعي والتخييلي وفجّر الحدود بينهما، وخلخل ثقة المتلقي بواقعية السرد، وبما إذا كان الراوي كائنًا سرديًّا متخيّلاً أم تجسيدًا لصوت الروائي المرجعي نفسه؟ وفضلا عن ذلك بدا الراوي منهمكًا بكتابة رواية(26) وبالحديث عن هذا الجنس السردي وأهميته وقدرته على معالجة قضايا المجتمع، وما يجب على الكاتب أن يتعلّمه، وما يتناوله من موضوعات ومفاهيم، وما هي الرسائل التي يبغي من خلاله إيصالها للمتلقي(27) والانشغال بكتابة القصص والمقالات الأدبية، ونشر روايته عن وداد وعن مواسم الثلج والنار والرعب في الجبهة(28) وزحمة أعماله في دار الطباعة والنشر(29).
ومن التقنيات التي وظّفها الشويلي هي تقديم الراوي رؤية نقدية داخلية لمواصفات العمل الأدبي الناجح، فالرواية التي تطمح للفوز بجائزة ما يجب أن تكون "مميزة وشيقة، ومليئة بأفكار مبتكرة وجاذبة وشخصيات قوية ومؤثرة، وقد يكون للأسلوب السردي واللغة دور كبير في الفوز بالجائزة"(30) كما بدأت هذه الرواية بتشخيص طبي أفصح عن الموت والفناء وانتهت بالشفاء والخلود الروحي. هذا الانتقال من (الجسد المريض) إلى (الروح المطمئنة) يمنح الرواية بنية دائرية أو تصالحية، وهذه البنية تُعدّ من أبرز السمات البنيوية التي تعبّر عن وعي سردي متقدّم، ففي الروايات التي تمارس ما وراء السرد، تمثل الدائرية وعيًا بالبناء ذاته، أي أن الرواية تعترف بأنها تُعيد الحكاية أو تكرّرها بوصفها لعبة فنية. وهنا تصبح الدائرية نوعًا من التأمل الذاتي في فعل السرد، وتؤكد أن الحكايات لا تنتهي فعلاً، بل تُروى بطرائق مختلفة، فضلا عن تأكيدها حتمية المصير، فحين يعود السرد إلى نقطة البدء، فإن هذا يشير أحيانًا إلى أن الشخصية لم تستطع الفكاك من قدرها، فكل ما جرى كان استدارة حول المصير ذاته.
لقد مثّلت روايات كاظم الشويلي الثلاث: (نيران ليست صديقتي، ومواسم الثلج والنار، وروايتي الفائزة بالجائزة) نموذجًا بارزًا لتحولات السرد ما بعد الحداثي في الرواية العراقية، وإعلانًا لتحرّر النص من قيود (عمود السرد) التقليدي. لقد تحوّل السرد في هذه الروايات إلى فضاء مفتوح لا نهائي، فضلا عن أن الشويلي نجح في توظيف تقنية ما وراء السرد وتنويعاتها بفاعلية عالية، متمرّدًا على تقاليد الكتابة التقليدية.
***
ا. م. د. إحسان ناصر حسين الزبيدي
...................
الهوامش:
(1) ينظر، عمود السرد ما بعد الحداثي النص الكاشف عن الرواية العراقية بعد 2003، بشرى موسى صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2023.
(2) الفن الروائي، ديفيد لودج، تر، ماهر البطوطي، مؤسسة هنداوي، 2023: 228.
(3) ينظر، نيران ليست صديقتي، كاظم الشويلي، دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط 5، 2024: 5، 11، 14.
(4) نيران ليست صديقتي: 15
(5) ينظر، م.ن: 6
(6) نيران ليست صديقتي: 15.
(7) مواسم الثلج والنار، كاظم الشويلي، دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط 4، 2024.
(8) ينظر، مواسم الثلج والنار: ،5، 7، 16.
(9) ينظر، م.ن: 6
(10) ينظر، م.ن: 7.
(11) م.ن: 5
(12) ينظر، م.ن: 98)
(13) روايتي الفائزة بالجائزة، كاظم الشويلي، دار الورشة الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط3، 2024: 5
(14) ينظر، م.ن: 6-7
(15) روايتي الفائزة بالجائزة: 17
(16) ينظر، م.ن: 26-32.
(17) ينظر، م.ن: 11
(18) م.ن: 47
(19) ينظر، م.ن: 5-11
(20) ينظر، م.ن: 53
(21) روايتي الفائزة بالجائزة: 52
(22) م.ن: 73.
(23) ينظر، نيران لست صديقتي: 19، وينظر كذلك، مواسم الثلج والنار: 21
(24) نيران ليست صديقتي: 47
(25) ينظر، مواسم الثلج والنار: 7، 19
(26) ينظر، نيران ليست صديقتي: 14، 33.
(27) ينظر، نيران ليست صديقتي: 55-57
(28) ينظر، مواسم الثلج والنار: 98
(29) ينظر، روايتي الفائزة بالجائزة: 17
(30) م.ن: 57.