قراءات نقدية
جبَّار ماجد البهادليّ: شَواخصٌ سَرديَّةٌ مِن رِحْلَةِ البَحثِ عَنِ المَجهُولِ
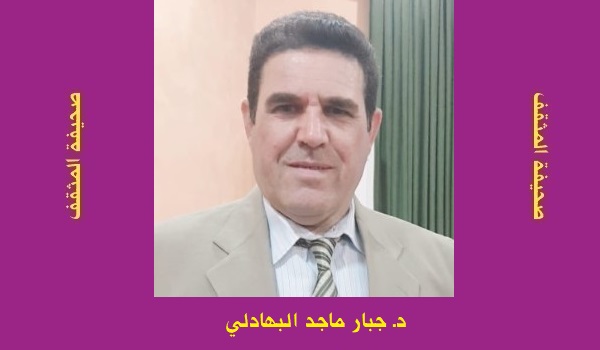
دِراسةٌ نَقديةٌ فِي رِوايَةِ الحُبِّ والحَربِ (طِفلٌ ودَفترُ ذِكريَاتٍ)
تقديم: (الحبُّ والحربُ)، دَالَتَانِ مُتضادتانِ، ونقيضانٍ لَدودانِ لا يلتقيانِ على هوى المَحجَّةِ أبداً وعلى الدوام . وإنْ التقياً صُدفةً من غيرِ تخطيطٍ سابقٍ لهما، فلا يولِّدان إلَّا الموتَ المُرَّ الزُّؤامَ من ثنائية (الحياةِ والموتِ)، أي لا يمكن أن أكون قائماً في حيزِ هذا الفضاء الوجودي الإنساني؛ لذلكَ لا يمكن لِأيِّ حُبٍّ أنْ يُعمرَّ أو يدومَ بأمنٍ وسلامٍ على أعقاب فتيلِ حربٍّ تشتعل استعارَاً، فلا تَعرفُ معنىً للحبِّ ولا لأبجدياتِ لُغةِ الحياة. وفي الطرف الآخر من المُعادلة، لا يمكن لحربٍ ضروسٍ أنْ يقوم سعير لظاها المُجْمرِ اليابس على مأكلٍ من أخضر الحبِّ والخير والسلام، وهذه نتيجةٌ حتميةٌ محسومةٌ لا بدَّ من فهمها إنسانياً ومجتمعياً في ظلٍّ حكم الاستبداد ودكتاتورية العَهد الجائر المُباد.
هذه المقدِّمة التعريفية الموجزة الكلام لثنائية (الحَربِ والسَّلامِ)، أو ما يُعرف مفهوماً بلغة الحبِّ والدمار، هي الثيمة المهمَّة و الرئيسة لبؤرة هذا العمل الأدبي السردي المرير، والتي تُمثِّلُ نقطة الانطلاق الأساسيَّة والمركزية لاشتغالات نصوص رواية (طفلٌ ودفترُ ذكرياتِ)، للروائي العراقيِّ المثابر حسن الموسوي، المعروف بأسلوبيته التعددية التعبيريَّة شعراً ونثراً، (قصَّةً وروايةً ونقداً).
هذه المدوَّنة الروائية البيئية الإنسانية، يقدِّمُ فيها السيِّد الموسوي شهادةً حُرَّةً توثيقيةً مُهمَّةً، وأرخنةً عينيةً تدوينيَّةً سرديَّةً حيَّةً ومؤلمةً عن خريطة السنوات الثمانِ العجاف من عمر بدء تاريخ الحرب العراقية الإيرانية التي قامت في النصف الثاني من ثمانينيَّات القرن العشرين بين البلدين الجارينِ. ويكشف في الوقت ذاته عن سياسة التسفير والتهجير العرقي والإثني الطائفي للكورد الفيليين العراقيين من التبعية الإيرانية التي تدَّعيها سلطة النظام البعثي وتوجَّهاته العنصرية الجديدة بحقِّهم. فضلاً عن جملةٍ من ممارسات أجهزة القمع الأمني والسياسي والاستبداد السلطوي والبطش بحقٍّ الأحزاب الإسلاميَّة، وخاصةً أفراد حزب الدعوة الإسلاميَّة المُعادين لسياسية نظام الحكم القائم.
إنَّ رواية حسن الموسوي التي احتفت ثيمتها المركزية بثنائية (الحبِّ والحربِ)، تُعدُّ إحياءً للذاكرة العراقية المُتَّقدة، وترجمةً حيَّةً عن حياة شهداء الحرب المُضحِّين، وتقدِّمُ تدويناً مؤرشفاً لسيرة وحياة بعضٍ من الأسرى العراقيين المعذَّبينَ في مُخيمات وثكنات الأسر، وتُعطي صورةً حقيقيةً جمَّةً عن الكثير من المُغيَّبينَ والمُعدمينَ من عوائل المُهجَّرين والمُسفَّرينَ العراقيينَ في جمهورية إيران.
وفق بناءٍ أُسلوبي روائيٍّ سرديٍّ مَكين يَمزج بين الشخصي الذاتي والموضوعي، أي بين الذات الفردية الواحدة والانفتاح على الذات الجمعية المشتركة، وبين الواقعي اليومي الحقيقي والتَّخيُّلي الأُسطوري والغرائبي؛ وذلك من خلال استدعاء الوقائعي التاريخي لواقعة الحدث السرديَّة التي تُراوحُ في مسارها الموضوعي بين عتبات الحبِّ الذاتي الإنساني، ومصادر نسق الحرب التدميري العدواني. بدأً من ساعة الصفر الأولى وحتَّى قيام ساعة الصُّلح والسلام بين كلاالبلدين الُمتحاربين.
تُوصفُ مُدوَّنة (طفلٌ ودَفترُ ذكرياتٍ)، بأنَّها رواية بيئية توثيقية بامتيازٍ، وعلى الرغم من أنَّها تبدأ ثيمتها الموضوعيَّة المركزية الرئيسة بسرديات العَلاقة الإنسانية العاطفية (الحبِّ) من طرف بطلها الأوحد، وتنتهي بثنائية الزواج الجمعي المُشترك من هُويَّة الطرف الآخر النسوي. بيدَ أنَّها في واقع الأمر تتقفَّى بفتوحاتها السردية آثار ومُعميَات السلطة القائمة ونظام الحكم البعثي السابق، وتنبش في حِفريَّات تاريخها الأسود المُظلم القاتم، وما خلَّفه من يأسٍ ودمارٍ وخرابٍ آسرٍ للشعب.
وسرديَّاتُ وقائعِ هذهِ الرِّوايةِ التاريخيةِ والوطنيةِ والإنسانيةِ تُعيدُ بعضاً من نهج تعسفه وظلمه ودكتاتورية منهجية فعل وقائعه وممارساته الطائفية والعنصرية والاستبدادية التعسفية الجائرة. وتؤدِّي بالتالي دور الفاعل المُضاد على نفسه الأمَّارة بالفعل الجرمي الشاهد عنه، والعَيَّان الرائيّ على وقائع وجرائم عصره، وبالدليل الحقيقي الواقعي الأكيد الكاشف عن فِعليَّات جريمته الثابتة.
وذلك أجل فضح ممارساته الداخلية، وكشف مظاهر وسبل عدوانية أنساقه المضمرة والظاهرة، وغطرسة أساليب سياساته اللَّإنسانية المُتطرفة. تلك السياسة الطائفية التي أثقلت على كاهل الشعب ودمَّرت حياة السواد الأعظم من جمهور النَّاس، وزرعتْ أُسسَ الفُرقةِ والكراهية والعدوان بينهم في أقصر الطرق، وفي أبهى سُبلِ التعايش السِّلمي والمجتمعي الإنساني. فأدَّت إلى التناحر والتشتت والتِّيهِ والضياع والتشظي والتهجير من أجل البحث عن ملاجئ آمنة للطمأنينة والحبِّ والسَّلام.
عَتباتُ الخِطابِ الرِّوائيِّ السَّرديّ:
من يتطلَّع في العتبة العدوانية المركزيَّة الكُليَّة الأولى لرواية (طفلٌ ودَفترُ ذكرياتٍ)، سيظنُّ لأوَّل وهلةٍ معتقداً في نفسه، بأنها عتبة إطارٍ تقليدية سياقية مُباشرة، وليست ذا بعد لُغوي فنَّي وانزياحي مُؤثِّرٍ ومُدهشٍ للنفس وللذائقة الإمتاعيَّة الرُّوحيَّة للقارئ، غير أنَّه في واقع الأمر سيندهش قريباً ويتفاجأ بكونه عنواناً نسقيَّاً مؤثِّراً جدَّاً ودلاليَّاً اجتماعيَّاً مُوحياً، وذو معنى حقيقي وإنساني كبير لم تظهر أهميته الشكليَّة ومعناه الدلالي إلَّا في خاتمة الرواية، وعند اكتمال تسريدها البنائي النهائي.
والذي عمد فيه الكاتب الرائي حسن الموسوي قصديَّاً وفنيَّاً أنْ تكون دلالته الفجائية الصادمة مؤجَّلةً إلى حين نهاية واقعة الحدث الموضوعية السرديَّة لهذه الرواية الفجائية الضاربة في الأثر، والتي تتَّخذ من جدليَّة الحياة والموت، والحبِّ والحربِ موضوعاً فكريَّاً وفلسفيَّاً وإنسانيَّاً لها في بوصلة صراعها الأبدي الدائر مع هُوية الآخر المُستبد، النظام الديستوبي الفوضوي الفاسد الظالم.
وحين نُجيلُ النظر في المعنى الدلالي البعيد لا القريب لرمزيَّة العنوان الرئيس ونستقرئ جوانبه الإنسانية الفريدة، ونستوعب مقارباته الحَدَثية المُثيرة في البحث عن هُويَّة المجهول المفقودة التي صَرَّحَ بها الراوي الكاتب بالإنابة عن لسان شخصَّية بطله الجندي الباسل المِقدَام حسين ونظيرته في الطرف الآخر الحبيبة والزوجة زينب، فإنَّهُ يقيناً سَيُخبرنا بإمتاعٍ عن الضربة الخفيَّة المُدهشة لخواتيم واقعة الرواية التي آخرَّ الإخبارَ عنها لغايةٍ ما، بأنَّ الطفل الرضيع (سجَّاد) ما هو إلَّا نُطفةٌ طاهرة من صُلب ذلك الرماد الطافي الراكد الذي خلَّفته الزوجة الراحلة من شريك حياتها الزوجية، تلك الحياة التي طالتها يدُ الزمن الغادر وأصابها الشرخ العدائي الكبير المُفرِّق بينهما بفعله الجبان.
ذلك هو التَّنائي القسري البعيد لا التداني القريب، والذي لا تُرجى عودة منه تجمع بين الشتيتينِ الظانينِ كلَّ الظنِّ أنْ لا تلاقياً من جديدٍ. فالطفل الوليد إذاً هو بذرةٌ لحياةٍ جديدةٍ مغايرةٍ مُفارقةٍ لِمَا بعد الحبِّ والحرب تعوُّض عن عطف الأبوَّة وبِرِّها الرَّحيم، وتَسدَّ مسدَّ شفقة الأم الصبور وَحُنوُّها التي قضى عليها ألم الفراق واستبدَّ بها طعم النأي البُعاد، حتَّى فاضت روحها الطاهرة نحو السماء.
فكانت تلك هي الصدمة الأولى الفارقة التي تلقَّاها بطل الرواية في رحلته الإجرائية الطويلة القاسية في البحث عن رحلة المجهول الحياتية الناقصة، والتي نتج عنها وجود طفلٍ يتيمٍ من غير أُمٍّ ترعاه أو ينشأ بكنفها الحاني. أمَّا دفترُ الذكرياتِ فكانَ هو المُذهل الآخر والصدمة الفجائية الثانية التي ورثها حسين عن يوميات زوجته وذكريات عمرها التي عاشتها في الكرادة في بلدها العراق، وأيامها المُضمَّخة بطعم الألم الموجع في بلد آخر مثل إيران لا يمتُّ لها بصلةٍ رَحمِ قريبٍ أو بعيدٍ.
وكان على أملٍ يحدوها وتُمنِّي نفسَها بلقاء حبيبها الأول وشريك حياتها حسين الذي طال انتظاره كثيراً، فقتلها صبرها وتفاقم شعور معاناتها من فواجع الدهر، وطول الفراق المرِّ المريرالذي ورثه منها زوجها في دفتر الذكريات المتبقِّي من مخلَّفات شَآبيب أمطار سيرتها الحياتية القتيلة المُتئدة.
وعلى وفق هذا التوصيف الدلالي والنسقي الثقافي الظاهر والمُضمر تكون جمالية العنوان الرئيس أكثر موضوعيةً وأكثر أهميةً في دلالاته التعبيريَّة المباشرة وصفاته التقريريَّة المُحبَّبة للنفس؛ كونه يحمل في طيَّاته السرديَّة وجعاً وهمَّاً إنسانيَّاً جمعياً مؤلماً وعذباً لا يتوفَّر في غير مكانه الآسر.
ونقف مرَّة أخرى قليلاً عند إحدى عتبات الخطاب السردي المتتالية، تلك هي عتبة (الإهداء) التي باح بها صوت الكاتب حسن الموسوي في تماهيه بكلمات الفقد الرثائية المؤثِّرة إلى حُلُمهِ الوردي المفقود، إلى الحبيبة التي حال بينه وبينها سيف الفراق، فلم يبقَ لهذا الأثر إلَّا هذه الكلمات الآسرة:
"إلَى حُلُمِي الوَردِي/ ذَلكَ الحُلُمُ الَّذي أجهزَ عَليهِ مَعتوهٌ/ شَهَرَ فِي وَجهِي سَيفَ الفُراقِ/ إلَّى لَيالي الفَقدِ الأليمَةِ / إليهَا... أَهدِي كَلِمَاتِي". (طِفلٌ ودَفترُ ذكرياتٍ، حسَن المُوسوي، ص 5).
ولعلَّ عتبة الإهداء المشحونة بدلالات (الفَقد) الحزين تُشير موحياتها الرمزية والدلاليَّة إلى وجود عَلاقةٍ مباشرةٍ بأهمِّ حدثٍ صادمٍ من أحداث الرواية، ذلك هو موت زوجة البطل حسين وحبيبة عمره التي أفنى نصف عمره بالبحث والتقصِّي عنها في مسيرة ارتحاله نحو عالم هُويَّة المجهول.
فإذا كان الإهداء عتبةً جماليةً وفنيَّةً لموضوع ذاتي وشخصي ووجداني مؤثِّر فعله الحدثي، فإنَّ عتبة (التصدير) لرواية (طفلٌ ودفتر ذكرياتٍ) كانَ مُقدمةً مَوضوعيَّةً تسريديَّةً لِرؤيا حُلُميةٍ مُخيفةٍ حدثت لِلبطل حُسين شخصيَّة هذه الرواية الأولى، وما صاب ذلك من تأويلٍ كثيرٍ ومُرعبٍ لأثر هذه الرُّؤيا الحُلُميَّة في (اللَّاعودة) حينما كان مسار رحلته الخطيرة في البحث عن نقطة المجهول.
إنَّه البحث عن أصل الهُويَّة المفقودة والحياة البديلة الآمنة المستقرَّة بعد أن ضاقت عليه الأرض بما رَحُبَتْ ففقدَ حياته ضحية لأجلها، ولأجل أنْ (يكونَ أو لا يَكونُ) بحسب التعبير الهاملتي المثير. وإلَّا ما الجدوى الموضوعية المبتغاة من سرِّ هذه المغامرة الحياتية المُهلِكة التي دفع حياته قُربَاناً من أجلها؟ ويبدو أنَّ الكاتب الموسوي يُريد في وقع تجليِّاته أنْ يُوصل رسالةً للقارئ مَفادُها بأنَّ:
"الحُلُمُ لَا يَشترطُ تَحقُّقُهُ عَلَى أرضِ الوَاقعِ أمَّا الرُّؤيا فَإنَّهَا تَتحقَّقُ بِكُلِ تَفاصيلِهَا وَكَأنَّها رِسالةٌ لِلشخصِ عَمَّا يَخفيهُ لَهُ القَدَرُ مِنْ أحداثٍ مُسجَّلةٍ فِي عِلمِ الغَيبِ. ثَمَّةَ طَاولةُ بَيضاءُ كَبيرةٌ اِنتشرتْ عَليهَا تَذاكرُ السَّفرِ، بَعضُ هَذهِ التذاكر مَكتوبٌ عَليهَا أسبوعٌ بِاللَّون الأَسودِ، وَبَعضُها مَكتوبٌ عَليهَا شَهرٌ وبِاللَّونِ الأخضرِ، وبَعضُها كُتِبَ عَليهَا اللَّا عَودة وبِاللَّونِ الأحمرِ القَانِي. لِلحَظاتٍ تَأمَّلتُ فِي تِلكَ التَّذاكرِ، حَبستُ أنفاسِي، اِزدردتُ رِيقِي، تَسارَعَتْ نَبضاتُ قَلبِي، اِرتجفتْ يَدِي مِثلَ سَعفةٍ يَابسةٍ تَتَمَايلُ بِخجلٍ عِندَ مَعانقتِهَا لِريحٍ عَاتيةِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص7).
بعد أنْ اتَّضحت الغايات والمقاصد ومصادر الأنساق الثقافية البعيدة والقريبة من العتبات النصيَّة الثلاث، (العنوان الكلي الرئيس والإهداء والتصدير)، يَأتي الحديث عن العتبات الداخلية الفرعيَّة الموازية لفصول الرواية ومتونها النصوصيَّة التسعة. ويتناهى إلى ظنِّي كثيراً أنَّ السيِّد المؤلِّف حسن الموسوي بوصفه كاتباً شموليَّاً متنوُّعاً، قاصَّاً وروائياً سرديَّاً مطَّلعاً على جماليَّات الميتا سرد الحداثوي؛ وذلك من خلال تنوُّع ثقافته المعرفيَّة المُكتسبة، وسعة اشتغالاته التجدديَّة المتعدِّدة.
ويمتلك من الخبرة اللُّغوية الشعريَّة ما يؤهِّلهُ أنْ يكونَ شاعراً ماهراً، فقد مكَّنته هذه الخبرات الثقافية والمعرفية الابستمولوجية المتنوُّعة أنْ يُجدِّد في اشتغلاته الروائية السردية مسايرةً لزمكانية السرد وتحوَّلاته العصرية. وقد دفعته هذه الاحترافية الفردية والتعدُّدية الإبداعيَّة إلى أنْ تكون روايته هذه متواليةً فَصليَّةً، وليست مُتواليةً عنوانيةً قصصيَّةً، وأثَّثَ صفحات مفاتيحها الأولى بأنْ وضع لكلِّ فصلٍّ من فصول الرواية التسعة مقدِّمةً تصديريةً على شكل أو هيأة مقاطع شعريةٍ تناسب زمكانياً حدث الواقعة السردية، ورموز شخصيَّاتها الروائية بهذا التشكيل الحكائي الجديد.
إنَّ هذا اللون من التعبير الأسلوبي يُعدُّ جانباً مُهمَّاً من جوانب التسريد الحداثي وما بعده الذي يناسب عصرنة السرد الروائي ويضفي عليه أهميةً فنيةً ودلاليةً تستهوي ذائقة القارئ وتدفع المتلقِّي إلى التواصل الجاد مع معطيات العمل السردي ومع مخرجاته الفنيَّة وحمولاته الفكريَّة.
ويأتي الفصل الأول من أحداث الرواية الذي وضع له الكاتب مُقدِّمةً شعريَّة تتضمَّن دلالاتٍ أربع مثل دالة (الفرحُ والحياةُ والموتُ والفَواجعُ) التي افتتح بها نصوص هذا لفصل وقارب بينها:
"الأفرَاحُ وِلاداتٌ مَيْتَةٌ/ فِي بِلادٍ تَحيَا بِالفَواجعِ فَقَطْ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 9).
وحسم الرائي الكاتب الأمر بهذا التخصيص الإجرائي التمثيلي المقلق للنفس وللمشاعر الإنسانيَّة بأنَّ سمة هذه البلاد (العراق)، هي ديمومة الفواجع والمآسي التي لا تنتهي من خريطة حزن الوطن.
في حينَ وشم الفصل التاسع والأخير من وقائع روايته بالحديث عن بعد المسافات والحواجز وهمَّهاالأخير، تلك المُسمَّيَات التي تُحيل بينه وبين الوصول لزوجته التي افتقدها في العراق حين تمَّ تهجيرها وإبعادها عنه قسراً. فكانت تلك المُهمَّة الكبيرة التي يرجو تحقيقها في سعيه الدائب إليها عندما تمَّ أسره من قبل القوات الإيرانية حينما كان جنديَّاً في أحد قواطع الجيش العراقي بالبصرة:
"لَا مَسافةَ/ أتخيلُهَا إليكِ/ الحَواجزُ/ وَهمُّ الخَطواتِ الأخِيرَةِ". (طَفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 91).
البِنيةُ السَّرديَّةُ لِلروايةِ:
إنَّ البِنية السرديَّة لواقعة الحدث الموضوعيَّة في مُدوَّنة حسن الموسوي المتوالية الفصلية الروائية (طِفلٌ ودفترُ ذِكرياتٍ)، والصادرة بطبعتها الأولى عام (2022م) عن دَارَي العَرَّاب في دمشق بسوريا، والصحيفة العربيَّة في بغداد/ العراق، بكم عددي نِيفَ عن مائة صفحةٍ من القطع الكتابي المتوسِّط، تقوم هذه البنية على ركيزتين أساسيتين مُهمَّتين هما: تضادية (الحبُّ والحربُ).
فالحبُّ هو تلك العَلاقة الإنسانيَّة العاطفيَّة الجميلة والمتأجِّجة التي بدأها الشَّاب الجامعي حسين، والذي يعمل في الوقت نفسه مساءً موظَّفاً صحيَّاً في المستشفى الحيدري في الكرادة الشرقية مع أو بصحبة صديقه وزميله الموظَّف عبَّاس بنفس المستشفى. ومن خلال رفقته لعبَّاس ارتبط حسين بعلاقة حبٍّ مع أخته الطالبة (زينب)، وقد أدَّت هذه العَلاقة الوجدانية إلى الزواج منها وقيام حياةٍ زوجيَّةٍ سعيدةٍ، ومن ثمُّ التطلُّع إلى تأثيث مستقبل إنساني زاهرٍ واجتماعيٍّ مستقلٍ.
ولكنْ للأسف لم تدُم تلك الحياة الجديدة طويلاً؛ بسبب ما قِيلَ عن تبعيَّة زوجته الإيرانية؛ وكون أصها من الكورد الفيليين الشيعة، والَّتي على إثرها قامت سلطات نظام الحكم السابق في ثمانينيَّات القرن العشرين بتصفيتهم وطردهم وتهجيرهم إلى الجارة إيران، لا ذنبٍ اقترفوه، بل لكونهم من التبعية الإيرانية التي ادَّعاها النظام، وفي خطوةٍ مُبيَّتةٍ وعاجلةٍ رأى النظام لا بُدّ من تسفيرهم وإجلائهم عن أرض العراق التي ولِدوا وعاشوا بها ردحاً من طويلاً من الزمن.
ولهذا الحائل يكون حسين العراقي قد فقد زوجته وحبيبته زينب التي يفترض لم تُسَفر معهم، إنَّما الذي يتمُّ تسفيره أخوها عبَّاس مع أهله، لكن تعنِّت الأجهزة وعنادهم معه وبُغضهم له واتِّهامه بخيانة النظام البعثي والتآمر كان سبباً كافياً بعدم بقائها معه خلافاً للقانون. وبهذا الإجراء التعسفي الظالم انطوت صفحة الحبِّ والزواج وخاض حسين صراعاً مريراً مع نفسه ومع إجراءات الآخر. وعلى وفق ما حصل لحسين وزينب من تدمير لحياتهما الزوجية المُبكِّرة بدأت حكاية المجهول.
أمَّا الحرب فهي الركيزة الثانية المهمَّة من صميم واقعة الحدث السردية، والتي أخذت مِساحاتٍ موضوعيَّةً واسعةً من أحداث الرواية وحكايات فصولها السردية الأخرى، وما نتج عنها من تجلِّيات سياسيةٍ وعسكريةٍ ومضايقاتٍ حزبيةٍ داخليةٍ صارخةٍ احتشدت تعبئتها بنذير الحرب، وكثيراً من الممارسات القمعية والتصفيات الجسدية التي اتَّخذتها الأجهزة الأمنية لمن يُعادي مبادئ الحزب والثورة وهرم النظام الدكتاتوري . وقد رافق ذلك القيام الفعلي بعسكرة المجتمع العراقي إسبارطيَّاً.
وقد بلغت تلك الممارسات العِدائية الاستبدادية ذِروتَها القصوى واستفحالها السلطوي إثر اندلاع طلائع الحرب العراقية الإيرانية بين البلدينِ المُسلمينِ في الثمانينيَّات، وبعد أنْ انقطعت سُبلُ العّلاقة الدبلوماسية بينهما وشهدت العلاقات السياسية بينهما تدهوراً إقليمياً ومحليّاً خطيراً غير مسبوقٍ أسهم في إشعال فتيل هذه الحرب التي لا طائل من ورائها، والتي لا رابح فيها أو خاسر سوى إزهاق أرواح الأبرياء وخراب وتدمير للبنية التحتية لكلا البلدينٍ المتحاربين بأوامر وأجندة خارجية إقليمية وعالمية معروفة لكلا الشعبين.
هذا الفعل من جانب خارجي حدث ولم ينتهِ إلا بعد مضي ثماني سنواتٍ لحربٍ عِجافٍ من القتال والموت والخراب. ومن جانب داخلي آخر فقد واجه البطل حسين ذاتيا حربين متتاليتينِ، حرب على المستوى المحلي الداخلي في مواجهاتٍ مستمرَّةٍ معه واستفزاز النظام السلطوي له ولعائلته؛ كونه أُتُّهِمَ بعدائه للنظام الحاكم وانتمائه لتنظيمات حزب الدعوة الإسلامية وولائه لشخصياته القيادية الثائرة وقتذاك والتي تتواجد في إيران كمعارضةٍ حقيقيةٍ .
الأمر الذي جعل من مختار المنطقة أنْ يوجِّه اتّهامه له مباشرةً دون هوادة وترك أمر اعتقاله له لوقت آخر.؛ بسبب أنَّ المختار يرتبط بعلاقة نسبٍ باُمِّه الذي حال دون اعتقاله كما يدَّعي المختار. فخاض حسين صراعاً مريراً وكبيراً مع أجهزة النظام الأمنية والحزبية القمعية ومحاربتها لَهُ؛ بسبب اتهام هذه الأجهزة لزوجته زينب بالعمالة للنظام الإيراني، وقيامها بعمل جماعي سردي ضد نظام الحزب والثورة دون أن يكون لزوجها حسين معرفة أو عِلْمِ بذلك الأمر السري.
أمَّا الأمر الآخر الذي عاش حسين مخاضه المرير، فهو استدعاؤه لأداء خدمة العلم الإجبارية العسكرية وخوضه لسلسلة المعارك الدائرة بين البلدين الجارين العراق وإيران التي لا نجاة منها إمَّا الهروب من الخدمة أو الوقوع في مثالب الأسر. فكان الأمر الثاني (الأَسرُ) أهون الشرَّينِ على نفسه وأجدى نفعاً من الهرب. وهو ما ساقته الأقدار بقدميه إليه راغباً به، فوقع أسيراً من قبل قوات الجيش الإيراني الذي كان حسين ينتظر مثل هذه الفرصة الكبيرة بفارغ الصبر من أجل البحث عن زوجته زينب في أماكن تواجد العراقيين المهجرين في أحياء العاصمة طهران مثل منطقة آباد.
لقد عاش حسين تجربة هذا الصراع المرير الداخلي والخارجي من أجل تحقيق هدفه الأسمى ألَا وهو البحث عن زوجته وعائلتها في إيران، وقد حدث له ذلك، وتحقَّق ما كان يسعى إليه؛ ولكن برياح الفقد المفاجئة التي لم تشتهيها سفن حسين السائرة نحو ضفاف الأمان ومرافئ السلام والحياة الآمنة التي كان ينتظرها على أحرِّ من الجمر.فكانت المفاجأة كبيرة ووقعها الإنساني مُذهل خطير.
فزينب الزوجة قد تمَّ تهجيرها خلال أيامٍ قليلةٍ من زواجها، وعلى إثر ذلك ماتت كمداً بحسرتها على فراق حبيبها حسين الذي انتظرته كثيراً لكنْ دون جدوى؛ ولكنَّها خلَّفت له إرثاً جديداً فتركت له ابنها سجَّاداً ذلك الطفل الصغير الذي يُذَكِّرهُ بزوجته زينب وتركت معه له دفتر ذكرياتها الذي كتبت فيه يومياتها الكَرَّاديَّة في بلدها العراق وحياتها في مثابتها الأخيرة آباد بطهران.
لم يجنِ حسين من وقع هذا الحبِّ الذي ساقه إليه القدر إلَّا الموت الذي كلَّفه حياته؛ نتيجة الصدمة الكبيرة القاضية التي تلقاها عل إثرها والتي أقصته من الحياة إلى الموت بعد أنْ أمضى جهاداً كبيراً ومعاناةً مضنيةً في تحقيق مسعاه الأخير في اللقاء بها بعد رِحلة البحث.
وبسبب صدمة هذا الفقد الفاجعية الأخيرة التي أدَّت إلى موت كلا الاثنين الزوج والزوجة ركني واقعة الحدث السردية (الحبُّ والحربُ)، يُوجَّه الكاتب حسن الموسوي في وقائع مرويَّاته الحكائية التسريدية الفاعلة الأثر في فصول هذه المدوَّنة الروائية رسالةً توثيقيةً وتدوينيةً لقارئه ومتلقِّيه مَفادُها بأنَّه لا حبٌّ إنسانيّ يدوم ويُعمِّرُ، ولا حربٌ ضَروسٌ مُدمِّرةً تستمرُّ فلا تؤثِّر، على الرغم
من أنَّ الأمر الأول وأعني ثيمة (الحبُّ)، أهون الخيارين من الأمر الثاني في حالة المقاربة بينها.
وعلى الرغم أيضاً من كثرة شخصيَّات هذه الرواية الثانوية التي تخطَّت أسماؤها التي ذكرها الأربعَ عشرةَ شخصيَّةً، ففد اثبتتْ رواية (طفلٌ ودَفترُ ذكرياتٍ)، بأنَّها رواية البطل الأوحد الشخصيَّة المركزية المتنامية الأحداث والأفكار والوقائع، وليست روايةً (بوليفونية)متعدِّدة الأصوات والرموز الشخصيَّة برغم كثرة مثاباتها الداخلية والخارجية الزمكانية، وتعدُّد صور عُقدُ صراعاتها وكثرة حواراتها السرديَّة والموضوعيَّة الإنسانية والوطنية والاجتماعية. وأنَّ أهمَّ ما يُميِّز سرديَّات هذه الرواية وحدتها الموضوعية وانتقالاتها الحدثية السريعة وهدفها الإنساني الذاتي القريب والبعيد.
تَمثُّلاتُ سَرديَّاتِ ثُنائيةِ (الحُبُ والحَربِ):
إنَّ من يُمعنُ النظرَ جليَّاً، ويتأمَّلُ بعينٍ نقديةٍ رابعةٍ في سرديَّات رواية (طفلٌ ودَفترُ ذكرياتٍ)، ويُحاول الشروع بتفكيك شفراتها اللُّغوية والدلالية، ويستوعب أنساقها الثقافية القريبة والبعيدة تعليلاً وتأويلاً وتحليلاً هرمنيوطيقياً معرفيَّاً مُتراتِبَاً لفصولها الحكائية التسعة، سيصل من خلال قراءته النقدية المتتالية لتلك الفصول إلى نتيجةٍ استقرائية منهجية مَفادها أنَّ الرواية تعدُّ متواليةً فصليةً خالية من العتبات العنوانية الفرعية الفصلية، وأنَّ بعضَ فصولها الأربعة الأولى الَّتي تشكِّل النصف الأول من مَتِن فضائها السردي كميَّاً لا نوعياً تقريباً، تعدُّ بأنَّها فصولَ تأثيثٍ وإعدادٍ وتمهيدٍ وتقديمٍ وتحشيدٍ لتجلِّيات الواقعة الحدثية ولموضوعات فكرة (الحبِّ والحَربِ)، أو مَظاهر الحرب والسلم، وأنَّ فصولها الخمسة الأخرى تمثِّل النصف الثاني من روح الرواية وثيمتها الفكرية والجماليَّة.
وفي الوقت ذاته تُشكِّل هذه الفصول الأخيرة جُلَّ سرديَّاتها الفعلية وشخصيَّاتها الفواعليَّة ووحداتها الزمكانية والعُقدية، وتمثِّلُ القسم النوعي الأسمى والأخطر والأجدر الذي بُنيتْ عليه واقعة الحدث الموضوعية لهذه المدوَّنة، وأنَّ الأحداث الحقيقية المثيرة والمهمَّة المتساوقة لجدليَّة (الحبِّ والحربِ) تبدأ من أحداث الفصل السردي الخامس تصاعدياً حتَّى تصل إلى خاتمة الرواية أو نهايتها الكليَّة.
وعلى وفق تلك القراءة التأمُّلية لم نجد هناك أثراً أُسلوبياً لتقنيتي (الاستباقِ والتأخيرِ) عند الكاتب حسن الموسوي، وإنَّما سار وفقَ المنهج النسقي الكتابي التعبيري الموضوعي لتمظهُرات الواقعة الحدثية من أجل تنامي سير الأحداث بخطىً تسريديةٍ ثابتةٍ لا تحتمل مناورة السرد في الاستباق أو التأخير؛كون موضوعها الفنِّي يُعدُّ مُوضوعاً حدثياً تسلسليَّاً وتراتبياً في وتيرة الأحداث السردية.
وقد اعتمد الراوي العليم أو (الكاتب) في بنائه السردي على عنصري الإمتاع والتشويق الفنِّي للقارئ وتكثيفهما من خلال أُسلوبيته التعبيريَّة، وخاصةً في الفصلين الأخيرينِ والمثيرين من أحداث الرواية التي أَخَذَنَا الكاتب فيها على حين غُرةٍ من خلال التنقل عبر فصولها التسعة دون أنْ نعرفَ المعنى الحقيقي المُلَغَّز لعنوان الرواية، أو نكتشف المعنى الدلالي الخفي وراء التسمية العنوانية التقليدية للرواية.
فمثل هذه الانتقالة التواصليَّة السريعة التي أحَاَلَنَا فيها الكاتب، وحَمَلَنَا على جناح السرد إلى نقطة النهاية التوقُّعية الصادمة الضرب في مُجريات حركة الحدث السردي وخواتيمه الإدهاشية المذهلة تعدُّ من أساليب السرديَّة المعاصرة التي تُحسب لشخصية المؤلِّف الكاتب ومهارته الفنيَّة الاحترافية الباسلة في تأثيث روايته البيئية الاجتماعية جمالياً وإيقاعياً عبر مَجسَّات تعبيره الأسلوبي السردي.
تَمثُّلاتُ الفصلُ الأولُ:
تُشيرُ مقدِّمة أو مُفتتح هذا الفصل وموحياتها الدلالية إلى الشعور الذاتي المغتبط بالأفراح التي أعدَّها الكاتب أشبه بولاداتٍ مَيتةٍ في بلاد حيَّةٍ تعيش وقع الفواجع والمآسي، ولا تعرفُ معنىً للفرح والسرور؛ بسبب ضغوطٍ كبيرةٍ واجهتها. وقد حرص الكاتب الموسوي على توثيق وأرخنة مكان وزمان الحدث الذي ابتدأت به الروايَّة، ويبدو أنَّ الكاتب له صلة وثيقة بالمكان؛كونه عنصراً أساسيَّاً مهمَّاً من عناصر السرد، وأشار إلى صفة البطل الشخصية ومكان عمله وعلاقاته بالآخرين:
"بَغدادُ/ الكَرادةُ الشَّرقيةُ/20 / 6/ 1980، بِولادةِ صَباحٍ جًديدٍ تًستيقظُ الشَّوارعُ بِناسِهَا وَبِناياتِهَا لِلشروعِ بِيومٍ جَديدٍ، يَومٌ رُبَّما يَحملُ بَينَ طَيَّاتِهِ شَيئاً مِنَ الأملِ لِأولئِكَ الَّذينَ دَاستْهُم الحَياةُ ولَفظتْهُم إلَّى حَاويةِ النَّسيانِ. مِنْ بَعيدٍ لَمحتُ صَديقِي عَبَّاسَاً والَّذي يَعملُ مَعِي فِي مستشفَى الحَيدري، وَهوَ يَسيرُ عَلَى ضَفةِ نَهرِ دِجلةَ مِنْ جِهةِ الرُّصافةِ قُربَ جِسرِ الجُمهوريَّةِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص10).
إذنْ المكان الأول لواقعة الحدث السرديَّة تحدَّد بمثابة الكرادة الشرقية، والتي هي إحدى مناطق بغداد التي تنعم بالحياة النابضة الثراء والباذخة الرفاهية والأمان. وكان فصلاً قصيراً، وحرص فيه حسن الموسوي أنْ تكون نهايته خاتمةً موضوعيَّةً بسيطة وذات وقعٍ حكائي سردي فاعل الأثر.
تَمثُّلاتُ الفَصلِ الثَّاني:
ينفي السارد أو بطل الرواية في مقدمته النثرية المكثَّفة أنْ تكون (السعادةُ) مصدراً من مصادر صفات حياته الشخصية التي يحياها كإنسانٍ سويٍّ بالغ العقل والفكر والعمل؛ ويُعلِّلُ فقدانه لها وعدم التمسك بها؛ كون (الحزنُ) يُشكِّل فِيتو بديلاً عنها؛ لذلكَ هي ليست سِمةً من سماته الشَّخصيَّة الدائمة، بل هي ضيف أو زائر لا يلبث المكوث في ذاتيته الموجعة النكوص.
وتُشير تجلِّيات هذا الفصل ومشاهده وتمظهراته الحدثية إلى أن الشرارة الأولى لواقعة الحُبِّ الوجدانية التي انطلقت من لَدُن حسين الفاعل الأول للرواية صوب زينب الفاعل الثاني منها من أجل التعرُّف عليها، وفي بناء وتوطيد علاقةٍ عاطفيةٍ وإنسانيَّةٍ تؤدِّي في نهاية الأمر إلى الارتباط الروحي والنفسي الزوجي والمَسكنة الأُسريَّة كمصدر دائم لسعادة الإنسان واستقراره الاجتماعي:
"مَعَ مُرورِ الوَقتِ تَوطَّدتْ عَلاقتِي بِزينَبَ؛ ولِذلكَ طَرَحتُ عَليهَا فِكرةَ الزَّواجِ. لَا أعتقدُ أنَّ زَينبَ قَدْ تَفاجأتْ حِينَمَا طَرحتُ عَليهَا فِكرةَ الزَّواجِ، فَهيَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَتاةٌ وَالزَّواجُ فِكرةٌ مُحبَّبةٌ لِكُلِّ فَتاةٍ، بَلْ تَكادُ تَشغلُ كُلَّ تَفكيرِهَا طُولَ الوَقتِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 18).
وقد رافقت هذه العلاقة الإنسانية ظهور بوادر قيام الحرب العراقية الإيرانية التي أخذت تلوح في الأفق آثارها الوخيمة. وما شهدته مدينة بغداد والكرادة الشرقية نقطة الحدث المهمَّة بالذات من أحداثٍ مأساويَّةٍ حيالَ ذلك القادم ألقت بظلالها الخطيرة على كاهل الجميع من سواد الشعب، وما رافق ذلك الحدث المثير من اعتقالاتٍ سياسيَّةٍ وتهجيرٍ قَسري وتصفياتٍ شخصيَّةٍ لأفراد الأُسَرِ من الذين وصفتهم السلطة بانتمائهم إلى التبعية الإيرانية. وهي من أكبر الحجج الواهية الخطيرة التي واجهوها مع الأجهزة الأمنية للنظام القمعي؛ الأمر الذي جعل حتَّى العشائر العراقيَّة العربيَّة تستشعر هذا الخطر الذي يمخر عباب جمهور مُعيَّن الناس المسالمين في ولائهم وحبِّهم للعراق:
"فَلَقدْ قَامتِ الأجهزةُ الأمنيةُ بِتهجيرِ عاَئلةِ الحَاجِّ عَبَّاسِ الكَرادِي، وَهوَ مِنَ الشَّخصيَّات العّربيَّةِ البَارزةِ فِي مَدينةِ الكَرادةِ، وَهوَ أيضَاً مُؤذِّنُ الحُسينيةِ وَمِنَ الرِّجالِ المُتدينينَ جِدَّاً ويَعملُ فِي تِجارَةِ الفَحمِ. ويَعودُ نَسبُهُ إلَى الإمامِ عَليٍّ بِنِ أبِي طَالبِ (عَليهِ السَّلامُ)". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 19).
تمثُّلاتُ الفَصلِ الثَّالثِ:
ما بين شخصيَّة القاتل الآثم أو المُجرم جَريمةُ قَتلٍ قُيِّدتْ ضدَّ فاعلٍ مجهول، وما بين قابيل الفاعل للقتل قصدياً، وهابيل الضحية المقتول ظلماً، دماءٌ تسيل وأثرٌ خطيرٌ ضدهُ شهود عدلٍ على وقع الجرم تؤكِّد حقيقة القاتل ولا تُبرِّئ ساحة من ثَبَتَ عليه فعل الجرم المشهود بتعضيد الحقّ.
وفي سرديَّات هذا الفصل يتماهى الكاتب السيِّد حسن الموسوي وبطله العراقي حسين الكرادي مع تناص واقعة الحدث التاريخية الدينية لقصة (قابيل وهابيل) الأخوينِ، وكيف أسقطها الكاتب تاريخياً على واقعة النص السردية لتمثُّلات هذا الفصل الذي تَعرَّض فيه بطله الشخصي حسين إلى الاعتقال والحجز في نظارة السجن؛ بسبب جريمة قتل حدثت صدفةً لشخصٍ أخر مجهول غير معروف الهَويَّة في طريق عودته من نوبة عمله في مستشفى الحيدري الذي يعمل فيه وقت الليل:
"لأولِ وَهلَةٍ أَفزعتني الشُّرطِي بِطريقةِ تَعامُلهِ مَعِي لَكنَّنِي سُرعانَ مَا سَيطرتُ عَلَى النَّفسِ وَحَافظتُ عَلَى هُدوءِ أعصابي -عَلَى الفَورِ تَوقَّفتُ لِأستعلِمَ مِنهُم عَمَّا يَجرِي مِنْ حَولِي، وَيَا لِلهولِ كَانتْ ثَمةَ جِثةٌ سَابِحةٌ فِي دَمِهَا مُلقاةٌ عَلَى قَارعةِ الطَّريقِ بِالقُربِ مِنْ مُستشفَى الحَيدري، وَسَطِ ذَلكَ المَشهدِ تَجمَّعَ رِجالُ الشُّرطةِ حَولَ جُثَّةٍ تَعودُ لِرَجُلٍ أربعينِي العُمرِ كَانَ قَدْ تَعرَّضَ لِعدَّةِ طَعَنَاتٍ فِي مَنطقةِ الصَّدرِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 22).
لم يصدق حسين ما حدث له من أمرٍ مُفاجئ ألمَّ به بَغتةً، وبعدَ إجراءِ تحقيقٍ مُفصَّلٍ معه والتعرُّف عَلى هَويته الشَّخصيَّة وَصفةِ عمله في المستشفى والتأكُّد من براءته وعدم ارتكابه لفعل الجريمة الآثم أمرَ الضابط المسؤول في مركز الشرطة بتبرئته وإطلاق سراحه.وقد حرص الكاتب الموسوي أن تكون خاتمة هذا الفصل تجمع بين الخاتمة الموضوعيَّة والتَّخيُّليَّة الفنيَّة المشوِّقة.
تمثُّلاتُ الفَصل ِالرابع:
تُخبِرُ مُقدِّمةَ الفصل الرابع وعتبةُ مُستهله الافتتاحي، كيف يتماهى الإنسان مع ذاته الأنويَّة؟ وكيف يتقارب مع ظلِّه وهو يسابق بخطاه الريح؛ كي يكون قريباً من هدفه المنشود ومطمئناً بتؤدةٍ على نجاح مساره الحقيقي المفقود. لقد آثر الكاتب والسارد الموسوي أنْ تكون أُولى سرديَّات هذا الفصل الإشارة الزمانية لبدء تاريخ الحرب العراقية الإيرانية، والتأكيد على توصيف مشاعر
البطل الذي كان يَكره الحَرب التي أخذ في البوح عنها لحبيبته زينب في وقت لقائه الأوَّل بها:
"بَغدادُ/ أيلولُ1980، وأخيراً اِندلعتِ الحَربُ بَينَ الجَارينِ المُسلمينِ العِراقِ وإيرانَ، بَعدَ أنْ شَهدَتْ العَلاقةُ بَينَ البَلدينِ تَدهورَاً خَطيرَاً، وَسَاعدَ تَدخلُ الأصدقاءِ والغُرباءِ عَلَى إشعالِ فَتيلِ هَذهِ الحَربِ. كُنتُ أَكرهُ الحَربَ وَلمْ أخفِ شُعورِي هَذَا لِحبيبتِي زَينبَ، وَقَدْ أخبرتُهَا بِذلكَ حِينَمَا اِصطحبتُهَا ذَاتَ صَباحٍ إلَى السُّوقِ. أنَا أكرهُ الحُروبَ، قُلتُ لَهَا، بَعدَ أنْ رَأيتُ أنَّ أغلبَ الرِّجالَ فِي السُّوقِ قَد اِرتدُوا البَدلاتِ الخَاكيةَ، وَهَذهِ إشارةٌ إلَى تَطبيقِ مَبدَأِ عَسكرةِ المُجتمعِ عَلَى أرضِ الوَاقعِ، الوَيلُ والثَّبُورَ لِكُلِّ مَنْ يُعارِضُ قَراراتِ القِيادَةِ الَّتي كَانتْ مُتمثِّلةً بِشخصٍ وَاحدٍ ألَا وَهوَ رَأس النِّظامِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، 28). ورأس النظام إشارة واضحة إلى شخص الرئيس صدام حسين.
وقد رافق شحن هذه المشاعر المُلتهبة بنذير الحرب مراقبة الأجهزة الأمنية الشديدة لتصرُّفاته الشخصيَّة، ورصدِ عَلاقاته مع أصدقائه المَشبوهين بولائهم لحزب الدعوة وإيران؛ الأمر الذي اُستدعي كثرة الاعتقالات والتنكيل بالشباب المؤمن بقضيته ومبادئه من الذين يمقتون نظام البعث وتصرفاته الإجرامية. فضلاً عن مضايقة هذه الأجهزة لأصحاب المَحلَّات من التُّجار بقضية العمل لصالحهم كوكلاء أو مُخبرينَ للأمنِ، وكتابة التقارير اليومية المُفصَّلة عما يجري في أقبية السوق:
"أخشَى عَليكَ مِنَ الرِّفاقِ قَالَ سَيِّدُ صَادقُ: -لَا عَليكَ أنَا لَا أهتمُّ لِمُضايقاتِهُم، لَقدْ قَلقتُ كَثيرَاً عَلَى سَيِّد صَادقٍ، اِختفاؤُهُ المُفاجئُ جَعلنِي أقلقُ عَليهِ وَبِالخصوصِ بَعدَ مَوجةِ الاِعتقالاتِ العَشوائيَّةِ الَّتي طَالتْ جَميعَ الشَّبابِ الَّذينَ يَرتادُونَ حُسينيَّةَ البُو جُمعَةَ. -أنَا أيضَاً بَدأتُ أخشَى عَلَى الشَّبابِ، لَقدْ أظهرَتِ الحُكومةُ وَجهَهَا القَبيحَ وَكَشَّرَتْ عَنْ أنيابِهَا، وَحَملةُ الاِعتقالَاتِ الأخَيرةِ دَليلٌ علَى فُقدانِهَا لِتوازِنِهَا". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 35).
ويعدُّ هذا الفصل من أكثر فصول الرواية حساسيَّةً ودقةً في مواجهة المدَّ السلطوي في محاربة الأشخاص المناوئين لأجهزة النظام الأمنية القمعيَّة والحزبية المقيتة في مطاردة الشرفاء وتعذيبهم.
تَمثُّلاتُ الفَصلِ الخامسِ:
يُعدُّ الفصل الخامس من فصول هذه الرواية الأكثر وجعاً وألماً ونكوصاً وارتكاساً نفسيَّاً مُقلقاً على روح شخصية بطلها الأوحد حسين وعلى قلبه المجهد. وهو من أكثر الفصول التي اشتدَّت فيها عُقدة الصراع الداخلي وقعاً والتحمت أبوابه بالانسداد والانغلاق الحياتي الذي سدَّ مسدَّ منافذ الطرق والآمال الموصلة لضفاف الواقع الحقيقي، وجعل الأمور تصل نفقٍ مظلمٍ حالكٍ الأرجاء له.
لذلك فإنَّ كاتب الرواية أو راويها العليم (السارد) يُقدِّمُ لنا على لسان حال بطله الباسل الهُمام حسن في الصفحة الأولى من مطالع مقدّمة هذا الفصل الذي جاء على شكل اعتراضاتٍ حكائيةٍ تقريريةٍ ذاتيةٍ تكشف عن اللَّحظات الإنسانية الهاربة التي يبحث عنها البطل المجاهد علَّه يصل إلى جزء قليل فيها لإرضاء ذاته الأمَّارة بالوجع الأليم المُدمي والاغتراب الوجودي الذي لا حدود له إلَّا بالاقتراب من المأمول القصدي الأخيرالذي يجد به بُغيته وهدوءَ وسَكينةَ حياته المُهدَّدة بالخطر.
ومن إضاءات هذا المأمول بحثه الدائم عن حُلُمه الوجودي الحياتي الضائع الذي خطفته يد الزمن في غفلةٍ من الناطور. وشعوره بألم الفقد الزوجي ومرارة الاضطهاد وظلم ذوي القُربى الإنساني له في المجتمع ومن حوله جعله يمضي حياته ومستقبله الإنساني وحيداً في عتمةٍ مظلمةٍ أطبقت على كلِّ شيءٍ، فسلبته حُلُمَ حياته وجعلته عاجزاً عن فعل أي شيءٍ، وأفقدته صدمة هذا الفقد حتَّى فرصة الدفاع عن نفسه أمام عتبات محكمة الحياة كما يصفها هو ذاته في مسروداته.
ومهما يكن من أمر ذلك الجَلل الذي سيطرَ على حياته ودمَّرها، وبدَّدَ شعوره النفسي والذاتي بفقدان بصيص الأمل ما زالت أمامَهُ فرصةٌ مؤاتيةٌ لتحقيق هذا الأمل الرفيع المنشود وامتلاكه القدرة الروحية على إطلاق صرخته الفورية المدوِّية في وجه الطغاة من العُتاة وثلة المُتسلطين.
ومن محطَّات هذا الفصل التسريديَّة الأشدُّ إيلاماً ووجعاً مريراً على نفسية حسين المأزومة حدوث ما لم يكن في الحسبان والتوقُّع، حيث حصلت واقعة الفقد الحدثية القاصية على أيدي أجهزة النظام البعثي التسلطي ومباغتتهم لبيت أهل زوجته وقرار تسفيرهم لإيران بحجَّة التبعية الإيرانية:
"فِي ذَلكَ المَساءِ الحَزينَ اَنتشرتْ سَيَّاراتٌ مَدنيَّةٌ مِنْ نَوعَ اللَّا ندكرُوز، وهَذهِ السيَّاراتُ مَعروفةٌ لَدَى العِراقيين، فَبحضورَهَا يَحضرُ الحُزنُ بِكلِّ صُورةِ، ويَحضرٌ جَبروتُ السُّلطةِالحَاكمةِ وَقَسوتُها، بِسُرعةٍ اِنتشرَ رِجالُ الأمنِ فِي كُلِّ مَكانٍ ولَمْ يَسمحُوا لأيٍّ كَانَ بِالاقترابِ مِنهُم. كَانَ البَابُ الرَّئيسُ لِمنزلَ أهلَ بَيتِ زَينبَ مُحطَّمَاً بِالكاملِ، بِخُطواتٍ ثَقيلةٍ تَقدَّمتُ نَحوَ البَيتِ، اِعترضَ طَريقِي مُختارُ المَحَلَّة قَائِلاً: - اِرجعْ إلَى بِيتِكَ وَلَا تَتقدَّمْ خُطوةً واحدةً إلَى أمامٍ. –أخْبرنِي، مَاذَا حَصلَ؟ قُلتُ بَعدَ أنْ تَملَّكتنِي الدَّهشةُ: -مَاذا حَصلَ؟ قَالَهَا المُختارُ، ألَا تَعرفُ أنَّ أهلَ زَوجتِكَ مِنَ التَّبعيَّةِ الإيرانيَّةِ، وَقَدْ جَاءَ هَؤلاءِ الرَّجالُ الأبطالُ لِكَي يَنقذُوا البِلادَ مِنْ شُرورِهُم". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 47، 48).
وعلى إثر هذه المُداهمة الأمنية أصبح حسين محلَّ شُبهةٍ عندَهم؛ كونه يلتقي بأصدقائه الذين يعتبرونهم متآمرين على سلطة النظام وأجهزة الحزب والثورة. وبعد الذي حدث لأهل زوجته التي تمَّ تهجيرها معهم صار الهمُّ والحُزنُ رَفيقاً لحياة حسين المتبقية. وراح يتأمَّل الماضي الجميل الذي عاشه في بيته وسط ذكرياته وأيام عمره الفائتات، ولم تكن وسلته المُسلِّية سوى المزيد من الدموع التي تُعوضه عن غياب زوجته زينب، وتبدَّدُ سيف الغياب القاطع الذي أجهز على شجرة حياته:
"بَعدَ ثَلاثةِ أيامٍ مِنْ تَرحيلِ زَينبَ وَعائلتِهَا، هَاجمَ رِجالُ الأمنِ بَيتنَا المَنكوبَ بَألمِ الفَقدِ. وَفِي البِدايةِ عَاثُوا فَسادَاً وَحطَّمُوا كُلَّ شَيءٍ وقَعَتْ أعينُهُم عَليهِ، حَالةُ الغَضبِ الَّتِي تَملكَتهُم لَجمَتْ لِسانِي وَجَعلتنِي أَقفُ كَالتمثَالِ بَينَهُم. وَبَأُسلوبٍ حَقيرٍ حَاولُوا قَدَرَ الإمكانِ مِنْ اِستفزازِي، مِنْ أجلِ أنْ يَبطشُوا بِي، لَكنِّي لَمْ أسمحْ لَمْ أمنحهُم هَذهِ الفُرصةُ، وحَينَمَا يَأسُوا مِنَ العُثورِ عَلَى أيِّ شَيءٍ دَاخلِ البَيتِ، تَصفَّحَ ضَابطُ الأَمنِ فِي وَجهِي مُتوعِدَاً بَأنَّه سَيعملُ جَاهدَاً عَلَى إنزالِ أقصَى عُقوبَةٍ لِمجرمٍ مِثلِي كَمَا وَصَفنِي". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 55).
لم تنتهِ سلسلة التهجير والتصفيات التي طالت الكُورد الفيليين الذين جمعوا بين ثنائية الضدين النقيضين، النقيض الأول؛ كونهم من القومية الكردية، والنقيض الثاني هم من الطائفة الشيعية، ومثل هذا الدمج العفوي والعقائدي المُوحدن بين القومية الكردية والطائفة الشيعية لا يحظى بِحُبِّ وتأييد نظام الحكم القائم لهم، بل يسعى بكراهيته لهم لاقتلاعهم من الجذر. الأمر الذي جعلهم يدفعون الثمن غالياً بالتهجير والتسفير؛ بسبب انتمائهم الطائفي والعرقي الثنائي المزدوج.
لم يكتفوا بكل هذا التنكيل، بل راحوا بتوجيه الاتِّهام المباشر لزينب زوجته وارتباطها بعلاقة سياسية مشبوهة بتنظيمات حزب الدعوة العميل كما يَدَّعون ذلك في مُداهماتهم العشوائية السريعة. وإخفاؤها لمنشوراتٍ معادية لهرم سلطة رئيس النظام الحاكم وقائد الحزب والثورة في العراق:
"أيُّها المُغفَّلُ مَاذَا فَعلتَ بِنفسكَ؟ يَا لِهذَا الزواجِ المَشؤومِ! لِماذَا وَرَّطتَ نَفسَكَ مَعهَا. فِي تِلكَ اللَّحظاتِ حَاولتُ جَاهدَاً أنْ أِسيطرِ عِلِى نِفسِي رُغَمَ حَالةِ الغَضبِ الشَّديدِ لِسماعِي أقوالَ المًختارِ الحَقيرِ. –أنتَ مُخطئٌ، قُلتُ فَي وَجههِ، وَأردفتُ، زَينبُ إنسانةٌ عَلَى هَيئةِ مَلاكِ وَالشّيءُ الصَحيحُ الوَحيدُ الَّذي عَملتهُ فِي حَياتِي هُوَ الزَّواجُ مِنهَا". (طِفلٌ ودَفتُر ذِكرياتٍ، ص 55، 56).
كلُّ هذه الممارسات اللَّا إنسانية لأجهزة النظام الأمنية ألقت بظلالها الخطيرة على حياة هذه الفئة التي تمَّ تهجيرُها من الناس المسالمين، والذين ولِدوا أباً عن جدٍ وعاشوا في أرض العراق. حتَّى وصل بهم الحال إلى بيعِ مُمتلكاتهم الشخصيَّة وأثاثهم الخاصّ بأسعارٍ زَهيدةٍ جدَّاً؛ بسبب قصر المدَّة الممنوحة لهم من قبل أجهزة النظام، والتي لم يستطيعوا حتَّى جمع أملاكهم أو عرضها وبيعها بشكل يتيح لهم فرصةَ التَّمكُّن وإتمام إجراءاتها بحال يليق بهم وبحبِّهم لبلدهم الكبير العراق. وقد كانت حصيلة ذلك الخذلان والانكسارُ والشعورُ بالحيف والظلم والاستغلال والمضايقات لحياتهم.
تَمثُّلاتُ الفَصلِ السَّادسٍ:
المقدِّمة الافتتاحية التي اختارها الكاتب حسن الموسوي بديلاً عنن العتبة العنوانية لهذا الفصل؛ لتكون نصَّاً موازياً افتتاحياً مقارباً لمعانيه الدلاليَّة والموضوعيَّة تكاد تكون صفةً قوليةً تؤكِّد فعليَّةَ الحدث السردي وتُعزِّزُ الرأي القائل بأنَّ طبيعة الإنسان تتغير بتغيُّر وحدتي المكان والزمان التي تمرُّ به دورة حياته. وعلى وفق ذلك الأمر التوصيفي جاءت سرديَّات هذا الفصل استكمالاً عما جرى لحسين من نوائب الحزن والفقد الذي توالت زيارته لعائلته، فهذه المرَّة طالت يدُ المنون والدته التي أحبتها زوجته زينب وألفت عشرتها الاجتماعية والأسرية في أيام زواجها بالعراق:
"فبالأمسِ فَقدتُ زَوجتِي زَينبَ بَعدَ أنْ تَمَّ تَهجيرُهَا إلَى بِلادِ المَنافِي وَاليومَ فَقدتُ أُمِّي الَّتِي لَفظتْ أنفاسَهَا الأخيرةَ وَهيَ عَلَى فِراشِ زَينبَ ذلكَ الفِراشُ الَّذي هَجرتُهُ مُنذُ اليَومَ المَشؤومِ. كَانتْ آخرُ كَلماتِ أُمِّي (المُلتقَى عِندَ رَبٍّ كَريمٍ مَعَ الحُسينِ، فِي جَنَّاتِ عَدنٍ، اِبنتِي زَينبُ)". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 60).
الفقد الأخير للوالدة خلَّفَ جُرحاً عميقاً آخر لن يندمل شفاؤه لدى حسين والتي صارت الهموم والأحزان ضالته الحياتية التي راح يناجيها بأبيات من الشعر العربي القديم لامرئ القيس وأخذته مشاعر الشوق والحنين لحبيبته زينب فراح يمنَّي نفسه بأنْ تصل رسالة منها عن طريق الحجَّاج العراقيين في السعودية كما فعل قبلها رجل عراقي مُهجَّر في إيصال رسالة إلى أحبته في العراق.
تَمثُّلاتُ الفَصلِ السَّابعِ:
ارتأى الرَّاوي العليم (كاتب النصِّ) على لسان تُرجُمانه أنْ تكون مقدِّمة هذا الفصل الحديث عن بغداد التي لا يعرفها إلَّا من عاش فيها واستوعب طرقها وحفظ شوارعها وأزقتها التي دمَّرتها الحَرب وخرَّبتها صروف الدهر المفتعلة. وبما أنَّ حسين كان جنديَّاً يَخدمُ في جبهات القتال العراقي ضد الجانب الإيراني، فقد انصبَّ اهتمامه هذه المرَّة في نقل مشاهد من القصف الشديد لهذا القتال الدامي بين الطرفين المُتحاربينِ، وكانت عينته المتفرِّدة منقولةً من قاطع الشَّلامجة في مدينة البصرة التي أرخن الكاتب لحدثها التاريخي هذا في الثاني والعشرين من إبريل عام1982إذ يقول:
"كَانَ المَلجَأُ عِبارةٌ عَنْ حُفرةٍ صَغيرةٍ وقَدْ تَمَّ وَضعُ السَّقائفِ الحَديديَّةِ فُوقَهَا وَمِنْ ثُمَّ تَمَّ وَضعُ التُّرابِ عَليهَا.لِذلكَ وَمَعَ تَساقطِ القَذائفِ المَدفعيَّةِ مِنْ حَولِي، كَانَ التُّرابُ يَنهالُ عَلَى وَجهِي بِصورةٍ جَعلتنِي أُفكِّرُ أكثرَ مِنْ مَرَّةٍ بِالهُروبِ مِنْ هَذَا المَكانِ وَمَهمَا كَلّفَ الأمرُ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 65).
وإثر ذلك راح يتساءل الجندي المقاتل حسين عن رَحَى الحَربِ الدائرة، وإلى أينَ المَفرُّ منها مادام لَظاها وأوارُها مُستعِرَاً منذ سنينٍ توالت؟ وكيف يمكن أنْ تنتهيَ هذه الحرب؟ومَنْ سَيُكتبُ له النجاح من هذه المحرقة؟ ومَنْ سيكونُ حطبُها المَأكولُ؟ مشاهد كثيرة ومؤلمة من وقائع وأحداث سريَّات هذا الفصل المُعبَّأ حَربيَّاً بصفحات القتال التي أخذت أعزَّالأصدقاء والأحباب من الشُّهداء العراقيينَ وأوقعت الكثير منهم في أقفاص الأسر. ونصل في الخاتمة لنتيجةٍ مُغايرةٍ بعكس ما تتوقَّع النفوسُ:
"بَعدَ الوُقوعِ فِي الأسرِ حَزِنَ الجَميعُ إلَّا أنَا فَقَدْ كُنت فِي قِمَّةِ الفَرَحِ فَعزَائِي الوَحيدُ أنَّنِي أمتلكُ قَلبَاً لَا يشبِهُ بَقيةَ القُلُوبِ، قَلبَاً يِمتلِكُ بُوصلةً أستطيعُ مِنْ خِلالِهَا الوُصُولَ إلَى زَوجتِي زَينبَ". (طِفلٌ ودَفترُ ذَكرياتٍ، ص 72).
تَمثُّلاتُ الفَصلِ الثَّامنِ:
لم تكن مقدِّمة الفص الثامن التي جاءت سطورها السرديَّة على شكل مقطوعةٍ شعريَّةٍ مُكثفةِ الصُّور والإيحاءات والإشارات والرموز الدلالية عن اللَّحظات الإنسانية الهاربة إلَّا تعبيراً حيَّاً ونابضاً عن تلك الهواجس والتداعيات التي غمرت شخصيَّة بطل الرواية، عن تلك الأعباء والهموم التي حملها على كتفه راحلاً عبر سفينة الزمن، وهو يحمل ظنونه وشكوكه وشكواه ومقاصده المستقبلية الموقوتة، والتي هي على شفا قيد لائحة الانفجارالمفاجئ الذي يمكن أن يحدثَ لحظةٍ ما. وكل هذا الألم المُضمَّخ بالشجن الزمني مَفاده البحث عن رحلة المجهول، وهوية الفقد الزوجي:
"خِلالَ رِحلتِي إلَى المَجهولِ تَمَّ نَقلُنَا بِواسطةِ شَاحنَاتٍ عَسكريَّةٍ قَديمَةٍ، لِلَحظاتٍ شَعرتُ فِيهَا وَأنَا فِي هَذهِ الشَّاحنةِ المُتهالكَةِ بِأنَّي جَسدٌ لَا حَياةٌ فِيهَ وَأنَا مَحشورُ فِي هَذَا المَكانِ المُزدحِمِ، اَتعبنِي كَثيرَاً تَمايلُ الشَّاحنةِ وَصَريرُ عَجلاتِهَا، لَكنَّها فَقَطْ كَانتْ بِدايةَ الرِّحلةِ. رِحلةٌ جَديدةٌ مِنْ مِشوارِي المَليءِ بِالعذابِ، لكنَّنِي عَلَى يَقينٍ تَامٍ بِأنَّ تِلكَ الخُطوةَ سَوفَ تَجعلنِي قَريبَاً مِنْ زَوجتِي زَينبَ كَمَا أنَّ الأَسرَ أفضلُ أَلفَ مَرَّةٍ مِنْ نَهايةِ شَاكرِ المَأساويَّةِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 74). وشاكر هو رفيقه في مواضع القتال في جبهة الحرب التي استشهد إثر القصف الشديد على ملاجئ القتال وخنادقه.
والحدث المهمُّ في هذا الفصل عن سرديَّات الحرب ورحلة البحث عن الزوجة من خلال معسكر الحشمتية للأسر الذي وضع فيه بإيران بعد سنة من التحاقه بصفوف الجيش العراقي ومشاركته في معاركه عام 1983م.وقد تمَّ الحديث عن مثابة وعراقة هذا المعسكر الضخم جدَّاً في زمن شاهً إيران. ولكنَّ الأهمَّ في تداعيات هذا الفصل هو الحديث عما أُسِرَ من أجله، تلك هي فكرة الهروب من الأسر التي سيطرت عليه وهي الشغل الشاغل لنفسه وفكره وكثرة همِّه الحياتي واليومي بها:
"كَانَ ذَلكَ بِدايةِ شَهرِ أيلول ٍمِنْ عَامِ 1983، يَومَهَا وَضَعتُ الخُطَّةَ الَّتِي سَأعملُ عَليهَا لِمَرَّاتٍ عَديدةٍ، قُمتُ بِتأجيلِ التَّنفيذِ، مَرَّةً لِعدمِ تَوفِّرِ الخُطَّةِ البَديلَةِ الَّتِي سَأعملُ عَليهَا إنْ تَعذَّرَ العَملُ عَلَى الخُطَّةِ الأصليَّةِ، وَمَرَّةً لِظروفٍ خَارجةٍ عَنْ إرادتِي، وَأُخرَى لِظروفٍ خَاصَّةٍ بِالمعسكرِ. يَا لَهُ مِنْ أمرٍ مًريعٍ حِينَمَا أفقدُ القُدرةَ عَلَى التَّركيزِ وَقِراءةِ الأحداثِ لَأجدَ نَفسِي تَائِهَاً فِي دُروبِ الحَيرة! كَانَ أيُّ خَطأٍ وَلَوْ كَانَ بَسيطاً سَيُكلفنِي الكَثيرَ وَيُبعدُنِي أكثرَ عَنِ اليَومِ المُوعودِ، اليَومُ الَّذي سَأقابلُ فِيهِ زَوجتِي زِينبَ". (طِفلُ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 79).
وراح حسين المهجوس بفكرة الهروب من معسكر الأَسر يُخطِّط لها وخاصةً أنَّ معسكر أسرى الحشمتية لم يكن الهروبً سهلاً منه، وسيكلِّفه كثيراً فقدانه لو اُكتشفت خطَّته المزعومة، فضلاً عنْ أنَّ هذا المعسكر كونه يُعدُّ فُندقاً من الدرجة الأولى؛ لخدماته الكثيرة ونظامه الدقيق وسعته الكبيرة:
"كَانتْ خُطَّتِي تَقتضِي بِالحصولِ عَلَى حُقنةٍ طِبيَّةٍ مَعَ قَليلٍ مِنَ النَّفطِ كَيْ أحقِنَ نَفسِي تَحتَ الجِلدِ بِتلكَ القُطيرَاتِ مِنَ النَّفطِ، وَهُنَا وَاجهتنِي مُشكلةٌ كَبيرةٌ، فَمِنْ أينَ لِيْ أنْ أحصلَ عَلَى الحُقنَةِ الطِّبيَّةِ؟ وَمِنْ أينَ أنْ أحصلَ عَلَى قَطرَاتِ النَّفطِ؟ كُلُّ الأبوابِ قَدْ سُدَّتْ فِي وَجهِي، فِي لُجَّةِ الحُزنِ، اِنزويتُ بَعيدَاً عَنْ أعيُنِ النَّاسِ، لِذتُ إلَى فِراشِي، وَضعتُ رَأسِي بَينَ رُكبتِي، وَأطلقتُ العِنانَ لِدموعِي". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 79).
وبعد الاستعداد والتحضير لهذه المُهمَّة والتأجيل في تنفيذها مرَّاتٍ عدَيدةً خَوفاً من فشلها أو كشفها حانت ساعة الصفر بعد مضي شهر من ذلكَ على تنفيذها بمساعدة من أحد زملائه الأسرى العراقيين المتعاطفينَ مع قضيته العسيرة والتي باتت تلوح في الأفق بشائرها المرضية للنفس:
"وأخيراً حَانَ مُوعدُ تَنفيذِ خُطَّتِي، فِي البِدايةِ بَدأتُ بِالتَودُّدِ إلَى زَميلِي فِي الأسرِ جَاسمٍ وَالَّذِي كَانِ مَسؤولاً عَنْ إعدادِ الشَّايِ، وَكَانَ الوَحيدَ الَّذِي تَكونُ مَعهُ طُولَ الوَقتِ كَميَّةٌ مِنَ النَّفطِ الأبيضِ، هِدفِي الأولُ هُوَ مُكاشفةُ جَاسمٍ بِخُطتِي وَكَسبُ تَعاطفهِ مَعِي مِنْ أجلِ أنْ يُعطينِي قَليلاً مِنَ النَّفطِ الأبيضِ كَيْ أحقنَ جِسمِي بِهِ مِنْ أجلِ الوُصولِ إلَى المُستشفِى، هَذهِ خُطَّتِي، وَلَمْ أكنْ أعرفُ إنْ كَانتٍ سَتنجحُ أمْ لَا، وَهَلْ أنَّ تَخطيطِي صَحيحٌ أمْ لَا؟". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 87).
وبعد تجرُّع مرارة هذا المخاض المصيري العسير والحذر الشديد من كشف خطورته التي كانت شديدة السريَّة لِئِلَّا الوقوع في الفشل من جديد وفقدان ما كان يسعى لأجله، لقد حانت ساعة الفرج وانبجست عيونها أملاً ورديَّاً. لقد حانت ساعة البحث عن المجهول، ذلك اللِّقاء الموعود بشريكة عمره وحبيبته الغالية زينب. وقد حدث ما كان يُخطِّط له وأرادهُ وتمنَّاه بعد أنْ حقن نفسه بكميَّةٍ مضاعفةٍ من قطرات النفط التي نُقِلَ على إثرها إلى المستشفى بطهرانَ. وقد تمَّ له ذلك وضحك له القدرُ، وأُطلقَ سراحهُ بصورةٍ غريبةٍ؛ وذلك من خلال مساعدة أحد رجال الدين اللُّبنانيين من الذين زاروا مستشفى الأسروالتقى به حسين صدفةً وتعاطف معه دونَ تخطيطٍ مُسبقٍ لمجريات الأحداث:
"وَصَادفَ أنْ قَامَ أحدُ رِجالِ الدِّينِ اللُّبنانيينَ بِزيارةِ المَرضَى الرَّاقدينَ مَعِي ِفي نَفسِ المَكانِ، وَحِينَمَا عَلِمَ بِأنِّي عِراقِي طَلَبَ مِنَ المَسؤولينَ الإيرانيينَ الَّذينَ كَانُوا بِرققتِهِ أنْ يَطلقُوا سَراحِي، حَيثُ قَالَ بِالحرفِ الوَاحدِ لَنْ أُغادرَ إيرانَ مَا لَمْ تُطلقُوا سَراحَ هَذَا المَريضِ العِراقِي. وَبِالفعلِ استجابتْ الحُكومة الإيرانيَّةُ لِرغبةِ رَجُلِ الدِّينِ اللّبنانِي، وَتمَّ إطلاقُ سَراحِي وَأنَا غَيرُ مُصدِّقٍ لِكُلِّ مَا يَجرِي مِنْ حَولِي". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 89).
هذا المشهد السردي الكبير للرواية وغيره من المشاهد الأخرى يُعلِّل الكاتب العليم أسباب إطلاق سراح الأسير حسين بطريقة تأكيدية وتعضيد سردي لا تقبل الشكَّ أو عدم القبول بها من قبل القارئ النابه. وهذا يشي بأنَّ الكاتب الموسوي قد خبر ظروف وتداعيات الحرب وظروف الأَسر وطبيعة جبهات القتال وكيف تُدار فيها الأمور والسياقات العسكرية والقانونية والأمنية، ويعني أنَّه كان شاهداً عسكريَّاً عَياناً ورائياً فعليَّاً لآليات القتال من خِلال خدمته الإلزاميَّة ومعايشته الجمعيَّة.
تَمثُّلاتُ الفَصلِ التَّاسع ِوالأخيرِ:
آخر مُقدِّمةٍ استهلاليةٍ من مُقدِّمات نهاية تمثُّلات رواية الحُبِّ والحربِ (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ)، فضَّل الكاتب والسارد والرائي حسن الموسوي فيها أن تكون من ثالثة أثافٍ لا رابع لها في الوصول إلى نقطة البحث عن المجهول المرجوة. وتتلخَّص في طول أو قصر المسافة التي تخيَّلَها البطل للوصول إلى مثابة اللَّقاء المرتقب، وسلسلة كثرة الحواجز والعقبات والتحدَيات والصعاب والمخاطر التي سيواجهها في إكمال رحلته التي باتت أكيدة الأثر، وكيف تكون الخُطوات الأخيرة التي هَمَّ بها في لقاء الحبيبة الزوجة زينب، وما سيلاقيه بَغتةً من مفاجآتٍ صادمةٍ مُذهلةٍ ومُثيرة له؟
هذه المقدِّمات الافتراضية الثلاث التي وضعها البطل أمام نُصبِ عينيه بعد التحرير من الأسر وإطلاق سراحه كفيلةٌ بأنْ توصله خطوات البحث عن زوجته زينب وأهلها إلى ثكنة معسكر المُهجَّرينَ العراقيينَ في منطقة آباد التي يكثر فيها العراقيون من المُسفَّرين التبعية مكانها الذي سَيدلُّه عليها أحد العراقيين المُهجَرّين من سكنة منطقته الكرادة الشرقية ذاتها الأمرالذي ُيعول عليه:
"دَولةُ آبادَ كَانتْ مَحطَّتِي الأولَى بَعدَ التَّحرُّرِ مِنَ الأسرِ، وَدَولةُ آبادَ هِيَ حَيٌّ مِنْ أحياءِ العَاصمةِ طَهرانَ وَأغلبُ سُكَّانِهَا مِنَ العِراقيينَ الَّذينَ تَمَّ تَهجيرُهُم مِنَ العِراقِ بِحُجَّةِ التَّبعيةِ إلَى إيرانَ. كَالمجنونِ أخذتُ أسيرُ فِي طُرقاتِ هَذَا الحَيِّ الغَافِي عِندَ سَفحِ جَبلٍ عَظيمٍ، فٍي البِدايةِ لَمْ يَكُنْ لِي هَدفٌ سِوَى التَّأقلُمِ مَعَ هذَا الوَضعِ الجَديدِ، بُغيةَ تَنفيذِ مُخطَّطِي فِي الوُصولِ إلَى زَوجتِي زَينبَ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 92).
لقد بات الطريق سالكاً أمام حسين للِّقاء بزوجته زينب بعد أن تعرَّف على أحد العراقيين المسفَّرين لإيران من الذين يعرفون أخ زوجته عبَّاس الذي لم يَدُر بِخُلدِه أو يتوقَّع يوماً بأنّهَ سيلتقي بصديقه ونسيبه وزوج أخته حسين في رحلةٍ غريبةٍ ظروف مفاجئة لا يصدقها العقل. ثّمَّ أخذ في الحديث عن مشاهد اللقاء الأخير وتصويره إذ يقول عن هذه اللَّحظات الحميميَّة الهاربة من الزمن:
"فِي لَحظةٍ يَتيمةٍ جَالَ عَبَّاسُ بِبَصرهِ نَحوِي حِينَ رُؤيتهُ لِيْ، أُصيبَ عَبَّاسُ بِالصَدمةِ، اِغرورقَتْ عَيناهُ بِالدموعِ وَهَرولَ نَحوِي لِيستقرَّ بَينَ أحضانِي. -حُسينُ آهٍ يَا صَديقِي، آهٍ مِنْ هَذهِ الدُّنيَا الغَدَّارةِ. كَمْ اِشتقتُ إليكَ يَا صَديقِي، ثُمَّ دَلَفَ إلَى البَيتِ وَهوَ يَصيحُ –أُمِّي، أُمِّي لَقدْ جَاءَ حُسينُ. لَمْ أتمالكْ نِفسي وَأنَا أستمعُ لِصياحِ صَديقِي عَبَّاس الهِستيرِي...". (طِفلٌ ودَفترَ ذِكرياتٍ، ص 96، 97).
وحينّ استقرَّ المَقام الأخير لرحلة البحث عن هوية المجهول بحسين في بيت نسيبه وأخ زوجته المُهجَّر عبَّاس ساوره الشكُّ والريبة لعدم حضور زوجته زينب، فراح يُفكِّرُ مُليَّاً بها وتساءل قائلاً:
"لِمَاذَا وَجَّهَ عَبَّاسُ كَلامَهُ لِأُمِّه، وَلَمْ يَقُلْ زَينبُ لَقدْ جَاءَ زَوجُكِ؟ بَعدَ أنْ اِستقرَ بِيَ الحَالُ داخلَ البَيتِ، جَاءتْ أُّمُّ عَبَّاسٍ وَهيَ غَيرُ مُصدِّقةٌ بَأنَّي أقفُ أمَامَهَا، وَمَا هِيَ إلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى سَقطتْ مَغشيَّاً عَليهَا. اِنشغلَ عَبَّاسُ بِأُمِّه وَانشغلتُ أنَا بِزينبَ الَّتِي لَمْ تَكنْ مُوجودةً فِي البَيتِ. -عَبَّاسُ، أينَ زَينبُ؟ قُلتُ بِقلقٍ شَديدٍ. بَعدَ أنْ أفاقَتْ أُمُّ عَبَّاسٍ لَمْ تستطعْ أنْ تَتمالكَ نَفسَهَا، قَالْت وَالدموعُ تُغالبُهَا، لَقدْ اِنتظرَتْكَ طَويلاً؛ لَكِنْ قَلبهَا الضَعيفَ لَمْ يَستطعِ الصُّمودَ، لَقدْ رَحلتْ زَينبُ، رَحلتْ وفِي قَلبِهَا غُصَّةٌ ومَرارةٌ، قَالتْ ذَلكَ وَدَخلتْ فِي نَوبةٍ مِنَ البُكاءِ واَلنَّحيبِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 97) .
لقد عاش حسين وقع الصدمة الكبيرة المفاجئة والمذهلة التي أفقدته زوجته زينب بمرارة موجعةٍ كبيرة، ولم يكن ما ستخبئه له صروف الدهر الطارئة من مُفاجآت تعوُّضه عن فقدان زوجته التي أحبها وضَّحى من أجلها كثيراً. وأخذ عبَّاس يهدِّئه ويقلِّلُ من فعل الصدمة التي هالته كثيراً بكلمات الرحمة والعطف والإيمان فقال له:
"إنَّها مَشيئةُ اللهِ، قَالَ عَبَّاسُ وأخذنِي إلَى غُرفةِ زَينبَ، وَكَمْ هَالنِي مَا رَأيتُ، كَانَ ثَمَّةَ طِفلٌ فِي غُرفةِ زَينبَ. كَانَ هَذَا الطِّفلُ يُشبهنِي جِدَّاً، إنَّهُ يُذكِّرَنِي بِصورتِي حِينمَا كُنتُ فِي الثَّالثةَ مِنْ عُمرِي، تِلكَ الصُّورةُ المُعلَّقةُ عَلَى وَاجهةِ مُصوُّرِ الذِّكرياتِ فِي شَارعِ الكَرادةِ دَاخلِ. إنَّهُ اِبنَكَ سَجادٌ، قَالَ عَبَّاسُ وَأردفَ، لِقدْ كَانتْ زَينبُ حَاملاً فِي اليَومَ الِّذي تَمَّ تَسفيرُنَا، لَقدِ ذَهبتْ فِي ذَلكَ اليَومَ المَشؤومِ بِرفقةِ أُمِّي إلَى الطَّبيبةِ الَّتي أكَّدتْ حَالةَ الحَملِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 98).
إثر هذه المشاعر الإنسانية للحبِّ والحرب التي اختلطت بالحزن والفرح ومشيئة القدر المُخبَّأ له برزايا الفقد والعذاب، والذي أفقده أخيراً حتَّى حياته في هذه الرحلة القَدَرِيَّةِ غير العادلة حيال ما حصل له من أمرٍ جللٍ، تموت الزوجة ويُعذَّبُ البطل في رحلةٍ كبيرةٍ مضنيةٍ ومثيرةٍ آملاً فيها اللّقاء بزوجته فتُودي به في آخر المطاف وبحياته.
تلك الرحلة الإنسانية المذهلة التي جسَّدها مِخيال الكاتب حسن الموسوي في خاتمة هذه الرواية بلوحةِ تجريبٍ سرديٍّة فنِّيٍّة يَعكس فيها ارهاصات الواقعي العراقي الجمعي المعيش، والذي تمتزج فيه وتختلط مشاهد الإحساس التجريدي الفنِّي والجمالي للَّوحة رواية (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ) بالتَّخيُّلي الأُسطوري والعجائبي الغريب في رحلة سرديَّةٍ إنسانيةٍ شخصيَّة موجعةٍ نحو فاق السماء السابعة:
"فِي رِحلتِي نَحوَ السَّماءِ أخبرتنِي المَلائكَةُ بِأنَّ صَديقِي عبَّاساً قَدْ اِنشغلَ بِرفعِ جُثَّتِي مِنْ عَلَى قَبرِ أُختهِ زَينبَ، فِيمَا جَالَ اِبني سَجادٌ بِبصرهِ نَحوَ الغُروبِ وَهوَ يَنظرُ إلَى تِلكَ الجِهةِ بِغضبٍ عَارمِ". (طِفلٌ ودَفترُ ذِكرياتٍ، ص 125).
أراد الرائي الموسوي في تجلِّيات هذا المشهد الصوري الختامي المُذهل للرواية أنْ يبعث برسالةٍ لِمُتلقيه ترمز برغم مرارتها لديمومة لحُبٍّ وإلى ولادةٍ حياةٍ متجدِّدة، وحربٍ لا تنتهي من خلال هذه النظرة العارمة بالغضب إلى جهة الغروب التي يُوحي بها طفل المستقبل إنها نظرة الحياة والموت.
أساليبُ السَّرديَّةِ المَعاصرةُ:
إنَّ أهمَّ ما يميَّز سرديَّات هذه الرواية وحكاياتها القصصيَّة الفاعلة الفكر هو منظومة وقائعها الحَدثية وإنسانيتها الموضوعَّية التي خرجت فيها من مسار سكَّة الذاتية الفردية الضيِّقة إلى شِعاب الذاتية الجمعيَّة المُشتركة وانفتحت جامعتها الإنسانية المُتوحدنة على هُويَّة الآخر الثقافيَّة المتنوَّعة. أليس الفنِّ الروائي هو انعكاس صوري حقيقي وإنساني لاقطٌّ يرصد تداعيات الواقع الراهن ليوتوبيا المدينة الفاضلة وديستوبيا عقابيل الآخر الفوضوي المتسلِّط الفاسد الظالم وتجلِّياته الجمَّة؟
وفضلاً عن ذلك كلِّه كُتبتِ الرواية بلغةٍ سرديةٍ تكثيفيةٍ واضحة ماتعةٍ شائقةٍ التعبير غير مترهلةٍ بعيداً عن لغة الهذيان والتعقيد اللَّفظي والمعنوي، وبأسلوب لُغوي اقتصادي هادفٍ مكينٍ يمزج بين الواقعي التقريري والتخيلي الانزياحي البلاغي الجديد الذي يُضفي على عناصر السرد بعداً فنيَّاً وجماليَّاً أكثر إمتاعاً وطراوةً نفسيَّةً وتَقبُّلاً ذاتياً.
لقد تمكَّن السيِّد حسن الموسوي بموهبته الإبداعية ومُثابرته الفنيَّة الفذَّة من توظيف عناصره الفنيَّة المهمَّة، واستدعاء رموزه وأصواته الشخصيَّة الفاعلة، وإيصال رسالته النصيَّة في خطابه الروائي لقارئه العادي ومُتلقيه الحاذق النابه بهذا الكم العددي المحدود والكيف النوعي الروائي المُتجدِّد الذي يُراعي آليَّات القراءة وجماليات التلقِّي المعرفي في هذا اللَّون من التجنيس الأدبي.
***
د. جبَّار ماجد البهادليّ - نَاقدٌ وكَاتبٌ عراقيّ







