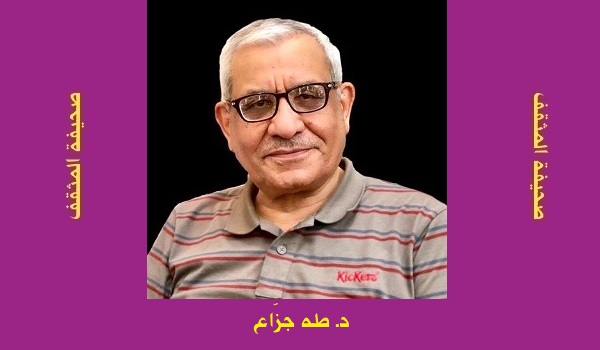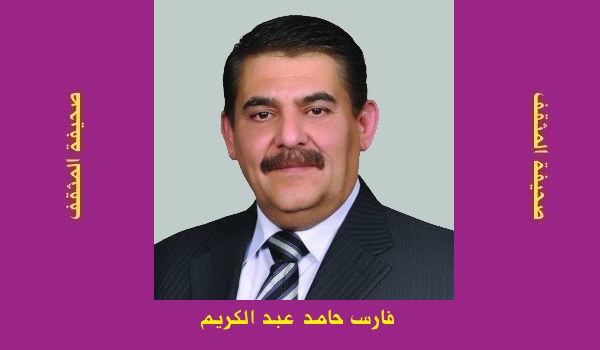قراءات نقدية
نورالدين حنيف: تناغم الدلالة والإيقاع في ديوان (ترانيم الصدى)

للشاعر منصور الفلاحي
تمهيد: السؤال المركزي الذي ينبغي أن نطرحه في كل مقاربة نقدية لعمل أدبي سواء أكان شعراً أم نثرا، وفي أيّ جنس أدبي إبداعي هو: هل قدّم هذا العمل الفني قيمة مضافة للساحة الثقافية المحلية والإقليمية والكونية أيضا؟
و في سياق هذا المبحث الخاص بديوان (ترانيم الصدى) نطرح السؤال نفسه في خصوصية نوعيّة ونقول: هل أضاف الشاعر في ديوانه جديداً للحساسية الشعرية المغربية المعاصرة؟ وهل أضاء بعض متاهاتها في أزمنة الحداثة الشعرية؟ وهل ساهم في الذائقة الفنية المرتبطة بالشعر عامة، وبقصيدة النثر خاصة؟
و الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لا ينبغي أن نحشرها في دوائر المستحيل، أو في خانات اللاممكن، أو في سديم الطوباوات الحالمة بقدر ما هي أسئلة مشروعة تتمتع بكامل المصداقية المتأتية من الصدق الفني الذي أسس لمثل هذه الأعمال الإبداعية.
وخير الجواب أن نقول إن أثر أيّ ديوان، أو أي رواية، أو أي عمل فني مغموس في مداد الجودة والفرادة، هو شبيهٌ بأثر الفراشة الذي تُحْدِثه في محيطها الأكبر والّذي لا يدعو إلى الالتفات اعتباراً لحجمها المتقزم أمام جبروت هذا المحيط. والأمر مجرد استعارة لجسد الفراشة للتعبير عن التأثير المتأتي من أصغر وَحَدَةٍ متناهيةٍ في الصغر، تمارسه على وحدَة أخرى متناهية في الكبر.
و مثال ذلك قطعة الدومينو الأولى التي بسقوطها تتسبب في سقوط منظومة الدومينوهات الأخرى ولو كانت تشكل بناءً كليًّا ينهار بفعل حركةٍ بسيطة جدا وفي غاية البساطة.
و مثله مقتل ولي عهد النمسا الّذي أدى إلى اشتعال الحرب العالمية الأولى. والأمثلة لا حصر لها في هذا المساق. يكفينا أن نقول من خلاله أن ديوان (ترانيم الصدى) فراشة. أوهو حجرٌ صغير، نرمي به على صفحة النهر الراكد، فيتغير وجه النهر. والساحة الثقافية الفنية المغربية هي ذلكم النهر.
أولاً: مدخل منهجي
قرأت ديوان (ترانيم الصدى) فأسعفني بالمنهج، على اعتبار أن النص أحيانا كثيرة يفرض خطة تناوله وتداوله وطريقة السبر لأغواره. وهي خطة بسيطة تقوم على ثلاثية التفكيك للعلامة، وقراءة العلامة ثم تأويل العلامة. وحرصنا أن تدخل هذه الثلاثية ضمن مدخليْن:
- مدخل يدرس العلامة في بنائها المزدوج، ونقصد بذلك بناء المفردة المعجمية في ذاتِها، ثم بناء المفردة التناسلية التوالدية في تداعياتِها. مثال ذلك: مفردة البحر في الديوان هي علامة معجمية، تحيل على ذاتها كفضاء مائي وواسع ومالح و... وتحيل على تداعياتها مثل مفردات الموج، الشطآن، الزبد، الغوص ... وهكذا. إن التعامل المنهجي مع هذين البناءيْن يُثرِي القراءة والتأويل.
- مدخل اعتبار النسق المعرفي المشترك بين المبدع والناقد والمتلقي، في دائرة كبرى هي تقاطع المعارف الثلاثة. وهذا شقٌّ منهجي يتعامل مع النص لا في ثباته السكوني المغلق على ثقافة المبدع وحدها بقدر ما ينفتح على هيرمينوطيقا تأويلية لمعارف الشاعر داخل دائرة التراث الإنساني العام، والذي يحضر في المتون الشعرية شئنا أم أبينا.
نستفيد من هذا أن التداعيات المرتبطة بالعلامة خارج ماهيتها الذاتية هي في عمق التحليل تأسيسٌ لموجوداتٍ مجازيةٍ ممكنة تصنعها الذات المتكلمة وتؤوّلها الذات القارئة وتقدّمها في صيغة دلالة.
فإذا وضع الشاعر منصور مفردة البحر كعلامة ذاتية تدل على وجودها المعجمي، فإنه في توجّهٍ دلاليٍّ يلقي بظلال تداعياتها أيضاً. فالبحر في سياق معيّن هو معادل موضوعي للذات المترنّحة بين مدّ الأمل وجزر الألم. وهكذا، فهذا التخريج تأويلٌ يفضي إلى بناء دلالة معينة نؤطّرها في المعادل الموضوعي الذي يمكننا من قراءة العلاقة بين البحر والذات الشاعرة، في اجتهاد لا يدّعي امتلاكا لحقيقة البحر أو لحقيقة الذات المتكلمة.
ثانياً: قراءة في الديوان
(ترانيم الصدى)1، ديوان شعري يتألف من أربع وأربعين قصيدة. هي في الأصل أربع وأربعون ترنيمة. تحاور الصدى في أكثر من منبر.
منبر الغياب – منبر الرثاء – منبر الفضيلة – منبر الحرب والكرامة – منبر الغيث – منبر العشق – منبر الموعظة والاعتبار – منبر الطبيعة ومنابر أخى لا يستقيم المقام لعدّها وإحصائها احتراما لأفق القارئ في اجتناء ما تبقى من منابر من خلال اجتهاده الخاص.
و نقول هنا، إن الشاعر منصور لم يفلت في منابره الناقدة صغيرا ولا كبيرا، حتى منبر الطرافة الهادفة والنكتة الواخزة. في مثل قصيدته الموسومة بـ (هل أتاك حديث الشمقمق؟). ص 90
أطّر الشاعر هذا الزخم في خيط فني ناظم هو خيط عشق الجمال في فيزيائه وفي روحانيته. في معناه وفي فائض معناه. في أبعاده الواقعية وفي أبعاده الدلالية الرامية إلى فعل الترميز البنّاء...
1 – قراءة في الإيقاع
الإيقاع في منظور الشاعر منصور الفلاحي اجتهاد موسيقي لا يمتح مصداقيته من مرجعية خليلية ماضوية. فهو لا ينتج نصًّا شعريا موزونا ينتمي إلى التقليد الإيقاعي القديم. وإنما يبدع قصيدة في مجال إيقاعي حداثي يصنع لذاته قوالبه الموسيقية الخاصة والمعتمدة بالدرجة الأولى على:
* وحدة الروي والقافية: يمارس الشاعر منصور هذه الوحدة الايقاعية داخل اختيارين. الأول يتعلق بوحدة الروي في المقطع ( وقد حضر في 34 قصيدة). وهو السائد. والثاني يرتبط بوحدة روي القصيدة، وهو النادر (10 قصائد). ومثاله القصيدة رقم 1، (أأصبحنا ظلال أحلامهم؟)
و في التوظيفيْنِ معاً يتجلى اجتهاد الشاعر منصور في إخراج الشعر من مرتبة الخطاب اليومي إلى مراتب شعرية الخطاب عبر مجموعة من الآليات وأولها آلية الإيقاع.
ولم يعتمد في هذه المهمة الفنية على المرجعية الخليلية لا تنقيصا أو تبخيسا، وإنما اختياراً لمرجعية ذاتية تمتح مادّتها المعرفية من أذن الشاعر ومن تمثلاته الخاصة لفن الإيقاع. وكأنه في كل (الترانيم) يسعى إلى بناء القصيدة المموسقة والمشروطة بفعل الغناء والشدو.
* إيقاع التناغم الدلالي
ليس من الضرورة أن تكون حركة النص أو الديوان جارية على وتيرة واحدة. وإنما الجميل في هذه الترانيم أن الشاعر منصور عرض نصوصه الشعرية داخل منعطفات دلالية متنوعة. هي في عمق التأويل اهتزازات تنشأ عن خصوصيات مقطعية تدل على أن الشاعر اشتغل في تدبيج ترانيمه في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة.
زمن التأليف عدد القصائد
2015 2
2016 4
2017 5
2018 3
2019 2
2020 7
2021 7
2022 6
2023 8
مكان التأليف عدد القصائد
سوق الاربعاء 2
أكادير 31
مراكش 2
مولاي بوسلهام 2
الرباط 1
قصيدتان بدون تحديد زمن التأليف
و ست قصائد بدون تحديد للمكان
هذا الانتقال في زمن التأليف وأمكنته يسهم في تغيير حركية الديوان وينوّع في طبيعة الأثر في المتلقي. ويسلط بعض الضوء على طبيعة الاعتمال وظروفه وشروط إنتاج القصيدة فيه.
و بخصوص مفهوم التناغم الدلالي فقد عبرت عنه الناقدة (خالدة سعيد) بقولها: " هو جزء من الإيقاع. وهو عنصر يتعلق بتوالي الموضوعات على نسق معيّن بموجب حركة نفسية معينة" 2
نأخذ على سبيل المثال موضوعة الأهل والأسرة والموت والفراق في الديوان.
- القصيدة 2 --- بعضٌ منّي --- ص 16
- القصيدة 31 --- سلام عليكم --- ص 76
- القصيدة 32 --- أيّ طعم للعيد --- ص 77
و هي قصائد مشبعة بتقنية التناغم الدلالي، وإطلالة خفيفة على متونها تشرح المفهوم وتقرّبه دون عناء.
إن إدراك هذا الايقاع يكون في معظم الحالات فرديا لا جماعيا، ويكون خاضعا في معظم الحالات لشرط التأويل الأول الذي قلنا فيه بوجود الدلالة في وضعٍ تأجيليٍّ لا يدّعي الإطلاق والقطعية والتعميم. ذلك أن الأخيلة تختلف وهي دائما منفتحة على أكثر من تصوّر وأكثر من تمثّل ...
* إيقاع التقابل
تُعدّ التقابلات من عُرى المعنى وأواصره. لها أثرها ووقعها في النفس نظرا لما فيها من توازٍ تُنتجه المجاورة على نحو من التقابل بين مفهوم وآخر، بين حالة وضدّها. في إطار تباينٍ شعريٍّ يُغني إمكانيات الشاعر الإبداعية ويفتحها على مزيدٍ من البناء والخلق الشعري.
و في هذا المنحى ركز الشاعر منصور على العناصر الشعورية والنفسية ليعبر عن الصراع والاضطراب الذي يغزو المجتمع المعاصر، مستغلا بذلك مظاهر التناقض في الحياة والوجود والكون.
من هنا خصوصية الأداء الشعري المنصوري الخارج من ربقة التضاد اللغوي الجاهز قاموسيًا إلى أفق التحليق بالتضاد والتقابل في سديم الإبداع لاجتناء أكثر من دلالة تشرَح وتُشرّح المعنى وفائضه.
و الأمثلة هنا غزيرة، نذكر منها:
ص 15 – (غادروا – عادوا )
(قولوا لهم صبحاً كنّا فأمسيْنا)
ص 21 – (قد يأتي الذي انتظرناه
أو قد لا يأتي وكالعادة)
ص 24 – وهبتك الجسد والروح
و أفضت بالسر والبوح)
ص 25 – (أنا الظاهر المستتر بلا صوت)
ص 31 – ها هنا ظلم
و صفح ولوم)
ص 33 – (حمم وبركان
بردا وسلاما)
...
و يكاد الديوان في كله وجله ينطق بهذا الإيقاع التقابلي الذي لا نستطيع محاصرته إحصاءًا وإجمالا. وتفيدنا هذه التقابلات أمريْن:
هي تؤطر سمعنا داخل صيرورة موسيقية تقابلية لا تهتم بالبذخ السمعي المؤثّث للأذن العربية الملتقطة لعناصر الجمال بقدر ما تذهب بها مذاهب التغيير في الحساسية الموسيقية المغموسة في عمق الدلالات والأبعاد؟
هي تؤطر نفسياتنا في استقبال تناقضات الوجود والماحول والحياة، وتدفعنا بملمسٍ حريريٍّ إلى تبنّي موقف معيّن لا نحدّده ولكن نقدر على تصنيفه داخل إطار عشق الجمال.
هي تؤطر الدلالات البعيدة لرؤيا الشاعر ولرؤانا في توجّهٍ لا يستهلك بل يعيد إنتاج التقابلات داخل بحر التأويل الممكن.
* إيقاع التوازي
التوازي هو التشابه القائم على تماثل بنيوي في بيت شعري أو في مجموعة أبيات شعرية. وعادة ما يكون التشابه بين المتوازيينِ باعتبارهما طرفين متعادلين في الأهمية من حيث المضمون والدلالة، ومتماثلين من حيث الشكل في التسلسل والترتيب.
و منه:
أ – التوازي الصوتي: مثل ما جاء في الديوان (مفاخ، مباخر) – (قؤول، صؤول) ...
ب – التوازي التركيبي: وبتعلق بالتوازي بين وحدتين دلاليتين، ومثله في الديوان: (أنا المهاجرالسابح في الوقت – أنا المنتظر بين طوابير الموت)...
د – التوازي الدلالي: وهو التماثل بين وحدتين دلاليتين في محور واحد. ومثله في الديوان ( يا ريح أي زئير- يا ريح أي أنين)...
إن فعالية الإيقاع في ترانيم الصدى لا تقف عند حدود النص في تشكله وانسجامه الصوري. وإنما تتعداه إلى الإحالة على دلالات البنية الشعرية سواء تعلقت بتوصيف الواقع في تناقضاته أو تعلقت بالسباحة في المخيال الشعري بديلا عن تعفّنات هذا الواقع.
الإيقاع هنا ليس حليةً تلبسها الترانيم
الإيقاع هنا حتمية صوتية شعرية وجودية.
* تداعيات العتبة
و قد أحسن الشاعر منصور وهو يدمج هذا التراكم في عنوان جامع مانع ومعبر ومحاصر لأقانيم البوح حصارا حريريا ناعما وواخزا في نفس الآن.
و هو عنوان موسوم في وعي الشاعر بعبارة غير بريئة. ونقول ذلك لأن الشاعر هنا لا يتحدث من مساحة الإمتاع والمؤانسة الشعرية المدغدغة لعواطف المتلقي. إنه كائن ورّط ذاته في مفهوم الجمال السائل والمتسائل والواضع لكثيرٍ من البداهات موضع السؤال. من هنا نقول بلا براءة صوغ العنوان. لأن المسألة لا تتعلق بعرض الترانيم للاستمتاع وإنما بوضعها رهن إشارة المتلقي لمساءلتها في توجهاتها الكاشفة عن أسرار هذا الصدى الذي أُسندت إليه الترانيم. فكيف نستوعب الصدى وهو مجرد رجعٍ للصوت؟ وكيف يتحول الصدى من حالة فيزيائية إلى حالة كاشفة في عمق الدلالة الوجودية عن تجليات هذه الذات المتكلمة والمخاطَبة في نفس الآن؟
و الترانيم جمع ترنيمة، وترنم المغني يعني رجّع الصوت وتغنّى به في تطريب وتحنان. وأما الصدى فله معنيان الأول يرتبط بالعطش الشديد، والثاني وهو ما يرومه الشاعر ويتعلق برجع الصوت يرده جسمٌ عاكس كالجبل أو المغارة أو الفضاء الواسع. وحتى الصدى بمفهوم العطش قد يجد مصداقيته الدلالية في الديوان بحكم عطش الشاعر وقصائده وترانيمه لقيم الجمال والحق والخير في محيط تنكر لهذه القيم.
و هي القيم التي باتت منعدمة أو تكاد في سياق وجودٍ عار من القيم.
و أما الصدى بمفهوم رجع الصوت فأولى وأجدر، بحكم ارتباطه في التركيب بالترنيمة. ويكون التجانس التركيبي والدلالي في العتبة أجدر وأولى بالتبنّي من أي تخريج آخر. فكلاهما خارج من حقل الصوت.
فلمَ أسند الشاعر الترانيم إلأى الصدى ولم يسندها للواقع؟ لأن مساق طرح السؤال هو حقنا في الاستفهام كقراء نحمل همّ التأويل. والجواب (في نسبيته – أن الصدى ليس حقيقة بقدر ما هو وهم حقيقة، والدليل تبخّر الصوت في الفضاء. وهو تبخّرٌ لا يترك لنا إلا فسحة قصيرة من الاستمتاع برجعه وهو يسير في اتجاه قدر التلاشي، فنكون في وضع المستمتع بوهم الصوت لا بالصوت ذاته في وجوده الفيزيائي والحقيقي. ولا يكون الأمر حينها إلا لعبا يفسح أمامنا مزيدا من الرغبة في تركيم حالات الصراخ برجعه الجميل وهو يدغدغ فينا أسماعنا وبعض دواخلنا.
من هنا مكر الشاعر منصور على اعتبار أن عنوانه (ترانيم الصدى) ليس بريئا كما أسلفنا. إنه يدين الترانيم كما يشجب الأغنيات والقصائد التي لا يتجاوز أثرها حدود الرجع والترديد الجميل الحامل لدلالة الترف والترفيه والإمتاع فقط. وكأن الشاعر يدعونا إلى تجاوز القصائد التي تقف عند حدود الجمال القشوري إلى معانقة القصائد التي لا تتبخر في السديم الواهم بقدر ما تكون نداءاتٍ متجذرة في الواقع وملتصقة به والعاملة في دأَبٍ مستمر على تغييره أو التحسيس بضرورة تغييره في أضعف الإيمان.
هكذا فالعنوان فاضح في أول التجلي لغائية الديوان، ولرسالة الديوان، ولهدفيته البعيدة والمتجاوزة لفعل الشبه والتكرار في ساحات الإبداع.
من هنا يحق لنا طرح السؤال التالي:
لِمَ قال الشاعر (ترانيم الصدى) ولم يقل (صدى الترانيم)؟ قد يبدو الأمر جانبيا وهامشيا بغير قيمة مضافة، أو قد يبدو متشابها ولا حاجة لطرحه... إن جمالية العبارة في ترانيم الصدى هي أشد وقعا بلاغيا على المتلقي من تقديم ملفوظة (الصدى) في التعبير. لأن الإدانة في العبارة الثانية تكون كالتالي:
الإدانة --- الترانيم --- الإنسان
الإدانة --- الصدى --- الطبيعة
والطبيعة بريئة، وأما العامل الموضوع في قفص الاتهام فهو الإنسان الذي صنع الترانيم خارج الواقع. ولم يضعها في الموعد الثقافي كي تمارس أدوارها في عمليات التغيير. من هنا أثر الفراشة في الترانيم السابقة للصدى في التركيب.
* في اجتراح الدلالة
وهذا باب إذا فتحناه فلا مكنة لنا بإغلاقه أو إيصاده نظر لزخم الدسم الفني فيه. وسنختار منه ما يلي إيثارا للاختزال والإيجاز.
أ – دلالة تكسير التوقع: أو أفق انتظارات المتلقي. فمن الشعراء من تقرؤه من عنوان ديوانه، ومنهم من لا يسلمك مقاليد دلالاته إلا بعد لأيٍ وتقصٍّ وبحثٍ وتنقيب. والأجدر فيهم من يعطيك انطباعا بالسهل الشعري فإذا هو متمنّع وممتنع حتى يشحذ القارئ مباضعه لممارسة عمليات التشريح للخطاب الشعري في متونه.
قال الشاعر منصور في كثير مما قال:
مات بعض من بعضي
و بعضٌ من بعضِ بعضي ص 18
و فيه فائدتان: واحدة دلالية تنوع في الخطاب وتحترم المتلقي الذكي وتحشره في عمليات إنتاج المعنى... والثانية صوتية تلعب لعبة التكرار في فونيمات الضاد والعين والباء... وفي كلا الحالتين يكسر الشاعر أفق انتظار المتلقي ويحوّل مجرى التفاعل فيه إلى مجارٍ أجرى من مجريات نهر القول.
ب – مقولة التوتّر: بوعيٍ فني من الشاعر يصنع مسافة توتر على حد تعبير الناقد (كمال أبوديب) بين مقولة الأحلام وبين مقولة الطي.
قال الشاعر:
و تلك الأحلام طواها الزمن
مجهضة بلا سترٍ بلا كفن ... ص 25
فهذه الأخيرة تستدعي مفعولا متشيئاً قابلا لفعل الطي، فكيف تُطوى الأحلام؟ بل كيف يمارس الزمن هذا الفعل المادي والحسي على غير ممكن يتسم بالتجريد والزئبقية؟
فالأحلام مصنوعة من مادة التخيل، والطي فعل حسي، فكيف يلتقيان؟
من هنا عبقرية الشاعر وهو يفتح المجال أمام اللاممكنات لتتحول إلى ممكنات، في رحم الإبداع الشعري القائم على فعل التخييل المجنّح. ذاك أن سياق الورود والتداول يتغير. فقولنا بالطي الواقع على الأحلام مستحيل في سياق الحقيقة، ولكنه ممكن جدا في سياق الخيال. والشعر هو الباب الواسع لاستقبال العبارة في جنوحها المحلق كيفما كان تحليقها ومهما شطّت في هذا التحليق الهيولى.
* خاتمة:
الديوان كتلة من الهمس في أذن الوعي الذاتي والإنساني. خطاب جمالي لمعانقة فن القيمة قبل اندحارها وهزيمتها في مجال الإبداع، وقبل انسحاقها وتلاشيها في مجال الوجود.
و الشاعر منصور الفلاحي يتغيّى في هذا الديوان إدانةَ الآخر في تخليه عن عشق الجمال عبر تخليه عن القضايا الحاسمة في وجوده.
فهو لا يقدم لنا ديوانا مكتظا بالكلمات والمفردات المعزولة والمغرّبة بقدر ما يقم لنا صرخة حريرية تدعو إلى اعتناق مذهب التفاؤل بالآخر والإيمان به في عشق القيم.
و الشاعر يمارس العتاب واللوم في غير تجريح، وينتقد الماحول في تشريح راقٍ وواعٍ بحجم الخسارة والهزيمة الذاتية والغيرية، داخل رؤيا فنية ووجودية تقيم عالما جديدا على أنقاض واقع مرفوض.
***
بقلم نورالدين حنيف أبوشامة
..................
إحالات:
1 – منصور الفلاحي، ترانيم الصدى، ديوان شعر، مطبعة وراقة بلال، فاس، المغرب، الطبعة الأولى 2024
2 – خالدة سعيد، حركية الإبداع، دار الفكر للطباعة والتوزيع، بيروت، 1986، ص 108